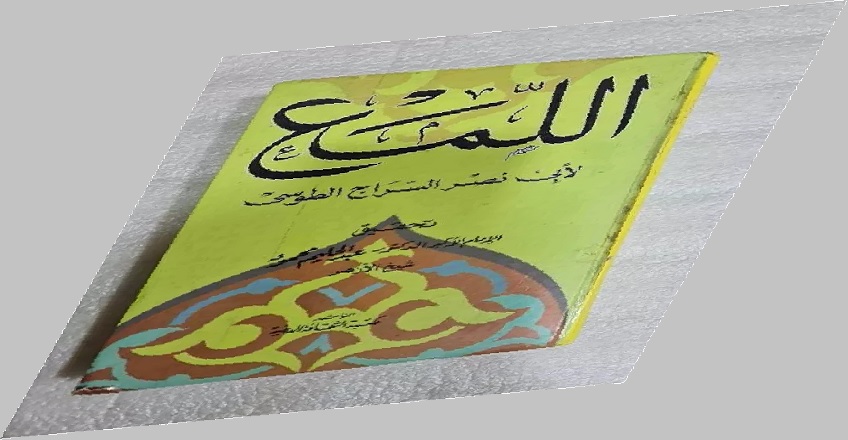أحكام التوبة
التوبة فرض على كل من قارف محظورا كبيرا كان أو صغيرا عندما يذنب، وتأخيرها عن وقتها ذنب آخر.
وقد تقدم الكلام في حقيقتها في اللسان بأنها الرجوع.
وهي في الشرع: «الرجوع عن معصية الله تعالى إلى طاعته».
وإذا أضيفت إلى أفعال الله تعالى فهي: «رجوع إنعامه على عباده بالتوفيق لها، والقدرة عليها لتحصل لهم سلامة العاقبة»، وحدّها: «الندم على المعصية لأجل ما يجب له الندم»؛ وهي رعاية حق الله تعالى على التجريد، فقد يندم المذنب على إخلال ببدنه أو بعرضه أو بماله ... إلى غير ذلك، وليس ندما شرعيا، ولا يزيل من عنقه ربقة الإصرار حتى يكون ندمه لأجل ما فرط في جنب الله تعالى.
وحقيقة الندم: «كراهة الذنب الواقع والتلهف عليه والتألم من أجله، ثم يلازم هذه الأحوال عزم على أن لا يعود لما ندم عليه حتى يعود اللبن في الضرع».
فإن قيل: فإذا كان قطب التوبة الندم وهو ألم، والآلام ضرورية لا تكتسب، فكيف يتعلق الأجر بما لا يكتسب، والرب تعالى قد ربط الأجور بالمكتسبات؟
فالجواب أن الضروريات على ضربين: منها ما يقع بسبب مكتسب، ومنها ما يقع بسبب ضروري أو بغير سبب؛
فالذي يقع بسبب ضروري أو بغير سبب لا يقع فيه من جهة التكليف أجر ولا إثم.
والذي يقع بسبب كسبي من الطاعات يكون عليه الأجر، كالندم على مقارفة الذنب.
فإذا كان المذنب يستصحب الفكر فيما ضيع من حق الله تعالى، وكيف اقتحم المعصية بمرأى من البارئ تعالى ومسمع ... إلى غير ذلك مما يتوقع من المقت وسوء العاقبة، فلا جرم أنه يكره وقوع الذنب، فيخلق الله تعالى له تلك الكراهة ألماً على مجرى العادة، فيتعلق الأجر على تفكره وكراهيته وألمه.
وهذا بمثابة العلم الحاصل عقيب النظر على مذهب من قال: إنه يحصل ضرورة، فكل ما وقع بواسطة الكسب فحكمه حكم الكسبي في الثواب عند الجماعة، فهذه حقيقة التوبة.
ثم تكون التوبة نصوحاً؛ وهي الخروج عن جميع الكبائر والصغائر، والندم على جميعها، وهي التوبة الكاملة، وتسميتها نصوحا مأخوذة من النصاح، وهي المخيطة إذا تخلصت من الثوب لا يتعلق بها منه شيء، وهي التي أمر الله تعالى بها جمهور الموفقين فقال: ﴿يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا﴾.
وقد تصح التوبة من الذنب مع البقاء على ذنب آخر، ما لم يكن من نوع الذنب الذي تاب منه، فإنه قد يتأكد الوعيد على بعض الذنوب، كما جاء في القتل، وأكل أموال اليتامى، ... إلى غير ذلك.
فيبادر المذنب إلى التوبة لتأكيد الوعيد، وهذا هو مذهب أهل الحق خلافاً للبهشمية، فإنهم قالوا: لا تصح التوبة حتى تكون من جميع الذنوب ـ على مذهبهم في التحسين والتقبيح ـ.
وأما القبول فمظنون لا مقطوع به، وزعمت المعتزلة أنه يجب على الله قبول التوبة، وقد سبق الكلام في نفي الإيجاب على الله تعالى بشهادة العقل.
وأما دليل السمع فإجماع الأمة على الرغبة إلى الله تعالى والابتهال في قبول التوبة، وقد ورد في الكتاب الدعاء والابتهال، قال تعالى: ﴿وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل من إنك أنت العليم﴾، وقال تعالى: ﴿ربنا وتقبل دعائي﴾، وقال: ﴿واجنبني وبني أن نعبد الاصنام﴾، وقال في قصة أم موسى: ﴿فتقبل مني إنك أنت السميع العليم﴾ ... إلى غير ذلك.
فهذه رغبات إلى الله تعالى، والتوبة عمل من الأعمال، فلو كان يجب على الله تعالى قبول التوبة لما كان في الرغبة والابتهال إليه فائدة.
فقد صح القطع بنفي الوجوب على الله تعالى عقلا ونقلا، وبقي الجواز والتنصل والرغبة إلى الله تعالى في القبول.
وأما ثبوت القبول لآحاد التائبين إذا تمت التوبة على شروطها فمظنون، إلا لمن نص الله تعالى على قبول توبته، كما نص في الكتاب على الثلاثة الذين خلفوا، وعلى أصحابهم من المهاجرين والأنصار.
ثم إن التوبة على المذنبين واجبة شرعا لا عقلا ـ كما زعمت المعتزلة ـ أنها تجب عقلا، والدليل على وجوبها من السمع، إجماع الأمة على وجوب ترك الزلات والندم على ما تقدم منها والعزم أن لا يعود المذنبون إليها.
ثم العجب من تناقض المعتزلة حيث أوجبوا على الله تعالى قبول التوبة عقلا، والقبول عبارة عن الثواب في الجنة ـ كما تقدم في شرح القبول ـ ، ثم أوجبوا على الله تعالى أن يخلد من مات مصرا على كبيرة في النار أبدا، ولو تقدمت له التوبة من جميع الذنوب، فإذا كان قبول ما تقدم من الثواب واجبا على الله تعالى، والثواب في الجنة، فمتى يوفى أجر التوبة في الآخرة مع الخلود في عذاب الجحيم إلى الأبد؟ فنعوذ بالله من شر التناقض ورعونة السفسطة.
وأما ما يتعلق من الذنوب بالغير وبما يختص بالنفس دون الغير، فقد تقدم الكلام فيه عند الكلام في كيفية الحساب، ومن تاب من الذنب ثم رجع إليه، فقد برئت ذمته من الذنب الأول وصحت توبته، وكان الرجوع إلى الذنب ذنبا آخر تجب عليه التوبة منه. والغرض من ذلك أن تعلم أن التوبة عمل برأسه، فإذا تم على شروطه لم يحبطه ذنب آخر، لا يحبط الطاعات إلا الكفر، لكونه ضد الإيمان الذي هو شرط في قبول الطاعات، قال تعالى: ﴿ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أشركت ليحبطن عملك﴾.
وزعمت الخوارج ومعظم المعتزلة أن المعصية تحبط الإيمان وجميع الطاعات، وليت شعري أي معصية سوى الكفر توازي الإيمان وأجره حتى تحبطه؟! وأيضا إنها خلافه، فتجتمع معه في المحل، على أن هذا لا يصح على مذهبهم، فإن فيه إحباط أكبر العمل بما هو دونه، وهذا هو محض الظلم على مذهبهم، فلا حرج من الإيمان إلا الكفر الذي هو ضده.
من كتاب مقدمات إلى علم العقائد لأبي الحسن علي بن أحمد بن خمير السبتي (ت614هـ/1217م) تحقيق الدكتور جمال علال البختي مطبعة الخليج العربي ـ تطوان ـ الطبعة الأولى 1425هـ/2004م (ص374-377).