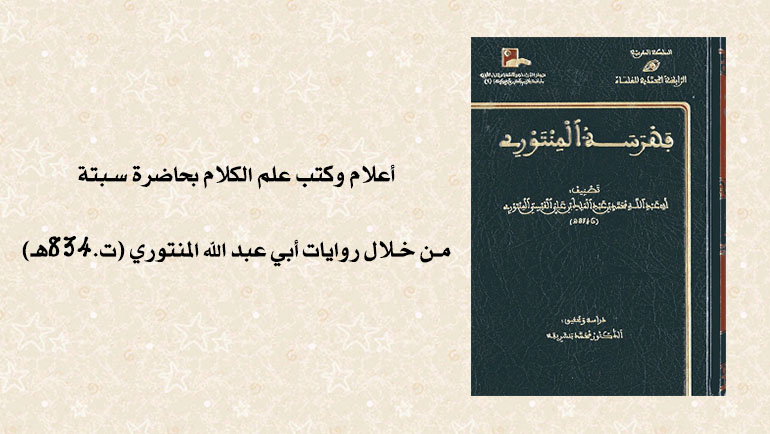نفي التساوي في القرآن الكريم من خلال بعض النماذج [الحلقة الثانية]

نماذج من القرآن الكريم: في نفي التساوي:
يوجد في القرآن الكريم ما لا يعد ولا يحصى من نماذج وشواهد وأمثلة تدل على نفي التساوي، والقرآن الكريم بحر في ذلك، وفي هذا السياق يقول ابن القيم الجوزية رحمه الله: «نفي التساوي في كتاب الله تعالى قد يأتي بين الفعلين كقوله تعالى: «أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ» [التوبة:19]. وقد يأتي بين الفاعلين نحو: «لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ» [النساء: 94]. وقد يأتي بين الجزئين كقوله «لاَ يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ» [الحشر: 20]. وقد جمع الله بين الثلاثة في آية واحدة وهي قوله تعالى« وَمَا يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِير وَلاَ الظُّلُمَاتُ وَلاَ النُّور وَلاَ الظِّلُّ وَلاَ الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الأَحْيَاءُ وَلاَ الأَمْوَاتُ»[فاطر: الآيات 19-20-21-22 ]. فالأعمى والبصير الجاهل والعالم والظلمات والنور الكفر والإيمان والظل والحرور والجنة والنار الأحياء والأموات والمؤمنون والكفار[1].
ويذكر الدمشقي أن نفي التسوية بين الفعلين أَو الفاعلين أَو الجزئين إِن رجع إِلى تفاوتهما فِي الرتبة دل على تفضيل أحد الفعلين على الآخر، وإن رجع إلى الثواب والعقاب دل على الأمر والنهي، وإن رجع إلى مدح أحد الفعلين وذم الآخر رجع إلى أن أَحدهما مأمور والآخر منهي[2].
ومثال نفي التَّسوِيَة بَين الفعلين قوله تعالى: « أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ يَسْتَوُونَ عِندَ اللّهِ» [التوبة: 19] وفيها يرجع إلى الثواب والعقاب وهذا يدل على الأمر والنهي، ومعنى الآية إنكار أن يشبه المشركون بالمؤمنين، وأعمالهم المحبطة المثبتة، ولما نفى المساواة بينهما أوضح بقوله: «وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِين»[التوبة: 19] من الراجح منهما، وأن الكافرين بالله هم الظالمون ظلموا أنفسهم بترك الإيمان بالله، وبما جاء به الرسول وظلموا المسجد الحرام، إذ جعله الله متعبدا له، فجعلوه متعبدا لأوثانهم، وذكر في المؤمنين إثبات الهداية لهم بقوله: «فَعَسَى أُوْلَـئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِين» [التوبة: 18]، وفي المشركين هنا نفي الهداية بقوله: «وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِين»[3].
وظاهر هذه الآية يقتضي أنّها خطاب لقوم سَوَّوا بين سقاية الحاجّ وعمارة المسجد الحرام وبين الجهاد والهجرة، في أنّ كلّ ذلك من عمل البرّ، فتؤذن بأنّها خطاب لقوم مؤمنين قعدوا عن الهجرة والجهاد، بعلّة اجتزائهم بالسقاية والعمارة.
ويوضح الشيخ الطاهر ابن عاشور أن ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر ليس لأنه محل التسوية المردودة عليهم لأنهم لم يدعوا التسوية بين السقاية أو العمارة بدون الإيمان، بل ذكر الإيمان إدماج، للإيماء إلى أن الجهاد أثر الإيمان، وهو ملازم للإيمان، فلا يجوز للمؤمن التنصل منه بعلة اشتغاله بسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. وليس ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر لكون الذين جعلوا مزية سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام مثل مزية الإيمان ليسوا بمؤمنين، لأنهم لو كانوا غير مؤمنين لما جعلوا مناصب دينهم مساوية للإيمان، بل لجعلوها أعظم وإنما توهموا أنهما عملان يعدلان الجهاد، وفي الشغل بهما عذر للتخلف عن الجهاد، أو مزية دينية تساوي مزية المجاهدين[4].
وقد دل ذكر السقاية والعمارة في جانب المشبه، وذكر من آمن وجاهد في جانب المشبه به، على أن العملين ومن عملهما لا يساويان العملين الآخرين ومن عملهما. فوقع احتباك في طرفي التشبيه، أي لا يستوي العملان مع العملين ولا عاملوا هذين بعاملي ذينك العملين. والتقدير : أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كالإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله، وجعلتم سقاية الحاج وعمار المسجد كالمؤمنين والمجاهدين في سبيل الله. ولما ذكرت التسوية في قوله : «لا يستوون عند الله» أسندت إلى ضمير العاملين، دون الأعمال لأن التسوية لم يشتهر في الكلام تعليقها بالمعاني بل بالذوات.[5].
ومثال التَّسوية فِي رتبة الثواب قَوْله: «لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ » [النساء: 94] فنفى سبحانه وتعالى التسوية بين المؤمنين القاعدين عن الجهاد وبين المجاهدين، ثم أخبر عن تفضيل المجاهدين على القاعدين درجة ثم أخبر عن تفضيلهم عليهم درجات.
وفيها ذكر أبو حيان الأندلسي بيان فضل المجاهد على القاعد وبيان تفاوتهما وأن ذلك لا يمنع منه كون الجهاد مظنة أن يصيب المجاهد مؤمنا خطأ، أو من يلقى السلم فيقتله بتأويل فيتقاعس عن الجهاد لهذه الشبهة، فأتى عقيب ذلك بفضل الجهاد بما ذكر في الآية من الدرجات والمغفرة والرحمة والأجر العظيم دفعا لهذه الشبهة، ويستوي هنا من الأفعال التي لا تكتفي بفاعل واحد، وإثباته لا يدل على عموم المساواة وكذلك نفيه، وإنما عنى نفي المساواة في الفضل، وفي ذلك إبهام على السامع، وهو أبلغ من تحرير المنزلة التي بين القاعد والمجاهد، فالمتأمل يبقى مع فكرة ولا يزال يتخيل الدرجات بينهما، والقاعد هو المتخلف عن الجهاد، وعبر عن ذلك بالقعود، لأن القعود هيئة من لا يتحرك إلى الأمر المقعود عنه في الأغلب، وأولو الضرر هم من لا يقدر على الجهاد لعمى أو مرض أو عرج، والمعنى: لا يستوي القاعدون القادرون على الغزو والمجاهدون[6].
ومن المعلوم كما ذكر الزمخشري أن القاعد بغير عذر والمجاهد لا يستويان، فما فائدة نفي الاستواء؟ يقول: معناه الإذكار بما بينهما من التفاوت العظيم والبون البعيد، ليأنف القاعد ويترقع بنفسه عن انحطاط منزلته، فيهتز للجهاد ويرغب فيه وفي ارتفاع طبقته، ونحوه: «هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ» [الزمر:10] أريد به التحريك من حمية الجاهل وأنَفَته ليهاب به إلى التعلم، ولينهض بنفسه عن صفة الجهل إلى شرف العلم فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِينَ جملة موضحة لما نفى من استواء القاعدين والمجاهدين كأنه قيل: ما لهم لا يستوون، فأجيب بذلك. والمعنى على القاعدين غير أولى الضرر لكون الجملة بيانا للجملة الأولى المتضمنة لهذا الوصف وَكُلًّا وكل فريق من القاعدين والمجاهدين وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنى أى المثوبة الحسنى وهي الجنة وإن كان المجاهدون مفضلين على القاعدين درجة[7].
واختلفوا هل أولوا الضرر يساوون المجاهدين أم لا، فإن اعتبرنا مفهوم الصفة، أو قلنا من أن الاستثناء من النفي إثبات لزمت المساواة، وقال ابن عطية: وهذا مردود، لأن أولي الضرر لا يساوون المجاهدين، وغايتهم إن خرجوا من التوبيخ والمذمة التي لزمت القاعدين من غير عذر، وكذا قال ابن جريج: الاستثناء لرفع العقاب، لا لنيل الثواب، المعذور يستوي في الأجر مع الذي خرج إلى الجهاد، إذ كان يتمنى لو كان قادرا لخرج، قال: استثنى المعذور من القاعدين، والاستثناء من النفي إثبات، فثبت الاستواء بين المجاهد والقاعد. وإنما نفي الاستواء فيما علم منتف ضرورة، لإذكاره ما بين القاعد بغير عذر والمجاهد من التفاوت العظيم، فيأنف القاعد من انحطاط منزلته، فيهتز للجهاد ويرغب فيه، ومثله: «قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ»[ الزمر: 10]، أريد به التحريك من حمية الجاهل، وأنفته لينهضهم إلى التعلم، ويرتقي عن حضيض الجهل إلى شرف العلم[8].
ومثال نفي التسوية بين الجزئين قوله تعالى: «لاَ يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ»[الحشر: 20] وقد نفى الله تعالى في هذه الآية أن يكون تساوي بين المؤمنين وغير المؤمنين، فجاءت الأداة لتبين ذلك، وهذا ما أبرزه الصابوني في تفسيره:« فلا يتساوى يوم القيامة الأشقياء والسعداء، أهل النار وأهل الجنة، أهل الجنة في الفضل والرتبة، أي أصحاب الجنة هم الفائزون بالسعادة الأبدية في دار النعيم وذلك هو الفوز العظيم»[9].
فلما تم الدليل على أن حزب الله هم المفلحون لما أيدهم به في هذه الحياة الدنيا من النصر والشدة على الأعداء واللين والمعاضدة للأولياء وسائر الأفعال الموصلة إلى جنة المأوى، وصرح في آخر الدليل بخسران حزب الشيطان فعلم أن لهم مع هذا الهوان عذاب النيران، وكان المغرور بعد هذا بالدنيا الغافل عن الآخرة لأجل شهوات فانية وحظوظ زائلة عاملا عمل من يعتقد أنه لا فرق بين الشقي بالنار والسعيد بالجنة لتجشمه التجرع لمرارات الأعمال المشتملة عليها، أشج ذلك قوله منزلا لهم منزلة الجازم بذلك أو الغافل عنه تنبيها لهم على غلطهم وإيقاظا من غفلتهم لا يستوي أي بوجه من الوجوه أصحاب النار التي هي محل الشقاء الأعظم وأصحاب الجنة التي هي دار النعيم الأكبر لا في الدنيا ولا في الآخرة وهي من أدلة أنه لا يقتل مسلم بكافر. ولما كان نفي الاستواء غير معلم في حد ذاته بالأعم من الأمرين كان هذا السياق معلما بما حفه من القرائن بعلو أهل الجنة، صرح به في قوله: «أَصْحَابُ الْجَنَّةِ» [الحشر:20] هم أي خاصة الفائزون المدركون لكل محبوب الناجون من كل مكروه وأصحاب النار هم الهالكون في الدارين كما وقع في هذه الغزوة لفريقي المؤمنين وبني النضير ومن والاهم من المنافقين فشتان ما بينهما[10].
ومن حكمة التسوية بين الجزئين أو المختلفين ما قاله ابن القيم رحمه الله: «نفى الله – سبحانه – عن حُكمِه وحِكْمَته التسوية بين المختلفين في الحكم فَقَالَ تَعَالَى: «أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ» [القلم: 35] «مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ» [القلم: 36] فأخبر أن هذا حكم باطل في الفِطر والعقول لا تليق نسبته إليه سبحانه وَقَالَ تَعَالَى: «أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ» [الجاثية: 21] وَقَالَ تَعَالَى: «أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ» [سورة ص: 28]. أفلا تراه كيف ذكر العقول ونبه الفطر بما أودع فيها من إعطاء النظير حكم نظيره، وعدم التسوية بين الشيء ومخالفه في الحكم؟ وكل هذا من الميزان الذي أنزله الله مع كتابه وجعله قرينه ووزيره فقال تعالى: «اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ» [الشورى: 17] وَقَالَ: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» [الحديد: 25] وَقَالَ تَعَالَى: «الرَّحْمَنُ» [الرحمن: 1] «عَلَّمَ الْقُرْآنَ» [الرحمن: 2] فهذا الكتاب، ثم قال: «وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ» [الرحمن: 7] والميزان يراد به العدل والآلة التي يعرف بها العدل وما يضاده؛ والقياس الصحيح هو الميزان؛ فالأَوْلَى تسميته بالاسم الذي سماه اللَّه به، فإنه يدل على العدل، وهو اسم مدح واجب على كل واحد في كل حال بحسب الإمكان، بخلاف اسم القياس فإنه ينقسم إلى حق وباطل، وممدوح ومذموم، ولهذا لم يجئ في القرآن مدحه ولا ذمه، ولا الأمر به ولا النهي عنه، فإنه مورد تقسيم إلى صحيح وفاسد، والصحيح هو الميزان الَّذي أنزله مع كتابه»[11].
وقد نفى الله سبحانه وتعالى المساواة بين الفعلين والفاعلين والجزئين في آية واحدة فقال: «وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى والبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ» [فاطر:19-20-21-22].
والآية هي طعن على الكفرة وتمثيل، فالأعمى: الكافر والبصير: المؤمن. أو الأعمى: الصنم، والبصير: الله عز وجل، أي لا يستوي معبودهم ومعبود المؤمنين، والظلمات والنور والظل والحرور تمثيل للحق والباطل وما يؤديان إليه من الثواب والعقاب، والأحياء والأموات تمثيل لمن دخل في الإسلام ومن لم يدخل فيه.
وقد ذكر الدمشقي أنه بَالغ فِي نفي تَسَاوِي الفاعلين بقوله «وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاء وَلَا الْأَمْوَات» فَإِن التفاوت بين الحي والميت أبلغ من التفاوت بين الأعمى والبصير وَنفي التسوية بين الفاعلين يرجع إِلى نفي تساوي الفعلين أَو الجزائين[12].
أربعة أمثال للمؤمنين والكافرين، وللإِيمان والكفر، شبه الكافر بالأعمى، والكُفر بالظلمات، والحرور والكافر بالميّت، وشبه المؤمن بالبصير وشبه الإِيمان بالنور والظل، وشبه المؤمن بالحي تشبيه المعقول بالمحسوس. فبعد أن بيَّن قلة نفع النذارة للكافرين وأنها لا ينتفع بها غير المؤمنين ضرب للفريقين أمثالاً كاشفة عن اختلاف حاليهما، وروعي في هذه الأشباه توزيعها على صفة الكافر والمؤمن، وعلى حالة الكفر والإِيمان، وعلى أثر الإِيمان وأثر الكفر.
وقدم تشبيه حال الكافر وكفره على تشبيه حال المؤمن وإيمانه ابتداء؛ لأن الغرض الأهم من هذا التشبيه هو تفظيع حال الكافر ثم الانتقالُ إلى حسن حال ضده لأن هذا التشبيه جاء لإِيضاح ما أفاده القصر في قوله : «إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالغَيْبِ» [فاطر : 18] فهوقصر إضافي قصرَ قلب، فالكافر شبيه بالأعمى في اختلاط أمره بين عقل وجهالة، كاختلاط أمر الأعمى بين إدراك وعدمه.
والمقصود : أن الكافر وإن كان ذا عقل يدرك به الأمور فإن عقله تمحض لإِدراك أحوال الحياة الدنيا وكان كالعدم في أحوال الآخرة كقوله تعالى: «يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُون» [الروم : 7] ، فحاله المقسم بين انتفاع بالعقل وعدمه يشبه حال الأعمى في إدراكه أشياء وعدم إدراكه [13]. والعمى يعبر به عن الضلال ، قال ابن رواحة :[14]
أَرَانَا الْهُدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُوبُنَا ///بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ
فالظلمات تنافي النور وتضاده، والظل والحرور كذلك، والأعمى والبصير ليس كذلك لأن الشخص الواحد قد يكون بصيرا ثم يعرض له العمى فلا منافاة إلا من حيث الوصف، والمنافاة بين الظل والحرور دائمة، لأن المراد من الظل عدم الحر والبرد فلما كانت المنافاة أتم أكد التكرار، وأما الأحياء والأموات من حيث إن الجسم الواحد يكون محلا للحياة فيصير محلا للموت، فالمنافاة بينهما أتم من المنافاة بين الأعمى والبصير، لأن هذين قد يشتركان في إدراك ما ولا، كذلك الحي والميت يخالف الحي في الحقيقة لاىفي الوصف على ما بين في الحكمة الإلهية، وقدم الأشرف في مثلين وهو «الظل والحر» وآخر في مثلين وهما «البصير والنور». ثم إن الكافر المصر بعد البعثة صار أضل من الأعمى وشابه الأموات في عدم إدراك الحق فقال وما يستوي الأحياء الذين آمنوا بما أنزل الله ولا الأموات الذين تليت عليهم الآيات البينات ولم ينتفعوا بها، وهؤلاء كانوا بعد إيمان من آمن فأخرهم لوجود حياة المؤمنين قبل ممات الكافر، وأفرد الأعمى والبصير لأنه قابل الجنس بالجنس إذ قد يوجد في أفراد العميان ما يساوي به بعض أفراد البصراء كأعمى عنده من الذكاء ما يساوي به البصير البليد، فالتفاوت بين الجنسين مقطوع به لا بين الأفراد، وجمعت الظلمات لأن طرق الكفر متعددة، وأفرد النور لأن التوحيد والحق واحد، والتفاوت بين كل فرد من تلك الأفراد وبين هذا الواحد فقال «الظلمات» لا تجد فيها ما يساوي هذا النور، وأما «الأحياء والأموات» فالتفاوت بينهما أكثر إذ ما من ميت يساوي في الإدراك حيا، فذكر أن الأحياء لا يساوون الأموات سواء قابلت الجنس بالجنس أم قابلت الفرد بالفرد.[15].
ويشير الشيخ الطاهر ابن عاشور أن تركيب الآية عجيب فقد احتوت على واوات عطْف وأدوات نفي؛ فكلّ من الواوين اللذين في قوله:« ولا الظلمات»، وقوله : «ولا الظل» عاطف جملة على جملة وعاطف تشبيهات ثلاثة بل تشبيه منها يجمع الفريقين. والتقدير: ولا تستوي الظلمات والنور ولا يستوي الظِّل والحرور، وقد صرح بالمقدر أخيراً في قوله: «وما يستوي الأحياء ولا الأموات».[16].
وأما عن الواوات الثلاثة في قوله: والبصير ولا النور ولا الحرور، فيقول: فكل «واو» عاطف مفرداً على مفرد، فهي ستة تشبيهات موزعة على كل فريق؛ فـ «البصير» عطف على «الأعمى» و«النور» عطف على الظلمات، و«الحرور» عطف على « الظل»، ولذلك أعيد حرف النفي.[17].
وعن أدوات النفي يضيف الشيخ فاثنان منها مؤكدان للتغلب الموجه إلى الجملتين المعطوفتين المحذوف فعلاهما «ولا الظلمات» «ولا الظل»، واثنان مؤكدان لتوجه النفي إلى المفردين المعطوفين على مفردين في سياق نفي التسوية بينهما وبين ما عطفا عليهما وهما واو «ولا النور»، وواو «ولا الحرور»، والتوكيد بعضه بالمثل وهو حرف «لا» وبعضه بالمرادف وهو حرف «ما» ولم يؤت بأداة نفي في نفي الاستواء الأول لأنه الذي ابتدىء به نفي الاستواء المؤكد من بعد فهو كله تأييس. وهو استعمال قرآني بديع في عطف المنفيات من المفردات والجمل، ومنه قوله تعالى : «وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ».[فصلت: 3].
وجملة «وما يستوي الأحياء ولا الأموات» أظهر في هذه الجملة الفعل الذي قدّر في الجملتين اللتين قبلها وهو فعل «يستوي» لأن التمثيل هنا عاد إلى تشبيه حال المسلمين والكافرين إذ شبه حال المسلم بحال الأحياء وحال الكافرين بحال الأموات، فهذا ارتقاء في تشبيه الحالين من تشبيه المؤمن بالبصير، والكافر بالأعمى، إلى تشبيه المؤمن بالحي والكافر بالميّت، ونظيره في إعادة فعل الاستواء قوله تعالى في سورة الرعد: «قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ» [الرعد: 16] .[ 18].
ومن نماذج نفي التساوي في القرآن الكريم قوله تعالى: «قُل لاَّ يَسْتَوِى الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُواْ اللَّهَ ياأُوْلِى الاَْلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» [المائدة: 100] فالآية تؤذن بأن قد وجدت كثرة من أشياء فاسدة خيف أن تستهوي من كانوا بقلة من الأشياء الصالحة، فيمكن أن تكون تلك الكثرة كثرة عدد في الناس كما هو معلوم عند العرب في الجاهلية والإسلام الاعتزاز بالكثرة والإعجاب بها.
ومعنى لا يستوي نفي المساواة وهي المماثلة والمقاربة والمشابهة. والمقصود منه إثبات المفاضلة بينهما بطريق الكناية، والمقام هو الذي يعيّن الفاضل من المفضول، فإنّ جعل أحدهما خبيثاً والآخر طيّباً يعيّن أنّ المراد تفضيل الطيّب. وتقدّم عند قوله تعالى: «لَيْسُواْ سَوَاء» في سورة [آل عمران : 113][19].
وقوله: «الخبيث والطيِّب» تعددت فيه أقوال فمنهم من قال الحلال والحرام، ومنه من قال المؤمن والكافر، وغيرهم المطيع والعاصي، وقيل الردئ والجيد، وفي ذلك يقول القرطبي بأن هذا على ضرب المثال والصحيح أن اللفظ عام في جميع الأمور، يتصور في المكاسب والأعمال، والناس والمعارف من العلوم، فالخبيث من هذا كله لا يفلح ولا تحسن له عاقبة وإن كثر، والطيب وإن قل نافع جميل العاقبة، قال الله تعالى: «وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِدًا» [الأعراف:58]، ونظير هذه الآية قوله تعالى: «أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّار» [سورة ص: 28]، وقوله:« أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» [الجاثية:21]، فالخبيث لا يساوي الطيب مقدارا ولا إنفاقا، ولا مكانا ولا ذهابا، فالطيب يأخذ جهة اليمين، والخبيث يأخذ جهة الشمال، والطيب في الجنة والخبيث في النار، وحقيقة الاستواء الاستمرار في جهة واحدة، ومثله الاستقامة وضدها الاعوجاج.[20].
ومن نماذج نفي التساوي قوله عز وجل: «وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيم». [فصلت: 34] فنفي الاستواء ونحوه بين شيئين يراد به غالبا تفضيل أحدهما على مقابلة بحسب دلالة السياق كقوله تعالى: «أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ». وقول الأعشى: [21]
ما يُجْعَلُ الجُدَّ الظَّنُونُ الّذي /// جُنِّبَ صَوْبَ اللَّجِبِ الماطر
مِثلَ الفُراتيِّ إذَا مَا طَمَا /// يَقْذِفُ بالبُوصِيِّ والماهرِ
ويرى الشيخ الطاهر ابن عاشور الظاهر أن يقال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، دون إعادة لا النافية بعد الواو الثانية كما قال تعالى: «وما يستوي الأعمى والبصير» فإعادة لا النافية تأكيد لأختها السابقة. وأحسن من اعتبار التأكيد أن يكون في الكلام إيجاز حذف مؤذن باحتباك في الكلام، وتقديره: وما تستوي الحسنة ولا السيئة والحسنة.فالمراد بالأول نفي أن تلتحق فضائل الحسنة مساوي السيئة، والمراد بالثاني نفي أن تلتحق السيئة بشرف الحسنة، وذلك هو الاستواء في الخصائص.[22].
وفي ذلك تأكيد وتقوية لنفي المساواة ليدل على أنه نفي تام بين الجنسين؛ جنس الحسنة وجنس السيئة لا مبالغة فيه ولا مجاز.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش:
[1] بدائع الفوائد، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، 4/8-9.
[2] الإمام في بيان أدلة الأحكام، الدمشقي، ص: 139.
[3] تفسير البحر المحيط، محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي، 5/22.
[4] تفسير التحرير والتنوير، الإمام الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، 10/145.
[5] التحرير والتنوير، 10/146.
[6] البحر المحيط، 3/344.
[7] تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله، 1/553-554.
[8] البحر المحيط، 3/345.
[9] صفوة التفاسير، محمد علي الصابوني، 3/336.
[10] نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للإمام برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي، 7/535-536.
[11] إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم الجوزية، 1/103.
[12] الإمام في بيان أدلة الأحكام، ص: 139-142.
[13] التحرير والتنوير، 22/292-393.
[14] ديوان عبد الله بن رواحة ودراسة في سيرته وشعره، د. وليد قصاب، ص: 162.
[15] البحر المحيط، 7/295.
[16] التحرير والتنوير، 22/293.
[17] التحرير والتنوير، 22/293.
[18] التحرير والتنوير، 22/294.
[19] التحرير والتنوير، 3/63.
[20] الجامع لأحكام القرآن، تفسيرالقرطبي، 3/ 657-658.
[21] ديوان الأعشى الكبير، تحقيق: محمد أحمد قاسم، ص: 154، الماطر: وردت في الديوان: الزاخر.
[22] التحرير والتنوير، 24/291.