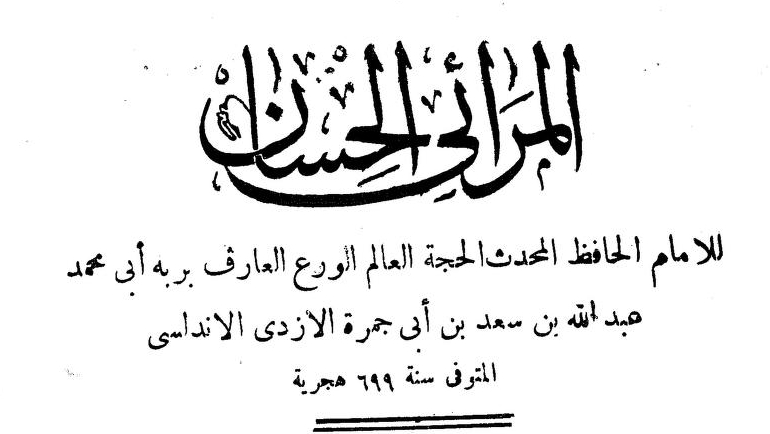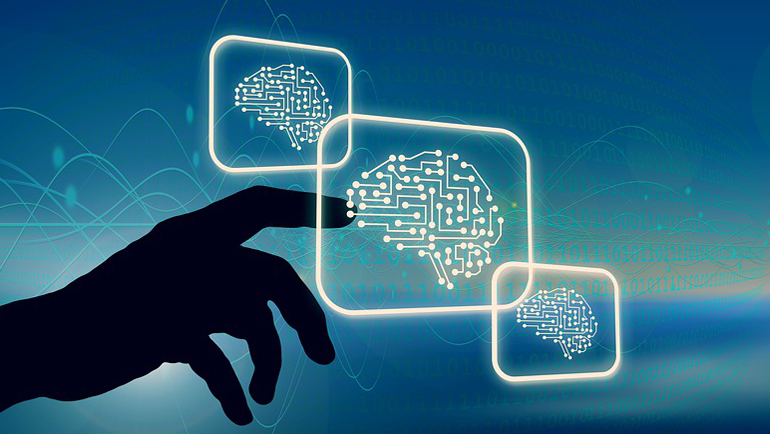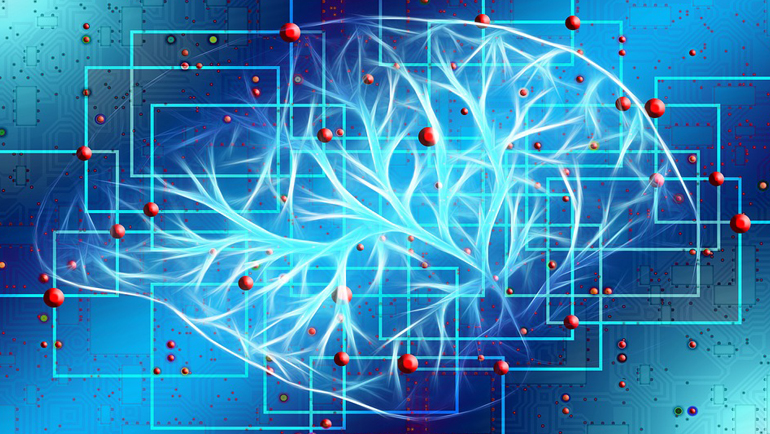أولا: قلق في القيم
يفرض علينا الحديث عن القيم، اليوم، كثيرا من الحذر والتواضع. فهو حديث إشكالي، غير بريء، ويترجم حالات مختلفة من الحيرة والقلق. ويتطلب يقظة خاصة في مواجهة مختلف أشكال اللايقين والتعقد التي تنتجها الحركية الجارية للعالم. كما أنه يزج بنا في حالات من الخوف التي تعترينا في هذا الوقت، والصعوبات التي تعترض الكبار، أو غير الكبار، في العالم على توقع أو تخيل المستقبل.
ينتاب المرء، في غالب الأحيان، شعور بقدرية صعبة التفسير؛ إذ كلما تبرم من اليقينيات القديمة وجد نفسه في مواجهة الشك والقلق. وهي حالات ليست دائما غير مفيدة في استنهاض العقل والتفكير والتواصل. إلا أن ما يثير الانتباه، في مقاربة سؤال القيم، يتمثل في غلبة نوع من الغمة أو الحداد على القناعات الماضية، أو فقدان قيم تبقى، عند استدعائها، راهنة وذات جذارة. لكن حركة الاقتصاد، وسطوة الإعلام، واتساع دوائر أنماط التواصل الافتراضية، والأشكال الجديدة للعنف.. الخ تدفع بالمرء إما إلى تحويل الشك إلى نظام واختيار، أو السقوط في فخ الأنماط القديمة أو الجديدة من الدوغمائيات.
وقد يكون من الأليق التذكير بأن العمل التحرري الطويل للفرد، وهو ما بشرت به الحداثة، عمل مكلف جدا. كل واحد، أو كل مجتمع يؤدي الثمن حسب طبيعة القوى والفاعلين فيه. وبقدر ما يمكن اعتبار الكلفة التي يتعين تقديمها من أجل الحرية، فإن ذلك لا يمنع الإقرار ببعدها المفارق بوصفها ثقلا ومسؤولية ليست هينة، لدرجة أنها قد تغدو استعبادا من نوع جديد.
فالفرد، وهو يتحرر من سطوة الجماعة يعرض ذاته، في نفس الآن، إلى حالات من الضعف، والوحدة والهشاشة. وهذا ما أدى بمفكر مثل “جيل ليبوفتسكي Gilles Lipovetsky إلى القول بأن انهيار الأشكال التقليدية للتأطير والتنشئة ليس دليلا على الوصول إلى “درجة الصفر” من القيم، بل يستدعي، هذا الانهيار، الفرد للتحرر من الوصاية المطمئنة، والضاغطة للواجب للانخراط في سبيل أخلاق للمسؤولية[1].
فالإنسان، اليوم، وفي كثير من بلدان الغرب، أو تلك التي تعرضت لتأثير الغرب مثل بلداننا، يجد نفسه أمام نوعين من السلوكيات: الأول “صبياني”، “طفولي” يسعفه على ممارسة حريته وكأنها نزوة أو هوى عابر؛ والثاني يتقدم به صاحبه بوصفه “ضحية” تعرض لظلم أصلي أو تاريخي وينظر إلى ذاته باعتباره كذلك، مهما حصل من جبر الضرر أو توصل إلى مكتسبات.
كيف، إذن، يمكن العيش في عالم بدون بوصلة؟ هناك من يرى، مثل “‘أندري كونت سبونفيل André Comte- Sponville بأن العيش في هذا العالم التائه، المستلب بكل أشكال الاستهلاك، الغارق في “ثقافة الإدراك”، ممكن، لكن ليس بتخيل قيم جديدة، وإنما بابتداع نمط جديد من الوفاء لتلك التي تركها لنا تاريخ الإنسانية، أو تلك التي أنتجها التاريخ الخاص لكل مجتمع مع الانتباه إلى ما يفرزه العالم الذي يتشكل أمامنا من مظاهر التسلط، والاغتراب، والقلق. وما هي هذه القيم؟ هي تلك التي تبقى وفية للأصول أو المبادئ الأربعة للأخلاق، تلك التي تسير في اتجاه الحياة، وفي اتجاه المجتمع ومصالحه، وفي اتجاه العقل أو ما هو كوني فيه، وأخيرا تلك التي تسير في اتجاه المحبة.
ذلك أن التفاعل الحي بين هذه الاتجاهات هو ما يؤسس للوفاء باعتبار أن متطلبات الحياة تقف عند حدود حاجات المجتمع، التي تقف، هي بدورها، عند حدود العقل الذي يتحدد ويستكمل بالمحبة. وهكذا فإن الانتقال الذي نعيشه اليوم، على صعيد القيم، ليس انتقالا من سلم للقيم إلى سلم آخر، وإنما انتقالا من التشبث المتشدد بإيمان ما إلى الوفاء للقيم النبيلة، باعتبار أن الوفاء هو ما يبقى من الإيمان حين نحسب أننا ضيعناه[2].
ومن بين شروط التعبير عن هذا الوفاء الجديد مساءلة العلاقة بين العقل والتواصل، والنظر في قواعد المناقشة بين الثقافات والأفراد في أفق إعادة بناء معنى جديد للفعل الجماعي.
ثانيا: حول التسامح والأصولية
هل تشكل لفظة “التسامح”، كما مسألة التنوع، كلمات أمر جديدة لإعادة الاعتبار لإنسانية الإنسان في العقدين الأخيرين؟ ولماذا تفرض مثل هذه الكلمات، في استعمالها شبه البديهي، تشابكا بين السياسة والأخلاق؟
يبدو أن بعض “المؤسسات”، التي تدعي التعبير عن “الضمير العالمي”، تجد نفسها إزاء شكل من أشكال الأمر الأخلاقي لاستدعاء تذاوت جديد وعلاقات إنسانية مغايرة. فالجرائم والأعمال البشعة التي يقترفها الإنسان ضد الإنسان، وإرادات القوة، كيفما كانت مرجعياتها وتبريراتها، التي تميل في اتجاه الإلغاء والتطهير والاستعباد، تفضح، أكثر فأكثر، تجاوزات الهويات المتطرفة والمصالح المتوحشة.
يعاني العالم، الذي نشهد اليوم على ولادته، من نقص مهول في الإحساس الإنساني. هل يمثل النداء إلى التسامح لحظة اعتراض حيوية على الميولات التخريبية التي تعلن عن ذاتها، منذ الآن، من خلال هذه الولادة الجديدة للعالم أو ما ننعته، عن اقتناع أو عن تهكم، بالعولمة؟ هل يتعلق الأمر بحمى تجارية جديدة وبشعار جديد يتعين مساءلته، بله نزع الهالة الأسطورية عنه؟
يبدو سؤال التسامح وكأنه يحيل على فضيلة وعلى نظام أخلاقي. وسواء تعلق الأمر بمثال أو بنمط سلوكي، فإن التسامح يندرج، في غالب الأحيان، في إطار الواجب، أو ما يجب أن يكون، أو ما هو مرغوب فيه. أن تسامح أو تعبر عن سلوك متسامح معناه أن تأخذ الآخر بعين الاعتبار؛ لأن السلوك المتسامح هو الذي يقبل حجج الآخرين، ويكون صاحبه على استعداد للاعتراف بأخطائه.
لذلك يكتسب التسامح معاني مختلفة، حسب مجالات القول والفعل والتواصل. فهو يحتمل معاني المقاومة، والصبر، والمعاناة، والشفقة، والتواطؤ، والقبول، والغفران، والاحترام والضيافة..الخ. وفي كل الأحوال أن التسامح معناه أن تكون قادرا على التبرم من مواقعك الخاصة، وأن تدخل ما يلزم من النسبية على أفكارك قياسا إلى نجاعة وصلابة حجج الآخرين.
أليس التسامح معناه امتلاك فضيلة الاستماع والفهم والاعتراف، وإدماج الآخر كأفق للفكر وللسلوك بدون فقدان الذات وتبديد مقوماتها؟ غير أنه كيف يمكن تصور هذا النوع من الفاعلية التواصلية تجاه مختلف تعبيرات الأصولية التي تفرض نفسها على العلاقات الإنسانية من كافة الجهات؟
إضافة إلى الإرادات المتنوعة المصادر التي تعمل على إعادة تنشيط ما هو ديني، تفرض “أصولية السوق” معاييرها على كل مناطق العالم تارة بنهج أساليب التفاوض والمساومة، وتارة أخرى باعتماد القوة الوحشية. تتقدم هذه الأصولية بوصفها نموذجا، أو بالأحرى معيارا مطلقا في إنتاج وإعادة إنتاج الثروة. يحوز فيها المال الأولوية المطلقة، بل إنها تخصص له من الذكاء والإمكانيات أكثر مما تمنحه لإنقاذ الناس من أوضاعهم التعيسة في العالم. لقد أصبح المال في كل مجتمعاتنا، وأكثر من أي وقت مضى، هو المعيار والمرشد والقيمة المطلقة، لدرجة غدا فيها قوة تغري بمقدار ما تعمي، تسلب بمقدار ما تشوش على النظر والحكم والموقف. كيف يجوز الحديث عن التسامح في وقت تتنامى فيه نسبة الفقر والأمية والأمراض، ويزداد البون شساعة بين الغنى والفقر؟ ذلك أن الخمس الأكثر غنى من سكان العالم يسيطر على أربع أخماس ثروات العالم. بأي طريقة يمكن مواجهة غطرسة أصولية السوق وكليانية المال بهدف خلق توزيع أكثر عدالة وتوفير فرص أكبر للمساواة والتضامن؟
تتساوق عبادة المال مع أصولية جديدة محايثة لها ومرتبطة بتحركاتها وآليات اشتغالها. ذلك أن المركب العسكري الإعلامي الذي صنعته هواجس القوى العظمى من أجل الردع وامتلاك أسباب القوة، ولد، هذا المركب، ما أسماه “بول فيريليو” بـ”أصولية التقنية”. تخترع البلدان الغنية الأسلحة، وأنظمة أسلحة تتحول، بشكل من الأشكال، إلى “ربوبيات واقية” تجد نفسها في حاجة مستديمة إلى تطعيمها بثروات بلدان الجنوب لضمان حماية الكبار. وكأن الأمر يتعلق بـ”آلهة آلات” أنتجت “وحدانية عقائدية” تتميز بلاتسامح ناذر وبعنف غير مسبوق.
لا يتعلق الأمر، هنا، بموقف مناهض للاختراعات التقنية أو بنزعة محافظة بلهاء، ذلك أن التسامح هو، في جوهره، فضيلة تتعارض مع كل أشكال الغطرسة. فأصولية السوق، وكذا أصولية التقنية، بشنها لحركة أحادية الجانب، تسعى إلى فرض عولمة وحشية على مختلف ثقافات العالم. وهنا يمكن أن نتساءل عما هو مسموح به إنسانيا؟ أي عما يمكن هضمه باعتباره خيرا من الناحية الإنسانية؟
وإذا كان التسامح يعني أخذ الآخر بعين الاعتبار بوصفه اختلافا، فإنه يبدو أن تواصلا تثاقفيا فعليا يمثل الأرضية المناسبة لإعادة تأسيس بيداغوجيا حقيقية للتبادل الإنساني. أن تصغي للآخر، أو أن تضع نفسك محله دون تشظ ذاتي أو فقدان للذات؛ أي العمل على تأسيس ثقافة فعلية للحوار. غير أن الشرط البدئي لكل حوار يتجلى في الاستعداد الدائم لتقديم تنازلات بين الأطراف المعنية للوصول، في آخر المطاف، إلى تفاهم ممكن. وبدون هذا الاستعداد يصعب تصور حوار هادف، بل قد يتحول إلى وسيلة للاحتواء، إما استنادا إلى الوسائط المختلفة للتأثير والتشويه أو اعتمادا على الضغط والقسر.
لذلك من الناذر أن نعثر على حالات حوارية بين الشمال والجنوب. هناك لا تكافؤ جوهري محايث لعلاقتهما يشوش على اللقاء ويحول دون التواصل. وبدل الإعلان عن إرادة للوعي، وإتباع أخلاق للمناقشة، لا يكف الشمال عن فرض إرادة القوة وإغفال أصول الحوار. فكيف، إذن، يمكن خلق فرص للتبادل، من خلال وبفضل بيداغوجيا للتسامح دون التحرر من وهم امتلاك الحقيقة الوحيدة، سواء باسم قوانين الاقتصاد أو باسم الدين؟
يولد هذا النمط من التموقع حالة من اللاتواصل ومن السلوكيات اللامتسامحة. ذلك أن الحوار هو، جوهريا، مسألة ثقافية. إلا أن الغرب، منذ مدة طويلة، ولاسيما منذ بضع سنين، يرى في النضال من أجل إعادة بناء هوية عربية إسلامية متجددة عملا مناهضا له. فكل ما يقاوم نماذجه يعتبر خارج التاريخ، على اعتبار أن التقدم وحده خالق للتاريخ. تاريخه هو، ومن ثم فإن التغريب، أو تعميم معايير الغرب، يتعين أن يصير مشروعا كونيا. وكم من فضائع وجرائم ارتكبت تحت عنوان هذا “الكوني”؟ وكم من تدخلات لا إنسانية تعبر عن أكثر مظاهر اللاتسامح عنفا وطغيانا وجدت في شعار “كونية الغرب” ذريعة ومبررا؟ وكيف، إذن، يمكن أن يحصل الحوار في عالم موزع ما بين خوف استيهامي من فقدان الهوية وبين اتجاه، يزداد غطرسة، لفرض أصولية السوق؟ إلى أي مدى يمكن بناء أخلاق للتسامح داخل حقل دولي مسكون بالحذر وبالمصالح المتوحشة وبنسيان الكائن؟
ثالثا: مفارقة التنوع
عندما تتعرض ثقافة ما إلى إرادة للقوة تستهدف الاعتداء على مقوماتها واحتقار رموزها وصورها، فإن هذه الثقافة تجد نفسها مضطرة للعودة إلى الأسس العميقة المكونة لها، والرجوع إلى العلامات الأكثر تعبيرا عن هويتها وتميزها. وفي هذه الحالة، يتفجر رد فعل لا عقلاني ضد الظلم من طرف هذه الثقافة. لذلك، فإن معايير وقواعد جديدة للحوار مطلوبة لتكسير الصور النمطية، ومحاربة إرادات التشويه وتأسيس تواصل تثاقفي واقعي وأخلاق فعلية للمناقشة.
وبمقدار ما نجد في أوروبا، مثلا، من يدعو إلى الصراع والاحتقار، فإننا نعثر، أيضا على أصوات تنشد الحوار واحترام المسلمين وغيرهم، كما أنه لا يوجد فقط إلا المتعصبين في العالم العربي؛ لأن المشهد الثقافي العربي الإسلامي عبارة عن فسيفساء حقيقية من الخطابات والمواقف والأحكام. وحده تثاقف متكافئ، عادل وإنساني يمكنه نزع الطابع الأسطوري عن الأحكام المسبقة والصور النمطية الخاطئة.
لذلك، فإن اعترافا واقعيا بين أوروبا والعالم العربي الإسلامي يبدو مطلبا دائما، طالما أن الإسلام أصبح له حضور لافت، ومعطى سوسيولوجيا وثقافيا لا يمكن تجاهله في أوروبا (هناك ما بين اثني عشر وخمسة عشر مليون مسلم في القارة الأوروبية)، كما أن الغرب يحتل، مهما كانت المقاومات، مكانة ذات أهمية بالغة في الحياة العربية الإسلامية، سواء من حيث أنماط التسيير والتواصل واللباس، أو على صعيد الفكر والنظر.
للاقتراب من الأسس الخطابية لمسألة التنوع يتعين تجاوز النزعة المانوية السائدة التي توهم بأن هناك حركتين اثنين تطبع زمن العالم؛ تفرز الأولى مقومات نفي الآخر والعنف، بينما تنتج الثانية الغيرية والتبادل، والوقوف على بعض أشكال الانزلاقات الممكنة للمطالب التي تعبر عن ذاتها باسم الهوية أو باسم الاختلاف؛ أي أن الحديث عن القيم، أو عن الثقافة عامة، يفترض الكشف عن الحدود المنزاحة، والمتحركة دوما التي تنتجها معادلات الهوية والاختلاف، الماضي والحاضر، والذات والآخر.
ذلك أنه بإغفال، أو استبعاد الواقع الاجتماعي، والسياسي والثقافي للتنوع، قد ننسى بأن خطاب التسامح نتاج تاريخي للذين يسيطرون، كيفما كانت طبيعة ودرجة هذه السيطرة، كما أنه لا مناص “لمعالجة “التنوع الثقافي” من وضعه في سياق المصالح المختلفة لمن ينطق باسمه أو يدافع عنه[3].” ذلك أن خطاب التنوع، كما هو الشأن بالنسبة للاختلاف، بتأكيده على خصوصيات الآخر، يمكن أن يضعه في إطار علاقة برانية والنظر إليه بوصفه غريبا، وتثبيته، بالتالي، ضمن فهم اختزالي لـ”هوية مفتعلة”. والحال أن عملية تثبيت الآخر في خصوصية ما، والدعوة إلى احترام الاختلافات يعملان، بأشكال لا واعية، على المشاركة في منع اللقاء بين أنماط الوعي، والتفاعل الحي بين القيم. ليست الغيرية هي الاختلاف واحترام الاختلافات. وبعيدا عن كونه شرطا مسبقا للقاء مع الآخر وللحوار، يمكن أن يمثل السلب الفعلي للغيرية.
من جهة أخرى يمكن للتفكير في الثقافة، أو القيم، انطلاقا من التنوع إخفاء التفاوتات الصارخة في توزيع الخيرات الثقافية، كما يمكن أن يتستر على إرادة للهيمنة تحت عنوان عملية ديمقراطية أو سياسية وقائية.
ولذلك بقدر ما تستدعي المطالبة بالاختلاف درجة عالية من الحذر المستمر، تستوجب معالجة “التنوع الثقافي” يقظة ثقافية خاصة. قد تكون هذه المطالبة رد فعل على نزعة أحادية جارفة تواكب العولمة النيوليبرالية، كما قد تترجم شعار مناهضي العولمة لإدانة تحويل الخيرات الثقافية إلى سلع، بقدر ما يمكن أن يعبر التنوع عن ذاته من خلال مفردات متشددة وعنيفة باسم الدين أو اللغة أو الجهة.
هذا ما أدى بـ “بول راس” إلى الملاحظة “بأن التاريخ يعلمنا كون ضحايا الحداثة، والشعوب المهملة، والفلاحين المستغلين، والعمال المطرودين، أو الذين تضاءلت قيمة عملهم بسبب التقدم التقني، والتجار الصغار المفلسين، كل هؤلاء يلجأون إلى بناء نماذج هويتية سكيزوفرينية، ويعمدون إلى فبركة ثقافة ترجع إلى هويات أولية يعاد صياغتها في المتخيل اعتمادا على أرض الأجداد، ونقاء الدم، واللغة الأصلية، والماضي الموهوم[4].”
وهكذا فإن تفكك كيان “وطني” باسم الحق في الاختلاف، أو المطالبة بالتنوع مهما كانت مشروعيتهما، وتفتت الأسس المشتركة لبلد ما قد ينتج عنه فتح باب جهنم، وتفجير نزوعات الموت. في هذه الحالة قد تبدو معرضة للاهتزاز والتدمير كل الحدود، كما يتوقع تعريض مقومات العيش المشترك إلى الخطر والتهديد. ومن تم يمكن للتشنج الهويتي باسم تنوع ما أن يولد أسباب الخصومة، والفتنة والمحنة.
ومع ذلك فالتأكيد على اعتبار التنوع الثقافي محرك الإنسانية تأكيد صائب. وهو ما يمنح المعنى لمختلف أشكال التبادل بين الناس، غير أنه، وكما يرى “موريس ميرلوبونتي” “أن مجموع الكائنات التي تعرف باسم الإنسان، المحددة بالصفات الفيزيائية التي نعرف تمتلك أيضا، بشكل مشترك، نورا طبيعيا، وانفتاحا على الوجود يجعل من مكتسبات الثقافة قابلة لأن تصل إلى الجميع. غير أن هذا الإشراق الذي نجده في كل نظرة موسومة بالإنسانية، يمكن أن نعثر فيه على أكثر أشكال السادية قسوة[5].”
ولعل البلاغة السائدة حول التنوع تفضح حتى أولئك الذين رفعوها في وجه تسليع العقول؛ لأنهم كلما ذهبوا بها بعيدا كلما تبين لهم بان أسس الدولة/الأمة، والسيادة، والحدود المعترف بها أصبحت معرضة للتهديد والهشاشة. وإذا كان التنوع فعل اعتراف عظيم فإنه يمكن أن يتحول إلى فخ حقيقي، خصوصا وأنه “أصبح لازمة مضللة تنسحب على وقائع ومواقف متناقضة، جاهزة لكل التوافقات المرحلية[6].”
ويبدو، اعتبارا لما سبق، أننا نشهد على تحولات دلالية واستخدامات خادعة لمفردات، نبيلة في ذاتها، وعلى تغيرات تحصل في الثقافة بسبب مفعولات التواصل، حيث تحولت الشعوب إلى فئات من “الجمهور”، وتم اختزال المواطنين إلى مستهلكين. بل إننا نشهد، أكثر من ذلك، على تنامي محموم للعدوانية، ولاسيما تلك التي تتخذ من العالم العربي موضوعا لها.
كيف يمكن مقاومة الفكر الوحيد والتفكير في التعدد؟ ثم كيف يمكن محاصرة ما هو تراجيدي والانخراط في التواصل؟
الجواب عن هذه الأسئلة يكثف، في تصوري، الرهان الحقيقي لبيداغوجيا التسامح ولسؤال القيم. ويبدو أنه رهان صعب في زمن تزداد فيه “أصولية السوق” تشددا وشراسة، بل وأصبحت تفرض ذاتها بكثير من التجبر والغطرسة، لا تترك للثقافات الأخرى أي هامش آخر للتعبير عن اختلافها سوى الارتكاس إلى أصولها العتيقة والعودة إلى ما يشكل ذاتيتها الدفينة. ويظهر أنه على الرغم من هذا الاحتقان الثقافي الحاد فإن التفكير فيما هو إنساني حاجة وجودية وانفتاح ممكن، بدون سلب درامي للذات، أو تماه وهمي مع الآخر، وبدون استجداء ثقافي أو رفض عصابي للآخر.
الهوامش
[1]. Gilles Lipovetsky; L’ère de l’après devoir, in La société en quête de valeurs, Institut de management d’EDF et de GDF, Paris, 1996, P. 26.
[2]. André Comte-Sponville; Une morale sous fondement, in La société en quête de valeurs; Op. cit. P. 138.
[3]. Armand Mattelart, Diversité culturelle et mondialisation; Ed La découverte, Paris, 2005, P.99.
[4]. Paul Rasse; La rencontre des mondes, diversité culturelle et communications; Ed Armand Colin; Paris, 2006, P. 301.
[5]. Maurice Merleau.Ponty; L’homme et l’adversité; in Signes, Ed Gallimard, Paris; 1960. P 391.
[6]. Armand Mattelart; Op.cit. P. 3.