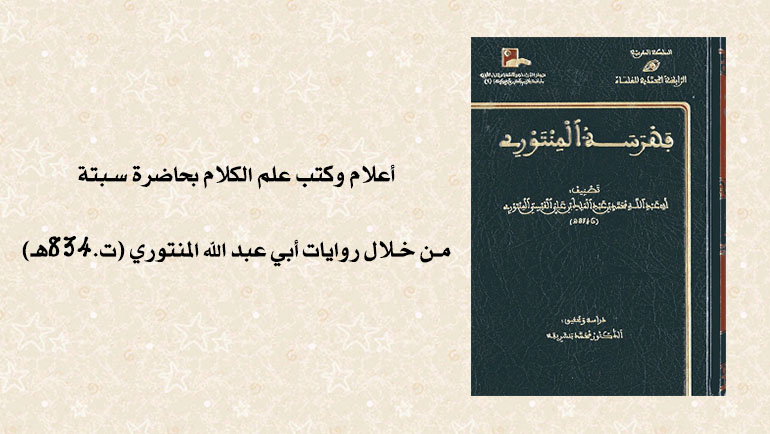مصطفى بوزغيبة مركز الإمام الجنيد للدراسات والبحوث الصوفية المتخصصة
يعتبر التصوف من العلوم الإسلامية التي كثر حولها النقاش، في أصله ومصدره، وتشعبت الآراء، واختلفت وجهات النظر، بين منصف وجائر، وتجرأ البعض على الخوض فيه بدافع الطعن والتشكيك فيه، ضاربا أصول المنهج العلمي عرض الحائط، فما يزال التصوف يحتاج لدراسات علمية منصفة.
وسنحاول في هذه السطور تسليط الضوء على التصوف من حيث التعريف، والمصدر والنشأة.
أولا: تعريف التصوف:
1. اشتقاق كلمة التصوف
اختلف العلماء حول اشتقاق مصطلح التصوف إلى عدة أقوال، كلها لم تسلم من الانتقادات والاعتراضات، “سُئل الشبلي رضي الله عنه: لم سميت الصوفية بهذا الاسم؟ فقال: هذا الاسم الذي أُطلق عليهم، اختُلِف في أصله وفي مصدر اشتقاقه، ولم ينته الرأي فيه إلى نتيجة حاسمة بعدُ”،[1] ويقول الإمام القشيري: “وليس يشهد لهذا الاسم من حيث العربية قياس ولا اشتقاق والأظهر فيه أنه كاللقب”[2].
وفيما يلي أقوال العلماء في اشتقاق التصوف وأهم الاعتراضات عليها:
منهم من قال: (من الصفاء)، حتى قال أبو الفتح البستي رحمه الله تعالى: [3]
تنازع الناس في الصوفي واختلفوا وظنه البعض مشتقاً من الصوف
ولست أمنح هذا الاسم غيرَ فتـىً صفا فصوفي حتى سُمي الصوفـــي
أورد القشيري أن هذا القول بعيد في مقتضى اللغة.[4]
أ) ومنهم من قال: (من الصُفَّة، لأن صاحبه تابعٌ لأهلها فيما أثبت الله لهم من الوصف) حيث قال تعالى: {واصبِرْ نفسَك مع الذين يدعونَ ربَّهم بالغداة والعشي يريدون وجهه} [الكهف/28].
واعتُرض على هذا القول بأن الصُفَّة لا تجيء على نحو الصوفي [5]
ب) وقيل: (من الصَّف) (فكأنهم في الصف الأول بقلوبهم من حيث حضورهم مع الله تعالى).
فالمعنى صحيح كما قال القشيري، ولكن يعترض عليه هذا الأخير بأن اللغة لا تقتضي هذه النسبة إلى الصف. [6]
ج) ومنهم من قال: (من الصوف) (أي نسبة إلى لبس الصوف الخشن، لأن الصوفية كانوا يؤثرون لبسه للتقشف).
ويُعترض عليه بأن الصوفية لم يختصوا بلبس الصوف.
د) ومنهم من قال: إنه تحريف لكلمة “سوف” اليونانية التي تعني الحكمة.
ورد عبد الحليم محمود هذا القول؛ لأنه: “لا يستقيم لسبب بسيط، وهو أن التسمية “بالصوفي” كانت موجودة قبل ترجمة الحكمة اليونانية إلى اللغة العربية…(و) هذا اللفظ نشأ في الإسلام بعد أن عرفت الكلمة اليونانية، وعرف معناها وتداولتها الألسنة ولاكتها الأفواه، وألفت معناها العقول، أي حوالي منتصف القرن الثالث الهجري، على أقل تقدير مع أن الكلمة عرفت قبل ذلك بكثير” [7]
ومهما يكن فإن هذه الطائفة – كما قال القشيري – أشهر من أن يحتاج في تعيينهم إلى قياس لفظ واستحقاق اشتقاق [8]
ويقول الهجويري: “ولا تخضع هذه الكلمة للاشتقاقات اللغوية المعروفة إذ أن الصوفية من الرفعة بحيث لا يكون لها أصل تُشتق منه” [9]
وعلى كلٌّ فلا مشاحة في الألفاظ، والأمر الأهم في هذه المسألة هو النظر إلى المعاني والدلالات التي يكتنزها هذا المصطلح، وهو تزكية النفوس وصفاء القلوب، للوصول إلى حضرة علام الغيوب. “وإن شئتَ فسمه الجانب الروحي في الإسلام، أو الجانب الإحساني، أو الجانب الأخلاقي، أو سمه ما شئت مما يتفق مع حقيقته وجوهره؛ إلاَّ أن علماء الأمة قد توارثوا اسم التصوف وحقيقته عن أسلافهم من المرشدين منذ صدر الإسلام حتى يومنا هذا، فصار عُرفاً فيهم”[10]
2- تعريف التصوف اصطلاحا:
إذا رجعنا إلى كتب الصوفية نجد للتصوف تعريفات كثيرة جدا، يقول الشيخ زروق في قواعده:
“وقد حُدَّ التصوف ورِسم وفُسر بوجوه تبلغ نحو الألفين، مرجعها كله لصدق التوجه إلى الله تعالى، وإنما هي وجوه فيه”[11]
وسنحاول جرد بعض التعاريف التي تقرب معنى التصوف للأذهان:
يقول سيد الطائفة الإمام الجنيد 297هـ في تعريف التصوف: “الخروج عن كل خلق دني، والدخول في كل خلق سني”[12]
ويقول الشيخ أحمد زروق 899هـ رحمه الله: “التصوف علم قصد لإصلاح القلوب، وإفرادها لله تعالى عما سواه. والفقه لإصلاح العمل، وحفظ النظام، وظهور الحكمة بالأحكام. والأصول “علم التوحيد” لتحقيق المقدمات بالبراهين، وتحلية الإيمان بالإيقان، كالطب لحفظ الأبدان، وكالنحو لإصلاح اللسان إلى غير ذلك”.[13]
وقال ابن عجيبة رحمه الله: “التصوف: هو علم يعرف به كيفية السلوك إلى حضرة ملك الملوك، وتصفية البواطن من الرذائل، وتحليتها بأنواع الفضائل، وأوله علم، ووسطه عمل، وآخره موهبة”[14]
من خلال هذه التعاريف يتضح أن التصوف يهتم بتصفية الباطن من الأمراض، وتعميره بالصفات الفاضلة، من أجل التقرب إلى الله تعالى.
ثانيا: نشأة علم التصوف:
ظهر التصوف كعلم في زمن كثرت فيه الفتن والمحن والفساد في الأرض، ومال الناس إلى زهرة الدنيا وتنافسوا فيها (المجون، اللهو والعصبية…)، وعمَّ البلاد الإسلامية الضعف والوهن في حياتها الروحية، ووقعت بذلك قطيعة بين العهد الذهبي للأمة الإسلامية (العهد النبوي والصحابة وأتباعهم) وبين العهد الذي يليه.
فظهور التصوف إذن كان كرد على تلك الأوضاع غير المرضية التي تمر منها الأمة الإسلامية، أما التصوف كحياة ومضمون؛ فكان منذ عصر النبوة. يقول ابن خلدون: “هذا العلم ـ يعني التصوف ـ من علوم الشريعة الحادثة في الملَّة؛ وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومَن بعدهم طريقة الحق والهداية، وأصلها العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى، والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها، والزهد في ما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه، والانفراد عن الخلق، والخلوة للعبادة، وكان ذلك عامَّاً في الصحابة والسلف. فلما فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية والمتصوفة”[15]
ويقول الشيخ زروق في أصل التصوف: “وأصل التصوف مقام الإحسان، الذي فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم ب(أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك).
لأن معاني صدق التوجه لهذا الأصل راجعة، وعليه دائرة، إذ افظه دال على طلب المراقبة الملزومة به.
فكان الحضُّ عليها حضا على عينه، كما دار الفقه على مقام الإسلام، والأصول على مقام الإيمان.
فالتصوف أحد أجزاء الدين، الذي علَّمه عليه الصلاة والسلام جبريل، ليتعلمه الصحابة رضي الله عنهم”[16]
ولتبيان أن التصوف كان منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الوحي أنزله فيما أنزل من تشريعات وأحكام، نورد نص فتوى العلامة محمد بن الصديق توضح ما نحن بصدده، “سُئل الإمام محمد بن الصديق عن أول من أسس الطريقة؟ وهل تأسيسها بوحيٍ سماوي؟ فأجاب: “وأما أول من أسس الطريقة؟ وهل تأسيسها بوحي؟… الخ فلتعلم أن الطريقة أسسها الوحيُ السماويُ في جملة ما أُسِسَ في الدين المُحمديّ، إذ هي بلا شك مقام الإحسان الذي هو أحد أركان الدين الثلاثة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما بيّنها واحداً واحداً ديناً، فقال “هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم” فغاية ما تدعو إليه الطريقة وتشير إليه هو مقام الإحسان، بعد تصحيح الإسلام والإيمان، ليحرز الداخل فيها والمدعو إليها مقامات الدين الثلاثة الضامنة لمحرزها والقائم بها السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة، والضامنة أيضاً لمحرزها كمال الدين، فإنه –كما في الحديث- عبارة عن الأركان الثلاثة، فمن أخلَّ بمقام الإحسان الذي هو الطريقة فدينه ناقص بلا شك، لتركه ركنا من أركانه”[17]
ويقول الإمام القشيري: “اعلموا أن المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يَتَسمَّ أفاضلهم في عصرهم بتسمية علم سوى صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، إذ لا أفضلية فوقها، فقيل لهم الصحابة والتابعين، ثم اختلف الناس وتباينت المراتب، فقيل لخواص الناس ممن لهم شدة عناية بأمر الدين الزهاد والعُبَّاد، ثم ظهرت البدعة، وحصل التداعي بين الفرق، فكل فريق ادعوا أن فيهم زهاداً، فانفرد خواص أهل السنة المراعون أنفسهم مع الله سبحانه وتعالى، الحافظون قلوبهم عن طوارق الغفلة باسم التصوف، واشتهر هذا الاسم لهؤلاء الأكابر قبل المائتين من الهجرة”[18]
وإن من عظيم كرمه تعالى على هذه الأمة أن جعل العلماء ورثة الأنبياء ليتسلسل النور الإلهي في هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر)[19]
هذا وقد سأل الأنبياءُ عليهم السلام اللهَ تعالى أن يديم هذه الوراثة في عقبهم، يقول الله تعالى على لسان سيدنا زكرياء عليه السلام:{فهب لي وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا} [سورة مريم الآيات 3– 5].
ويقول الله تعالى في شأن سيدنا سليمان عليه السلام: {وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين} [سورة النمل/16].
فكل العلماء ورثوا من الأنبياء تصرفا أو عـدة تصرفــات كـل حسـب تخصصـه “فورث عنهم العارفون بعض المعارف والأحوال وورث عنهم العابدون التقرب بالأقوال والأعمال وورث عنهم الفقهاء التقرب بمعرفة الأحكام المتعلقة بالجوارح والأبدان وورث عنهم أهل الطريقة الأحكام المتعلقة بالبواطن”[20]
ويتضح لنا من كلام العز بن عبد السلام أن العلماء أصناف، بحسب ما ورثوه من تركة النبي صلى الله عليه وسلم، وحظ أهل التصوف من التركة هو التزكية فكان “الشيوخ رضي الله عنهم نواب الشارع صلى الله عليه وسلم في إرشاد الخلق بل هم الوَرّثَةُ للرُّسُل على الحقيقة، ورِثُوا علوم شرائعِهِم غيرَ أنهم لا يُشَرِّعون فلهم حفظُ الشريعة في العموم، وما لهم التشريع، ولهم حفظُ القلوب من الميل إلى غير مرضاة الله ومراعاة الآداب الخاصة بأهل الحضرة الإلهية”.[21]
يتبين لنا من خلال النصوص السابقة أن التصوف عاشه النبي صلى الله عليه وسلم، وتربى في أحضانه الصحابة الكرام وأتباعهم، وتسلسل فيهم هذا النور حتى أصبح علما قائما بنفسه، له أصوله ومصطلحاته ورجالاته… لا كما يعتقده بعض المستشرقين ومن سار على نهجهم، أن التصوف له أصول بوذية أو نصرانية…
وهنا قد يُطرح سؤال وهو: لماذا لم تنتشر الدعوة الصوفية في صدر الإسلام؟ ولماذا لم تظهر هذه الدعوة إلا بعد عهد الصحابة والتابعين؟
ويجيب الدكتور أحمد عَلْوَشْ عن هذا السؤال بقوله: “إنه لم تكن من حاجة إليها في العصر الأول، لأن أهل هذا العصر كانوا أهل تقوى وورع، وأرباب مجاهدة وإقبال على العبادة بطبيعتهم، وبحكم قرب اتصالهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتسابقون ويتبارون في الاقتداء به في ذلك كله، فلم يكن ثمَّة ما يدعو إلى تلقينهم علماً يرشدهم إلى أمرٍ هُم قائمون به فعلاً، وإنما مثلهم في ذلك كله كمثل العربي القُحِّ، يعرف اللغة العربية بالتوارث كابراً عن كابر؛ حتى إنه ليقرض الشعر البليغ بالسليقة والفطرة، دون أن يعرف شيئاَ من قواعد اللغة والإعراب والنظم والقريض، فمثل هذا لا يلزمه أن يتعلم النحو ودروس البلاغة، ولكن علم النحو وقواعد اللغة والشعر تصبح لازمة وضرورية عند تفشي اللحن، وضعف التعبير، أو لمن يريد من الأجانب أن يتفهمها ويتعرف عليها، أو عندما يصبح هذا العلم ضرورة من ضرورات الاجتماع كبقية العلوم التي نشأت وتألفت على توالي العصور في أوقاتها المناسبة.
فالصحابة والتابعون ـ وإن لم يتسموا باسم المتصوفين ـ كانوا صوفيين فعلاً وإن لم يكونوا كذلك اسماً، وماذا يراد بالتصوف أكثر من أن يعيش المرء لربه لا لنفسه، ويتحلى بالزهد وملازمة العبودية، والإقبال على الله بالروح والقلب في جميع الأوقات، وسائر الكمالات التي وصل بها الصحابة والتابعون من حيث الرقي الروحي إلى أسمى الدرجات فهم لم يكتفوا بالإقرار في عقائد الإيمان، والقيام بفروض الإسلام، بل قرنوا الإقرار بالتذوق والوجدان، وزادوا على الفروض الإتيان بكل ما استحبه الرسول صلى الله عليه وسلم من نوافل العبادات، وابتعدوا عن المكروهات فضلاً عن المحرمات، حتى استنارت بصائرهم، وتفجرت ينابيع الحكمة من قلوبهم، وفاضت الأسرار الربانية على جوانحهم. وكذلك كان شأن التابعين وتابعي التابعين، وهذه العصور الثلاثة كانت أزهى عصور الإسلام وخيرها على الإطلاق، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: “خير القرون قرني هذا فالذي يليه والذي يليه” (خير الناس قرني هذا ثم الذين يلونهم).[22]
فلما تقادم العهد، ودخل في حظيرة الإسلام أُمم شتى، وأجناس عديدة، واتسعت دائرة العلوم، وتقسمت وتوزعت بين أرباب الاختصاص؛ قام كل فريق بتدوين الفن والعلم الذي يُجيده أكثر من غيره، فنشأ ـ بعد تدوين النحو في الصدر الأول ـ علم الفقه، وعلم التوحيد، وعلوم الحديث، وأصول الدين، والتفسير، والمنطق، ومصطلح الحديث، وعلم الأصول، والفرائض “الميراث” وغيرها..
وحدث بعد هذه الفترة أن أخذ التأثير الروحي يتضاءل شيئاً فشيئاً، وأخذ الناس يتناسون ضرورة الإقبال على الله بالعبودية، وبالقلب والهمة، مما دعا أرباب الرياضة والزهد إلى أن يعملوا هُم من ناحيتهم أيضاً على تدوين علم التصوف، وإثبات شرفه وجلاله وفضله على سائر العلوم، ولم يكن ذلك منهم احتجاجاً على انصراف الطوائف الأخرى إلى تدوين علومهم ـ كما يظن ذلك خطأً بعض المستشرقين ـ بل كان يجب أن يكون سداً للنقص، واستكمالاً لحاجات الدين في جميع نواحي النشاط، مما لا بد منه لحصول التعاون على تمهيد أسباب البر والتقوى”[23]
فأصبح التصوف منذ القرن الثاني، علما مستقلا بذاته عن بقية العلوم له قواعده وأخصاؤه وهم الشيوخ العارفون بالله، والذين وضعوا مدونات للتعريف بهذا الفن واستمداده من الشرع، وقواعده وثماره… على غرار ما فعل شيوخ العلوم الأخرى. يقول ابن خلدون: “وصار علم التصوف في الملة علما مُدَّونا بعد أن كانت الطريقة عبادة فقط، وكانت أحكامها إنما تتلقى من صدور الرجال، كما وقع في سائر العلوم التي دونت بالكتاب من التفسير والحديث والفقه والأصول وغير ذلك”.[24]
ثالثا: موضوع علم التصوف:
موضوع علم التصوف هو: “أفعال القلب والحواس من حيث التزكية والتصفية”.[25]
فيعمل المسلم على التخلي عن جميع الأمراض الظاهرة مثل: السرقة والزنى وأكل الحرام… والتخلص من الأمراض الباطنية مثل: الكبر والعجب والحسد… مصداقا لقوله تعالى: {وذروا ظاهر الإثم وباطنه} [الأنعام/121].
ثم يتحلى بمكارم الأخلاق وجميل الصفات، مثل: التواضع والحلم والكرم والرحمة… للفوز برضا الله تعالى ونيل سعادة الدارين.
رابعا: فائدة علم التصوف:
قال الشيخ زروق: “فائدة الشيء، ما قصد له وجوده، وفائدته: حقيقته في ابتدائه، أو انتهائه، أو فيهما.
كالتصوف: علم قُصد لإصلاح القلوب، وإفرادها لله، عمَّا سواه.
وكالفقه: لإصلاح العمل، وحفظ النظام، وظهور الحكمة بالأحكام.
وكالأصول: لتحقيق المقدمات بالبرهان، وتحلية الإيمان بالإيقان.
وكالطب: لحفظ الأبدان.
وكالنحو: لإصلاح اللسان، إلى غير ذلك فافهم”.[26]
ويقول حامد إبراهيم محمد صقر: “وفائدته (أي التصوف): إصلاح الإنسان ظاهرا وباطنا؛ فالتضلع في هذا العلم يقي صاحبه سوء الخاتمة، ويحمله على التوبة والإنابة وسلوك ما يوجب الفوز والسعادة”[27]
[1] قضية التصوف المنقذ من الضلال، عبد الحليم محمود، 29.
[2] الرسالة القشيرية، 279.
[3] إيقاظ الهمم في شرح الحكم، للعلامة ابن عجيبة، 6.
[4] الرسالة القشيرية، 279.
[5] الرسالة القشيرية، 279.
[6] المصدر السابق نفسه.
[7] قضية التصوف المنقذ من الضلال، 30.
[8] الرسالة القشيرية، 279.
[9] كشف المحجوب، 55.
[10] حقائق عن التصوف، 26.
[11] قواعد التصوف، 21.
[12] حلية الأولياء، 1/55.
[13] قواعد التصوف، 6.
[14] معراج التشوف إلى حقائق التصوف” لأحمد بن عجيبة الحسني، 4.
[15] مقدمة ابن خلدون، 3/ 989.
[17] الإعلام بأن التصوف من شريعة الإسلام، عبد الله بن الصديق، 11-12.
[18] كشف الظنون1،/345.
[19]سنن أبي داود، كتاب العلم، باب الحث على طلب العلم.
[20] قواعد الأحكام في إصلاح الأنام، العز بن عبد السلام، 2/367.
[21] الأنوار القدسية، عبد الوهاب الشعراني، 1/ 173.
[22] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الشهادات، باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد.
[23] المسلم مجلة العشيرة المحمدية” عدد محرم 1376هـ. من بحث: التصوف من الوجهة التاريخية للدكتور أحمد علوش، نقلا عن: حقائق عن التصوف، للشيخ عبد القادر عيسى، 27-28.
[24] مقدمة ابن خلدون، 3/991.
[25] نور التحقيق في صحة أعمال الطريق، حامد إبراهيم محمد صقر، 98.
[26] قواعد التصوف، 30.
[27] نور التحقيق في صحة أعمال الطريق، 99.