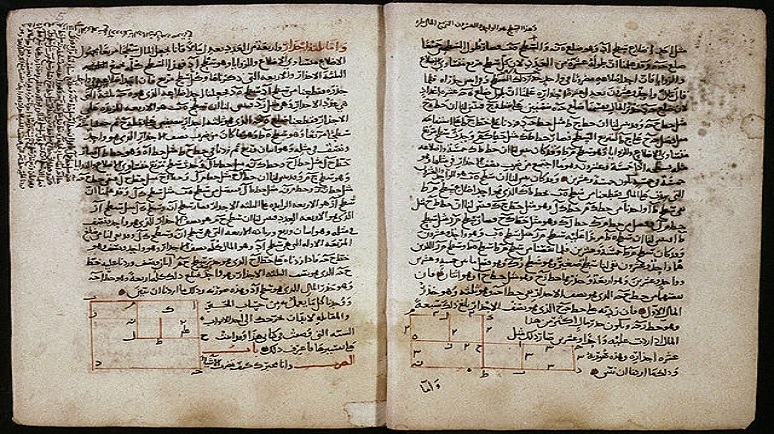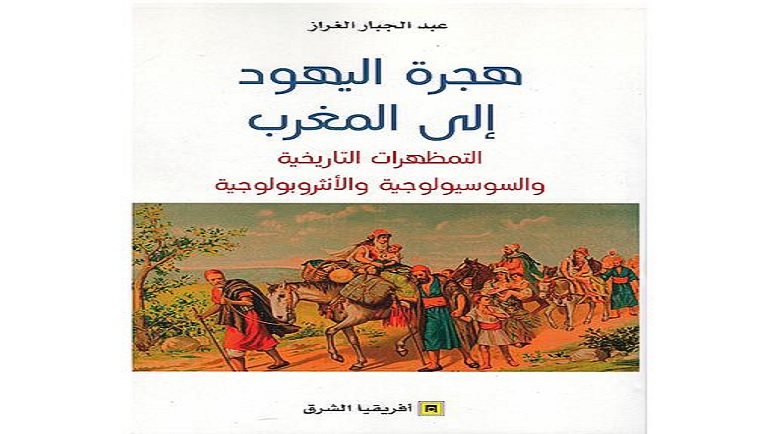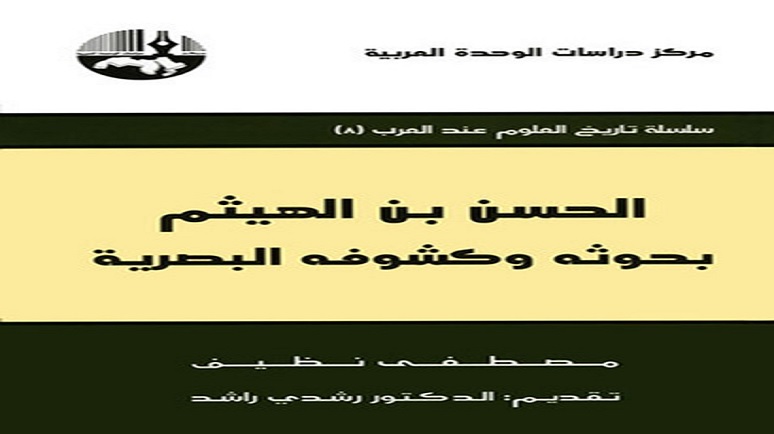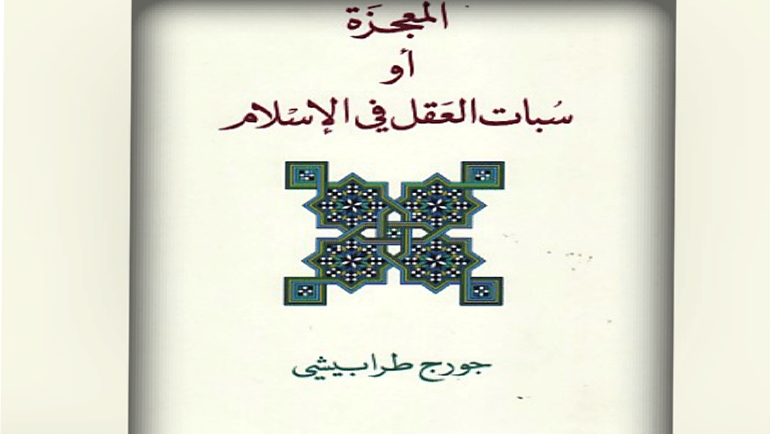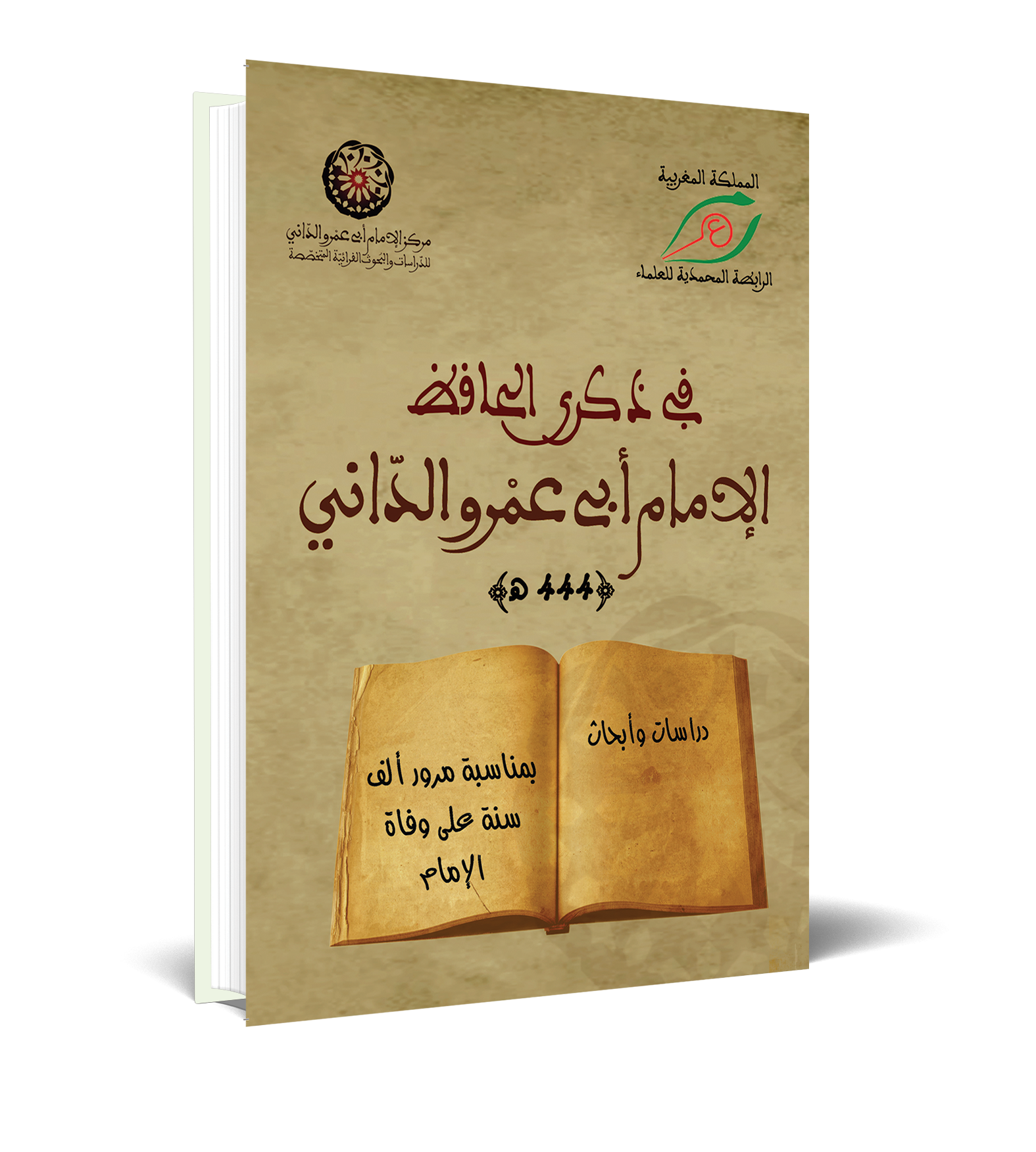ظل سؤال المنهج في الفكر الإسلامي المعاصر محدودا وأحيانا مغيبا. وهذا الغياب لسؤال المنهج قد يجد له الباحث مجموعة من الأسباب؛ من أهمها:
- طغيان الثقافة التراثية ذات الهم الكمي، وحضور هاجس التكديس والحفظ والتلقي السلبي.
- افتقاد الاستقلالية الفكرية اللازمة تجاه التراث، وعدم القدرة على فرز قطاعاته المعرفية المختلفة، وكشف الأطر المنهجية والمفاهيمية لكل قطاع..
- تهميش بحوث وكتب ودراسات قديمة، ذات طابع منهجي، ككتب آداب البحث والمناظرة والجدل وتاريخ العلوم… فبقيت منسية ولم تخرج لا تحقيقا ولا دراسة؛ فانقطع التواصل بهذا التراث المنهجي الذي كان يوازي ويرصد الإنتاج والكسب المعرفيين لعلماء المسلمين عبر مراحل التاريخ؛ إذ يتابعه بالنقد والتقويم ويرسم له الحدود المنهجية الضابطة. ولا يمكن تحصيل الاجتهاد في اصطناع المناهج ووضع النظريات ما لم تحصل معرفة شاملة بمناهج المتقدمين من علماء الإسلام في شتى العلوم[2].
- عدم انفتاح الفكر الإسلامي المعاصر على قطاعات معرفية حديثة وحيوية وضرورية لضبط التعامل العلمي مع المعارف والظواهر؛ كفلسفة العلوم وفلسفة المعرفة، ونظرية المعرفة، وعلم المناهج، وتاريخ العلوم، والمنطق، والفلسفة، وعلم نفس المعرفة، وعلم اجتماع المعرفة، واللسانيات، والتأويليات.
- تحقير سؤال المنهج والمعرفة، بوعي أو بدون وعي، عند أغلب المهتمين بالشأن الإسلامي المعاصر، وطغيان الهم الدعوي ذي النفس الخطابي والحماسي المحدودين؛ فالجهد المعرفي ليس هو التنقيب في الكتاب والسنة عن المعلومات والمفاهيم الجاهزة، كما يفعل الخطاب الدعوي البسيط، وإنما الجهد المعرفي في تجريد نموذج من النص المقدس “الكلي” ليساعدنا على تفسير الجزئي، في إطار الكلي، وعلى الحكم عليه، لتحقيق الانطلاقة المعرفية الاجتهادية المطلوبة في كل عصر[3].
في مقابل جمود الخطاب الفكري الإسلامي المعاصر، وضمور سؤال المنهج، ظهرت دراسات حديثة بادرت إلى طرح سؤال المنهج. ولعل من أبرز المشاريع الفكرية المعاصرة التي يمكن وسم خطابها بالمنهجي؛ مشروع إسلامية المعرفة الذي ينطلق من أن أزمة الأمة تكمن في فكرها، وفي منهج تفكيرها، وما يتصل بذلك من نظم للتربية والتعليم، تكرس الاغتراب، والابتعاد عن الإسلام وتراثه ونمطه في الحياة[4].
وينتقد مشروع إسلامية المعرفة المنهج التقليدي ويكتشف تناقضاته، ويوضح عناصر الجمود والتكلس فيه؛ حيث بقي الفقه الإسلامي نظاما ودائرة مغلقة، ولم يستطع أن يساير تحديات المنافسة الحضارية في العلم والتكنولوجيا. ولم تفد عمليات الإصلاح الداخلي التي تزعمها بعض الأئمة المجددين مثل محمد عبده والأفغاني؛ ذلك أن هذه المحاولات بقيت وفية للمفاهيم المغلقة التي كرسها فقه التقليد، في نظرته للفقه أو الاجتهاد[5].
ووعيا بهذه الاعتبارات سعى مشروع إسلامية المعرفة إلى تنظيم المبادئ الأساسية التي تكون جوهر الإسلام، جاعلا منها إطارا منهجيا للفكر الإسلامي ودليلا لتكوين العقلية والنفسية والشخصية الإسلامية في جهودها العلمية والحياتية[6].
كما دعا المشروع إلى القطع مع الجدل الكلامي والخوض الفلسفي في قضايا الذات الإلهية والصفات والقدر والسببية من حيث إن العقيدة الإسلامية، من الوجهة المنهجية، تتميز ببساطة البناء المؤسس على حقائق الوجود التي أتى بها الوحي. وألح المشروع على ضرورة إعادة تشكيل العلوم الحديثة ضمن الإطار الإسلامي ومبادئه وغاياته حتى تستعيد الرؤية الإسلامية، منهجا، وتربية وشخصية، صفاءها، وتتبين معالمها ومسالكها، ويستعيد الوجود الفردي والجماعي جديته وفاعليته في الحياة والوجود[7].
عموما فمشروع إسلامية المعرفة، مشروع منهجي، منطلقه البحث في إشكالية المنهاجية في الفكر الإسلامي باعتبارها نابعة من أزمة وجود الأمة الإسلامية في العصر الحديث. ويكمن جوهر هذه الأزمة في الجمود والقصور الذي ألم بمنهجية الفكر الإسلامي، انطلاقا من أن أزمة الأمة أزمة فكرية جوهرها منهجي. ولا سبيل لهذه الأمة للخلاص من أزمتها الحضارية المعاصرة من خلاص إلا بالوعي بأهمية المنهج.
يعد الدكتور طه جابر العلواني من أهم ممثلي المشروع، ومن المنظرين اللامعين له. فمنذ استشهاد الدكتور إسماعيل راجي الفاروقي، يكاد يكون طه جابر العلواني المتحدث الرسمي باسم مشروع إسلامية المعرفة، والمنظر الأول للفكرة. لهذا تميزت كتاباته بطابعها التأسيسي. ويمكن لمتتبع المتن الفكري لطه جابر العلواني أن يلحظ، بيسر، مدى محورية الهم المنهجي في مؤلفاته، بالنظر إلى عديد الكتابات التي عالج من خلالها الدكتور طه الإشكال المنهجي القائم في الفكر الإسلامي المعاصر، بدءًا بمؤلفه الموسوم بـ”إصلاح الفكر الإسلامي بين القدرات والعقبات، ورقة عمل”، وكتابه: “نحو منهجية معرفية قرآنية”، وصولا إلى كتابه: “معالم في المنهج القرآني”، الذي نتناوله، هنا، بالدراسة..
وهو الكتاب الذي يمثل دراسة قرآنية انطلقت من القرآن العظيم، وعاشت في رحابه، وبقيت تصدر منه وترد إليه حتى نضجت واستوت على سوقها، لم تأت القرآن مقتبسة مستشهدة لآراء كونتها، ثم جاءت تجعل آياته عضين تعزز بها مذاهبها، وتستشهد به لمواقفها، بل جاءته معلنة فقرها وحاجتها واضطرارها إليه مع يقين تام بأنها ستجد فيه ضالتها، وفي مكنونه المتكشف للمتطهرين بغيتها وغاياتها.
فهي دراسة نموذجية في طريقة تكوينها وبنائها، وتعاملها مع القرآن المكنون، فضلا عن نموذجيتها في القضايا التي تناولها. ولقد بقي المؤلف يتدبر آيات الكتاب الكريم، ويرتاد مغانيها ومعانيها ويقلب الفكر في قضايا المنهج ليصل إلى بناء هذه الدراسة.
تعد هذه الدراسة من الدراسات المنهجية في الصميم؛ ففي سائر جوانبها تجد محاولة جادة متميزة لمعالجة مشكلات المنهج في العلوم الإنسانية ومعالجة قضية المنهج بذاته؛ أي من حيث كونه منهجا، بل جاوزت ذلك بفضل القرآن العظيم لتقدمه منهجا قرآنيا بديلا عن سائر المناهج المعروفة.
والكتاب في شكله العام يحتوي على مقدمة، وفصلين: الأول بعنوان: المنهج العلمي الحديث. والثاني بعنوان: المعالم المنهجية في القرآن. بالإضافة إلى خاتمة.
قدم له الدكتور وليد منير حيث اعتبر الكتاب: “محاولة تأسيسية وخطرة في آن واحد؛ أما تأسيسيتها فترجع إلى أنها محاولة جادة لبناء منهج علمي متكامل الأبعاد انطلاقا من النص القرآني، وهو النص المركزي الأكبر في “الثقافة العربية الإسلامية”، مما يقتضي عقلنة مفهوم “الوحي”، ومفهوم “النبوة” بحسب ما نفهمه نحن من معنى “العقلانية” في تراثنا العلمي الإنساني.
وأما خطرها فينبع من كونها مبادرة شجاعة نحو ربط الدلالة القرآنية بالدلالة الكونية الشاملة في تعبيرها، وفقا لمنظور كثير من العلماء المجتهدين، عن قوانين الله في خلقه، وعن غاية الله من إيجاده الوجود على النحو الذي وجد به تحديدا، وبالتالي عن وجوب صدور الفعل الإنساني عن فاعله، وهو الإنسان، ممثلا لطبيعة القانون والغاية، وإلا صار انحرافا عن مسؤولية الحفاظ على تناغم العالم في معزوفة الخلق[8]“.
كما اعتبر وليد منير “معالم في المنهج القرآني”، مبادرة طموحة نحو نظرية شاملة توازن بين الثوابت والمتغيرات عبر الزمان والمكان، وتضع أسسا وقواعد لمسار تفكير العقل المسلم، وإطارا مرجعيا لحركته، بما يكفل له تجديد نفسه دوما، وشحذها بطاقات تفسيرية خلاقة[9]“.
لقد استهدف الدكتور طه جابر العلواني في هذا الكتاب الكشف عن منهج القرآن الكريم ومنهجيته، إيمانا منه بأن القرآن الكريم ليس كتابا دينيا يمكن أن يتعلم الناس منه العقيدة والشريعة وأخبار الماضيين من الأنبياء وأممهم وأخبار الآخرة فحسب؛ بل هو كتاب يمثل مصدرا لمنهج علمي يقود حركة الفكر الإنساني في مجالات المعرفة المختلفة انطلاقا من قوله تعالى: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ (المائدة: 48). ويشير الدكتور طه على أن الشرعة مبسوطة مفصلة في سور كثيرة من القرآن المجيد، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المنهاج، لكن العثور على معالم المنهج القرآني وتحديد صفات الآيات الكريمة التي تحملها في ثنايا القرآن المجيد يتطلب جهدا واجتهادا كبيرين، وذلك الجهد والاجتهاد أشق وأعمق بكثير من الجهد والاجتهاد اللذين يقتضيهما البحث عن الشريعة..
فعلماء أصول الفقه قدموا لنا أدوات ووسائل كثيرة تهدي حركتنا ونحن نتدبر لبلوغ آيات الشريعة، ولكن فيما يتعلق بالبحث عن المنهج لم نجد طريقا ممهدا كتلك الطريق التي مهدها علماء أصول الفقه للوصول إلى شريعة القرآن؛ فكان لابد من العمل على رسم منهج للوصول إلى “معالم المنهج القرآني” ودلائله فيه. وهنا تكمن خطورة ومشاق هذا البحث على حد تعبير الدكتور طه[10].
وفي استهدافه الكشف عن معالم المنهج القرآني يرفض الأستاذ طه إضافة مسعاه إلى ما شاع مؤخرا من وجود “إعجاز علمي في القرآن”، فإن ذلك خلاف ما يرمي الباحث إليه؛ لأن قصارى ما يمكن أن يقدمه “الإعجاز العلمي والتفسير العلمي” هو إسقاط ثقافة العصر على القرآن المجيد، وتحكيمها فيه، وتحويلها شواهد على صحته وعلو قدره. وهذا أمر يرفضه الباحث ولا يتبناه[11].
إن الهدف الأساسي الذي يتغيا أستاذنا تحقيقه من بحثه، هو التدليل على قدرة المنهج القرآني في تجاوز المناهج المعاصرة، والإقرار بأن المنهج العلمي التجريبي ذاته في أزمة، وفي حالة بحث عن مخارج تتجاوز هذه الأزمة، وتخرجها منها. يقدم الباحث القرآن المجيد، ومعالم منهجه ليستوعب بها أزمة المنهج العلمي ويتجاوز بها تلك الأزمة، والتهديدات التي تنذر بها لو استمرت “أزمة المنهج” بدون علاج[12].
يقول الدكتور طه جابر: “إن أزمة المنهج تهدد إنجازات البشرية بالمصادرة والتراجع والدمار؛ ولذلك فإن هذه الأزمة الكونية القائمة على كونية المنهج لا يمكن الخروج منها، وإنقاذ المنهج العلمي من إشكالاتها إلا بكتاب كوني يستوعب التفكيك، وينطلق في مجالات إعادة التركيب، ويستوعب العدمية والعبثية ويتجاوزها ليتجه باتجاه الغائية ويعيد بناء سائر التصورات والمفاهيم الكونية التي أهملتها أو فككتها نظريات العلم المنبت عن ينابيعه الإلهية وغاياته الربانية الكونية، وما نجم عن نظريات ما عرف “بالحداثة وما بعد الحداثة” من تفكيك خطير لم تصحبه قدرات تركيبية موازية له. وأي محاولة لإخراج المنهج العلمي من أزمته والعلم كله من فلسفة النهايات دون هداية كتاب كوني لن تكون نافعة أو مجدية، وهذا الكتاب لن يكون سوى القرآن الكريم[13].
إن قيمة الكتاب تكمن في الكشف عن معالم المنهج القرآني، مما يدل على أن القرآن كتاب منهج، وليس كتابا دينيا شأنه في ذلك شأن التوراة والإنجيل. وهنا قضية أعتقد أنه من المفيد التوقف عندها ولو قليلا؛ ذلك أن كثيرا من العاملين في حقول الفكر والمعرفة، يظنون أن معادلة المسلمين الصعبة اليوم وأزمتهم الفكرية تتمثل في فقدان المنهج، و يجهدون أنفسهم بالبحث والدرس، وتقليب الأمر على وجوه كثيرة، وقد يكون من ذلك التطلع إلى ما عند الآخرين. ولذا لا ينبغي فهم القول: بأن أزمة الأمة فكرية جوهرها منهج، على أن الأمة تفتقد المنهج كليا، “فالمنهج مصدر المعرفة موجود ومعصوم ومختبر تاريخيا؛ ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ (المائدة: 48). لقد ولد المنهج الإسلامي بنزول القرآن، الذي ابتدأ نزوله بـ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ (العلق: 1-5).
وجاء بعد هذا الأمر ﴿وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ (القلم: 1)، ﴿الرَّحْمَنُ. عَلَّمَ الْقُرْآَنَ. خَلَقَ الْإِنْسَانَ. عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ (الرحمان: 1-3).
جاءت هذه الآيات، وغيرها، لتهيئة العقل البشري قصد امتثال المنهج لهدم واقع الشرك وبناء واقع تحكمه وتهيمن عليه قيم التوحيد بما هي عوامل نفسية تشكل في الإنسان الدوافع، نحو البناء الحضاري المنشود، ولقد جاء المنهج القرآني مصحوبا بالرؤية الكلية التي هي أساس المنهج التي تجعل الإنسان قادرا على الإجابة عن الأسئلة النهائية في الفلسفة والتي يعبر عنها بالعقدة الكبرى: من قبيل من أنا…؟ ومن أوجدني..؟ من أين أتيت وما مصيري…؟
إن القرآن الكريم منح الإنسان منهج النظر؛ حيث منحه الثقة بنفسه وجعله صاحب إرادة وصاحب فعل. لكن للأسف؛ فالمبادئ العامة للمنهج الإسلامي بقيت على حالها مجرد مبادئ وأسس عامة، ولم تتطور لتصبح علوما محددة، فضلت الأمة الإسلامية طريقها، وفقدت منهجها، وتحولت عقليتها من عقلية إبداعية تجديدية استئنافية إلى عقلية سكونية انبثق عنها فكر التعاقب والاجترار والتكرار.
والكتاب يسعى إلى الإجابة عن سؤال كيف انحرف الفكر السكوني بكثير من المفاهيم الإسلامية وقطعها عن غاياتها وبيئاتها وفهمها بطريقة قاصرة؟ من خلال الكشف عن منهج القرآن المجيد الذي يعتبر بمثابة المسدد لمسار تفكير العقل المسلم. وهنا تكمن قيمة العمل وأهميته.
يتناول المؤلف في الفصل الأول بالدراسة والتحليل والنقد سياقات المنهج الغربي المعاصر بعد أن تتبع تعريفاته العديدة والمختلفة باختلاف المدارس الفلسفية الغربية. وأهم هذه الانتقادات ما أثاره الدكتور طه عن العقل الفطري والعقل الوضعي، وعن ملابسات التطور والتحكم في العلوم الطبيعية والرياضية، وعن طبيعة التفكير والعقل والانحياز المادي. لينسب إلى طبيعة التفكير السائد في الغرب أزمات المنهج العلمي المعاصر..
ومما يبرز خطورة هذه الأزمة مقولات نهاية التاريخ وصراع الحضارات التي تمثل ردة حقيقية عن المنهج والعلم ومعطياته، وتجعله بمثابة جاهلية حقيقية، أو تصيره مندرجا تحت العلم المذموم، وما هو بذلك. فللعلم قواعد ومناهج وله روح وغايات ومقاصد، فإذا فصل بين العلم وروحه فقد تأثيره العمراني وتحولت منتجاته ومعطياته إلى وسائل دمار شامل كما هو حاصل اليوم[14].
ويشير الأستاذ طه جابر إلى أنه ليس صحيحا ذلك التصور القائل إن الحضارة المعاصرة تملك الوسائل التي تمكنها من تصحيح مسارها ذاتيا، وتجديد ما يبلى من وسائلها بنفسها، مؤكدا، في الوقت نفسه، أن أي مصدر غير كوني لا يملك أن يقدم اليوم للبشرية العلاج النافع من داخل الفكر البشري، بعد أن بلغت الحضارة هذه المديات من التأزم، وبلغت التحديات التي تواجهها مثل ذلك المستوى، ونخشى لو استمر العلم يترنح في أزماته على أيدي ذلك النوع من أنصاف العلماء الذين ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآَخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾ (الروم: 6). أن يتراجع تراجعا خطيرا باتجاه الخرافة، أو الغيبية السلبية والغنوصية ونحوها من الاتجاهات البائدة[15].
ولأن أزمة العالم أزمة كونية، فإن أي مصدر غير كوني لا يملك أن يقدم اليوم للبشرية العلاج الناجع من داخل الفكر البشري بعد أن بلغت الحضارة هذه المديات من التأزم. يقول طه جابر العلواني: “إن حل أزمات العلم المعاصر ومنهجه لا يمكن أن تقدمه المختبرات ومراكز البحوث الأرضية لأنها كلها لم تكتشف الآفاق الكونية التي تربط بها الإنسانية خلقا وكيانا وتوليدا، كما لم تكتشف العلاقات بين الغيب والإنسان، وهذه المختبرات والأدوات والوسائل ليست مؤهلة لذلك[16]“.
يترتب على هذا أن الخروج من هذا التأزم لا يمكن أن يأتي على يد من كانوا سببا فيه، ففاقد الشيء لا يعطيه. لنجد أنفسنا أمام سؤال: من بيده الحل؟ أو من يملك الحل؟
يبادر أستاذنا فيجيب بأن القرآن المجيد وحده الذي يمكن أن يقوم بالتحدي، ويحقق الإعجاز، ويستوعب المنهجية المعاصرة مهما ارتقت، بل ويخرجها من أزماتها، ويعل مسيرتها ويصل بها إلى نهاياتها الفلسفية؛ لتأخذ بعدها الكوني، فبفضل قدرات القرآن الاستيعابية وبفضل قدراته في التجاوز لا تسقط البشرية مرة أخرى في أحضان اللاهوت الأرضي[17]“.
بيد أن هنا إشكالا معرفيا خطيرا يعاني منه الفكر الإنساني برمته بما فيه فكر المسلمين يحول دون إبراز وتقديم المنهج القرآني لعالم اليوم، يتمثل عند أستاذنا في النظرة القاصرة للقرآن باعتباره كتابا دينيا بالمفهوم اللاهوتي للدين، وهذا يمنع من اكتشاف أن في القرآن منهجا علميا كونيا، ومنهجية كونية لا تقاس إلى المنهجية العلمية المعاصرة، ولا تتنافى معها، ولا تناقضها في الوقت نفسه، بل تستوعبها وترقيها[18].
يؤكد الدكتور العلواني أن المنهجية القرآنية سوف تعيد صياغة فلسفة العلوم الطبيعية في بعدها الكوني؛ الذي يتضمن غاية الحق من الخلق في الوجود وفي الحركة، وبذلك يحرر القرآن “المنهجية المعاصرة والعلوم” التي انبثقت عنها من التأويلات الوضعية والمادية التي أصابتها بقصور مناقض للأصول التي تكونت بمقتضاها وبنيت عليها، بحيث صارت الحتمية العلمية سبيلا إلى الاغتراب الإنساني..
فالقرآن المجيد بمنهجيته الكونية سوف يساعد البشرية على إعادة بناء منهجيتها بعد أن يخرج هذه المنهجية من أزمتها، كما سوف يساعدها على إعادة فهم مدلولات القوانين الطبيعية، وهذه قضايا أساسية إذا لم تعالج بدقة وبمنهج كوني، فإن الإنجازات التي بلغتها البشرية تصبح في خطر حقيقي[19].
وشدد المؤلف في خاتمة فصله الأول على قدرة المنهج القرآني على ترشيد العلم وإنقاذ البشرية، وتصحيح مساريها العلمي والعملي؛ وهذه القدرة في نظر المؤلف إنما هي نتيجة طبيعية لعالمية الخطاب القرآني، مشددا على ضرورة تقديم الخطاب القرآني في مستوى يستوعب عالمية ثلاثية “المنطق والمنهج والتفكير الإنساني المشترك” التي فرضت أن يكون الخطاب المفيد خطابا عالميا. وقد نفى العلواني أن يكون المقصود بالعالمي هنا، الخطاب المصدر بـ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ عند الأصوليين، بل الخطاب المستوعب للعناصر الثلاثة المتقدمة: “المنطق، والمنهج، والتفكير الإنساني المشترك”، وإلا فسيكون خطابا حصريا خاصا بشعبك أو أمتك أو قومك أو إقليمك[20].
ليأتي الفصل الثاني لبسط المعالم المنهجية في القرآن والتي حددها المؤلف في التوحيد، والجمع بين القراءتين، والوحدة البنائية.
التوحيد باعتباره محور الرؤية الكلية القرآنية؛ والتي أصبح الإنسان قادرا على بلوغ مستوى “الاستقامة والحيدة العلمية”، في فهمه لما حوله وتفسيره له، وفهم خواصه، وتحديد وسائله وأساليبه؛ لأن التوحيد من شأنه تحرير الإنسان عقلا ونفسا وقلبا ووجدانا من الخرافة والأوهام والمشاعر السلبية وسائر الضغوط والتحيزات التي من شأنها أن تقلل الطاقات المعرفية الواعية لدى الإنسان[21].
والجمع بين القراءتين محدد يمكن من الربط بين الغيب والواقع، ويمكن من استخلاص محددات يقرأ الواقع بها، ويمكن من الصياغة الدقيقة لإشكالات الواقع والعروج بها إلى القرآن المجيد في وحدته البنائية للوصول إلى هديه في معالجتها[22].
الوحدة البنائية والاستيعاب الكوني محدد ينبغي أن يجري التعامل معه باعتباره مصدر المنهجية الكونية، فلا يجوز تجزئته بحال، وهذه الوحدة تجعل من المحال أن يقع في القرآن تضارب، أو اختلاف أو نسخ، أو تعارض[23].
إن هذه المحددات الثلاثة، وفي مقدماتها الجمع بين القراءتين ستكشف، حسب الدكتور طه، عن استيعاب القرآن المجيد لمبدأ الصيرورة، ويعطي للصيرورة مدلولا كونيا يستوعب المعنى الوضعي ويتجاوزه، والجمع بين القراءتين عند الباحث ليس من قبيل التنويه بفضيلة من فضائل القرآن، بل لندرك أن الجمع إنما هو خطوة منهجية تتوقف على معرفة منهجية وفلسفة العلوم الطبيعية ليتم الجمع بينهما وبين منهجية القرآن المعرفية بالشكل المنهجي[24].
وباكتشاف المحددات المنهجية القرآنية نستطيع صياغة أسئلتنا وتوجيهها إلى القرآن كي يجيب عنها: هل هناك سببية أم لا؟ وإذا وجدت فهل هي مطلقة أم نسبية؟ وهل الإنسان حر كامل الإرادة أم لا؟ وما مجال جبره واختياره في جدلية الحياة والواقع؟ وما قصد الوجود وغايته؟ وما معنى المصير؟ وقد فسر القرآن الكريم هذه الأمور تفسيرا واضحا، فيما عجز عن ذلك المنهج العلمي المعاصر؛ إذ لم يقدم تفسيرا مقنعا بخصوصها.
ويرجع الدكتور طه ذلك لمل استقر في العقل الأوروبي، أن العلم لا علاقة له بالغيب وهناك خشية كبيرة جدا لدى العلماء بأن ربط العلم بالغيب قد يجر إلى هيمنة الكنيسة من جديد. أما القرآن فيبين أن ما يجري الكون لا ينتج عن علاقة أو جدل بين الإنسان والطبيعة وحدهما، بل إن للإنسان والطبيعة خالقا هو الله، فحين يحتار العالم الطبيعي في تفسيره هذه الظواهر فلأنه لم يضع في حسابه بعد الغيب. ولغياب الإيمان بالله وتجاوز الغيب فإنه يعجز عن إدراك تفسير تلك الظواهر. وهنا يتقدم القرآن لحل هذا الإشكال المنهجي ويستوعب أزمة المنهج. ويقول له: ما زلت أيها المنهج العلمي على شيء من حق حتى تستحضر البعد الثالث: الإيمان بالله والغيب.
إن القرآن الكريم في هذه الحالة يعزز الموقف العلمي ويطهر المنهج العلمي ويقوم بعملية تصديق عليه، وتنقية له، من جوانب النقص واستحضار للأبعاد الغائبة عنه، ويقوم، بعد ذلك، بالهيمنة عليه ووضعه في إطاره، واعتباره قائما على تلك السنن الثابتة التي لن تجد لها تحويلا[25].
وفي معرض تأكيده على اشتمال القرآن على منهجية كونية، يتطرق الدكتور طه جابر العلواني لنظرة القرآن للإنسان والطبيعة، مؤكدا على وحدة المنشأ والمصدر والمصير بالنسبة لكل من الإنسان والطبيعة، كما يؤكد أن للقرآن منهجه في التعامل مع المكان والزمان والتاريخ. ولأن فقه الواقع، في نظر العلواني، جزء من المنهج، فالقرآن المجيد، بحسبه، قد بنى “الواقع” في منظومة متكاملة، تبدأ فكرة في الذهن، وبعد التفاعل معها تنتقل لمرحلة التصور، لتنتقل إلى العقل ليطبق عليها منطقه، ويختبر بذلك سلامتها، ويطمئن إلى جدوها وفائدتها، فإذا بلغت منه هذا المبلغ انتقلت إلى القلب ليربط عليها وهنا تصبح عقيدة[26].
ولأهمية الواقع في بناء المنهج، يشير المؤلف أننا نجد في القرآن عددا من المداخل المنهاجية لدراسة الواقع وفقهه؛ حيث وردت منتشرة متناثرة في آياته، فالقرآن يقارب الواقع باستقرائية تاريخية، وقد يقاربه بالتنبيه إلى الأخذ “بالنظر العقلي”، وبعقلية استنباطية تجمع بين الدعوة إلى البحث الميداني، واستقراء الوقائع والأحداث، والتأكيد على استعمال المداخل التحليلية النظرية والفكرية في التعامل مع الظواهر التي تتناول للوصول إلى النتائج، ثم اختبار صحة النتائج ودقتها.
ومع اعتراف العلواني بوجود فقه للواقع في القرآن يمكن من بناء منهج علمي يستوعب المنهج العلمي التجريبي، يشدد على أن اكتشاف المداخل المنهاجية القرآنية لدراسة الواقع وفقهه، يحتاج إلى إمكانات عقلية كبيرة، وقدرات ذهنية واستعدادات عالية، وتكوين منهجي، ومهارات بحثية ومعرفية، وهي الأمور التي لم تزل نادرة الوجود في بيئاتنا بحسب تعبير العلواني[27].
يقترح المؤلف منهجا للإجابة على تساؤلات الواقع، يخالف به منهج “علم أصول الفقه”؛ فبعد أن انتقد آلية عمل المجتهد في المدونة الأصولية؛ والتي اعتبرها أقرب إلى الانتقائية، لخص آلية عمل المجتهد في المدونة الأصولية بقوله: “حين تعرض للمجتهد نازلة من النوازل ينظر فيها، وبعد أن يلم بها وبجوانبها المختلفة يقرأ -كله- ويدون ملاحظاته ثم يجمع كل ما يتعلق بها من آيات الكتاب الكريم، بعد أن يكون قد أدرك سياقها، ثم بيانها من سنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وكيف علمها لجيل التلقي، ودربهم على اتباعها، ومعرفة آثارها في جيل التلقي، ثم يبدأ النظر للكشف عن الحكم الذي يمكن أن يحكم به على الواقعة الحادثة بعد تقييمها، وتحديد ما فيها من مصالح أو مفاسد[28]“.
كانت هذه نظرة العلواني لطبيعة المجتهد كما هي في علم أصول الفقه، والتي حكم بقصورها، ولتجاوز هذه الآلية يقترح منهجا يرى من خلاله: “أنه على الباحث أن يصوغ سؤاله أو إشكاله؛ إذ إن ذلك السؤال أو الإشكال بمثابة النازلة، وهو تصور لها في كل الأحوال، ثم يعرج بها إلى القرآن.
يرى العلواني أن “الإشكالية أو الأزمة” حالة ضرورية لفهم رسالة الأنبياء ومضامين رسالاتهم، وإدراك أهميتها، والقارئ الذي يأتي للقرآن الكريم بدون أزمة، أو بدون شعور كامل ووعي بها، فإنه من الصعب أن يتجاوز في فهمه للقرآن الجوانب التعبدية، والفهم الظاهري؛ لذلك تركزت أنظار جمهرة علمائنا في التاريخ على الاستنباطات الفقهية والفهم اللغوي الذي يعززه المأثور أحيانا، وعلى الجانب المتعلق بالتزكية والتطهر؛ لأن الغالبية العظمى أو الجمهرة كانوا يدخلون إلى رحاب القرآن أفرادا يحملون هموم التزكية والخلاص الفردي، فيعطيهم القرآن من كريم عطائه ما تخبت له قلوبهم، وتقشعر به جلودهم، وتتزكى به نفوسهم.
أما الذين يفضى القرآن إليهم بمكنون منهجيته فهم أولئك الذين يجثون بين يديه وملؤوا عقولهم وقلوبهم ونفوسهم وجلودهم همٌ عام، و”أزمة عالمية أو إقليمية” في الأقل لم يجد أولئك لها حلا من داخل أي نسق معرفي بشري؛ سواء أكان موضوعيا أو وضعيا، فجاؤوا القرآن ضارعين خاضعين يلتمسون الحل فيه وهم على يقين أن الحل لا يخرج عن محكم آياته، فليس للأزمة إذا استفحلت واستحكمت من دون الله كاشفة..
فالسقف المعرفي له أثره على القارئ، ولكن لا ليقايس القرآن عليه؛ بل ليصوغ أسئلته منه، ويذهب بها إلى القرآن المجيد بحثا عن الحل الشافي، وهنا يبرز أهم فرق بين عصر النبوة والعصور التي تليه؛ ففي عصر النبوة كان القرآن هو الذي ينزل على الواقع فيعالج مشكلاته. أما في عصرنا هذا، فإن الأمر قد اختلف، فنحن مطالبون بأن نتقن دراسة وتحليل وفهم مشكلاتنا وصياغتها بصيغة السؤال، ثم نأتي بها إلى القرآن لنطرح بين يديه ونلتمس منه الجواب أو الهداية إليه؛ فنتلوه ونحاوره حتى نبلغ سبيل الرشد في أزمتنا[29].
وقد قدم المؤلف أمثلة في هذا المقام لإشكاليات واقعية ومنهج قراءة القرآن لتوليد الإجابة من رحابه؛ كإشكالية التسيير والتخيير، وإشكالية السببية والاحتمالية، وإشكالية الصدفة والقدر، حيث قاده منهجه المقترح إلى اجتهادات جديرة بالدراسة والمناقشة.
يحمل خطاب الدكتور طه أيضا مخططا واسعا حول مقاصد التشريع الكبرى: “التوحيد، التزكية، العمران” باعتبارها مؤشرات منهجية لبناء مجتمع ذي مناشط متوازنة تكفل له السواء النفسي من جهة، وتنقذه من براثن التبعية لترسيمات المشروع الغربي الذي انتهى به الأمر إلى خداع المستضعفين باسم العولمة التي لا تعني عالما واحدا بقدر ما تعني تسلط الغرب على هذا العالم الواحد وقهره، وهو المسكوت عنه في خطاب الغرب.
كما يرسم مشروع المنهج حدود العلاقة المنهجية بين الكتاب والسنة، وهو أمر شديد الأهمية، بل هو في نظر طه من أخطر القضايا المعرفية. ويخلص إلى أن السنة الصحيحة في أغلبها، تجد مهادها المفهومي والدلالي في القرآن الكريم؛ فالقرآن والسنة يتعاضدان جذريا، من حيث التأكيد والتشديد على قيم وسلوكيات ومعايير بعينها. يقول طه جابر العلواني موضحا لما ينبغي أن تكون عليه علاقة القرآن بالسنة: “إن القرآن المجيد هو المصدر المنشئ الوحيد للمنهج وتتكامل السنة الثابتة به، الدائرة معه في جانبها الموحى معه بوصفها المصدر المبين على سبيل الإلزام.
كما أنها المصدر التطبيقي الذي يقدم للبشرية “نموذج التأسي” بما يشتمل عليه من ترجمة عملية للهدي القرآني ونقله إلى سلوكيات إنسانية تندرج فيها المواقف التاريخية بأبعادها الزمانية والمكانية. أما ما بقي من السنة الصحيحة فهي كما نص الشاطبي مثلها مثل السنة جملة: راجعة في معناها إلى الكتاب؛ فهي تفصيل مجمله، وبيان مشكله، وبسط مختصره، أما القرآن فهو كلية الشريعة وينبوعها… ولأن الله جعل القرآن تبيانا لكل شيء؛ فيلزم من ذلك أن تكون السنة حاصلة في جملته[30]“.
بعد هذا التطواف الممتع، يختم طه جابر العلواني كتابه بالتدبر في قوله تعالى: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ (المائدة: 48)، مشيرا إلى أن الله، عز وجل، قد قرن في هذه الآية “المنهاج بالشرعة”، ومادام سبحانه قد قرن المنهاج بالشرعة فذلك يعني أنهما متساويان في الأهمية، أو متقاربان جدا في أقل تقدير. مؤكدا على أنه وإن كان القرآن قد اشتمل على الشريعة وقام ببيانها؛ فلابد أن يكون قد اشتمل على المنهاج وبينه كذلك[31].
إن أهمية هذا المنزع التحليلي العميق تكمن في كونه ينبه القارئ إلى أن المنهج القرآني أمر يحتاج إلى بحث وجهد وكد وكدح، وأن المراد بالمنهج ليس المعنى البسيط السهل المتبادر إلى الذهن، وهو المعنى اللغوي أي الطريق والنهج أو الواضح البين،كما أنه ليس السنة ولا جملة علم أصول الفقه. بل هو المعنى الفلسفي للمفهوم. إنه المنهج بمحدداته كما عرضها الباحث في صلب دراسته.
ويستمد البحث قيمته من قيمة صاحب المشروع الدكتور طه جابر العلواني المجدد والمصلح والناقد، والذي يتمثل همه الأكبر في إعادة تشكيل العقل المسلم وفقا لمنهج علمي واجتماعي وثقافي مستقى من القرآن المجيد.
في الختام نؤكد أن بيان منهجية القرآن المعرفية مهمة عالمية؛ تهم العالم كله، ويحتاج إليها العالم كله، وإن تصورها البعض مهمة في إطار الخصوصية الجغرافية والبشرية الإسلامية، ومع كون المهمة عالمية يتأكد أيضا كونها قرآنية محضة، فأمام التدافع الديني، ومآزق الأنساق الحضارية العالمية، وختم النبوة وبروز الأزمات الفكرية والمعرفية عالميا ومحليا، يتصدى القرآن وحده لخوض معركة شاملة بحسبانه كتاب وحي حق مطلق.
وأعتقد أننا أمام تحد كبير ومهمة صعبة تتجلى في الكشف عن منهجية القرآن المعرفية، والكشف عن جوانبها الكثيرة، والبناء عليها وضرورة تفعيلها؛ بما يمكن من إنقاذ البشرية ويدخل الناس في السلم كافة، سالكين طريق القرآن المجيد. لكن علاقتنا الحالية بالقرآن العظيم تمكننا من تحقيق مقصدنا هذا؟
الهوامش
- طه جابر العلواني، معالم في المنهج القرآني، القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، (1431ﻫ/2010م).
[2]. انظر: طه عبد الرحمان، تقويم المنهج في تجديد التراث، المركز الثقافي العربي، ط1، بتصرف، ص20.
[3]. عبد الوهاب المسيري، في أهمية الدرس المعرفي، مجلة إسلامية المعرفة، السنة الخامسة، العدد العشرون، ص120.
[4]. إسلامية المعرفة، المبادئ العامة، خطة العمل، الإنجازات، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط1، ص32.
[5]. طه جابر العلواني، معالم في المنهج القرآني، م، س، ص63.
[6]. المصدر نفسه، ص75.
[7]. المصدر نفسه، ص67-77.
[8] . المصدر نفسه، ص11.
[9] . المصدر نفسه، ص15.
[10] . المصدر نفسه، ص20.
[11] . المصدر نفسه، ص22.
[12] . المصدر نفسه.
[13] . المصدر نفسه، ص23.
[14] . المصدر نفسه، ص59.
[15] . المصدر نفسه.
[16] . المصدر نفسه، ص60.
[17] . المصدر نفسه، ص61.
[18] . المصدر نفسه، ص62.
[19] . المصدر نفسه، ص62-63.
[20] . المصدر نفسه، ص63.
[21] . المصدر نفسه، ص83.
[22] . المصدر نفسه، ص84.
[23] . المصدر نفسه، ص86.
[24] . المصدر نفسه، ص89.
[25] . المصدر نفسه، ص111-112.
[26] . المصدر نفسه، ص95.
[27] . المصدر نفسه، ص102.
[28] . المصدر نفسه، ص104.
[29] . المصدر نفسه، ص105.
[30] . المصدر نفسه، ص125-126.
[31] . المصدر نفسه، ص147.