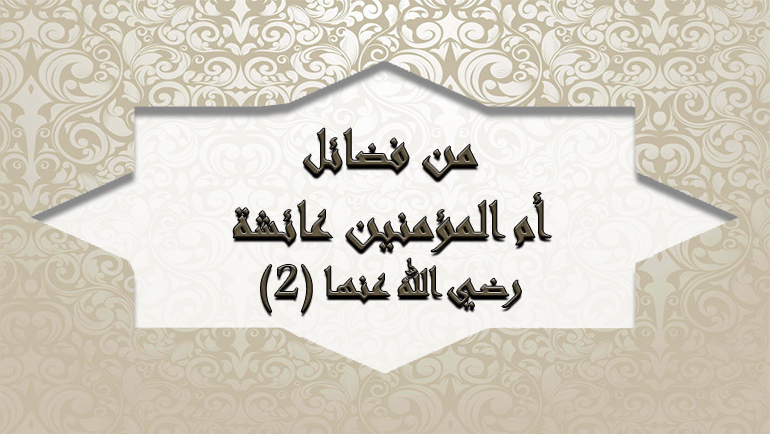لعلّ العناية المبكّرة بمناحي الاستنباط، وطرائق التّنسيق بين ظواهر الكتاب والسّنة في تاريخ الفكر الإسلامي هي التي ميّزت علم الأصول عن سائر العلوم الشّرعية، وبوّأت ذويه مكانة سامية؛ إذ لا يخفى على ذي بصيرة ما في ضبط المناهج من أهميّة بالغة في العلوم على اختلاف أجناسها ومجالاتها، فهي أسمى ما يقصد إليه أصحاب الهمم العالية، وتتشوّف إليه نفوسهم؛ إذ بمقدار تفاوتها تماسكا واضطرابا، تتفاضل العلوم، وتتمايز الفوائد المترتّبة عليها.
ولئن سما الفكر الأصوليّ بالأنظار الفقهيّة نحو التّجريد والتّقعيد، وضرب بسهم وافر في وضع مناهج حريّة بتيسير مهمّة الفقيه في الاستنباط، وصون نظره من التّأويل الفاسد، ووقايته من الوقوع في التّناقض مع منطق التّشريع[1]، فإنّ ما أثمرته جهود ذويه من مباحث نظريّة، واهتدت إليه من قواعد اطّرد الاستناد إليها في التّفريع طوال قرون لم يبرأ من النّقائص، فمسائل أصول الفقه ليست على درجة سواء، فقد استمدّ أهله من بعض العلوم العقليّة والنّقليّة ما أرهق الفكر، وأهدر الوقت، وحال الاشتغال به دون تطوير العلم، وضمّنوه مدارك اختلفت قوّة وضعفا، وأصولا تفاوت احتياج الفقيه إليها سعة وضيقا، وأهملوا فيه قواعد أوسع ممّا دوّنوه، وأولى بالاعتبار في الاجتهاد، لذلك احتاج إلى مراجعة نقدية لبنيته تنقيحا، وتقويما، وإثراء. ونحن لا نرمي إلى مجرّد الكشف عن مواطن الخلل التي انتهت بهذا العلم إلى أزمة منهجيّة في القرن الثّاني عشر للهجرة، بل أيضا إلى ما حواه من قواعد جليلة تكفل مرونة الشّريعة، واطراد صلاحها. وفي هذا السّياق تتنـزل هذه الدّراسة، فهي قراءة تقويمية معتدلة لعلم أصول الفقه لا تجنح إلى هدم ما شاده السّابقون بتعلّة كونه غير صالح لإسعاف الفقيه المعاصر، فإنّ ذلك من الجور، والتنكّر لما بذلوه من جهود مثمرة، ولا تميل أيضا إلى قبوله على علاّته بدعوى بلوغه الكمال؛ لأنّ ذلك تقديس للنّسبيّ الخاضع للزّمان والمكان، وموجب لتثبيط الفكر، وحرمـان المتأخّرين من الإسهام في إثراء مضامين العلم، وسبـر منـاهج الاستنباط، والتّجديد فيها[2].
أوّلا: ما لا يحتاج إليه من المسائل
تولّد من شيوع علوم الحكمة، والعقليّات في القرن الرّابع الهجري حالتان تأثّر فيهما العلماء بالمنهج الذي كان يجرى عليه الفلاسفة: الأولى: هي العزوف عن النّقـل والحفظ، والتّوسّع في طرق التّأمل والنّظر، لذلك انكبّ العلماء على النّقد والتّصحيح، والتّعليل، والتّمحيص، فهذّبوا العلوم، وأجادوا التّقاسيم، والتّفاريع، وفي هذا القرن تأثر الفكر الأصولي بالمنطق في ضبط الحقائق والمعاني، وتحرير المسائل، وتقويم الأنظار، وسرت إليه روح الجدل والمناظرة، وفي القرن الخامس امتلك ذويه حبّ التوسّع في تحقيق المسائل إمعانا في نصرة المذاهب، وفي ترسيخ ما تقرّر فيها من مناحي الاستنباط، فتصدّى كلّ فقيه للانتصار لمذهبه، والدّفاع عن مدارك إمامه، وتفنيد ما تقرّر عند غيره بقطع النّظر عن رتبته قوّة وضعفا[3]، والحالة الثّانية: هي التّشوف إلى تحصيل كثير من العلوم، والمشاركة فيها تشبّها بالحكماء الذين جعلوا علومهم متولّدا بعضها من بعض ومتفرّعا عليه، فكان العالم يرغب في أن يكون جامعا بين العلوم النّظريّة، والنّقلية حتّى ينعت بالمتكلّم، المنطقي، الأصولي، الفقيه، الأديب الشّاعر[4]. ولكن لمـّا استفحل ميل النّفوس إلى المشاركة في معظم العلوم صارت المؤلّفات مزيجا من المسائل التي يتوقّف بعضها على فهم بعض[5]، ولم يسلم علم الأصول من ذلك، فقد وسّعه الأصوليّون بإدخال ما لا يفتقر إليه في خدمة الغرض الذي من أجله وضعت قواعده، فقد مزجوه بالمنطق، والكلام، واللّغة، والنّحو مزجا تولّدت منه مباحث نظريّة موغلة في التّجريد عظم فيها اختلافهم، وعكفوا عليها قراءة وإقراء حتى توهّم الطلبة في طور التّحصيل أنّها من صلب العلم، وذلك نحو تعليل أفعال الله تعالى بالأغراض[6]، وابتداء الوضع[7]، والتكليف بالمحال[8]، وأمر المعدوم[9]، وتعبّد النبيّ بشرع قبل البعثة، وكون الإباحة تكليفا[10]، وكون اسم الخطاب يصدق على الكلام في الأزل[11]، وتعريف الألفاظ الشّرعية باعتبار الكلام النّفسي[12].
وقد كان الخوض في هذه المسائل النّظريّة موجبا لإهدار الجهود، وتضييع الأوقات، فقد كان الرّجل يفني زهرة عمره في الاشتغال بها شرحا وتمحيصا واستدلالا، طلبا للتّضلّع فيها دون أن يكون لذلك أثر في تحصيل ملكة النّظر[13]، ولا في تطوير قواعد هذا العلم فضلا عن التّجديد فيها، فأقصى ما بلغ إليه البالغون راجع إلى الكشف عمّا غمض، وتبيين ما ورد مجملا في المؤلّفات السّابقة، أو إلى تحرير العبارات، وتحسين التّبويب، والتّصنيف بين المسائل، فأبو حامد الغزالي وهو أجود من عبّر عن هذا الصّنيع في المستصفى قد جرى في تقسيمه على منهج محكم دقيق، فبيّن أنّ هذا العلم وإن كثرت أبوابه، وانتشرت فصوله، فإنّ جميع شعبه ترجع إلى أربعة أقطاب تربط بينها وشائج قويّة، وهو وإن مهر في تبيين كيفيّة ذلك بأسلوب لم يسبق إليه، وبرع في اختيار الحجج وترتيبها، فإنّه لم يثر العلم بأنظـار جديدة، ولم يخرج عمّا اعتمده الباقلاني، وإمام الحرمين في تقرير المسائل، وشرحها، والاستدلال لها[14].
وقد كان هذا الإمام واعيا بذلك الإسراف في المزج وما نشأ عنه من خلل في التّأليف[15]، ولكنّه لم يستطع التحرّر من هذه العادة التي جرى عليها المصنّفون في عصره؛ لأنّ “الفطام عن المألوف شديد، والنّفوس عن الغريب نافرة[16]“، ولم يكتف أبو إسحاق الشّاطبي بعده بالتّنبيه على الدّخيل في الأصول، بل وفّق في تنقيح كتابه من معظم مسائله[17]، وعضد ما ذهب إليه بسوق جملة من النّصوص الدّالة على أنّ الخوض فيما لا ينبني عليه عمل مذموم في الشّرع[18]، وقد أطلق عليه في المقدّمة الرّابعة “عارية”، وأرجعه إلى ثلاثة أنواع:
الأوّل: مالا يكون منتجا للفروع أو لا يكون عونا في ذلك؛ إذ هذا العلم لم يختصّ بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدا له، ومحقّقا للاجتهاد فيه. وهذا لا يقتضي عنده أن نعتبر كلّ ما ينبني عليه فرع هو من جملة أصول الفقه وإلاّ جعلنا النّحو، واللّغة، والاشتقاق، والتّصريف، والمعاني، والبيان، وغير ذلك من العلوم من مسائله، وإنّما المراد أنّ كلّ أصل يضاف إلى الفقه لا يولّد فقها، فليس بأصل له.
والثّاني: ما ينبني عليه فقه، ولكنّه ليس من مسائل الأصول مثل فصول كثيرة من النّحو، ومعاني الحروف، وتقاسيم الاسم، والفعل، والحرف، والكلام على الحقيقة، والمجاز، والمشترك، والمترادف والمشتقّ[19]، والثّالث: الاستدلال لصحّة مذهب أو إبطال آخر فيما ينبني عليه فقـه ولا يؤدّي الاختلاف فيه إلى اختلاف في الفروع. وقد مثّـل لهذا النّوع بالخلاف الجاري بين المعتزلة والأشاعرة في الواجب المخيّـر[20]، والمحرّم المخيّر[21]، فهم وإن اختلفوا في كون الواجب والتحريم راجعين إلى صفات الأفعال أو إلى خطاب الشّارع الحكيم، فإنّ كلّ فرقة موافقة للأخرى في العمل[22].
وقد كان الشّيخ ابن عاشور واعيا منذ عهد مبكّر من حياته العلميّة بالفوائد النّاشئة عن الاكتفاء بصرف العناية إلى المسائل الجوهريّة، والإعراض عن الاستطراد الشّاغل عن الغرض المقصود، فقد قال في مقدّمة حاشيته على شرح التّنقيح التـي فرغ منها سنة 1329ﻫ ما نصّه: “وأوّل ما صرفت إليه الهمّة في هاته الحاشية هو تحقيق مراد المصنّف، رحمه اللّه، ثمّ تحقيق الحقّ في تلك المسائل مع تمثيلها بالشّواهد الشّرعية، وتنـزيلها على ما ليس متداولا في الفروع الفقهيّة، لتكون في ذلك دربة على استخدام الأصول للفقيه. وقد أعرضت عن التّطويل بجلب الأقوال؛ لأنّ في ذلك ما يضيّع الزّمان، ويؤدّي إلى الملال، وعن الإكثار من المسائل والفوائد، والتّطوّح إلى المستطردات، فإنّ في هذا الكتاب وفاء بما يحتاج إليه من صميم علم الأصول بما ضمّت عليه جوانح العبارات، وأومأت إليه لواحظ الإشارات[23].”
وعليه، وجب أن نبقي من قواعد هذا العلم ما يخضع لأحد المعيارين التّاليين:
الأوّل: أن يكون التمرّس بها مؤهّلا للنّظر والاجتهاد، والثّاني: أن تهدي إلى أحكام ما يقتضيه التطوّر العلميّ من نوازل طبية، واجتماعية، ومالية في مختلف العصور دون أن يلحق النّاس عنت أو حرج، لذلك وجب إهمال ما لا يكوّن الاشتغال به ملكة فقهيّة راسخة، وطرح القواعد العقيمة التي لا تولّد ثمرة،ولا تنتج حكما.
ثانيا: ما يفتقر إلى التّقويم
معظم المسائل الأصوليّة التي تحتاج إلى المراجعة المتأنّية تتعلّق بقواعد التّفسير، والإجماع، والقياس، وسوف نكتفي في هذا المقام بضرب بعض الأمثلة من كلّ نوع لتجلية وجوه الضّعف فيه.
1. قواعد التفسير
ترجع هذه القواعد إلى بيان محامل ألفاظ الشارع في انفرادها، واجتماعها، وافتراقها وهي حريّة بأن تقرّب فهم المتضلّع فيها من أفهام العرب الخلّص الذين تذوّقوا أساليب الكتاب والسنّة، ووقفوا على دقائق معانيهما بمقتضى السّليقة، والجبلّة.
وهذا النّوع وإن كان يعرب عن شعور الأصوليّين بما يحكم نصوص الشّريعة من وحدة موضوعيّة تعرب عن تناسق منطقيّ مطرد بين معانيها، وعن إيقانهم بخلوّ أحكامها من التّناقض، فإنّهم لم يهتدوا إلى بيان السّمة الأولى بصورة جليّة لا تقبل النّقض، لذلك تفاوتت أعمالهم قوّة وضعفا بحسب مراعاة السّياقات المختلفة المقارنة لنـزول القرآن الكريم، ولملابسات ورود الحديث، وبمقدار الاهتداء إلى تمييز التّشريع العامّ الصّالح لأن يخاطب به جميع المكلّفين في كل عصر ومصر عن الخاصّ المنوط بحال أو ظرف معيّن مبني على مصلحة مؤقّتـة. ولئن حظيت هذه القواعد بالعناية الفائقة؛ إذ استبدّت بالقسط الأوفر من المدوّنة الأصولية[24]، وكشف فيها الأصوليّون عن دقائق، وأثروا فيها مباحث لم يتطرّق إليها أهل اللّغة نحو التّعارض الجاري بين الحقائق، أو بين الحقيقة والمجاز، وحمل اللّفظ المشترك على جميع معانيه المحتملة[25]، فإنّ كثيرا منها يحتاج إلى البحث و إعادة النّظر، وسوف نكتفي هنا بمبحث تخصيص السّنة للقرآن الرّاجع إلى البيان النّبوي. فممّا لا مرية فيه أنّ النّبي، صلّى الله عليه وسلّم، هو أوّل من تكفّل بتبيين معـاني القرآن قولا وفعلا. وقد حصر الأصوليون البيان النّبويّ في تخصيص العام، وتقييد المطلق، وتفصيل المجمل، وتوسّعوا في حمل المطلق على المقيّد ولو كان الإطلاق في الحكم التّقييد في جنسه[26]، وأمعن قوم في تخصيص العام وادّعوا طريانه على جميع العمومات إلاّ النّادر منها حتّى صار قولهم “ما من عام إلاّ وقد خصّص” جاريا مجرى الأمثـال[27]. وقد استشعر الإمامان ابن تيمية، والشّاطبي خطورة هذا القول الذي اشتهرت نسبته إلى ابن عبّاس، ورسّخه الجويني في البرهان، وعنه تناقله كثير من الأصوليين، فأخذت الألسن تلوكه دون تروّ في مضمونه، أو تبصّر بما يفضي إليه من نتائج، لذلك رمى الأوّل صاحب هذه الدّعوى بتردّد حاله بين الجهل وقصور العبارة؛ إذ دلّ الاستقراء على أنّ أكثر عمومات الكتاب محفوظة سالمة من المعارض[28]، وأنكر الثّاني التّخصيص بالمنفصل مطلقا[29]. ولا غرو في هذا الإنكار، فهو منسجم مع قوله باطّراد قطعيّة قواعد الأصول؛ إذ طرو احتمال التّخصيص موجب لإبطال هذه الدّعوى التي صدّر بها مقدّمة الموافقات[30]، وهو أيضا جار على وفق القاعدة التي قرّرها وأطنب في الاحتجاج لها، وهي كون الكلّيات هي الأصل في التّشريع القرآني؛ إذ الإفراط في القول بالتّخصيص يعود عليها بالنّقض والإبطال، إذ جعل أصحاب هذه الدّعوى التّخصيص هو الأصل الغالب حتى نقل ابن تيمية عن بعضهم أنّ العموم المجرّد الذي لم يظهر له مخصّص مدرك ضعيف[31]. ولعلّ الإفراط في تلك الدّعوى هو الذي حمل صاحب الموافقات على إبطال التّخصيص بالمنفصل مطلقا، فقابل غلوّ ذويها بمثله وإلاّ فإنّ احتمال بعض الكلّيات للتّخصيص، لا يعود على هذا الأصل الذي قرّره بالنّقض.
والظاهر أنّ ذلك الإسراف ناشىء عن عدم تمييز ذويه للمحالّ القابلة للتّخصيص عن غيرها، فهم أطلقوا تلك القاعدة دون مراعاة للفرق بين الثّابت والمتغيّر في الشريعة، فالأوّل يتناول أمرين رئيسين: أحدهما: العبادات وهي خاضعة لقاعدة تفصيل المجمل الذي لا يتصوّر التّبيين فيه إلا من جهة النّبي -صلى الله عليه وسلّم-؛ إذ الأصل فيها التّوقيف، والثّاني: التّشريع الأسريّ المبني على الجبلّة الثّابتة نحو الأمومة، والأبوّة، والبنوّة. وتخصيص السّنة لعموم القرآن في هذا النّوع ممكن نحو تخصيص قوله عليه السّلام: “لا يتوارث أهل ملّتين[32]“، وقوله: “إنّا معشر الأنبياء لا نورث[33]“، وقوله: “لا يرث القاتل[34]” لعموم قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ (النساء: 11)، ونحو تخصيص قوله -صلّى الله عليه وسلّم-: “لا يجمع بين المرأة وعمّتها، ولا بين المرأة وخالتها[35]” لعموم قوله تعالى: ﴿وأحلّ لكم ما وراء ذلكم﴾ (النساء: 24).
وأمّا المتغيّر وهو المعاملات المبنيّة على المصالح الإضافيّة؛ أي التي تختلف بحسب الأشخاص والأحوال، والزّمان، والمكان، فالقول بأنّ السّنة النبويّة مخصّصة لعموم القرآن فيه موجب لنتيجتين خطيرتين: الأولى: أن يكون الواقع في عصر التّنـزيل هو الذي يوجّه المفسّر ويعيّن له المعنى المقصود من العموم في الآية، فالقول بأنّ بيوع الغرر المنهيّ عنها في السنة مخصّص لعموم قوله تعالى: ﴿وأحلّ الله البيع﴾ (البقرة: 274) قاض بأنّ صور تلك المعاوضات الماليّة الجارية في عصر النّبي -صلى الله عليه وسلم- هي التي بيّنت المراد بالبيع الوارد في الآية، وهذا يسلب عن النّص قداسته النّاشئة عن كونه مطلقا لا يحكمه زمان أو مكان معيّن، والنتيجة الثّانية أن يكون التّشريع القرآنيّ مراعيا لخصوص أحوال العرب، لنوطه بالمعاملات التي كانت جارية بينهم زمن النّبوّة وهذا مناف لما تميّز به من العموم والدّوام. والظّاهر أنّ تبيين الرّسول صلّى الله عليه وسلّم لهذا النّوع هو من جنس تحقيق المناط؛ إذ ما أفتى فيه من الحوادث، أو قضى فيه من النّوازل، إنّما هو من الجزئيّات الخارجيّة التي تكفّل بتنـزيل قواعد القرآن العامّة عليها. ولا شكّ في أنّ هذا الضّرب الذي غفل عنه الأصوليّون هو من أعظم طرق البيان النبويّ، لكونه نبراسا مضيئا يهتدي به الفقيه في فهم الكلّيات القرآنيّة، وفي كيفيّة إدراج وقائع عصره فيها، فبيوع الحصاة والمضامين، والملاقيح، والمنابذة، والملامسة، وحبل الحبلة، والمزابنة[36]، وكراء الأرض بما ينبت على الأربعاء أو بشيء يستثنيه صاحب الأرض[37]، وغيرها من المعاملات المشتملة على الغرر، والجهالة، والمخاطرة إنّما هي من جنس أكل أموال الناس بالباطل الذي ورد النّهي عنه في قوله تعالى: ﴿ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ (البقرة: 187). فتلك المعاوضات الماليـّة الجارية في بيئة الرّسول -صلّى الله عليه وسلّم- جزئيّات لهذه الكلية القرآنية الصّالحة للانطباق على مختلف صور الغرر الحادثة بعد انقطاع الوحي؛ إذ يصبح تحقيق مناطها في النّوازل الطّارئة موكولا إلى ذوي الملكات الفقهية الرّاسخة[38]. والظّاهر أنّ القول بتخصيص السّنة لعموم الكتاب في تلك الصّور الجزئيّة من المعاملات الجارية في عهد النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- كان من الموجبات التي جرّأت بعض الباحثين المعاصرين على اعتبار الواقع أصلا للتّشريع القرآني، وسببا منشئا لمادّته، وعلى التذرّع بذلك إلى الحكم على الوحي بكونه ظاهرة تاريخية ومن ثمّ، فلا يصلح العمل بأحكامه لتغيّر ظروف التّنـزيل[39].
2. الإجماع
يحتلّ هذا المدرك في الفكر الأصولي مكانة رفيعة؛ إذ ظلّ طوال قرون الأصل المهيمن الذي يحتجّ به في إثبات دعوى، ودحض أخرى، والمعيار الذي توزن به سائر الأدلّة، فقالوا بتقديمه على النّصوص الظّنية حال التّعـارض[40]، بل بكونه حكما على الكتاب والسّنة المتواترة عند طائفة[41]، وناسخا للأصلين عند أخرى[42]، وقضوا بتكفير جاحده دون تمييز للمرتبة الموجبة لذلك عن غيرها، ولكن من أنعم النّظر في هذا الباب انتابته حيرة شديدة؛ إذ كيف اكتسب الإجماع هذه القوّة في الاستدلال، وقد فرضوا فيه مسائل نظريّة يتعذّر وقوعها في العادة، وبالغوا في أخرى إلى حدّ الإغراب[43]، وتفرّقوا في جلّ مباحثه طرائق قددا، فاختلفوا في حقيقته، وفي حجّيته، وفي سنده، وفي إمكان انعقاده في سائر العصور، وفي اعتبار قول المخالف، وفي غير ذلك، لهذا وجب أن يتعاهد الدّارسون مباحثه بمراجعة جذريّة تعتمد السبر، والتّمحيص، والتصحيح، يقول الشّيخ ابن عاشور: “لقد يقع نظر المطلع على أصول الفقه، ويقرع سمعه في دروسه من مسائل الإجماع ما يتجرّعه إن كان قنوعا بالظّواهر، ولوعا بتعداد المسائل، وعقد الخناصر وإن لم يجد بينها ذمما ولا أواصر، ولكنّه إن كان لا يحتمل أن يتقبّل شيئا جزافا، ولا يسع من المجملات تجهيلا ولا اختلافا، يكاد بعد إعمال نظره، وخصفه على هذا الباب من ورق شجره، يمتلكه اليأس من تحرير باب الإجماع، وينقطع دون ذلك ماله من الأطمـاع[44].” ولمّا كان المقام لا يسمح بالخوض في تفصيل أحكامه الموجبة للإشكال، المثيرة للحيرة لتشعّب الأقوال، ووجوه الاعتراض الواردة عليها، اكتفيت بالتّنبيه على المسائل التّالية:
أ. تعريف الإجماع: تولّد من اختلاف الأصوليّين في تصوّر حقيقة هذا المدرك اختلافهم في تعريفه، ويظهر بادي النّظر أنّ من اعتبر فيه وفاق العوام وخلافهم عرّفه بكونه اتّفاق أمّة محمّد على أمر من الأمور الدّينيّة[45]، ومن قصره على أهل العلم الذين بلغوا رتبة الاجتهاد عبّر عنه بأنّه اتّفاق أهل الحلّ والعقد من هذه الأمّة على حكم شرعيّ[46]، والتّحقيق أنّ التّعريفين لا يردان على محلّ واحد، فمن تتبّع موارد استعمال هذا المصطلح في المدوّنة الأصوليّة تبيّن له أنّ أهل العلم يطلقونه على ثلاثة أمور: الأوّل: أن يتّفق المسلمون جيلا بعد جيل على نسبة قول أو فعل أو هيئة إلى النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- وهذا هو الذي يرجع إلى التّعريف الأوّل. والثّاني: أن تطبق كلمة مجتهدي عصر من العصور على حكم لدليل عيّنوه واتّفقوا على العمل بمقتضاه وهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد، وداود الظاهري واعتبره الآمدي والإمام وغيرهما حجّة ظنّية، والثّالث: أن يسكت أهل العلم في عصر معيّن على قول أو فعل صدر من مجتهد وهو المعروف عندهم بالإجماع السّكوتي وقد أنكر المحقّقون الاحتجاج به إلاّ إذا مرّت عليه أزمنة كافية، فيكون عندئذ حجّة واهية[47].
ب مراتب الإجماع: ذكر ابن عاشور في التّوضيح والتّصحيح أنّ الذي انتهى إليه استقراؤه لكلام المحقّقين أنّ هذا المدرك على سبع مراتب تتفاوت قوّة وضعفا:
الأولى: إجماع الصّحابة على مشاهدة قول أو فعل أو صفة من النّبي -صلّى اللّه عليه وسلّم- وقد عبّروا عنه بالمعلوم من الدّين ضرورة، وبالإجماع العام، وبالمتواتر من الدّين وهو من أحوال إثبات الشّريعة؛ إذ به بيّنت المجملات، وأوّلت الظّواهر، وأسّست القواعد، لذلك أطبقت كلمة الأصوليين على حجيته، ووجوب العمل بمقتضاه، ورجّحوه على بقيّة المدارك، وقضوا بتكفير جاحده ومثّلوا له بصفة الصّلاة وأوقاتها وكيفيّة الحجّ، ونقل ألفاظ القرآن وسوره، وبختم رسالة محمّد -صلّى الله عليه وسلم- ونبوّته[48].
الثانية: إجماع مجتهدي الصّحابة على مقتضى النّص حتّى يتنـزل منـزلة القطع عندهم، ولكنّه لم يبلغ مبلغ المعلوم ضرورة لسبب الخلاف والتّوقف فيه، ومثّل له بإجماعهم على تحريم المتعة والحمر الأهليّة، فقد كان ابن عبّاس يرى إباحتهما[49]. وهذه المرتبة دون الأولى قوّة؛ لأنّ الإجماع فيها حجّة قطعيّة نظريّة، لذلك قالوا بتأثيم جاحده دون تكفيره[50].
الثالثة: إجماعهم على فهم مراد من نصّ؛ لأنّهم أعلم المسلمين بمقصد الشّريعة من خطابها، وقد مثل لذلك بإجماعهم على أنّ قوله تعالى: ﴿فلا جناح عليه أن يطوّف بهما﴾ (البقرة: 158) يدلّ على وجوب السّعي بين الصّفا والمروة، وهو خلاف ما يقتضيه ظاهر الآية، فإنّ نفي الجناح في فعل معيّن ظاهر في الإباحة بمعنى استواء الفعل وتركه دون النّدب والوجوب، لذلك رأى عروة بن الزّبير أنّ السّعي غير واجب، وما فهمه وإن كان جاريا على وفق العرف في استعمال الكلام، فإنّه غير مراد؛ لأنّ المعنى الموجب للتّعبير بنفي الإثم عن السّاعي هو ظنّ كثير من المسلمين أنّ في ذلك إثما، فالدّاعي إلى هذا النّفي هو مقابلة الظنّ بما يدلّ على نقيضه مع العلم بانتفاء احتمال قصد الإباحة؛ إذ أفـادت مجموع الظواهر من القول والفعل على الوجوب[51]. وهذه المرتبة دون السّابقة قوّة، لكونها جارية في الأمور الاجتهاديّة.
والظّاهر أنّ الاختلاف في المرتبتين الثّانية والثّالثة يجري فيما يتعذّر إثباته بالدّليل، فهو وإن كان ممكنا، فإنّه لم يتحقّق في واقع الأمر، فقد كان الاتّفاق في عصر الصّحابة مقصورا على من حضر من الفقهاء[52]، ولم يكن العمل بالحكم الذي انتهى إليه اجتهادهم، وأطبقت عليه كلمتهم متوقّفا على استشارة الغائب منهم[53] وإذا كان الإجماع بالمعنى المذكور لم يتحقّق في عصر الصّحابة، فمن باب أولى ألاّ يحصل في سائر العصور، لاختلاف الدّيار، وتباعد الأمصار[54].
الرابعة: اتّفاق مجتهدي عصر من عصور الإسلام على حكم لدليل من الكتاب والسنّة. وهذا هو الذي جرى فيه الاختلاف الشّهير بين العلماء، فالجمهور على أنّه حجّة تجب متابعتها خلافا للإمام أحمد ابن حنبل، وداود الظاهريّ، فقد أنكرا إمكانـه. وهذا النّوع لا يلزم جاحده شيء، لكونه حجّة ظنّية[55].
الخامسة: الإجماع عن قياس أو استدلال أو عن فهم في نصّ محتمل مع التّصريح بالاتّفاق على الحكم، وقد جعله القاضي عبد الجبّار مثل قول واحد من المجتهدين وجوّز لمن بعدهم مخالفتهم، وهذا هو الذي يمكن تغييره نظرا إلى اختلاف المصلحة وكأنّه مراد من جوّز انعقاد إجماع بعد إجماع، وجعل الأوّل مشروطا بألاّ يطرأ عليه إجماع آخر وقد ردّه القرافي في باب النّسخ[56]. وقد يكون الإجماع ضعيفا، لبنائه على سند واه نحو القياس مع وجود الفارق، وقد مثّل له بإجماع الفقهاء على تنصيف عدّة الوفاة في الأمة المتوفّى زوجها، وقد اعتبر ابن عاشور ذلك من معضلات المسائل الفقهيّة؛ لأنّ الحكمة من تشريع هذه العدّة هي تحقّق الحمل أو عدمه، وهذا لا فرق فيه بين الحرّة والأمة، فإنّ وصف الرّق هنا طرديّ لا يصلح أن يكون مؤثّرا في هذا الحكم، والوصف المناسب لتعليل الاعتداد هو الإنسانيّة، وهو مشترك بين جميع النّساء بصرف النّظر عن كونهنّ حرائر أو إماء[57].
السّادسة: أن يحصل اتّفاق العلماء على حكم معيّن دون أن يصرّحوا بقولهم أجمعنا ونحوه، بل نتتبّع أقوالهم، فلا نجد بينهم خلافا، وقد سمّى ابن تيمية هذا النّوع الإجماع الاستقرائي وهو عنده ظنّي لا تدفع به النّصوص القطعيّة[58].
السّابعة: سكوت العلماء في عصر على قول أو فعل صدر من مجتهد وهو المعبّر عنه بالإجماع السّكوتي وفي أصل الاحتجاج به خلاف شديد. وقد ضعّف إمام الحرمين هذه المرتبة في البرهان، وأنكر حجّيتها ثمّ تنازل لقبولها إذا طالت السّنون وكان الأمر ممّا شأنه أن يبلّغ وأمّا المحقّقون من الأصوليّين، فقد أنكروا حجّيته[59]. وقد مثل له بسكوت الصّحابة عمّا قضى به عمر في الطلاق بلفظ الثلاث في كلمة واحدة؛ إذ لم يثبت أنّ أحدا منهم قد أنكر عليه ذلك، وقد نفى ابن عاشور أن يكون سكوتهم عاضدا لما ذهب إليه الخليفة؛ لأنه لا يصلح للاحتجاج به يقول في هذا المقام: “وما أيّدوه به من سكوت الصحابة لا دليل فيه؛ لأن الإجماع السّكوتي ليس بحجة عند النّحارير من الأئمة مثل الشافعي، والباقلاني، والغزالي، والإمام الرازي، وخاصة أنه صدر من عمر بن الخطاب مصدر القضاء والزجر، فهو قضاء في مجال الاجتهاد لا يجب على أحد تغييره، ولكنّ القضاء جزئي لا يلزم اطراد العمل به، وتصرف الإمام بتحجير المباح لمصلحة مجال للنّظر، فهذا ليس من الإجماع الذي لا تجوز مخالفته[60].”
والظاهر أنّ إطلاق الإجماع على هذا الضّرب من باب التّسامح في العبارة؛ لأنّ هذا المدرك في جوهره وليد التّباحث العلميّ الذي ينتهي إلى الوفاق، ولمّا خلا السّكوت عن هذا المعنى، امتنع أن يكون دليلا على الموافقة[61]، والمرتبة السّادسة في حكم هذه، للتّقارب بينهما في المعنى.
ج. حجّية الإجماع: جرت عادة الأصولييّن أن يوردوا الآيات والأحاديث التي يمكن أن تستروح منها حجّية الإجماع، لكنّ المحقّقين منهم يرون أنّها لا تدلّ على الغرض المطلوب، فمن أشهر ما استدلّوا به قوله تعالى: ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتّبع غير سبيل المومنين نوله ما تولّى ونصله جهنّم، وساءت مصيرا﴾ (النساء: 114)، وقوله تعالى: ﴿وكذلك جعلناكم أمّة وسطا﴾ (البقرة: 142)، وقوله تعالى: ﴿كنتم خير أمّة أخرجت للنّاس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتومنون بالله﴾ (ال عمران: 110). فوجه الدّلالة في الآية الأولى أنّ الجمع بين مشاقّة الرّسول -صلّى الله عليه وسلّم- واتّباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد يقتضي أن يكون الثّاني محرّما؛ إذ لو لم يكن حراما لما ضمّ إلى المشاقّة في الوعيد، فإنّه لا يحسن الجمع بين حلال وحرام في عقاب، وإذا حرم اتّباع غير سبيل المؤمنين وجب اتّبـاع سبيلهم لعدم الواسطة بينهما[62]. وقد ضعّف الجويني، والغزالي الاستدلال بهذه الآية على حجّية الإجماع، يقول الأوّل: “إنّ الرّب تعالى أراد بذلك من أراد الكفر، وتكذيب المصطفى -صلّى الله عليه وسلّم- والحيد عن سنن الحقّ. وترتيب المعنى ومن يشاقق الرّسول، ويتّبع غير سبيل المؤمنين المقتدين به، نولّه ما تولّى، فإن سلّم ذلك، فذلك، وإلاّ فهو وجه في التّأويل لائح، ومسلك في الإمكان واضح، فلا يبقى للمتمسّك بالآية إلاّ ظاهر معرّض للتّأويل، ولا يسوغ التّمسّك بالمحتملات في مطالب القطع[63]“، ويقول الثّاني: “والذي نراه أنّ الآية ليست نصّا في الغرض، بل الظاهر أنّ المراد بها أنّ من يقاتل الرّسول ويشاقه ويتّبع غير سبيل المؤمنين في مشايعته ونصرته ودفع الأعداء عنه نولّه ما تولّى، فكأنّه لم يكتف بترك المشاقّة حتى تنضم إليه متابعة سبيل المؤمنين في نصرته والذّب عنه والانقياد له فيما يأمر وينهى، وهذا هو الظاهر السّابق إلى الفهم[64].”
وقد اعتمدوا في الاستدلال بالآية الثّانية طرقا منها ما نقله الفخر الرّازي عن الجمهور ومفاده أنّ إقدام الأمّة على شيء من المحظورات موجب لسلب العدالة والخيرية عنها[65]، ويبطل هذا أن الخطأ لا ينافي الوصفين، فلا تنهض أن تكون الآية دليلا على عصمتهم من الخطأ فيما أجمعوا عليه وأجيب عن هذا الاعتراض بأن العدالة الكاملة تستلزم أن يكون الجميع معصومين من الوقوع في الخطأ في المعتقدات والأقوال والأفعال[66]، والثاني للقاضي البيضاوي وحاصله أنّه لو وجد فيما اتفقت عليه الأمّة باطل لكان ذلك موجبا لانثلام عدالتهم[67]، وهذا لا يناسب الثناء عليهم بما في الآية، وهذا يرجع عند التّحقيق إلى الطريق الأول والثالث قال أهله الخطاب في الآية للصحابة، وهم لا يجمعون على خطأ، فالآية دالّة على حجية الإجماع في الجملة، واعترض ابن عاشور على هذا الطّريق بأنّ الخطأ فيما سبيله النّظر والاجتهاد لا يقدح في عدالة الصحابة. وقد رجّح أن الآية دالة على حجية الإجماع العام فيما طريقه النقل للشريعة، وهو الذي عبر عنه في المرتبة الأولى بالتواتر، وبالمعلوم من الدين بالضرورة، ولا تصلح لأن تكون مفيدة لحجية الإجماع المبنيّ على الاجتهاد؛ لأنّ الآية صريحة في كون الوصف الوارد فيها مدحا لجميع المسلمين لا لخصوص علمائها[68].
ووجه الاستدلال في الآية الثّالثة أنّ الأمة إذا أجمعت على حكم لم يجز أن يكون ما أجمعوا عليه منكرا، وتعين أن يكون معروفا؛ لأنّ الطائفة المأمورة بالأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر في ضمنهم، ولا يجوز سكوتها عن منكر يقع، ولا عن معروف يترك[69]. وقد ذكر ابن عاشور أنّ هذا الاستدلال إنّما يصحّ لإثبات حجية النّوع الأوّل المعبّر عنه بالمعلوم من الدين بالضرورة؛ لأنّ المعروف والمنكر في هذا النوع ضروري، ولكن لا ينهض أن نثبت به حجّية الإجماع المنعقد عن اجتهاد، وهو الذي يريده المستدلون بالآية، فاستدلالهم بها عليه من السّفسطة؛ لأنّ المنكر لا يعدّ منكرا إلاّ بعد إثبات حكمه شرعا، وطريق إثبات حكمه الإجماع، فلو أجمعوا على منكر عند الله خطأ منهم لما كان منكرا حتى ينهي عنه طائفة منهم لأن اجتهادهم هو غاية وسعهم[70].
هذا وقد تمسّكوا في إثبات دعواهم بأحاديث لا يخلو معظمها من مقال، فمن ذلك ما ورد في كتاب الفتن والملاحم من سنن أبي داود “إنّ الله أجاركم من ثلاث خلال: ألاّ يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا، وألاّ يظهر أهل الباطل على أهل الحقّ، وأن لا تجتمعوا على ضلالة[71]“، وما ورد في سنن التّرمذي في الفتن “إنّ الله لا يجمع أمّتي على ضلالة[72]“، فالأوّل: فيه محمّد بن إسماعيل بن عياش الحمصي عن أبيه، قال أبو حاتم الرّازي “لم يسمع عن أبيه شيئا، حملوه على أن يحدّث عنه فحدّث. هذا آخر كلامه، وأبوه إسماعيل بن عياش قد تكلّم فيه غير واحد[73]“، والثّاني: في إسناده سليمان بن سفيان، وقد ضعّفه الأكثرون[74] وهذا الحديث وإن أورد له الحاكم شواهد، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، فإنّه لا يصلح للدّلالة على الغرض[75]؛ لأنّ الخطأ في الإجماع لا يعدّ ضلالة على أنّ العصمة لا تثبت إلاّ فيما يتّفق عليه جميع الأمّة؛ لأنّ طريقه النّقل المتواتر، وهذا إنّما يتصوّر في المعلوم من الدّين ضرورة لا فيما كان طريقه النّظر والاجتهاد[76].
د. دعوى أنّ كلّ إجماع مبنيّ على نص: ذكر الإمام ابن تيمية أنّ كلّ ما أجمع عليه الصّحابة قد بيّنه الرّسول -صلّى الله عليه وسلّم- إذ لا توجد مسألة أجمع عليها المسلمون إلاّ وفيها بيان من السّنة، وقد ناط ادّعاء خلوّ المجمع عليه من النّص بخفاء المدرك الذي استند إليه المجمعون[77]، وقد ذكر ابن عاشور في كتاب المقاصد ما يفنّد هذه الدّعوى، فقد بيّن أنّ استقراء الموارد التي جرى فيها اتّفاق السّلف على حكم معيّن في غير المعلوم ضرورة، يفيد أنّ جلّها يرتدّ إلى مراعاة المصلحة المرسلة العامّة أو الغالبة، ويندر أن تستند إلى نصّ، لذلك اعتبر العلماء الإجماع مدركا قائما برأسه، يقول في هذا المقام ما نصّه: “ونحن إذا افتقدنا إجماع سلف الأمّة من عصر الصّحابة فمن تبعهم، نجدهم ما اعتمدوا في أكثر إجماعهم فيما عدا المعلوم من الدّين بالضرورة إلاّ الاستناد إلى المصالح المرسلة العامّة، أو الغالبة بحسب اجتهادهم الذي صيّر تواطؤهم عليه أدلّة ظنّية قريبة من القطع، وإنّهم قلّما كان مستندهم في إجماعهم دليلا من كتاب أو سنّة، ولأجل ذلك عدّ الإجماع دليلا ثالثا، لأنّه لا يدرى مستنده، ولو انحصر مستنده في دليل الكتاب والسنّة، لكان ملحقا بالكتاب والسنّة، ولم يكن قسيما لهما[78].”
3. القياس الأصولي
يعدّ هذا المدرك من أعظم الأصول المستقرّة في الفطرة؛ إذ التّسوية بين النّظيرين والتّفرقة بين المختلفين ممّا قضت به العقول الرّاجحة السّالمة من المؤثّرات الفاسدة[79]، لذلك قال الجمهور بحجّيته، واستندوا إليه في التّفريع، وأنكروا على الظّاهريّة إبطال الاستدلال به. ولم يكن المثبتون في العمل بهذا المدرك على درجة واحدة، فقد تفاوتوا في مقدار استخدامه سعة وضيقا تبعا لاختلافهم في شروط كلّ ركن، وفي طرق إثبات العلل وقد أسرفت طائفة منهم لمّا لجأت إليه قبل بذل غاية الجهد في البحث عن النّصوص، فأبطلت به جملة من الأحاديث النّبويّة الشّريفة[80]. ولا يخفى على ذي بصيرة أنّ استخدام القياس بالمعنى المعهود عند جمهور الأصوليّين لا يخلو من مزالق، لكثرة ما يتطرّق إليه من احتمال يوجب ضعفه؛ إذ هو مبنيّ على مقدّمات يشترك فيها مع النّص، وأخرى يختصّ بها[81]، فقد صدر الإمام الغزالي باب طرق إثبات العلة بالتنبيه على مثارات الاحتمال الواردة على القياس، وقد أنهاها إلى ستة: الأول: جواز أن يكون الأصل تعبديا، فيكون المجتهد قد علل ما ليس بمعلل، والثاني: عدم الاهتداء إلى عين العلة على تقدير أن الأصل معلل، فيكون القائس قد ناط الحكم بمعنى غير معتبر عند الشارع، والثالث: الاقتصار على وصف في التعليل مع أن الحكم منوط بقرينة أخرى زائدة على قصر اعتباره عليه، الرّابع: أن يجمع القايس إلى العلة وصفا طرديّا لا يصلح لأن يكون مناطا للحكم، والخامس: أن يصيب في أصل العلة وفي عينها وضبطها لكن يخطئ في وجود هذا الفرع، فيخالها موجودة بجميع قيودها وقرائنها والواقع خلاف ذلك، والسادس: أن يصحح العلة بما لا يصلح أن يكون دليلا، وهنا لايجوز له القياس وإن اهتدى إلى عين العلة؛ لأنه بمنـزلة من أصابها بمجرد الوهم والحدس من غير دليل[82]، وقد أجملها ابن عاشور في قوله: “جزئيـات المصالح قد يطرق الاحتمال إلى أدلّة أصول أقيستها، وإلى تعيين الأوصاف التي جعلت مشابهتها فيها بسبب الإلحاق والقياس، وهي الأوصاف المسمّاة بالعلل، وإلى صحّة المشابهة فيها[83].” وعليه، فالمواضع التي يعرض لها الاحتمال في القياس ثلاثة:
أ. دليل الأصل: يعرض له التّخصيص، والتّقييد، والمجاز، والمبالغة، واحتمال كذب النّاقل في الخبر، ويحتمل أن يكون لغير التّشريع، لذا وجب تحرّي المقام الذي ورد فيه، فقد يغلط الفقيه في بعض تصرّفات الرّسول -صلى الله عليه وسلّم- فيعمد إلى القياس عليها دون التّثبت في موجب صدورها[84]. فليست جميع جزئيّات الشّريعة متساوية؛ إذ منها ما يصلح لأن يكون أصلا يقاس عليه نظيره، ومنها ما لا يصلح لذلك، فما بني على خصوص عادة العرب وأحوالهم، أوكان من الأقضية التي روعي فيها مصلحة خاصّة، لا يصحّ أن يحمل المسلمون على اتّباعه في جميع العصور[85].
ب. تعيين العلل: تحظى العلّة في الفكر الأصولي بمنـزلة عظيمة؛ إذ بفضلها يهتدى إلى النظير، ويجري القياس، ويتّسع مجال الحكم[86]. لذلك صرفت الهمم إلى العناية بضبط شروطها، وطرق إثباتها، ولكنّ ذلك لم يمنع من الوقوع في وجوه من الزّلل، فقد يكون المعنى المؤثّر في الحكم غير ما ادّعى القايس عليّته، فربمّا كانت العلّة مركّبة من وصفين فاقتصر على اعتبار أحدهما، أو فرّط في تنقيح المناط[87] فجمع إليه معنى أو وصفا طرديا. وقد يخطئ الفقيه فيعتبر خصوص المحلّ مؤثرا في الحكم مع كونه من الواقع الموضوعي[88]. وقد مثّل ابن عاشور لذلك بما وقع لبعض الفقهاء من القول في آية القتل العمد الموجبة للقود، فقد أخذ بعضهم بما روي عن رسول اللّه -صلى الله عليه وسلّم-: “كلّ شيء خطأ إلاّ السّيف[89]“، فهذا الفقيه راعى الصّفة التي كانت الغالبة على آلات القتل في وقت تشريع القصاص وهي السّيف، ثمّ ألحق به كلّ آلة محدّدة، للاشتراك في وصف الأصل، والعجيب أنّه قال بعد ذلك بمنع حكم القود في القتل برمي صخرة صمّاء من علو على جالس تحته، وفي القتل بضرب الرّأس بدبوس. ومنشأ الزّلل في ذلك أنّه انتزع من الواقع الموضوعي وصفا جعله مناطا للحكم، ولو أنّه اعتبر المقصد الشّرعي الذي هو حفظ النّفس، لأثبت حكم القصاص في جميع تلك الصّور التي قال بمنعه فيها[90]. ومن ذلك الوصف الغالب على حقيقة الحرابة في زمن التّشريع وهو الكون في البرية، فقد اعتبره طائفة من الفقهاء مناطا للحكم، فمنعوا بذلك إقامة هذا الحدّ في المدن. وقد أفتى حذّاق الفقهاء باعتبار حكم الحرابة في المدينة إذا كان الجاني حاملا للسّلاح، ولم يعدّوا ذلك الوصف مؤثّرا[91]. ولا ريب في أنّ هذه الطّريقة التي جروا عليها في انتزاع العلل موجبة لتقريب ذويها من أهل الظّاهر في تضييق معاني التّشريع، وإلحاق الحرج بمن يأتون بعدهم.
ج. صحّة مشابهة الفرع الحادث بالأصل: يقتصر نظر المجتهد بعد استنباط العلّة بأحد الطّرق المعهودة على مجرّد التّحقق من وجودها في المحلّ المسكوت عنه[92]، فمن ذلك ما ذهب إليه المالكية من أنّ تعمّد الأكل والشّرب في نهار رمضان موجب للكفّارة مع أنّ النصّ اقتصر على صورة الجماع[93]، فقد قال الأعرابي للّرسول صلّى الله عليه وسلّم: “واقعت أهلي في رمضان يا رسول الله” فقال له عليه السلام: “اعتق رقبة[94]“، فقد حذف المالكية خصوص الوقاع عن التأثير[95]، وناطوا الحكم بالمعنى الأعمّ وهو انتهاك حرمة الشّهر. وبيان ذلك أنّ إيجاب الكفّارة لا يكون إلاّ لجناية، ولا جناية في ذات الجماع لكونه مباحا، وإنّما الجناية في إفساد الصوم، وانتهاك حرمة الشّهر المبارك، وهو معنى عام يندرج تحته إفساد الصّوم بالأكل، وإفساده بالشّرب[96].
ولا ريب في أنّ النّظر من أخطر ضروب الاجتهاد؛ لأنّه مزلّة أقدام، فقد يظنّ الفقيه وجود العلّة في الفرع المتنازع فيه مع خلوّه منها، لذلك وجب التّحقق من كون الجامع بين الأصل والفرع أولى من الفروق الجارية بينهما؛ إذ لا أثر لمطلق المشابهة في القياس، فالاحتجاج في منع الإيثار بالأعضاء بقياس جسم الإنسان على الأموال بجامع عدم الملكيّة واه؛ لأنّ الفوارق بين المقيس،والمقيس عليه أولى في الاعتبار، ومن هذا القبيل إلحاق المرابحة للآمر بالشراء ببيع العينة، أو ببيع ما لا يملك أو ببيع الكالئ بالكالئ في الحكم، لمجرّد المشابهة الصّورية، وقياس التأمين على الوعد الملزم مع أنّ الفرع من جنس المعاوضات، والأصل من جنس التبرّع.
وكان الشّأن أن يعمد المتأخّرون إلى سبر أقيسة أصحابهم للكشف عن مواضع الضّعف فيها، وأن يراجعوا الشروط الموضوعة للأركان، ويقوّموا طرق إثبات العلل، ولكنّهم قنعوا بما تقرّر في المذاهب، وانتصبوا لشرحها، والاستدلال لها وليتهم اكتفوا بذلك، فقد عمدوا إلى أقوال الأيمة فجعلوها أصولا يفرّعون عليها أحكام النّوازل، وسمّوا ذلك تخريجا[97].
وقد أفرط المفتون، والقضاة في الجري على هذا المسلك الذي حرم العقول من متعة النّظر في نصوص الشّريعة، لاستخراج العلل والمعاني الكامنة فيها، فضعفت الملكات، وفسد الذّوق الفقهيّ، وتضرّر العلم بسبب ذلك. ولا شكّ في أنّ التعويل على هذه الطّريقة في التّفريع من الخروج عن المنحى السّليم في النّظر، والحيدة عن منهج السّلف، فقد كان الفقيه في عصر الاجتهاد إذا نـزلت واقعة، وتحقّق من اشتمالها على المعنى، أو الوصف المعتبر في حكم المنصوص ألحقها به[98]، ولكن عندما قصرت الهمم، وأخلد ذووها إلى التقليد أحجموا عن قياس الحادثة على الكتاب والسنة، وأقبلوا على إلحاقها بالمسائل المستنبطة. والعجيب أنّ ابن رشد الجدّ قد استحسن هذه الطريقة، ودافع عنها في المقدمات وخطّأ قول المنكرين لها، وعلّل دعواه بأنّ القياس على المسائل لا يكون إلا بعد تعذر إجرائه في الأصول[99]، فإذا وقعت النازلة ولم توجد في موارد الكتاب والسنة، ولا في ما أجمعت عليه الأمة نصا، ولا وجد في شيء من ذلك نظير تعتبر بـه، ووجد ذلك في ما استنبط مما استنبط منها، وجب القياس على ذلك[100].
ثالثا: ما يصلح أن يكون خصبا منتجا للأحكام في مختلف العصور
لا شكّ في أنّ الكلّيات الخمس، والمصالح المرسلة، واعتبار المآل وما يرجع إليه نحو الاستحسان، وسدّ الذّرائع من أجلّ القواعد التي تحتوي عليها المدوّنة الأصوليّة، ولكن مع ذلك عظم فيها الاختلاف، ولم تنل حظا وافرا من العناية حتّى ظهر أبو إسحاق الشّاطبي في القرن الثّامن فبسط الكلام في تجلية منـزلتها في التّشريع، وفي أثرها في الاجتهاد، فبيّن أنهاّ من الأصول القطعيّة الثّابتة بطريق الاستقراء المعنوي، وأخذ يطنب في سوق النّصوص الجزئيّة التي بها يثبت صدق دعواه حتى يبيّن أنّ الأصوليّين قد اختلفوا فيما حقّه الاتّفاق[101]. وقد كان يرمي من وراء ذلك إلى رفع الاختلاف العميق بين المسلمين في زمن استفحل فيه التّعصب المذهبي، وساد الجهل بالمعاني الحقيقيّة للشّريعة ممّا قضى بانتشار الفرق الضّـالة، وانتشـار البدع بين النّاس[102]، وإلى تبيين أهميّة هذه الأصول في تدبير شؤون الأمّة بما يحفظ كيانها ويحقّق مصالحها الحيوية دون حرج أو مشقّة. والظاهر أنّ معاصريه لم يكونوا واعين بقيمة ما دعا إليه، ولا بأثره في الاجتهاد، وربّما شقّ عليهم هجر ما اعتادوه في النّظر، لذلك ظلّ عمله محجوبا عن الأنظار طوال قرون[103].
وقد عمد ابن عاشور إلى إحياء ما دعا إليه أبو إسحاق الشّاطبي من قبل وزهد فيه معاصروه، فأفاض في تبيين أنواع المصالح المرعيّة، والمفاسد الملغاة في الشّرع، حتى تحصل للفقيه ملكة يدرك بها مقصود الشارع، فينحو نحوه عند عروض المصالح، والمفاسد لأحوال الأمّة جلبا ودفعا[104]. فهو يرى أنّ النّظائر الكثيرة لأنواع ما روعي أو ألغي من المصالح خير قانون يهتدي به الفقيه في معرفة أحكام النوازل، فإنّ المصالح العارضة إن كانت من جنس الطرديّ أسقط اعتبارها، وإن كانت من جنس المعتبر في نصوص الشرع أثبت لها من الأحكام ما ثبت لكلياتها العاليـة دون تردّد[105].
وقد قضى العجب ممّن قال بحجيّة القياس، ثمّ تردّد في صحّة الاستناد إلى المصلحة المرسلة مع كونها أولى بالاعتبار منه، وأدخل في الاحتجاج الشرعي[106]، للوجوه التالية: الأوّل: تطرّق الاحتمال إلى دليل أصل القياس، وإلى تعيين العلة، وإلى صحّة مشابهة الفرع الحادث بالأصل، والوجه الثاني: أنّ أوصاف الحكمة قائمة بذواتها لا تفتقر إلى تشبيه فرع بأصل، والوجه الثالث: أنّ تلك الأوصاف وإن تفاوت وضوحها للنّاظر فيها، فإنّه لا يحتاج إلى استنباط، ولا إلى سلوك طريقه؛ لأنه يكتفى بإدخال المصلحة المحدثة تحت أجناس نظائرها[107]، والوجه الرابع: أنّه لا مطمع للفقيه عند طروّ الحوادث والنّوائب العارضة في وجود نظائر جزئية ليقيس عليها فضلا عن وجود نصّ مقنع يفيء إليه[108].
وعليه، فالاعتبار بالنّظائر الجزئيّة متعذّر في أكثر النّوازل الحادثة، وهو مظنّة الزّلل حال الإمكان، لكثرة تلك الاحتمالات[109]، لذلك لم يعتن ابن عاشور بالعلل والحكم الجزئيّة إلاّ من حيث كونها جزئيّات يستعان بها على انتزاع مقصد كليّ، بل صرف الهمّة إلى الأجناس القريبة والأجناس العالية من المعاني المعتبرة في أحكام الشّريعة؛ إذ المصالح أوسع طريق خليق بأن يسعف المجتهد بأحكام النّوازل[110]، فهي تدع للمفتي والقاضي مجالا فسيحا لتقدير الأحكام بحسب ما تقتضيه الظروف والأحوال، وتكفل للشّريعة مرونتها وصلاحها لكلّ العصور.
رابعا: ما كانت تفتقر إليه المدوّنة الأصوليّة
لئن شهد منهج الاجتهاد نقصا علميّا من لدن القرن الخامس، فإنّه لم يتولّد من مراعاته خلل اجتماعي، بل ظلّ طوال قرون يسعف الفقيه بأحكام مجارية لواقع النّاس، محقّقة لمصالحهم. وقد أرجع محمّد الفاضل ابن عاشور ذلك إلى أنّ أوضاع الحياتين الفرديّة والاجتماعية قد استمرّت منذ انقطاع الاجتهاد المطلق إلى ظهور الحركة الإصلاحيّة الحديثة متماثلة، أو متقاربة جدّا في عامّة مقوّماتهـا، يقول في هذا المقام “كانت التقادير والاعتبارات التي أخذ بها الفقيه في القرن الثّالث والقرن الرّابع باقية بعينها، لا يستطيع فقيه في القرن الثّامن أو التّاسع أن يأخذ إلا بها، وإذا كانت صور تقدير الحوادث النّازلة قد بقيت متشابهة، فإنّ الرّجوع بها إلى الدّليل لا يكون إلا من الطرق التي رجع إلى الدليل منها عند المتقدمين، فيكون تشابه الحوادث قاضيا بتشابـه الأدلة وتقارب مسالك الاستدلال، فبذلك لم يتهيأ تكوّن دافع يدفع بالفقيه إلى النظر في الأدلة ومسالك الاستدلال، فأصبحت أكثر الصور التي تعرض لحياة النّاس بعد استقرار المذاهب، وتمام التّفريع فيها سابقا حدوثها تقرير الحكم لها، إذا كدّ الفقيه ذهنه بوضع حكم لها، لم ينته به كدّه إلاّ إلى تحصيل الحاصل… ولذلك فإنّ تعطّل الاجتهاد المطلق، وتنازل الاجتهاد في المراتب لم يكن فيما قبل القرن الثّالث عشر إلاّ نقصا علميّـا، لكن لم يترتّب عليه خلل اجتمـاعيّ[111].”
ولكن لمّا شهدت تلك الأوضاع في القرن الثّالث عشر تغيّرا جذريّا أضحى ذلك المنهج الذي جرى عليه المتأخّرون قاصرا عن الوفاء بحاجة المسلمين؛ لأنّ صور المعاملات الجديدة الجارية بين النّاس باتت قليلة النظائر في المدوّنة الفقهيـة[112]، وأصبحت معظم قواعد الأصول قاصرة عن إسعاف الفقيه، لذلك اشتدّت حاجته إلى النّظر في المدارك ومراجعة قواعد الاستنباط، للبحث عن أقوم المناهج الهادية إلى أحكام ما اقتضاه التطوّر السّريع من صور المعاملات الجديدة التي يندر أن نلفي لها نظائر في نصوص الشّريعة.
كان ابن عاشور واعيا بهذا الخلل المنهجي وبالآثار النّاشئة عنه، لذلك رمى في كتاب مقاصد الشّريعة إلى”إغاثة المسلمين ببلالة تشريع مصالحهم الطارئة متى نـزلت الحوادث، واشتبكت النوازل[113]“، فاستنبط لذلك قواعد ضابطة لأنواع التّشريع في المعاملات حريّة بأن تكون نبراسا للفقيه يقيه من اللّجوء إلى المسالك الضيقة التي جرى عليه المتأخرون في التّفريع[114]، ونتدارك بها النّقص الذي كان يشكو منه فقه المعاملات، فقد كانت معظم جهود الأيمة مصروفة إلى التخريج على المسائل في العبادات مع كونها مبنيّة على حكم ومقاصد قارّة لا ينشأ عن اطّراد العمل بـها في جميع الأجيال حرج أو مشقّة فادحة إلاّ في أحوال نادرة تدخل تحت أحكام الرّخص، وظلّت المعاملات تفتقر إلى قواعد قريبة يستند إليها المفتون والقضاة في النوازل[115]. فقد ضمّن القسم الثّالث من الكتاب المذكور المقاصد الرّاجعة إلى أحكام الأسرة، والتّصرّفات الماليّة، وأحكام التبرّعات، والمعاملات المنعقدة على عمل الأبدان، وأحكام القضاء والشّهادة، والعقوبات[116]. ولا ريب في أنّ هذا النّوع من القواعد حريّ بوقاية الفقيـه من الزّلل النّاشئ عن بناء الأحكام على المعاني الشّرعية العالية، فإنّ تنـزيل القواعد الموغلة في العموم على الوقائع المشخّصة بظروفها وملابساتها، لا يحصّل الاطمئنان الذي يحقّقه تنـزيل القواعد الخـاصّة بنوع معيّن من التّشريع.
الخاتمة
لم يشهد علم المقاصد تطوّرا بعد ابن عاشور، بل عرف حيدة عن المنحى الإجرائيّ الذي كان يرمي إليه، فقد استمرّ التساؤل عما بتّ فيه الشيخ كاعتبار المقاصد مدركا شرعيّا، واطّرد الاشتغال بالتّخريج على المسائل المستنبطة، والاستناد إلى القياس الأصولي في أعمال المجامع الفقهيّة مع أنّ المقاصد أولى وأدخل في الاحتجاج الشّرعي منهما[117].
وأصبح يخوض في مسائل هذا العلم الدّقيق صنفان من الباحثين الأوّل من غير أهل التّخصّص الشّرعي، ومعظم هؤلاء قسوا على العلم بأحكام جائرة ناشئة عن الجهل بمضامينه، وخصائصه ومنهجه، فكان كلامهم فيه لا يشفي غليلا، ولا يبدي دليلا، وأمّا الصّنف الثاني فمن أهل التّخصّص، وقد اختلفت أعمالهم جودة ورداءة. فأقصى ما بلغوا إليه هو الكشف عن جهود المتقدّمين في تأسيس لبنات هذا العلم، وفي تفاوت عنايتهم بمراعاة المقاصد في أحكام النّوازل، أو الخوض في العلاقة بين علم الأصول وعلم المقاصد منهجا ومضمونا، أو تناول المقاصد عند علم من الأعلام، مع أنّ هذه العنديّة يتعذّر إثباتها في معظم الأحوال. وكثير من هؤلاء يفتقرون إلى تكوين أصولي متين يؤهّلهم للنّظر في العلم، ويمكّنهم من الاستيلاء على دقائقه، لذلك تاهوا في غضون مباحثه تيها أرداهم في وهاد الفوضى، فقصرت عباراتهم عن تبيين مراد المتقدّمين، وخاضوا فيما لا يصادف محلاّ، وأطنبوا في مواضع الإيجاز، وقدّموا ما حقّه التأخير، وصرفوا الهمّة فيما لا يخدم الغرض من هذا العلم، فهضموه حقّه، وشوّهوا حقائقه، وحادوا به عن الصّراط المستقيم.
الهوامش
1. لاشكّ في أنّ من طفق يتقصّى المعاني الجزئيّة للنّصوص دون إرجاعها إلى أصل جامع يؤلّف بينها طفحت عليه، وحسرت دون كثرتها قواه، ومن أخذ يتلقّى الفروع دون الاهتداء إلى وجوه التّماثل والاشتراك بينها، فرّق بين النّظيرين، وسوّى بين المختلفين أو أوشك.
2. هناك اتّجاه يروم ذووه تبديد علم الأصول، وهدم ما بناه السّابقون؛ لأنّ جميع قواعده عندهم لم تعد صالحة لبيان أحكام الحوادث المعاصرة، وهو تعليل واه مبنيّ على دعوى لا يشايعها دليل؛ إذ من نظر في محتويات هذا العلم بعين الإنصاف أقرّ بأنّ فيه ما يمكن أن يسعف الفقيه المعاصر بأحكام النّوازل. وهناك اتّجاه ثان يفرط أهله في التّنويه بالسّابقين، وفي الإشادة بما انتهت إليه جهودهم في هذا العلم، وينكرون أن يكون للمعاصرين حظ من المراجعة أو التّجديد فيه؛ لأن ما تركوه لنا هو أقصى ما تبلغ إليه قدر البشر. ولاشك في أنّ هذا مناف لسنّة التّطوّر المطّردة. وقد ذمّ ابن عاشور فريقي التّمجيد والإبادة في مجال التّفسير، لحيدة كلّ منهما عن مهيع الاعتدال، يقول في ذلك: “ولقد رأيت النّاس حول كلام الأقدمين أحد رجلين رجل معتكف فيما شاده الأقدمون، وآخر آخذ بمعوله في هدم ما مضت عليه القرون، وفي كلتا الحالتين ضرّ كبير، وهناك حالة أخرى ينجبر بها الجناح الكسير، وهي أن نعمد إلى ما أشاده الأقدمون فنهذّبه ونـزيده، وحاشا أن ننقضه أو نبيده، عالما بأنّ غمض فضلهم كفران النّعمة، وجحد مزايا سلفها ليس من حميد خصال الأمّة”، التّحرير والتّنوير، 1/7.
3. لعلّ أوّل من جرى على هذا المهيع، فتصدّى لإقامة الحجج على صحّة قواعد المذهب الذي ينتسب إليه، ولدحض ما تقرّر عند المخالف في جميع المسائل هو الإمام الجويني، يقول الشّيخ محمّد الفاضل ابن عاشور متحدّثا عن طريقته في البرهان: “سلك فيه مسلك الباقلاني في تقرير النّظريّات، وتقعيد القواعد، وبيان المعاني والمآخذ إلاّ أنّه زاد على الباقلاني إفاضة مطّردة في الاستدلال، وإقامة الحجّة على صواب النّظر الذي يميل هو إليه وهو الذي أصّله الإمـام الشّافعي في رسالـة الأصول، فأطنب في إقامة البراهين على حجّية ما يرى الشّافعيّة حجّيته، وعلى عدم حجّية مـا لا يرى الشّافعيّة حجّيته”، محاضرات، ص350.
4. يقول ابن عاشور في هذا المقام: “فكنت تجد العالم يريد أن يكون فقيها أصوليّا نحويّا أديبا شاعرا. وقد كان المثل لهم أبا حامد الغزالي، وبهذه الطّريقة اضمحلّت صفة الاختصاص العلمي والإمامة في علم معيّن… وكان أشدّ ظهور هذه المشاركة بالمشرق أمّا إفريقيّة والأندلس، فلم يزل أكثر علمائها ينتحل الفقه ومختصّا به وأقبل طوائف منهم على العربيّة والأدب، فظهرت بينهم أعلام وأيمّة فيهما”، أليس الصبح بقريب، 40.
5. لاشكّ في أنّ الجمع بين التّحقيق والمشاركة قد أسهم بقسط وافر في الحيلولة دون تطوّر العلوم؛ لأنّ من توزّعت مواهبه على هذين الأمرين عسر عليه أن يكون ماهـرا في جميع ما صرف إليه الهمّة، واقتنع من كلّ علم بعلالة، م، ن، ص77-78.
6. جوّز طائفة من المتكلّمين أن توصف أفعال اللّه بكونها أغراضا وعللا غائيـة خلافا لأصحاب الأشعري، ووجه المنع عند هؤلاء أن نوط الفعل بالغرض موجب لأن يكون مستفيدا من غرضه ذلك، ويلزم من كون ذلك الغرض سببا في فعله أن يكون هو ناقصا في فاعليته محتاجا إلى حصول السبب. وقد ذكر ابن عاشور أن هذا الدليل مشتمل على مقدمتين سفسطائيتين: الأولى: أنه لو كان الفعل لغرض للزم أن يكون الفاعل مستكملا به وهذه سفسطة التبس فيها الغرض النافع للفاعل بالغرض بمعنى الداعي إلى الفعل، والراجع إلى ما يناسبه من الكمال لا توقف كماله عليه. والثانية: إذا كان الفعل لأجل الغرض كان الغرض سببا مقتضيا لعجز الفاعل، وهذه شبّه فيها السبب الذي هو بمعنى الباعث بالسبب الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. وقد تعجّب الشّيخ ممّا ذهبوا إليه؛ إذ أنهم يسلمون أن أفعال الله منوطة بالثمرة والحكمة، ثمّ يقضون بمنع أن تكون تلك الحكم عللا وأغراضا مع أن ثمرة فعل الفاعل المحيط علمه بكل شيء لا تخلو من أن تكون غرضا؛ لأنها تكون داعيا إلى الفعل ضرورة تحقّق علم الفاعل وإرادته، التّحرير والتّنوير، 1/380.
7. اختلف الأصوليّون في الواضع للغات والألفاظ على مذاهب، الأوّل: أنّ الله وضع اللّغة ووقفنا عليها، وهو ما قال به أبو الحسن الأشعري، واختاره الآمدي، وابن الحاجب. وممّا استدلّوا به على هذه الدّعوى قوله تعالى: ﴿وعلّم ءادم الاَسماء كلّها﴾، والتّحقيق أنّ هذه الآية لا تنهض أن تكون دليلا على أنّ اللّغة توقيفيّة، ولا على عدم ذلك، لكونها مجملة والمذهب الثّاني: أنّ اللّغات كلّها اصطلاحيّة أي أنّ الواضع لها هم البشر، وهو لأبي هاشم من المعتزلة، والثّالث: أنّ القدر الذي وقع به التّنبيه على الاصطلاح توقيفي؛ إذ لو كان اصطلاحيّا لافتقر في تعليمه إلى اصطلاح آخر وتسلسل، وأمّا الباقي فيكون اصطلاحيّا، الإسنوي، نهاية السّول، 2/23-28.
8. المحال خمسة أقسام: الأوّل: محال لذاته نحو الجمع بين الضدّين، والثّاني: عاديّ نحو طيران الإنسان، والثّالث: محال لطروّ مانع نحو تكليف الزّمن المقعد بالمشي، والرّابع: محال لعدم القدرة عليه وقت التّكليف به مع أنّه مقدور عليه حالة الامتثال كالتّكاليف كلّها؛ لأنّها غير مقدورة قبل الفعل على رأي الأشعري؛ إذ القدرة عنده لا تكون إلاّ عند الفعل، والخامس: محال لتعلّق علم اللّه بعدم حصوله كالإيمان من الكافر الذي علم اللّه أنّه لا يؤمن، فإنّ الإيمان منه مستحيل؛ إذ لو آمن لانقلب علم اللّه تعالى جهلا. والنـزاع إنّما يجري في الأقسام الثّلاثة الأولى على ثلاثة أقوال: أحدها: أنّ التّكليف بالمحال جائز عقلا وغير واقع سمعا وهو لجمهور الأشاعرة، والثاني: أنّه جائز عقلا، وواقع سمعا، وقد نسبه الإسنوي إلى الإمام الرّازي، والثّالث: أنّ التّكليف بالمحال ممتنع عقلا وبالضّرورة غير واقع شرعا وهو رأي المعتزلة ومختار الشّافعي وابن الحاجب، الإسنوي، نهاية السول، 1/345، الزّركشي، البحر المحيط، 1/386-387، زهير (محمّد أبو النّور): أصول الفقه، 1/177.
9. يرى الأشاعرة وجمهور أهل السنّة أنّ الحكم يتعلّق بالمعدوم، ومرادهم بذلك أنّ الشّخص في حال عدمه يوجّه إليه الخطاب بأنّه يفعل إذا وجد، وكان مستوفيا شروط التّكليف، وليس معنى تعلّق الحكم بالمعدوم أنّه في حال عدمه يكون مطالبا بالإتيان بالفعل أو بعدم الإتيان به، فإنّ ذلك غير معقول ولم يقل به أحد. وذهب المعتزلة إلى أنّ المعدوم لا يتعلّق به الحكم؛ إذ الحكم لا يتعلّق إلاّ بالموجود بعد استيفاء شروط التّكليف من البلوغ والعقل، وفهم الخطاب. واختلافهم في هذه المسألة راجع إلى اختلافهم في قدم الحكم وحدوثه، وهذه المسألة الخلافيّة مبنيّة على خلاف آخر بين القائلين بثبوت الكلام النّفسي في أنّه هل يسمّى في الأزل خطابا أولا. فمن قال بالأوّل قال إنّه حكم في الأزل، وأنّ الأمر يتعلّق بالمعدوم تعلّقا معنويّا، ومن نفى التّسمية في الأزل منع من أن يكون حكما في الأزل ونفى تعلّق الأمر بالمعدوم، المطيعي (محمّد بخيت)، سلّم الوصول، 1/299، زهير (محمّد أبو النّور)، أصول الفقه، 1/159-160.
10. يرى الأصوليّون أنّ الإباحة وإن كانت شرعيّة، لكنّها ليست بتكليف خلافا للأستاذ أبي إسحاق، فإنّه يرى أنّه تكليف على معنى أنّنا كلّفنا اعتقاد إباحته، واعترض عليه بكون الاعتقاد للإباحة ليس بمباح بل واجبا، والكلام في المباح. والنـزاع في هذه المسألة لفظيّ إلاّ أن يقال هو تكليف بمعرفة حكمه، لإجماع المسلمين على أنّ المكلّف لا يجوز له أن يقدم على تصرّف قبل أن يعلم حكم الشّرع فيه، وقد ينشأ عن هذا أنّ العلم بحكم المباح خارج عن المباح ذاته، الزّركشي، البحر المحيط، 1/287.
11. الإسنوي، نهاية السّول، 2/23-28، المطيعي (محمّد بخيت)، سلّم الوصول، 1/299.
12. راجع مثلا تعريف الحكم عند الأصوليين، الإسنوي، نهاية السّول، 1/50-51.
13. قد يفني المرء زهرة عمره في العكوف على علم الأصول قراءة وإقراء، ولا يكون قادرا على التّرجيح بين الأقوال في مسائل الاختلاف فضلا عن الاستنباط من الكتاب والسنّة، أو إلحاق الحوادث بنظائرها.
14. يقول الشّيخ محمّد الفاضل ابن عاشور في مقام الحديث عن هذا الكتاب ما نصّه: “امتاز بحسن العرض، وبوضوح البيـان، وباستقامة البراهين، وبنصاعة الحجج، وبحسن الجمع، وحسن التّرتيب، وحسن المقابلة، وحسن الاستدلال، ولكنّه في جوهره لخّص علم الأصول على نحو ما هو عليه في كتاب إمام الحرمين البرهان أو في كتاب القاضي أبي بكر الباقلاني من قبله التقريب والإرشاد، فلم يأت الغزالي في كتاب المستصفى بأنظار جديدة في أصول الفقه، ولم يغيّر أصول الفقه، ولكنّه اكتفى بالنّقد المنهجيّ الذي يرجع إلى الغاية من استعمال العلم لا إلى جوهر العلم في ذاته”، محاضرات، ص352.
15. يقول في هذا المقام “وإنما أكثر فيه المتكلمون من الأصوليين لغلبة الكلام على طبائعهم، فحملهم حبّ صناعتهم على خلطه بهذه الصنعة، كما حمل حبّ اللّغة والنحو بعض الأصوليين على مزج جملة من النحو بالأصول، فذكروا فيه من معاني الحروف ومعاني الإعراب جملا هي من علم النحو خاصّة، وكما حمل حبّ الفقه جماعة من فقهاء ما وراء النّهر كأبي زيد رحمه الله وأتباعه على مزج مسائل كثيرة من تفاريع الفقه بالأصول”، المستصفى، 1/10.
16. المرجع نفسه.
17. لئن ضمّن أبو إسحاق الشاطبي مقدّمات كتابه قراءة لعلم الأصول، وأعرب فيها عن المنهج الحريّ بأن يسمو بقواعده إلى مرتبة القطع، وتدارك في القسم الخاصّ بالمقاصد النّقص الذي كان باديا في هذا العلم، فإنه لم يخرج عمّا جرى عليه الأصوليون في سائر المباحث إلاّ ما امتاز به من عمق التّحليل وقوّة الاستدلال، ورفعة البيان، ابن عاشور (محمد الفاضل)، محاضرات، 363-364.
18. استند في إثبات دعواه إلى النّصوص الدّالة على إعراض الشّارع عمّا يخلو من الفائدة العمليّة نحو قوله تعالى: ﴿يسئلونك عن الاَهلّة، قل هي مواقيت للنّاس و الحجّ﴾ (البقرة: 188)، وقوله: ﴿يأيّها الذين ءامنوا لا تسئلوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم﴾ (المائدة: 102)، فالآية الأولى: وقع الجواب فيها بما يتعلّق به العمل، عدولا عمّا رمى إليه السّائل، والثّانية: نـزلت في رجل سأل رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- عن أبيه، ومن ذلك نهيه عليه السّلام “عن قيل وقال وكثرة السّؤال”، لكونه مظنّة السّؤال عمّا لا يفيد، الموافقات، 1/46.
19. الحقيقة أنّ هذه المباحث لم ترد في الأصول، لكونها من مسائله وإنّما لكونها من مقدّماته التي يتوقّف عليها توقّفا قريبا، ووجه المؤاخذة فيها هو التّوسع في بحثها، وتحريرها كأنّها من صلب هذا العلم، درّاز، شرحه على الموافقات، 1/43.
20. قسّم الأصوليّون الواجب بحسب ذاته إلى واجب معيّن وواجب مخيّر. والمراد بالأوّل إيجاب شيء مبهم من أشياء محصورة مثل خصال الكفّارة، وجزاء الصّيد، وفدية الأذى. وقد ذهب الأشاعرة إلى أنّ هذا الخطاب يقتضي إيجاب واحد لا بعينه من الأمور المعيّنة والمكلّف مخيّر في تحقيقه في أيّ فرد من هذه الأفراد المعيّنة، فالواجب يسقط بفعل أي واحد منها. فمتعلّق الإيجاب عندهم هو الواحد لا بعينه، وذهب المعتزلة إلى أنّ الخطاب يقتضي إيجاب كل ّواحد من هذه الأمور المعيّنة، فكلّ واحد منها قد تعلّق بالإيجاب عندهم ولم يتعلّق بواحد مبهم؛ لأنّ الأحكام تابعة عندهم لما يدركه العقل في الفعل من حسن وقبح، وقال بعض المعتزلة بكون الخطاب يقتضي إيجاب واحد معيّن عند الله غير معيّن للنّاس، الإسنوي، نهاية السّول، 1/134-135، الزّركشي، البحر المحيط، 1/186.
21. يرى الجمهور جواز تحريم واحد لا بعينه، ويكون معناه أن يترك أيّها شاء جمعا وبدلا، فلا يكون جامعا بينها في الفعل، ومنع المعتزلة ذلك؛ إذ الجميع عندهم محرّم، وامتثال المكلّف يتحقّق بترك واحد. والخلاف في هذه المسألة، وفي الواجب المخيّر لا طائل تحته؛ إذ لا يترتّب عليه فائدة عمليّة، درّاز، شرحه على الموافقات، 1/44-45.
22. الموافقات، 1/42-45.
23. التّوضيح والتّصحيح، 1/3-4.
24. عياض، ترتيب المدارك، 1/76.
25. ذكر السّبكي في مقدّمة الإبهاج أنّ أهل الأصول قد “دقّقوا في فهم أشياء من كلام العرب لم يصل إليها النّحاة ولا اللّغويون، فإنّ كلام العرب متّسع جدّا، والنّظر فيه متشعّب، فكتب اللّغة تضبط الألفاظ، ومعانيها الظاهرة، دون المعاني الدّقيقة التي تحتاج إلى نظر أصولي، واستقراء زائد على استقراء اللّغوي. مثاله دلالة صيغة افعل على الوجوب، ولا تفعل على التّحريم، وكون كلّ وأخواتها للعموم، وما أشبه ذلك.. لو فتّشت كتب اللّغة لم تجد فيها شفاء في ذلك، ولا تعرّضا لما ذكره الأصوليّون. وكذلك كتب النّحو لو طلبت معنى الاستثناء، وأنّ الإخراج هل هو قبل الحكم أو بعد الحكم، ونحو ذلك من الدّقائق التي تعرّض لها الأصوليون، وأخذوها باستقراء خاصّ من كلام العرب، وأدلّة خاصّة لا تقتضيها صناعة النّحو، فهذا ونحوه ممّا تكفّل به أصول الفقه”، 1/46.
26. ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلاميّة، ص90.
27. الأصبهاني، بيان المختصر، 2/539، ابن السّبكي، رفع الحاجب، 3/229.
28. يقول في هذا المقام: “من الذي سلّم أنّ أكثر العمومات مخصوصة؟ أم من الذي يقول ما من عموم إلاّ وقد خصّ إلاّ قوله: “بكلّ شيء عليم”، فإنّ هذا الكلام وإن كان قد يطلقه بعض السادات من المتفقّهة، وقد يوجد في كلام بعض المتكلّمين في أصول الفقه، فإنّه من أكذب الكلام وأفسده… وأنت إذا قرأت القرآن من أوّله إلى آخره، وجدت غالب عموماته محفوظة لا مخصوصة سواء عنيت عموم الجمع بأفراده، أو عموم الكلّ لأجزائه، أو عموم الكلّي لجزئياته… فالذي يقول بعد هذا ما من عام إلاّ وقد خصّ إلاّ كذا وكذا، إمّا في غاية الجهل، وإمّا في غاية التّقصير في العبارة”، مجموع الفتاوى، 6/442- 444.
29. أنكر أبو إسحاق الشّاطبي التّخصيص بالمنفصل؛ إذ هو مجرّد دعوى تولّدت من القول بمراعاة المعاني الأصليّة لصيغ العموم الواردة في نصوص الشّريعة، فهو يرى أنّ الشّارع الحكيم نقل ألفاظ العموم عن المدلول اللّغوي الأوّل إلى معان أخرى، وصار له في هذه العمومات عرف خاصّ مخالف لعرف أهل اللّغة، لذا وجب حمل كلامه عليها، الموافقات، 3/269.
30. يقول في مطلع المقدّمة الأولى: “إنّ أصول الفقه في الدّين قطعيّة لا ظنية، والدّليل على ذلك أنّها راجعة إلى كلّيات الشّريعة، وما كـان كذلك، فهو قطعيّ”، 1/29.
31. مجموع الفتاوى، 6/442.
32. أبو داود، كتاب الفرائض، باب: هل يرث المسلم الكافر، 3/328-329.
33. أحمد، المسند، 2/463.
34. مالك، كتاب العقول، باب ما جاء في ميراث العقل والتّغليظ فيه، 2/867.
35. البخاري، كتاب النّكاح، باب: لا تنكح المرأة على عمّتها، 6/128.
36. من صور بيع الحصاة أن يبيعه قطعة أرض يحدّدها برمية الحصاة، ولا يخفى ما في ذلك من جهالة للمبيع، أو أن يلزم البيع على ما تقع عليه الحصى من الثياب المختلفة، والمراد بالمضامين بيع ما في بطون إناث الإبل، وبالملاقيح بيع ما في ظهور الجمال، وبالمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما، ويقول كلّ واحد منهما هذا بهذا، ومعنى الملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره، ولا يتبين ما فيه، أو يشتريه ليلا ولا يعلم ما فيه، و المقصود من بيع حبل الحبلة أن يبتاع الرجل الجزور إلى أن تنتج النّاقة، ثمّ تنتج التي في بطنها، وللمزابنة صور منها بيع ثمر النّخل بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا، المازري، المعلم بفوائد مسلم، 2/235-246، الشوكاني، نيل الأوطار، 5/146-148.
37. الكراء المنهي عنه مقيّد باشتراط مكان معين من الحقل، ولاشكّ في أنّ هذا محظور لخروجه عن معنى الشركة الموجب للاشتراك في النماء؛ إذ قد يسلم المعيّن ويصيب غيره آفة، أو يهلك ويسلم غيره، فيغنم أحد المتعاقدين ويخسر الآخر، لذلك قال الليث “وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة”، البخاري، كتاب: الحرث والمزارعة، باب: كراء الأرض بالذهب والفضّة، 3/73.
38. دور الفقيه في هذا الضّرب من الاجتهاد أن يتحقق من وجود معنى القاعدة العامة في القضية محلّ النظر، فلا يسند إليها حكما شرعيا إلاّ بعد معرفة كونها من جزئيات تلك القاعدة. وقد قرّر أبو إسحاق الشاطبي أنّ هذا الضرب من الاجتهاد لا يمكن انقطاعه؛ إذ “لو فرض ارتفاعه لم تتنـزل الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين إلاّ في الذّهن؛ لأنّها مطلقات وعمومات وما يرجع إلى ذلك منـزلات على أفعال مطلقات كذلك، والأفعال لا تقع في الوجود مطلقة، وإنما تقع معينة مشخصة”، الموافقات، 4/93.
39. عضد هؤلاء قولهم بما لا يشهد له دليل؛ إذ ادّعوا أنّ لكلّ آية من آي الكتاب العزيز مناسبة، وقد ذكر ابن عاشور أنّ كثيرا من المفسّرين أولعوا بتطلّب أسباب النـزول، وأغربوا في ذلك وأفرطوا حتـى كاد بعضهم أن يوهم النّاس أنّ لكلّ آية سببا، التّحرير والتّنوير، 1/46.
40. المطيعي (محمّد البخيت)، سلّم الوصول، 3/320، زهير (محمّد أبو النّور)، أصول الفقه، 3/214.
41. الغزالي، المستصفى، 1/176. الزّركشي، البحر المحيط، 4/444.
42. اختلف أهل الأصول في كون الإجماع ناسخا على مذهبين: الأوّل: للجمهور ومفاده أنّ الإجماع لا يكون ناسخا لغيره، والثّاني: أنّه يكون ناسخا لغيره وهو ما تمسّك به بعض المعتزلة، وعيسى بن أبان، القرافي، شرح التّنقيح، ص314، الإسنوي، نهاية السّول، 2/589، ابن النّجار: شرح الكوكب المنير، 3/570، زهير (محمّد أبو النّور)، أصول الفقه، 3/81.
43. من ذلك ما نقله الزّركشي عن أبي إسحاق الإسفراييني من أنّ مسائل الإجماع تربو على عشرين ألف مسألة،البحر المحيط، 4/439.
44. التّوضيح والتّصحيح، 2/92.
45. المستصفى، 1/173.
46. يقول القرافي في بيان حقيقته ما نصّه: “هو اتّفاق أهل الحلّ والعقد من هذه الأمّة في أمر من الأمور”، ويقول الرّهوني” والحقّ أنّ الإجماع الذي هو أحد الأدلة الشّرعيّة أخصّ ممّا ذكر، وهو اتّفاق المجتهدين من هذه الأمّة في عصر على حكم شرعي عن اعتقاد”، تحفة المسؤول، 2/214. ونقل الزّركشي عن الإمام أبي محمّد القاسم الزّجاج أنّ الإجماع هو” اتّفاق مجتهدي أمّة محمّد -صلّى الله عليه وسلّم- بعد وفاته في حادثة على أمر من الأمور في عصر من الأعصار”، شرح التنقيح، 322، البحر المحيط، 4/436.
47. ابن عاشور، التّوضيح والتّصحيح، 2/92.
48. هذا النّوع هو الذي وصفه كثير من قدماء الأصوليين بكونه مقدما على الأدلة كلها، ابن عاشور، التّوضيح والتّصحيح، 2/92-93.
59. ابن القيّم، زاد المعاد، 4/8.
50. التوضيح والتّصحيح، 2/93.
51. استندوا في هذا التّأويل إلى أمرين: الأوّل: سبب التّصدّي لنفي الإثم عن السّاعي بين الصّفا والمروة، والثّاني: ما علم من أوامر الشّريعة اللّاحقة بنـزول الآية أو السّابقة لها، التّحرير والتّنوير، 2/62-64.
52. قصر ابن تيمية العلم بحصول الإجماع على عصر الصحابة؛ إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمّة في الأصقاع، فتعذّر العلم به غالبا، ولهذا اختلف أهل العلم فيما يذكر من الإجماعات الحادثة، مجموع الفتاوى، 11/341.
53. الدّسوقي (محمّد )، نظرة نقدية في الدّراسات الأصوليّة المعاصرة، 121-122.
54. يرى د. الدسوقي أن تعريف الإجماع في أدبنا الأصولي يحتاج إلى مراجعة وتطوير؛ حيث إن تعريفه بأنه اتفاق جميع المجتهدين من أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- في عصر من العصور على حكم شرعي، يعتبر افتراضا لا تشهد له النصوص، ولم يفهمه الجيل الأول؛ حيث كانوا يتشاورون ويقضون بما يجمعون عليه، وما كان إجماعهم إجماعا لكل علماء الصحابة، وإنما كان إجماعا لمن حضر منهم، فما كان أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي يتوقف على تنفيذ ما وصل إليه حضور علماء الصّحابة إلى أن يستشير غيرهم ممن هم منبثون في مختلف أصقاع المسلمين، ومن ثمّ، فإنّ تقييد صحّة الإجماع باتّفاق كل المجتهدين في عصر من العصور لا ينهض له دليل ولا تؤيده آثار، ولهذا لم يتحقق هذا الإجماع المفترض في تاريخ الأمة. وإذا كان هذا الإجماع بما قيده به الأصوليون لم يتحقّق في عصر الصّحابة، فعدم تحقّقه في عصور من بعدهم أصعب وأشقّ، لاختلاف الدّيار وتباعد الأوطان، على أنّه ليس من اليسير أن يتفق عدد كبير من المجتهدين في عصر واحد على مسألة واحدة، وعليه حتى يكون الإجماع عمليا ومفعَّلا ينبغي أن نعتمد إجماع الجمهور أو الأغلبية.
55. ابن النّجار، شرح الكوكب المنير، 2/263. ابن عاشور، التّوضيح والتّصحيح، 2/ 92-93.
56. شرح التنقيح، ص314.
57. يقول في هذا المقام: “أمّا الإماء فقال جمهور العلماء إن عدّتهن على نصف عدة الحرائر قياسا على تنصيف الحد، والطلاق، وعلى تنصيف عدة الطلاق، ولم يقل بمساواتهن للحرائر، في عدة الوفاة إلا الأصم، وفي رواية عن ابن سيرين، إلا أمهات الأولاد فقالت طائفة: عدتهن مثل الحرائر، وهو قول سعيد والزهري والحسن والأوزاعي وإسحاق وروي عن عمرو بن العاص، وقالت طوائف غير ذلك. وإن إجماع فقهاء الإسلام على تنصيف عدة الوفاة في الأمة المتوفى زوجها لمن معضلات المسائل الفقهية، فبنا أن ننظر إلى حكمة مشروعية عدة الوفاة، وإلى حكمة مشروعية التنصيف لذي الرق، فيما نصف له فيه حكم شرعي، فنرى بمسلك السبر والتقسيم أن عدة الوفاة إما أن تكون لحكمة تحقق النسب أو عدمه، وإما أن تكون لقصد الإحداد على الزوج، لما نسخ الإسلام ما كان عليه أهل الجاهلية من الإحداد حولا كاملا، أبقى لهن ثلث الحول، كما أبقى للميت حق الوصية بثلث ماله، وليس لها حكمة غير هذين؛ إذ ليس فيها ما في عدة الطلاق من حكمة انتظار ندامة المطلق، وليس هذا الوجه الثاني بصالح للتعليل؛ لأنه لا يظن بالشريعة أن تقرر أوهام أهل الجاهلية، فتبقى منه تراثا سيئا؛ ولأنه قد عهد من تصرف الإسلام إبطال تهويل أمر الموت، والجزع له، الذي كان عند الجاهلية، عرف ذلك في غير ما موضع من تصرفات الشريعة؛ ولأن الفقهاء اتفقوا على أن عدة الحامل من الوفاة وضع حملها، فلو كانت عدة غير الحامل لقصد استبقاء الحزن لاستوتا في العدة، فتعين أن حكمة عدة الوفاة هي تحقق الحمل أو عدمه، فلننقل النظر إلى الأمة نجد فيها وصفين: الإنسانية والرق، فإذا سلكنا إليهما طريق تخريج المناط، وجدنا الوصف المناسب لتعليل الاعتداد الذي حكمته تحقق النسب هو وصف الإنسانية؛ إذ الحمل لا يختلف حاله باختلاف أصناف النساء، وأحوالهن الاصطلاحية أما الرق، فليس وصفا صالحا للتأثير في هذا الحكم، وإنما نصفت للعبد أحكام ترجع إلى المناسب التحسيني: كتنصيف الحد لضعف مروءته، ولتفشي السرقة في العبيد، فطرد حكم التنصيف لهم في غيره. وتنصيف عدة الأمة في الطلاق الوارد في الحديث، لعلة الرغبة في مراجعة أمثالها، فإذا جاء راغب فيها بعد قرأين تزوجت، ويطرد باب التنصيف أيضا. فالوجه أن تكون عدة الوفاة للأمة كمثل الحرة، وليس في تنصيفها أثر، ومستند الإجماع قياس مع وجود الفارق”، التّحرير والتّنوير، 2/442-443.
58. يقول في هذا المقام: “هذا الإجماع وإن جاز الاحتجاج به، فلا يجوز أن تدفع النّصوص المعلومة به؛ لأنّ هذا حجّة ظنّية لا يجزم الإنسان بصحّتها، فإنّه لا يجزم بانتفاء المخالف وحيث قطع بانتفاء المخالف. فالإجماع قطعيّ. وأمّا إذا كان يظنّ عدمه ولا يقطع به، فهو حجّة ظنّية والظني لا يدفع به النّص المعلوم. لكن يحتجّ به ويقدّم على ما هو دونه بالظن ويقدّم عليه الظنّ الذي هو أقوى منه. فمتى كان ظنّه لدلالة النص أقوى من ظنّه لثبوت الإجماع قدّم دلالة النّص. ومتى كان ظنّه للإجماع أقوى قدّم هذا والمصيب في نفس الأمر واحد”، مجموع الفتاوى، 19/267-268.
59. الباجي، إحكام الفصول، 391، الجويني، البرهان، 1/698-705، الرّازي، المحصول، 2/74، ابن عاشور، التّوضيح والتّصحيح، ص93-94.
60. التّحرير والتّنوير، 2/417-418.
61. الدّسوقي، نظرة نقديّة في الدّراسات الأصوليّة المعاصرة، ص120..
62. يقول الفخر الرّازي: “روي أنّ الشّافعي -رضي الله عنه- سئل عن آية في كتاب الله تدلّ على أنّ الإجماع حجّة فقرأ القرآن ثلاثمائة مرّة حتّى وجد هذه الآية. وتقرير الاستدلال أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام، فوجب أن يكون اتباع سبيل المؤمنين واجبا. بيان المقدمة الأولى: أنه تعالى ألحق الوعيد بمن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، ومشاقة الرسول وحدها موجبة لهذا الوعيد، فلو لم يكن اتباع غير سبيل المؤمنين موجبا له، لكان ذلك ضما لما لا أثر له في الوعيد إلى ما هو مستقل باقتضاء ذلك الوعيد، وأنه غير جائز، فثبت أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام، فإذا ثبت هذا لزم أن يكون اتباع سبيلهم واجبا، وذلك، لأنّ عدم اتّباع سبيل المؤمنين يصدق عليه أنّه اتّباع لغير سبيل المؤمنين، فإذا كان اتّباع غير سبيل المؤمنين حراما لزم أن يكون عدم اتباع سبيل المؤمنين حراما وإذا كان عدم اتباعهم حراما كان اتّباعهم واجبا، التفسير الكبير، 11/35.
63. البرهان، 1/677-678.
64. المستصفى، 1/175.
65. التفسير الكبير، 4/90.
66. التّحرير والتّنوير، 2/19.
67. أنوار التّنـزيل، 1/195.
68. يقول في هذا المقام: “وأمّا كون الآية دليلا على حجية إجماع المجتهدين عن نظر واجتهاد، فلا يؤخذ من الآية إلا بأن يقال إن الآية يستأنس بها، لذلك فإنها لما أخبرت أن الله تعالى جعل هذه الأمة وسطا وعلمنا أن الوسط هو الخيار العدل الخارج من بين طرفي إفراط وتفريط علمنا أن الله تعالى أكمل عقول هذه الأمّة بما تنشأ عليه عقولهم من الاعتياد بالعقائد الصّحيحة ومجانبة الأوهام السخيفة التي ساخت فيها عقول الأمم، ومن الاعتياد بتلقي الشريعة من طرق العدول وإثبات أحكامها بالاستدلال استنباطا بالنسبة للعلماء وفهما بالنّسبة للعامة، فإذا كان كذلك لزم من معنى الآية أن عقول أفراد هاته الأمة عقول قيمة وهو معنى كونها وسطا، ثم هذه الاستقامة تختلف بما يناسب كل طبقة من الأمة وكل فرد، ولما كان الوصف الذي ذكر أثبت لمجموع الأمة قلنا إن هذا المجموع لا يقع في الضّلال لا عمدا ولا خطأ، أمّا التّعمد، فلأنّه ينافي العدالة، وأمّا الخطأ فلأنّـه ينافي الخلقة على استقامة الرأي، فإذا جاز الخطأ على آحادهم لا يجوز توارد جميع علمائهم على الخطأ نظرا، وقد وقع الأمران للأمم الماضية فأجمعوا على الخطأ متابعة لقول واحد منهم؛ لأنّ شرائعهم لم تحذّرهم من ذلك أو لأنهم أساءوا تأويلها، ثم إنّ العامّـة تأخذ نصيبا من هذه العصمة فيما هو من خصائصها وهو الجزء النقلي فقط وبهذا ينتظم الاستدلال”، التّحرير والتّنوير، 2/19-20.
التّحرير والتّنوير، 2/19.
69. يقول ابن تيمية: “وأمّا إجماع الأمّة،فهو حقّ، لا تجتمع الأمّة ولله الحمد على ضلالة كما وصفها الله بذلك في الكتاب والسّنة، ﴿كنتم خير أمّة أخرجت للنّاس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتومنون بالله﴾ (ال عمران: 110) وهذا وصف لهم بأنّهم يأمرون بكلّ معروف، وينهون عن كلّ منكر… فلو قالت الأمّة في الدّين بما هو ضلال لكانت لم تأمر بالمعروف في ذلك ولم تنه عن المنكر فيه”، مجموع الفتاوى، 19/176-177.
70. التّحرير والتّنوير، 4/51-52.
71. انظر: سنن أبو داود: 4/452.
72. انظر: سنن الترمذي: 3/315.
73. المنذري، مختصر سنن أبي داود، 6/139.
74. النّسائي، الضّعفاء والمتروكون، ص116. ابن أبي حاتم، الجرح والتّعديل، 2/119.
75. راجع ما ذكره الإمام الرّهوني في إبطال الاحتجاج بالأحاديث التي استند إليها الأصوليون في إثبات حجّية الإجماع، تحفة المسؤول، 2/232.
76. ابن عاشور، التّوضيح والتّصحيح، 2/98.
77. يقول في مجموع الفتاوى، “وقد كان بعض النّاس يذكر مسائل فيها إجماع بلا نصّ كالمضاربة، وليس كذلك، بل المضاربة كانت مشهورة بينهم في الجاهليّة لاسيما قريش، فإنّ الأغلب كان عليهم التّجارة، وكان أصحاب الأموال يدفعونها إلى العمّال ورسول الله -صلّى اللّه عليه وسلّم- قد سافر بمال غيره قبل النّبوّة كما سافر بمال خديجة، والعير التي كان فيها أبو سفيان كان أكثرها مضاربة مع أبي سفيان وغيره، فلمّا جاء الإسلام أقرّها رسول الله -صلّى اللّه عليه وسلّم- وكان أصحابه يسافرون بمال غيرهم مضاربة، ولم ينه عن ذلك، والسّنة قوله وفعله وإقراره، فلمّا أقرّها كانت ثابتة بالسّنة”، 19 /196.
78. مقاصد الشّريعة الإسلاميّة، ص85.
79. ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 19/176-177. ابن القيّم، إعلام الموقّعين، 1/122-123.
80. ابن تيمية، م، ن، 11/341.
81. الأصبهاني، بيان المختصر، 2/586. ابن السّبكي، الإبهاج، 2/987.
82. المستصفى، 2/279.
83. مقاصد الشريعة الإسلامية، ص84.
84. ابن عاشور، مقاصد الشّريعة، ص30.
85. ذكر ابن عاشور أنّ الصّحابة كانوا يتأسّون ما فعله الرّسول -صلى الله عليه وسلّم- أو حكم به وإن لم يرد فيه نصّ لفظي يقتضي الدّوام؛ لأنه ينير لهم وجوه الحق؛ ولأنّ أحوالهم كانت قريبة من الحال التي كانت في زمن رسول اللّه صلى الله عليه وسلّم، م، ن، ص92.
86. لمّا كانت العلّة لبّ القياس وقوامه عدّها فقهاء سمرقند الرّكن الوحيد الذي تتقوّم منه ماهية القياس، المؤلف: مسالك العلّة وقوادحها عند الأصوليين، 3.
87. يرد تنقيح المناط عند الأصوليين بمعان: أحدها: أن يدل ظاهر على علية وصف، فيعمد الفقيه إلى حذف خصوصه عن الاعتبار لينيط الحكم بالمعنى الأعم، والثاني: أن تكون أوصاف فيبذل جهده في تخليص الصالح منها للعلية مما اقترن به من أحوال ومعان طردية لا مدخل لها في التأثير، والثالث: أنه يرد بمعنى إلغاء الفارق، وهو أن ينفي المعلل اعتبار الفارق بين الأصل والفرع ببيان عدم تأثيره في الحكم، م، ن، ص262.
88. يقول ابن عاشور في هذا المقام: “وإنما حقّ الفقيه أن ينظر إلى الأسماء الموضوعة للمسمى أصالة أيام التشريع، وإلى الأشكال المنظور إليها عند التشريع من حيث إنّهما طريق لتعرّف الحالة الملحوظة وقت التشريع، لتهدينا إلى الوصف المرعي للشارع… ولم يزل الفقهاء يتوخون التفرقة بين الأوصاف المقصودة للتشريع وبين الأوصاف المقارنة لها التي لا يتعلّق بها غرض الشارع، ويسمونها الأوصاف الطردية وإن كانت هي الغالبة على الحقيقة الشرعية مثل الكون في البرية في حقيقة الحرابة، فإنّ ذلك أمر غالب وليس هو مقصود الشارع، فلذلك أفتى حذاق الفقهاء باعتبار حكم الحرابة في المدينة إذا كان الجاني حاملا للسلاح، وتخفيفا لأهل المدينة”، مقاصد الشريعة الإسلامية، 105-106.
89. هذا حديث ضعيف أخرجه عبد الرّزاق، المصنّف ح 17182. ابن أبي شيبة، المصنّف 9/414، البيهقي، السّنن الكبرى، 8/42، ابن عدي، الكامل في الضعفاء، 2/442.
90. ابن عاشور، مقاصد الشّريعة الإسلاميّة، ص45.
91. لم يزل العلماء ينقّحون المناط ممّا قارنه من أحوال وأوصاف طرديّة لا تعلّق لها بغرض الشّارع الحكيم، م، ن، ص106.
92. معنى الظهور في العلة أن تكون مدركة بإحدى الحواس الظاهرة، ووجه اشتراطه أن العلة إذا لم تكن جلية في الأصل فكيف تكون طريقا إلى معرفة الحكم في الفرع المتنازع فيه، والمراد بالانضباط أن تكون لها حقيقة معينة محدودة لا تختلف باختلاف المحال، المؤلف: مسالك العلة وقوادحها عند الأصوليين، 1/332-333.
93. يقول ابن عبد البرّ: “ذهب مالك -رحمه الله- إلى أنّ المفطر عامدا في رمضان بأكل أو شرب أو جماع أنّ عليه الكفّارة”، التمهيد، 7/162.
94. البخاري، كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدّق عليه فليكفر، 2/235- 236، مسلم، كتاب الصوم، باب تغليظ تحريم الجماع في رمضان على الصائم، 1/781-782.
95. ناط الإمام الشافعي الحكم الجماع؛ لأنّ الأكل ليس في معناه؛ إذ لم يماثله في تحريم الملّة وقد اعترض عليه ابن العربي بأنّهما وإن افترقا في تحريم الملّة، فإنّهما مستويان في التحريم هنا وفي الهتك فإنّهما يبحان جميعا ليلا من الزوجة والحرمان نهارا إباحة مستوية وتحريما مستويا، القبس، 2/503.
96. يقول القاضي عبد الوهاب: “تجب الكفارة بكل فطر على وجه الهتك من أكل و شرب و غير ذلك سوى الردة خلافا للشافعي في قوله لا كفارة إلا في جماع “، الإشراف، 1/433.
97. بين القرافي في الإحكام أن واجب الفقيه المقلد إذا وقعت له نازلة لم يرد فيها نص عن إمامه وأصحابه ورام تخريجها على قواعد المذهب أن ينعم النظر في القواعد الإجماعية والمذهبية، فمتى تبين الفرق بين الصورة محل النظر والأصل المخرج عليه كأن تخلو من معنى يرى إمامه كونه معتبرا في هذا الأصل امتنع التخريج؛ إذ الفرق المؤثر بين الفرع الحادث والأصل المقيس عليه موجب لفساد القياس، فكما يمتنع عن المجتهد القياس على قواعد الشرع مع الفارق، كذلك يمتنع قياس المفتي المقلد مع قيام الفرق المؤثر، فإن نسبته إلى قواعد مذهبه بمنـزلة نسبة إمامه إلى قواعد الشريعة. وقد بنى على هذا التقرير أن المفتي لا يجوز له تخريج المسكوت عنه على المنصوص إلا إذا كان استحضاره لقواعد الإجماع وقواعد المذهب شديدا، ومن لم يكن كذلك فلا يفتي إلا بالنصوص المنقولة في المذهب إذا علم سلامتها من المعارض الراجح وأما من قصر عن مرتبة التخريج ولم يكن ذا اطلاع واسع على مسطورات المذهب، فليس له أن يتصدى للفتيا سواء أكان حافظا لنص المسألة أم لا، لاحتمال أن يكون هذا المحفوظ عاما مخصصا في المذهب بنص ثان للإمام أو مطلقا مقيدا بوصف أو حال أو معنى غير موجود في الفتوى، الفروق، ص260.
98. عرّفه الباجي بأنّه “حمل أحد المعلومين على الآخر في إيجاب بعض الأحكام لهما وإسقاطه عنهما بأمر يجمع بينهما”، والتلمساني بكونه “إلحاق صورة مجهولة الحكم بصورة معلومة الحكم، لأجل أمر جامع بينهما يقتضي ذلك الحكم”، إحكام الفصول، 457، مفتاح الوصول، 652.
99. قارن ما ذكره ابن رشد بما أورده ابن عاشور في النحو الرابع من أنحاء النظر الفقهي، فقد نبه فيه على شدّة احتياج الفقيه إلى معرفة مقاصد الشريعة فيما لم يرد فيه نصّ، ولا نظير يعتبر به؛ إذ بها نحفظ عموم الشريعة ودوامها أي صلاحيّة اطراد أحكامها في جميع الأعصار والأمصار، لذلك قال الإمام مالك بحجيّة المصالح المرسلة، وقال جمهور العلماء بمراعـاة الأصول المعنويّة المستقرأة من موارد الكتاب والسنة، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص15-16.
100. يقول في هذا المقام: “واعلم أن هذا المعنى مما اتفق عليه مالك وأصحابه، ولم يختلفوا فيه على ما يوجد في كتبهم من قياس المسائل بعضها على بعض، وهو صحيح في المعنى وإن خالف فيه مخالفون؛ لأن الكتاب والسنة والإجماع أصل في الأحكام الشّرعيات كما أن علم الضرورة أصل في العلوم العقليات. فكما بني العلم العقلي على علم الضّرورة أو على ما بني على علم الضرورة هكذا أبدا من غير حصر بعدد على ترتيب ونظام الأقرب على الأقرب. ولا يصحّ أن يبنى الأقرب على الأبعد، فكذلك العلوم السمعيات تبنى على الكتاب والسنة وإجماع الأمة أو على ما بني عليها أو ما بني على ما بني عليها بصحته هكذا أبدا إلى غير نهاية على ترتيب ونظام الأقرب على الأقرب، ولا يصح بناء الأقرب على الأبعد”، 1/38-39.
101. قوي اختلافهم فيها مع كونهم أشدّ احتياجا إليها مما صرفت إليه الهمم في تحقيق الوئام بين المسلمين، فهذا الضرب حري بألاّ يجري فيه اختلاف وأن تصرف إليه العناية البالغة من أجل استثماره والتواصل معه في الاجتهاد المعاصر.
102. الاعتصام، 1/30.
103. ناط عبد الله دراز خمول ذكره بطبيعة المباحث المبتكرة التي اشتمل عليها، وبطريقة صوغه وتأليفه، مقدّمة تحقيق الموافقات: 1/11-12.
104. مقاصد الشريعة الإسلامية، ص78.
105. يقول في هذا المقام “وإنّما غرضنا من ذلك أن نعرف كثيرا من صور المصالح المختلفة الأنواع المعروف قصد الشريعة إيّاها، حتى يحصل لنا من تلك المعرفة يقين بصور كليّة من أنواع هاته المصالح، فمتى حلّت الحوادث التي لم يسبق حلولها في زمن الشارع، ولا لها نظائر ذات أحكام متلقاة منه عرفنا كيف ندخلها تحت تلك الصور الكليّة، فنثبت لها من الأحكام أمثال ما ثبت لكلياتها، ونطمئن بأننا في ذلك مثبتون أحكاما شرعية إسلامية، وهذا ما يسمى بالمصالح المرسلة”، ص83.
106. يقول في هذا المقام: “وإني لأعجب فرط العجب من إمام الحرمين على جلالة علمه، ونفاذ علمه كيف تردد في هذا المقام، وأما الغزالي فأقبل وأدبر فلحق بطرف الوفاق لاعتبار المصالح المرسلة ومرة بطرف رأي إمام الحرمين؛ إذ تردد في مقدار المصلحة”، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص84.
107. ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص84.
108. المرجع نفسه، ص78.
109. لم يحسن كثير من فقهاء العصر استخدام هذا المدرك، لذلك انتهوا إلى أحكام واهية، فمن ذلك إلحاق الموسر المماطل بالغاصب في تضمين المنفعة، وهو قياس فاسد؛ لأنّ المضمون هو منفعة ما تجوز الإجارة فيه، وهي محظورة في الدراهم والدنانير، فلا يضمن غاصبها منفعتها، جمعة (عليّ)، آليات الاجتهاد، ص74.
110. علل ابن عاشور لجوء الفقهاء إليه في التفريع بأنّهم رأوا دلالة النظير على نظيره أقرب إرشادا إلى المعنى الذي صرّح الشارع باعتباره في نظيره أو أومأ إلى مراعاته فيه أو أوصل الظنّ الراجح بأنّ الشّارع ما راعى في حكم النظير إلاّ ذلك المعنى، فإنّ “دلالة النظير على المعنى المرعي للشارع حين حكم له بحكم ما دلالة مضبوطة ظاهرة مصحوبة بمثالها… فتكفي الفقيه مؤونة الانتشار في البحث عن المعنى من أجناسه العالية ثمّ بما فيها من التمثيل والضبط تنتقل بالمجتهد إلى المعنى الذي اشتمل عليه النظير غير المعروف حكمه، فيلحقه في الحكم بحكم كلياته القريبة، ثمّ بحكم كلياته العالية؛ إذ لا يعسر عليه ذلك الانتقال حينئذ فتتجلّى له المراتب الثلاث انجلاء بيّنا”، ص180-109.
111. ومضات فكر، ص38-39.
112. “أمّا بالنّسبة للقرنين الأخيرين، فإنّ الأوضاع انقلبت انقلابا تامّا بحيث أصبحت المسائل المدوّنة في كتب الفقه قليلة النّظائر في الحياة العمليّة الحاضرة، وذلك هو الذي جعل مشكلة الاجتهاد مصوّرة في يومنا الحاضر بما لم تتصوّر به في القرون الغابرة ولا يمكن أن تتصوّر به. فقد أصبحت مظهرا لانعزال الدّين عن الحياة العملية، واندفاع تيّار الحياة بالأمة الإسلاميّة في مجرى الهوى الذي ما جاء الدّين إلاّ ليخرج بالمكلّفين عن داعيته، فإذا استطاعت الدّولة الإسلاميّة أن تلفّق قوانين للأحوال الشّخصيّة تستمدّ من المذاهب المختلفة نصّا أو تخريجا، فأين هي من بقيّة القوانين العامّة والخاصّة؟ وأين الدّارسون للشّريعة والباحثون في الأحكام والدّاعون إلى الاجتهاد فيها من مبالغ الدّراسات الاجتماعيّة، والاقتصاديّة، والقانونيّة التي تطفح على بلاد الإسلام بكلّ نظام أجنبيّ مستعار دخيل على الملّة، غريب على الدّين؟”.
113. مقاصد الشريعة الإسلاميّة، ص5.
114. من ذلك اللّجوء إلى الحيل الفقهية، والتّخريج على كلام الأيمة، والرّجوع إلى عمل العلماء في الأندلس، أو فاس، أو تونس، ولا ريب في أنّ هذه المسالك لا تلائم طبيعة التّشريع الجامع بين وصفي العموم والخلود، أليس الصبح بقريب، ص199.
115. ابن عاشور، أليس الصّبح بقريب، ص202.
116. ذكر محمّد الفاضل ابن عاشور أنّ والده وإن كان ينقد الشاطبيّ، ولا يلتزم أصوله ولا مناهجه، فإنّه سلك طريقته في الكشف عن مقاصد الشّريعة محاولا تطبيقها على الأبواب الجزئيّة بإيجاد جوامع كلّية، ومعاقد منهجيّة لتصرّفات الأحكام على حسب ما تتلاقى فيه المذاهب بالنّسبة إلى كلّ باب. فكان كتاب مقاصد الشّريعة في نظره تطبيقا جزئيّا للمنهج الذي جرى عليه أبو إسحاق الشاطبيّ؛ إذ استخرج فيه أصول الأبواب وحاول أن يجعل لكلّ حقيقة من الحقائق الشّرعيّة حكمة مسيطرة على جميع التّصاريف التي تتصرّف عن تلك الحقيقة من الأحكام، محاضرات، 365-366. ولئن سلّمنا بهذا الحكم الذي لا يخلو من النّظر، فإنّه لا يصدق إلاّ على القسم الثّالث من كتاب المقاصد. فأمّا القسم الأوّل: فتضمّن مباحث نظريّة نحو نوط التّشريع بالمقاصد، واحتياج الفقيه إلى معرفة المقاصد، والطّرق الهادية إليها، وقد ساير فيه الشاطبي على وجه الإجمال دون التفصيل، وأمّا القسم الثّاني: فقد أفرده للمقاصد العامة حقيقة، وأنواعا، ومراتب. وقد فصّل فيه ما أجمله الشّاطبي في الكلام على الغاية العامّة للشّريعة؛ أقصد جلب المصلحة، ودرء المفسدة؛ إذ لما كانت المصلحة من الجنس العالي الموغل في العموم، بيّن الأصول والمقاصد الراجعة إليها وأثرها في التّشريع. وفي هذا القسم كشف عن أصول لم يسبق إليها، هداه إليها استقراء موارد التّشريع كتابا وسنّة، ولولا المقام القاضي بالاقتصار على تشخيص الأدواء، لفصّلنا القول في ذلك تفصيلا، ولكن حسبنا أن نورد مثالا نثبت به صدق ما ادّعينا فقد بيّن مثلا أن اعتبار الفطرة في الأحكام خليق بتحقيق صلاح الإنسان الذي تتوقف عليه الغاية العامّة من التشريع؛ إذ كلّ ما يجري على مقتضى النّظام الجبلّي فهو من الصلاح المنشود، وكلّ ما يفضي إلى اختلاله والاقتيات عليه، فهو من الفساد المحظور، يقول في هذا المقام: “ونحن إذا أجدنا النظر في المقصد العام من التشريع نجده لا يعدو أن يساير حفظ الفطرة والحذر من خرقها واختلالها. ولعلّ ما أفضى إلى خرق عظيم فيها يعدّ في الشرع محذورا وممنوعا، وما أفضى إلى حفظ كيانها يعد واجبا، وما كان دون ذلك في الأمرين، فهو منهي أو مطلوب في الجملة، وما لا يمسها مباح”، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص59.
117. يرى محمّد الشاذلي النّيفر أنّ القياس ضروريّ، لتفتّح الشّريعة على الحياة الإنسانيّة؛ إذ هو الحريّ ببيان حكم جميع الحوادث النّازلة، والمشاكل الطّارئة في المجتمع، فإذا أخذنا به لم تتعاص علينا مشاكل العصر الحاضر مثل مشكلة التأمين، وحقوق أرباب الأموال والعمال، وإدارة الأموال في البنوك، ويرى عليّ جمعة أنّ القياس لا يزال من المدارك الصالحة لهذا الزّمن، ولكنّنا لم نحسن استخدامه على الوجه الصّحيح، لافتقارنا إلى التّدريب عليه فقهيّا، وقد اعتبره محمّد المختار السّلامي أحد مقوّمات عموم الشّريعة وشمولها التي تفتح للاقتصاد المعاصر منافذ تشريعيّة، ولكنّه دعا إلى أن يكون جماعيّا، لاستشعاره بخطورة الإقدام عليه، تفتّح الفقه الإسلامي على الحياة الإنسانية، ص27، آليّات الاجتهاد، ص72، القياس وتطبيقاته المعاصرة، ص12-93.