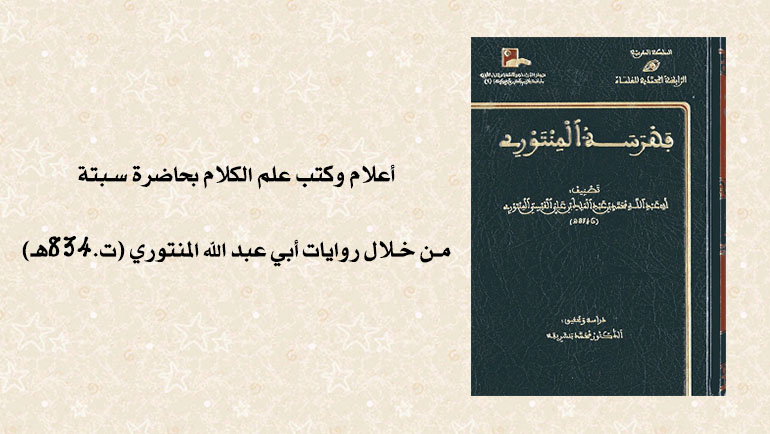يعلم من الثروة الهائلة للفكر التفسيري أن هناك طرائق وآليات مختلفة لمناهج بيان القرآن الكريم، وقد شكلت هذه المناهج مدارس واتجاهات في علم التفسير بما اعتمدته من أدوات وقواعد الاستمداد من النص القرآني على مستوى الألفاظ والمعاني والمضامين والمقاصد، ميزت النشاط التفسيري منذ نشأته إلى يوم الناس هذا، وبما جد فيه من مناهج الفهم والإفهام والاستنباط، انطلاقا من مسلمة هيمنة الخطاب القرآني على الإنسان والزمان والمكان.
وما كان لهذه المناهج أن تتجدد وتستجيب لحاجات عصرها لولا جهود العلماء الربانيين في مجال النقد والتقويم والمقارنة والتجديد وإعادة القراءة لمكونات المنهج الأم مادة وتوظيفا، لتكشف للجيل الوارث عن القضايا والإشكالات المعرفية والمنهجية قصد صيانة الموروث واستثماره في الاستجابة لواجب العصر، وإن واجب العصر كما قرره كثير من المهتمين بصيرورة الأمة؛ إعادة روح التكامل المنهجي بين العلوم الشرعية، لإيجاد نسق معرفي قوامه الوحدة والتناسق، نموذجه في ذلك وحدة الوحي ومحورية القرآن، وتفتق العلوم والمعارف الإسلامية عنه خادمة له فهمًا وبيانا، وفي مقدمتها علم التفسير، الذي قام على أصول حاكمة على التفسير التطبيقي وبياناته، ليبقى متجانسا مع القرآن، موافقا له مهما تراكمت عليه الأقوال وتطاولت عليه الأزمنة.
فالمراجعة المستمرة لما راكمه السابقون واللاحقون حول الوحي من مناهج ومفاهيم، بحثا عن أقوم مناهج الاستنباط والاستثمار والاستمداد، أمر يوجبه تجديد أمر الدين في هذا الدين ومن نتائج المراجعة تجريح المنهج الجزئي في التعامل مع قواعد وآليات الاستمداد من الوحي؛ لأن في ذلك تفتيت لوحدته الموضوعية والعضوية والمقاصدية، وتكريس ودعم لأشكال الاضطراب المنهجي والمعرفي من حيث ندري أولا ندري.
وفي معمعة التوحيد المنهجي هذه وأنت تستشعر برد المبشرات بثمرة البدايات، تصطدم بمن ينعتُ “التفسير التطبيقي بأنه مجال فوضى يدخله كل من هب ودب… وأنه لم يصغ بعد الصياغة التي تقيم صلبه وتشكل أركانه وتضبط أنساقه القاعدية والمنهجية… بل بقي عريا من أي سياج نظري نقدي له نسقه الذي يحكمه، ومنطقه الذي يقننه ويقعده… ومن هنا كان التفسير التطبيقي مرتعا للخلل والخطل، في حين تجد علم أصول الفقه مثلا أو علم النقد الحديثي يفوقان علم أصول التفسير بكثير، بانضباط المصطلح ووجود التقعيد والمنهج بالمعنى الحقيقي[1].
إن إشكالية إعادة النظر في نسقية مباحث قواعد التفسير وعلاقة أصول الفقه بأصول التفسير وقواعده تأتي في مقدمات مراجعة مناهج قراءة الوحي، إلا أن تشهد بأن (التفسير التطبيقي بقي عريا[2] من أي سياج نظري يقننه ويقعده) فهذا يعني أن مفسري الأمة منذ 14 قرنا كانوا يهرفون بما لا يعرفون، وإلا القول إن أصول الفقه أو علم النقد الحديثي يتميزان بوجود التقعيد والمنهج الحقيقي، فهذا لا معنى له إلا توسيع الشقة بين الشيء وذاته، وتكريس التجزئة بين أدوات وآليات الاستمداد من الوحي، وكأن الوحي مصدرا وطبيعة، لم يأت من إلَـه واحد، ولا كان بلغة واحدة ولا على يد رسول واحد؟
تلك بعض موجبات المداخلة وبعضها الآخر توجبه مراجعة مباحث علمي الأصول، إسهاما في بناء نسق منهجي منتظم متجانس مستوعب يحيي الأمة كما أنشأها أول مرة.
صحيح أن علم أصول التفسير من حيث كونه علم مصادر وآليات وقواعد فهم الوحي وإفهامه، ومن حيث كونه محور مناهج قراءة الوحي يحتاج إلى مراجعة نقدية تحديدية تحيينية، تعيد إلى العلوم الشرعية وحدتها وحيويتها وشموليتها، وتجتث من مباحثها ومفاهيمها ما يثبت النقد العلمي أنها طفيليات علقت به وتكاثرت في ظروف فكرية وتاريخية معينة، لإعادة إحكام الصياغة المنهجية ورصف بناء المباحث، وأحسب أن الدعوة إلى تحقيق مشروع إعادة بناء علم أصول التفسير استجابة لما سطرته الأقلام والأفكار ذات البعد التوحيدي المعاصرة[3] هي ما تحتاج إليه المرحلة -وهي واجب العصر- بتعبير الأستاذ الشاهد البوشيخي، أي: بناء نسق منهجي ينتظم ويستوعب بمقوماته الوحي بشقيه القرآن والسنة، وقضاياه الموضوعاتية والمقاصدية: العقيدة والأخلاق والنظم العملية، فكل ذلك شريعة وكل ذلك حكم وأمر من الحاكم الآمر، لا ترى فيه عوجا ولا أمتا: يصدق بعضه بعضا وحيا وموضوعا ومقاصد.
وإن الذي صار عريا من السياج الناظم هو فكر المسلمين في مرحلة الركوض والذي صار مجال فوضى ودخله كل من هب ودب هو عالم المسلمين يوم أن ترهلت لحمته ووهن نسيجه الحضاري فتنامى في جسمه ﴿مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ﴾ (النساء: 45)، فلا أصول الفقه سلمت ولا الفقه نجا، ولا علم نقد الحديث منعهم من التقول والافتراء.
فعلم أصول الفقه -بالمفهوم القائم والموروث من عصور الانحطاط- مع القول بعلميته، ها هم أهله يتنادون بتجديده بتنقيته من المنطق الأرسطي، وهيمنة الفكر الكلامي، ومما أقحم فيه من مباحث معرفية تعيق التوظيف والإجراء، كشرع من قبلنا وتأخر البيان عن وقت الحاجة، ومما تشابه منه بالقواعد الفقهية، ومن إشكالية مبحث اتصال وانفصال المقاصد، الخ… وإن نظرت إليه من جهة المذهبية الفقهية ترى الاختلاف في عدد مصادر التشريع وفي ترتيبها، مرورا بمباحث الدلالة ومنهاج توظيفها ومع كل هذا فهو يؤدي وظيفته بشكل عام، كما يؤديها علم أصول التفسير وقواعده.
بل إن علم أصول الفقه بإجماع علوم القرآن وأصول التفسير هو جزء لا يتجزأ من علم أصول التفسير وقواعده، ولولا ما تراكم على هذا المنهج من تصورات تجزيئية ومفاهيم انفصالية والتباعد الذي أنشأته جفوة الاصطلاح وشدة التقسيم، لكان لمنهاج الاستنباط من الوحي شأن آخر.
ونحن اليوم إذا أردنا الإحسان في بناء المناهج والتوفيق في توظيفها، مطالبون بإعادة مفهوم أصول الفقه إلى المعنى الأصلي الذي نشأ به وعنه هذا العلم ضمن العلوم المساعدة والضابطة لفهم القرآن الكريم إذ واقع الدرس الأصولي عند المتأخرين وكما هو عليه أمرها في المؤلفات المدرسية تعريفا وتصنيفا وممارسة، انحصر توظيف قواعده فيما عرفوه بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية[4].
ويعنون بالأحكام العملية ما ليس اعتقادا، كالوحدانية والرسالة والعلم باليوم الآخر وإن سماه السلف الفقه الأكبر، وما ليس أخلاقا وقيما، وينضم إلى هذا الإخراج القهري ما تعلق بالسنن الكونية والاجتماعية وما يخدمها من القصص القرآني.
وهذا الحصر المفهومي فتح ممارسة سلبية في عقلية المجتمع الإسلامي أثرت على التأليف والتصنيف في الفكر الفقهي ومنه إلى التأثير في أخلاق وسلوكيات المجتمع الإسلامي يوم أن تخلت مؤلفات الفقه الإسلامي عن مباحث العقيدة ومباحث الأخلاق، لتفقد بذلك أعمال الجوارح روحها وحيويتها فضعف التدين في الناس بضعف منهج فقه الدين.
ولقد تأثر التفسير التطبيقي بذلك يوم أن اجتزأ من القرآن آيات الأحكام وصاغها على منهج الفقهاء، إلا صنيع أبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي في تفسيره: “الجامع لأحكام القرآن”.
إن منهج التصحيح يلزمنا بالرجوع إلى أصل نشأة هذا الفن من العلوم، علم أصول الفقه بمعنى فهم الشريعة بمعناه الجامع، والبحث في ذلك يحيلنا إجماعا على أن مفتقه هو الإمام الشافعي في كتابه “الرسالة”، وسبب تأليفها شاهد على أنها أنجزت في مبادئ وقواعد فقه القرآن كل القرآن، ودون استثناء.
يكتب عبد الرحمن بن مهدي الحافظ الإمام (ت: 198) إلى الشافعي وهو شاب أن يضع له كتابا في معاني القرآن والسنة، فوضع له كتاب الرسالة[5] والشافعي في مقدمتها ينص على أن ما يؤسسه هو لفهم القرآن بقوله: “كل ما أنزل في كتابه جل ثناؤه رحمة وحجة… ومن أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه، فاز بالفضيلة في دينه ودنياه… وليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها”[6].
نتساءل باحثين: من خصص أحكام الله بما اصطلح عليه بالأحكام الشرعية العملية وأخرج منها الأحكام العقدية والأحكام الأخلاقية، ومن أوقف النوازل على أفعال الجوارح، واستثنى منها أفعال القلوب وهي الأصل في أفعال الجوارح، ومن حاصر أصول الفقه بمعنى آليات فهم الوحي في شق واحد من أجزاء الشريعة.
إن ابتداء أمر الأصول والقواعد ونشأة الآليات والضوابط يوم أن احتيج إليها لبناء منهاج نظري للبيان، كان لبيان ما يحتاج إلى البيان، في القرآن. والسنة تبع له، وإن كانت السنة أداة رئيسة من أدوات البيان. وعلماء الشريعة الأوائل، بنوا قواعد البيان للوحي بكل أبعاده الموضوعاتية، ولم يزعم أي علم من علوم الشريعة استقلاله بقواعد البيان، مستغن بنفسه عن غيره، وإن عوامل اجتماعية وبيئية وفكرية معينة هي التي خصصت أصول البيان، بعد أن تأسست أصولا لفهم الوحي، بما اصطلح عليه بأصول الفقه بمباحثه المعروفة وهي لا تكفي وحدها في نظرنا للاستمداد من الوحي ولا إلى بيانه.
إن القاعدة في الإطار التفسيري توظف جنبا إلى جنب مع قواعد بلاغية وعقدية وأخلاقية واجتماعية وتربوية انسجاما مع موضوعات الوحي وقضاياه فضلا عن الاستفادة من علم القراءات وعلم الرسم القرآني، ومثل هذه الأدوات تخلو منها مباحث أصول الفقه.
وما لم نحرر مفهوم الفقه ومفهوم الحكم ومفهوم الشريعة من قيد المصطلح الذي ألصق به، ونرجع به إلى المفهوم القرآني، لن نحقق النسقية المنهاجية التي تستلزمها نسقية الوحي. وتلك قضية مطلوب البث فيها على استعجال بالمصطلح القضائي.
ومع ما قيل في علم أصول الفقه وفي علم أصول التفسير وما يمكن أن يقال، فإن هناك مباحث عديدة تمثل القاسم المشترك بينهما، وإن توحد المصطلح والمفهوم لهذين العلمين أو على الأقل سريان عرف العموم والخصوص بينهما يسمح بفتح باب مراجعة جملة من المباحث الجامعة ومن ذلك:
النموذج الأول: قضية جمع القرآن مرتين، وأعني جمعه في مصحف واحد وهذا لم يكن إلا مرة واحدة في عهد أبي بكر الصديق أما ما قام به عثمان فلم يكن إلا نسخا للمصحف المجموع في عدة نسخ ثم نشرها في عواصم الأقاليم الإسلامية المشهورة في عهد عثمان.
تجمع الروايات أن السبب هو اختلاف القراءة بين الغزاة أثناء غزو أرمينيا وأذربيجان. وأن عثمان كان قد نمى إليه أن شيئا من ذلك الخلاف يحدث للذين يقرئون الصبية، فأكبر الصحابة هذا الأمر مخافة أن ينجم عنه التحريف والتبديل وأجمعوا أمرهم أن ينسخوا الصحف التي كانت عند أبي بكر.
يروي البخاري في صحيحه في باب فضائل القرآن الكريم عن أنس بن مالك أن عثمان أرسل إلى حفصة “أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها ثم نردها إليك، فأرسلت إليه بتلك الصحف ثم أرسل إلى زيد بن ثابت الأنصاري وإلى عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأمرهم أن ينسخوها في المصاحف حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق.
فعثمان عدد نسخ القرآن وأرسل إلى كل إقليم بمصحف إمام يرجع إليه عند الاختلاف لا أنه جمع القرآن مرة ثانية.
النموذج الثاني: قضية إبقاء عثمان على حرف واحد ونسخ الستة
تجد عددا كبيرا من كتب علوم القرآن قد أضاف مؤلفوها إلى رواية البخاري السابقة استنباطا من عند أنفسهم دون دليل، القول بأن عثمان أبقى على حرف واحد[7] مع العلم أن رواية البخاري لم تذكر إلا نسخ الصحف في مصاحف وأن نزول القرآن على سبعة أحرف عملية وحي والوحي لا يرفعه إلا الوحي، وما كان لعثمان أن يرفع وحيا ولاسيما والصحابة معه وما عارضوا ولا جاءنا خبر بمراجعة. وما كان لهم أن يسكتوا على فعل كهذا. ثم إن الأحرف السبعة نزلت للتيسير ودواعيه قائمة إلى قيام الساعة والقراءات القرآنية بوجوهها الثابتة المعجزة تستوعبها. إذن، فلم هذا التحمل، الذي لا تتحمله طبيعة الوحي ولا واقع التنزيل[8].
النموذج الثالث: هل فسر الرسول، صلى الله عليه وسلم، القرآن كله؟ وضع السؤال بهذه الصيغة يوحي بتقصير الرسول صلى الله عليه وسلم في أداء مهمة البيان مع أنه ما أنزل عليه الذكر إلا ليبين مهمته محصورة في البلاغ المبين.
وما دام مفهوم البيان يشمل ما يبين به الشيء من الدلالة وغيرها من أدوات الكشف كالكتابة والإشارة والعلامة والحال… وكل ما يبين به الشيء[9]، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين كل ما يحتاج إلى البيان بالنسبة لمرحلة النبوة وبين القواعد والكليات التي تستوعب ما يحتاج إلى بيان بالنسبة إلى ما بعد النبوة…
ثم إن قصد التكليف لا يتحقق إلا بالبيان وإلا استحال الامتثال. وشرط التكليف القدرة على المكلف به على الوجه الرافع للحرج، ولا يعقل خطاب مقصود من غير فهم كما أبان ذلك الشاطبي[10].
النموذج الرابع: وهو من مقدمة جامع البيان في مسألة البيان، فمع أن القرآن نص على مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم، هي البيان، ومع أن البيان في اللغة شامل لكل ما تتم به عملية البيان، تجد عددا كبيرا من مصنفات علوم القرآن تتساءل في مبحث خاص، هل فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما يحتاج إلى البيان؟ معتمدة في هذا التساؤل على ما نسب إلى عائشة رضي الله عنهما “ما كان صلى الله عليه وسلم يفسر شيئا من القرآن إلا آيات تعد علمهن إياه جبريل”[11].
قال الطبري معلقا على المبحث والحديث: “ولو كان تأويل الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان لا يفسر من القرآن شيئا، إلا آيات تعد هو ما يسبق إلى أوهام أهل الغباء من أنه لم يكن يفسر من القرآن إلا القليل، كان إنما أنزل إليه الذكر ليترك البيان لا ليبين[12]، هذا مع ما في الخبر عن عائشة -والقول له- من العلة التي… لا يجوز معها الاحتجاج به… لأن روايته عمن لا يعرف في أهل الآثار وهو جعفر بن محمد الزبيري[13].
النموذج الخامس: وهو مأخوذ من مقدمة الطبري في جامع البيان “باب القول في الوجوه التي من قبلها يتوصل إلى معرفة تأويل القرآن[14] فبعد أن بين أن مما أنزل الله من القرآن… ما لا يوصل إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: “إن منه ما لا يعلم تأويله إلا الله الواحد القهار، وذلك ما فيه من الخبر عن آجال حادثة، وأوقات آتية، كوقت قيام الساعة والنفخ في الصور، ونزول عيسى…[15] فإن تلك لا يعلم أحد حدودها ولا يعرف أحد تأويلها إلا الخبر بأشراطها. ومحل القول في النص أمران، مع التقدير الكبير لشيخ المفسرين.
الأول: إذا كان التأويل عنده بمعنى التفسير، فإن المتلقي للخطاب يعلم منه أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن النفخ في الصور واقع لا محالة، وأن نزول عيسى آت لا شك فيه، كما يعلم أن آجال ذلك لا يعلمه إلا الله.
الثاني: أن التعبير عن المعلومة بالقول: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ (آل عمران: 7)، جعلت عددا من الدراسات القرآنية تذهب إلى القول بأن هناك آيات في القرآن الكريم، لا يعرف معناها من كل الوجوه إلا الله وحده، وهذا يتنافى مع تصريح القرآن من حيث كونه بيان، ومن حيث كون الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا لما يحتاج من البيان إلى البيان.
وقد رتب الطبري على هذا التقسيم الاستشهاد له بما روي عن ابن عباس: “التفسير على أربعة أوجه وجه تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر أحد بجهالته وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله”.
والشاهد في هذا السياق يجعل القارئ في حيرة من معنى التفسير والتأويل في قول ابن جرير، كما يجعله يؤكد موقفه من كون الوجه الرابع من التفسير لا يعلمه إلا الله على إطلاقه، مع أن هذا المنقول عن ابن عباس لم تحقق روايته بمنهج المحدثين.
النموذج السادس: من البرهان للزركشي، في مبحث: ما نزل من القرآن مكررا. قال معللا، تكرار المنزل “وقد ينزل الشيء مرتين تعظيما لشأنه وتذكيرا به عند حدوث سببه، خوف نسيانه، وهذا كما قيل في الفاتحة نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة”، والظاهر أن هذا التعليل لا يستقيم مع قول الله تعالى: ﴿سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى. إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ…﴾ (الأعلى: 7- 6).
فمع كون الفاتحة مما يحضر في كل ركعات الصلاة، والصلاة فرضت في مكة، تجد قولهم بتكرار النازل، ولعل الذي دفعهم إلى ذكر ذلك، كون آيات مدنية، تخللت سور مكية أو العكس.
قال الزركشي: والحكمة في هذا كله أنه قد يحدث سبب من سؤال أو حادثة، تقتضي نزول آية، وقد نزل قبل ذلك ما يتضمنها، فتؤدى تلك الآية بعينها تذكيرا لهم بها، وبأنها تتضمن هذه[16]. وفي هذا ما فيه من التحمل والتكلف.
ومن هذا الضرب ما عنون له صاحب البرهان، “بتقدم نزول الآية على الحكم”، ومثل له بقول الله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ (الأعلى: 14) فإنه يستدل بها على زكاة الفطر، بما رواه البيهقي بسنده عن ابن عمر، ومع أنه نقل عن بعضهم قوله: “لا أدري ما وجه هذا التأويل لأن هذه السورة مكية، ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة” فإنه ضرب صفحا عن هذا النقد، ورده بما قاله البغوي في تفسيره بأنه يجوز أن يكون النزول سابقا على الحكم[17].
وبنفس المنهاج استدل على نزول قوله تعالى: ﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ﴾ (القمر: 45)، في مكة. وتأخر حكمها إلى المدينة، قال: قال عمر بن الخطاب، كنت لا أدري أي الجمع يهزم، فلما كان يوم بدر، رأيت رسول الله، صلى الله عليه ويسلم، يقول: “سيهزم الجمع ويولون الدبر”[18]. مع أنه واضح من نظم الآية وسياقها، أنها تخبر عن مستقبل، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم، رددها مستشهدا ومخبرا بصدق ما أخبر به القرآن، “لا نزولا لها قبل الحكم”، وإنما أخبر بما سيحدث، ويشهد لهذا قولة عمر سابقا في الآية، وفي عدد من المباحث في البرهان من هذا النمط كثير. من مثل قول عدد من المفسرين وأصحاب أسباب النزول[19]، أن قوله تعالى: ﴿إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ﴾ (التوبة: 40). الآيات أنها مكية في سورة مدنية مع أن سبب النزول وسياقه ودلالة الآية في سياقها تدل على أن الآية مدنية في سورة مدنية[20].
النموذج السابع: ونأخذه من كتاب قواعد التفسير، لخالد السبت، باعتباره ممثلا لما نحن بصدده في هذه المرحلة المعاصرة، وذلك في صورتين مشابهتين لما عند الزركشي.
الصورة الأولى: قرر تحت عنوان “قاعدة: نزول القرآن تارة يكون مع تقرير الحكم، وتارة يكون قبله، والعكس”[21]. ومثل لما نزل قبل تقرير الحكم، بقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ (الأعلى: 14). وهو وإن علق بقوله وفيه نظر، فقد ساق ما ساق من نصوص شارحة للقاعدة نقلا عن الزركشي في البرهان وغيره، وأثبته جزء قاعدة في الباب.
الصورة الثانية: ما مثل به لقاعدة: “قد يكون سبب النزول واحدا”، والآيات النازلة متفرقة، والعكس”[22]. ومثل له بما أخرجه البخاري في قصة عويمر العجلاني الذي جاء إلى الرسول، صلى الله عليه وسلم، قائلا: “يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يصنع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله عليه القرآن فيك وفي صاحبتك”[23]. وبما أخرج البخاري أيضا “أن هلال ابن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم، بشريك بن سمحاء، فقال له النبي: البينة أو حد في ظهرك… فقال هلال: والذي بعثك بالحق، إني لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ…﴾ (النور: 6).
وصاحب قواعد التفسير هذا، وإن انتبه إلى إشكالية الصحة وعدمها في النقل، تحت قاعدة “إذا تعددت المرويات في سبب النزول، نظر إلى الثبوت، فاقتصر على الصحيح”[24]، فهو من جهة يقرر في سياق القاعدة، تكرار النزول، ومن جهة أخرى لم يوظف مبدأ الثبوت في قاعدة إنفراد السبب وتعدد النازل[25]. إذ جاء بروايات متعددة في سبب نزول قوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ (النساء: 32). دون أن يحقق الروايات أو يعلق عليها، بما يخرج المتلقي من حيرة شتات الفهم، وتضارب القواعد، أما قصة عويمر العجلاني فتدل على أن القرآن كان قد نزل سابقا في قصة هلال بن أمية ولم يكن جواب الرسول، صلى الله عليه وسلم، لعويمر إلا جواب فتوى وإصدار حكم.
وبعد، ففي علوم القرآن، جملة مباحث تحتاج إلى مراجعة على مستوى التصنيف وتوحيد المصطلحات، وتحديد المفاهيم وتصحيح المضامين، سعيا إلى بناء قواعد منهج البيان، وهو أمر لا يتم إلا بعمل جماعي متكامل من أهل الاختصاص يبدئ فيه لتحقيق المناط بين علم أصول التفسير وعلم أصول الفقه.
الهوامش
- انظر: أبجديات البحث في العلوم الشرعية للدكتور فريد الأنصاري 156، ومداخلة الدكتور الأنصاري أيضا في الدورة التدريبية للباحثين في التراث العربي الإسلامي (نحو منهجية للتعامل مع التراث ص: 172، فما بعدها).
- عدي عريا من ثيابه خلعا فهو عار وعريان سلم من الغيب ونزع عنه الثوب، وعداه من الأمر جرده وخلصه منه.
- مثل صنيع الأستاذ لطفي الصباغ في كتابيه: بحوث في أصول التفسير:16، ولمحات في علوم القرآن: 151،
ومثل النداءات المتكررة المكتوبة والشفهية للأستاذ الشاهد البوشيخي.
- انظر نموذج ذلك في كتاب أصول الفقه لأبي زهرة، ص: 7، وهو يعد من أئمة العصر في هذا المجال.
- انظر مقدمة الرسالة، ص: 19.
- نفسه.
- مثلا مباحث في علوم القرآن للقضان، ص: 85.
- للتوسع،انظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري،1/48، والملل والنحل لابن حزم، 2 / 77.
- انظر معجم مقاييس اللغة ولسان العرب، ومفردات الراغب، مادة بان…
- انظر الموافقات، 3 / 344.
- أنظر جامع البيان، 1 / 55.
- نفس المصدر، 1/57.
- نفس المصدر، 1/58.
- جامع البيان، 1/50.
- نفس المصدر، 1/47.
- البرهان للزركشي،1/31.
- نفسه.
- نفسه.
- بنوا هذا القول بمدنية ومكية آيات في سورة يعينها على [المعنى والقصد والسياق] البيان.
- أنظر أسباب النزول للواحدي، 141.
- أنظر قواعد التفسير، 1/58.
- قواعد التفسير للسبت، 1/65.
- صحيح البخاري، كتاب التفسير.
- قواعد التفسير للسبت، 1/69.
- نفس المرجع والصفحة.