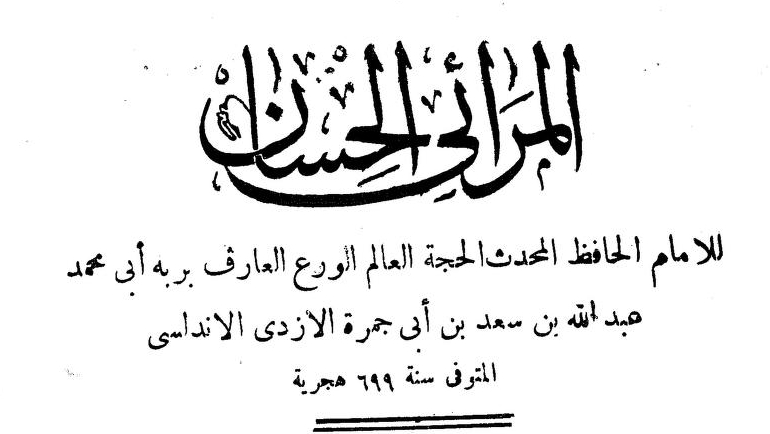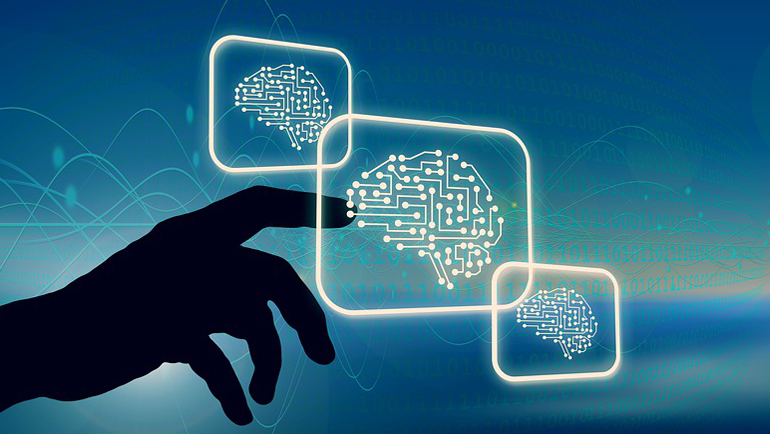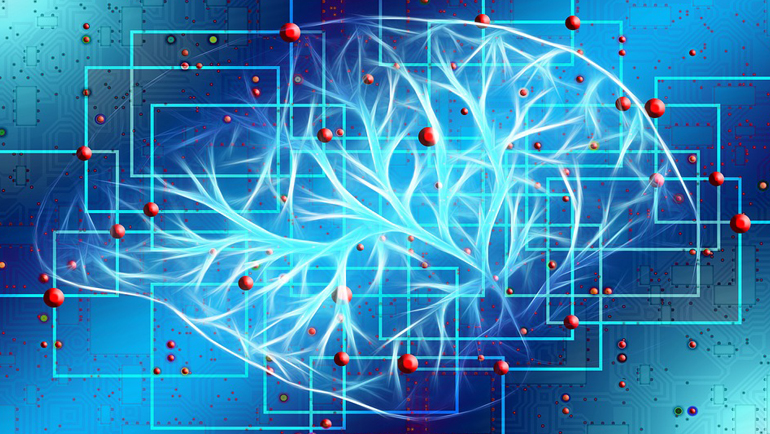![دور السياق في فهم (نص) ([1])الحكم الشرعي([2])](https://www.arrabita.ma/wp-content/uploads/2020/06/8F.jpg)
تمهيد
لعل المعنى الوحيد الذي يتبادر إلى الذهن عند ذكر عبارة «(نص) الحكم الشرعي» هو المعنى الاصطلاحي الذي يحصر دلالته في أحكام الأعمال (الشريعة) موضوع الفقه وأصوله فيميزه عن المعنى الأوسع الذي يشمل معها أحكام المعتقدات (العقيدة) موضوع الكلام وأصوله. فالحكم الشرعي بهذا المعنى الثاني يجمع بين أحكام العمل وأحكام النظر لأنه لا يستثنى التصديق والنظر عامة بل هو يشملهما شموله للفعل والعمل: ذلك أن المعتقد الديني تصور معين هو حكم المتصور وهو تصور مأمور أن يُصدق على ما يقتضيه حكمه وليس هو مجرد تصور مرسل([3]).
ويقتضي التناظر بين العمل والعلم في المنظور الفلسفي وبين الشرع والعقد في المنظور الديني أن يكون الكلام في العقد غير الكلام في أصوله (دين)؛ كون الكلام في العلم غير الكلام في أصوله (فلسفة) مثلما أن الشرع غير أصوله (دين)؛ كون القانون غير أصوله (فلسفة). فكيف نفهم ذلك؟ إذا كان علم أصول الفقه هو ما بعد علم الفقه فعلم أصول الكلام ينبغي أن يكون ما بعد علم الكلام بشرط ألا يبقى أي منهما مقصورا على المسألة المنهجية منهجية استخراج الأحكام الشرعية من النص بالنسبة إلى الأول، ومنهجية استخراج الأحكام العقدية من النص بالنسبة إلى الثاني. إنما علم أصول الفقه هو كما حددناه في حوارنا مع الشيخ البوطي([4]): علم نظرية الحق المجردة والمطبقة بشروط التنظير والتطبيق في مستوى تشريع الأحكام وتنفيذها، ومنهما مسألة المنهجية التي تستخرج الأحكام من موضوع العلم وما يتعلق به من نصوص تنـزيلا لها عليه. فيكون العلم بموضوع النص شرعيا من غير ذلك النص متقدما على العلم به منه لأن هذا النص هو نفسه من ضروب ظهور الموضوع العملي (الحقوق والواجبات) أو أحد تصوراته. ومعنى ذلك أن نص الشرع الإسلامي ليس إلا أحد مظاهر نص الشرع بذاته أو أحد تصوراته التي لا يفهم إلا بنظريته التي لا يمكن أن تستمد منه بل من العلم بالموضوع الذي يعتبر نصا أصليا يكون كل نص مجرد تصور بالقياس إليه([5]): لذالك كانت دعوة القرآن إلى النظر في النفس والآفاق لفهم آيات الله الكونية والخلقية (=وذلك هو النص المطلق) طريقا لإدراك أعماق الوحي (الذي هو النص المصور لهما في الرسالة) والهداية إلى الصراط المستقيم فيكون الإيمان بها اختيارا حرا لأنه على علم([6]).
وقياسا عليه يكون علم أصول الكلام علم نظرية الحقيقة المجردة والمطبقة بشروط التنظير والتطبيق في مستوى تشريع الأحكام وتنفيذها، ومنها مسألة المنهجية التي تستخرج الأحكام من موضوع العلم ومما يتعلق به من نصوص تنـزيلا لها عليه. فيكون علم أصول الكلام هو ما يقبل التحديد على النحو التالي: إنه علم نظرية الحقيقة المجردة والمطبقة بشروط التنظير والتطبيق في مستوى معرفة القوانين الوجودية وتطبيقاتها (نص المشيئة الكونية المطلق) ومنهما مسألة المنهجية التي تستخرج القوانين من موضوع العلم والنصوص المتعلقة به (النص المرسل المعبر عن النص الأصل) وتنـزيل القوانين عليه. فيكون العلم بموضوع النص من غير النص متقدما على العلم به من النص لأن النص نفسه هو أحد مظاهر الموضوع النظري في نص متعال على كل النصوص: وطلب طبيعة هذا النص الأصل هو هدف هذه المحاولة الرئيسي. ومعنى ذلك أن العقد الإسلامي ليس إلا أحد مظاهر العقد بذاته أو أحد المناظير إليه فلا يفهم إلا بنظرية المناظير العقدية المتقدمة على اختيار المنظار المفضل؛ إذ لا معنى للتفضيل من دون مفاضلة متقدمة عليه أساسها المقارنة المحتكمة إلى الأصل. وبهذا المعنى يكون الكلام تطبيق أصول الكلام لشرح العقد الإسلامي والدعوة إليه بوصفه أفضل عقد تماما، كما أن الفقه هو تطبيق أصول الفقه لشرح الشرع الإسلامي والدعوة إليه بوصفه أفضل شرع. فلا يمكن للمرء أن يزعم أن شيئا ما هو الأفضل إذا لم تتحقق شروط المقارنة بعلم متقدم على موضوعاتها التي ستقع مقارنتها للمفاضلة بينها.
وبهذا المعنى فإن الحكم الشرعي لا يقتصر على الفقه وأصوله بل هو يشمل العقيدة وأصولها؛ أعني موضوعي القرآن الكريم الأساسيين. فيكون الحكم دالا على معاني الحكم الشرعي كلها من حيث هو محدد للعقد والتصديق موضوع الاعتقاد الحر تحديده للعمل والتطبيق موضوع طاعة الاختيار. لذلك فنحن لن نأخذ صفة «الشرعي» في معنى النسبة إلى الشريعة من حيث هي قسيمة العقيدة بل في معنى النسبة إلى الشرع بمعناه الأعم المرادف للدين الذي يشمل عقد القلوب وعمل الجوارح. فيكون العنوان وكأنه يعني: دور السياق في فهم (نص) الحكم الديني ببعديه إيمانا وعملا.
والمعلوم أن الشريعة تتردد بين دلالتين؛ دلالة دنيا تقتصر على العمل الظاهر دون العقد الذي هو من السرائر التي يتولاها الله. وذلك هو معنى الفقه الظاهر. ودلالة عليا تشملهما. والعقيدة مثلها مثل الشريعة تتردد كذلك بين دلالتين؛ دلالة دنيا تقتصر على مجرد العقد دون علامته أو العمل الذي يمكن أن يكون دليلا على تمام الإيمان عند المطابقة مع العقد وألا يكون مطابقا له فيكون عند الله على عكس ظاهره عند الناس؛ إذ هو عندئذ رياء ومن ثم فهو دون مجرد العقد. وللعقد دلالة عليا تشمل الوجهين وذلك هو الإيمان التام.
والمعنى الأعلى في الحالتين يفيد أن كمال العقيدة هو التطابق بين العقد بالقلب والعمل بالجوارح، وكمال الشريعة هو التطابق بين عمل الجوارح وعقد القلب: واجتماعهما هو الدين التام من مدخل دلالة تلازم كمال العمل وكمال العقد. فيكون كلا الوجهين من الدين شاملا لكل الدين مع تقديم وتأخير لوجهي تحققه التام في حياة الإنسان أي الإيمان بالقلب والعمل بالجوارح. وبذلك فإن المطلوب هو محاولة تحديد الدور الذي يؤديه السياق في فهم أحكام الشرع بهذا المعنى؛ أي أحكام إيمان القلوب وأحكام عمل الجوارح: فيؤول الأمر إلى دور السياق في فهم القرآن والسنة مصدري الإيمان والعمل الدينيين عند المسلمين.
والقرآن والسنة هما مرجع كل الأحكام الشرعية بهذا المعنى الأعلى الذي يشمل العقيدة التامة والشريعة التامة أو الدين الكامل: ﴿… اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا﴾ (المائدة: 4). لكنهما يحيلان الإنسان على الموضوعات التي لهما بالنسبة إليها وظيفة المرجع الروحي المستند إلى العلم بالمرجع الوجودي رغم التطابق بين المرجعين([7]). لذلك كان أسلوب النص فيهما خبريا حكميا وليس خبريا تقريريا: فهما لا يقرران حقيقة متقدمة على الحكم. بل الحكم هو الذي يجعل المخبر عنه بالصفة التي يخبر بها عنه، وهي إذن تشريعات قيمية مشروطة بتشريعات وجودية متقدمة عليها([8]). فتصح لذلك المطابقة بين الدين والشرع؛ إذ إن الأمر يتعلق بـ السن الإلهي (وضع السنن) الذي يحدد أحكام وجوده تحديده لأحكام قيمته. وإذن فالأحكام نوعان كونية وأمرية([9]). والكونية ليست كلها مصحوبة بالأمرية ضرورة. لكن الأمرية تلازمها الكونية حتما: وهو ما يعني أن الحكم يشمل مفهوم قانون الحقائق من حيث هو كوني ومفهوم قانون الحقوق من حيث هو أمري. والحكم الكوني الذي هو موضوع العقد يتعلق بخلقات الأشياء والأفعال وما يتصل بها من تصورات وأحكام وجودية. والحكم الأمري الذي هو موضوع الشرع يتعلق بقيم الأشياء والأفعال وما يتصل بها من تصورات وأحكام قيمية.
وبهذا المعنى فإن كل النصوص القرآنية والسنية يتقدم فيها الإنشاء على الخبر إذا احتكمنا إلى فقه اللغة العادي: فلما تتكلم في أمر يكون القول إنشائيا بمعنى الأمر والنهي دون تمييز بين كونه عملا وشرعا أو نظرا وعقدا، ولا تكتفي بتقرير الحقوق أو الحقائق إذ هي تعليم لعلم وليست علما. وهي ليست تعليما لعلم الحقائق والحقوق إلا بمنطق تقديم النماذج والأمثلة لما ينبغي أن تكون عليه هذه الحقائق والحقوق لأن قصدها هو تربية الإنسان على طلب الحقائق والحقوق بنفسه فرض عين كما حددت ذلك سورة العصر فجعلته شرط الاستثناء من الخسر: ﴿والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين ءامنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر﴾.
وإذن فالقرآن والسنة لا يخبران بمعنى التقرير لحقائق متقدمة على إرادة المشرع للحقائق والحقوق أو بصورة مرسلة بل خبرهما منشئ للمخبر عنه وللخبر في آن بدليل أنه لا يصح فيه إلا التصديق ولا يقبل التكذيب: إنه من جنس المعطيات الوجودية التي لا معنى فيها للتكذيب إلا بمعنى تكذيب المرء لمداركه وليس لموضوعها. لذلك فلابد من حسم أمر يتلو عن هذه الحقيقة: لم التمييز إذن بين الأمرين إذا كانا كلاهما إنشائيا بهذا المعنى؟
وحتى نوضح هذه الفكرة فلنفرض أن أحدا صنع الوجود وله علم مطلق بقوانينه: ألا يكون في إخباره لنا بها وكأنه يضعنا أمام إنشاء مضاعف؟
فالفرع الأول من الإنشاء يقول: هو هذا الوجود بمجرد دعوتنا إلى الوجود الذي وضعه أمام مداركنا التي أهلت لإدراكه وتدعى في النص لإدراكه بشروط الإدراك السوي.
والفرع الثاني يقول: هو هذا نموذج علمه والعمل به في النص المخبر إخبارا تكليفيا وليس إخبارا مرسلا تكفي ملاحظته دون الالتزام بالأفضل الذي يقدمه.
لذلك فلا أحد من الفرعين بالمعروض للتصديق والتكذيب، بل للقبول أو عدم القبول؛ لأنهما معطيان من نفس جنس الإعطاء، وإن كانا من درجتين مختلفتين؛ لأن أولهما؛ يدعونا إلى العلم بالموجود الذي يعرض أمام مداركنا والثاني؛ يدعونا إلى العمل بما يقاس على النماذج التي يقترحها من المنشود. لكن إذا كان الأول مشرعا للحقائق وعلمها والثاني للحقوق والعمل بها فإن الفصل بين الفرعين يزول؛ لأن التشريع في الحالة الثانية ليس لعمل المشرع (الله الخالق بالمشيئة الكونية)، بل لعمل سيقوم به المشرع له (الإنسان العامل بأوامر المشيئة الأمرية) ومن ثم فهو حكم لعمل لم يحصل بعد، ولنقل للتقريب إنه تشريع للعالم المنشود وليس للعالم الموجود.
وعندما يقول ابن خلدون إنه «قل أن يخالف الأمر الوجودي الأمر الشرعي» فإنه يعني أن الأمر الوجودي في التاريخ هو أيضا من جنس المشيئة الأمرية؛ أي إنه لا يصبح من جنس المشيئة الكونية إلا بعد الوقوع والوقوع في كل الحالات يخضع لقوانين الحقائق وليس لقوانين الحقوق([10]). وإذن، فهذا التشريع الثاني فرعه النصي من المشرع (الله) وفرعه الفعلي من المشرع له (الإنسان) وإن كان لا يخرج عن إطار القوانين المنتسبة إلى المشيئة الكونية إذ لا شيء يحصل من دون نواميس كونية هي سنن المشيئة الكونية أو تشريعاتها الوجودية. والوسيط بين الأمرين كما هو بين من القرآن هو التاريخ: فله مقوم أول ينتسب إلى تشريع الحقائق ومقوم ثان ينتسب إلى تشريع الحقوق في شكلهما المتطابق عند النظر إلى الماضي والمنفصل عند النظر إلى المستقبل والمتدافع عند النظر إلى الحاضر وهو متدافع لتدافع الماضي والمستقبل فيه.
لابد، إذن، أن ندرس معاني دور السياق في ذاتها ثم بالقياس إلى معاني الحكم لنحدد العلاقة بينهما بإطلاق ثم بالإضافة إلى محددات الحكم لكي نصل إلى تحديد واضح لدور السياق في فهم النصين اللذين يترددان بين نوعي الأحكام الشرعية والعقدية. فتكون الخطة كالتالي:
- نظرية السياق الظاهر: أوجه العلاقة بين السياق والحكم إجمالا.
- نظرية الحكم عامة ونظرية الحكم القرآنية خاصة.
- نظرية السياق الباطن: أو البدائل من السياق الظاهر والمغنية عنه بنقل الخطاب من الظرفي إلى البنيوي.
- نظرية الأفق المبين أو السياق المطلق.
- الحكم الشرعي والحكم العقدي وسياقاهما.
المسألة الأولى: نظرية السياق الظاهر
السياق من التصورات الإضافية. فلا يمكن الكلام على السياق إلا بالإضافة إلى وحدة نصية([11]) معينة. ولهذه الوحدات درجات متعددة بين أدناها (أدنى الوحدات الدالة) وأقصاها (كل ما هو من صنع الإنسان). ويكون السياق محيطا بها سواء كان من جنسها (مقالا مثلها) أو من غير جنسها (مقاما). وهو دائما من الجنسين([12]). ولما كان السياق إضافيا ومحيطا بالمضاف إليه فإن حدود المضاف إليه هي التي تعين حدود السياق حدوده الملامسة للنص بالجوار والفاصلة بينه وبين السياق. وبذلك يتعدد السياق بتعدد الوحدات النصية مع تناظر تام يجعل عدتهما واحدة([13]).
ولما كان السياق ليس لا متناهيا لأنه مهما اتسع يبقى ذا تعين يوحده فإنه لا بد من حدود تحيط به من خارجه. فيكون الحد الأقصى للنص الإنساني دائما هو ما دون الحد الأخير الأقصى للسياق أعني الثقافة الإنسانية؛ وحينئذ يمكن القول إن النص والسياق يتطابقان: «السياق المطلق لأي نص إنساني هو الثقافة الإنسانية ككل أي المعلوم منها وهي النص المطلق كذلك». لذلك فهذا الحد يمثل الفارق الجوهري بين النص الإنساني المطابق لسياقه ومن ثم المنغلق على أفق محايث والنص الذي يمكن أن يكون ما بعد إنساني لأنه يحرر الإنسان من المحايثة الخانقة([14]): «فالأول تاريخي بمعنى الخضوع لسياق ثقافي والثاني ما بعد تاريخي؛ بمعنى خضوع كل السياق الثقافي إليه فيكون كل ما هو ممثلا للامتناهي الوجودي وراء متناهي الثقافي».
لن نتكلم على التصنيفات التقليدية للسياق إلا بعد أن نقدم التصنيف المرجح لدينا والذي حددناه بالاعتماد على نظرية تمكن من تجاوز تصور بيرس التثليثي([15]) لأبعاد الرمز تجاوزا ييسر فهم الدور الذي يؤديه السياق في فهم النص القرآني عامة وأحكامه خاصة. فإذا أخذنا الرمز من حيث هو وحدة وسميناه دليلا فإن دلالته تكون ذات وجهين:
- الأول؛ دلالة متجهة إلى مجموعة الظاهرات التي انتخب منها الرمز ليكون رامزا: الكلام الأشكال الأنغام…
- الثاني؛ دلالة متجهة إلى مجموعة الظاهرات التي لم يؤخذ منها الرمز بل أخذت منها الظاهرات المرموزة: مجموعة من باقي الظاهرات الطبيعية الظاهرات الإنسانية الظاهرات الرمزية نفسها عندما تكون هي بدورها مادة للكلام عليها.
وكلا الوجهين مضاعف ذلك أنه بين الأمرين نجد الوجه الدال من الرمز والوجه المدلول منه:
- فالوجه الدال من الرمز هو التشكيل الصوري الدال للمجموعة التي أخذ منها الرمز: نص لوحة أنغومة… وذلك هو الوجه الأول من فعل الترميز.
- والوجه المدلول من الرمز وهو التشكيل الصوري المدلول للمجموعة التي أخذ منها المرموز: نظرة منظر حالة عاطفية…
فيكون الحاصل مجموعتين مختلفتين تماما (1 و2) وهما مجموعة الظاهرات التي اختيرت لتكون رامزة ومجموعة الظاهرات التي اختيرت لتكون مرموزة وبينهما تشكيلان يتمثل الترميز في جعلهما متشاكلين (3 و4) إذ هما ثمرتا فعل الترميز أي ما ترمز به الظاهرات الرامزة وما يرمز له من الظاهرات المرموزة. لذلك كان كلاهما مضاعفا؛ أعني تشكيل عناصر الدال وتشكيل ما بينها من علاقات وتشكيل عناصر المدلول وتشكيل ما بينها من علاقات مع:
أ. اعتبار الموجود منها في العينة وما كان يمكن أن يوجد من عناصر المجموعة المستعملة أو المستعمل منها (مواد الترميز) وعدم المستعمل.
ب. واعتبار التشكيلات الممكنة والحاصلة (صورة الترميز) ([16]).
- ويوحد ذلك كله الوحدة الجامعة بين النص والسياق في الوضعية الدلالية التامة([17]) التي لا يمكن للإنسان أن يخرج منها لأنها هي عين عالمه الذي ليس فيه داخل وخارج وذهن وعين إلا بإضافة، وهو ما يمكن أن نطلق عليه اسم أفق الدلالة.
ومعنى ذلك أن المحيط المطلق الذي يحوي الإنسان هو عالمه الرمزي بروامزه ومرموزاته المتضايفة بإطلاق فيه هو أولا كجسد واع ثم في ثقافته ككيان رمزي بإطلاق ثقافته التي يحيا بها وفيها كما يحيا السمك في الماء وبه من حيث هي عينة من الثقافي الكلي؛ أعني تاريخ كل ما اكتسبه الإنسان من حيث هو إنسان إلى ما حبته به خلقته أو فطرته([18]). لكن الإنسان عندما يأخذ مجموعة محدودة من الرموز فإنه يمكن أن يتكلم على داخل وخارج وعلى نص وسياق وعلى رمز ومرموز غير رمزي ساكتا عن الأفق الموحد بين الأمرين لكأن سمكة تتصور نفسها في لحظة طيرانها عند القفز فوق الماء بأنها قابلة لأن تحيا من دونه وخارجه([19]).. فكيف تعمل هذه العناصر؟
أولا: كيف يعمل الوجه الدال من الرمز أعني التشكيل الصوري للمجموعة التي أخذ منها الرمز.
التشكيل الصوري للمجموعة الرامزة نوعان كلاهما مضاعف([20]):
- درجتا الاختيار والتأليف الأدنيان؛تشكيل لمادة العناصر وهو بدوره نوعان أعني اختيار ما حضر منها على أرضية كل عناصر ذلك الجنس من الرموز التي تؤدي هذه الوظيفة في تلك الحضارة وتحويلات العناصر المختارة الحاضرة في النص مثلا (وسنصطلح على تسمية ذلك بصورة عامة ودون حصر في الرمز اللساني بالمعجم والصرف).
- درجتا التأليف والاختيار الأقصيان؛ تشكيل للعلاقات الواصلة بين العناصر المشكلة وهو بدوره نوعان؛ أعني الاختيار بين التركيبات الممكنة وتركيب الحاصل منها فعلا بين العناصر المختارة (ولنسمه بنفس الاصطلاح العام أدبا ونظما). فيكون السياق بهذا المعنى نصيا من جنس النظام الرمزي المتكلم الناتئ عليه وذا درجات أربع يوحد بينها تراث الأمة من حيث هو رامز: السياق المعجمي والصرفي والسياق الأدبي والنظمي للدوال، وهو الثقافة في وجهها الدال ويغلب عليها الوجه المتعين رمزيا في التراث المادي.
ثانيا: كيف يعمل الوجه المدلول من الرمز أعني التشكيل الصوري للمجموعة التي أخذ منها المرموز.
التشكيل الصوري للمجموعة المرموزة نوعان كذلك وكلاهما مضاعف أيضا:
- تشكيل لصورة العناصر وهو بدوره نوعان؛ أعني صرف المدلولات ومعجم المدلولات.
- وتشكيل للعلاقات الواصلة بين العناصر المشكلة وهو بدوره مضاعف؛ أعني نظم المدلولات وأدب المدلولات.
وهنا، أيضا، يكون السياق نصيا من جنس النظام الرمزي الناشئ عليه، وذا درجات أربع يوحد بينها تراث الأمة من حيث هو مرموز: السياق الصرفي والمعجمي والنظمي والأدبي بمعناها العام وغير الخاص بالنص في معناه اللساني وهو الثقافة في وجهها المدلول ويغلب عليها الوجه المتعين في التراث اللامادي.
والحضارة المادية تحمل تشكيلات الدال أو التراث الرمزي المادي بالفعل كحصيلة لتشكيلات المدلول الذي هو التراث الرمزي اللامادي، وتستنبط التشكيلات الأخيرة من التشكيلات الأولى بوصفها علة لها فتكون التشكيلات المادية المعلول الدال على علته التي هي التشكيلات اللامادية. لكن في مستوى التعبير يمكن القول إن المدلولات معلولة للعلل بعكس مستوى الأمر المعبر عنه أعني فعل الإنسان. ولنضرب مثالين هما أكثر الأمثلة دلالة على هذه النظرية: الرسم والموسيقي.
المثال الأول: الرسم
من حيث الدال: الدال الرسمي وعناصره هي صرف الأشكال وعلاقات عناصره هي بنى الفضاء المادي (المكان) الممكنة للتأليف بين الأشكال (سواء كانت بغير الألوان وهي عندئذ أبسط أو ملونة فيتضاعف الأمران العناصر والفضاء؛ إذ بالإضافة إلى عناصر الشكل وفضائها تضاف عناصر اللون وفضائها؛ أعني التفازيح وضمنها النور والظل). والمعجم هنا هو الأشكال (والألوان) الممكنة بالمقابل مع الأشكال (والألوان) الحاصلة في اللوحة مثلا والأدب هو كل التأليفات الشكلية واللونية السابقة في المعلوم من تاريخ ذلك الفن.
من حيث المدلول: المدلول الرسمي وعناصره هي المعاني التي اصطلح المبدعون والنقاد على أدائها بتلك الأشكال وعلاقات العناصر المعنوية هي بنى فضاء الذوق الرسمي الممكنة للتأليف بين المعاني (بنفس المستويين الشكلي واللوني). والمعجم المعنوي هو المعاني الممكنة بالمقابل مع المعاني الحاصلة في اللوحة مثلا، والأدب هو كل التأليفات المعنوية السابقة في المعلوم من تاريخ تأويل ذلك الفن.
المثال الثاني: الموسيقى
من حيث الدال؛ الدال النغمي وعناصره هي النوتات وعلاقات عناصره هي بنى الفضاء المادي (الزمان) الممكنة للتأليف بين الأنغام (سواء كانت من دون كلام أو مع الكلام وهو ما يضاعف الأمرين). والمعجم هنا هو الأنغام (والكلمات) الممكنة بالمقابل مع الأنغام (والكلمات) الحاصلة في الأنغومة (السمفونية)، مثلا، والأدب هو كل الأناغيم السابقة في المعلوم من تاريخ الفن.
من حيث المدلول؛ المدلول النغمي وعناصره هي المعاني التي اصطلح المبدعون والنقاد على أدائها بتلك الأنغام وعلاقات المعاني هي بنى فضاء الذوق الموسيقي الممكنة للتأليف بين المعاني (بنفس المستويين الصوتي والكلامي). والمعجم المعنوي هو المعاني الممكنة بالمقابل مع الحاصلة في الأنغومة، مثلا، والأدب هو كل التأليفات المعنوية السابقة في المعلوم من تاريخ تأويل ذلك الفن.
3. المفتاح المطلق: والتشاكل بين هذين الوجهين هو المحدد الحقيقي للدلالة والتفاهم بالكتاب المرتل جمعا للرسم والموسيقى في ثمرتهما الرئيسية أي النص الناطق الذي يؤصل تاريخ شعب وهويته الروحية في تربة بعد التاريخ لأنه هو عين الدلالة الحية التي بالقياس إليها يؤول الوجهان أحدهما بالآخر؛ إذ لا معنى للرموز إلا بما لها من دلالة حية في هذا الوسط الفعلي الذي يمثل شبكة التأويل الحية وأفقه ومن دونهما لا وجود للتفاهم بين أبناء ثقافة واحدة فضلا عنه بين البشر من ثقافات مختلفة. وهذا يقال على كل النصوص المقدسة حتى تلك التي ليست وحيا منـزلا: فأساطير الشعوب البدائية لها هذه الوظيفة وظيفة الكتاب المرتل حتى وإن كان غير مكتوب في كتاب بالمعنى الاصطلاحي، بل هو مكتوب في كتبهم الحية التي هي ذاكرة الكواهن (النساء) أو الكهنة (الرجال) الذي يحفظون الأساطير ويربون بها وعليها أجيال تلك الأمة.
4. وهذا التشاكل هو عين العقل أو الإدراك أو الوعي([21]): ولولاه لما أمكن أن «نقرأ» العالم فضلا عن تراث الثقافات القديمة التي انقرضت الأقوام الذين عاشوها: ننطلق من عناصر الدال وتشكيلها لنفرض عناصر المدلول وتشكيلها فنفهم الحضارات الغابرة. ونفس الشيء نفعله مع العالم: نقسم عوارضه إلى عناصر وعلاقات بينها ثم نفترض تشكيلا لها في فضائين هما الزمان والمكان ونعتبر ذلك التشكيل دالا على قوانينها فيصبح بوسعنا فهمها والتعامل معها. وهذا هو المعنى المطلق لمفهوم الآية: إذا لم نتصور العالم نصا فإننا لا يمكن أن نقرأه فنكتشف معناه ونبدع قوانينه التي حدد القرآن طبيعتها الرياضية.
5. دلالة «وعلم آدم الأسماء كلها»: ولولا هذا المفتاح لما أمكن للإنسان أن يفهم معنى الآية فيقرأ أمر الله، وقراءة أمر الله هي التي تعطينا الأفق المبين الذي يتعين عند الإنسان بالقدرة على فهم وجهي كُنْ الخالقة والمشرعة؛ أي الآيات الكونية والآيات الشرعية. وفهم الآيات الأولى وإبداع قوانينها هو شرط استعمار الإنسان في الأرض (علوم الطبيعة غايات وأدوات) وفهم الآيات الثانية وإبداع قوانينها هو شرط استخلافه فيها (علوم التاريخ غايات وأدوات). والمعلوم أن ابن خلدون حاول إبداع قوانين الآيات الثانية لكنه لم يجد الأدوات التي كان ينبغي أن تكون قد وفرتها قوانين الآيات الأولى بمقتضي أوامر القرآن.
فإذا كان العالم مكتوبا بقوانين رياضية وكان الاستخلاف مشروطا بالاستعمار وشارطا لشكله الأفضل أعني إرث الصالحين للأرض لرعايتها بمقتضى شرع الله بات من الواجب أن تكون العلاقة بين قوانينهما من نفس الجنس. ومعنى ذلك أن علم قوانين الاستخلاف (مطلوب ابن خلدون الثاني في المقدمة: أعني بعدي صورة العمران أي الدولة والتربية) مشروط بعلم قوانين الاستعمار (مطلوب ابن خلدون الأول في المقدمة: أعني بعدي مادة العمران: أي الاقتصاد والثقافة) تماما كما أن الاستخلاف مشروط بالاستعمار، وشكل الاستعمار الأفضل مشروط بشكل الاستخلاف الأفضل.
لذلك فالتشارط بين الأمرين وبين علميهما بين بنفسه لكل ذي عقل، وهو أصل الاكتشاف الخلدوني الذي يحير العقول (للظن أن شروطه لم تكن حاصلة في الثقافة العربية الإسلامية اقتصارا على وجهها التاريخي والفلسفي) رغم أن علامته شاهدة أعني التلازم بين كل حقيقة يثبتها ونص قرآني يأتي به شاهدا على تلك الحقيقة. وقد أول البعض هذا الحضور القرآني بكونه مجرد تبرك حسن ظن بابن خلدون، وأوّله من أساء به الظن بأنه تقية يخفي بها تصوره المادي الجدلي المزعوم للتاريخ: فعندما يبحث ابن خلدون في علم الديموغرافيا وعلم الاقتصاد أصولا لعلم العمران نرى بوضوح امتناع تحقيق ما يطلب لغياب العلوم الرياضية المساعدة فيكتفي بعموميات لم يكن بالوسع أن تثمر في غياب الفكر النظري الذي يذهب إلى الغايات في متوالية الشروط المؤسسة لأي علم.
ولنعد الآن إلى التصنيفات التقليدية بعد أن فهمنا التصنيف الأساسي الذي سنستعمله لنفهم هذه التصنيفات ونفهم لما هي ما هي مع إضافة ما يحررها من محدوديتها التي تحول دونها والمساعدة على فهم دور السياق في فهم النصوص سواء كانت عادية أو مقدسة. ولولا قصد الإضافة بوحي مما يمكن أن يوجه إليه النص القرآني انتباه الباحث من سبل غير مطروقة وقادرة على الكشف عن أمور بكر لكان هذا العمل فاقدا لكل معنى؛ إذ يكفي عندئذ عرض النظريات السائدة وكفى المؤمنين شر القتال:
تصنيف السياقات بالإضافة الحيزية إلى النص: الداخل والخارج
أولا: السياق الداخلي ويكون وحدة العناصر الأربعة التالية:
- نصيا: أ. نصا فعليا وهو المبيضة ومسوداتها مهما تعددت.
ب. نص افتراضي هو كل ما استثنته المبيضة ومسوداتها من بدائل مهما تعددت ولنسم هذا النص الافتراضي أفق تحرير الدال.
- غير نصي: أ. ما يتعلق به النص أو موضوعه.
ب. ما له صلة بموضوع النص واستثناه النص ولنسم ذلك بأفق تحرير المدلول.
ثانيا: السياق الخارجي ويكون وحدة العناصر الأربعة التالية:
- نصيا: أ. النصوص الشارطة للنص الذي نطلب سياقه.
ب. والنصوص المشروطة فيه.
- 2. غير نصي: أ. شوارط موضوع النص.
ب. ومشروطاته وكلاهما من جنس ما موضوع النص ضرورة.
ثالثا: الوحدة السياقية: هي الوحدة التي تتألف من العناصر الأربعة التالية:
- بمقتضى حديها:
أ. في غاية النص أو الوحدة الدلالية الأقصى وهي الطبيعة وما بعدها.
ب. وفي بداية النص أو الوحدة التداولية الأقصى وهي التاريخ وما بعده([22]).
- بمقتضى وجهيها:
أ. الطبيعة والتاريخ هما الوجه الفعلي من الوحدة.
ب. وما بعد الطبيعة وما بعد التاريخ هما الوجه الافتراضي منها ([23])وهما مصدر الذي تنسبه الحضارات إلى نصوصها المقدسة.
تصنيف السياقات بحسب طبيعتها النصية وغير النصية
1. السياق النصي وهو لا متناهي الدرجات رغم تميز الدرجات الأربع التي هو خامسها؛ لأنه أصلها ومبدأ وحدتها:
أ. الداخلي؛ هو كل درجات وحدة النص من أدناها وقد يكون المفردة إلى آخر مستوى من مستويات جنسه الأدبي.
ب. الخارجي؛ هو كل درجات وحدة النص إلى آخر مستوى الأجناس الشارطة والمشروطة في ذلك الجنس الأدبي وهو ما يمتد إلى كل الثقافة.
2.السياق غير النصي وهو لا متناهي الدرجات رغم تميز الدرجات الأربع التي هو خامسها لأنه أصلها ومبدأ وحدتها:
أ. الداخلي، هو كل درجات وحدة المجال موضوع النص من أدناها وقد يكون لمحة إدراكية واحدة أو معطى حسيا واحدا إلى آخر مستوى من مستويات المجال الذي يمثل موضوع مدركات الفن.
ب. الخارجي، هو كل درجات وحدة مجال النص إلى آخر مستوى مجالات الفنون الشارطة والمشروطة وهو ما يمتد إلى كل الطبيعة.
ملاحظة: كل هذه الأنواع من السياقات لدرجاته مستويات خمسة بحسب الأحياز التي هي المحدد اللازم فيها جميعا:
- المستوى المكاني البعد والقرب من مكان النص ومكان ما يتعلق به: الجغرافيا الثقافية.
- ثم المستوى الزماني بنفس المعنى: التاريخ الثقافي.
- ثم المستوى السلمي بنفس المعنى: السلم الثقافي.
- ثم المستوى الدوري بنفس المعنى: التشابك بين الفنون والاختصاصات في الثقافة.
- وأخيرا المستوى الوجودي بنفس المعنى: المنظور الوجودي العام في الثقافة التي ينتسب إليها النص.
لكن تأثير ما يؤثر من السياق يخضع إلى قانون برقلس في تأثير المبادئ (انظر كتابه: الأصول الربوبية Eléments théologiques) بمقتضى سلم فاعلية العموم والخصوص. فالأبعد من المبادئ هو في الحالتين الأقوى تأثيرا لوجود أثره بذاته ثم لوجود أثره في كل ما يتوسط بينه وبين النص تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى الظاهرات الطبيعية والعضوية. فما هو مؤثر فيها يزداد أثره بذاته المتقدمة وبحضوره في كل ما بينه وبين ما يتأثر به. وبهذا المعنى يكون فعل الأصل متصلا في الفروع مهما توالت رتبها؛ فيكون الجيل الأخير منها أكثر تأثرا بالجيل الأول من كل الأجيال التي تفصله عنه بخلاف ما يراه بادئ الرأي لأن تأثيره يتضاعف بعدة الأجيال كلما ابتعد الفرع عن الأصل في هذه الأحياز الخمسة: ومعنى ذلك أنه بخلاف المعتقدات السائدة نحن أكثر إسلاما من الأجيال المتقدمة علينا وعندما لا يكون ذلك صحيحا فعلته انقطاع فعل التأثير إما بسبب تدخل فعل بديل حال دونه من خلال إيقاف عملية التربية على قيم الإسلام.
فلا شيء مما يؤثر يزول أثره لكأن التأثير من جنس سجل أعمال الإنسان الذي يصفه القرآن. ولعل أهم عناصر نسيج النص القرآني هو هذه الحقيقة: فالقصص القرآني تذكير بالطبقات التكوينية الروحية المتراكمة ومن ثم فهي نسيج التكاثف المتدرج لأثر الأصل من بداية الذاكرة إلى غايتها. فلا شيء يغيب عنه لكأنه نسخة مطابقة لكل ما يجري تصورها كاميرا كونية ليست محصورة بزاوية نظر خارج ما يجري، بل ما يجري هو نفسه زاوية النظر لما يجري فتكون النسخة (الكتاب الذي يعرض يوم النشر) ذاكرة كونية لا يعزب عن بالها حتى وإن غفلنا عما لا يتناهى منها لضيق مساحة الوعي؛ أي إن ما يؤثر من الشعر الجاهلي في الشعر العربي الحالي مثلا أقوى مما يؤثر فيه من الشعر الحالي إذا كان شعرا عربيا مهما ادعى صاحبه من قطيعة مع الماضي.
المسألة الثانية: نظرية الحكم عامة ونظرية الحكم القرآنية خاصة
نظرية الحكم
- المعنى الأول؛ هو فعل الحكم المعرفي: فعل حي لملكة تقضي في الأشياء قضاء مطلقا بإثبات الوجود أو نفيه، أو قضاء نسبيا بإثبات صفة لموجود أو معدوم أو نفيها عنها. وإذن فهو مؤلف من جزم مثبت أو ناف لحال في موضوع الحكم تفترض لا مثبته ولا منفيه، بل مرسلة وكأنها مقترحة للحكم لها أو عليها بالسلب أو بالإيجاب. ويمكن أن نصطلح على حال الموضوع الذي يتعلق به الحكم فنسميها الموضوعة Proposition. أما الحكم Jugement بإثباتها أو بنفيها فهو الجزء الثاني مما يسمى عادة قضية لأن القضية تشمل الأمرين:
أ. الموضوعة على حالها من دون حكم بالسلب ولا بالإيجاب، وكان ينبغي أن نقول «العارضة» لأننا نتصورها أمرا يعرض بذاته أمام ناظري العقل ليحكم فيها.
ب. والحكم إيجابا أو سلبا حكما يقر ما يتصور العقل أنه واجده في العارضة فيقضي فيه بما يتصوره مطابقا لما فيها دون زيادة ولا نقصان إذا كان علما (ويمكن لهذا الحكم أن يكون ظنا أو رجما = درجات الموقف القضوي).
فالقضية اسم مرة من فعل قضى الذي يفترض أمرا متقدما عليه يقضى فيه فيكون الحكم اسما مختزلا يجمع بين موضوع القضاء وفعل القضاء جزما بالإثبات أو النفي. والموضوعة أو العارضة تفرض على حال موجودة قبل الحكم وبصرف النظر عنه وتفرض هذه الحال حالا لا تكون إلا ما هي عليه لمطابقتها الأشياء في ذاتها قبل الحكم فيها حتى يكون للجزم المثبت أو النافي معنى لأنه يفرض مضافا إليها وتاليا عنها. ولولا ذلك لما اعتبرت المطابقة معها علامة الصدق وعدم المطابقة علامة الكذب. والموضوعة هي إذن تأليف معين لأحوال أمر ما أو بين أحوال ما للموجودات خارج الذهن دون أن تكون ذات قيام في العين فتكون عالما موازيا للعالم المحسوس. إنها، إذن، تنتسب إلى عالم وسط بين عالمي العين والذهن لعله عالم عقلي مفترض شرطا للعلم الإنساني من وجهين: من وجه خضوع عالم العين للقوانين ومن وجه احتكام عالم الذهن لعالم القوانين.
ولسنا ندري من أين أتى هذا الفرض الفلسفي اللهم إلا إذا كان بوعي أو بغير وعي مبنيا على القول بالعلم السابق في العقل الإلهي في الأديان (ما يسميه ابن سينا بالعناية)؛ إذ حتى عالم المثل الأفلاطوني فهو ديني عند أفلاطون. فكل ما نعلمه، إذن، هو أن هذا العالم المشروط في المعرفة الإنسانية الفلسفية شكلا ومضمونا يشبه عالم اللوح المحفوظ في التصور الديني لشروط المعرفة والوجود. والفرق الوحيد أن نظرية اللوح المحفوظ الدينية تتضمن وجهين يجعلانها غير متناقضة بخلاف نظرية عالم المعقولات الفلسفية:
الأول: أنها تسلم بأنها عقيدة في حقيقة وليست معرفة بحقيقة قابلة للإثبات بالدليل العقلي لكونها شرط العقل نفسه.
والثاني: أنها لا تردها إلى علمها المتناهي بل تميز فيها بين ما ينتسب إلى الشهادة وما ينتسب إلى الغيب.
ولذلك فهي تضع وسيطا بين الوجهين هو النبوة التي ليس من وظائفها الاطلاع على الغيب بل التنبيه إلى وجوب احترام هذه القسمة لتحرير الإنسان من التجبر مصدر كل طغيان، وذلك هو الكفران الذي يحرر منه الإيمان([24]). ولما كان الخروج من عالم الذهن إلى عالم العين لا يتم إلا بتوسط العالم الوسيط بينهما والحكم عليهما فإننا ينبغي أن نسأل عن طريق الولوج إلى هذا العالم في المعرفة الفلسفية ما هو بالقياس إلى طريق الولوج السلبية إليه في المعرفة الدينية أعني الوحي (انظر الهامش السابق)؟ لابد إذن أن يكون للإنسان فوق العقل المستمد من التجربة أعني من المطابقة مع ما في العين عقل متقدم عليه وعلى ما في العين يحتكم إليه للتمكن من تجاوز خدع ما في العين وما في الذهن؛ أي عقل من جنس شبيه بالوحي قد نسميه بالحدس العقلي أو التلقي عن عالم المعقولات ذي الشبه مع اللوح المحفوظ الديني، حتى وإن كان التلقي يتم بتوسط طرائق المعرفة الإنسانية العادية.
وبيّن أنه لا يمكن للتجربة أن تكون هي الحكم الوحيد؛ لأن التطابق الجزئي بين ما في الذهن وما في العين يبقى مهما تراكم تطابقا جزئيا فلا يكون كافيا لإعطائنا قوانين كلية وضرورية، بل هو يعطينا وصفات أو قواعد ظرفية وآنية. فمن أين لنا بالقوانين الكلية والعامة التي لا نعتقد أنها مجرد علم شرطي، بل هي عين القدرة على الشرط وغيره في العقل الإنساني؟ كيف لنا بما يشبه القضاء والقدر شرطا للمعرفة العلمية أي تصور العالم وكأنه عمل على خطة (قضاء) ذات نظام مقدر (قدر) بحيث تكون النسب المقدارية فيه هي القوانين والنظام الموحد بينها هو المشروع أو الخطة أي القضاء فلا يكون العلم الإنساني الذي هو خبر عن حال متقدمة عليه مشروطا بعلم قبلي يكون إنشاءً لحال متأخرة عنه هي الحال المتقدمة على العلم الإنساني بمعناه البعدي؟
ولا يتأسس العلم إلا عندما يتصرف الإنسان بالقياس إلى هذا التصور فيكون فيهما مؤمنا بالعلم المتقدم شرطا في العلم المتأخر أو مدعيا أنه صاحب العلمين: وهو في هذه الحالة الثانية يفترض نفسه صاحب القضاء والقدر فيفترض نظاما من القوانين يصنع بواسطته عالما من الرموز المحاكية لصورة فرضية من العالم الذي يتصوره موجودا حقا وراء العالم الذي في العين ليكون ما في العين قابلا للعلم وللعمل فيه على علم. ومن دون ذلك يكون العلم الإنساني بل والعالم الإنساني كله مجرد أحلام فلا يتعدى خدعة الشيطان الديكارتي الماكر. وعالم الشهادة في القرآن من دون هذا الإيمان بما وراءه شرطا لقيامه وعلة لقيمته يعتبر عالم الشيطان الماكر: لعب ولهو.
- المعنى الثاني؛ هو ثمرة فعل الحكم: ثمرة الفعل الحي وتبرز الوظيفتين الحدين الوظيفة النظرية (نسب المعاني) والوظيفة العملية (نسب القيم).
فأما نسب المعاني فيمكن تصنيف فعل الحكم فيها بصورة غير مسبوقة على النحو التالي. بيّنا أن التمييز بين أبعاد علم اللسان الثلاثة ليست مفيدة ما لم تفهم بصورة تضاعف علم علاقة الرموز بعضها بالبعض لينقسم إلى فرع تابع إلى علم علاقة الرموز بالمرموز وعلم علاقة الرموز بالرامز: فما يجريه الإنسان من تشكيل على الرموز مادتها (الصرف) وصورتها (النحو) ينقسم إلى ما يفيد أمورا حول المرموز أو الموضوع، وإلى ما يفيد أمورا حول الرامز أو الذات. والأمور الأولى يحتكم فيها إلى مرجع المدلول والأمور الثانية يحتكم فيها إلى مرجع الدال. فيكون لدينا أمران هما وجها التشبيك من حيث كيفية حصول الفعل ومن حيث ثمرته:
أ. التشبيك الحاصل بين عناصر الدال.
ب. وما ظهر من الحال التي كان عليها المشبك خلال قيامه بفعل التشبيك.
والأول هو العامل المفيد في فهم الدلالة لإفادته حول الموضوع المرموز والثاني هو العامل المفيد في فهم التداول لإفادته حول الذات الرامزة.
وسنبين مقومات كلا الوجهين عند الكلام في نظرية السياق بمقتضى ما ينتج عن هذا التصنيف الجديد لعلم علاقة الرموز بعضها بالبعض: الخيار المعجمي والصرفي والنحوي والأدبي في علمية التشبيك المناظر لما يراد إفادته من الموضوع ودلالة الاختيار المعجمي والصرفي والنحوي والأدبي على ما يمكن أن تكون حال المشبك قد كانت عليه في فعل التشبيك. وإذا كانت عناصر المستويات المعجمي والصرفي والنحوي والأدبي الدالة على ما يراد إفادته حول الموضوع معلومة بعض الشيء فإن عناصرها الدالة على ما يفاد حول الذات ليست محددة بدقة.
وهي تشبه كل ما يدل على أحوال الذات أحوالها المصاحبة لأفعالها: فهي في الأغلب من اللاواعي من السلوك وتظهر في كيفيات أداء فعل التواصل وليس في ما فيه من عوامل مقصودة. ويمكن أن نطلق عليها الوجوه البلاغية لكيفيات أداء الخطاب: مثل النبرة والنغمة والنظم الدال على حال المتكلم وليس على خاصيات موضوع الكلام.
فهل يمكن أن نجد توازيا مع المستويات الأربعة التي وصفنا: ما يناظر المستوى المعجمي وما يناظر المستوى الصرفي وما يناظر المستوى النحوي وما يناظر المستوى الأدبي؟
وتشبيك عناصر الدال يفيد بتناظره مع تشبيك عناصر المدلول: وهذا التناظر هو أداة الدلالة التي يمكن أن تكون دالة إما على ما أراد المشبك إفادته وهو المعنى الأول أو على معنى هذا المعنى أي معنى ما أراد المشبك إفادته من حيث فهم المشبك. فيكون للتناظر معنى دلالي في توجهه إلى الموضوع المشبك ومعنى تداولي في توجهه إلى الذات المشبكة. وقياسا على نسب الدلالة والتداول في المعاني النظرية ينبغي أن توجد نفس آلية الإفادة بالتشاكل التشبيكي لأداء المعاني المتعلقة بكل أصناف القيم الأخرى؛ أي القيم الذوقية والرزقية والعملية والوجودية.
- المعنى الثالث؛ هو تطبيق الأمرين السابقين في مجال المعرفة الدينية والمعرفة الدنيوية: فعل حي في ثمرته ينتج وظيفتين مركبتين من الوظيفتين هما تطبيق الحد النظري على المجال العملي وتطبيق الحد العملي في المجال النظري وهما المشار إليهما في القرآن الكريم الآية: 79 من سورة ءال عمران قوله عز وجل: ﴿بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ﴾. فأثر الوظيفة النظرية في الوظيفة العملية هو الحكم الجمالي وهو من أهم مقومات المعرفة الدينية. وأثر الوظيفة العملية في الوظيفة النظرية هو الحكم الغائي وهو مثل الحكم الجمالي من أهم مقومات المعرفة الدينية. ثم الوظيفة المطلقة أو الإبداع بإطلاق: «كن المشروطة في كل حكم لأنها تضع موضوع الحكم نفسه بحكم متعد إلى الإيجاد في العين وليس مجرد إثبات الوجود في الذهن أو في قول الحكم». وهذه الأصناف الثلاثة تمثل القاعدة الخفية لكل معرفة دنيوية مؤثرة؛ أي إن المعرفة الدنيوية لا تكون مؤثرة إلا بمماثلة خفية بين فعل الإنسان الخالق للرموز وفعل الله الخالق للمرموزات وراء الرموز.
وهذه المماثلة إذا كان صاحبها مؤمنا تكون شهادة لله وقياما له وهي يكون صاحبها شيطانيا إذا تصور نفسه بديلا من الله وليس محاكيا له قدر المستطاع كما كلف إذ دعي للوجود والحياة والعلم والقدرة والإرادة بالشروط التي تحددها الرسالة: «كفرانا بالطاغوت وإيمانا بالله» (راجع سورة البقرة؛ الآية: 256).
- المعنى الرابع؛ هو تحديد آلية فعل المعرفة الدينية: لذلك وضع القرآن الكريم ملكة الحكم بين أمرين في نفس الآية: «فهي الوسيط بين الكتاب رمزا للوح المحفوظ، والنبوة رمزا للتلقي منه أي بين مصدر العلم وأمانة تبليغ العلم». فعندما تلتفت إلى المصدر تكون ملكة فهم وإدراك فيكون الحكم العملي شرط الحكم النظري وعندما تلتفت إلى التبليغ تصبح بالإضافة إلى ذلك ملكة درس وتعليم ويصبح الحكم النظري شرط الحكم العملي.
- المعنى الأخير؛ هو الحاكمية الإلهية: إن الحكم إلا لله + ألا له الحكم: إدراك الحكم عبودية الحاكم لله وحده شرطا لسلامة المعاني الأربع أو كونه ربانيا وهو مدلول الآية 79 من سورة ءال عمران. وهو في حكم الحقيقة شهادة للمشيئة الكونية أي إدراك يتوخى الصدق لما يتلقاه من قوانين الوجود أو مجاري عاداته أو سننه الكونية وفي هذه الحالة يكون حكم النظر تابعا لحكم الذوق وفي حكم الحق شهادة للمشيئة الأمرية أي إرادة تتوخى الصدق في ما تتلقاه من قوانين القيم، أي نماذجه ومثله أو سننه الأمرية، وفي هذه الحالة يكون حكم العمل تابعا لحكم الرزق. لكن أصناف الحكم كلها تابعة لحكم الوجود الذي رمزت له سورة يوسف برؤية برهان الرب.
محددات الحكم
أولا: أصناف الحكم بحسب مجالاته
يمكن عقلا أن نحدد مجالات الحكم بخلاف ما جرت عليه العادة الفلسفية فلا نقتصر على المجالات الثلاثة المعهودة بل نتعداها إلى مجالين آخرين هما شرطها وشرط شرطها. فلا يمكن للإنسان أن يميز بين الخير والشر وبين الجمال والقبح وبين الصدق والكذب لو كان عقله ليست له القدرة على التحرر من الفعل المضطر؛ إذ هو من دون ذلك كان فعله سيكون من جنس فعل المرآة ليس لها إلا أن تعكس الموجود، ومن ثم فهي لا تصدق ولا تكذب بل تعكس لا غير. وليس يمكن للإنسان أن يتحرر من شلال الضرورة لو كان حاصل وجوده هو واجبه: المسافة الفاصلة بين الحاصل والواجب علتها أنه مشدود إلى ما يتعالى عليه أو شاهد للمطلق. فيكون الشرط هو التمييز بين الحر والمضطر وشرط الشرط هو التمييز بين الشهود والجحود. وبذلك تصبح مجالات التقويم خمسة لا ثلاثة:
- الذوقي (جميل قبيح).
- والرزقي (خير شر)
- والنظري (صدق كذب).
- والعملي (حر مضطر).
- والوجودي (شهود جحود).
والتحديد النقلي وضعه القرآن الكريم في سورة يوسف التي وضعت نظرية التقويم التي يدور حولها كل الوجود الإنساني فأشارت إلى ما ينتج عن خروج الرسول من الغفلة بفضل علمه الذي جاءته به آيات الكتاب المبين في شكل أحسن القصص:
- فالتقويم الذوقي بيِّن من قضية جمال يوسف والحب في الأسرة وبين المرأة والرجل.
- والتقويم الرزقي بيّن من قضية رحلة الأخوة ورؤيا الفرعون والتبادل في مصر.
- والتقويم النظري بيّن من تأويل الأحلام وتوقع المستقبل.
- والتقويم العملي بيّن من وزارة يوسف.
- والتقويم الوجودي بيّن من برهان رب يوسف؛ البرهان الذي لولاه لكان يوسف مثل أي غافل عنه قد استجاب لدواعي الفتنة فلم يكن التقويم سويا فيها جميعا. وما يعني أن التقويم الوجودي هو أصل كل التقويمات الأخرى.
وإذن، فقد تبين عقلا ونقلا أن الحكم من حيث هو فعل حي تقويم بالأساس وهو من ثم ينقسم إلى خمسة أصناف تفرضها مجالات الفعل: فهو حكم ذوقي وحكم رزقي وحكم نظري وحكم عملي وحكم وجودي دائما. لكن كل واحد من هذه الأبعاد يكون الغالب فيه طابعه الذاتي إذا كان هو المقصود فتكون نسبته إلى الأبعاد الأربعة الأخرى كنسبة الصورة إلى أرضيتها: «وليكن مثالنا الحكم الذوقي ففيه يكون المقوم الذاتي هو الذوق، لكن الأبعاد الأخرى حاضرة أرضية له؛ لأن جميع الأبعاد موجودة في كل حكم وقس عليه بقية الأنواع». وهذا ما عاشه الصدر الأول في حياة الرسول. عاشوه من حيث هي نص حدث (القرآن) وحدث نص (السنة).
ثانيا: مقومات فعل الحكم
تنقسم مقومات الفعل التي لا يخلو منها حكم إلى العناصر التالية:
1.لابد في الحكم مما سنصطلح على تسميته بالقضاء لأنه قرار يترجم عن إرادة، ومن ثم فهو فعل يعبر عن الحياة والإرادة اللتين تمثلان مقومي مادة الحكم: ولنسم ذلك بوجه الحكم الوجداني ومنه يأتي تحديد جهة الموضوعة بفضل الإدراك المحدد لمجال الحكم هل هو: 1. ذوقي (حياة) أو روحي (إرادة) فيلزم موقف الذات الوجودي بإطلاق لصلتها بغايات الوجود الإنساني 2. أم هو رزقي (قدرة) أو زماني (علم) فيلزم موقفها بإضافة لصلتها بأدوات الوجود الإنساني.
2. ولابد في الحكم مما سنصطلح على تسميته بالقدر لأنه تعيين يترجم تحديد المراد ومن ثم فهو فعل يعبر عن القدرة والعلم اللذين يمثلان مقومي صورة الحكم: ولنسم ذلك بوجه الحكم الفرقاني ومنه يأتي تحديد درجة الجزم المثبت أو النافي في الحكم.
3. وذانكما هما معنيا «قضى» مجتمعين في عبارة «وقضى ربك» بمعنى الأمر المعبر عن الإرادة الأمرية وبمعنى الخلق المعبر عن المشيئة الخلقية. وكلاهما يمكن أن يكون إنسانيا أو إلهيا كما يعتقد المؤمنون أو إنسانيا مؤلها أو إلهيا مؤنسا كما يعتقد من يجادل في المعتقد الأول. ولما كان الحاكم مترددا بين هذين الحدين الإنساني والإلهي حقا أو اعتقادا فإن المسألتين التاليتين تنتجان عن هذه الثنائية: الحاكم الإلهي والحاكم الإنساني.
ثالثا: في حالة الحاكم الإلهي
ما العمل إذا طلب المحكوم له من الحاكم أن يحكم بحكم الله وليس بحكم الإنسان؟ وما معنى هذا الطلب؟ هل الحل يكون عندئذ في المقايسة بين الحاكمين الإلهي والإنساني؟ وبصورة أدق ما مميزات الحاكمية الإلهية وهل هي قابلة للتحقق من دون توسط الحاكمية الإنسانية؟ كيف سنميز بين الحاكميتين فنعلم أن الحاكمية الإنسانية مجرد تطبيق للحاكمية الإلهية، أم إن الحاكمية الإلهية مجرد غطاء للحاكمية الإنسانية؟ أفلا يكون معيار الحاكمية الإلهية في هذه الحالة بيّنا: ألا يكفي أن يعتقد المحكوم له أن الحاكم الإنساني قد عمل ما يستطيع ليتنـزه عن الهوى في الحكم وهو يعلمه بالقياس على نفسه؟ ذلك ما حددته سورة المائدة. والحل حدّده القرآن: فالحاكم والمحكوم ينبغي أن يضعا نفسيهما في وضعيتهما يوم الحساب في حضرة الحاكم المطلق الذي لا تخفى عنه خافية فيكون الكذبُ مستحيلا بين المتنازعين، لأن كلا منهما يكون شاهدا على نفسه.. والحيفُ مستحيلا عند الحكام لأن المحكومين يرفضون ذلك، بل إن الحاجة إلى الحكام تصبح لاغية.
رابعا: في حالة الحاكم الإنساني
عندئذ لا إشكال في تحديد السياق إذ يكفي أن يقيس المحكوم له الحاكم على نفسه بأن يضعه موضعه ليعلم القصد من الحكم ويفهم الشروط والنتائج.
دور السياق بالقياس إلى أصناف الحكم الشرعي
الصنفان الأولان وقائيان الجوهر (في حال عدم الفعل) وعلاجيان بالعرض (في حال وجود الفعل):
ويتعلقان بحفظ الإنسان للغايات حاضرة في وجدانه ومؤثرة في أفعاله: تاريخي هو الحكم التربوي وما بعد تاريخي، وهما الوعد والوعيد. والجزاء فيهما إيجابا وسلبا معنوي ورمزي لا غير.
الصنفان الثانيان علاجيان بالجوهر (في حال وجود الفعل) ووقائيان بالعرض (في حال عدم الفعل)([25]):
ويتعلقان بحفظ الإنسان للأدوات فاعلة في وجدانه وأفعاله: تاريخي وهو الحكم القانوني وما بعد التاريخي، وهو الحساب بمقتضى كتاب اليمين وكتاب الشمال. والجزاء فيهما إيجابا وسلبا فعلي وليس مجرد رمز.
فلنحاول حصرها:
1. النسبة بين الفاعل وفعله من حيث القصد (القصد الحيني).
2. والنسبة بينه وبين المفعول به من حيث المنـزلة (هل هما فردان متساويان أم إن أحدهما يستغل نفوذا ما على الثاني).
3. والنسبة بين الفعل وظرفه من حيث الاستعداد (هل كان الفعل مبيتا أم ابن حالة طارئة).
4. والنسبة بين الفعل والتقاليد من حيث التوافق وعدمه (هل في الفعل استفزاز لشعور عام: أخلاق).
5. ثم أثر ذلك كله على النظام القانوني العام من حيث علاقته بالرأي العام (هل عدم تطبيق الحد يقوي النظام العام أم يضعفه: سياسة؟).
طبيعة المرجعية القرآنية والسنية في صلتها بتصنيف الأحكام السابق
فالقرآن نص ما بعد تاريخي وما بعد طبيعي حول حدث لا يمكن أن يكون مقصورا على الوجه التاريخي والوجه الطبيعي اللذين رآهما المسلمون منه حتى وإن ظنوه في الأغلب متعينا في سبب النـزول، وغالبا ما يقص القرآن بنفسه المفيد من سياقه التاريخي والطبيعي ومن سياقه ما بعد التاريخي وما بعد الطبيعي. والسنة حدث تاريخي وطبيعي حول علاقة حدث تاريخي وطبيعي بما بعد التاريخ وما بعد الطبيعة من حيث صلتهما بالنص القرآني أو بالتاريخ الإنساني مؤولين في ضوء اللحظة التاريخية للتجربة المحمدية. وكلاهما عاشه المسلمون الأوائل من حيث هو فعل حي كان في نفس الوقت حدثا ونصا أو نصا وحدثا ونحن نعيشه كنص ونعلم حدثه كحدث تاريخي:
فهل كانوا يتعاملون مع أحكامهما بصورة موحدة أم بحسب الأصناف التي ذكرنا فاعتبروا بعضها وقائيا بالمعنيين وبعضها علاجيا بالمعنيين؟
وهل يمكن أن نقتصر على تاريخية الحدث فنرجع النص إلى الحدث وتصبح الأحكام تاريخية مثلها مثل أحكام القانون؟
اقترحنا ومثلنا له بأمر يساعد على فهمه ([26]). فيمكن أن نقيس الأحكام الشرعية على العلاجات الطبية لأمراض النوع الإنساني الكلية؛ أعني الأمراض التي لابد أن يمر بها كل إنسان: «فنسبة أحكام الشريعة إلى أمراض النفس هي عينها نسبة أحكام الطب إلى أمراض البدن». فالتطعيم الذي اكتشفه الطب لهذه الأمراض النوعية صالحة لكل جيل بحسب تعرضه لتلك الأمراض التي تتكرر وليكن مثالنا الحصباء. فالأحكام هي التطعيم الخلقي مثل التطعيم العضوي الذي يحرر الأجيال منها؛ إذ ربيت عليها. وعندما يفعل التطعيم فعله يتوقف المرض فلا نحتاج إلى التطعيم إلا إذا عاد المرض. وطبعا فالتطعيم البدني أيسر من التطعيم الروحي: لذلك نحتاج إلى نظام تربوي هو جهاز التطعيم الدائم بشرط أن يكون تحرريا بالصورة التي وصفنا في أحد الهوامش عندما بينا أن كل درجات الحكم التي توالت في نـزول القرآن المنجم([27]) تبقى صالحة، والعمل بها هو الذي يحدد درجات الإيمان وأصناف المؤمنين؛ لأن العمل يزيد وينقص مثله مثل العلم.
المسألة الثالثة: نظرية السياق الباطن
ليس من همنا أن نعرض الزاد المشترك أو المعلوم من النظريات الخاصة بالعلاقة بين النص وسياقه فضلا عن كوننا لسنا واثقين من مناسبته لغاية البحث: فهم أحكام القرآن والسنة بمعنييها العقدي والشرعي. من أراد الإطلاع على النظريات الجاهزة فليطلبها من المدونات المدرسية الخاصة بالفن. أما ما نحاول تقديمه هنا فهو ما لا يمكن أن يجده المرء في المدونات المدرسية لأن غرضنا هو علاج المسألة بمنطق التنظير المناظر للتفصيل المبدع الذي يضع النظرية لعلاج مشكل نظري لم يطرح سابقا بدل استعمال نظرية سابقة. فالمشكل المطروح جديد: إذا كان المقدس متقدما على كل سياق بسبب كونه سرمديا وكان لابد له من سياق يساعد على فهمه فكيف يكون محددا لسياقه الذي يؤدي هذه الوظيفة؟
لابد، إذن، في مثل هذه الحالة أن يكون العلاج النظري من جنس تفصيل الثياب المناسبة للابسها، وليس من جنس الثياب المستعدة لأن تلبس دون قياس دقيق. لذلك فالمطلوب هو أن نفهم سر التعالي الذي يجعل النصوص المقدسة متضمنة لسياقها في ذاتها وغنية عن المحددات الخارجية: ونحن نتكلم على القرآن من منطلق إيماننا بأنه متعال على كل سياق ولا يفهم بما يسميه السياقيون بأسباب النـزول وظروف الرسالة. ونحن نذهب إلى أكثر من ذلك فنعكس معتبرين أسباب النـزول وظروف الرسالة هي التي ينبغي أن تفهم بالقرآن لا العكس. والمبدأ هو: إذا كان قائل القرآن هو خالق الحدث التاريخي فإن الحدث يكون معلول القول سواء تقدم على النـزول أو تأخر عنه. ذلك أن الترتيب الزماني بين الحدث والنـزول ليس هو المحدد بل المحدد هو الترتيب اللازماني بين الخلق والأمر: الأمر يعود إلى القضاء والخلق إلى القدر والله يقضي ويقدر وليس العكس. وطبعا فهذا ليس ترتيبا زمانيا، بل هو ترتيب منطقي ووجودي.
لكن السؤال أعم فهو يخص كل إبداع رمزي حقيقي وحتى وإن كان لا يبلغ تمامه إلا في النصوص المقدسة عامة، وهما في الزائف والمحرف منها وحقا في النص المقدس الحقيقي والمحفوظ. فما الذي يجعل الإبداع متحررا من سياقه ليصبح ذا ذاتية تخصه فيكون عينا من أعيان الوجود يمكن التعامل معها بصفتها تلك؟ هل اتساقه يكفي لتعليل ذلك؟ وإذا كان ذلك كذلك؛ فما هي مقومات الاتساق التي تحقق ذلك؟ لا يمكن أولا أن نحدد كيفية تخلص النص المبدع من سياق الإبداع إذا لم نفهم طبيعة الآليات التي تحقق انفصاله عنه ليكون ذا تعين يجعله ذاك النص بعينه. ويقتضي ذلك أولا أن يكون النص الإبداعي منفصلا عن السياق لكي يكون ذا وجود ذاتي قائم بذاته يضفي عليه العينية وكونه ما هو. ولما كان السياق يتحدد بمقتضى الأحياز التالية بات من الواجب أن نفحص طبيعة علاقته بها وكيفية تخلصه منها:
فله حيزان طبيعيان هما المكان والزمان (ويحددان انفصالا يتميز به تعين الوجود المحسوس في الإدراك الحسي).
وله حيزان تاريخيان هما السلم والدورة (ويحددان انفصالا يتميز به تعين الوجود المعقول في الإدراك العقلي).
ويجمع بين الطبيعي والتاريخي الحيز الوجودي (ويجمع بين نوعي الأحياز في وحدة حقيقية التعين الوجودي الذي يجعله ذاك النص الفاعل في سياقه الخارجي والمنفعل به).
ثم هو يقتضي ثانيا أن يكون فصل النص المبدع عن سياق الإبداع على ضربين حتى يمكننا من المقابلة بين داخل النص وخارجه فينقسم السياق إلى نوعين داخلي وخارجي كلاهما يمكن أن ينتسب إلى المقالي أو إلى المقامي أو إلى أثر الأول في الثاني أو أثر الثاني في الأول، ويتحد ذلك كله في قيام النص من حيث هو عينه الناتئة على أرضية الثقافة كلها نتوء الصورة على خلفيتها. ولا يمكن أن يكون القصد بالانفصال مجرد تعين النص تعينا ماديا في كتاب أو في أي حامل للنص سواء كان مكتوبا أو محفوظا في ذاكرة شخص.
إنما قصدنا بالانفصال ما تحققه عوامل تعين النص بوصفه وحدة ذات قيام مستقل يجعله مشارا إليه ككيان قابل لأن يكون ذا تخوم محددة بعض التحديد فيصبح قابلا لأن يكون ذا علاقات بغيره سواء كان غيره من جنسه أي نصا مثله أو من غير جنسه، أي ليس بنص فيكون موضوعا له أو مجالا خارجيا محيطا به ومحددا له: وإذن فالنص ذو تعينين يحققان انفصاله عما هو من جنسه وكلاهما ذو وجهين دالي (سياق داله النصي) ومدلولي (سياق مدلوله النصي) وانفصال عما هو من غير جنسه وكلاهما ذو وجهين مرجع دالي (مرجع داله غير النصي) ومرجع مدلولي (مرجع مدلوله غير النصي).
لكن الانفصال الضروري لتحقيق الاستقلال لا يلغي البديل الضروري من الاتصال الدال على الاندراج المتبادل والتداخل بينه وبين ما حوله سواء كان من جنسه أو من غير جنسه بديل يمكن من استنباط السياق من النص نفسه ما يجعله جزءا منه. ولنضرب مثالين ييسران فهم القصد. ففي علم الإحاثيات مثلا يمكن أن نستنتج من قطعة عظم أشياء كثيرة عن الهيكل العظمي الذي تنتسب إليه تلك القطعة وقد نذهب إلى استنتاج الكثير حول مجال التاريخ الطبيعي. وفي علم الآثار يمكن أن نستنبط من قطعة فخار أشياء كثيرة عن صناعة الفخار في تلك الحضارة وقد نصل إلى استنباط الكثير حول مجال التاريخ الحضاري.
وفي هاتين الحالتين لا يمكن فهم الاستنباط إلا بافتراض قراءتنا للعلاقة بين القطعتين وما يستنبط منهما بقراءة عملية رياضية نفترضها محددة للعلاقة بين النص وسياقه، وتسمى بلغة الهندسة الإسقاطية نموذج الإسقاط الرياضي للكل على الجزء من زاوية معينة (الكل هنا هو السياق الذي يسقط في النص والجزء هو النص الذي يستنبط منه السياق والزاوية هي النظرية التي تمكن من العودة من بنية موضوع الإسقاط في المسقَط عليه إلى بنيته في المسقط منه)؛ أي إن السياق بصنفيه يمكن استنباطه من النص لأنه مسقط رياضيا بصورة ضمنية فيه؛ بحيث يعد النص بهذه الوظيفة مثالا مصغرا من الثقافة كلها إذا كان أبدوعة حقيقية (وتلك هي علامة كونه أبدوعة وبهذه العلاقة يعرف الأسلوب) عند من يحسن التحليل بسوي التعليل والتأويل المتحرر من التدجيل.
ولفعل الإبداع بآليات الإسقاط الرياضي المحققة لعينية النص ضربان معلومان هما: الضرب المعرفي (كل العلوم سواء كانت غائية بصنفيها الطبيعي والإنساني أو أداتية بصنفيها المناسبين لكل منهما على حدة أو لهما معا) والضرب الفني (كل الفنون الجميلة وخاصة ما يستعمل منها اللسان كالشعر والرواية). لكننا سنكتفي بالعلمي من المعرفي وبالروائي من الفني لأنهما أوضح هذين الضربين دلالة على الآليات التي نريد تحليلها. سؤالنا يقتضي إذن أن نفهم آليات تحرر فعل الإبداع في العلم والرواية من التحيز السياقي ممثلين لهذين الضربين ببديل منه يتضمنه فيغني عنه وباستيعاب ما لا يقبل البدل منه في الفنون وفي العلوم: والسر في ذلك هو الكيفية التي يحول بها فعل الإبداع المدلول إلى دال فينقل الفكر من المعنى إلى معنى المعنى. وباكتشافنا هذا السر نتقدم خطوة أخرى في الثورة التي بدأتها الحضارة العربية الإسلامية في مباحث الإعجاز من الرماني إلى الجرجاني. فتحرر الإبداع الأدبي من السياق الخارجي مقاميا كان أو مقاليا بالمقابل مع تحرر الإبداع العلمي منه يعتمد عند النظر إليه من منطلق المتلقي على تقديم استيعاب ما لا يقبل الصوغ النسقي على ما يقبله ليكون مادة التنسيق عند القارئ.
آليات التعالي الروائية على السياق
فقارئ الإبداع الفني عامة والروائي خاصة ينطلق من عينية المعنى (الرواية المتحيزة في سياقها الذي أسطرته الأبدوعة) إلى كلية معنى المعنى الذي يجعل الأبدوعة مستقلة عن سياقها لتضمنها كُليَهُ، فيكون ذلك التعيين المعنوي هو الذي ينقل الأبدوعة من العينية ذات السياق المشار إليه إلى الكلية ذات السياق المطلق لتنطبق على ما يدركه مما تتلكم فيه، أي إن مدلولها العيني يصبح معنى أول يطلب معناه الثاني في كليات التجربة الإنسانية الذوقية. لذلك كان أفضل أدوات التجريد الأدبي التعيين التحييثي للأبدوعة بشرط أن تكون أبدوعة لا تاريخا لأن ما يضفي على العيني هذه القدرة على النقل من المعنى إلى معنى المعنى هو البدعنة أو الأسطرة لا نسخ الواقع ذاته، بمعنى نقله بل نسخه بمعنى تجاوزه للإيحاء بما يجعله ذلك الواقع. فكلما تضمنت الأبدوعة قدرا أكبر من أدوات التعيين في الأحياز الخمسة كانت أكثر قابلية لتحقيق الكلية التي سيطلبها قارئها وراء العينية التي هي معين المعنى مرقاة لمعنى المعنى:
ـ التعين التاريخي هو ظرف ثقافي يتحدد بالتضايف مع نسق الثقافة من حيث هي مدة في الزمان، ومن ثم من حيث هو تعبير عن امتداد متوالٍ يجعل الزمان في الأبدوعة يصبح أنغومة موسيقى.
ـ التعين الجغرافي هو ظرف ثقافي يتحدد بالتضايف مع نسق الثقافة من حيث هي انتشار في المكان ومن ثم حيث هي تعبير عن انتشار متساوق يجعل المكان في الأبدوعة يصبح لوحة رسم.
ـ التعين السلمي أي المنـزلة في السلم الاجتماعي للمنازل والأدوار يجعل الشخوص في الأبدوعة يصبحون كائنات حية فعلا ذات منازل وأدوار رغم أنهم من خلق الخيال.
ـ التعين الدوري أي في صيرورة القيم ذاتها بما تحدده التعينات السابقة في التبادلات الاجتماعية يجعل المنازل والأدوار في الأبدوعة نسيجا حيا ينتج بعضها البعض فتتراتب كأنها نسيج ذو وجود أكثر حقيقة وجودية من التاريخ المعيش.
ـ التعين الوجودي الذي هو حصيلة التعينات السابقة وهو العالم المتعالي على التاريخ أو ما بعد التاريخ لأنه معين الممكن المطلق الذي يحاكيه التاريخ ولا يحاكي التاريخ.
آليات التعالي المعرفية على السياق
وفي المقابل يكون الإبداع المعرفي عامة والعلمي خاصة عند قارئه عودة من الكلي الذي استوعب العيني إلى العيني الذي لا يقبل الاستيعاب فيكون هو الذي ينقل النظرية من الكلية إلى العينية لتنطبق على ما يدركه مما تتلكم فيه، أي إن مدلولها المجرد يصبح معنى أول يطلب معناه الثاني في عينيات التجربة الإنسانية المعرفية. لذلك كان أفضل أدوات التعيين العلمي التجريد التفريقي للنظرية بمنهج التبديه Axiomatisation. فكلما تضمنت النظرية قدرا أكبر من أدوات التجريد المخلص من الأحياز الخمسة المشار إليها في كلامنا على الأباديع الأدبية (وهي نظير النظريات العلمية) تخليصا مستندا إلى استيعابها لا إلى إلغائها كانت أكثر قابلية لتحقيق العينية التي سيطلبها قارئها:
التجريد الزماني؛ يجعل النظرية تستبدل زمان التحصيل الخارجي للمعرفة بالرتبة في نضوج المجال النظري الذي تنتسب إليه: الترتيب الزماني قد يهم تاريخ العلم الخارجي، لكن التجريد من الزمان في النسق العلمي يستعيض عن التوالي الزماني بالترتيب المنطقي.
التجريد المكاني؛ يجعل النظرية تستبدل مكان التحصيل الخارجي للمعرفة بموقع المجال الذي تنتسب إليه النظرية في جغرافية الثقافة الإنسانية: التوزيع المكاني قد يهم التاريخ الخارجي للعلم، لكن التجريد من المكان في النسق العلمي يستعيض عن التوزيع في المكان بالمنـزلة في النسيج الرمزي للثقافة الإنسانية.
والتجريد السلمي؛ يجعل النظرية تستبدل المنـزلة والدور في سلم الموضوعات الظاهر أو بمقتضى المدارك الحسية بالمنـزلة والدور في سلم حقائقها أو بمقتضى المدارك العقلية، فتكون المنـزلة والدور هي عينها الموقع من تشابك الحقائق النظرية التي تقدم للعقل صورة من الكوسموس.
والتجريد الدوري؛ يجعل النظرية تستبدل تبادل التأثير الظاهر للظاهرات بتبادل التأثير الباطن لقوانينها فتكون تفاعلاتها المحققة لتكامل أجزاء الكل هي ما يحدد موقعها في الدورة التي تمثل مجرى التفاعلات في العالم.
والتجريد الوجودي؛ هو المثال الأعلى من الصورة النظرية للكوسموس أو العالم من حيث هو نظام طبائع وما بعد طبائع (العالم المادي) ونظام شرائع وما بعد شرائع (العالم الروحي).
وبعبارة رياضية تجمع الآليتين يمكننا القول إن الأديب يخفي المعادلات التي تمثل الإخراج المؤسطر أو البدعنة أو الفكشنة ويعرض علينا مثالا منها على مسرح السرد فتكون كالقيم المحددة للمتغيرات في المعادلات، لكنها بشفافية تدل على كونها ممثلة للمعادلات وليست دالة بذاتها، بل بكونها إحدى قيم المتغيرات في المعادلات الخفية التي على القارئ طلبها. والناقد يبحث عن تلك البدعنة إما بوصفه قارئا مثاليا أو بوصفه مقيما لآليات البدعنة. أما العالم فإنه يظهر المعادلات ولا يهتم بالعرض العيني لبعض قيم المتغيرات فيها: «لأن مسرح السرد العلمي هو تاريخ العلم وهو المخفي في العلم كما أن معادلات المسرود في الأدب هي المخفي لأنها هي تاريخ الوعي الإنساني بتجربة الإنسان الخلقية».
ومن ثم فسر اختلاف الآليتين هو أن الأبدوعة الأدبية (الأسطورة) تظهر المادة الحية وتخفي الصورة المحيية في حين أن الأبدوعة العلمية (النظرية) تظهر الصورة المحيية وتخفي المادة الحية. ولما كانت الأبدوعة الأدبية أوسع من الأبدوعة العلمية كان تاريخ العلم هو نفسه أحد مواد الأباديع الأدبية موادها الخفية في ركح السرد لأنها تنتسب إلى فعل الإخراج المؤسطر الذي هو استراتيجية التأليف الإبداعي في الأدب الراقي عند الأمم التي دعيت للتخلق بأخلاق نصها المرجعي، ومن ثم بالعمل من منطق معايير الإبداع فيه وليس بمجرد محاكاته التي نهوا عنها. وتلك هي العلة في تقديمنا الأدب الساخر على الكلام الماكر والنقد الماخر على الفكر الذاكر: فكل مقدم في هذه الحالة هو الغاية وكل مؤخر هو البداية في تطور الأمم الروحي.
المسألة الرابعة: نظرية الأفق المبين أو السياق المطلق
آليات التعالي المطلقة على السياق
أما النص الذي اجتمعت فيه هذه الفنون بلا تأخير ولا تقديم فهو القرآن الكريم الذي يظهر المادة ويظهر إخفاء الصورة ويظهر الصورة ويظهر إخفاء المادة. لذلك فهو النص المعجز الذي ليس له مثيل رغم كونه مثال كل نص يزعم السخفاء تمثيله به أدبيا كان أو علميا. ففيه نجد مبدع الأسطورة الذي يظهر المادة ويفضح ما يجري وراء الكواليس في إخراج الأسطورة أو أي عرض لإخفاء الصورة. ونجد مبدع النظرية الذي يظهر الصورة ويفضح ما يجري وراء الكواليس في استخراج النظرية أو أي عرض لإخفاء المادة.
إنه القرآن الكريم الذي يجمع بين الضربين البسيطين (الأدبي ببعديه وتوابعهما والعلمي ببعديه وتوابعهما) والضربين المركبين (من التفاعل في اتجاهيه وتوابعهما) والضرب المتعالي عليها جميعا لكونه أصلها المتعالي بصورة تتجاوز التقابل بين الكلي والجزئي؛ (أي إنه يبلغ غاية الجزئية بغاية الكلية في العبارة العلمية وغاية الكلية بغاية الجزئية في العبارة الأدبية). ويتحقق ذلك بصورة مطلقة نؤمن بوجودها لكننا لا نستطيع إلا التمثيل لمادتها بالصوغ العلمي ولصورتها بالصوغ الأدبي على النحو التالي:
فالصوغ العلمي المقصور على الهدف العلمي يحقق الانفصال بالأبدوعة العلمية Scientific fiction التي هي شرط وحدة النظرية العلمية في سعيها إلى الكمال التصوري؛ أعني العبارة الكلية المطلقة على العينية أو شخصية الكيان الطبيعي ذي الدينامية الموجودة فعلا في مجرى العالم التصوري نموذجا للعالم الطبيعي، وهي غاية التعين: «تحقيق الاستقلال عن السياق الخارجي وحصر السياق الداخلي في نسقية النص العلمي من خلال الارتفاع إلى الكلية النظرية، وهو القصد بطرد النظرية التي هي نسيج منطقي». ويتحقق ذلك بالوجهين التاليين: «إما بالاعتماد على النسقية التبديهية (الرياضيات) أو على المطابقة التجريبية في ما لا يقبل الصوغ الرياضي التبديهي من التعيين الطبيعي، وهما مدلولا النموذج من حيث هو بنية نظرية (النموذج الرياضي) ومثال متعين في واقعات (النموذج العيني). والواقع أن كل العلوم تجمع بين الأمرين؛ لأن المطابقة التجريبية غاية هي مكملة للنسقية الرياضية غاية في المجال الذي يتأبى عن إطلاقهما (لا يمكن للتعيين العلمي ألا يكون إلا تجريبيا ولكن في إطار النمذجة التبديهية) كما هو شأن كل العلوم ذات الموضوع الموجود فعلا والذي ليس هو مجرد كائن ذهني.
والصوغ الأدبي المقصور على الهدف الأدبي يحقق الانفصال بالأبدوعة الدرامية Literary fiction التي هي شرط وحدة القصة الدرامية في سعيها إلى الكمال التمثلي؛ أعني العبارة الكلية المطلقة على العينية أو شخصية الكيان النفسي ذي الدرامية الموجود فعلا في العالم التمثلي نموذجا للعالم التاريخي وهي غاية التعين: «تحقيق الاستقلال عن السياق الخارجي وحصر السياق الداخلي في نسقية النص الأدبي من خلال الارتفاع إلى الكلية العملية وهو القصد بسرد الأسطورة». ويتحقق ذلك بالوجهين التاليين: «إما بالاعتماد على النسقية الدرامية (الأسطورة أو الحبكة أو Plot) أو على المطابقة التاريخية النموذجية في ما لا يرد إلى الحبكة القصصية من التعيين التاريخي». والواقع أن كل الآداب تجمع بين الأمرين؛ لأن المطابقة التاريخية هي المكملة للنسقية الدرامية في المجال الذي يتأبى عن إطلاقها (لا يمكن للتعيين العملي ألا يكون إلا تاريخيا).
والضرب المؤلف من أثر الأول في الثاني هو منطق تاريخ التربية المبدعة للإنسان نفسه بالاستناد إلى الإبداعين السابقين. ومعين هذا الضرب غايته من الضرب الأول لتحقيق التجاوز نحو الإبداع التاريخي الروحي بأداة التربية الروحية فتتحول الأسطورة الأدبية إلى حقيقة تاريخية (إبداع الإنسان نفسه). أما وسيلته فهي من الضرب الثاني لتحقيق الإبداع التاريخي المادي بأداة التربية المادية ﴿بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ﴾.
والضرب المؤلف من أثر الثاني في الأول؛ هو منطق تاريخ التعليم أو البحث المبدع بكل معانيه ويكون معنى هذا الضرب غايته من الضرب الثاني (أي من الإبداع العلمي). أما أداته فهي من الضرب الأول؛ (أي من الإبداع الأدبي: نموذج البحث الذي يتأسس عليه الخيال العلمي هو في جوهره العلم الخيالي) ﴿وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ﴾.
أما الضرب الأتم؛ فهو الجامع لكل هذه الضروب أعني الإبداع القرآني الذي هو أصل كل الضروب: إنه النص المرجعي المطلق المعبر عن الوجود في كتاب مثالي هو عندنا اللوح المحفوظ. ويكون مرجعيا لجمعه بين هذه الوجوه الأربعة وتعاليه عليها إذ هو أصلها جميعا في المثال. وليس القرآن عند المسلمين إلا نسخة من اللوح المحفوظ أرسلت إلى جميع المخلوقات عامة وإلى العالمين خاصة في حدود ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾. ولما كان اللوح المحفوظ متقدم على الأمر والخلق؛ لكأنه خطتهما وإستراتجيتهما المتقدمة وتاريخهما وتقويمهما المتأخر عنهما، فإنه متضمن لسياقة الخارجي وقابل للقراءة به دون أن يكون معلولا له.
وبذلك يكتمل الفهم الدقيق لعلة تنـزيل «الحكم» بين «الكتاب» و«النبوة» تنـزيلا([28]) عالج قضية الإنسانية في غاية وعيها بتحريف الاستخلاف تحريفه ممثلا بغايته في تأليه عيسى رمزا لطغيان الإنسان فاقد روح الوجدان وعقل الفرقان: ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ﴾ (ءال عمران: 78). فالحكم الذي هو منبع الحكمة يتلفت إلى الكتاب المطلق قبله (اللوح المحفوظ) فيكون قادرا على الالتفات إلى النبوة بعده (قراءة اللوح المحفوظ) للإنباء المطلق (الرسالة) بالنبأ العظيم (القرآن) الذي عنه يتساءلون؛ أعني التعين الفعلي لأصل هذه الأبعاد الأربعة كتابا والتفاتا إليه ونبوة والتفاتا إليها للإنباء بالنبأ العظيم: القرآن معجزة ابن آمنة وعين الرسالة.
فكيف تحققت هذه المستويات في القرآن الكريم؟ أي ما هي محددات الأفق المبين المغني عن السياق الخارجي؛ إذ إن القرآن يحقق ما لا ينجح في تحقيقه العلم والأدب: «أثر النسقيتين المطلقتين من المنطلق النازل (من الله إلى الإنسان) وأثر الضميمتين المطلقتين من المنطلق الصاعد (من الإنسان إلى الله) مع الحدين والحصيلة (بحث التحيز)».
أ. فقه الربوبية([29])؛ كيف يعرف الله نفسه بصورة تجمع النسقيتين العلمية والأدبية جمعا مطلقا فتستغني عن الضميمتين التجريبية والتاريخية؛ لأن تعينه في فعلي النسقية هو مثال ما فيهما من تعين.
ب. فقه الإنسية([30])؛ كيف يعرف الله الإنسان بصورة تجمع الضميمتين العلمية والأدبية بإطلاق وتحتاجان إلى النسقيتين في المعنى حاجة مطلقة.
ج. الخطاب من أ إلى ب([31])؛ أثر النسقيتين المطلقتين أو أثر ما بعد التاريخ في التاريخ.
د. الخطاب من ب إلى أ([32]): حاجة اللانسقيتين المطلقتين إلى النسقيتين أو أثر التاريخ في علم ما بعد التاريخ والعمل به.
ﻫ. طبيعة القول القرآني([33]): الجمع بين الأسطرتين المبدعتين؛ إذ إن الوسيلة أو أسلوب الرسالة هي الأسطرة الأدبية المبدعة والغاية أو مضمون الدعوة هي النمذجة العلمية المبدعة. دعوى الأسلوب غنية عن التمثيل فالكل يسلم بذلك. علينا أن نثبت الدعوى الخاصة بمضمون الرسالة: مثال ذلك نظام الملكية والإرث وأساسه الرياضي المستند إلى الكسور والنسب. أو العلاقة بين نظام الرزق ونظام الذوق في سورة النساء (بحثي في الفرائض الفصل المتعلق بالتبادلين).
فيكون ما يجري في التاريخ والطبيعة المتحدين بالقياس إلى ما يجري في ما بعد التاريخ وما بعد الطبيعة المتحدين من جنس النسبة بين المعنى ذي المستويين المتحدين ومعنى المعنى ذي المستويين المتحدين: «التاريخ والطبيعة هما المعنى المضاعف وما بعد التاريخ وما الطبيعة هما معنى المعنى المضاعف». ويكون السياق المطلق هو ما سماه القرآن الكريم بالأفق المبين الذي يكون فيه الله ليس هو على الغيب بضنين. وما ينبغي فهمه من تحقيق نفس الغاية رغم التقابل بين آليات التحرر من السياق ببديل منه وباستيعاب ما لا يقبل البدل منه في الآداب وفي العلوم هو سر الفرق بين الصورة والمادة أو كيفية تحويل المدلول إلى دال لنصل إلى معنى المعنى.
فالإبداع الأدبي يحقق ذلك بتقديمه استيعاب ما لا يقبل الصوغ النسقي على ما يقبله ليكون مادة التنسيق عند القارئ. فقارئ الإبداع الأدبي ينطلق من العيني إلى الكلي فيكون هو الذي ينقل الأبدوعة من العينية إلى الكلية لتنطبق على ما يدركه مما تتلكم فيه، أي إن مدلولها العيني يصبح معنى أول يطلب معناه الثاني في كليات التجربة الإنسانية الخلقية. لذلك كان أفضل أدوات التجريد الأدبي التعيين التحييثي للأبدوعة. فكلما تضمنت الأبدوعة قدرا أكبر من أدوات التعيين في الأحياز الخمسة كانت أكثر قابلية لتحقيق الكلية التي سيطلبها قارئها: «التعين التاريخي والتعين الجغرافي والتعين السلمي، أي المنـزلة في السلم الاجتماعي للمنازل والأدوار والتعين الدوري أي في صيرورة القيم ذاتها بما تحدده التعينات السابقة في التبادلات الاجتماعية والتعين الوجودي الذي هو حصيلة التعينات السابقة».
لكن قارئ الإبداع العلمي بالمقابل ينطلق من الكلي إلى العيني فيكون هو الذي ينقل النظرية من الكلية إلى العينية لتنطبق على ما يدركه مما تتلكم فيه أي إن مدلولها المجرد يصبح معنى أول يطلب معناه الثاني في عينيات التجربة الإنسانية العلمية. لذلك كان أفضل أدوات التعيين العلمي التجريد التفريقي للنظرية. فكلما تضمنت النظرية قدرا أكبر من أدوات التجريد في الأحياز الخمسة كانت أكثر قابلية لتحقيق العينية التي سيطلبها قارئها: التجريد الزماني والمكاني والسلمي والدوري والوجودي.
وبعبارة رياضية تجمع الآليتين يمكننا القول: إن الأديب يخفي المعادلات التي تمثل سيناريو الإخراج ويعرض علينا مثالا منها على مسرح السرد فتكون كالقيم المحددة للمتغيرات في المعادلات لكنها بشفافية تدل على كونها ممثلة للمعادلات وليست دالة بذاتها، بل بكونها إحدى قيم المتغيرات في المعادلات الخفية التي على القارئ طلبها.
أما العالم فإنه يظهر المعادلات ولا يهتم بالعرض العيني لبعض قيم المتغيرات فيها.
أما مسرح السرد العلمي فهو تاريخ العلم وهو المخفي في العلم([34]) كما أن معادلات المسرود في الأدب هي المخفي لأنها هي تاريخ الوعي الإنساني بتجربة الإنسان الخلقية.
ومن ثم فسر اختلاف الآليتين هو أن الأبدوعة الأدبية (الأسطورة) تظهر مادة السرد وتخفي صورته وهي صورة يبدعها كل قارئ حسب قدرته التصورية إذ يخرج الأحداث على ركح إدراكه والعالم المتخيل أو الرمزي والأبدوعة العلمية (النظرية) تظهر صورة الظاهرات (قوانينها) وتخفي مادتها، وهي مادة يبدعها كل قارئي حسب مجاله العلمي إذ يعين المجردات على ركح إدراكه والعالم الفعلي أو المادي. والعالم المتخيل أو الرمزي هو طبعا أوسع من العالم الفعلي أو المادي لذلك كان تاريخ العلم هو نفسه أحد مضمونات الأباديع الأدبية مضموناتها الخفية في ركح السرد إلإدراكي والخيالي؛ لأنها تنتسب إلى فعل الإخراج الذي هو إستراتيجية التأليف الإبداعي في الأدب الراقي.
أما النص الذي يمثل الأفق المبين أي ركح السرد الأدبي وركح الطرد النظري إذا تصورناه موجودا ثم رفعناه إلى المطلق ليكون الأفق المبين الذي لا يكون الله فيه على الغيب بضنين فهو القرآن الكريم الذي يظهر المادة ويظهر إخفاء الصورة في السرد الروائي، ويظهر الصورة ويظهر إخفاء المادة في الطرد النظري فهو النص المعجز الذي لم أر له مثيلا غير القرآن الكريم. ففيه نجد مبدع الأسطورة بإظهار المادة وبفضح ما يجري وراء الكواليس في إخراج الأسطورة، أي إنه يعرض إخفاء الصورة، ونجد مبدع النظرية بإظهار الصورة وبفضح ما يجري وراء الكواليس في استخراج النظرية أي إنه يعرض إخفاء المادة.
ولابد في ختام هذه المسألة من بيان المقصود بهذا الأفق المبين من منظور بؤرته الأساسية أو سنامه الأعلى: فقه الربوبية. فتعريف الله نفسه بصفاته هو الأفق المبين الذي تفهم الآفاق الأربعة الموالية بفضله وفي ضوئه. والآفاق الأربعة الموالية التي تمثل مستوياته الأدنى هي:
- فقه الإنسية (نظرية الإنسان القرآنية).
- الخطاب من أ إلى ب (نظرية الرسالة القرآنية: التربية القرآنية).
- الخطاب من ب إلى أ (نظرية العبادة القرآنية: المعرفة الإنسانية ببعديها اللذين هما الشرط النظري والشرط العملي لاستعمار الأرض والاستخلاف فيها).
- طبيعة القول القرآني (الأفق المبين بكل أبعاده).
يقتضي تحديد سنام الأفق المبين وبؤرته أن نعالج أمرين:
الأول؛ تحديد بنية الصفات الخمس الذاتية بإرجاعها إلى بنية اللوح المحفوظ أو القضاء والقدر ممثلين للأمر والخلق ترجمة للوح المحفوظ في الوجود.
الثاني؛ هو رد كل الصفات الإلهية ممثلة بأسمائه إلى الصفات الخمس الذاتية أي الوجود والحياة والعلم والقدرة والإرادة.
سنام الأفق المطلق
- نرجع الصفات الإلهية إلى صفات الله الذاتية الخمس التالية([35]): 1. الواجد([36]) 2. والحي 3. والعالم 4. والقدير 5. والمريد.
- ونبين أن هذه الصفات تنقسم إلى جنسين كل منهما مؤلف من مادة وصورة: فالحياة مادة والإرادة صورتها والقدرة مادة والعلم صورتها.
- فندرك أن الحياة والإرادة تمثلان مصدر القضاء الإلهي: إذ القضاء حياة مريدة.
- وأن القدرة العلم يمثلان مصدر القدر الإلهي: إذ القدر قدرة عالمة.
- وأن الجنسين يجمعهما أصل واحد هو الواجدية التي هي مدد يصدر عن الذات أو المعين المطلق بتوسط القضاء والقدر مددها إلى كل المخلوقات، وهو مدد مضاعف إذ منه مادة الموجودات وسر قيامها لأن الواجد هو القيوم.
ومن ثم فالأفق المبين المطلق منظورا إليه من زاوية الوجود الإنساني هو القضاء والقدر المترجم عن اللوح المحفوظ بما هو إرادة قضت وعلم قدر لأمور تتقوم إنيتها بما تستمده من حياة الله وإرادته، وتتحدد ماهيتها بما تستمده من قدرة الله وعلمه: «فبقاء الشيء دوام لابد فيه من مدد وثبات المدد على وتيرة محددة لابد فيه من نظام». فلا يكون الإيمان بالقضاء والقدر خيارا يمكن للإنسان أن يحقق شيئا في حياته من دونه، بل هو شرط العلم والعمل اللذين هما جوهر قيام الإنسان وشرط بقائه خلال امتداد مدته. فما لم يسلم الإنسان بأن ما يحصل قضت به إرادة حية (حكمة عملية إلهية لأنه حياة مريدة) وقدره علم قادر (حكمة نظرية إلهية لأنه قدرة عالمة) فإنه لا يمكنه أن يعلم شيئا ولا أن يعمل شيئا: وبهما يتحقق استخلاف الإنسان في العالم لاستعماره.
فتلقي الوجود بوصفه قضاء يعني أنه خاضع لمشروع حكيم وتلقيه بوصفه قدرا يعني أنه ذو قوانين رياضية: وتلك هي نظرية القرآن الكونية. والتلقي الأول يعطي الإنسان الأمل شرط العمل، والتلقي الثاني يعطيه الأداة شرط العلم ومجموعها هو شرط تأثير الإنسان في الكون لاستعماره ورعايته وذلك هو مفهوم الاستخلاف كما حله ابن خلدون أساسا لنظرية المقدمة.
المسألة الخامسة: الحكم الشرعي والحكم العقدي وسياقاهما
سياق الحكم وسياق النازلة
ليست تشريعات القرآن كلها من مستوى واحد:
- فبعضها من جنس التشريع الخلقي وهو الأهم لكونه يحدد المبادئ الأساسية لكل تشريع.
- وبعضها من جنس التشريع الدستوري.
- وبعضها من جنس التشريع القانوني.
- وبعضها من جنس الحكم القضائي.
- وبعضها من جنس الإجراء التنفيذي.
وكلها من المشيئة الأمرية التي لا تخرج عن إطار المشيئة الكونية. وهذه الأنواع الخمسة ليست مختلفة بالرتبة فحسب فتكون من جنس واحد، بل هي مختلفة من حيث الطبيعة. والسياقات الخارجية التي منها أسباب النـزول خاصة ليست خارجية إلا في الظاهر: «فهي في التشريع المنـزل لاحقة منطقيا حتى لو تقدمت زمانيا، ومن ثم فهي جزء من النص وليست أمرا خارجا عنه». ولنضرب مثالا إنسانيا لتفهيم ذلك. ففي السياسة الخارجية أو حتى في السياسة الداخلية يمكن للسلطة السياسية أو الاقتصادية أن تخطط بعدة طرق لكي تحدث أمورا يكون الدافع إليها مشروع نص قانوني يراد وضعه وتمريره بتلك الأحداث التي تبدو قد اقتضته في حين أنه هو الذي اقتضاها. فإذا كان ذلك ممكنا للإنسان وتأثيره في تخطيط ثمرات الأحداث التي ينتجها محدود فكيف بالشارع إذا كان إلها يقضي ويقدر كونيا وأمريا([37])؟
نحن نفترض أن كل الأحداث التي تعد أسباب نـزول ليست أسبابا إلا في الظاهر لكنها في الحقيقة نتائج للخطة التي تسعى إلى تنـزيل النص الذي تكون تلك الأحداث، وكأنها تعينه الفعلي لكي يمثل لما يعبر عن الحاجة إلى النص المنـزل فيفهم جيد الفهم؛ لأنه يكون قد أصبح مطلوبا من الذين سيخضعون له([38]). وبصورة عامة فإن قابلية الفاعل لأن يكون متحكما في سلسلة الأحداث وفي سلسلة النصوص يجعل الترتيب الزماني بين عناصر السلسلتين ليس بالضرورة دالا على أن أحد عناصر إحدى السلسلتين سبب لأحد عناصر السلسلة الأخرى لمجرد كونه قد تقدم عليه بالزمان فضلا أن يكون دالا على تفضيل إحداهما بالتعليل. وإنما الدلالة تأتي من نسبة السلسلتين إلى أصلهما الذي هو تناسق فعل التشريع من منظور الأفق المبين المطلق.
سياق الحكم: ظرف نازلة ونظام نص
سياق النازلة هو ظروفها وتقاس في التكييف الفقهي على ما حدده نظام النص من عوامل مقارنات النوازل أو ما يعتبره منها محددا لمحكوميتها.
وإذن، فلابد من نظام توصيف أو تكييف فقهي للنوازل يمكن من الصعود منها إلى النصوص: «المفروض أن يكون هذا النظام موجودا أولا، وأن يكون منهج الصعود من النوازل إلى النصوص شبيها بقراءة الأطباء للأعراض عند تحديد المرض». (ابن تيمية يكثر من التمثيل من الطب ومن اللغة). ويوجد نظام تأويل أو تطبيق للنصوص على النوازل يمكن من النـزول من النصوص إلى النوازل: «المفروض أن يكون هذا النظام موجودا، وأن يكون منهج النـزول من النصوص إلى النوازل شبيها بوصف الأطباء لعلاج المرض إذا كان التكييف من جنس تأويل الأعراض للتشخيص».
وإذن، فنحن أمام نظامين: فما هما وكيف يعملان؟ إنهما نظام الشبكة الرامزة وهي شبكة النصوص ونظام الشبكة المرموز إليها وهي شبكة النوازل. ولو أخذنا مثالا النصوص الطبية فإنه لا يمكن أن ترمى الشبكة الرامزة على أي شيء لتنتظمه في عيونها، بل لابد من توافق ما بين الشبكة الرامزة والشبكة المرموزة: شبكة النصوص الطبية وشبكة الأعراض المرضية. فالشبكة الرامزة هي تصنيف النصوص للأعراض بمقتضى دلالتها ومن ثم فهي شبكة رامزة صناعية لشبكة رامزة «طبيعية»: الأعراض شبكة رامزة طبيعية للأمراض والنصوص شبكة رامزة صناعية لدلالة الأعراض على الأمراض. والعلم الواصل بين الشبكتين هو العلم المحدد لدلالة المجموعات الأعراضية (syndromes) على الأمراض. فيصبح العرض الذي يمكن أن يكون موجودا في عدة أمراض ليس دالا على مرض معين بذاته بل باجتماعه مع مجموعة من الأعراض الأخرى ويكون كل مرض مدلولا عليه بمجموعة مميزة من الأعراض. منظومة هذه المجموعات هي التي تمكن من التشخيص.
ولابد، إذن، من منهجيتين: فما هما وكيف تعملان؟ منهج تشبيك المصادقات (بمستوييها الأعراضي والأمراضي) ومنهج تشبيك المفهومات (بمستوييها حدود المجموعات الأعراضية وحدود المجموعات الأمراضية). ويمكن أن نعتمد في تحليل علمية التشبيك التأويلي لعملية التشخيص على:
- مثال القانون الوضعي.
- أو مثال الطب.
- أو مثال علاقة النظرية العلمية بمجال بحثها.
- أو مثال التعبير الإنساني على مدركاته.
- أو أخيرا مثال الفعل عند كل كائن عاقل عامة. والتشاكل بين كل هذه الأمثلة يبين الطابع الكلي للعملية من حيث هي عين فعل العقل الإنساني الذي يستند إلى فعلين: «فعل التلقي الوجداني (تلقي المعطى) وفعل العلاج الفرقاني (تحليل المعطى وتصويره)».
وسنضرب أمثلة كلها مستمدة من القرآن ولكن من دراسات لنا سابقة مع تصرف يصلها بمسألة العلاقة بين النص والسياق كما حددناه في بحثنا. وغاية الأمثلة جميعا أن تبين أمرين أحدهما سلبي والثاني إيجابي:
فأما الأمر السلبي؛ فهو بيان استغناء تفسير القرآن الكريم عن كل سياق خارجي مقاليا كان هذا السياق أو مقاميا بسبب ما أشرنا إليه من النسقية المطلقة في النص القرآن النسقية التي تحرره من التحيز في الظرفين الطبيعيين (الزمان والمكان) والظرفين الثقافيين (السلم والدورة)، وتكتفي بالظرف المحرر من الظروف؛ أعني الظرف الوجودي، كما يحدده القرآن أعني العلاقة بين القطبين المتراسلين الله والإنسان والرسالة النازلة بوجهيها، أي المشيئة الكونية والمشيئة الأمرية والرسالة الصاعدة بوجهيها؛ أي النظر اجتهادا للعلم قوانين الرسالة الكونية وجهادا للعمل بقوانين الرسالة الأمرية.
وأما الأمر الإيجابي؛ فهو ما أطلقنا عليه اسم الأفق المبين المطلق؛ أعني الأفق الذي تشير إليه الصفات الإلهية التي تختم الآيات القرآنية لتحديد المنظور الذي ينبغي الاعتماد عليه منطلقا للتحليل من أجل الفهم المحرر من التأويل عملا بنهي الآية السابقة من سورة ءال عمران. وهذا الأفق أرجعناه إلى بنية العلاقة بين الصفات الخمس التي تؤول إليها كل أسماء الله الحسنى.
المثال الأول: وهو تفسير شبه كامل لسورة يوسف
بدأناه في كتاب الشعر المطلق ولم ننهه بعد لما فيه من أعماق لا تكاد تفنى([39]) وخاصة في عملية تأسيس القويم المخمس وعلاقته بأحكام الفعل الشرعية وببنية الأفق المبين سواء كان مطلقا أو نسبيا، بل وببنية؛ أي موجود عدا مصدر الوجود الله، جل وعلا، الذي يتميز دون سواه بالوحدانية. وكل ما عداه مخمس الأبعاد: فله ذات وصورة عن الذات (هي تعاكس ذاته وكل المخلوقات في العالم) وأثر ذاته في صورته وأثر صورته في ذاته وهويته هي وحدة ذلك كله وهي من مخمسة.
ونحدد في هذا المثال كل الأفق المبين النسبي؛ أعني ما يناظر صفات الله من صفات الإنسان، وتلك هي المجالات التي تتعلق بها الأحكام الشرعية وصلتها بالحكم العقدي الأصلي الأحكام العقدية المضمونية؛ أي المؤسسة للأحكام الشرعية بصنفيها من حيث صلتها بمادة العمران مباشرة وبصورته بصورة غير مباشرة: يوسف حول أصناف مجالات التقويم الإنساني أعني لحمة العمران وسداه.
- فصفة الواجد عند الله؛ تناظرها صفة الإيمان بالله أو القيمة الوجودية.
- صفة الحي عند الله؛ تناظرها صفة الذوق عند الإنسان أو القيمة الذوقية.
- صفة القادر عند الله؛ تناظرها صفة الرزق عند الإنسان أو القيمة الرزقية.
- صفة العالم عند الله؛ تناظرها صفة النظر عند الإنسان أو القيمة النظرية.
- صفة المريد عند الله؛ تناظرها صفة العمل عند الإنسان أو القيمة العملية.
فإذا جعلنا الصفتين الأخيرتين صورتين والصفتين الثانية والثالثة مادتين كانت الصفة الأولى أصلا نظير الواجدية الإلهية، وهي الموجودية الإنسانية فنحصل على نفس البنية النظرية ولكن بصورة نسبية فيكون الإنسان أصل قيامه الإيمان بالله ومنه يتفرع قضاؤه الذي مادته الذوق (الحياة) وصورته العمل (الإرادة) وقدره الذي مادته الرزق (القدرة) وصورته النظر (العلم) ([40]).
وهذا الأفق المبين النسبي حددته سورة يوسف: حيث يرمز الجمال إلى الذوق وأسفار الأخوة إلى مصر إلى الرزق وتأويلات يوسف إلى النظر ووزارته إلى العلم وبرهان ربه إلى الإيمان الذي تنبع منه كل القيم الأخرى. وقد تضمنت السورة ما يدعونا إلى استخراج الأفق المبين النسبي منها بآياتها الثلاث الأولى والعشر الأخيرة، فضلا عن كون موضوعها قصة واحدة موضوعها هذه القيم من حيث هي الرابط بين ما بعد التاريخ ممثلا بالرؤى والتاريخ ممثلا بما حصل أو تأويل رؤيا يوسف تأويلا بمعنى التحقق الفعلي الذي بين مضمونها والتي هي الوحيدة التي لم يؤولها يوسف بمعنى تفسر الأحلام.
المثال الثاني: ويتعلق بمسألة الذوق
وفيه نمثل للحكم الشرعي حول مقوم مادة العمران (الذوق أو أصل الثقافة والرزق أو أصل الاقتصاد) من القانون الخاص: من النساء حول النشوز([41]). فالتناظر بين آية نشوز الرجال: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ (النساء: 127) والآية التي تتكلم في نشوز النساء: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ (النساء: 34) يمكن لهذا التناظر أن يساعدنا على تحديد المقصود بالنشوز في الحالتين، ومن ثم على تعديل علاج إحدى الحالتين بعلاج الحالة الأخرى.
ولعل أول عنصر وأهمه يساعد على بيان دور ما أطلقنا عليه اسم الأفق المبين المطلق محاولة فهم المعنى المقصود في الآيتين أعني منظور المشرع هو صفتا الله اللتين ختمتا بها تذكيرا بالوجه الذي يحدد طبيعة الاحتكام إلى الشرع. فالله وصف نفسه في الآية الخاصة بنشوز الرجال ب خبير بما نعمل ووصف نفسه في الآية المتعلقة بنشوز النساء بـ: علي كبير. فأي معنى لهذا الفرق؟ أليس القصد أن الله في الحالة الأولى لا تخفى عنه نوايا أفعال الرجال الناشزين وأنه في الحالة الثانية فوق كل متجبر من الرجال في معاملة النساء معاملة جعلتهن يصبحن ناشزات؟ فيكون الحكم في الحالتين محملا الزوج مسؤولية ما يحصل سواء كان هو الناشز أو المنشوز منه؟
ولعل ثاني عنصر يساعد على تحديد دور الأفق المبين النسبي للمعنى المقصود في الآيتين؛ أعني منظور المشرع له هو نوع الدافع لعلاج النشوز في الحالتين. فلو لم يكن الزوج والزوجة مدفوعين بالخوف من النشوز، ومن ثم بالحرص على بقاء العلاقة لما كان للكلام في علاجه معنى ولكان يكفي أن يتفارقا بالحسنى.
وإذن، فالأمر في الحالتين يتعلق بوجود علاقة حب بين زوجين حصل بينهما خلاف أغضب أحدهما من الآخر فبات على الثاني أن يسترضيه أو أن يصلحه إذا كان الأمر كما هي حال الرجل غالبا في المجتمعات القبلية أكبر سنا من الزوجة وأكثر تجربة.
ولعل ثالث عنصر يساعد على تحديد أفق الوصل بين الأفقين السابقين (لكونه سبب الحكم) للمعنى المقصود أعني منظور النازلة التي ينـزل عليها التشريع هو نوع الخلاف المؤدي إلى النشوز. ولنبدأ بالسلب. فلا علاقة له في الحالة الأولى بسلوك المرأة الجنسي؛ إذ لو كان متعلقا به لكان العقاب بهجرانها في المضجع فاقدا لكل معنى. إنما هو متعلق في حالة نشوز الزوجة بنقيض صفتي الصالحات الواردتين في النص: «القنوت وحفظ الغيب». ومعنى ذلك أن النشوز هنا ناتج عن عدم قناعة المرأة بالمستوى المادي الذي يوفره لها الزوج وعن عدم حفظها أسرار بيتها، ومن ثم بالحاجة إلى الإصلاح؛ لأن شرطي الصلاح لم يتحققا بعد فيها. وهو في حالة نشوز الزوج متعلق بالصفتين المذكورتين نصا في الآية: «الإحسان والتقوى نقيضا للشح والكبر». ومعنى ذلك أن النشوز هنا ناتج عن بخل الزوج وتكبره في التعامل مع زوجته.
فإذا جمعنا الآفاق الثلاثة المطلق (منظور المشرع) والنسبي (منظور المشرع له) والواصل بينهما (النازلة المحكوم فيها) كانت الحصيلة في حالة نشوز المرأة أن الأمر متعلق بزوج يحب امرأته ويريد أن يحافظ على بيته فيتعامل معها معاملة الأب لابنته أو موقف المربي لا موقف الزوج فحسب. أما في حالة نشوز الرجل فالأمر يتعلق بزوجة تحب زوجها وتريد أن تحافظ على بيتها فتعامله معاملة المحبة التي «تدلل» حبيبها ليتحرر من البخل والكبر في معاملته لها. وفي كلتا الحالتين فنحن لا نتكلم على إجراءات قانونية بل على أحكام خلقية للتعامل بين الزوجين المتحابين عندما يحصل بينهما خلاف لم يخرج من البيت إلى المحاكم.
وهذا طبعا لا ينطبق على سلوك الزوج والزوجة اللذين لا يكون الحل بينهما إلا بالفراق إما لعدم وجود الحب والمودة أصلا، أو لأن النشوز سببه فساد المرأة أو فساد الرجل فسادهما الخلقي. ذلك أن الفساد الخلقي لا يمكن أن يكون علاجه ما ورد في الآيتين بل هو سيكون مقويا له: «فإذا كانت المرأة فاسدة خلقيا فهل هجرانها في المضجع يشجعها على الزيادة في الفساد أم على النقصان؟ وهل يقبل الوعظ من نخرته دودة الفساد الجنسي؟».
والنتيجة هي أن سوء فهم طبيعة التشريع يؤدي إلى الخلط بين التشريع الخلقي والتشريع القانوني: «أو بين الإلزام القانوني بوازع خارجي والالتزام الخلقي بوازع ذاتي». والقاعدة التي نضعها للتمييز بين النوعين من التشريع هي: «ما لم يوجد جزاء يطبقه حكم بين المتنازعين ويكون ثالثا غيرهما فلا يمكن الكلام عن تشريع قانوني، بل نحن في مجال التشريع الخلقي المحدد للتعامل بين الناس من دون لجوء إلى المحاكم». والحكم الوحيد هنا هو الضمير الذي لا ينسى الرقيب المطلق؛ (أي الله). لذلك ذكرت كلتا الآيتين بالصفة الإلهية التي ينبغي عدم نسيانها في التعامل المطلوب في الحالتين: «فالله خبير بالأعمال ومن ثم بالنوايا التي وراءها ناموس للتعامل في حالة نشوز الزوجة وهو علي كبير فوق كل متجبر في حالة نشوز الزوج».
المثال الثالث: ويتعلق بمسألة الرزق وصلتها بالذوق
نمثل فيه لحكم المقوم الثاني من مادة العمران، أي الحكم المتعلق بالرزق من سورة النساء كذلك: الإرث([42]). وهنا تعترض قضية حامية هي مطالبة الحداثيين بالمساواة بين الجنسين في الإرث دون إدراك لشرطها: «إلغاء حرية المالك في الوصية بإطلاق». لم يسأل أحد من المساواتيين عن المساواة فيم تكون؟ هل يمكن أن يوجد قانون يفرض مساواة منـزلة الوارثين المحتملين منـزلتهم العاطفية لا الوجودية؛ إذ هذه المنـزلة ليست نسبية إلى الغير في قلب صاحب الملك عندما يكتب وصيته؟ وهل يمكن للقانون أن يزيل بإطلاق حق المالك في هذا التعيير العاطفي والمصلحي الذي تترتب عليه بنود الوصية المحددة للنصيب من الإرث ولا أقول الفرائض لما في هذه الكلمة من الجلال الذي لا يفهمه من لم يدرك معنى تحويل الحد من حرية الوصية المطلقة إلى فريضة أو عبادة؟ أليس المتكلمون في الأمر لا يعلمون فيم يتكلمون: «فهل لمن لم يصبح بعد وارثا قبل وفاة المالك حق في ما سيرث بعد أن يصبح؟» حق الوارث أمر يتجدد بعد أن لم يكن. فقبل وفاة المالك لا يتعلق الأمر بحق الوارث في المساواة، بل بحق المالك في التصرف الحر في ملكه بالوصية إذا بقي له منه قدر معلوم. لذلك فالحكم الوارد في الآية لا يتعلق بحق الورثة، إذ لا حق لهم، بل هو يتعلق بضبط حق المالك في التصرف في ما يملك بعد وفاته أعني حق الوصية لئلا يضر بهذا الحق فلا يلغيه بمقتضيات أمرين ذوي دور بعيد سنحللها في المسألة الموالية:
أولهما؛ خلقي واقتصادي هو كيف يبقى المشرع قدر المستطاع على وحدة الملكية القاعدية التي هي شرط العمران الإنساني السوي أعني العمران الذي لا يتحول إلى مجرد أرقام في اقتصاد خفي الاسم.
والثاني؛ خلقي بايولوجي هو كيف يحرر المشرع حركة تبادل النساء من حركة تبادل المال تشجيعا للتزاوج الخارجي وتقليلا من التزاوج الداخلي الذي كان يمكن أن ينجر عن خروج إرث المرأة بقدر يجعل الأسرة تبقى عليها للإبقاء عليه.
لا أظن المتكلمين في مسألة عدم التساوي بين النساء والرجال في الإرث من منطلق الآية الحادية عشرة من النساء قرؤوها قراءة كاملة. فهم يقفون من نصها قبل غايته التي تحدد المبدأ الأساسي الذي يدور عليه الكلام، ولا يتصل بأحكام الإرث إلا بصورة عرضية. فالأمر لا يتعلق بالإرث أو بمنـزلة الورثة عند الله، بل بتعديل منـزلتهم عند صاحب الملكية عند التفكير في توزيعها بين أقربائه لئلا يبني وصيته على ظنونه. وهذا المبدأ مؤلف من موضوع الحكم والأفق المبين الذي ينبغي أن ينظر إلى الحكم من منطلقه: “…1. ﴿آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ﴾ 2. ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾” (سورة النساء غاية الآية 11 منها).
من كان يبحث عن فهم هذه الآية في صلتها بأحكام الإرث فعليه أن يفهم موضوعها أولا والمبدأ الذي تضعه ثانيا: عليه أن يبدأ بالمنطوق به قبل العجلة التي أجاءته إلى المسكوت عنه.
فالمعلوم أن الوصية منظورا إليها من منطلق المالك ينبغي أن تستند إلى علاقة المالك بما يملك وبمن سيوصي له مما يملك. والصلة الأولى هي حق الملكية؛ أعني حرية التصرف في ثمرة عمله (وهذه ذات صلة بالنظام العام الذي هو هنا قرآني وقائل بحرية الملكية المشروطة بخدمة الصالح العام). والصلة الثانية هي صلته بمن يمكن أن يفيده بما يملك حسب ظنه أو علمه المظنون بما أفاده به في حياته أو بما سيفيده به بعدها: «وهو جزء من حق التصرف في الملكية ويسمى حق الوصية». لكن الوارث لا صلة له بالملكية ذاتها بل صلته بمالكها فحسب؛ خاصة إذا لم تكن الملكية ثمرة لعمل كل أفراد الأسرة وخاصة للرجال منهم في النظام القديم: «وهي صلة قرابة أو صداقة ولا علاقة لها بالملكية إلا إذا كان شريكا». فلا حق للوارث في ما يملك المالك ما دام حيا: الإرث حق بعد الوفاة بمقتضى إرادة المالك (الوصية) أو إرادة المشرع (الحد من حق حرية التصرف في الوصية) وهو حق لا وجود له قبلها.
لذلك فمحدد الحسم في موضوع الآية أمران لا يتصلان بحق الوارث: الأول؛ هو علاقة المالك بما يملك والثاني؛ هو علاقته بمن سيختاره لينقل إليه ما يملك.
والعلاقة الثانية؛ هي التي تحدد عملية النقلة وهي التي انطلق منها نص الآية في تحديد الفرائض. أما العلاقة الأولى؛ فهي بمنأى تام عن المنقول إليه. وموضوع الآية هو، إذن، محاولة تخليص هذه العلاقة من تحكم المالك الذي يبنى تفضيله لوارث على وارث يبنيه عادة على العلاقات العاطفية وعلى الظنون المتصلة بنوايا من يمكن أن يختاره المالك ليرث ملكه. الكلام يدور إذن حول محددات إرادة المالك في توزيع ملكه: هل يكفي لتحديدها علم المالك بعلاقة من يمكن أن يورثهم ملكه بحسب ما يدركه مما يتصوره من نفع يحصل له منهم ؟
أحكام هذه الآية تتصل بمسألة الإرث من هذا الوجه لا غير وهي تريد أن تؤطر إرادة المالك أو حرية تصرفه بالوصية في ما يملك حتى لا تكون مطلقة الحرية بمجرد الاعتماد على الظن: «إنها، إذن، حد من حرية المالك في الوصية وليست تحديدا لحقوق الورثة إذ ليس للورثة حق، بل ليس لهم وجود قبل أن يحددهم نص قانوني (يحد من حرية تصرف المالك في الوصية) أو وصية المالك». لذلك فلا حق لمن سيصبح وريثا ما لم تحدده وصية أو شرع يحد من الحرية المطلقة في الوصية. والنص القرآني لا يحدد حقوق الورثة لذاتها، بل يحد من حق المالك في الوصية لئلا يحرم البعض لمجرد الظن مرجعا إياه إلى علم الله وحكمته في جعل الأمر من الفرائض أي من العبادات وليس من المعاملات. الفريضة التي تشير إليها الآية هي إذن فريضة الحد من حرية المالك المطلقة في المفاضلة بين أبنائه وآبائه عند تقسيم ما بقي من ماله قبل الوفاة. ويؤيد هذا الفهم الحد من حرية الوصية في التشريع الإسلامي عند ضم الحديث إلى القرآن: «فالوصية للورثة ممنوعة والوصية لغير الورثة لا تتجاوز ثلث ما سيصبح تركة».
وهنا نصل إلى بيت القصيد في النظام التشريعي الإسلامي بعيد الغور في النظام الذي يتجرأ عليه بعض التحديثيين بأفقر أدوات الفكر لو كانوا يعلمون. وحتى نفهم بعد الغور فيه فلنطرح سؤالين جوهريين لكل عمران سوي حتى ندرك العلاقة بين المثال الأول من النساء وهذا المثال الثاني وعلة جعل القرآن مسألة الذوق ومسألة الرزق مترابطتين فعالجهما معا:
- ما النظام الاقتصادي الذي نريده؟ هل نريد مجتمع الشركات العامة التي تجعل الناس أرقاما فاقدين للذوق هدف الحياة الأول أم مجتمع الوحدات التآنسية التي يتحرر فيها الذوق قدر المستطاع من سلطان أسباب الحياة القاهر؟
- وما طبيعة الحياة العاطفية المحددة للانتخاب العضوي بمعاييره السوية طبيعتها التي نريد؟ فالتزاوج الداخلي الذي يصبح القاعدة بمؤثرات العامل الاقتصادي يؤدي إلى الأمراض البايولوجية لفرط تأثير دافع الحفاظ على الملكية الدافع الذي لا ينكره إلا متعام.
فالتزاوج الخارجي الذي يمكن من تحقيق شروط الصحة العضوية؛ هو التزاوج الذي يكون المحدد الأول فيه الذوق لا الرزق. ولا يتحقق ذلك إذا كان الطمع في إرث المرأة حائلا دون تحريرها من التزاوج الداخلي من أجل الحفاظ على الملكية، ومن ثم مانعا لطلبها من الخارج لقوة الدافع المالي فلا يبقى إلا طلبها الداخلي. ولو انتبهت النخب العجلى إلى هذه البعائد لترددت كثيرا في الجرأة على كل شيء مع الجهل بأدنى شروط الفهم العميق لمقاصد الشرائع في حياة العمران. فحتى لو سلمنا لهم بأن الشرائع كلها من جنس الشرائع الوضعية فإن الأوضاع ليست متساوية للتمايز بين عقول الواضعين. فمنهم من يرى البعائد ويسميهم اليونان حكماء. ومنهم من لا يرى أبعد من ذبابة أنفه ويسميهم العرب سفهاء. فما أشقى المرأة التي يختارها المغازلون لمالها! ولعل الباحثة بمقتضى الجنس والخبرة أدرى مني بالمفاضلة بين المرأة تُختار حبا لذاتها وجمالها أو تُصطاد طمعا في ما عندها ومالها!
والسؤال الآن هو لم كان الحد القرآني من حرية تصرف المالك في الوصية بهذه الصورة التي جعلت بعض المعاملات من العبادات دون أن تحافظ على مبدأ العبادات الأساسي، أعني المساواة بين البشر من حيث منـزلتهم عند الله إلا بالتقوى أو العمل الخلقي في التعارف كما حددت ذلك آية التعارف؟ أي لماذا لم يفرض الله الحد بصورة تجعله يساوي بين الذكور والإناث في هذه الفريضة رغم كونها فريضة؛ أي عبادة وليست معاملة؟ وهذا السؤال كان يمكن أن يكون مفهوما لو طرحته الباحثة بعد أن تكون قد برهنت على فهم معنى الآية بالقصد الأول. ذلك أن تحديد مقادير الإرث هو معناها بالقصد الثاني. وهذا القصد الثاني لا يمكن أن يفهمه من غاب عنه القصد الأول. فإذا كان الشارح لم يفهم أن الآية تتعلق بالحد من حرية المالك في التوريث بحسب ظنونه فإنه لا يمكنه أن يفهم القصد من المقادير التي اختيرت حدا بمعنى ما لا يمكن النـزول دونه. ذلك أن ما فوقه يبقى ممكنا بعدة طرق لم يتأخر بعض المالكين والفقهاء عن تصورها وتطبيقها، بل هم تحيلوا في الاتجاه المقابل للهبوط دون هذا الحد الأدنى وحتى لحرمان المرأة من الإرث أصلا اتباعا لما نبهت إليه الآية وحذرت منه لعلم الله بأن الغالب على البشر بالجبلة تفضيل الذكور على الإناث: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. والجواب هنا مضاعف ويفهم بفرضيتين:
1. فلو فعل نص الآية فحقق المساواة في توزيع الإرث لكان ذلك معارضة مطلقة لحرية المالك في التفضيل أعني في حرية الوصية. والحد من حرية المالك في الوصية يفقد معناه إذا لم يكن مشروطا بدواعي الحاجة إلى الحد منها: «إنها في النص القرآني المعيار المتحكم في إرادة المالك إرادته التي تعبر عنها وصيته، والتي يفهم منها قيس المالك لمقدار الموصى به بنفع الموصى إليه له». ومن هذا القاعدة العامة التي تكاد تكون كلية تنتج قاعدة تفضيل الذكور على الإناث فهي أمر شبه كوني في المجتمعات البشرية. لكن الحد القرآني الذي يعترف بهذه الظاهرة اقتصر على وضع مبدأ الحد الأدنى (حظ الذكر مثل حظ الأنثيين)، ولم يمنع حق الهبة للبنات لمن كان من الآباء لا يقول بهذا الأمر شبه الكوني. والهبة غير الوصية لأنها تتم في حياة المالك وليست بعد وفاته: «والهبات يمكن أن تأخذ شكل البيع بسعر تفضيلي ورمزي تجنبا للمماحكات القانونية بعد الوفاة».
لكن هذا الفهم رغم اختلافه عن تعليل إخوان الصفاء الذي يهزأ منه بعض الباحثين دون عميق فهم لا يقدم من المسألة إلا علتها السطحية، وهي علة رغم وجاهتها أقل أهمية من العلة العميقة ذات الغور البعيد والتي لا يدركها من يسارع لطلب المسكوت عنه ويهمل المنطوق به؛ أعني بعائد المعرفة العلمية بقوانين العمران.
ولو فعل نص الآية ما يطلبه الداعون لتغيير أحكام الإرث من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين لفقدت هذه الأحكام دوريها المقومين لتوازن القوى بين وحدات العمران الإنساني الدنيا اقتصاديا وبايولوجيا. فالمعلوم أن العمران البشري كله يدور مباشرة حول موضوعين وردا في سورة النساء، ويدور بصورة غير مباشرة حول نوعي السلطان الناتجين عنهما في العمران. ويعبر عن الأمرين المباشرين في الأنثروبولوجيا بمادتي التبادل الأساسيتين وموضوعي التواصلين المصاحبين لهما موضوعيه الجوهريين إما لعلمه (مصدر السلطان الرمزي) أو للعمل به (مصدر السلطان الفعلي).
فالعمران كما يمكن أن يستنتج من نظرية ابن خلدون ومن تفسير سورة يوسف، عليه السلام، ليس هو إلا الحل الذي تمكن الإنسان من وضعه خلال تاريخه المتعثر لعلاج هذين التبادلين والسلطانين المترتبين عليهما من أجل تحقيق الوحدة المتعالية عليها أربعتها بوصفها الوجود المادي والروحي للجماعة البشرية:
فالتبادلان المقومان للعمران هما:
- التساكن للتآنس ويدور حول معنى الذوق وأصله الحب عامة والحب المؤسس للوحدة الدنيا للقيام الإنساني الروحي أو الأسرة.
- والتعاون للتعايش ويدور حول معنى الرزق وأصله المعاش عامة والمعاش المؤسس للوحدة الدنيا للقيام الإنساني المادي أو المؤسسة الاقتصادية.
وكلا التبادلين مصحوب بتواصليين هما بالجوهر علم وعمل لما يقتضيانه من نظام يزع المتبادلين ويضبط الحقوق والواجبات:
- فالأول؛ نظامه ووازعه خلقي روحي ومهمته الوزع الداخلي والأمن الخارجي في المستوى الرمزي من وجود الإنسان.
- والثاني؛ نظامه ووازعه سياسي زماني ومهمته الوزع الداخلي والأمن الخارجي في المستوى المادي من وجود الإنسان.
ولا يتحقق التلاحم بين المستويين المضاعفين من العمران من دون مبدأ موحد:
- ثم مبدأ عام يوحد الكل في الجماعة ذات الهوية شبه الواعية بكونها ذات منفصلة عما عداها من الجماعات بكيان تاريخي جغرافي معين يمكن أن نسميه أمة.
فأما التبادل الأول فهو التبادل الذوقي عامة وأهم شيء فيه هو الحب والتواصل العاطفي الذي تنبني عليه الحياة التآنسية والتواصل بين وحدات إنتاج الإنسان نفسه في المجتمع: الأسر سواء في أضيق مستوياتها (الخلية الأسرية الدنيا) أو في أوسعها (القبيلة).
وأما التبادل الثاني فهو التبادل الرزقي عامة وأهم شيء فيه هو ملكية موارد العيش والتواصل المصلحي الذي تبني عليه الحياة الاقتصادية والتواصل بين وحدات إنتاج أسباب عيش الإنسان في المجتمع.
والمعلوم أن السلطان على محددات التواصل الأول والسلطان على محددات التواصل الثاني ينسحب كل منهما على الآخر. وغالبا ما يصبح العامل الثاني المحدد الأساسي للعامل الأول؛ أي إن الزيجات تكون في الأغلب مصلحية فلا يكون الذوق هو المحدد، بل الرزق هو الذي يعود إليه التحديد في المقام الأول؛ إذ يدخل في الاعتبار عامل الملكية والإرث المتوقع قبل عامل الذوق؛ وخاصة في المستويات التي تصبح فيها الملكية ذات دلالة سلطانية أي تمكن من سلطان ما يقاس بالمنـزلة في السلم الاجتماعي…
لذلك فإن تحرير المبدأ الأول (سلطان الذوق) من تأثير المبدأ الثاني (سلطان الرزق) ييسر التبادل الذوقي أو بلغة سطحية يجعل تبادل النساء متحررا ما أمكن التحرر من تأثير تبادل الرزق. وذلك هو الشرط الضروري ولعله الكافي كذلك لتشجيع التزاوج الخارجي والعزوف عن التزاوج الداخلي فيحصل التبادلان بأفضل طريقة للفصل بينهما ما أمكن أعني بالحد من تأثير الثاني في الأول: التبادل الذوقي والتبادل الرزقي. ثم إن هذا الشرط لا يقتصر على تشجيع التزاوج الخارجي، بل هو أيضا يحافظ على معنى التقابل بين الداخل والخارج بمعيار موضوعي فيمكن من تمتين التلاحم الداخلي في الوحدات الدنيا ومن توطيد التواصل الخارجي بينها: «فالثبات النسبي لملكية الأرض أو رأس المال مثلا في الأسرة يجعل الملكية تنمو ويقلل من انفراط الوحدات الدنيا للعمران أعني وحدات التساكن للتآنس».
ومن له دراية بعلم الاقتصاد يدرك أن الاقتصاد العالمي اليوم يقوم على أساسين ليس منهما بد: إحداهما محررة للإنسان والثانية مستعبدة له. فالوحدات الاقتصادية ذوات الاسم الخفي تزيل الحدود بين الوحدات الدنيا (الأسر والشركات الأسرية)، بل وحتى بين الوحدات القصوى (مثل الأمم والدول) فتزيل النسيج الاجتماعي عامة؛ سواء كان وطنيا أو دوليا ويصبح الجميع أرقاما في آلة جهنمية هي بالذات مجتمع الحداثة التي يكون فيها الإنسان لولبا من لوالب السوق أو برغيا من براغيه. والشركات المتوسطة والصغرى، وهي في الأغلب أسرية، لا تقتصر على المحافظة على الملكية وحدها، بل هي تحافظ في نفس الوقت على النسيج الإنساني الذي هو المطلوب الأول والأخير للحياة البشرية إلا عند من يفضل الأرقام على البشر. ثم إن دورها التنموي لا يقل عن دور الأولى بل إن دورها التنموي أهم بكثير، لأنها هي التي تمثل أهم مغذ لسوق الشغل إذ إن الشركات الكبرى تستعيض بالآلة عن العمال والشركات الصغرى ليس لها القدرة على كلفة الآلات فتبقى مصدرا مهما للعمل الإنساني.
بل إن الشركات ذات الاسم الخفي بخلاف ما يظن من ليس له علم بالاقتصاد الحديث لا تستمد قوتها الاقتصادية إلا من هذه الشركات ذات الاسم العلني الذي هو في الغالب اسم أسرة: «إنها في الحقيقة ليست وحدات إنتاج، بل هي وحدات تسيير للإنتاج الذي لا يتحقق حقا إلى في الشرطات الصغرى والمتوسطة، وهي، إذن، من جنس تغول السلطان الرزقي الذي يلغي الذوق لكي لا يبقي إلا على سلطان السوق». وذلك هو المعنى الحقيقي لمصطلح الاستمداد الخارجي الانجليزي Outsourcing الذي لجأ إليه الاقتصاد الحديث للجمع بين الشكلين من عمل الملكية من حيث هي أداة إنتاج اقتصادي ويماثله انتقال وحدات الإنتاج إلى البلاد النامية بالمصطلح الفرنسي Délocalisation حيث لا يزال العمل جاريا في وحدات صغرى تحافظ على التساكن من أجل التآنس، وحيث لا يزال لهاتين الكلمتين معنى عند أهل البلاد التي تنتقل إليها الصناعات الفرعية المغذية للشركات الأم.
المثال الرابع: ويتعلق بمسألة السلطان على الحياة الروحية (الذوق) والزمانية (الرزق)
نمثـل فيه لحكم مقومي صـورة العمران (سلطة الذوق أو أصـل التربية وسلــطة الرزق أو أصل الدولة) معا: من سورة الشورى([43]). فالآية: 38 من الشورى حددت حكم الحكم بمعناه السياسي فعرضت الحل الذي يقدمه القرآن الكريم لحسم الخلاف بين البشر كلهم؛ فضلا عن الخلاف بين فرق المسلمين الذي ما كان ليوجد لو راعى علماؤنا وأمراؤنا أحكام القرآن الكريم. فهذه الآية حددت المبادئ الخمسة التي يستند إليها الحكم فعالجت علاجا وافيا وشافيا أسباب الفرقة بين فرقتي الإسلام الرئيسيتين: «1. والذين اَستجابوا لربهم 2. وأقاموا الصلاة 3. و(أمر)+(هم) 4. (شورى)+(بينهم) 5. ومما رزقناهم ينفقون».
- فالمبدأ الأول؛ الذي تتفرع عنه كل المبادئ الأخرى هو إيجابا الاستجابة للرب، ويتضمن الدلالة المسلوبة أعني تحرير الإنسان من الاستجابة لغير الرب أو من الطغيان والكفر بالطاغوت شرط في الإيمان بالله كما حددت ذلك الآية 256 من البقرة.
- والمبدأ الثاني؛ هو رمز العبادات الدال على هذه الاستجابة وقد اختيرت الصلاة من بين الفروض الدينية رمزا للتعبد لأنها رأس العبادة.
- والمبدأ الأخير؛ هو رمز المعاملات الدال على امتطاء الدنيا لتحقيق الاستجابة أو العبادة الحقيقية وقد اختيرت الزكاة والصدقة رمزا عليها وهي الإنفاق من الرزق.
- والمبدأ قبل الأخير؛ هو آلية الحكم التي عرفت بكونها التشاور دون تفاضل بين المتشاورين لذلك فصلنا بين «شورى» وبين «بينهم» لإبراز هذا القصد: فهي شورى بين الجميع وليس بين جماعة يطلق عليها أهل الحل والعقد أو أولى الأمر بمعنى العلماء والأمراء وحدهم. ويمكن تصور هذين الفهمين تاليين عن الفهم الأصل؛ «أي إن التشاور بين الكل يمكن أن يختار من يصبحون أهل حل وعقد بما يشبه التوكيل الشرعي وليس بمجرد الاستحواذ من دون تعاقد صريح يسهم فيه الجميع».
- والمبدأ النواة أو قلب المعادلة الإسلامية البديل من الحكم الفرعوني التام (الحلف بين هامان وفرعون كما نراه اليوم بين هامان الفاتيكان وفرعون البيت الأبيض) ومن شقيه (هامان طاغية أو الحكم الكنسي أو فرعون طاغية أو الحكم العلماني) الذي يدور حوله ما تقدم عليه (المبدآن الأولان) وما تأخر عنه (المبدآن الأخيران) هو طبيعة الحكم: إنه «أمر+هم». وقد فصلنا بين المضاف والمضاف إليه لنبرز القصد من الإضافة. فهي تعني أن الأمر كل الأمر هو أمر الجماعة التي هي صاحبة الأمر أعني الحكم. وهذا الأمر لا يكون إلا بآلية الشورى التي لا يتفاضل فيها أحد على أحد إلا بالتقوى والعلم. فيكون النص وكأنه حدد طبيعة النظام فجعله جمهورية (الأمر للجماعة) ديموقراطية (شورى بين أفراد الجماعة).
وبذلك فإن القرآن قد حررنا من الدائين اللذين تعاني منهما الإنسانية ويكاد المسلمون أن ينكصوا إليهما:
- الهامانية التي سيطرت في نظرية الطغيان باسم الحكم بالحق الإلهي النافي لحق الإنسان.
- والفرعونية التي سيطرت في نظرية الطغيان باسم الحق الإنساني النافي لحق الإله.
- والطغيان المطلق الجامع بين الطغيانين كما في حكم المافيا العولمية التي ليس البابا وبوش إلا وجهها الناطق الرسمي بما تزين به ما شان من أفعالها.
فالقرآن الكريم حررنا من الهامانية لما نهى عن الرهبانية وأزال السلطة الكنسية. كما حررنا من الفرعونية لما جعل الحاكمية لله بشرعه ولم يجعله نـزوات أصحاب القوة والشوكة لفرض إرادتهم وهواهم. وحررنا من الحلف اللعين بين الطاغوتين عندما خصص كل سورة آل عمران لنتائج هذا الحلف (تأليه عيسى وعبادة البعض للبعض) وآلياته (التحريف المادي والتأويلي للشرع الإلهي). لكن المفكرين المسلمين يتصورون أنفسهم فلاسفة لمجرد أخذ علم الكلام المسيحي المتخفي في ثوب العلمانية فيتصورون عقلانية ما هو مجرد إيديولوجية أساسها الفصل بين الدين والدنيا؛ الفصل الذي كانت ثمرته المرة الاستبداد المادي (الذي هو بيد أمراء سوق الرزق الدولية ملوثي البيئة الطبيعية) والاستعباد الروحي (الذي هو بيد أمراء سوق الذوق الدولية ملوثي البيئة الثقافية).
المثال الأخير ويتعلق بالأصل أي بحرية الإيمان أو قيام بما يأتي من الواجد
نمثل فيه لحكم العقد الأساس أعني حرية العقيدة التي تنتج عنها كل الأحكام الأخرى في الإسلام مثل تعدد الأديان وتعدد الشرائع والإرجاء في الغيبيات: من البقرة حول حرية العقيدة([44]). ولنضرب مثالا حكم حرية المعتقد لنبين كيف أن الاقتصار على النص وحده مع اعتبار الأفق المبين المعتمد على الصفتين اللتين ختمت بهما الآية يغنيان عن النظر في أي سياق خارجي مقاليا كان أو مقاميا: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾؛ فقصد الآية لا يمكن فهمه إنشائيا بمعنى الإنشاء من عدم كالأمر بالممكن أو بالمستحيل، بل أتى النهي عن الإكراه فيها نتيجة لتقرير حقيقة خبرية مفادها امتناع الإكراه في الدين لمن كان مؤمنا حقا حقيقة تقال لتذكير من لا يعلمها إذا أقدم على إكراه المؤمنين كما يفعل الطغاة. إن عبارة «لا إكراه في الدين» ليست أمرا غفلا بل هي لمن يعرف أساليب القرآن الكريم فيفهمها في ضوء الأفق المبين كما حددته الصفتان اللتان ختمت بهما الآية ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ نتيجة استدلال صارم نتيجة تقرر ثمرة الإيمان الحقيقي؛ إذ هي تقوم على دليلين يثبتان استحالة الإكراه في الدين ولا تقتصر على النهي عن الإكراه فيه:
فأما الدليل الأول فصورته البلاغية مبنية على الإيجاز القرآني المعجز. لم يبق نص الآية منه إلا تحقق الشرط والنتيجة بترتيب عبارته تقدم النتيجة على تحقق الشرط مع إضمار العلاقة الشرطية بمقدمها (الشرط) وتاليها (المشروط). وكل ذلك من بلاغة القرآن التي لا يدركها من يجهل منه اللسان. فـ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ هي في الحقيقة نتيجة لشرطية متصلة موجبة المضمر منها هو نص العلاقة الشرطية الكامل (إذا تبين الرشد من الغي امتنع الإكراه في الدين) والمعلن هو النتيجة (لا إكراه في الدين) وتحقق الشرط (قد تبين الرشد من الغي). وكل ذلك في القسم الأول من الآية القسم الذي يمكن تحليل صورته على النحو التالي:
العلاقة الشرطية (مضمرة): إذا تبين الرشد من الغي (مقدم) امتنع الإكراه في الدين (تال).
ملاحظة تحقق الشرط (مضمرة): تبين الرشد من الغي بنـزول القرآن الكريم وتعريف الذات الإلهية في آية الكرسي المتقدمة على هذه الآية.
النتيجة: لا إكراه في الدين ومعناه امتنع الإكراه في الدين.
ويكفي تحليل العلاقة بين قسمي العبارة «لا إكراه في الدين» و«قد تبين الرشد من الغي» حتى يتجلى أنها تضمر فاء التعليل قبل «قد» لأن مفاد القول هو: «لا إكراه في الدين (ف) قد تبين الرشد من الغي». فيكون التلو للتعليل «لا إكراه لأنه تبين» وليس لمجرد التوالي الزماني «لا إكراه بعد أن تبين»: نـزول القرآن والرسالة الخاتمة يجعلان الإنسان يتبين الرشد من الغي فيدرك إدراكا ضروريا امتناع الإكراه في الدين.
وإذن، فالأمر بعدم الإكراه مبني على تقرير حقيقة حصلت فعلا حدوث الفعل التاريخي بنـزول القرآن الذي يبين الرشد من الغي، فكانت سببا في حقيقة معرفية تحصل دائما في وعي الإنسان كلما توفرت شروطها. وإذن فالأمر هنا ليس مجرد إنشاء يمكن أن يعبر عن ضعف وخوف وسرعان ما يزول بزوالهما.
وبذلك نفهم لم يتكلم القرآن الكريم دائما عن التعدد الديني بوصفه سنة من سنن الله التي لن تجد لها تبديلا أو تحويلا، واعتبر كل محاولة لمنعه خروجا عن هذه السنة. فالله لو أراد وحدة الأديان في التاريخ لجعل الناس أمة واحدة رغم الإخبار بأنهم أمة واحدة في المثال المصحوب بالنهي عن السعي لجعلهم أمة واحدة في الواقع؛ لأن الدين عند الله الإسلام في الواجب وهو متعدد في الواقع حتى يسلم من يسلم وهو مختار ويكفر من يكفر وهو مختار. ذلك أن المسافة بين الحاصل في التاريخ والواجب في المثال هي فسحة الفعل الحر في الاعتقاد الذي يكتمل عندما يقترب التاريخ من المثال فيحصل الإدراك الجازم بامتناع الإكراه في الدين: «من دون ذلك لن يكون تبين الرشد من الغي ثمرة للاجتهاد وحماية حرية المعتقد ثمرة للجهاد».
لذلك فقد فرض القرآن على المسلمين حماية حرية المعتقد في كل الأديان بالجهاد، وكلف الدولة الإسلامية بحماية أصحاب ديانات ثلاث يعترف بها حمايتهم في ممارسة طقوسهم اثنان منها لهما رسالة منـزلة حتى وإن كنا نعتقد أن القيمين عليها حرفوها (أهل الكتاب من اليهود والنصارى) والثالث دين طبيعي (الصابئة). كما وعد القرآن أصحاب هذه الأديان بعدم الخوف والحزن مثلهم مثل المسلمين إذا آمنوا وعملوا صالحا. وباقي الأديان غير المعترف بها أعني المجوسية وكل أصناف الشرك وقف القرآن من أصحابها موقف الإرجاء في ما يختلفون فيه مع المسلمين. ومن ثم فهو لم يأمر بمنعها حتى وإن لم يأمر بحمايتها كما فعل مع الأديان الثلاثة المعترف بها. وكل هذه الحقائق لا تحتاج إلى دليل أو إحالة لأن الآيات التي تنص عليها يعلمها كل من قرأ القرآن الكريم حتى مترجما.
أما الدليل الثاني الوارد في الآية فدوره أن يحدد طبيعة من يتبين الرشد من الغي فلا يكون قابلا للإكراه في الدين بفعلين أساسيين يبرزان الوجه السالب والوجه الموجب من الحقيقة الواحدة للدين المطلق الذي دعت إليه الرسالة الخاتمة وهما:
- الكفر بالطاغوت.
- والإيمان بالله.
وهو كذلك على صورة الشرطية المتصلة مثل الدليل الأول دون قلب بين المقدم والتالي في عبارة النتيجة. فقد جاءت صورته البلاغية على الترتيب المنطقي العادي بين النتيجة وشرطها رغم ازدواج مقدمته بسبب ازدواج نتيجته. ولن نهتم بتحليل الصورة المنطقية؛ إذ ليس فيها قلب كما في الحالة الأولى فتستغني عن التحليل. لذلك فسنكتفي بإبراز العلاقة الثورية بين مقومي الدين السلبي والإيجابي الدالين على الإيمان التام العلاقة بينهما، وبين عنصري الدليل الأول عنصريه السلبي والإيجابي: «علاقة الإكراه في الدين بالكفر بالطاغوت (العلاقة بين العنصرين السلبيين) وعلاقة تبين الرشد من الغي بالإيمان بالله (العلاقة بين العنصرين الإيجابيين)».
فالإكراه في الدين في الدليل الأول يناظره الكفر بالطاغوت في الدليل الثاني. والكفر بالطاغوت يحرر المؤمن الصادق من الإكراه في الدين: «من يكفر بالطاغوت يتحرر من الإكراه في الدين ومن يتحرر من الإكراه في الدين يكفر بالطاغوت». وكلاهما يكون في وضع الانفعال (لا يقبل أن يكرهه أحد في دينه) وفي وضع الفعل (لا يريد أن يكره أحدا في دينه). فيكون عدم قابلية الإكراه ثمرة الكفر بالطاغوت فعلا وانفعالا: «وذلك لا يكون إلا بالجهاد ضد من يمنع حرية العبادة والتصدي لمنع حرية العبادة هو أحد العلتين اللتين تشرعان الجهاد في الإسلام حصرا فيهما لكونهما فرعي الفساد في الأرض الروحي (منع حرية العبادة) والمادي (العدوان على المستضعفين)([45]). وهذا هو الجهاد الأصغر الذي يكون فيه رد الفعل (سلب) محررا من العدوان (سلب): «فيكون الجهاد الأصغر تصديا للعدوان أو محو سلب».
وتبين الرشد من الغي في الدليل الأول يناظره الإيمان بالله في الدليل الثاني. وكلاهما يحقق الآخر ويتحقق به: «من يؤمن بالله يتبين الرشد من الغي ومن يتبين الرشد من الغي يؤمن بالله». فيكون تبين الرشد من الغي ثمرة الإيمان بالله والسبيل إليه: «وذلك لا يكون إلا بالاجتهاد في التفكر والتدبر لتبين الرشد من الغي والوصول إلى الإيمان بالله؛ أعني نظام الدعوة القرآنية التي لا تعتمد سبيلا أخرى لإنارة العقل والوجدان». وهذا هو الاجتهاد وهو ليس هو شيئا آخر غير الجهاد الأكبر. فتبين الرشد فعل (إيجاب) والإيمان بالله فعل (إيجاب): «فيكون الجهاد الأكبر تعميقا للسلام أو تثبيت إيجاب».
والجمع بين الأمرين؛ أعني الجهاد ضد الطاغوت والاجتهاد لتبين الرشد من أجل الإيمان هو الذي استعار له القرآن الكريم اسم الاستمساك بالعروة الوثقى (التي) لا انفصام لها. والعروة الوثقى التي لا انفصام لها هي الدين السوي الذي لا إكراه فيه؛ أي الذي لا يمكن الإكراه فيه سواء كان له أو عليه: «فمن يكفر بالطاغوت؛ أي من يجاهد الطاغوت ومن يؤمن بالله أي من يجتهد للإيمان به على علم لا يمكن أن يجبره أحد على الكفر بالدين الحق أو على الإيمان بالدين الزيف، وهو لا يسعى إلى إجبار أحد عليهما وإن كان من واجبه أن يسعى بالتي هي أحسن لتبليغ الدعوة إليهما.
الخاتمة
إذا تحققت كل هذه الشروط التي حاولنا حصرها وتحديد مقوماتها نكون قد حققنا نقلة نوعية في فهم النص الديني أشبه بما حصل في الرياضيات عند اكتشاف منهج تحليل اللامتناهي. فنظرية الأفق المبين ورد كل التفسير إلى البنية الصورية والمنطقية للنص المستغني عن كل سياق خارجي يرفعنا إلى مستوى الفهم الذي يمكن للرسالة كما ينبغي أن لها لتكون حقا خاتمة الرسالات وفاتحتها تعيينا للفطرة الإنسانية الغفل في البداية والنقدية في الغاية بفضل التصديق والهيمنة. فيتبين بذلك أن التشريعات القرآنية هي أفضل التشريعات الممكنة عقلا لأنها لا تشرع خلقا إلا ما كان موافقا للخلقة وهو معنى الفطرة الإنسانية. ويترتب على ذلك نتيجتان لو عمل بهما فقهاؤنا ومتكلمونا لكان الإسلام حقا أكثر الأديان انتشارا ولكانت مناهج الدعوة أقل المناهج عند العالمين استنكارا:
النتيجة الأولى؛ هي أن التربية الدينية غنية عن العنف لأنها ينبغي أن تكون مجرد الحفاظ على الفطرة السوية ومن ثم فدورها ليس تلقين عادات منافية للخلقة بل تحرير الإنسان منها أي منع التدجين الثقافي من قتل المؤهلات الطبيعية: يولد الإنسان على الفطرة وأبواه…
والثانية؛ وهي الأهم هي أن أحكام القرآن ينبغي أن تؤخذ بكل مراحلها التي تحدد مراحل التدرج في الإيمان فيكون الإنسان مسلما من أدناها إلى أقصاها ولا يمكن حصر مفهوم الإسلام في من ينطبق عليه أقصاها بل كل السلسلة.
ومعنى ذلك أن المراحل التي يتألف منها سن أي حكم هي الرتب الإيمانية التي يعترف بها القرآن ويحتفظ بها علامات ثابتة في التدرج التربوي الذي تنبني عليه التربية الروحية وشروط الخلق السوي في الحضارة الإسلامية لتكون نموذجا للحضارة الإنسانية كلها([46]). ويكفي حصرها لمعرفة تلك المراحل ومن ثم اعتبار أحكامها صالحة دائما وليست منسوخة إلا عند من يريد أن يرتقي إلى الدرجة الموالية منها في السمو الروحي. ذلك أن القيم كلها متراتبة الدرجات: «ففي قيم الذوق وقيم الرزق وقيم النظر أو سلطان الذوق وقيم العمل أو سلطان الرزق وقيم الوجود لا تتساوى الناس، بل تتراتب وكلها لها نصيب منها هو كسبها الاجتهادي علما والجهادي عملا، ويجمع بين المفهومين التربية المجاهدة»([47]).
وليس من شك في أن الكثير ممن يتقحم الكلام في الدين والفلسفة سيجادل في مضمون هذه المحاولة طلبا لحصر حق الكلام في مثل هذه القضايا بين أيدي «العلماء» مواصلة للفصل التقليدي بين مجالات الاجتهاد؛ أعني مصدر الحال التي عليها علوم الأمة وما حل بها من جمود وجماد. لذلك فلابد هنا من حسم أمر هذه المسألة المعرفية أعني المسألة التي بقيت ضمير كل أعمال ابن تيمية وابن خلدون: «ما طبيعة العلاج المتقدم على المقابلة بين مسائل العقل ومسائل النقل العلاج القادر على تخليصنا من الحلول الزائفة بالتوفيق بينهما ردا لهذا إلى ذاك أو ذاك إلى هذا؟».
فكل إيهام بأن علوم الملة لَها مَا لِأَصليها من القدسية التي تحول دون المرء وتجاوزها إلى المعرفة العقلية ليس دليلا على صدق الإيمان، بل هو عين البهتان والتحيل على مقاصد القرآن. إنما هو في الحقيقة ناتج عن كل تمويه بالسلطان الديني الذي يريد أن يفحم الخصوم بأن يفرض عليهم بما يبدو وكأنه يلزمهم به من نفي لحجية القرآن والسنة. وحتى أطمئن كل المجادلين بهذه الطريقة المنافية لمنهج القرآن فضلا عن أخلاق العلم ولئلا يعود أحد إلى مثل هذا فليعلم الجميع أن: «القرآن والسنة هما اللذان ينهيان الاحتجاج بهما من حيث هما نص ويدعوان إلى الاحتجاج بما يحتجان به هما بدورهما في الدعوة إلى الحق وبنفس الكيفية، أعني بالمنهج العقلي ذي الضوابط الخلقية والمعرفة التجريبية ذات النسقية المنطقية التي تعتبر الوجود في قيامه العيني حجة مؤيدة لصورته النصية، بل هي السبيل الوحيدة لفهم هذه الصورة». لذلك فهما يقتصران على وظيفتين لا يعدوانهما في الاحتجاج للدعوة:
- وظيفة النداء إلى ضرورة الاحتجاج في كل دعوى بمؤيدات من الوجود وليس من النصوص.
- ووظيفة شرعة الاحتجاج في الدعوة بهذه المؤيدات شرعتها بصنفيها المنهجي والخلقي.
وما مضمون ما يثبتانه بالحجة مقبول ليس لأنه منصوص عليه فيهما، إذ لابد من تحرير القصد في النص ولا يكون بالنص من دون دور، بل لأنهما أثبتاه بالحجة المصاحبة له أي إن القرآن والحديث لا يعتمدان على حجة السلطة، بل على سلطة الحجة المستمدة من العلم بالوجود، وليس من الأحكام النصية التي هي نتيجة للاستدلال الدعوي وليست مقدمة له([48]). ومن لم يفهم ذلك فلن يفهم علة كون القرآن شبكة من الاستدلال بالاعتبار الوجودي الاستدلالي الذي لن تجد له نظيرا في أي نص ديني سابق: «وتلك هي علة كونه خاتما بمنطق التصديق (نقد النصوص السابقة نقدا يوصل إلى التمييز بين ما يصدقه وما يكذبه) والهيمنة (تجاوز التجارب الروحية السابقة إلى ما يحقق ما لم يتحقق فيها) فيكون بذلك ليس بمعنى غلق مسار سابق بل فتح مسار إلى يوم الدين بإزالة ما جمد المسار من الأول وكان ينبغي ألا يوجد: حجة السلطة التي حالت دون منهج التصديق والهيمنة».
ذلك أنه لو كان القرآن والسنة حجةَ سلطة في ما يدعوان الناس إليه لكان يكفي النبيء أن يقرأ على المخاطبين آيات من القرآن، أو أن يتفوه بحديث دون حاجة إلى الاستدلال بالاعتبار العلمي والاحتجاج بالسنن التاريخية كما يقتضي ذلك الفرق بين حجة السلطة وسلطة الحجة: «الإمام المعصوم عند الشيعة والبابا عند المسيحيين تغنيهما حجة السلطة عن سلطة الحجة». لكن القرآن كله دعوة تخاطب عقول المدعوين للنظر في ما يقدمه لهم من حجح وما يوجههم إليه من مجالات الاعتبار والبحث العلمي، وكذلك ينبغي أن يكون سلوك كل عالم مسلم: «لا تجد في القرآن الكريم حجة السلطة التي تستغني عن الدليل بل سلطة الحجة التي تستغني عن السلطة حتى وإن كان القرآن يسمي الأمرين سلطانا».
ولعل الدليل الذي ليس بعده دليل على ما ندعي حول طبيعة الحجة التي يطلبها القرآن هو ردود القرآن على المعاجزين إلى حد بيان عدم الحاجة إلى المعجزات لأنها أولا؛ لم تفد في الماضي لإقناع الناس ولأنها ثانيا؛ ما جعلت إلا لتخويف من لم يرزقه الله بعقل يفهم وقلب يهتدي. ومن باب أولى أن يكون الحديث مستندا إلى سلطة الحجة لا حجة السلطة: «فمثاله هو القرآن وهو في الغاية التفسير النبوي للقرآن».
وإذن، فكون القرآن معجزة الإسلام الوحيدة لا يعني أن معجزة الإسلام هي النصية، بل يعني أن الإسلام يستبدل الحجية النصية بحجية الاعتبار العلمي المستند إلا المنهج العقلي، وأن معجزته الوحيدة هي دعوة النص إلى التحدي الدائم لحجة السلطة بسلطة الحجة؛ أي طلب الحقيقة من معينها.
لذلك فليس الإعجاز القرآني إلا الاقتصار على دعوة الإنسان من منطلق ما يتقوم به جوهره عندما يستعمله في استعماره العالم الذي استخلف فيه وكلف برعايته على علم: «يخاطب العاقل بعقله ويجعل المعقولية معيار خياره العقدي حتى إن حرية المعتقد أسست على تبين الرشد من الغي؛ أي عاقلية الإنسان (انظر سورة البقرة/الآية: 256) بعد تحريره مما يفسد على عقله القدرة على التمييز بينهما أي سلطان الطاغوت؛ أي حجة السلطة فكان الكفر بها مشروطا في الإيمان بالله». ومعنى ذلك أن خطاب العاقل بعقله لا يغني عن الحاجة إلى الهدي الإلهي في مجالين ليس للعقل من دونهما معنى. فهو يقتضي تربية الإنسان الخلقية وتربيته المعرفية. فالعقل ليس المقصود به مجرد الملكة النفسية الغفل بل هو الملكة التي هذبتها التربية الخلقية والتربية المعرفية المحررتين من عوائق المعرفة السوية:
فأما تربيته الخلقية فهي الشرعة وتتعلق بالأخلاق عامة وبأخلاق الحجاج خاصة وتلك هي مقومات علم نفس طلب الحقيقة أو الدعوة إليها وأخلاقهما التي هي الجزء الرئيس من فلسفة القرآن الخلقية: «وقد حصر الله أخلاق طلب الحقيقة والدعوة إليها في أخلاق الاجتهاد طلبا لشروط العلم والعمل على علم لأن التأثير يكون بالمثال لا بالأغلال».
وأما تربيته المعرفية فهي المنهاج وتتعلق بمناهج طلب الحقيقة والدعوة إليها وتوجيه الفكر إلى أحيازها ليبحث عنها: وقد حصر القرآن الكريم المناهج في المعرفة الحسية والتجريبية الجامعة بين الحس والمنطق كما حصر الأحياز أو مجالات البحث المعرفي مجالاته الشاهدة في خمسة مجالات لا تعدوها هي أصناف الآيات وهي:
- العالم الطبيعي.
- والعالم التاريخي.
- والنفس البشرية.
- والتجارب الروحية أو تاريخ الرسالات.
- ثم القرآن الكريم بوصفه ذورتها وسر أسرارها جميعا.
ويجمع بين التربيتين علة الحاجة إليهما لن يكون المكلف راشدا من دون الإيمان بها: إنها الإيمان بنظرية الوجود القرآنية أو علاقة الإنسان الشهودية التي تحرره من وهم العلم المحيط والعمل المطلق. وبهما يتحرر الإنسان من وهم التأله الذي يعتبره القرآن الكريم أساس كل الانحرافات الدينية والفلسفية في تاريخ البشرية كما تبين آيات آل عمران وغايتها تبرئة المسيح عليه السلام من هذا الوهم: «فكل هذه المجالات ليست إلا آيات يدل بها عالم الشهادة على عالم الغيب من ورائه، وذلك هو الوحيد مجال الإيمان وليس فيه علم لأحد يمكن أن يدعيه لأنه الغيب محجوب حتى عن الأنبياء بشهادة رسولنا الكريم في مسألة الروح. ولو كان عالم الغيب غير محجوب لكان من ينكشف له قائلا بحجة السلطة كما هي الحال عند أدعياء التصوف العرفاني».
لذلك فالحجج النصية ليست حججا، بل هي أفخاخ ينصبها كل من يريد أن يستمد سلطة من النصوص يسكت بها خصومه تحصنا بقدسية النص للإلجام لا للإفهام، وهي تستعمل في الغالب لتأليب العوام. ولما كنا لا نقبل حتى بإلجام العوام فكيف نسكت على إلجام العلماء لمجرد كونهم يسعون إلى تحرير علوم الملة من الجمود علما وأن التمييز بين علماء العقل وعملاء النقل في الإلهيات وحتى بين العالم والعامي إذا أمده الله بنور الإيمان لا معنى له عند مسلم فهم طبيعة الخطاب القرآني: «فالقرآن قد خاطب الناس من حيث هم عقلاء دون تمييز بينهم إلا بالدرجة لا بالطبيعة». لاشك أن بعض الناس أعلم من بعضهم الآخر في أحد المجالات، لكن لا أحد يمكن أن يعد عالما بإطلاق ولا أحد يمكن أن يعد عاميا بإطلاق، بل من هو أعلم في مجال قد يكون أجهل في مجال آخر والعكس بالعكس.
وقد اعتبرت هذه الإشكالية ضمير الفكر التيمي والخلدوني؛ لأن ابن خلدون عمل بالحل دون طرح المشكل طرحا صريحا، وابن تيمية طرح المشكل وعمل بالحل دون صوغه صوغا يحرره من الطابع الجدالي لفكره (في الدرء خاصة). ونحن قد حاولنا بيان شروط صوغ المشكل والحل لنصل إلى الحل العلمي: «فما قبل المقابلة بين العقل والنقل هو ما يمكن من الحكم بأن صريح المعقول لا يعارض صحيح المنقول؛ أعني الاقتصار على ما ينتج عن النظر بمقتضى الأفقين بأداة المنطق وحدها دون لجوء للمضمون التاريخي الذي هو أمثلة من المعاني العامة وليس ما يفيده النص بالقصد الأول».
وهو حكم ممتنع من دون حكمين سابقين يحددان صريح المعقول وصحيح المنقول بعلم لا يصبح عليه أي من هذين الوصفين المستثني للوصف الثاني، ولما كان صريح المعقول هو المعقول الخالص وصحيح المنقول هو المنقول الخالص بات من الواجب وضع العلم المحدد للخالص من المعقول والخالص من المنقول. والمنقول الخالص هو المضمون القضوي سواء كان من التاريخ أو من الطبيعة أو مما بعدهما. وصريح المعقول الخالص هو الحكم الذي من المفروض أن يكون الحقيقة المطابقة للمضمون القضوي الخالص، أو إن شئنا الموقف القضوي العلمي أعني المعرفة ذات المطابقة التامة مع مضمون القضية ومن ثم المتحررة من الذاتية لكونها عين الحقيقة.
فيكون العلم المتقدم على المقابلة بين العقل والنقل هو المنهج الذي يخلص العقل من الذاتية ليطابق النقل الصحيح، وذلك هو المنهج المنطقي الجديد والمنهج الذي يخلص النقل مما ليس من الموضوع أي الذي يحقق الموضوعية وذلك هو المنهج التاريخي الجديد: «وتلك هي ثورة فيلسوفي النهضة العربية الإسلامية ابن تيمية وابن خلدون». وبصورة أدق فالأمر المتقدم على المقابلة هو منهج صورة المعرفة الخالصة ومنهج مادة المعرفة الخالصة الساعيان لتحقيق التطابق بينهما. لذلك فالقضية التي عالجناها في بحثنا تبدو نقلية وعلاجها يبدو عقليا: لكنها في الحقيقة قضية متقدمة على المقابلة بين النقلي والعقلي لأنها من مسائل المنهج الذي يحقق التطابق بين صورة العلم ومادته الخالصتين.
ولعل مسك الختام هو بيان مدلول الخيرية([49]) التي توصف بها أمة محمد وشروطها لأن كل الأحكام القرآنية والسنية ليس لها من هدف إلا تحقيق هذه الشروط بالتربية الإسلامية القويمة حتى تكون الأمة أهلا للشهادة على العالمين. فالآية: 110 من ءال عمران عسيرة التفسير: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آَمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾؛ فهي لا يمكن أن تكون خبرية مرسلة، بل هي خبرية مشروطة. فلكأن المعنى هو أن المخاطبين «يكونون خير أمة ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر». فيكون الأمر والنهي المشار إليهما شرطي الخيرية، ومن ثم فالخيرية تصبح وصفا عاما يستحقه كل من قام بالأمر والنهي المشار إليهما. فلا تكون خبرا يصف المسلمين بالمعنى الذي ينطبق على جماعة مشار إليها في التاريخ، بل حدا ورسما لمن ينبغي أن يتصف بالخيرية فيعد مسلما.
وتوجد خمس قرائن تؤيد هذا الفهم اثنتان من آية الخيرية ذات الصيغة الخبرية هذه، واثنتان من آية الخيرية الإنشائية (الآية: 104 من سورة ءال عمران)، والخامسة جامعة بين الآيتين وتستمد من الآيات الخمس المتوسطة بين الآيتين 104 و110 من سورة ءال عمران. فهو أولا فهم يخلص الآية: 110 من حصرها في ظرفها خطابا لجماعة من المسلمين قد يكون الرسول توجه إليهم به في مكان وزمان محددين؛ إذ لو قرئت خطابا محددا بظرفيه الزماني والمكاني لكانت ربما دالة على لوم المخاطبين لتغير حصل فيهم نقلهم مما كانوا (كنتم) إلى ما اقتضى خطابهم بما يشبه العتب على عدم بقائهم على ما كانوا عليه من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر (فتكون «تأمرون وتنهون» كأنهما تضمران قبلهما جوابا على شكل «كنتم… لما كنتم…»). وهذه القرينة الأولى سلبية لأنها تعتمد على فرضية مستبعدة هي فرضية الطابع الظرفي للخطاب القرآني، وهو ما يتنافى مع ما يتصف به من كلية تتجاوز الظرفيات. لذلك فالقرينة الثانية من نفس الآية تنفي حصر الخيرية في المسلمين بالمعنى التاريخي لأنها تشير إلى أن بعض أهل الكتاب لهم الصفة الجامعة والمعللة للاتصاف بشرطي الخيرية؛ أعني الإيمان بالله.
أما القرينتان الثالثة والرابعة فهما حاسمتان؛ لأنهما تستثنيان فرضية القرينة الأولى استثناء مطلقا وتؤكدان القرينة الثانية فتوجهان الفكر إلى الفهم الكلي للعلاقة الشرطية بين الوصف بالخيرية والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المشار إليهما في الآية. وهاتان القرينتان تستمدان من الآية: 104 من سورة ءال عمران: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ الآية التي تدل بطابعها الإنشائي (القرينة الثالثة) وبثمرتي الإيمان بالله بداية وغاية (الدعوة إلى الخير بداية والفلاح غاية) الناتجتين عن هذا المعنى (القرينة الرابعة).
فتقدم هذه الآية: 104 ذات الصيغة الإنشائية على الآية: 110 ذات الصيغة الخبرية يجعل الأولى في محل الشرط والثانية في محل الجواب. فيكون الجمع بين الآيتين منطقيا من جنس «إذا…(وحصرًا إذا)…فإذن» وهو معنى التلازم المنطقي أو اللزوم بين الحدين طردا وعكسا. لكأن الحصيلة هي إذا أطعتم أمر الآية: 104 كنتم ما تصفكم عليه الآية: 110 ولا تكونوا كما تصفكم الآية: 110 إلا إذا أطعتم ما تأمركم به الآية: 104. ولست أظن أن حوصلة أي قارئ تضيق بهذه البنية المنطقية البسيطة في عرف المناطقة للعلاقة بين الآيتين على ما فيها من عمق وبلاغة لا تضاهى هي عين ما يحرر الخيرية بمعناها القرآني من المرضين اللذين يمكن أن يصيبا القائلين بخيرية شعب من حيث هو ذلك الشعب أو ملة من حيث هي تلك الملة. فتكون في تلك الحالة خيرية لا تختلف في شيء عن خيرية الشعب المختار دينيا (الصهيونية) وخيرية الشعب المختار فلسفيا (النازية)، بل هي قد تصل إلى الجمع بين الخيريتين بهذا المعنى العنصري لمجرد تعيين المتصفين بها تعيينا حصريا وليس تعيينا منفتحا على كل من يحقق الشرط فيتحقق فيه المشروط مثلما يزعم اليمين الأمريكي من المسيحية الصهيونية في خيريتهم الوهمية.
وكل حديث للرسول قد يلجأ المرء إليه فيؤوله بهذا المعنى؛ (أي بمعنى خبري يعين العرب وقريش بأعيانهم ولأعيانهم ممتازين على العالمين) لا يمكن أن يكون تأويله مقبولا بل ينبغي تأويله بصورة لا يستثنيها نص القرآن الصريح في تحرير البشرية من عقيدة الشعب المختار: «لا يمكن أن يحرر القرآن البشرية من عقيدة الشعب المختار اليهودية ليخضعهم لعقيدة الشعب المختار العربية أو الإسلامية». الاصطفاء الذي يبقى بعد حسم إشكالية هذه العقيدة هو الاصطفاء بمعنى تحديد الشروط التي يتحقق مشروطها في من يسعى إليه في إطار المعيار القرآني المطلق كما تحدده آية الخيرية أعني معيار الإيمان بالله والتقوى. فيكون الكلام على العرب وقريش خبريا في حدود ما حصل ليكون محمد الذي حقق الشروط، وذلك قد كان وهو ماض حاصل لا يكون الكلام عليه إلا خبريا، لكنه إنشائي عند الكلام على المستقبل؛ أي مباشرة بعد حصول هذه المعجزة معجزة اصطفاء محمد: «إذا فعلوا ما جعل محمد يكون منهم يكونون أخيارا بالمعنى الذي نحلله في هذه الآيات السبع من سورة ءال عمران».
أما القرينة الجامعة فهي ما تفيده الآيات الخمس المتوسطة بين الآية: 104 ذات الصيغة الإنشائية والآية: 110 ذات الصيغة الخبرية ومن ثم مطابقة الدلالة الجامعة لوجهي الشرطية شرطا وجواب شرط بمعنى التلازم بين مدلول الآيتين: 104 و110 أو اللزوم الطردي والعكسي بينهما: «فحتى يصح التطابق بين الشرط والمشروط تعريفا لمعنى الخيرية من حيث هي وصف لفاعل الخير بالمعنى المطلق أو المؤمن بالله فينبغي أن يكون ما بين الشرط والمشروط تعريفا لجوهر هذا التطابق بين فعل الخير والاتصاف به أو التدين بمعناه المطلق أي الإسلام لأن الدين عند الله هو الإسلام».
وقد جمعت الآيات الخمس المتوسطة معنى التدين الذي هو الاتصاف بالخير بسبب فعل الخير؛ (بمقتضى المعادلات التالية: ففاعل الخير للخير= خير= مسلم لله. والعلة أن الإنسان مسلم بالفطرة = يعني أن فعله الخير بقصده فعل لوجه الله وهو جوهر ما يكون فعلا ناتجا عن الإيمان الصادق) في المعاني التالية:
- فهو وحدة الأمة التي تلقت الآيات البينات وحدتها؛ بمعنى مقاومة دواعي الفرقة (الآية: 105).
- وهو المبدأ المحافظ على هذه الوحدة سلبا (العذاب يوم الحساب الآية: 106).
- وهو المبدأ المحافظ عليها إيجابا (النعيم يوم الحساب: 107).
- وهو وظيفة الشرائع السماوية (العدل الإلهي لئلا يعد الله ظلاما للعبيد 108).
- ليكون أخيرا طبيعة العلاقة بين الخالق والمخلوق عامة والإنسان خاصة (ومن ثم دلالة أن يكون القرآن محددا لمعنى الخيرية بالقياس إلى الإيمان به الآية: 109).
الهوامش
([1])نضع النص بين قوسين لأننا نريد أن نبحث في العلاقة بين السياق والحكم ليس من حيث هو منصوص فحسب، بل من حيث هو معمول به ومن ثم فلن يقتصر بحثنا على النقلة من النصوص إلى الأمر الذي تتعلق به النصوص نوازل كانت (في الفقه وأصوله) أو أحوالا قلبية (في العقد وأصوله) بل نريده أن يشمل النقلة في الاتجاه المقابل كذلك أي من الأمر إلى النصوص.
([2])عنوان الندوة التي عقدتها الرابطة المحمدية للعلماء حول موضوع: “أهمية اعتبار السياق في المجالات التشريعية وصلته بسلامة العمل بالأحكام” في الرباط في شهر جوان 2007.
([3])التصور المرسل مضمون معرفي لا يصبحه جزم مثبت ولا جزم ناف. لكن العقد نسبة بين المتصور والتصور هي جزم مثبت له أو ناف. والحكم الديني في بعده العقدي كما في بعده الشرعي لا يكتفي بتصور الأمر بل هو يصدقه ويعمل به.
([4])انظر أبو يعرب المرزوقي والشيخ البوطي أزمة أصول الفقه حوارية صدرت عن دار الفكر دمشق
بيروت 2006.
([5])حتى نيسر فهم القصد فلنضرب مثال العلم. فالنظرية العلمية الصحيحة تعد علما إذا وقع تفضيلها على عدة نظريات بعد المقارنة بينها فتفضل لأنها تبينت خلال المقارنة النظرية الأصح ومن ثم فهي العلم الأفضل.. ونفس المعنى يقال عن الشرع الإسلامي. فليس هو الشرع عامة بل هو يعد الشرع المفضل بعد بيان أنه مطابق للشرع الأفضل من خلال المقارنة مع الشرائع الأخرى أولا واستجابته لمقتضيات العلاج الشرعي بمقتضى طبعه. وإذن فهذا الوصف لا يناله الشرع إلا كما ينال العلم الصحيح هذا الوصف أي إلا إذا تمت مقارنة الأحكام التي توصل إليها وتبين أنها الأكثر مطابقة للأحكام التي يقتضيها علاج الظاهرة التي هو شرعها أفضل علاج. وهذا لا يعلم بمجرد معرفة النص بل لا بد من معرفة الظاهرة التي يكون النص أحد تصوراتها. والظاهرة هي بدورها من حيث هي معلومة بمنظور التشريع لها تعد نصا من جنس خفي هو ما يقتضيه علاجها العلاج التشريعي.
([6])وهذا هو المخرج الوحيد من الدور الذي آلت إليه كل تأسيسات ما يسمى بعلوم الملة: لا يمكن أن تؤسس علوم النصين (القرآن والسنة) وعلوم استثماراتهما في تنظيم الحياة الروحية للأفراد والجماعات فضلا عن علوم استثماراتهما في كل أوجه الحياة الإنسانية الأخرى من دون أن يتقدم على ذلك علم كل هذه الأمور بذاتها حتى يكون للمرء القدرة على المفاضلة بين الخيارات أو على الأقل القدرة على إثبات أفضلية الخيار الديني الذي يرجحه في فهم القرآن والسنة. وعلم القرآن والسنة بذاتهما هو العلم الذي يحقق النصين والذي يستخرج منهما نسقهما من دون أن يكون ذلك مستمدا مما يقولانه عن نفسيهما بل مما يقتضيه العلم بهما من حيث هما ظاهرتان موضوعيتان تحققان ماديا وتفهمان معنويا قبل الوصول إلى تفضيل ما يقولانه عن نفسيهما.
([7])المعلوم أن هذا التطابق بين المرجعيتين أصلي لعدم وجود فارق الزمان بينهما عند النظر إليهما من زاوية مبدع النص والموضوع. لكن ذلك يضع الإنسان أمام مفارقة. فالمرجعية النصية تحيله إلى مرجعية وجودية فتجعلها متقدمة عليها في العلم بالله. ذلك أن القرآن يدعو المؤمنين لتدبر الآيات الوجودية ليفهم الآيات النصية وليس العكس. ولا حل لهذه المفارقة يحررنا من الدور إلا إذا لم نعتبر النص يدعونا إلى طلب ما يقدم لنا بل هو يدعونا إلى ما لا نجده فيه بل في الوجود. فتكون المرجعية الروحية مرجعية بالنموذج الذي تقدمه من كيفيات تدبر الآيات الوجودية وليس بمضمونها المعرفي، ومن ثم فأداؤها لهذه الوظيفة يكون بالشكل وطبيعة الدعوة الخلقية والمنهجية. وهو إذن أداء مضاعف كما حددت ذلك الآية: 48 من المائدة: الشرعة والمنهاج. فأما شكل الشرعة فهو يتعلق بأخلاق التدبر العلمي والعملي كيف تكون، أي إن الذات التي تتدبر الكون لتفهم آيات الله ينبغي أن تتصف بالصفات التي يقدم القرآن الكريم نماذج منها قابلة للاحتذاء. وأما شكل المنهاج فهو يتعلق بتقنيات العلم والعمل كيف تكون، أي إن التعامل مع موضوع العلم والعمل ينبغي أن يتصف بالصفات التي يقدم القرآن الكريم نماذج منها قابلة للاحتذاء. والنماذج بنوعيها قدمها القرآن بأسلوبين: أسلوب القص للتجارب السابقة وأسلوب الممارسة للتجربة المحمدية التي يراها معاصروه بالعين المجردة. والحاصل من ذلك أن المهم ليس مضامين التجارب المقصوصة أو التي رآها المسلمون في التجربة المحمدية بل الأشكال النموذجية التي وقع التعامل بها مع آيات الله الكونية والأمرية أي الطبيعة والتاريخ.
([8])وهذا يلغي كل احتجاج بأسباب النـزول: فالنص النازل هو سبب نـزوله إذا كان ولا بد من جعل الصلة بين النص والنوازل التي نـزل بمناسبتها علاقة سبب بمسبب. فعندما يكون الفاعل للأمرين واحدا ليس للترتيب الزماني دلالة على أن السابق في الترتيب الشاهد هو السبب واللاحق فيه هو المسبب بل يمكن أن يكون العكس. وهو بيّن حتى في العمل السياسي: فيمكن لحزب من الأحزاب أن يحدث أحداثا في الشارع السياسي ليمرر قانونا يخطط لتمريره فيكون الحدث في الشارع رغم تقدمه الزماني على سن القانون معلولا لإرادة سن القانون.
([9])لكن ذلك أوقع علماء الإسلام في خطأين يبدوان متقابلين وهما في الحقيقة نفس الخطأ: فأما الخطأ الأول فهو التخلي عن البحث في القوانين الكونية والاكتفاء بالقوانين الأمرية وهو ما أدى إلى شبه انعدام كامل لعلوم الطبيعة، وما يتبعها تأسيسا وأدوات عقلية وأما الخطأ الثاني فهو الظن بأن القوانين الكونية والقوانين الأمرية موجودة في القرآن والسنة وليست في موضوعيهما اللذين يوجه القرآن والسنة النظر إليهما ويدعوان إلى علمهما. فترى بعض الدجالين يزعم أنه واجد كل العلوم في القرآن ويسمي ذلك بالإعجاز العلمي. وبخلاف ما يطلبه القرآن الداعي إلى النظر في النفوس والآفاق يصبح هؤلاء الدجالون ناظرين في النصوص لكي يؤولوها بفقه لغة قاصر همه الوحيد تحكيم ما حصله غير المسلمين من النظر في النفوس والآفاق بدل الوصول إلى ذلك بالطريقة الوحيدة الممكنة عقلا ونقلا: البحث العلمي في الأنفس والآفاق. ومن ثم فهم بحلهم السخيف والكسول يحكمون على الأمة بالبقاء عالة على غيرها حتى في فهم نصوصها المقدسة.
([10])ومشكل القوانين التي يخضع لها الفعل خلال الوقوع وليس قبله ولا بعده هو المشكل المحير في قضية أفعال العباد: هل هي خاضعة لقوانين المشيئة الأمرية فيكون الإنسان فيها خالق أفعاله والله خالق الحكم (المعتزلة) أو خاضعة لقوانين المشيئة الكونية فيكون الله خالق الفعل والحكم كليهما (الجبرية) أم إن الأمر على خلاف هذين التصورين كما ترى الأشعرية القائلة بالكسب. ولا أحد يجهل ما يزعم في الكسب واستحالة فهمه. فلنحاول مع ذلك علاج القضية علاجا يبين دور المشيئتين وفعل العبد. وليكن مثالنا لعبة الشطرنج. فصانعها وواضع قواعدها يفعل ذلك بمشيئة أمرية وكونية متطابقتين: ما أراده مثالا للعبة هو ما حققه فعلا لها. وهو العامل والمشرع. لكن اللاعب بهذه اللعبة سيكون في وضعية يكون فيها نظام اللعبة وقواعدها تشريعا أمريا له يحاول في الأشواط التي يلعبها أن يلعب بحسب تلك القواعد والعلم بها وقد يربح وقد يخسر بمقدار علمه بالقواعد وجهده لكسب المهارة وذلك هو كسبه.ومع ذلك فالفهم والعلم والجهد والطاقة النفسية وقدرة الحفظ واكتساب الخبرة كل ذلك خاضع لقوانين المشيئة الكونية التي هي من جنس قوانين اللعبة التي يخسر شوطها أو يربحه بحسب حصيلته مما ذكرنا. وبذلك يكون الكسب محوطا بالمحتمات التي لا تكاد تحصى فيبدو القائلون بالجبرية المطلقة أقرب إلى وصف الأشياء من القائلين بالحرية المطلقة. لكنهما على خطأ: ليس مستواهما واحدا بل الفعل جبري من منطور محدداته الكونية واختياري من منظور محدداته الأمرية. ولولا ذلك لكانت كل الأفعال منتسبة إلى الماضي فحسب. لكنها قبل الانتساب إلى الماضي تكون تصورا ثم تصبح فعل إنجاز وخلاله يحصل هذا الجهد الذي هو اجتهاد وجهاد للكسب. وتلك هي مساحة الحرية الإنسانية.
([11])سنصطلح على تسمية كل الوحدات الرمزية مهما كانت طبيعتها نصا تيسيرا للبحث، لأن ما ينطبق عليه في هذه النسبة ينطبق عليها جميعا سواء كانت ذات ترميز لساني أو غير لساني كما نبين في المثالين المستمدين من الرسم والموسيقى وفيهما نطلق نفس المصطلحات لتسمية كل مستويات النص والسياق بنفس الأسماء دون أن يكون المقصود مقصورا على ما تفيده في علاقتها بالنص كالصرف والنظم والأدب والمعجم التي تصبح جميعا شاملة لكل ترميز حتى لو لم يكن لسانيا.
([12])لكن إذا فرضنا الحدين الأدنى والأقصى موجودين فإن السياق يكون نصيا خالصا في الأدنى وغير نصي خالصا في أقصاهما. ذلك أن الوحدة الدنيا الدالة من النص عديمة الدلالة الذاتية بل كل دلالتها من السياق، ومن ثم فالسياق هو الذي يعطيها الدلالة ولا يكتفي بالمساعدة في تدقيق دلالتها. كما أن الوحدة العليا من النص والتي هي كل الثقافة لا يمكن من دون دور أن يكون لها سياق من جنسها؛ خاصة ونحن نتكلم عن الثقافة الإنسانية ككل وليس على ثقافة خاصة بشعب معين.. عندئذ يكون السياق من جنس المقومات الطبيعية للوجود الإنساني وربما ما بعد الطبيعية عند من يؤمن بمثل هذا التصور.
([13])ولابد هنا من الإشارة إلى حقيقة عجيبة لعلها ستكون الواسطة بين النصين الإنساني والإلهي حتى وإن كان النوع الثاني ليس مما يقول به الجميع. فرغم أن الأمرين متناهيان النص وسياقه وأن لكل منهما حدا أدنى لا ينـزل دونه، وحدا أقصى لا يعدوه.. فإن عدتهما لا متناهية لأن التناسب بالتناظر بينهما ليس له حد: ذلك أن بين الحد الأدنى والحد الأقصى من النص مسافة قابلة للقسمة اللامتناهية فتناظرها حدا بحد قسمة لا متناهية للسياق. لكننا سنكتفي بقدر محصور هو المفيد في عملية تحليل النصوص عند اعتبار القسمة القابلة للحصر دون اعتبار القسمة الممكنة قابلة للحصر. والعجيب أن كل جزء من قسمة النص حتى في حالة الاقتصار على الأنواع القابلة للحصر يشبه الثقب الأسود يبتلع كل ما دونه وكل ما فوقه من النصوص وما دون سياقه وسياق ما دونه (فضلا عن كونه هو بدوره جزءا من سياق ما دونه) وسياق ما فوقه من النصوص؛ لكأن كل جزء وحدة لا يبنتس الروحية التي تمثل زاوية نظر لكل الوجود مترائيا فيها: وهذا هو المعنى الحقيقي للآية. وهذه الظاهرة أو الآية بمعناها التام يمكن أن تكون وسيطا بين نوعي النصوص الإنساني والإلهي؛ لأنها تبين كيف أن المتناهي يتضمن اللامتناهي ومن ثم تجعل نصا قيل بلغة إنسانية وقاله إنسان قابلا لأن يكون كلاما إلهيا بمعنى أنه لا متناهي ومطلق ليس بهذا المعنى التناسبي بين أجزاء النص وسياقه المحدودين بالشاهد من الوجود (الطبيعة والتاريخ حدا أقصى للسياق المحيط بالحد الأقصى من النص) بل بمعنى الغيب أي ما بعد الطبيعة وما بعد التاريخ.
([14])وبذلك نفهم التناقض الجوهري في كل محاولات تفسير القرآن بسياقه التاريخي. فلو كان القرآن يفهم بسياقه التاريخي لكان معنى ذلك أن محاولة التحرر من المحايثة أمر مستحيل، ومن ثم فالموقف الوحيد هو الموقف الثقافوي النسبوي لما بعد الحداثة ويقع إطلاق النسبي بنفي ما بالقياس إليه هو نسبي. فالقرآن وكل نص مقدس يقرب منه دعوة للتعالي على الغرق في المحايثة الطبيعية والتاريخية بالإحالة إلى ما بعد الطبيعة والتاريخ وتقاس حرية الإنسان بالمسافة الفاصلة بين الطبيعة والتاريخ وما بعدهما، بل إن العقل الإنساني ليس هو في جوهره إلا الوعي بهذه المسافة التي هي شرط حريته ومن ثم شرط عمله المبدع في النظر والعمل على حد سواء.
([15])انظر في ذلك مقالنا الذي يصدر قريبا إن شاء الله مقالنا في نظرية الرمز وفيها ننقض تثليث بيرس بوجهيه وجه المقولات ووجه الرموز لنثبت حاجته إلى بعدين آخرين متقدمين عليه تقدم الشرط على المشروط. ذلك أن المنظومات النظرية لا ترد إلى عناصرها القانونية فتكون متقدمة عليها تقدم الكل على الجزء، والموضوعات الوجودية لا ترد إلى عناصرها الأولية فتكون متقدمة عليها تقدم الكل على الجزء. فيكون قبل العناصر الثلاثة المقولية والرمزية عنصران هما مادة الوجدان التي تنتأ عليها المقولات الثلاث أعني الأولية والثانوية والثالثية وصورة الفرقان أعني التصور والقضية والقياس. ومادة الوجدان التي تنتأ عليها الرموز والمقولات الجزئية الثلاثة لها في نفس الوقت خاصية المقولة والرمز ومثلها صورة الفرقان فتكون أنواع الرموز مثلها مثل المقولات خمسة وليست ثلاثة: ذلك أن ما يشترطه الرمز ليرمز ينبغي أن يكون أولى منه بالوظيفة الرمزية وما تشترطه المقولة للمقولية ينبغي أن يكون أولى منها بها. وشرح ذلك يخرج عن المقام فضلا عن كونه لجدته قد لا يكون يسيرا على الأفهام.
([16])مثال ذلك أننا لو حاولنا تحليل هوية المسجد الإسلامي فإننا يمكن أن نحلل المواد المستعملة والمواد التي كان يمكن أن تستعمل ثم الهيأة التي صورت عليها والهيئات التي كان يمكن أن تصور عليها. ولعل مثال المسجد الإسلامي كمسجد القيروان من أفضل الأمثلة لعلتين: فهو أولا مطابق لما نريد إبرازه من عناصر لابد من اعتبارها. لكن الأهم من ذلك هو بيان طبيعة تشكيل الصورة وتشكيل المادة. فالمعلوم أن مادة المساجد الإسلامية كانت في البداية أي مادة اتفق بما في ذلك سعف النخيل وأجذاعه. فالمسلمون كانوا يأخذون المواد الموجودة لبناء المسجد (وهذا ليس لعدم الحيلة كما يظن بعض السخفاء، بل هو موقف وجودي: فمثلنا أن الأرض كلها عندهم مسجد فكذلك المواد كلها صالحة أي إنهم تحرروا من الأصنمة أو الفتشنة. ونفس الأمر يقال عن علاقتهم بالمواد الحضارية السابقة وليس عندهم إزاءها موقف ناتج عن الأحكام المسبقة بمقتضى نظرية استخلافهم في كل ما تقدم عليهم واستعمار العباد الصالحين الذين يرثون الأرض. لكن صورة المسجد تبقى ما ينبغي أن تكون بمقتضى طبيعة تصورها الإسلامي لأنها هي مقصود البناء. ثم تطور المسلمون فباتوا يناسبون بين المادة والصورة بحيث إن إضفاء أثر الصورة على المادة بات قصدا أولا فأصبحت المادة تصنع من أجل صورة المسجد إلى أن باتت المادة شبه لا شيء لكثرة قربها من الصورة أو بصورة أدق لشدة طواعيتها لكأنها فاقدة لتمنع المادة أمام فعل التصوير: فاختاروا الخشب والجبس والآجر أو اللبنات المحمية والقرميد أو الأغشية المحمية حتى تكون صورتها سابقة على مادتها من أجل أن يتناسب المادي مع الصوري في الفن المجرد الذي يكون فيه كل شيء رمزيا بإطلاق لأنه من فعل الإنسان وليس من فعل الطبيعة. وهذا أيضا من ثمرات الموقف الوجودي الإسلامي: فالمادة نفسها من صنع الإنسان لتتوجه بالتدريج نحو الصورة التي تتوجه بالتدريج نحو التحقق في هذه المادة بفضل تصوير المادة تصويرا لا يحقق فيها الصورة التامة التي هي هوية المسجد هنا فحسب، بل يجعلها مستعدة لتلقي أفضل أعيانه الممكنة في الوجود الدنيوي. وكل الذين لم يفهموا هذا الأمر يتصورون أنهم قادرون على رد القرآن الكريم إلى الكتب المتقدمة عليه بالزمان بما يجدونه من أوجه شبه سطحية بين أدوات التعبير فيه وفيها وحتى بين وجه الشبه بين المضمونات. وفضلا عن كون هذه الفكرة ليس فيها جديد -رغم سخف مستعمليها للتشكيك في أصالة القرآن- لأن القرآن نفسه يعتبر الأصل واحدا والفرق بين الكتب السماوية ناتجا عن تحريفه فإن مبدأه هو ما نعنيه بهذه الملاحظات: القرآن لا يستمد شيئا مما تقدم عليه إلا بالمعنى الذي يستمد به المسجد الإسلامي مادته من العمارة المتقدمة على بنائه لكنه تفجر جديد للنبع الأصلي الواحد أو إن شئنا قراءة جديدة للوح المحفوظ ليس لمميزها سوابق لأنه الغاية التي أكملت الدورة فعادت إلى البداية المطلقة أو المفطورية الآدمية كما فطرها الله جل علا لتكون منطلقا للكونية الإنسانية والأخوة الآدمية أخوة التعارف بمعنيي الكلمة معرفة ومعروفا.
([17])وكل المشكل الديني يدور حول هذا الأفق هل هو مقصور على ثقافة بعينها أو حتى على الثقافة الإنسانية ككل، أم هو يتجاوز الثقافي وحتى الطبيعي إلى ما يتعالى عليهما أي ما بعد التاريخ و ما بعد الطبيعة؟ ففكر الحداثة كان يذهب إلى المخرج من الثقافي في مدلوله الكوني إلى ما يتعالى عليه في ما بعد الطبيعة نافيا ما بعد التاريخ. وفكر ما بعد الحداثة أكمل هذا الموقف وبيّن أن نفي ما بعد الطبيعة هو بدوره نتيجة مضطرة للتاريخانية المطلقة التي هي بالضرورة ثقافوية فيما يخص الإنساني الخالص وإحيائوية فيما يشترك فيه الإنساني مع الحيواني عامة. فيكون الأفق الأعلى هو الثقافة وليس الثقافة الكلية، بل الثقافة الخصوصية ويصبح التفاهم مستحيلا حتى بين البشر. وقد بينا – في مقالنا حول اللغة والإبداع وفلسفة اللغة الفلسفية صدر في مجلة إسلامية المعرفة عدد: 41. أن ذلك لو صح لامتنع التفاهم حتى في نفس الثقافة سواء بالتساوق أو بالتوالي بل وحتى بين الإنسان ونفسه؛ لأن كل لحظة من شلال الوعي تصبح رمزا خارج الوعي ماضيا بمجرد حصولها أو مستقبلا بمجرد حصول تصورها المتقدم على تحققها. ولما كان الأمر كذلك فإن التفاهم مع الذات يجعل التفاهم داخل نفس الثقافة ممكنا وبين الثقافات كذلك، بل وخارج الثقافة بدليل قابلية الطبيعة للعلم. وكان ذلك كله يكون ممتنعا لو لم يكن للتاريخ وللطبيعة ما بعدهما.
([18])وعن هذه العلاقة ينتج أمر عجب: فالإنسان في علاقته بجسده يمر بوسيط هو ثقافته وفي علاقته ككل نفسه وجسده بمحيطه الطبيعي يمر بوسيط هو ثقافته والعكس بالعكس أي إنه يتعلق بثقافته بتوسط جسده ويمر في علاقته ككل نفسه وجسده بمحيطه الطبيعي وسيطا بينه وبين ثقافته. فتكون هذه الوساطة شبيهة إلى حد كبير بعلاقة النص بالسياق: نفترض نظريا سياقا ثقافيا خالصا وسياقا طبيعيا خالصا وسياقين ناتجين عن فعل الأول في الثاني والثاني في الأول وسياق مزيج من كل ذلك هو أفق المعنى في كل فعل ترميز بثا أو تلقيا.
([19])ومثلما أسلفنا فعندما نذهب بالأمر إلى غايته فيتطابق النص الإنساني المطلق والسياق الإنساني المطلق في وحدتهما المطلقة التي هي الثقافة يصبح الإنسان كائنا مطلق المحايثة فيفقد القدرة على التعالي ويموت منه العقل والروح: وتلك هي غاية أي ثقافة صارت الدنيا مبتغاها؛ لأن معبودها بات هواها. لذلك فهذا القفز خارج الماء هو حياة الإنسان لأنه بخلاف ما وصفنا به السمك يحيا بهذا الطفو على الماء وليس بالغرق فيه: التعالي على الدنيا والهوى غير ممكنين من دون افتراض نص وسياق مطلقين تكون كل النصوص والسياقات البشرية قابلة للفهم بالرجوع إليهما رغم كون معانيهما غير قابلة للحصر لأنهما من جنس اللامتناهي الذي يفهم به كل متناه دون أن يكون فهمه فهما متناهيا.
([20])من الخطأ الكلام على محور الاختيار ومحور التأليف بالمفرد وبالمعنى التقليدي. فالمحوران مضاعفان وهما متلازمان في درجتين مختلفتين: فالاختيار ليس مقصورا على اختيار الوحدات الدنيا من المعجم، بل هو أيضا اختيار للتأليفات من الأدب والتأليف ليس مقصورا على تأليف الوحدات الدنيا الدالة في النظم، بل هو كذلك تأليف للوحدات الدنيا غير الدالة في تصريف الوحدات الدنيا الدالة لتركيب دلالاتها. فيكون المحوران مضاعفين ومن ثم فالمستويات أربعة لأن المحورين التقليديين كلاهما جامع بين الاختيار والتأليف. ولم ينتبه العلماء إلى هذا الأمر لتوقف التحليل دون أعماق المسألة؛ أعماقها التي يرينا إياها أبعاد نص القرآن الكريم كما تتجلى لمن ذاق تلاوته. والحاضر من هذه المستويات هو النص وكل ما بقي منها غير حاضر في النص هو السياق، لأن النص لا يدل بما يحضر فيه فحسب بل بعلل اختياره واستثناء غيره أعني ببقية هذه المستويات.
([21])﴿الر تِلْكَ آَيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ. إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآَنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (يوسف: 1و2).
([22])وعندما يكون التاريخ وما بعده موضوعا يكون من مجال الدلالة لا من مجال التداول لأن مجال التداول هو ظرف الذات وأفعالها المحدد وليس ظرف الموضوع وانفعالاته المحدد.
([23])ولولا هذا الوجه الافتراضي لظن الإنسان التاريخ حالا ضرورية وليست أحد الإمكانات والخيارات التي حصلت وكان يمكن لغيرها أن يحصل فضلا عن كونها بذاتها لا تعلم وإنما يعلم منه هو أحد فهومها وتأويلاتها في ضوء هذا الوجه الافتراضي.
([24])وعدم التمييز هذا هو العلة التي لأجلها رجعت السلط الروحية المعصومة في الإسلام تماما كما هو الشأن في الأديان المحرفة التي نقدها الإسلام بالذات لهذا السبب: فالنبي لا يعلم الغيب بل ينبه إلى أن العلم لا يتجاوز الشهادة حتى يحرر الناس من السلطة الروحية المعصومة التي تستعبد الناس روحيا وتتحالف مع مستعبدهم ماديا، وذلك هو الطاغوت الذي عالجته آل عمران حيث يتبين أن الحلف بين هذين الطغيانين انتهى إلى تأليه عيسى ابن مريم حتى يتخذ الناس بعضهم بعضا أربابا.
([25])مسألة أساسية ينبغي حسمها في ضوء هذه الأصناف؛ لأنها صارت شوكة في خصر الأمة: هل الحدود واجبة التطبيق دائما أم هي من جنس الأحكام القصوى التي يمكن لولي الأمر الشرعي تحديد شروط تطبيقها؟ والجواب هو طبعا بالإيجاب إذا كان في ذلك مصلحة أجمع عليها من فوضتهم الأمة للتشريع لها ولتحديد شروط العمل بالتشريعات. لكن ذلك يقتضي حصر شروط التطبيق بالانطلاق من مقومات الفعل الذي يتعلق به الحد ومقومات السلطة الشرعية التي لها هذا الحق بمنطوق القرآن نفسه.
([26])الفكرة قدمت أول مرة في ندوة صاحب العالمية الثانية في السودان خلال مناقشة تصور النسخ.
([27])مشكل شائك: كيف كان القرآن ينـزل منجما ويؤثر بما يتميز به؟ هل كان كل نجم يتضمن ما به يؤثر القرآن فيكون كل نجم عينا من الكل؟ كيف نثبت هذه الحقيقة أولا وكيف نثبت أن من أسلموا بتأثير سماع القرآن قد أدركوا ذلك (مثال قصة إسلام عمر بن الخطاب)؟ قد يكون لمسألة الأفق المبين المتعين في بنيته المستمدة من صفات الذات الإلهية التي تقبل أسماء الله كلها الرد إليها دور أساسي في علاج هذه المسألة.
([28])المواضع الثلاثة التي ورد فيها هذا التنـزيل المتوسط هي الآية: 79 من آل عمران وفي الآية: 89 من الأنعام والآية: 16 من الجاثية.
([29])صفات الله التي نعتمد عليها هي التي يدور حولها الجدل الكلامي هل هي لله بذاته دون زيادة عليها أم هي معلولة؛ أعني جوهر الخلاف بين المدرستين الكلاميتين الأساسيتين: المعتزلة والأشعرية. راجع في ذلك مناقشتنا المسألة بعمق في رسالتنا حول منـزلة الكلي بعنوان تجليات الفلسفة العربية دار الفكر دمشق وبيروت 2000.
([30])صفات الإنسان في القرآن: وهي تستحق دراسة على حيالها. لكن ما يعنينا هو التناظر بين الأفقين المبينين المطلق والنسبي، وهو ندرسه بدقة وصرامة في هذه المحاولة لأن ما يعنينا هو ما يغني عن الأحداث ومنها أحداث علم نفس الإنسان والاقتصار على البنى المجردة.
([31])كيف تفعل النسقيتان في التاريخ؟ نقيس ذلك على فعل قواعد لعبة الشطرنح على أشواط اللعب ودور الكسب في جعل هذه القواعد يزداد دورها كلما ازدادت خبرة اللاعبين.
([32])كيف تفعل اللانسقيتان في ما بعد التاريخ؟ أي كيف يؤثر اجتهاد الإنسان وجهاده في علم الله وعمله؟ الجواب حاولناه عند الكلام عن علاقة الكتابين كتاب اللوح المحفوظ المفروض حاويا لكل شيء قبليا وكتاب الحساب المفروض حاويا لكل شيء بعديا.
([33])طبيعة الخطاب القرآني تجعله بهذه الآليات مستغنيا عن السياق المقامي والمقالي؛ لأنه بمقتضى الحد متقدم على كل النصوص وعلى كل الظرفيات ولمزيد التوضيح يمكن الرجوع إلى الباب الثاني من كتابنا فلسفة الدين دار الهادي بيروت 2006.
([34])وهو مخفي بدرجة جعلت أوغست كونت يقول في دروسه: إن متعلم الرياضيات، مثلا، صار يتعلمها من المتون التدريسية التي تعتمد على العرض النسقي (الدغمائي أو المدرسي بالمعنى الإيجابي للمصطلحين) ويكاد يجهل تمام الجهل الأعمال المبدعة التي وضع أصحابها النظريات التي يتعلمها والتي لا توجد إلا في تاريخ العلم لا من حيث مضمونه المعرفي، بل من حيث ظروف حصوله في الممارسة العلمية. وما لم يحصل اكتشاف طريقة تصل بين الأمرين لتحقيق التكامل بين النسقية المنطقية للتصورات العلمية والتواردية الحدسية للأحداث التاريخية التي نشأت تلك التصورات علاجا نظريا لها لن يكون التعلم تعلما يكون مبدعين، بل تعلما يكون ببغاوات تحفظ نظريات خالية من كل مضمون فتردد صيغ جوفاء ولا تستطيع تحقيق فضائلها الإبداعية أعني صوغ المشاكل وعلاجها.
([35])وطبعا فهذه الصفات الخمس بمجرد وجودها للذات الإلهية جعل البعض يتوهم نظيرا سلبيا للذات الإلهية ولصفاتها واعتبرها أمورا موجودة هي العالم الذي هو غير الله، ومن ثم فهو العدم ثم نفاها لأنها لا تقوم بذاتها ليرجعها إلى الذات الإلهية وصفاتها فأدخل العدم وصفاته المقابلة في ذات الله وصفاته: فتوهم أن نظير الذات الإلهية هو العالم الذي هو العدم المطلق، ونظير الواجد المطلق هو الفاقد المطلق ونظير الحي المطلق هو الميت المطلق، ونظير العالم المطلق هو الجاهل المطلق، ونظير القادر المطلق هو العاجز المطلق، ونظير المريد المطلق هو الكاره المطلق. وذلك هو الموقف المسمى بوحدة الوجود الذي يبدو نفيا للعالم كما في مدلول أكوسميسم لكنه في الحقيقة أتييسم؛ إذ إن الله وصفاته صارت أعيانا في العدم تحل في العالم وأعيانه لتنتقل من العدم إلى الوجود.
([36])وهذه الصفة يسميها المتكلمون تقليدا للفلاسفة بالوجود. لكن كلمة الوجود لا وجود لها في القرآن الكريم، بل الصفة الوحيدة التي تؤدي المعنى الذي يناسب الذات الإلهية دون أن يكون شرطا في قيامها بل مشروطا بقيامها هو الواجد. لذلك استعضنا عن الوجود بالواجد ولعلل أخرى نشرحها لاحقا.
([37])وهذا التحليل يلغي كل خرافات مفسري النصوص بأسباب نـزولها، فضلا عمن يريد أن يجعل النصوص تاريخية مثل ما يعتبره أسبابا لها. والهدف الخفي بين: إذا كان الحكم تاريخيا مثل النازلة التي اعتبرت سببا له، وكانت النازلة السبب قد زالت بزوال ظرفها التاريخي فإن النتيجة هي وجوب التحرر من الحكم. وبالتدريج تسقط كل الأحكام أعني كل الشرع العملي والنظري أي في مجالي الحقوق والحقائق.
([38])وهذا التفسير يفسد على الكثير ممن يزعم أن بعض الخلفاء كان لهم دور في التشريع المنـزل كما يزعم بكثرة للفاروق. وطبعا لو كان هذا الدور بالمعنى الذي يحاولون الإيحاء به لكان معناه أن النبي يغير النصوص – ومن ثم فهو مؤلفها وليست قرآنا منـزلا- استجابة لضغط عمر! لكن الحقيقة هي أن عمر الذي كانت له المنـزلة المعلومة في الجماعة كان «السبب المناسبة» ليكون مصدر الحدث الذي يتعين فيه طلب النص المراد تنـزيله: عمر ليس سببا بمعنى كونه علة مؤثرة بل بمعنى كونه مصدر الحدث الذي يكون المناسبة لتنـزل النص. كأن معلما ما في فصله دفع أفضل طلبته لطرح مشكل يريد أن ينبه إليه تلامذته الآخرين ثم يعالجه أمامهم فيقدم الحل ويصبح الحل نصا يعمل به بعد ذلك. فتحصل ثمرتان: تشجيع النجابة بين التلاميذ وإفهام التلاميذ الأمر المجرد (الحكم) بتعينه في مثال حي هو ما يبدو من فعل التلميذ النجيب. ولما كان الكتاب تعليما بالأساس فإن هذه المنهجية كانت مقصودة وليست مجرد صدفة حصلت مرة أو مرتين، بل هي كانت من «حيل» التعليم الفنية التي من دونها لا يكون التبليغ ناجحا.
([39])لم نتصد بعد لشرح الآيات الثلاث الأول والآيات العشر الأخيرة من السورة وهي لا تقل إفادة من مضمون القصة التي استوحينا منها مجالات التقويم الخمسة لأنها تحدد المقصود بالغفلة السابقة وبشروط نصر الله لأنبيائه في التاريخ.
([40])يوجد مشكل بحاجة إلى فهم: هل الدولة (وأصلها سياسة الدنيا) تمثل سلطة الرزق أم سلطة الذوق؟ وهل التربية (وأصلها سياسة الدين) هي سلطة الذوق أم سلطة الرزق؟ النظام في الأفق سواء كان المبين المطلق أو النسبي قد يقضي بهذا الترتيب المعاكس لطبيعة الأمر. ومن ثم نجد هذا المشكل الذي يحتاج إلى حل. فالواضح أن سورة النساء ربطت مسألتي الذوق والرزق من خلال علاج مسائل الزواج والعلاقة الجوهرية بين الرجل والمرأة أي الجنس الذي هو أصل كل ذوق ومسائل الإرث والتصرف في الملكية والعلاقة الجوهرية بينها المتعاملين أي الرشد الذي هو أصل كل علم. وفي الحقيقة فإن حل التعاكس الحاصل؛ (إذ تصبح الدولة سلطة الذوق والتربية سلطة الرزق بدلا من العكس) موجود في المقابلة بين المثال والحاصل من النظر والعمل في صلتهما بأصلهما. ولنبدأ بالقول إن هذا أمر خال من هذا التعاكس ومن ثم فهو ملائم لطبيعة الأشياء في الأفق المبين المطلق لأن كل الصفات مطلقة فلا خوف على العلم من القدرة ولا على الحياة من الإرادة. لكن في الأفق المبين النسبي هناك خطر وقوع العلم تحت سلطان الرزق وخطر وقوع العمل تحت سلطان الذوق: وذلك هو الحاصل بالفعل في التاريخ إذ إن سلطان الدولة على الرزق يجعل المستولين عليها خاضعين للذوق فيفعلون ما يحلو لهم وفقدان التربية للسلطان على الرزق يجعلها خاضعة للرزق فيعمل بأهلها ما يريد أصحاب الدولة فيصبح الديني تابعا للدنيا. وخضوع الذوق للرزق يفقد النظر فاعليته لأنه يقتضي استقلال العالم وخضوع الرزق للذوق يفقد العمل فاعليته لأن طابع العمل الشاق يقتضي تبعية العامل. فيكون ذلك مشكلا في الأفق المبين النسبي أي للإنسان ولكنه غير مشكل في الأفق المبين المطلق أي لله جل وعلا. ولهذا كانت هاتان العلاقتان محتاجتين لصورة مقابلة في المثال: أن يكون النظر تابعا للذوق ليحصل الإبداع الرمزي وأن يكون العمل تابعا للرزق ليحصل الإبداع المادي. وذلك هو شرط الحركة الفاعلة في التاريخ: فمن دون ذلك لا يحصل الإبداع الرمزي ولا الإبداع المادي، وكلاهما مقوم للعمران الأول للتآنس أولا وللتعاون ثانيا والثاني للتعاون أولا وللتآنس ثانيا.
([41])نأخذه بتصرف من مقال سابق لنا كتبناه لمناقشة آراء الحاج قاسم صاحب العالمية الثانية.
([42])نأخذه بتصرف من مقال سابق لنا كتبناه لمناقشة مطابة بعض العلمانيين بما يتصورونه مساواة بين المرأة والرجل في الإرث وقد صدر هذا المقال بعدة مواقع وبصحيفة القدس العربي في لندن في بداية صيف 2007.
([43])نأخذه بتصرف من حوار أجرته معنا صحيفة الوقت البحرينية وصدر في أربع حلقات خلال شهر جويلية وأوت 2007.
([44])نأخذه بتصرف من مقال علقنا فيه على خطاب البابا حول الإيمان والعقل وصدر بمجلة أخبار الأدب في نوفمبر2006.
([45])كما هو معلوم ليس للجهاد غير الدفاعي إلا علتان: فالتصدي لمن يمنع حرية العبادة هو العلة الأولى للجهاد. والعلة الثانية هي التصدي لمن يعتدي على المستضعفين وعلى حقوقهم. أما الجهاد الدفاعي فعلته بينة هو لا يحتاج إلى تعليل: إذ هو يعم كل الموجودات من الفيزياء (رد الفعل = الفعل مع التقابل في الاتجاه) إلى الإنسان.
([46])ولنأخذ مثالا على ذلك أحكام التعامل مع الخمر في اللحظة الرسولية. فالتدرج التربوي فيها جعل الوصول إلى آخر درجات التحرر من سلطان الخمر على ذوق الإنسان هو التجنب التام ليتطهر المجتمع الإسلامي من إحدى العاهات التي نرى ضررها الذي يضاهي ضرر الدخان وكل المخدرات. لكن المرحلة الأخيرة في هذا التدرج هل هي ناسخة لما تقدم عليها من المراحل بإطلاق أو بإضافة لمن ارتقى في الدرجات؟ إذا اخترنا الفهم الثاني حررنا الأمة من الحاجة إلى جعل الشريعة مستندة إلى الردع بالقوة العامة لكأنها قانون وضعي. فهي قانون خلقي أصله وهدفه التربية الروحية التي لا تكون إلا حرة. لذلك فالذي يطبق حكم «لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» من المسلمين وهو الحكم المتعلق بأولى الدرجات في التحرر من سلطان الخمر يكون قد غلب سلطان الدين على ذوقه على سلطان الخمر عليه دون أن يكون قد وصل لغاية التدرج. والذي يتجبنها بإطلاق يكون قد بلغ آخرة الدرجات. وكل السلسلة بين هذين الحدين يمكن اعتبارها درجات في تحصيل الأخلاق الإسلامية ومن ثم تغليبا لأحكام السلطان الديني على سلطان الخمر على الذوق.
([47])أ. ومعنى ذلك أن آخرة درجات الحكم لا ينبغي أن تنسخ الدرجات السابقة إلا بإضافة لا بإطلاق فلا يعد أصحابها إلى متدرجين في التخلق بأخلاق الإسلام لا خارجين عنه. فيكون حكم الدرجة الأخيرة ناسخا لأحكام الدرجات المتقدمة عليها بالنسبة إلى من بلغ إلى الكمال فوصل إلى غاية التربية الإسلامية بكامل الحرية. وبذلك نبقى على الأمل ونفتح الباب أمام الساعين إلى الارتقاء في تحقيق قيم الإسلام. والمعلوم أنه يمتنع أن يكون الجميع في نفس الدرجة من الكمال الخلقي فضلا عن امتناع تحقيق ذلك بسلطان القوة العامة. وإذا فعلنا فإن ذلك سيلجئنا إلى جعل أحكام الدين غير تربوية بل زجرية لا فرق بينها وبين قانون الطرقات. فالإيمان الذي هو التصديق المؤدي إلى العمل عن قناعة شخصية لا يمكن أن يكون متساوي الأثر عند الجميع بل هو من جنس العلم الذي فيه رتب. فيكون للمؤمنين رتب مثل العلماء ولا يمكن حصر الإيمان في رتبة واحدة. وينبغي أن تكون أتم درجات الإيمان الممكن للإنسان هي الغاية في التربية الدينية أعني المجاهدة الخلقية كما أن آخر درجات العلم هي الغاية في التربية العقلية أعني المجاهدة المعرفية. بهذا وبهذا فقط يكون الإسلام دين الفطرة والعقد الحر الذي يلتذ صاحبه بطاعته الاختيارية فلا يأمره غير ضميره والقدوة الحسنة.
ب. وقد طبق الرسول، ﷺ، ذلك عندما جعل تصورات العقد -ناهيك عن تصورات التشريع- متناسبة مع المستويات الذهنية والتدرج التربوي الإسلامي للإنسان كما فعل مع العجوز التي حيزت الله في السماء وهو أمر قد يعده بعض المتكلمين كفرا. وبهذه المناسبة فإنه من التجني بإطلاق معنى الحرام على ما لم ترد فيه أحكام تتضمن هذه الصفة ذاتها في القرآن الكريم حتى لو وردت في الحديث، لأن الحديث تفسير للقرآن وليس تشريعا موازيا أو مكملا إلا بمعنى الأحكام التطبيقية في القانون الوضعي وهي دائما دون النصوص التي جعلت لتطبيقها منـزلة تشريعية؛ إذ إن ما تتجاوز به الأصل يكون إضافي إلى ظروف التطبيق لا إلى الحكم. والله ورسوله أعلم.
([48])لابد من توضيح جوهر الثورة القرآنية التي هي شكلية بإطلاق؛ أي إن مضمونها أمثلة عينية من المطلوب الكلي الذي من واجب المسلم الإبداع الدائم لأعيانه. ليس المطلوب احتذاء الأعيان الحاصلة بل فعل التعيين المحصل للأعيان: فهي شكلية بأسلوب العبارة وشكلية بأسلوب العلاج. وكل تعلق بالمضامين الواردة فيه خلط بين المثال المضروب والمعنى المقصود. وقد يقبل هذا التعلق في التربية العامية فيكون جزءا من الهوية القاعدية للتقاليد والعوائد اتباعا لبعض السنن إتباعا حرفيا. وهذا الموقف العملي يصبح ضرره كبيرا إذا فرض على الموقف النظري فيصبح دعوة إلى تجميد الثورة في أعيان أمثلتها، وهو لعمري جوهر ما يريده العلمانيون الذين يريدون بالأرخنة استنتاج ضرورة التجاوز الملغي للقرآن نفسه لكونه يكون لاغيا مع المضمونات العينية التي رد إليها وحصر فيها. لكن أسلوب العبارة القرآنية هو الذروة التي يمكن تخيلها في الإبداع الأدبي وأسلوب العلاج القرآني هو الذروة التي يمكن تخيلها في الإبداع العلمي؛ وهما الأسلوبان اللذان وصفنا عند الكلام عن فنيات التحرر من السياق ما يعني التحرر من المضمون العيني ضرورة. وأثر الأسلوب الأول في الأسلوب الثاني هو الذي يحدد الشرعة أو أسلوب التربية الخلقية وأثر الأسلوب الثاني في الأسلوب الأول هو الذي يحدد المنهاج أو أسلوب التربية العلمية. والأسلوب الشامل لها ليكون أصلها ومبدأ وحدتها هو الأسلوب القرآني الذي بلغ الذروة فيها جميعا. وما لم نعامل القرآن بمقتضى طبيعته التي وصفنا هنا نبقى دون الشروط الضرورية لفهم الثورة المحمدية ولم هي تقتضي أن يختم الوحي وأن يكون الإسلام دين البداية والغاية أي الديني في كل دين وأن كل ما تختلف به الأديان الأخرى عنه ليس هو إلا تحريفات الدين عند الله.
([49])وهو مثال مأخوذ من مقالنا مآل العجلة والارتجال (موقع الملتقى) في الرد على أحد الجاعلين من الخيرية المحمدية مجرد تفضيل شبه عنصري للعرب والمسلمين -من حيث أعيانهم وليس من حيث اتصافهم بالصفات التي اشترطها القرآن ليكون كل متصف بها خيرا دون النظر إلى جنسه أو سلالته أو انتسابه الديني الرسمي- حتى كادت الخيرية تصبح من جنس عقيدة الشعب المختار التي أتى القرآن ليحرر منها البشرية، ويعيد مفهوم الأخوة الإنسانية التي لا فضل فيها لعربي على أعجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى.