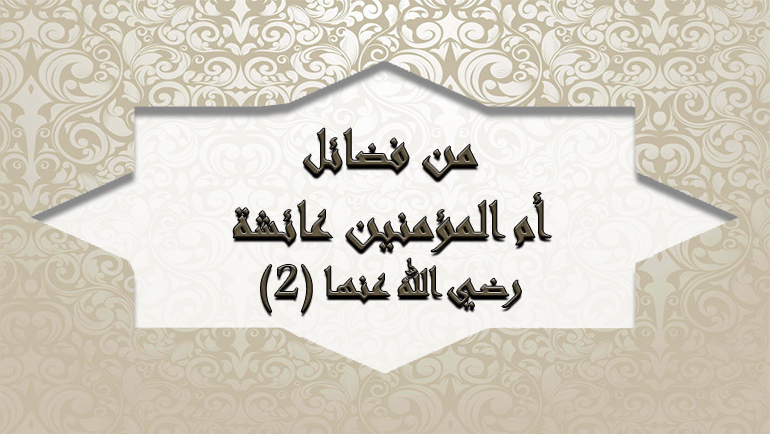من أشهر الوثائق السياسية في عالم اليوم “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948م. ولم تصدر هذه الوثيقة من فراغ، فقد سبق للأمريكيين في حرب الاستقلال التي شنوها ضد احتلال بريطانيا لبلادهم، سبق لهم أن أصدروا “إعلان الاستقلال” في يوليه سنة 1776 وضمنوه “أن كل الرجال قد ولدتهم أمهاتهم سواسية”، وأشاروا إلى حق الإنسان في الحياة والحرية والمساواة.
ثم لما كانت الثورة الفرنسية في أغسطس سنة 1789، أصدرت إعلانا لحقوق الإنسان وتضمن: “يولد الناس أحرارا ومتساوين في الحقوق”. وما لبث هذا الإعلان أن صار ذا شهرة واسعة وصيت ذائع، وصارت مبادئه من الأصول التي انبنى عليها الفكر السياسي الغربي في العصر الحديث.
وجاء “الإعلان العالمي” في سنة 1948 مستندا للأصلين السابقين، فكان وثيقة دولية ذات إشعاع على الدساتير والقوانين الوطنية التي تصدر في غالبية الدول. وبعد صدور هذا الإعلان عملت الأمم المتحدة على إنجاز مهمة أكثر صعوبة، وهي تحويل مبادئ الإعلان إلى مواد تتضمنها معاهدة دولية تقرر التزام الدول المصدقة على هذه المعاهدة، التزامها قانونا بتطبيق هذه المبادئ؛ أي تحويل المبادئ الخاصة بحقوق الإنسان إلى أحكام قانونية ملزمة.
وأعدت مشروعي اتفاقيتين: الأولى؛ تتناول الحقوق المدنية والسياسية، والثانية؛ تعالج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي 16 ديسمبر سنة 1966 صدقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على هاتين الاتفاقيتين، ولكن كان تنفيذ كل منهما يتطلب موافقة 35 دولة على الأقل. ولم يتوافر هذا العدد إلا بعد عشر سنوات؛ في 3 يناير سنة 1976 بالنسبة للاتفاقية الخاصة بـ”الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، وفي 23 مارس سنة 1976 بالنسبة للاتفاقية الخاصة “بالحقوق المدنية والسياسية”.
وتتضمن الاتفاقية المدنية والسياسية حق كل كائن بشري في الحياة والحرية والأمن والحياة الخاصة، وحقه في المحاكمة العادلة. وحمايته من العبودية ومن الاعتقال، وحقه في حرية الفكر والضمير والديانة وممارسة الرأي والتعبير عنه وحقه في التنقل والتجمع. كما تتضمن الاتفاقية الاقتصادية والاجتماعية كفالة الظروف المعيشية الأفضل، وحق الشخص في العمل والأجر العادل وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية له وتشكيل الجمعيات والانضمام لها.. إلخ.
أولا: ريادة الإسلام في تكريم الإنسان وكفالة حقوقه
يسهل القول بأن الإسلام كان سابقا لهذه الوثائق في تقرير جملة المبادئ التي تضمنتها، حماية لحق الإنسان في العيش الحر الكريم، وهذا هو الواقع الذي تنبئ به الحقيقة التاريخية. إن أصل النصوص والمبادئ التي وردت في الوثائق التي سبقت الإشارة إليها، وهو الأصل الذي صاغه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الأولى بقوله: “يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق..”، هذا النص المشهور المتكرر، هو ذاته نص عبارة عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص التي يحفظها صبية المدارس والكتاتيب منذ المئات من السنين: “بم تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا”، وأن أحمد عرابي، قال: “لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارا”، دون أن يكون قد طالع إعلان الاستقلال الأمريكي ولا إعلان الحقوق الفرنسي إنما كان يردد مقولة مشهورة لعمر يعرفها صبية الكتاتيب.
يقول الله تبارك وتعالى: ﴿يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى..﴾ (الحجرات: 13) تشير هذه الآية إلى وحدة المنشأ للناس كافة، والحديث موجه هنا للناس كافة لا للمؤمنين وحدهم. والرسول الكريم يوصي في خطبة الوداع: “أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب”، ثم يؤكد أن “ليس لعربي على أعجمي ولا لأحمر على أبيض فضل إلا بالتقوى”.
بهذا يتقرر أصل التساوي بين الناس جميعا حسب خلقهم الأول وعناصرهم الأولى، وأن التفاضل يرد بعد ذلك من الفعل الإرادي للبشر، وهو التقوى جماع خاصتي العمل والإيمان، والتعامل والسلوك. كل ذلك تأكد من ألف ومائتين من الأعوام السابقة على الإعلان الأمريكي.
وتسهل أيضا المقارنة بين هذا المبدأ الإسلامي وبين ما قامت عليه عقائد البشر وقت نزول الرسالة المحمدية، فكتب الهنود البراهمانيمين بالهند تقرر التفاضل بين الناس حسب عناصرهم ونشأتهم الأولى، واليونان كانوا يرون أنفسهم شعبا مختارا، غيرهم دونهم ويسمون الغير برابرة، والرومان يتحلون بنظامهم القانوني وما يتيح لهم من ضمانات، يضنون به أن يكون نظاما قانونيا حاكما لغير الرومان من سائر البشر. والإسرائيليون يعتقدون أنهم وحدهم شعب الله المختار. وعرب الجاهلية يرون كمال الإنسانية في عروبتهم دون الأعاجم، ويأبون على بناتهم الزواج من الأعاجم.
هذه أهون الملاحظات وأيسرها في هذا الشأن الذي نتحدث عنه. وهي هينة بمعنى أنها معروفة أو أن معرفتها قريبة المنال لمن ينشد المعرفة. إنما ما يحتاج إلى نظر هو أن حقوق الإنسان يمكن تلخيصها على تنوعها وتعددها في أمرين عامين جوهريين هما: حرية إرادته وحرمة شؤونه؛ أي أن يتاح له من الأوضاع ما يمكنه من أن يعمل إرادته وفق ما تنزع إليه مشيئته، وأن يكون له حرم يحيط بكل ما يلتصق به من شؤون، ويشمل هذا المجال الحيوي لإعمال الإرادة، ويأمن فيه أي عدوان أو اقتحام.
هذه الحقوق ليست لازمة للإنسان بموجب كونه إنسانا فقط؛ أي أنها ليست فقط لازمة للفرد ليحيا حياة صحيحة، ولكنها لازمة كضرورة لإقامة نظام اجتماعي رشيد، بمعنى أنه يتعين توافرها للأفراد لكي يقوم التنظيم الجماعي لهم على تماسك وترابط وليؤدى وظيفته بفاعلية وكفاية ويسر.
وذلك لأن البناء الاجتماعي لا تتماسك هياكله إلا إذا كانت لبناته قد هيئت بمواصفات خاصة تفيد القدرة على التحمل والبعد عن الخور والهشاشة. ومثال لذلك، فإننا لا نستطيع أن نقول بقيام نظام نيابي حقيقي، مهما كفلنا أدق الضمانات لصحة العملية الانتخابية، دون أن يكون الفرد آمنا على نفسه وعلى عياله ورزقه. لأن فقدان الأمن سيقتحم بالخوف نفسه ليعدم إرادته قبل أن تتشكل.
ثانيا: حقوق الإنسان وإشكالية المشروعية
وما يحتاج إلى نظر، أيضا، هو معرفة ما هو المصدر الذي تعتمد عليه إعلانات حقوق الإنسان، طبعا إن لها قوة تأتيها من تأييد الناس لها واقتناعهم بفائدتها. ولكن هذا المصدر وحده لا يكفي مستندا لإعطائها الدرجة القصوى المطلوبة من الاحترام والمشروعية. لأن “تأييد الناس واقتناعهم” أمر يدور في إطار الخيارات البشرية التي يلحقها التغيير ويرد عليها الخلاف بين الجماعات والمدارس والمذاهب. وبهذا فهي محكومة وليست حاكمة كما يراد لها أن تكون.
هذا هو المأزق الذي يقابل الفكر الوضعي العلماني، عندما يبحث في شرعية الأحكام المطلوب تقريرها لتقسيم أمور الجماعة البشرية وأوضاعها. فالقانون، مثلا، مصدره إرادة الشعب التي تتمثل في نوابه المنتخبين، وهو يتقرر إذا وجد نفع فيه، ويلغى ويتعدل حيثما وجد النفع في الإلغاء أو التعديل. ولكن بقيت مشكلة أمام الفكر الوضعي العلماني، وهي أن ثمة أحكاما يتعين أن يكون لها قدر من الاستقرار وألا تكون عرضة للتغيرات السريعة (التي قد تكون طارئة) والتي قد تتأثر بأحداث عارضة تؤثر في ميزان الأغلبية والأقلية البرلمانية.
هذه المشكلة واجهها الفكر الوضعي الأوروبي بتقرير أن ثمة أحكاما “دستورية”؛ أي أنها أحكام قانونية تعلو على القانون وتحكمه، ولها قدر من الاستقرار والثبات؛ فلا يجوز إلغاؤها أو تعديلها إلا بإتباع إجراءات خاصة، وإلا إذا توافرت أغلبية كبيرة غير عادية لتقرير التعديل أو أن يستفتى عليه بأن يطرح، لا أمام البرلمان، ولكن أمام الناس كافة لتقرر أغلبيتهم ما تراه.
ولكن هذا الوضع لم يكف، فثمة أحكام تشكل المرتكزات الرئيسية للنظام السياسي الاجتماعي الذي يقوم عليه الدستور، وليس من المنطقي أن تكون المرتكزات مما يمكن للدستور نفسه أن يقوضها، ومثال ذلك، شكل الدولة وهل يكون ملكيا أو جمهوريا، أو ما يتعلق باستقلال الدولة أو حدود سيادتها الجغرافية.. الخ
هذه المشكلة حلت بطريق منع تعديل هذه الأحكام بأية كيفية كانت؛ لأنها أحكام تتعلق بأصل قيام الدولة وتماسكها. لذلك فإن هذه الأحكام لا تتعدل ولا تتغير “بطريقة مشروعة”، وهي لا تتغير إلا بأحداث تحدث من خارج بناء الشرعية القانونية القائمة في وقت ما، ومن نحو الحروب والثورات.
ولكن بقيت رغم كل ذلك مشكلة، وهي أنه إذا كان القانون وضعيا بمعنى أننا نحن الذين ننشئه إنشاءً ونخلقه خلقا، ونحن الذين نلغيه ونعدمه وإذا كان الدستور هنا كالقانون يسويه البشر بإرادتهم، ومصدر شرعيته مكسوب من رضائهم في النهاية، وإذا كانت إرادة البشر متغيرة، فما الذي يحكم إرادة البشر في تغيرها؟
يمكن أن نقول إن ما يحكمها هو صالح الجماعة في كل ظرف خاص، وأنها تسير مع ما يتحقق للبشرية من نفع متغير مع تغير الظروف والأحوال. ولكن يبقى سؤال هو ما المعيار الذي نحكم به بالنفع والصلاح، والمعيار الذي يتحدد به المفيد والضار من الأمور؟
هذا السؤال الذي بلغناه سؤال فلسفي، يتعلق بالبحث عن المعيار الذي يوجه الإرادة البشرية ويرشد العقل البشري إلى النافع ليجتلبه والضار ليجتنبه، أي معيار الحسن والقبح، والصحة والفساد. إن رجال الفكر القانوني الوضعي بلغوا هذا السؤال ووقفوا عنده، إنهم وضعيون علمانيون يفضلون حكم الأرض على تشريع السماء، ويستبعدون “الغيب” من أن يكون له أثر في تشريعات الأرض.
وها هي الحاجة العملية والمنطقية تلجئهم للبحث عن معيار حاكم “للقيم العليا في المجتمع ويكون هو مصدر الشرعية العليا التي تميز الحسن من القبيح والصحيح من الفاسد والنافع من الضار. تفتق الفكر الوضعي هنا عن مقولة فلسفية أسموها “القانون الطبيعي” أو مجموعة المبادئ “المبادئ الأصلية والأزلية” وعرفوها بأنها تلك القيم والمبادئ المتضمنة في كيان الجماعة البشرية. وهذه المبادئ والأصول والقيم هي التي تحكم الشرعية العليا للجماعة ولقوانينها ولدستورها، وهي أيضا تحكم السلوك والتعاملات إذا لم يوجد نص من قانون أو دستور.
هنا تتعين ملاحظة، صنع الفكر الوضعي، لقد بدأ بأن أنكر غيب السماء فوجد نفسه في النهاية يبتدع غيبا جديدا، “غيبا أرضيا”، أسماه “القانون الطبيعي” أو “قواعد العدالة” أو “المبادئ الدستورية العليا”. ونسب إلى هذا “الغيب الأرضي” أنه مصدر “حقوق الإنسان”.
هذه الحقوق الجوهرية لحياة الإنسان ولاستقامة نظام المجتمع، أقوى من أن تسندها وتدعم وجودها “وثيقة دولية” أو نص دستوري، أو نسبة غامضة إلى مصدر مصنوع أسموه “القانون الطبيعي” إنها حقوق ذات قداسة مستمدة في الأساس من تشريع السماء ومن “غيب السماء”، وبهذا يصدق وصف الأزلية والأصالة عليها، وهو الوصف الذي يقرره القانون الوضعي ولكنه يبحث له عن مستند فلسفي خارج الدين، فتكون النتيجة أنه خرج على الدين لينشئ دينا جديدا أسماء “القانون الطبيعي”.
تقرير الحقوق في الإسلام يصدر عن أصول الشريعة الإسلامية التي تنزّلت إلينا بالقرآن الكريم وسنّة النبي، عليه الصلاة والسلام، وهي تستمد شرعيتها العليا من قداسة النصوص التي شرعتها وأقامتها فيصلا بين الحق والباطل. لذلك كانت رعاية الحقوق المنصوصة وأداء الواجبات المقررة، كان في ذلك نوع من التعبد لله، عز وجل، مع لزومها لضبط السلوك الاجتماعي وترشيد التعاملات البشرية وكفالة العدل والمساواة بين البشر.
هنا تتصل مجموعة الحقوق والواجبات المشرعة في أصول الإسلام، تتصل بالجانب الإيماني الذي يربط الإنسان بربه، وتتصل في الوقت نفسه بأصل انتماء المسلم للجماعة الإسلامية، وهي في مجموعها تستهدف تحقيق العدل باعتبار المساواة بين الناس كافة أنهم لا يتفاضلون إلا بالتقوى، من حيث إن التقوى مسلك إرادي يصنعه الإنسان ويكون مسؤولا عنه، ومن حيث إن التقوى اتباع لأسس السلوك الاجتماعي الحميد، وإطاعة لأوامر الله ونواهيه؛ أي التزام بقيم العدالة والمساواة المأمور بها والمنهي عما ينقضها.
وهنا أيضا تتأكد المساواة كقيمة لتحقيق العدل، من حيث أن صاحب الشرع الحاكم هو الإله المعبود من دون الخلق جميعا، والناس إزاء ذلك جميعهم سواسية كأسنان المشط، ولا يتأله ناس على ناس. هذا كله من حيث الشرعية العليا ومعايير الأحكام التي يتبعها البشر. وبهذا تبدأ حقوق الإنسان بالعبودية لله وحده. ويستمد البشر سيادتهم إزاء بعضهم البعض بهذه العبودية عينها. هذا هو الوعاء الفكري العام الذي يمكن أن نضع في إطاره مبدأ “حقوق الإنسان” في الإسلام.
ثالثا: في طبيعة الحق
لا يقيم الفكر الآخر نظره إلى الحقوق على أساس كونها حقوقا فردية فقط، وهو لا يسقط في النزعة الفردية في إدراكه لهذه الحقوق، إنما يقيم رؤيته في إطار التكوين المؤسس للمجتمع، والحق هنا لا ينحصر في نطاق المزايا التي يتمتع بها الفرد، إنما هو نظام وصلاحيات شرعية ووظائف اجتماعية، الحق في الإسلام وظيفة اجتماعية فضلا عن كونه مزية فردية، وهو عنصر في بناء هيئات المجتمع ومؤسساته.
إن الفكر الآخذ عن الإسلام مبني في ظني على أساس التكوين الجماعي للمجتمع، وليس على أساس التكوين الفردي؛ لأنه في الغالب الأعم ينظر إلى الفرد في إطار وجوده الجماعي، ومن ثم ينظر إليه على أساس التكوينات المؤسسية التي تشخص هذه الجماعات.
وإذا كان هذا هو التصور فقد قام النسق الحقوقي للفرد في الإسلام، مصوغا في “واجبات” فحقوق الزوجة في الأسرة تحددها واجبات الزوج، وحق الولد في التربية يكلفه واجب إنفاق الأب عليه، وحق إبداء الرأي يعبر عنه بواجب النصيحة والجهر بكلمة الحق، وحق التجمع والدعوة يفيده واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. وهكذا.
هذا الأسلوب في صياغة حق الفرد بأنه واجب على الغير إزاءه، وأنه واجب عليه إزاء جماعته، يتفق مع التكوين المؤسسي لهيئات المجتمع، وما يفيده ذلك من بيان ما على المندرجين في هذا التكوين من واجبات لغيرهم من الأفراد أو للجماعة كلها، ونحن نلحظ أن غالب الحقوق العامة التي يصوغها الفكر الغربي بحسبانها من حقوق الإنسان السياسية، نلحظ أنها في الفكر الإسلامي ترد في فروض الكفاية. وقد كان من أنبغ ما فتح الله سبحانه به على المسلمين أن يتفق فكرهم على صياغة ما يسمى بفرض الكفاية، ليجمع بين الحق العام والواجب العام، وليربط بين مسؤولية الفرد ومسؤولية الجماعة، وليقيم هذا التضامن العجيب بهذه الفكرة الفذه.
إن فقه المعاملات الغربي، نظر إلى علاقات التعامل بين الأفراد، مدركا أن الحق والالتزام وجهان لعلاقة واحدة، وأدرك في هذا النطاق أن وجه الالتزام هو ما يحسن أن يكون عليه المعول في النظر والتقدير، ولكنه في صدد الحقوق العامة لم ينظر هذه النظرة ولم يدرك فكرة أن ممارسة الحق هي واجب اجتماعي في الوقت ذاته. ولم يستطع أن يدرك فكرة فروض الكفاية هذه.
والصياغة الغربية الليبرالية للفكرة الحقوقية، تنظر إلى الفرد كما لو كان مستقلا عن الجماعة في التصور الأصلي؛ أي أنه في البدء كان فردا، ثم دخل الجماعة متنازلا عن بعض حقوقه لتحمى الجماعة له حقوقه الباقية، فظهرت فكرة الحق في تصور فردي، وهو تصور صوري لأن الفرد لم يكن خارج جماعة قط، منذ مولده، ومنذ خلق الله الإنسان على الأرض، وآدم، عليه السلام، نزل الأرض في أسرة، والفرد لا يكون خارج جماعة قط، حتى وفاته. ولأن اندراج الفرد في الجماعة لم يفقد، ولا يفقده حقوقا فردية له، بل إنه لم يكسب حقا فرديا أو جماعيا إلا في كنف الجماعة التي حمته ورعته وأبلغته إنسانيته وعلمته معنى الحق، والحق “علاقة” ولا يقوم حق دون جماعة تقوم “علاقة” الحق بين أفرادها وهيئاتها.
إن وضع الفكرة الحقوقية بهذا التصور الليبرالي، الذي يؤكد على الحق إنما أقام الحق في مواجهة الغير، فقام تصور أن حق الفرد ينتهي عندما يبدأ حق غيره، وحريته تقف عندما تنهض حرية غيره.. وهكذا، فصار وجود “الآخر” يشكل نوعا من القيد وهو نوع من الانتقاص، لذلك يصعب تصور الفكرة الحقوقية الغربية بدون مفهوم الصراع.
يختلف هذا الوضع عن صياغة الفكر الإسلامي، التي حددت الحق بحسبانه واجب الغير له، أو واجبه هو نحو جماعته، وهي صياغة توقظ في الفرد دائما مثيرات “العطاء” لا مثيرات “الأخذ”.
المساواة بين البشر يقرها الإسلام ويحض عليها، فالناس سواسية كأسنان المشط ولا فضل لعربي على أعجمي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى؛ بمعنى أن الناس لا يتفاضلون إلا بما في مكنة كل منهم من وجوه الخيارات الإرادية في عبوديتهم لله ومعاملاتهم مع سائر الناس؛ لأن التقوى المأمور بها في العبادة والتعامل، إنما ترد في مجال الخيارات المتاحة للناس والتي ترد بشأنها تبعة الثواب والعقاب.
إذا كانت المساواة مقررة هكذا في الإسلام، فإن الضوابط الإسلامية للتنظيم الاجتماعي لا تكتفي بهذا التقرير، بل تتجاوزه لتؤكد على “العدالة” بوصفها الهدف الأصيل من تقرير المساواة.
إن المساواة تعني منع التمييز بين الناس بسبب يلحق بهم دون أن يكون لإرادتهم دخل في قيامه، وأن يقوم هذا السبب لديهم على وجه الاطراد دون أن يكون في مكنتهم بالعمل الإرادي أن يرفعوه أو أن يتجاوزوه، وتقوم هذه الأسباب عادة لدى جماعات من البشر تشترك فيه، تلك هي الأسباب المتعلقة بالجنس أو لون البشرة أو اللغة أو ما يشابه ذلك. والمساواة على هذا الوصف صفة سلبية تشكل الحد الأدنى لما يتعين أن يكون عليه وضع الإنسان.
والمساواة تعني أن تنظر الجماعة إلى الأفراد المكونين لها بحسبانهم محض أفراد فيها، لا يتميز أي فرد فيهم عن الآخرين إلا أن تكون أوصافا مكتسب كشروط التعليم أو الخبرة ونحو ذلك، أو على الأقل أن تكون أوصافا مفارقة وغير لصيقة بالفرد دائما، كشرط بلوغ الفرد سنا معينة ليتمكن من إجراء أعمال معينة أو للتعيين في منصب ميعن، فالسن شرط غير مكتسب ولكنه شرط مفارق يطرأ على الإنسان ويطرأ على الناس جميعا على حد سواء.
والمساواة بهذا تصنع إنسانا “مجردا” من الأوصاف التي تميزه بالفطرة عن غيره من أفراد الجماعة ولكنها لا تكفي وحدها لأن تكفل للإنسان وصفا اجتماعيا مساويا لغيره في الحقيقة والواقع. وتفسير ذلك أنك إن سويت بين الناس في التكاليف بافتراض أنهم سواسية، فإن هذه التسوية لا تكفل لكل من المكلفين قدرا مساويا من الأعباء مع غيره، ما دامت ظروفهم الواقعية غير متماثلة. وذلك كما نسوى بين المريض وصحيح البدن في إيجاب التجنيد عليهما. هنا نجد أن مبدأ المساواة مع أهميته ولزومه لم يكف لتحقيق ما نصبو إليه من مساواة حقيقية، وهنا نجد أنه يلزمنا مبدأ آخر نقيمه لتحقيق التساوي الواقعي، ألا وهو مبدأ العدالة.
والخليفة الراشد أبو بكر، رضي الله عنه، يجهر بأنه سيعطى الضعيف أكثر وسيعطي القوي أقل، وذلك حتى يأخذ للأول حقه ويأخذ من الثاني حق الغير عليه. هذا الذي قرره الخليفة الراشد يكشف عن قصد اختلاف المعاملة باختلاف أوضاع البشر بهدف تحقيق التساوي في الواقع من بعد. هنا نجد “العدل” وهو قيمة إيجابية، ونحن مأمورون بإقامة العدل بنص أمر الإيجاب الموجه إلينا في القرآن الكريم ﴿إن الله يامر بالعدل والإحسان…﴾ الآية.
إن الإسلام وجه غالب أوامره في هذه المسألة إلى إقامة “العدل” وإشاعته وقرن القرآن الكريم الأمر بالعدل في الحكم، قرنه بأداء الأمانات إلى أهلها ﴿إن الله يامركم أن تودوا الاَمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل…﴾، وإن اقتران الحكم بالعدل بأداء الأمانة يفيد أن العدل حق للمعدول معه يستأديه منا، وهو أمانة علينا أن نوفيها.
والعدل بنص هذه الآية الكريمة واجب إفشاؤه “بين الناس”، فهو حق للناس جميعا كائنا من كانوا لا ينقص حقهم علينا ولا من أماناتنا لهم اختلاف جنس ولا لون ولا اختلاف دين أو عقيدة أو مذهب. ويذكر الشيخ محمد الصادق عرجون أن خطاب هذه الآية موجه “لكل من كان أهلا لتحمل الأمانة على عمومها، ولكل من تعرض للحكم بين الناس، سواء أكان هذا التعرض بطريق الأمانة العامة والولاية السياسية، أو بطريق التقاضي إليه… أو كان بطريق الفتوى أو بطريق الرياسة العرفية كرئيس الأسرة أو رئيس العمل…”. وقال القرطبي إن هذه الآية من أمهات الأحكام “تضمنت جميع الدين والشرع” وأنها عامة في جميع الناس تتناول الولاة ومن دونهم.
فالعدل هو الميزان الذي تعتمد عليه السياسة التشريعية، وهو الهدف الأعلى للسياسة الشرعية في الإسلام.