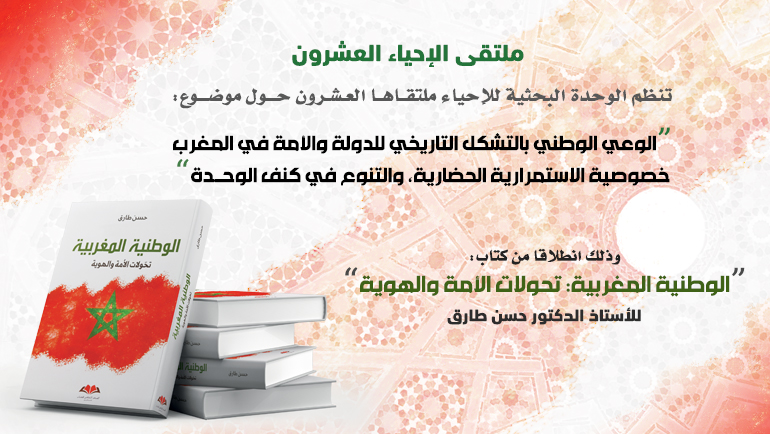تقرير عن مناقشة دكتوراه بعنوان: جمالية الشعر الصوفي إبان القرنين: 6/7 الهجريين، دراسة من خلال نماذج
نوقشت يوم الإثنين 16 مارس 2015 برحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أطروحة جامعية لنيل شهادة الدكتوراه بعنوان:” جمالية الشعر الصوفي إبان القرنين السادس والسابع الهجريين/ دراسة من خلال نماذج: غزليات ابن عربي (638هـ) وخمرية ابن الفارض (632هـ) وبردة البوصيري (698هـ)”. للطالبة الباحثة إلهام الحشمي، تحت إشراف الدكتور عبد الوهاب الفيلالي ، وقد تكونت لجنة المناقشة من السادة الأساتذة:
– الدكتور خالد سقاط/رئيسا
– الدكتور عبد الوهاب الفيلالي/مقررا.
– الدكتور محمد البوحمدي/عضوا
– الدكتور محمد الكنوني/عضوا
وحازت الطالبة على ميزة مشرف جدا مع توصية بالطبع بعد إجراء التصويبات اللازمة.
نص التقرير الذي تقدمت به الطالبة:
لقد كانت الغاية المنشودة من هذا البحثِ هي تحديدُ هويةِ الشعر الصوفي الجميل، والكشفِ عن مقوماته الفنية والجمالية، وآلية اشتغالها فيه استنادا إلى الفترة الزمنية التي ظهر فيها، وهي فترة القرنين السادس والسابع الهجريين،- كان لابد من الإدلاف إلى رحاب القصيدة الصوفية واختراق سطحها الظاهر، والنفاذ منه إلى العمق، لرفع النقاب عن خفايا وجهها الفني، وخبايا أسرارها الجمالية. وما كان لي وأنا أروم تحقيق هذه الغاية أن أُغْفِلَ قلائد الشعر الصوفي وأمهات قصائده، لذلك ألفيتُني أسارع لاختيار هذه العينات الشعرية، لرصد مناحي قوتها ومظاهر شاعريتها، وقد اعتملَت فيها حرارة الوجدان وصدق العاطفة، وسموّ المعاني المحلقة في رياض الحب الإلهي والمحبة المحمدية.
من هنا سمت هذا العمل بـ:
“جمالية الشعر الصوفي إبان القرنين السادس والسابع الهجريين، دراسة من خلال نماذج: غزليات ابن عربي (638هـ)، خمرية ابن الفارض (632هـ) وبردة البوصيري (698هـ).”
لاشك أن هذه الصيغة تفتح أمام القارئ ثلة من التساؤلات التي قد تخامره للوهلة الأولى، فيتساءل:
– ما المقصود بالشعر الصوفي الجميل ؟
– ما هويته؟ وما مقوماته؟
– ثم ما حقيقة هذا الشعر وقد تُنُووِل في ظل فترة زمنية كهاته؟
لئن كانت هذه التساؤلات، تكشف للقارئ عن قيمة الموضوع وجدته، فإنها بالنسبة للباحث الذي يحمل بداخله هاجس بلورتها وتخصيبها، لتَفتَح أمامه أسئلةً أخرى متعددة، من قبيل:
– متى نشأت القصيدة الصوفية؟
– هل حدث ذلك عندما أحس الذوق الصوفي أنه بحاجة لهذا الحس الفني والجمالي المبثوث في القصائد الدنيوية؟
– ما الذي كان سيحدث لو لم يكن هناك شعرٌ دنيوي جميل؟
– هل كنا سنصادف قصيدة صوفية جميلة بهذه الحرارة، وهذا الوهَجِ الفني العظيم؟ بل لماذا عجز هذا الفكر الصوفي برمته عن ابتكار نفس صوفي صرفٍ خاص به – على الأقل حتى حدود الفترة الزمنية المدروسة- ؟
– أيعود هذا العجز إلى كون جمالية الشعر في أصلها تتحقق بعيدا عن المضامين الفكرية الأخلاقية التي تضعف الشعر ؟ أم أن هذا الفن الجمالي هو ما يكسب القيم الأخلاقية مسحتها الفنية المؤثرة ؟
هذا ما حاولت هذه الأطروحة على امتداد فصولها ومباحثها الإجابة عنه والإلماع إليه.
إننا إذ نضع بين يدي القارئ هذه التساؤلات والافتراضات، لا يساورنا أدنى شكٍّ، من أنه سيشاركنا متعةَ الإعجاب بالموضوع وخصوبةَ آفاقه، وما مرادنا من هذا كله إلا وضعَه في الصورة العامة التي جاز لنا التحرك فيها، بوحي من هذه التساؤلات المعرفية، وتلكم الالتفاتات النقدية.
بعد هذا الذي تقدم، وارتباطا بصيغة العنوان ذاتها، أعود لأؤكد أنني آثرت الاشتغال بهذه النماذج دُونًا عن غيرها، وذلك لأنها تمثل قمة النضج، ومنتهى التطور الذي حققته القصيدة الصوفية الجميلة، في واحدة من أزهى الفترات الزمنية عطاء وإبداعا وإشراقا؛ ألا وهي فترة القرنين السادس والسابع الهجريين، التي ازدانت بالأعمال الرائدة والعظيمة التي خلفها ابن عربي في تراثه الشعري عامة، والغزلي منه على وجه الخصوص، وكذلك ابن الفارضِ في خمريته البديعة. وإذا كنت قد ركزت على منجز هذين الشاعرين سواء في الغزليات، أو في الخمريات، فاستأثَرا بالنصيب الأوفر من مباحث هذه الدراسة وفصولها، من حيث المقاربةُ والتحليل، فذلك لأنهما بمثابة أصولٍ، ولا سبيل البتةَ إلى تجاوز أو إغفال جانب من الجوانب الفنية المبثوثة في ثنايا أشعارهما، التي تتشابك ضمن مذاهبهما الوجودية العملاقة، على أن عنايتنا برصد جماليات المدحة النبوية الجميلة ممثلةً في نموذج «البردة للبوصيري»، لم تكن أقلّ حظا من غزليات ابن عربي، أو خمرية ابن الفارض؛ من حيث التركيزُ على مناحي الجمال فيها مبنى ومعنى، فلقد اتخذناها أيضا نموذجا فنيا متفردا، اكتمل به بناء صرح المدحة النبوية الجميلة. وجماع هذه النماذج برمتها هو ما يقدم لنا الصورة المثلى المجوَّدة، التي آلت إليها القصيدة الصوفية الجميلة، بعد أن قطعت أشواطا رائدة في مسيرتها التاريخية والفنية.
سعيا وراء تحقيق نسقيةٍ متينة لهذا البحث، توسلت بمنهج يتناسب وطبيعة الـمُنجَزِ وخُصوصيته.
ما دامت معالجة هذا الموضوع تفرض تتبع النصوص الشعرية المعتد بها في هذه الرسالة، والانطلاق منها لدراسة خصائصها النوعية والفنية الجمالية معنى ومبنى، فإن الدراسة المعتمدة – ولا شك – ستكون دراسة نصية تعتمد الموازنة والتحليل مَعْلَمَيْنِ رئيسين من معالمها، وسمتين بارزتين من سماتها، دون إغفال منهج التأويل الذي يسمح بالانفتاح على كل المعاني والدلالات المحتملة، ارتباطا بعنصر التكثيف والرمزية الذي يَسِمُ المعنى الصوفي ويطبع لغته وأسلوبه. هذا إلى جانب منهج الوصف، وذلك لما له من دور فعال في تقديم النص الموصوف، والإحاطةِ بمختلف جوانبه وتوضيحه للمتلقي. أما المنهج التاريخي فقد كان الالتفات إليه وإلى ما يتصل به من مظاهر حضارية وفكرية وثقافية، متاحا بالقدر الذي يخدم الوصف، ويغني التحليل. ويبقى المنهج الذي يوفق بين الحس الجمالي وبين الفكرة المعبرة عن الجمال، المنهجَ المهيمن الذي يسري في جنبات هذا البحث، والكل يتفاعل في أفق رصد جمالية الشعر الصوفي.
لقد أفرز هذا التفاعل توزعَ الدراسةِ هيكليا عبر مستويين اثنين؛ يمثل أحدهما الجانب النظري في البحث، بينما يمثل الثاني الجانب العملي الإنجازي، وقد روعي في بنائهما التسلسلُ والتدرجُ في عرض الفصول والمباحث التزاما بمبدإ التناسق المنهجي الذي تبنيناه قبل.
أما الباب الأول، والموسوم ب” العلاقة بين التصوف والشعر” فيتكون من فصلين ينصرف أولُهما بمبحثيه” مبحثُ تعريف الشعرِ”، و”مبحث تعريف التصوف”، لبسط الحدود المعرفية الفاصلة بينهما، والخلوص منهما للوقوف عند الوشائج الخفية التي تؤلف بينهما في العمق، وتوحد بينهما في الجوهر.
فيما يُعْنَى الفصل الثاني من هذا البابِ، برصد مظاهر التفاعل المتحققة بين التصوف والشعر، وذلك على امتداد مبحثين؛ خُصص أولهما لرصد أنماط الكتابة الصوفية المتولَّدة عنهما، فيما انصرف ثانيهما للتركيز على خصائص الشعر الصوفي الاستغراقي، المعبَّر عنه بالإلهيات، أو شعر الحب الإلهي، باعتباره أرقى هذه الأنماط وأكثرها فنية.
هذا، وقد ذيلت كل فصل من هذه الفصول بالاستنتاج الذي يناسبه ويفضي إليه.
أما الباب الثاني فيضاهي سابقه قيمة وأهمية، وذلك لأنه يعرض لرهان تُعَوِّل الدراسة عليه، ألا وهو رهان الكشف عن السمات الفنية والجمالية للقصيدة الصوفية الجميلة. وارتباطا بذلك، قُسم هذا الباب إلى فصلين هما:
الفصل الأول:”جماليات فكرية” ويضم مبحثين، خصص الأول منهما للحديث عن المؤثرات الثقافية التي باشرت أثرها البَيِّن في فكر هؤلاء الأعلام المستشهَد بأشعارهم.
فيما انصرف المبحث الثاني منهما لطرح القضايا الفكرية الصريحة التي تداولها هؤلاء الشعراء، ونظَّروا لها من داخل الممارسة الشعرية.
أما الفصل الثاني من هذا الباب؛ فقد كان الإطارَ العمليَّ الذي سنَحت لنا من خلاله هذه النماذج مجتمعةً من استنطاق منجزها الشعري، والكشف من خلاله عن خصائصها وسماتها، وذلك عبر مبحثين؛ خصص الأول منهما للحب الإلهي بمظهريه البديعين، “المظهر النسيبي؛ ترجمان الأشواق لابن عربي(638هـ)، والمظهر الخمري؛ خمرية ابن الفارض (632هـ). فيما خصص المبحث الثاني للحب المحمدي مجسدا في نمط المِدحة النبوية الجميلة، التي مثلنا لها بنموذج “البردة” للبوصيري(698هـ). وقد عملنا على بسط مراحل تطورها بداية قبل أن ننصرف إلى رصد مناحي فنيتها وجماليتها التي جعلتها من غُرَر القصائد المدحية. وقد ذُيِّل هذا الفصل باستنتاجات عامة ارتباطا بمبحثيه معا.
كان الخلوص من هذه الأبواب برمتها إلى خاتمة عامة أفضت إليها هذه الدراسة، مناسبةً أخرى، حاولتُ أن أستجمع فيها نتائج البحث في شكل استنتاجات تركيبية، وهذا ما خصصته لشقها الأول الذي عنونته ب “استنتاجات”، والذي انطلقت منه لرصد آفاق الاشتغال، والتطلعات الممكن استشرافها، استنادا إلى قضايا هذه الأطروحة ومباحثها.
وانتهى هيكل هذا البحث بملحق للأشعار المعتمدة في هذه الدراسة، بما في ذلك “الخمريةُ” و”البردةُ” أما غزليات ابن عربي، فمثبتةٌ في ديوانه ” ترجمان الأشواق” الذي يغنينا عن إثباته في هذا الملحق. على أن وضع الفهارس العامة بدءا بفِهْرس الآيات القرآنية، مرورا بفهرس الأحاديث، ووصولا إلى فهرس المحتويات، فكان آخر خطوة سَدَّ بها هذا البحث دفتيه.
هذا، وقد أتاح تنوع مصادر البحث، وتعدد مراجعه ما بين كتب السير، والتراجم، والمعاجم اللغوية، والدراسات النقدية والأدبية، والرسائل والأطروحات الجامعية، وغير ذلك…- إمكانية توسيع الرؤية، وتعميق النظر في زوايا وجوانب هذا الموضوع، الذي لم أقف – في حدود ما اطلعت عليه من دراسات و أبحاث – على نموذج قاربه بهذه الصورة المقترحة، وهذه الخطة المتبعة، ارتباطا بهذه العينات الشعرية المختارة.
أما فيما يخص الصعوبات، فلست أريد أن أتحدث بتفصيل عن صعوبات هذا العمل، وذلك لإيماني الشديد بأنه –وحده- كفيل بتقديم نفسه إلى القارئ؛ فالاشتغال بمتن غزير كهذا يحيل البحثَ كلَّه إلى مغامرة، وإذا كان لابد من سرد صعوبات هذا العمل، فهي غزارة المصادر والمراجع الهائلة في مجال الدراسات الصوفية، والتي وإن كانت تفتح أمام البحث آفاقا كثيرة، تخصبه وتغني مجاله، فإنها في الوقت ذاته تعد من أهم الصعوبات التي تواجهه، وتكمن في مدى القدرة على الإحاطة التامة، فالاختيار الدقيق الصائب، ثم التجاوزُ والإقصاءُ. وبموازاة مع هذه الوضعية، يجد الدارس نفسه مجبرا على التسلح بأدوات نقدية – قد لا تتوفر لديه- يتوسل بها في الحكم حتى يتجنب الأحكام الذوقية والانطباعية، ويتوخى الحياد والموضوعية في الدراسة والتحليل.
أما عامل البُعْد المكاني عن هذه الكلية العامرة، وعن أجوائها العلمية المحفزة والمثيرة، والتي تشرفت بالتلمذة فيها لسنوات خلت، افتقدتها مجبرة في ظل إكراه ظروف العمل، فقد كان من أشد الصعوبات وأكثرها ضررا بالنسبة لمسار البحث وتطوره، ولكن العزم مع النية والصبر يحققان النصرَ، فمن توكل على الله كفاه، ومن استضاء بسراج توجيهات أساتذته الأجلاء، بلغ مداه.
لقد أسفر هذا المدى عن النتائج والخلاصات الآتية:
1-لم يتسن لنا الوقوفُ عند حد قار ثابتٍ لمفهوم الشعر، كما لمفهوم التصوف، وذلك لاستعصائهما معا على القبض والتحديد، خاصة في ظل المتغيرات البيئية، والذاتية والخارجية التي باشرت أثرَها البيِّنِ على هذا المفهوم أو ذاك، إلا أنه بالنظر إلى طبيعة بعض خصائصهما النوعية، استطاع البحث أن يتنبه إلى بعض مظاهر الائتلاف التي تربطهما، وتوحد بينهما في العمق والجوهر. وقد ثَبَتَ لدينا بما لا يدع مجالا للشك أن في الشعر بعضا من التصوف، كما أن في التصوف بعضا من الشعر، وقد كان هذا التماهي قمينا بأن يُسَوِّغ المزاوجة بينهما في بوثقة واحدة؛ ألا وهي بوثقة العاطفة والوجدان والإبداع في آن، فتكونَ ثمَرةُ هذا التزاوجِ، ولادةُ أنماطٍ كتابية شتى من أنماط الكتابة الأدبية الصوفية، سواء ما ارتبط منها بالنثر أو بالنظم.
ولأن حاجتنا منها مجتمعةً، كانت إلى الشعر، فقد كان إقصاؤنا لما ليس شعرا ضمنها، خطوةً أولى عاودنا بعدها الإقصاءَ مجددا، داخل دائرة الشعر نفسِها لكل الأنماط النظمية الباردة التي تفتقر لمعالم الفنية، ومقومات الجمال، إما ارتباطا بمواضيعها، أو بمقصدية الناظم منها. واكتفينا مقابل هذا، بالإبقاء على شعر الحب الإلهي، وشعر الحب المحمدي كنموذجين متفردين، ومَعْلمين من معالم الشعر الصوفي الجميل، الراقي بمعانيه ومبانيه، كما بمناحي الجمال والجلال والقوة فيه. وهو الضرب الذي قصدناه من هذه الدراسة أولا وأخيرا.
2- لقد أمكننا الوقوفُ عند سر من أسرار هذه اللذة المبددة في جسد القصيدة الصوفية الجميلة، والذي كشفَت عنه آليات تشغيل تلكم المقوماتُ الفنيةُ والجمالية، المستعارةُ من الخطاب الشعري الدنيوي، والتي طُوِّعت جميعا لاحتواء المعاني الصوفية بحمولتها العاطفية ووزنها الوجداني الثقيل، وذلك ليتسنى لها بواسطتها حسنُ التعبيرِ، ومن ثَمّ غيرت من نمط اشتغالها لتغَيُّر وِجْهَتِهَا، فأصبح النسيب بعناصره ومكوناته الفنية من أطلال، وديار ورحلة وأضعان ومعشوقة وغيرها، أصبح مسخرا للتعبير عن الحب الإلهي المقدس، وغدا خلوا من صور الحب الحسي المدنس، واستُثْمرت الخمرة الدنيوية استثمارا فنيا راقيا، فكانت خمرةً أزليةً تسكر وتطرب وتفني وتحيي، دون أن تمت البثةَ بصلة للخمرة الدنيوية الدَّنية.كذلك تمردت الأمكنة على جغرافيتها وغدت مكانا واحدا يسير في اتجاه المطلق؛ في اتجاه الذات الإلهية السامية، واستحالت الأزمنة زمنا واحدا سرمديا لا ينتهي، ولا يُحَدُّ، ذلك هو زمن الحب، وزمن العبادة، وزمن الاستغراق في ذات الله تعالى، وفي جميل نعوته، وجليل صفاته.
بالنسبة للآفاق:
سنحت لنا القصيدة الصوفية الجميلة أن نستشرف بإيعاز من قضاياها ومباحثها الفنية والمعرفية، آفاقًا وتطلعاتٍ أودعناها ضمن هذه العناوين الفرعية: “الأَصيلُ والمستعار والمبتدع في القصيدة الصوفية”، و” آثارُها الذوقيةِ”.
فأما الأصيل الثابت في حق هذا الشعر، فهو جمال الفكرة الصوفية نفسها، وقد استمدت جمالها من جلال معانيها الراقية السامية، ذات النزعة الأخلاقية، التي هي أصل من أصول التصوف وثوابتِهِ. غير أن ما ينبغي التنبيهُ إليه في هذا السياق، هو هذا الإنجاز الباهر الذي حققه هذا الضرب من الشعر، لـمَّا استطاع الجمعَ بين ما هو فنيٌّ وما هو أخلاقي في بوثقة واحدة. وقد تنبه شعراء الصوفية بحسهم النقدي الثاقب، إلى أهمية الجمع بينهما، خاصة في الفترات الزمنية التي سبقت هذه المرحلة، فكان الظهور القوي لهذا التآلفِ في صورته المثلى المجوِّدة، قد برز ببراعة وبداعة مع أعلام وفحول هذه الفترة ممن استشهدنا بهم في هذه الدراسة، وعند أقرانهم من كبار شعراء هذه المرحلة أيضا، ممن تجرأوا على تسخير الفن لخدمة الأخلاق.
وأما المستعار: فهو المقومات الفنية والجمالية التي هي من ركائز القصيدة الشعرية الدنيوية، والتي سبق وألمحنا إليها، وقد استطعنا الخلوصَ منها إلى أن الحقيقة الفنية الكامنة وراء هذه الاستعارة، كانت هي تحقيق شعرية خاصة للسماع. ولسنا بحاجة إلى أن نثبت أهمية السماع في التجربة الشعرية الصوفية، لأن ذلك تحصيلُ حاصلٍ، فالسماع كاستراتيجية كان حاضرا في التراث الشعري، لكن الذي نود التنبيه إليه هو هذه الوثبةُ النوعيةُ، التي تحققت لهذا السماع في ظل التجربة الشعرية الصوفية، ونقصد كيف غَدا فنًّا قائما بذاته، له أسسه وأصولُه، وطقوسه وأجواؤه التي يُنشد فيها ويلقى وفْقَها.وهو ما أسهم في تنشيط الحركة الفنية والإنتاجية بالنسبة للشعر، والارتقاءِ بالحب إلى أسمى المقامات، وبهذا تسنى لها أن تعيد للشعر قيمتَه ووظيفتَه الاجتماعيةِ الضائعةِ في العصور الخوالي. ولا أدل على ذلك من أن ابنَ عربيفي مرحلة سابقة، وبخاصة في كتابه “محاضرة الأبرار كان يعتد كثيرا بأشعار الغزل الدنيوي السابقة عليه، فكثيرا ما كان يقول:”ومن سماعنا قول مهيار” لا بل إن ما كان يختاره لمهيارٍ هو ما حاول نظمَه في مرحلة لاحقة، وهو نفسُه ما اقترحه على تلامذته في السماع، وغير ذلك من الإشارات النقدية التي يبدي ظاهرها اهتماما بهذا اللون الشعري أو ذاك لحاجة فنية لا غير، لكن باطنَها ينطوي على خطاب نقدي صامت، يخفي وراءه حاجة هذا الفكر الصوفي العملاق، إلى نَفَس غزلي صرف، يكون أصلا في الممارسة الإبداعية، وأساسا في التجربة الاستغراقية، دونما حاجة إلى استعارة أشعار الغزل الدنيوية.
من هنا وبإيعاز من هذه العوامل كلِّها، وارتباطا بفكرهما الصوفي العملاق، وبشاعريتهما الفذة، استطاع ابن الفارض، وابن عربي بما نظماه من أشعار صوفية جميلة، أن يؤصلا لسماع صوفي صرف بعد أن كان سماعا دنيويا، وقد امتدت آثاره الذوقية إلى مدى أبعد، وأعمق، بحيث أنتجت جيلا من المتلقين أصبحوا يتداولون فيما بينهم السماع الصوفي الصرف. وجيلا آخر لم يَـحُلْ ذلك بينهم وبين التوسل بالشعر الدنيوي مجددا، وقراءته قراءة صوفية، كما هو الحال بالنسبة للإمام الجوزي (597هـ) في كتابه “المدهش”، وابن الخطيب (767هـ) في كتابه “روضة التعريف بالحب الشريف”. فهما من آثار التصوف المشرقة التي تناولت موضوع الحب الإلهي في أوسع مداه، وجعلت الوجود كلَّه قائما عليه، وتلك آثارٌ نزمع بحول الله تعالى أن نوفَّق في المستقبل القريب من مواصلة الاشتغال بها ضمن الحديث عن الآثار الذوقية للقصيدة الصوفية الجميلة ما بعد القرن السابع الهجري.
المبتدع: لا مجال لحصر مناحي الإبداع في القصيدة الصوفية الجميلة، فهي جمة وفيرة. وقد كان لنا معها في رحلة التنقيب هاته، وقفات مستفيضة، على أن آية ما يستدل به مظهرا إبداعيا عظيما في مسار هذه التجربة الصوفية الإبداعية، هذا التنظيرُ للشعر، والتقعيدُ له، والذي تحقق من داخل التجربة الوجودية نفسِها، وهو ما أضفى على المقاربة الشعرية الصوفية، قيمة نقدية مضافة متجددة. وهذا دليل واضح على أن التفكير في الشعر كان يتم من داخل الشعر نفسِه..
آثارها الذوقية: فيما يخص الجانب المتعلقَ بما ترتب عن هذه القصيدة الصوفية من آثار امتدت آفاقها، وفاعليتها إلى ما بعد القرن السابع الهجري، إلى القرون الأخرى الموالية، فيعكسه هذا النفسُ الشعري القوي الراقي الذي تأَتَّى لها في صورتها المثلى المجودة التي ظهرت بها، سواء في باب الغزليات أو الخمريات مما عُبِّر به عن المحبة الإلهية، أو في المراثي أو المدائح مما تُوُسِّل به للتعبير عن المحبة المحمدية، حسبنا شاهدا على ذلك، تلكم القصائدُ الجمة الغزيرة التي نُسجت على منوال خمرية ابنِ الفارض سواء في عصره أو في العصور اللاحقة من بعده. والتي كان لها الأثرُ العظيمُ في تطور فن الخمريات في الشعر العربي عموما، كذلك تلكم القصائد البديعة التي نظمها أصحابها معارضين بها بردة البوصيري، والنماذج التي عارضت البردة َكثيرةٌ جدا، ولا مجال لحصرها، ويكفي أن نشير في هذا السياق، إلى أن البردة بفنيتها وشاعريتها، ومظاهر قوتـها، استطاعت أن تؤرخ لقصيدة المديح النبوي، وتبشر بميلاد القصيدة المدحية الجميلة التي لم يستطع الذوق الشعري فيما بعد مقاومتَها.
لقد استطاعت المدحة النبوية بعد البردة في ظل هذه الآثار الذوقية التي رسختها، من أن تسير في مسارين:مسارُ المدرسة المشرقية ممثلا في البديعية. ومسارُ المدرسة المغربية التي ظلت وفيةً للنموذج الذي كشف عنه البوصيري.
وبعد… فهذا ما استطعنا الوصول إليه من نتائجَ وخلاصات من خلال هذه الرحلة الممتعة الفريدة التي سعدنا بها في عالم القصيدة الصوفية الجميلة، بكل بمقوماتها الفنية والجمالية، فألفيناها معينا لا ينضَبُ للواردين، ومددا لا ينقطع عن السائلين، وأبوابا لا توصد في وجه كل باحث في معارفها، منقِّبٍ في تفاصيلها وأسرارها، متعطش للتملي بسحر جلالها وجمالها… وقد غادرناها – مكرهين- دون أن تغادرنا متعةُ الإعجاب بها والانبهار بفنيتها التي جادت بها أنساقُها المتلاحمة القوية لفظا ومعنى ومبنى… ولو مضينا نتتبع دُررها لـمَا انتهت بنا هذه الرحلةُ عند حد، فلنوقف سياحة القلم، ولنذكر ما قاله أجدادنا من عظماء هذه الأمة:
” إني رأيت أنه لا يَكتب أحد كتابا في يومه، إلا قال في غده: لو غُيِّر هذا لكان أحسن، ولو زِيد هذا لكان يستحسن، ولو قُدِّم هذا لكان أفضل، ولو تُرك لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر”.