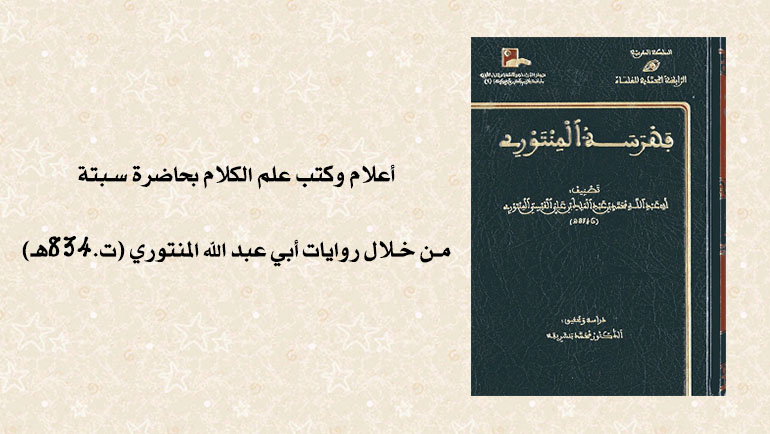تعزيز المشترك القيمي الإنساني… الترياق لتجاوز أزمة وباء كورونا وغيرها
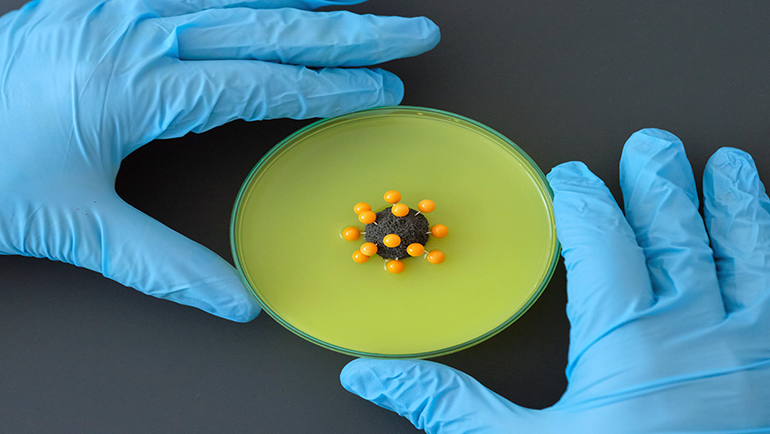
مما لا شك فيه أن عالمنا المعاصر يحظى بتطور وثروة غير مسبوقة، يستحيل تخيل ذلك منذ قرن أو قرنين؛ إذ شهد العالم في العقود الأخيرة تحولات مهمة على النطاق الاقتصادي وعلى مستوى التنظيم السياسي وعلى صعيد التطور العلمي الذي حقق نتائج باهرة ماديا أفادت الإنسانية، وحلت معضلات بشرية كانت إلى عهد قريب من قبيل المستحيلات…كذلك أصبحت المجتمعات وأقطارها المختلفة أكثر تقاربا مما كانت، ولم يقتصر هذا كله على مجالات الاقتصاد والاتصال، بل أيضا في ضوء الأفكار والمثل العليا في تفاعلها.
ومع هذا كله نعيش أيضا في عالم يعاني مظاهر قاسية من الحرمان والقهر، وظهرت أزمات كثيرة؛ وهي أزمات عالمية بقدر ما هي شاملة، إذ تضرب في غير مكان وعلى غير صعيد من صعد العمل الحضاري والنشاط البشري. وأصبح من تكرار القول: الكلام عن المأزق الوجودي الراهن كما تشير إليه عناوين المؤلفات والمقالات التي تتناول الوضع البشري مثل: الصدمة، الرعب، النهاية، السقوط، الانحلال، العدمية …إلى أن أصبح عنوان: “العالم في أزمة” من أكثر العناوين شيوعا وتداولا. وما فيروس كورونا إلا تجل من تجليات أزمة عالمية خانقة لا تدع ولا تذر.
وباء كورونا الذي أدخل العالم معه،مرحلة قلق إلى حد الهلع، من فيروس غير مرئي ينتشر بسرعة كبيرة،وعدد ضحاياه يتزايد إصابةً وموتًا، غير آبه بالحدود الجغرافية للدول… إن العالم مع كورونا يواجه أخطر أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، وإن جائحة فيروس كورونا المستجد حطمت وهم السلامة والأمن، وأثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن الأوبئة تهديد حاضر ومميت لنا جميعا.
ينضاف إلى خطر كورونا ما يشهده كوكب الأرض من تصادم وحروب ومجاعات وكوارث، فإننا نجد أن كل الاحتمالات المطروحة أمامنا لا تنذر إلا بخطورة الوضع. والبشرية مهددة بأكملها إذا لم تستدرك، وبسرعة، المخاطر التي تتهددها.
وسواء وعت البشرية عمق الكارثة أم لا، فإن الإنسان الذي يعيش على هذه الأرض، ينوء كاهله بأخطر الأزمات التي تحاصره من كل الاتجاهات. وما أبلغ وصف الفيلسوف الألماني مارتن هايدجر (1889-1976) للحضارة المعاصرة حين قال، إنها “حضارة تبدو كقصر شامخ في منظر كئيب، يعاني سادته من الأرق والقلق، ويقاسي خدامه من المرض والجهل والجوع”.
ثمة إحباط عام يلف الأسرة الدولية من جراء الوعي بخسارة المستقبل. نعم هناك خوف على المستقبل، وخوف مما قد يحمله مستقبل الجماعة الدولية من تدهور أمني، ومشكلات صحية واقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية…الأمر الذي أدى إلى طرح أخطر سؤال نعرفه في زماننا المعاصر: الإنسانية إلى أين؟ وهو سؤال اكتسب شرعيته وراهنيته مع تفشي وباء كورونا المستجد.
ونعتقد أن تعزيز الوعي بثقافة المشترك الإنساني كفيل بتجاوز خطر كورونا وكذا تحقيق السلم والأمن والتعاون الإنساني، وأن لا غنى عن تعزيز ذلك من منطلق التأكيد على المشتركات القيمية التي تجمع بين مكونات المجتمع الإنساني على اختلاف أديانهم وثقافاتهم، باعتبارها استراتيجية كفيلة بأن توحد بين الناس، وأن تدفعهم نحو التفكير في حلول جماعية لتجاوز أزمات واقعهم في الحاضر والمستقبل… نعني بالمشتركات القيمية؛ مجموعة القيم الأساسية التي يمكن أن توحد بين الناس من مختلف الخلفيات الثقافية والسياسية والدينية والفلسفية. فثمة مجموعة قيم إنسانية مشتركة بين كل الفضاءات الثقافية والدينية في العالم، ينبغي استثمارها والتركيز عليها لتكريس وحدة الإنسانية ووحدة “الجوهر الإنساني”.
إن قيما مثل: العدل، المساواة، الحرية، التعاون، المحبة، التواضع، رفض الظلم، رفض العنف…هي جزء من إنسانية كل إنسان. ولذلك فالجوهر الإنساني حاضر في كل التقاليد الثقافية والدينية لكل الشعوب عبر التاريخ الطويل للإنسانية.
والقول بقيم مشتركة أو إنسانية لا يعني أن المشتركات يجب أن تكون شاملة، وتسري مقتضياتها على سائر الناس في كل الظروف والأحوال؛ بل إن التأكيد هذا يعني أن هناك مشتركات أو عموميات كثيرة فيما بيننا، وأنه يمكن البناء عليها للتخفيف من فظاعات هذا العالم، وصنع حياة أفضل لأولئك الذين يأتون بعدنا.
في تقرير أعدته لجنة “إدارة المجتمع العالمي” التابعة للأمم المتحدة، بعنوان “جيران في عالم واحد”. (المنشور ضمن سلسلة عالم المعرفة الكويتية) وأملا في عيش أفضل في جوار عالمي؛ يؤكد التقرير على ضرورة تمثل قيم “حسن الجوار”، المنسجمة تماما مع جاء في ديباجة ميثاق الأمم المتحدةوالتي أعلنت تصميم شعوب العالم على “أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معا في سلام وحسن جوار”. ولم يكن الذين صاغوا هذه الكلمات أول من وضعوا رؤية لعالم واحد يكون كل الناس فيه جيرانا. فلقد استلهمت عصبة الأمم مثلا أعلى مشابهة لهذا في مطلع القرن المنصرم. وقبل ذلك بزمن طويل، تحدث الفلاسفة والمفكرون الدينيون عن الأسرة الإنسانية.
إن الالتزام بالمشتركات القيمية، وتوخي أرفع صفات السلوك بين البشر، سيمكن البشرية من تخطي أزماتها المعاصرة، وضمان مستقبل واعد للأجيال اللاحقة.
بالنظر إلى عالمية المشكلات والأزمات التي تهدد البشرية؛ فما يحدث على مسافات يمكن أن يعرض العالم كله للخطر. فانتشار الملوثات المشعة في أوربا يمكن أن يسبب سرطانات الجلد في مناطق أخرى من العالم، ونقص المحاصيل في روسيا يمكن أن يعني المزيد من الجوع في أفريقيا، والركود الاقتصادي في أمريكا الشمالية يمكن أن يدمر الوظائف في آسيا، والصراعات في أفريقيا يمكن أن تجلب المزيد من طالبي اللجوء إلى أوربا، كما أن الأوضاع المتوترة بالشرق الأوسط يمكن أن تكون سببا في حرب عالمية ثالثة، والصعوبات الاقتصادية في أوربا الشرقية يمكن أن تؤدي إلى كراهية الأجانب في أوربا الغربية. وهو ما تعزز صدقه مع تفشي وباء كورونا الظاهر بالصين والغازي للعالم أجمع…لقد أدى اختصار المسافات، وزيادة الصلات، وتعميق الاعتماد المتبادل – أدت جميعا مع تفاعلاتها- إلى تحول العالم إلى جوار بشري واحد، الأخطار فيه عالمية لا تستثني مكانا دون غيره أو رقعة جغرافية دون سواها.
والواقع أنه في إطار الجوار العالمي، يتعين على المواطنين أن يتعاونوا لخدمة أغراض كثيرة: للمحافظة على السلم والنظام وتوسيع النشاط الاقتصادي، والتصدي للتلوث،ووقف التغير المناخي أو الحد منه، ومكافحة الأمراض الوبائية، وكبح جماح انتشار الأسلحة، ومنع التصحر، والحفاظ على الوراثي وتنوع الأنواع، وردع الإرهابيين، وتفادي المجاعات، والتغلب على الركود الاقتصادي، واقتسام الموارد الشحيحة، واعتقال المتاجرين في المخدرات، وما إلى ذلك. إن المسائل التي تتطلب من الدول القومية توحيد جهودها –وبعبارة أخرى، تدعو إلى اتخاذ إجراءات فعالة على مستوى الجوار العالمي- في تزايد مستمر.
ولكي نكون جيرانا عالميين، فإننا نحتاج إلى طرق جديدة لكي يفهم بعضنا بعضا، وإلى طرق جديدة للحياة أيضا. وقد حدث مرارا وتكرارا، في تاريخ البشرية، أن حدث انقلابشاملفي النظرة إلى العالم والحياة، ووباء كورونا فرصة ذهبية أمام البشرية، لترى بعيون جديدة، وتفهم بعقول جديدة، لتتمكن بحق من بداية حياة جديدة،والتحول إلى طرق جديدة للعيش، تغليبا للمشترك الإنساني ولروح التعاون الجماعي، وقضاء على الأنانيات المقيتة والمصالح الذاتية الضيقة.
ونعتقد أن الالتزام الجماعي بالمشترك الإنساني، يمكن أن يوحد بين الناس من مختلف الخلفيات الثقافية والسياسية والدينية والفلسفية، مما يسهم في تعزيز الجهود المبذولة من أجل مواجهة التحديات المعاصرة. كما أن بمقدور هذه المشتركات القيمية أن تساعد الناس على إيجاد حلول فعالة وناجعة للعديد من المشكلات التي تهدد الأمن والسلم العالميين، وأن تساعدهم على أن يتصرفوا في ضوء مصالح متبادلة أوسع، وأبعد مدى.
هذه القيم جميعا تهيئ الأساس لتحويل العالم، إلى مجتمع عالمي أخلاقي يرتبط فيه الناس بما هو أكثر من روابط المصلحة. فجمعيها نابعة، بطريقة أو أخرى، من المطلب الذي ينسجم مع التعاليم الدينية في جميع أنحاء العالم، مطلب “المعاملة الإنسانية”؛ وصيغته هي: “ينبغي أن يعامل كل إنسان معاملة إنسانية”، والمقصود بذلك حفظ كرامته، فلا يحرم من ثابت حقوقه، ولا ينزل منزلة الوسيلة لغيره، ولا تقدر ذاته على أساس العرق أو الجنس أو السن أو اللون أو الدين أو اللغة أو الموطن أو المجتمع؛ ويتصل بهذا المطلب مبدأ أساسي أخذت به الأديان عرف باسم “القاعدة الذهبية”، وصيغته السالبة هي: “لا تعامل غيرك بما لا تريد أن تعامل به”؛ وصيغته الموجبة هي: “عامل غيرك بما تريد أن تعامل به”، والراجح أنه لا دين من الأديان الكبرى يخلو من صورة أو صور خاصة لهذه القاعدة، ونجد لها صورا متعددة في الإسلام تفردت عن غيرها بجعل إيمان المرء نفسه موقوفا على هذه المعاملة، نذكر منها الأحاديث الشريفة التي وردت في شعب الإيمان: “لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه”؛ وواضح أن هذه القاعدة تقضي باجتناب كل أشكال الظلم التي تنتج عن الأثرة والأنانية في مختلف مجالات الحياة. وهذا هو الشيء الجوهري الذي تمثل في الدعوة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة للاعتراف “بالكرامة المتأصلة لكافة أعضاء الأسرة الإنسانية وحقوقهم المتساوية غير المنقوصة.
وقد حدد الفيلسوف المغربي طه عبد الرحمن في كتابه: سؤال العمل: بحث عن الأصول العملية في الفكر والعلم، الصادر عن المركز الثقافي العربي، معالم استراتيجية المشتركات القيمية ونوردها تعميما للفائدة:
أ.الالتزام بثقافة المسالمة واحترام الحياة؛ ويقضي هذا الالتزام بحل الخلافات بالطريق السلمي في إطار من العدل مع السعي إلى تربية النشء على هذه الروح المسالمة؛ إذ لا بقاء للإنسانية من غير سلام عالمي؛ كما يقتضي باجتناب تعذيب الإنسان، جسمانيا أو نفسانيا، وبالأولى قتله ما لم يضر بحقوق غيره؛ ويتطلب هذا الالتزام، من جهة أخرى، العناية بالأسباب الطبيعية للحياة التي يضمها كوكب الأرض، نظرا لأن الموجودات في هذا الكون متعلق بعضها ببعض، ولأن الصلة المطلوبة بالطبيعة ليست هي الفعل فيها، وإنما التفاعل معها.
ب.الالتزام بثقافة التضامن والنظام الاقتصادي العادل والمساواة؛ ويقوم هذا الالتزام الثاني في اعتبار الملكية الخاصة حقا يستلزم أداء واجبات إزاء الآخرين، بحيث يصير تدبير المصالح المادية الخاصة مراعيا لحاجات المجتمع، كما يقوم في تنشئة الجيل الصاعد على قيم الرحمة والرأفة والعناية بالضعفاء والفقراء، بل ينبغي، بموجب هذا الالتزام، تجاوز نطاق التكافل المتمثل في الإعانات الظرفية للأفراد المحتاجين وفي مشاريع المساعدات لبعض المجتمعات الفقيرة إلى مستوى إعادة بناء مؤسسات الاقتصاد العالمي بما يحد من الاستهلاك الجامح والربح الفاحش، وينقل السلطة الاقتصادية من التنافس على السيطرة إلى خدمة الإنسانية، تحقيقا للعدل بين الأمم؛ فلا سلام عالمي بغير عدالة عالمية.
كذلك يقتضي الأمر احترام المساواة أيضا في العلاقات بين الأجيال الحاضرة والمقبلة، إن قيمة المساواة بين الأجيال تشكل الأساس لاستراتيجية التنمية المستديمة، التي تهدف إلى ضمان ألا يضر التقدم الاقتصادي بفرص الأجيال المقبلة من خلال استنزاف رصيد رأس المال الطبيعي الذي يعمل على استمرار الحياة الإنسانية على كوكب الأرض. وتتطلب المساواة من جميع المجتمعات أن تنتهج هذ الاستراتيجية.
ج.الالتزام بثقافة التسامح والاحترام المتبادل وبالصدق في الحياة؛ والمراد بهذا الالتزام الثالث والأخير هو أن يترك ممثلو الديانات تحقير العقائد المخالفة وتشويه مقاصدها واختلاق أسباب الحقد والتعصب والعداء ضد معتنقيها، كما أن واجب غيرهم من رجال الإعلام وأهل الفن والكتاب والعلماء ورجال السياسة والحكام أن يجتنبوا كل أشكال التحريف والتضليل والنفاق والاحتيال والانتهاز والكذب فيما يقولون ويكتبون؛ هذا مع العمل على تربية الناشئة على الصدق في الفكر والقول والفعل؛ إذ لا عدالة عالمية بغير تصادق في الأقوال والأفعال بين بني البشر.
إن التسامح أمر لا غنى عنه للعلاقات السلمية في أي مجتمع. وعندما يتحول التسامح إلى احترام متبادل، وهي صفة أكثر إيجابية، فإن نوعية العلاقات ترتقي بشكل واضح. ومن تم فإن الاحترام المتبادل يشكل أساسا لإقامة مجتمع تعددي –وهو نوع المجتمعات الذي يمثله الجوار العالمي- لا يتميز بالاستقرار فحسب بل باحترام تنوعه الذي يغنيه.
تجدر الإشارة أن استراتيجية المشتركات القيمية التي وصفناها الآن؛ لا يمكن تفعيلها إلا إذا تمت ممارستها على نحو مسؤول، كما تتوقف فاعليتها على قدرة الناس والحكومات على تجاوز المصالح الذاتية الضيقة، وعلى تقبلهم لحقيقة أن مصالح الإنسانية بوجه عام سيتم خدمتها على أفضل وجه من خلال قبول مجموعة الحقوق والمسؤوليات المشتركة.ومن شأن استراتيجية المشتركات القيمية التي وصفناها أن تساعد على إضفاء الطابع الإنساني على العلاقات بين مكونات الأسرة الإنسانية.
وينبغي التشديد هاهنا على أن تأسيس بعد أخلاقي لإدارة شؤون مجتمعنا العالمي يتطلب نهجا ثلاثيا، يكسب استراتيجية المشتركات القيمية فعالية مضاعفة، ويتضمن، تشجيع الالتزام بالقيم الأساسية المتعلقة بنوعية الحياة والعلاقات، وتعزيز الإحساس بالمسؤولية المشتركة إزاء الجوار العالمي. والتعبير عن هذه القيم من خلال الأسس الأخلاقية لمجتمع مدني عالمي، والقائمة على الحقوق والمسؤوليات المحددة التي تشارك فيها كل القوى الفاعلة، العامة والخاصة، الجماعية والفردية. مع تجسيد هذه الأخلاقيات في النظام المتطور للمعايير الدولية.
ترى هل يكون وباء كورونا كفيل بتحقيق التقارب بين مختلف الثقافات ابتداءفي المجال العلمي، يعقبه فهم أرحب مجالا، ونزوع إلى الإنسانية أكثر امتدادا، حيث تتجمع القلوب، من هنا ومن هناك، وتتشابك الأيدي لتعاون على البر والتقوى، تحقيقا لخير بني الإنسان؟.