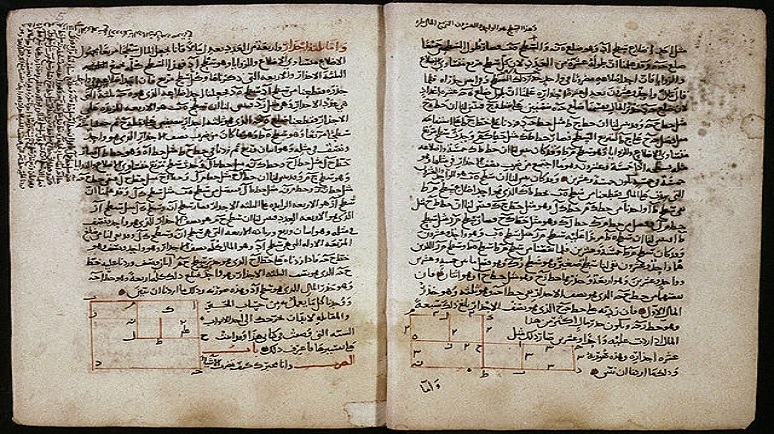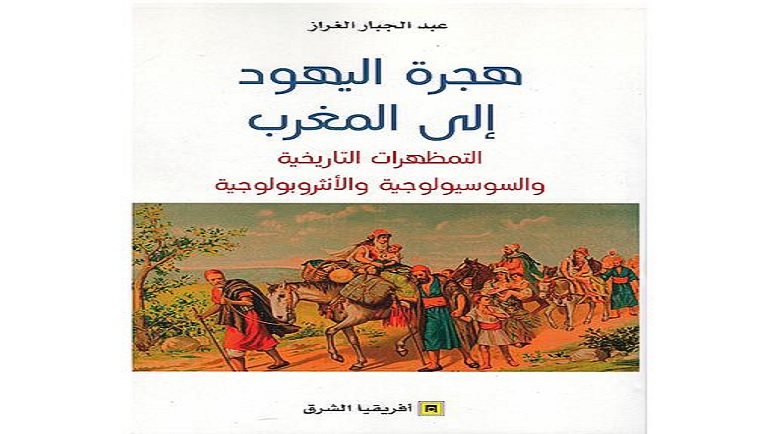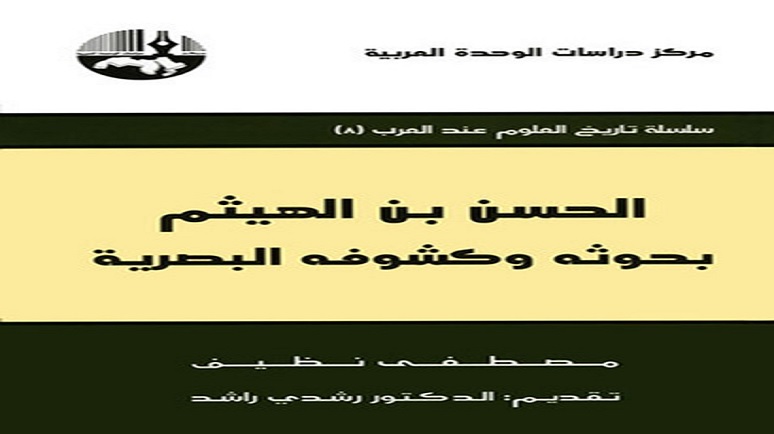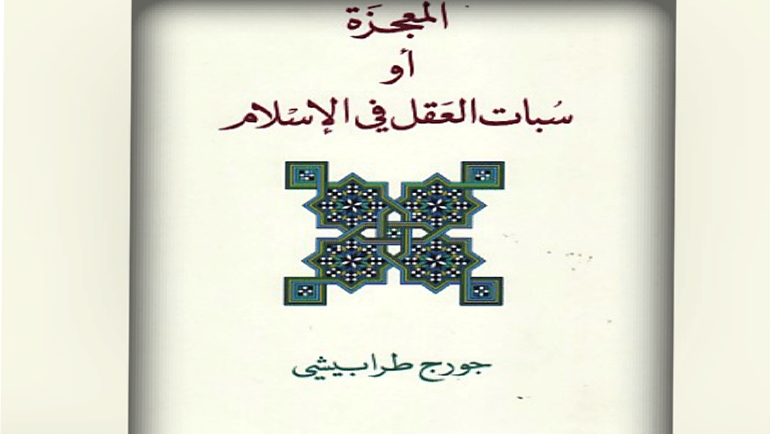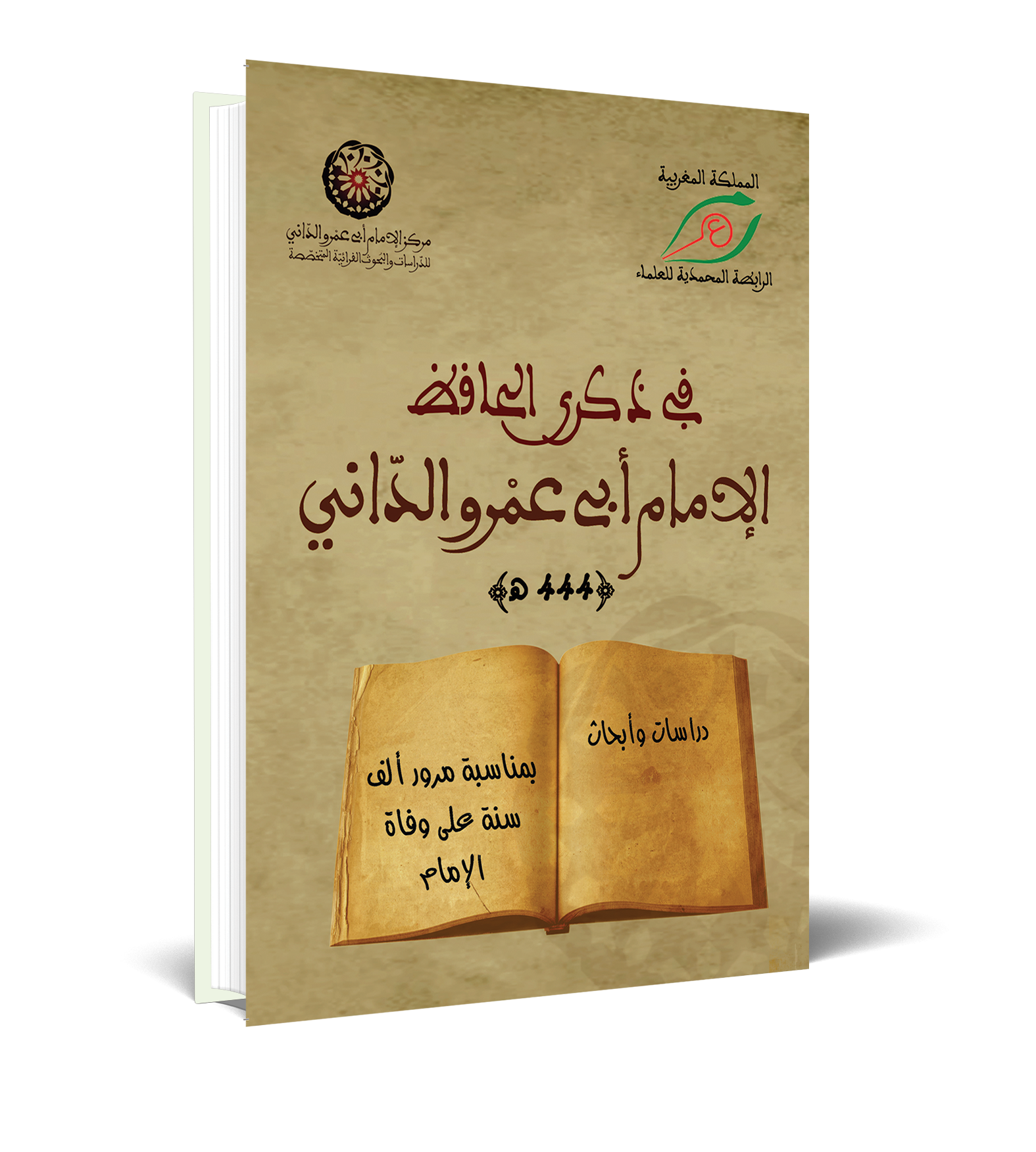بلاغة القرآن الكريم من كتاب (فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب) للإمام العلامة شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبيّ (ت:743هـ) – الحلقة الثانية –

تكلمنا في الحلقة السابقة عن البسملة وبعض نكتها، ونخصص هذه الحلقة للكلام عن الفاتحة.
– (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)
تكلم في هذه الآية عن الحمد وعن الفروق الدلالية بينه وبين ألفاظ أخر متقاربة، فقال: «واعلم أنه ذكر هاهنا ألفاظاً متقاربة المعنى، متدانية المغزى، ولابد من الفرق وهي: الثناء والشكر، والحمد، والمدح؛ فالثناء: الذكر بالخير مطلقاً.
الراغب: الثناء ما يذكر من محامد الناس فيثنى حالاً فحالاً ذكره.
الجوهري: أثنى عليه خيراً، والاسم: الثناء.
والشكر: الثناء على المحسن بما أولاكه من المعروف. والحمد: نقيض الذم، والمحمد: الذي كثرت خصاله المحمودة. والمدح: الثناء الحسن. فالثناء: هو القدر المشترك بين المفهومات الثلاث.
قال الإمام [أي الرازي]: المدح أعم من الحمد؛ لأن المدح يحصل للعاقل وغيره، والحمد لا يحصل إلا للفاعل المختار على ما يصدر منه من الإحسان والفضائل.
وقال الراغب: كل شكر حمد، وليس كل حمد شكراً، وكل حمد مدح، وليس كل مدح حمداً.
وقال القاضي: الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري من نعمة أو غيرها، والمدح هو الثناء على الجميل مطلقاً، تقول: حمدت زيداً على علمه وكرمه، ولا تقول: حمدته على حسنه؛ بل مدحته.
وقال الإمام: وإنما خص الحمد ها هنا دون المدح ليؤذن بالفعل الاختياري، ودون الشكر ليعم الإحسان والفضائل».(1/717).
– (الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)
قال الزمخشري – رحمه الله تعالى -: «و(الرحمن): فعلان من رحم، كغضبان وسكران من غضب وسكر، وكذلك (الرحيم) فعيل منه، كمريض وسقيم، من مرض وسقم، وفي (الرَّحْمَنِ) من المبالغة ما ليس في (الرَّحِيمِ)؛ ولذلك قالوا: رحمنُ الدنيا والآخرة، ورحيم الدنيا. ويقولون: إن الزيادة في البناء لزيادة المعنى. وقال الزجاج في الغضبان: هو الممتلئ غضباً».
وقف الطيبي – رحمه الله تعالى – على الفرق بين اللفظين، وعلى وجه تقديم الرحمن على الرحيم، وذكر مذاهب العلماء في ذلك، وجنح إلى أن الرحمن يشمل جلائل النعم وأصولها والرحيم دقائقها وفروعها، وذكر أن هذا من باب التتميم لا الترقي متعقبا للزمخشري – رحمهما الله تعالى -، وقال: «قال صاحبا “الإيجاز” و”الانتصاف”: الرحمن أبلغ؛ لأنه كالعلم إذ كان لا يوصف به غير الله، فكأنه الموصوف. وهو أقدم؛ إذ الأصل في نعم الله أن تكون عظيمة، فالبداية بما يدل على عظمها أولى. هذا أحسن الأقوال وأقرب إلى مراد المصنف؛ يعني أن هذا الأسلوب ليس من باب الترقي، بل هو من باب التتميم: وهو تقييد الكلام بتابع يفيد مبالغة؛ وذلك أنه تعالى لما ذكر ما دل على جلائل النعم وعظائمها، أراد المبالغة والاستيعاب، فتمم بما دل على دقائقها وروادفها؛ ليدل به على أنه مولى النعم كلها: ظواهرها وبواطنها، جلائلها ودقائقها، وهو المراد بقوله هنا: “أردفه الرحيم، كالتتمة والرديف”، وفي “الفاتحة” قوله: “من كونه منعماً بالنعم كلها: الظاهرة والباطنة والجلائل والدقائق”، ولو قصد الترقي لفاتت المبالغة المذكورة وذهب به معنى التعميم المطلوب في ألفاظ “الفاتحة” كما سبق. وذلك أن الترقي يحصل فيما إذا قلت: فلان يعلم التصريف والنحو، والتتميم لا يحصل إلا من قولك: يعلم معاني كلام الله المجيد والتصريف؛ إذ من شرط التتميم الأخذ بما هو الأعلى في الشيء، ثم ما هو أحط منه ليستوعب جميع ما يدخل تحت ذلك الشيء؛ لأنهم لا يعدلون عن الأصل والقياس إلا لتوخي نكتة، والجواب إذن من باب الأسلوب الحكيم، والله أعلم.
والذي عليه ظاهر كلام الإمام: أنه من باب التكميل وهو أن يؤتى بكلام في فن، فيرى أنه ناقص فيه فيكمل بآخر، فإنه تعالى لما قال: “الرحمن” تُوُهِّم أن جلائل النعم منه، وأن الدقائق لا يجوز أن تنسب إليه لحقارتها، فكمل بالرحيم. وينصره ما روينا عن أنس قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: “ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شسع نعله إذا انقطع”، وزاد: “حتى يسأله الملح”(1/715-716)
– (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ)
وقف الطيبي –رحمه الله تعالى – على الفرق الدلالي بين قراءتين (مَالِكِ) و(مَلِكِ)، وساق نصوصا عن حجة الأفاضل الخوارزمي صاحب (المطلع على غوامض كلام العرب)، وعن الزجاج، وعن القاضي البيضاوي القائل: «المالك هو المتصرف في الأعيان المملوكة، والمَلِك هو المتصرف بالأمر والنهي في المأمورين».
ووقف الطيبي أيضا على اختصاص يوم الدين دون يوم القيامة، وقال: «وفي اختصاص يوم الدين دون يوم القيامة وغيره من أساميه فائدتان:
– إحداهما: مراعاة الفاصلة،
– وثانيتهما: العموم المطلوب في الألفاظ، فإن الجزاء يشتمل على جميع أحوال القيامة من ابتداء النشور إلى السرمد الدائم. بل يكاد يتناول أحوال النشأة الأولى بأسرها. فظهر من هذا الاختصاص ومن مآل معنى القراءتين في الصورتين إفادة التعميم المطلوب من ألفاظ هذه السورة الكريمة، والدلالة على التسلط والغلبة والتصرف والملَكة فسبيل (مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ) و (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) سبيل (رَبِّ الْعَالَمِينَ) في الحمل على المفهومين. فانظر إلى حسن هذا الترتيب السري، وهذا النظم الأنيق تدهش منه؛ وذلك أن (رَبِّ الْعَالَمِينَ) إذن بالتصرف التام في الدنيا ملكاً وتربية، و (مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ) دل على ذلك في العقبى تسلطاً وقهراً، وتوسيط (الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) بينهما مناد بترجيح جانب الرحمة، وأنه تعالى رحمن الدنيا ورحيم الآخرة». (1/735)
(إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)
تكلم الطيبي – رحمه الله تعالى – عن ضمير النصب (إياك) وبحث في اشتقاقه اللغوي تبعا للزمخشري، وعن الالتفات في الآية، وهو الانتقال من الغيبة إلى الخطاب، وفائدة ذلك أن «الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب؛ كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع، وإيقاظاً للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد»(1/745).
وعلل هذه النكتة البلاغية، وقال: «قال ابن جني: إنما ترك الغيبة إلى الخطاب؛ لأن الحمد دون العبادة، ألا تراك تحمد نظيرك ولا تعبده؟! ولما صار إلى العبادة التي هي أقصى أمد الطاعة قال: (إِيَّاكَ نَعْبُدُ) إصراحاً بها وتقرّباً منه» (1/748).
وقدَّم طلب الإعانة على العبادة على الاستعانة «لكونه وسيلة وأخر لكونه طلباً»، ولما في تقديم العبادة كالوسيلة من «إشعار بأنهم فعلوا بقدرتهم ليحصلوا ما ليس من قدرتهم، وهو الاستعانة، وكلاهما من فضل الله».
ثم تكلم عن الضمير المستتر في كل من الفعلين، وقال: «قال القاضي: والضمير المستكن في الفعلين للقارئ ولسائر الموحدين. أدرج عبادته في تضاعيف عبادتهم، وخلط حاجته بحاجتهم لعلها تقبل ببركتها ويجاب إليها؛ ولهذا شرعت الجماعة. انظر إلى هذه الاعتبارات الدقيقة في معنى الشمول والعموم لتعثر على تلك الرمزة وهي كونها أم القرآن ومطلع التنزيل».
(اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ)
وقف الطيبي تبعا للزمخشري – رحمهما الله تعالى – على علة طلب الهداية، وقال: كيف طلبوا الهداية وهم مهتدون؟ وهل هذا إلا تحصيل للحاصل؟ وأجاب بجوابين:
– أحدهما: أنهم طلبوا الزيادة،
– وثانيهما: طلبوا الثبات.
قال القاضي: والمطلوب إما زيادة ما منحوه من الهدى، أو الثبات عليه، أو حصول المراتب المترتبة عليه. فإذا قاله العارف الواصل عنى به: أرشِدْنا طريق السير لتمحو عنا ظلمات أحوالنا وتميط غواشي أبداننا؛ لنستضيء بنور قدسك فنراك بنورك. (/1/754)
(صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ)
وقع في الآية تكرار لنكتة، قال الزمخشري –رحمه الله تعالى-: «فائدته التوكيد لما فيه من التثنية والتكرير والإشعار بأن الطريق المستقيم بيانه وتفسيره: صراط المسلمين، ليكون ذلك شهادة لصراط المسلمين بالاستقامة على أبلغ وجه وآكده، كما تقول: هل أدلك على أكرم الناس وأفضلهم فلان، فيكون ذلك أبلغ في وصفه بالكرم والفضل من قولك: هل أدلك على فلان الأكرم الأفضل؛ لأنك ثنيت ذكره مجملاً أولاً، ومفصلاً ثانياً، وأوقعت فلاناً تفسيراً وإيضاحاً للأكرم الأفضل؛ فجعلته علماً في الكرم والفضل، فكأنك قلت: من أراد رجلاً جامعاً للخصلتين فعليه بفلان فهو المشخص المعين؛ لاجتماعهما فيه غير مدافع ولا منازع…».
ووقف على نكتة إطلاق الإنعام في قوله: (أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ) وقال معلقا على كلام الزمخشري: «إن الأصل أن يذكر متعلق “أنعمت”، وهو الإسلام، فأطلق ليشمل كل إنعام، ثم كنى به عن ذلك المقيد ليؤذن بأن نعمة الإسلام مشتملة على جميع النعم، فلو قيد أولاً، لم يفد هذه الفائدة»(1/758).
ثم وقف على قوله: (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) ونقل عن الراغب وقال: «إن قيل: كيف فسر على ذلك وكلا الفريقين ضال ومغضوب عليه؟
قيل: خص كل فريق منهم بصفة كانت أغلب عليهم، وإن شاركوا غيرهم في صفات ذم.
إن قيل: ما الفائدة في ترادف الوصفين، وأحدهما يقتضي الآخر؟
قيل: ليس من شرط الخطاب أن يقتصر في الأوصاف على ما يقتضي وصفاً آخر دون ذلك الآخر، ألا ترى أنك تقول: حي سميع بصير، والسمع والبصر يقتضي الحياة؟ ! ثم ليس من شرط ذلك أن يكون ذكره لغواً، وإنما ذكر (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ)؛ لأن الكفار قد شاركوا المؤمنين في إنعام كثير، فبين بالوصف أن المراد ليس إلا نعمةً مخصوصةً»(1/762)