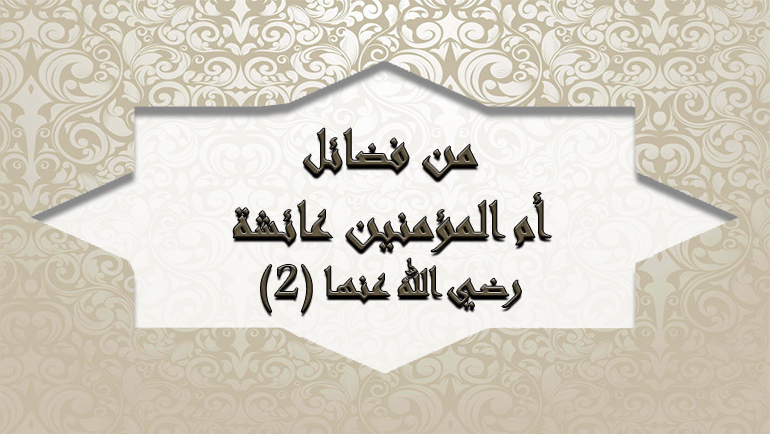لا شك أن الناظر بعمق في مصادر الشريعة وأصول المعرفة الإسلامية يجدها متوحدة النظر والمعالجة لكل قضايا الفهم والإفهام، متفقة في منهجها البياني القائم على الوضوح واليسر والبساطة والوسطية. وإذا كانت صبغتها كذلك فقد وجدنا القرآن الكريم، والسنة النبوية، والاجتهاد الأصولي الفقهي، تضافرت وتكاملت سهامهم في بيان وإفهام الخطاب التكليفي الذي نيط بالإنسان المكلف.
ولما كانت الأصول تعني فيما تعنيه “الأدلة الكلية الثابتة قطعا إما بالذات أو بالمعنى في صورة قوانين محكمة، لإفادة الفقه[1].”
والشرح الأولي لهذا التعريف يقتضي أن (الأصول) منحصرة في الأدلة المنطلق منها لاستنباط الحكم الشرعي بشرط أن يراعى فيها المفهوم الكلي لا الجزئي؛ كالنظر إلى الكتاب أو السنة من حيث أنهما (كل)، لا من حيث خصوص آية كذا أو حديث كذا… وكون ذلك (بالذات أو بالمعنى)؛ يعني أن الأصول (ذاتية) كالكتاب والسنة، وإما (معنوية) كالإجماع والقياس، ورفع الضرر ورفع الحرج، وسد الذرائع وغيرها من (الكليات الاستقرائية القطعية) التي لا مادة لها في صورتها الكلية، وإنما هي (معان) مبثوثة في الأولى، ينتظمها الاستقراء في صورة قطعية.
قلت لما كان الأمر كذلك فقد حاولت بيان مساهمات هذه الفروع الثلاثة في إفهام الخطاب وتبليغه (القرآن والسنة والاجتهاد). انطلاقا من التقسيم التالي:
أولا: المنهج القرآني في إفهام الخطاب
تفرد القرآن الكريم بمنهجه الخاص في السعي إلى بيان خطابه التكليفي وفق بلاغته الفطرية الرامية إلى إفهام الجمهور بشكل أساسي، وقد استفيد منه عدة أساليب منها:
أ. إجراء الصيغة على عادة العرب في التعبير
اهتم الأصوليون بالمادة القرآنية أيما اهتمام، كما وقفوا عند بيان قيمتها، ومبلغ أصالتها وفائدتها وما ينبغي أن يتوجه إليه من ذلك مما يتعلق به العمل، دون الغوص فيما لا يتعلق به عمل، ثم اعتنوا بقوة إيضاحه وإفهامه وعظيم نعمته في تقويم اللسان.
وقد قال المتنزل به: ﴿الرحمن علم القرءان. خلق الاِنسان علمه البيان﴾ (الرحمن: 1-2) وقال سبحانه أيضا: ﴿هذا بيان للناس﴾ (ءال عمران: 138) وقال: ﴿عربي مبين﴾ (النحل: 103) وقال: ﴿وكذلك أنزلناه قرءانا عربيا﴾ (طه: 110)… وقال ﴿وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم﴾ (إبراهيم: 04)؛ لأن مدار الأمر على البيان والتبيين، وعلى الإفهام والتفهيم، وكلما كان اللسان أبين كان أحمد كما أنه كلما كان القلب أشد استبانة كان أحمد[2].”
فهو على مهيع من أجرى أساليبه وفق “معهود العرب في لغتهم العربية من حيث ذوات المفردات، والجمل، وقوانينها العامة، بل جاء كتابا عربيا جاريا على مألوف العرب من هذه الناحية، فمن حروفهم تألفت كلماته، ومن كلماتهم تألفت تراكيبه، وعلى قواعدهم العامة في صياغة هذه المفردات وتكوين التراكيب جاء تأليفه[3].” فلو لم ينزل على ما عهدوا لما تحققت معجزته فيما يقصد إليه من الإعجاز، ولو لم ينزل على طريقتهم لكان بعيدا عن مقاصده الكبرى المتمثلة في “البيان والهداية”.
بل الأعجب من ذلك أنه جاء مرضيا للعامة والخاصة، فإذا قرأته على العامة أو قرئ عليهم أحسوا جلاله، وذاقوا حلاوته، وفهموا منه على قدر استعدادهم ما يرضي عقولهم، وعواطفهم، وكذلك الخاصة إذا قرؤوه أو قرئ عليهم أحسوا جلاله وذاقوا حلاوته، وفهموا منه أكثر مما يفهم العامة، ورأوا أنهم بين يدي كلام ليس كمثله كلام لا في إشراق ديباجته، ولا في امتلائه وثروته، وليس كذلك كلام البشر، فإنه إن أرضى الخاصة والأذكياء لجنوحه إلى التجوز والإغراب والإشارة، لم يرض العامة، لأنهم لا يفهمونه، وإن أرضى العامة لجنوحه إلى التصريح والحقائق العارية المكشوفة، لم يرض الخاصة لنزوله إلى مستوى ليس فيه إمتاع لأذواقهم ومشاربهم وعقولهم[4].” فهو يسير سيرا وسطا ويقتفي نهجا معتدلا.
فلا هو يجنح إلى الغرابة والإلغاز بإطلاق؛ لأنه يفقد بذلك صفة الخطاب الجمهوري، ولا هو يجنح إلى التصريح والبداهة؛ لأنه بذلك يفقد سر إعجازه، فهو “خطاب يتمتع في تقنياته الأسلوبية بكل الجماليات التي تؤصل لها بلاغة المشافهة شعرا ونثرا، وهو يعتمد اعتمادا كبيرا على التجنيس الصوتي، وقوة الإيقاع، وحركية المجاز، بقدر ما يعتمد على سوق المثل، وصوغ الحكمة، ونسج القصص، وهو ينهل من وضوح الحكي بقدر ما ينهل من غموض الشعر، ولكنه رغم ذلك ينفصل عن مفهومي الشعر والقص معا، ويتناءى عنهما[5] لسر إعجازه.
أما عن فائدته العلمية فقد أشار الغزالي إلى معنى جميل، وهو بصدد ذكر فضل أسلوب القرآن على علم الكلام قال: “فأدلة القرآن مثل الغذاء ينتفع به كل إنسان، وأدلة المتكلمين مثل الدواء ينتفع به آحاد الناس ويستضر به الأكثرون، بل أدلة القرآن كالماء الذي ينتفع به الصبي والرضيع، والرجل، والقوي، وسائر الأدلة كالأطعمة التي ينتفع بها الأقوياء مرة ويرضون بها أخرى، ولا ينتفع بها الصبيان أصلا[6].”
هذا عن منطق القرآن في البيان وعن أصالة مادته. وعلى هذا المهيع أيضا جرى الشعر المحمود من أشعار العرب. قال الشاطبي رحمه الله: “فالممدوح من كلام العرب عند أرباب العربية ما كان بعيدا عن تكلف الاصطناع، ولذلك إذا اشتغل الشاعر العربي بالتنقيح اختلف في الأخذ عنه، فقد كان الأصمعي يعيب الحطيئة واعتذر عن ذلك بأن قال: “وجدت شعره كله جيدا فدلني على أنه كان يصنعه، وليس هكذا الشاعر المطبوع، إنما الشاعر المطبوع الذي يرمي بالكلام على عواهنه جيده على رديئه”. وما قاله هو الباب المنتهج والطريق المهيع، عند أهل اللسان.
وعلى الجملة فالأدلة على هذا المعنى كثيرة، ومن زاول كلام العرب وقف من هذا على علم[7]“؛ لأنه “متى كان اللفظ أيضا كريما في نفسه متخيرا في جنسه، وكان سليما من الفضول بريئا من التعقيد، حبب إلى النفوس، واتصل بالأذهان، والتحم بالعقول، وصغت اليه الأسماع، وارتاحت له القلوب، وخف على ألسنة الرواة، وشاع في الآفاق ذكره، وعظم في الناس خطره، وصار ذلك مادة للعالم الرئيس، ورياضة للمتعلم الريض، فإن أراد صاحب الكلام صلاح شأن العامة، ومصلحة حال الخاصة، وكان ممن يعم، ولا يخص، وينصح ولا يغش، وكان مشغوفا بأهل الجماعة، شنفا (مبغضا) لأهل الاختلاف والفرقة جمعت له الحظوظ من أقطارها، وسيقت إليه القلوب بأزمتها، (جمع زمام وهو كل ما يشد به) وجمعت النفوس المختلفة الأهواء على محبته وجبلت على تصويب إرادته[8].”
بهذه الوصفة تكون الألفاظ، والأساليب بريئة من اللوم، متنزهة عن النقص عالية في الوضوح والبيان. وهكذا يكون صاحبها قد أعذر وأنذر، وأقام الحجة، ووضح المحجة، وبين البلاغ لأنه من شرط البلاغ أن يكون مبينا، ولذلك وجدنا القرآن الكريم يضيف إلى البلاغ كلمة المبين ليحدد الشروط التي ينبغي أن يتصف بها الموضوع الذي يراد نقله إلى الآخرين؛ إذ لابد أن يتصف هذا المنقول أو هذا المبلغ بالمبين والبينات، وتوفير هذه الشروط هو واجب العلماء. وإلا كانت الحجة عليهم، لا لهم لتقصيرهم في طريق البيان، وعجزهم عن درج ومنزلة البلاغ المبين.
كما اشترط في قانون اللسان أيضا أن يكون مبنى الخطاب مراعيا لم يحقق الفهم لدى عامة المخاطبين، ولذلك لابد من اختيار الألفاظ والمعاني اللائقة بالجمهور دون نهج أسلوب الإبهام والخفاء لأنه “إنما يصح في مسلك الإفهام والفهم ما يكون عاما لجميع العرب، فلا يتكلف فيه فوق ما يقدرون عليه بحسب الألفاظ والمعاني فإن الناس في الفهم وتأتي التكليف فيه ليسوا على وزان واحد ولا متقارب، إلا أنهم يتقاربون في الأمور الجمهورية وما والاها. وعلى ذلك جرت مصالحهم في الدنيا، ولم يكونوا بحيث يتعمقون في كلامهم ولا في أعمالهم إلا بمقدار ما لا يخل بمقاصدهم، اللهم إلا أن يقصدوا أمرا خاصا لأناس خاصة فذاك كالكنايات الغامضة، والرموز البعيدة التي تخفى عن الجمهور ولا تخفى عمن قصد بها وإلا كان خارجا عن حكم معهودها.
فكذلك يلزم أن ينزل فهم الكتاب والسنة، بحيث تكون معانيه مشتركة لجميع العرب ولذلك أنزل القرآن على سبعة أحرف واشتركت فيه اللغات حتى كانت قبائل العرب تفهمه[9].” وإنما وجب أن يراعى في بناء الخطاب مسلك العامة في الفهم لما ينبني على الفهم من التكاليف المختلفة.
فلابد، إذن، من صياغة المفاهيم في قالب لغوي عفوي، غير متكلف سهل العبارة، واضح المقاصد،جاء في الموافقات في معرض الحديث عن الاستدلال: “واعلم أن المراد بالمقدمتين هاهنا ليس ما رسمه أهل المنطق على وفق الأشكال المعروفة (…) إلا أن المتحرى فيه إجراؤه على عادة العرب في مخاطبتها ومعهود كلامها؛ إذ هو أقرب إلى حصول المطلوب على أقرب ما يكون، ولأن التزام الاصطلاحات المنطقية والطرائق المستعملة فيها مبعد عن الوصول إلى المطلوب في الأكثر، لأن الشريعة لم توضع إلا على شرط الأمية[10]. ومن حيث إنها وضعت على شرط الأمية؛ إذ لم تخاطبهم على طريقة العلوم التي لم يعهدوها كالفلسفة والرياضيات… وجب أن تقتفي طريقة إفهام الأميين.
وفي معرض الحديث عن قصد الإفهام قال: “لابد في فهم الشريعة من اتباع معهود الأميين وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم، فإن كان للعرب في لسانهم عرف مستمر فلا يصح العدول عنه في فهم الشريعة، وإن لم يكن ثم عرف فلا يصح أن يجري في فهمها على ما لا تعرفه[11].”
والدليل على ذلك؛ أن اللغة القرآنية بوصفها نصوصا “لم ترد التفلت من البيئة العربية في مدلول الكلام. فقد ذكر الضريع، وكثير من نباتات الصحراء، والواحات، والنخيل، والأعناب والرمان، والأسد، والسدر، والتين، والزيتون. وكذلك ذكرت أسماء أماكن جغرافية مكة باسم بكة ويثرب… وكثير من أسماء الحيوانات في تلك البيئة؛ كالبعير سفينة الصحراء، والبغال، والحمير، والفيلة، والبقر.. وكذلك أسماء الأشياء؛ كالأباريق، والأكواب، والبئر، وبعض السباع؛ كالقسورة، والقرد، والخنزير. وهكذا تحضر البيئة العربية بوصفها مكان النص بموجوداتها المكانية، والنباتية، والحيوانية[12]“؛ كل ذلك لتقريبهم من مقاصد الخطاب القرآني.
وكيف يتسنى لغير العربي ممن لا يعرف النخل أن يدرك معنى العرجون القديم في قوله تعالى: ﴿والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم﴾ (يس: 38) وكذلك الطلح في قوله: ﴿وطلح منضود﴾ (الواقعة: 31). والطلع في قوله: ﴿والنخل باسقات لها طلع نضيد﴾ (ق: 10) إلى غير ذلك مما يطول ذكره[13].” وكل ذلك مناسب لهم مأخوذ مما كانوا يباشرونه يوميا في عملهم وداخل حياطهم.
وكان من الطبيعي أيضا أن يتعرض القرآن لخصوص عاداتهم، ويعرفهم بأحكام ما كانوا يتعاطون له؛ كالأزلام، والأنصاب، والبحيرة، والسائبة كما في قوله تعالى: ﴿ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام﴾ (المائدة: 105). وكذلك المكاء، والتصدية كما في قوله تعالى: ﴿وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية﴾ (الأنفال: 35). وكذلك الوأد في قوله تعالى:﴿ وإذا الموءودة سئلت. بأي ذنب قتلت﴾ (التكوير: 8-9). ومع أن الاجتماع العربي آنذاك يعيش وسط مجتمعات وثنية، إلا أن النص القرآني لم يتعرض لأوثان الهند والصين وغيرها من البلدان بل ذكر اللات، والعزى، ومناة الثالثة الأخرى مما تعرفه العرب.
وعلى طبق نظرة العربي إلى المرأة والعلاقة معها، وهي علاقة تقوم على مبدأ الغيرة ورد النص القرآني بالوعد الإلهي: ﴿حور مقصورات في الخيام﴾ (الرحمان: 72). وأن ﴿فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان﴾ (الرحمن: 55)[14].
ومن تأمل هذه الشواهد والأمثلة تظهر العلاقة الوثيقة بين النص القرآني، والبيئة العربية من حيث إجراء صيغ وأساليب التواصل على عادتهم في التعبير. ومقصد الخطاب القرآني في ذلك أن يعرفهم بما لهم وما عليهم.
أكثر من ذلك، فإن الخطاب القرآني لم يقف عند أساليبهم في العادات والأمور العملية بل اختار أيضا الأساليب ذات البعد والأثر النفسي من ذلك” قوله تعالى: ﴿يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا﴾ (طه: 100). قال: وسبب اختيار كلمة زرقا لعيونهم يوم القيامة لوجهين:
ـ الأول: أن الزرقة أبغض شيء من ألوان العيون إلى العرب؛ لأن الروم كانوا أعداءهم، وهم زرق العيون، ومن أقوالهم في صفة العدو: أسود الكبد، أصهب السبال، أزرق العيون، فأصهب من الصهبة بالصاد المهملة، وهي حمرة أو شقرة في الشعر، والسبال ما على الشارب من الشعر ومقدم اللحية، والاثنان مرادان.
ولهذا قال بشار في وصف البخيل:
وللبخيل على أمواله علل *** زرق العيون عليها أوجه سوء
ـ والثاني: أن المراد به العمى؛ لأن حدقة من يذهب نور بصره تزرق.
ويعضد هذا قول امرئ القيس:
أتوعدني والمستشرف مضاجعي *** ومستنة زرق كأنياب أغوال[15]
هكذا، إذن، يبدو أن اختيار اللغة المناسبة لمقام المتلقي- باعتباره مشاركا للملقي في صناعة الخطاب، أو قل إن شئت هو صانع الخطاب، والعمدة في ذلك – هو أساس الإفهام، وإلا فكلما خرج الخطاب عن المتعارف عليه، انقطعت حلقات التواصل، وأصبح المتكلم في عزلة تامة عن الوسط البيئي، واللغوي، والاجتماعي، والنفسي…الذي هو جزء منه.
ب. التعريف بالأمر المحسوس الظاهر
والمراد بذلك أن المنهج القرآني وهو يشيد القصد الإفهامي تهيئة للمكلف للامتثال يجنح إلى إفهام التكاليف العملية بما هو مادي محسوس. ولذلك قال الشاطبي: “فلابد من الرجوع إلى أمور محسوسة أو ظاهرة[16] وإنما استفيد ذلك من الملاحظة الاستقرائية لمنهج البيان الشرعي، فمنها أن الله تعالى عرفهم الأوقات؛ أوقات الصلاة بالشمس، والصيام بالهلال فقال تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اليل﴾ وقال: ﴿وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الاَبيض من الخيط الاَسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى اليل﴾ (البقرة: 186) وقال صلى الله عليه وسلم: “صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا الثلاثين” وقوله أيضا: “يقبض العلم، ويظهر الجهل، ويكثر الهرج” فقيل يا رسول الله وما الهرج؟ فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. (البخاري) وحين سئل، صلى الله عليه وسلم، عن أوقات الصلاة قال للسائل صل معنا هذين اليومين “ثم صلى ثم قال له: الوقت ما بين هذين” أو كما قال[17]. فهو، عليه الصلاة والسلام، يعلمهم بعلامات، وأمارات مادية محسوسة؛ إذ “الفعل بالغ من جهة بيان الكيفيات المعينة المخصوصة التي لا يبلغها البيان القولي، ولذلك بين، عليه الصلاة والسلام، بفعله لأمته، كما فعل به جبريل حين صلى به، وكما بين الحج والطهارة كذلك وإن جاء فيها بيان بالقول فإنه إن عرض نص الطهارة في القرآن على عين ما تلقى بالفعل من الرسول، عليه الصلاة والسلام، كان المدرك بالحس من الفعل فوق المدرك بالعقل من النص لا محالة، مع أنه إنما بعث ليبين للناس ما نزل إليهم… ولو تركنا والنص لما حصل لنا منه كل ذلك، بل أمر أقل منه[18]. فالزيادات التي يفي بها الفعل لا يصرح بها النص ولا يدلل عليها.
وقد يعدل عن المحسوسات واللوازم والأعراض الظاهرة إلى المرادفات الواضحة على أساس أن تكون هذه أشهر، وأوضح، وأوفى بتبليغ المقصود من الاصطلاح أو اللفظ المعرف. وذلك ” كما تفسر ألفاظ القرآن والحديث بمرادفاتها لغة من حيث كانت أظهر في الفهم منها (…) فإن التصورات المستعملة في الشرع إنما هي تقريبات بالألفاظ المرادفة، وما قام مقامها من البيانات القريبة.([19]).
ج. الاعتناء بالمعنى قبل المبنى
فإن المتكلم واضع الاصطلاحات ينبغي أن ينظر إلى قصد الكلام أولا فيرتب له ما يناسبه من الصيغ؛ إذ الصيغة في خدمة المعنى وليس العكس. يقول الشاطبي: “الاعتناء بالمعاني المبثوثة في الخطاب هو المقصود الأعظم[20].” ولذلك فإن “المعرف إذا انتبه إلى هذه الخاصية فحدد المعنى المراد من المصطلح في ذهنه بدقة ثم حاول إرساله إلى المتلقي في قالب لغوي مناسب، بعيدا عن الصنعة المتكلفة التي لا تلبس ثوبا ثقيلا من التعقيد في رص العبارات، والألفاظ إلى درجة يصبح اقتناص المقصود صعبا أو متعذرا، فيفتقد بذلك التعريف حقيقته كتعريف، ولا هو أيضا من الكلام المهلهل الذي لا يفي بمعنى محدد، بل يحتمل الوجوه المختلفة والتأويلات المتضاربة”[21].
فلابد من الحرص على سلامة العبارة مع تعبيد الطريق لها، فكل “عاقل يعلم أن مقصود الخطاب ليس هو التفقه في العبارة، بل التفقه في المعبر عنه، وما المراد به، هذا لا يرتاب فيه عاقل، ولا يصح أن يقال: إن التمكن من التفقه في الألفاظ والعبارات وسيلة إلى التفقه في المعاني بإجماع العلماء، فكيف يصح إنكار ما لا يمكن إنكاره؟ ولأن الاشتغال بالوسيلة والقيام بالفرض الواجب فيها دون الاشتغال بالمعنى المقصود لا ينكر في الجملة، وإلا لزم ذم علم العربية بجميع أصنافه. وليس كذلك باتفاق العلماء لأنا نقول: ما ذكرته في السؤال لا ينكر بإطلاق كيف وبالعربية فهمنا عن الله تعالى مراده في كتابه؟وإنما المنكر الخروج في ذلك إلى حد الإفراط (…) لأن العرب لم يفهم منها قصد مثله في كلامها، ولم يشتغل بالتفقه فيه سلف هذه الأمة[22].”
د. مراعاة مبدأ التدرج
إذا كانت “الصيغة الإفهامية” تقتضي موافقتها للقناة اللغوية الطبيعية العربية، وترميزها بالعلامات والأمارات المادية المحسوسة الظاهرة التي تناسب مقام الأمي ومستواه الإدراكي، ثم سلامة الفكرة ووضوح المعنى، فإنها تتوقف أيضا على الكم الزمني، والكيف المنهجي الذي يستدعيه واجب عبور الصيغة من المتكلم إلى المستمع بما يمكن دائما من القصد الامتثالي الإجرائي.
ولربما كانت عبارة “الرباني من يربي بصغار العلم قبل كباره” حكمة بالغة تثوي أبعادا تربوية منها كيفية التنصل من الثقافة السائدة في الواقع على أساس الإنطلاق منها ومشاركة المخاطب في بعضها للتخلي عنها كلية والثوران عليها. والبعد الآخر كيفية التدرج بالمتلقي مراعاة لطاقة الإنسان الاستيعابية وقوة إرادته في تلقي الخطاب والتوافق معه.
هي نفس المقاصد التي قصد إليها الخطاب القرآني وهو يوجه خطابه إلى المتلقي العربي مستحضرا أنه على أساس متطلباته سينظم خطابه وينتجه، وتكون “إرادة الخطاب في احتكاكها بإمكانات الواقع اختبارا لهذا الواقع، وتبدو كما لو كانت تطرح عليه هذا السؤال. إلى أي مدى تستطيع التجاوب معي؟ وإلى أي مدى تستطيع مجاوزة النقص الذي يحتوي مسار أفعالك؟ وتحولات الخطاب ما هي إلا قياس متدرج لطاقة الإنسان على استيعاب (بغية) ذلك الخطاب[23].
هذا التجاوب المتوقع بُدُوه وظهوره من طرف المتلقي، والتجاوز المنتظر منه لواقعه استدعى أن لا ينفصل الخطاب القرآني عن عرض فهم الإنسان العربي “للطبيعة التاريخية المتحولة التي تشكل حياة الإنسان وتغرس فيها دوافع شتى ونزوعات متوفزة. ولا شك أن هذه الدوافع والنزوعات تؤسس معرفة ناقصة بالذات وتشوش تشويشا واسعا على إصغاء تلك الذات لأعماقها. ولكن الخطاب القرآني يمتلك قدرا كبيرا من تأثيره النافذ عبر تمثيله لعاطفة التجاوز عن الضعف الإنساني في حدود معينة.
إن العادة تمثل قوة طاغية، ويتوقف امتصاص هذه القوة على تمكن الخطاب من بث قيمه الجديدة رويدا من سياسة طويلة المدى نستطيع أن نرى الخطاب القرآني، إذن، (مخططا قصديا) لاحتواء الآنية التاريخية في كليته الشاملة[24].”
فالخطاب القرآني إذ يشاركهم في تقنياته الأسلوبية التي تؤصل لها بلاغة المشافهة شعرا ونثرا، وهو إذ يشاركهم في مختلف ألوان إنتاجهم الأدبي في سوق المثل، وصوغ الحكمة، ونسج القصص يكون قد أصبح مقتدرا على تهيئة المخاطبين للدخول في مواجهة إيجابية مع ذواتهم لاستيعاب حقائق لم يأتلفوا معها من قبل.
ومع إبداء تعاطفه مع المخاطب والاعتراف له ببعض موروثاته العرفية والثقافية[25] ضمن مجاوزة هذه الذات لواقعها، فإذا بالنماذج[26] التي كانت تشكل وتمثل “رد فعل مضاد لقيم الثقافة السائدة سرعان ما أصبحت فعلا يصحح الثقافة السائدة نفسها، ويحل محلها ثقافة مغايرة[27].”
بيد أن هذه الثقافة البديل “ليست مفارقة بالكلية للثقافة التي تثور عليها أو تدحضها، وإلا ما أمكن لها أن ترسخ أقدامها في الواقع. وهنا تبرز وظيفة الخطاب بوصفه موصولا بهذه الثقافة ومنفصلا عنها في آن.
الاتصال والانفصال هو إستراتيجية الخطاب بمعنى من المعاني، ومن هذه الثنائية ينبع مفهومه وتتبلور وظيفته[28].” فهو يعمل على استقطاب وتوظيف عناصر الاختلاف إلى مجال الائتلاف بصورة تدريجية.ومن ثم لم يكن النص القرآني “قارئا لنص أصلي بقدر ما كان قراءات لوضعية أو وضعيات اجتماعية مشخصة ونتاجا لخصوصياتها يتبدى هذا الملمح أكثر جلاء في ظاهرة التدرج في التشريع لبعض الأحكام كتحريم الخمر، وتحريم الربا على قول، وبنزول القرآن منجما على هذا النحو ينم عن كونه نصا تاريخيا كونه نزل حسب الحوادث ومقتضى الحال ورعاية لوسائل تغيير الواقع، وهو في سبيل ذلك يتحرى أفضل الطرق كل ذلك في سياق تاريخي حيث دخل خير البشر وخضع لتموضعهم الاجتماعي والتاريخي[29] والتراثي”.
فالخطاب سواء في شقه النظري القرآن، أو في شقه التطبيقي سنة الرسول، عليه الصلاة والسلام، كان ينزع إلى القواسم المشتركة بين مضمونه وبين من كان مجتبى ومختارا لتمثيله وتطبيقه. ولذلك كان الرسول منهم، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتزوج النساء…
وكما كان القرآن متجاوبا مع الرسول، صلى الله عليه وسلم، يعلمه كل يوم شيئا جديدا ويرشده ويهديه ويثبته ويزيده اطمئنانا ويسليه، كان أيضا متجاوبا مع المؤمنين ففيه “صور متنوعة وألوان متباينة تلتقي كلها عند غاية واحدة: هي رعاية حال المخاطبين وتلبية حاجاتهم في مجتمعهم الجديد الآخذ في الازدهار وعدم مفاجأتهم بتشريعات وعادات وأخلاق لا عهد لهم بمثلها… إذ لو نزل جملة واحدة فإنه كان ينفر من قبوله كثير من الناس لكثرة ما فيه من الفرائض والمناهي، ويوضح ذلك ما أخرجه البخاري عن عائشة، رضي الله عنها، قالت “إنما نزل أول ما نزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس، إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمر، لقالوا لا ندع الخمر أبدا ولو نزل ﴿لا تزنوا﴾ لقالوا لا ندع الزنا أبدا[30].”
هكذا ظل الخطاب القرآني ينزل نجوما مدة عشرين سنة أو يزيد. ويعلل الخطاب القرآني بصيغة المتكلم الذي هو الله هذه الظاهرة انطلاقا من تقديره للحالة البشرية فيقول من زاوية رؤيته للمتلقي الأول (المخاطب): ﴿وقال الذين كفروا لولا نزّل عليه القرءان جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك، ورتلناه ترتيلا﴾ (الفرقان: 32).
ويقول من زاوية رؤيته للمتلقي الثاني (المخاطبين): ﴿وقرءانا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا﴾ (الإسراء: 106).
وهو إذ كان يراعي قدراتهم في التكليف كان يراعي قدراتهم في الفهم؛ إذ لا تكليف إلا بعد الفهم، فالتدرج إذن خاصية خادمة للقصد الإفهامي للشارع بدأ من الأخف إلى الأثقل، ومن الواضح البسيط إلى المركب.
وقد استقينا أمثلة ونماذج من كتاب “قواعد الأحكام في مصالح الأنام “تبين بجلاء المقاصد والأبعاد التربوية للتدرج ومنها:
ـ أن الله أخر إيجاب الصلاة إلى ليلة الإسراء لأنه لو أوجبها في ابتداء الإسلام لنفروا من ثقلها عليهم.
ـ ومنها تأخير وجوب الزكاة إلى ما بعد الهجرة لأنها لو وجبت في الابتداء لكان إيجابها أشد تنفيرا لغلبة الضنة بالأموال.
ـ ومنها الجهاد لو وجب في الابتداء لأباد الكفرة أهل الإسلام لقلة المؤمنين وكثرة الكافرين.
ـ ومنها القتال في الشهر الحرام لو أجل في ابتداء الإسلام لنفروا منه لشدة استعظامهم لذلك وكذلك القتال في البلد الحرام.
ـ ومنها القصر على أربع نسوة لو ثبت في ابتداء الإسلام لنفر الكفار من الدخول فيه، وكذلك القصر على ثلاث طلقات فتأخرت هذه الواجبات تأليفا على الإسلام الذي هو أفضل من كل واجب ومصلحته تربوا على كل المصالح.
ولمثل هذا أقر الشرع من أسلم منهم على الأنكحة المعقودة (غيلان الثقافي)[31] على خلاف شرائط الإسلام، وكذلك أسقط عن المجانين ما يتلقونه من أنفس المومنين وأموالهم؛ لأنه لو ألزمهم بذلك لنفروا من الدخول في الإسلام. وكذلك بني الإسلام على غفران جميع الذنوب لأن عدمها لو بقيت بعد الإسلام لنفروا. وكذلك قال جماعة قد زنوا فأكثروا من الزنا ومن غيره من الكبائر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ما تقول وتدعوا إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة؟ فأنزل الله تعالى: ﴿قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا﴾ (الزمر: 53) الآية. وقال في غيرهم ﴿قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾ (الأنفال: 38).
وإنما أمرهم في ابتداء الإسلام بإفشاء السلام، وإطعام الطعام، وصلة الأرحام والصدق والعفاف؛ لأن ذلك كان ملائما لطباعهم حاثا لهم على الدخول في الإسلام[32].”
هذا عين الحكمة وبها أمر الإسلام في كثير من نصوصه وحث المربين والعلماء على تطبيقها في تدبير كل شأن ديني أو دنيوي فقال تعالى: ﴿كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم ءاياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون﴾ (البقرة: 150).
قال سيد قطب، رحمه الله، في تفسير الآية: “.. والحكمة ثمرة التعليم بهذا الكتاب وهي ملكة يتأتى معها وضع الأمور في مواضعها الصحيحة ووزن الأمور بموازينها الصحيحة، وإدراك غايات الأمور والتوجيهات… وكذلك تحققت هذه الثمرة ناضجة لمن رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزكاهم بآيات الله[33].”
وقال في تفسير قوله تعالى: ﴿ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن﴾ (النحل: 125) قال: “الدعوة بالحكمة النظر في أحوال المخاطبين وظروفهم، والقدر الذي يبينه لهم في كل مرة حتى لا يثقل عليهم، ولا يشق بالتكاليف قبل استعداد النفوس لها، والطريقة التي يخاطبهم بها، والتنويع في هذه الطريقة حسب مقتضياتها، فلا تستبد به الحماسة والاندفاع والغيرة فيتجاوز الحكمة في هذا كله وفي سواه[34].” فالحكمة النظر في حال المخاطب، وفي طريقة الخطاب، وفي مقدار ما سيلقن للمخاطب.
ﻫ. ترتيب المدني في الفهم على المكي
وهي قاعدة بالغة الأهمية في الفهم وترتيب السور والآيات بعضها على بعض، وقد نص العلماء أن الأصول التشريعية كلها والكليات الدينية عامتها قد تم النص عليها في السور المكية، وما ورد بالمدينة من التشريع إنما هو كالفروع الجزئية بالنسبة إلى ما شرع بمكة، فكان من الواجب على الفقيه المجتهد أن يفهم الجزئيات منزلة على وزان الكليات قال إمام المقاصد أبو إسحاق الشاطبي: ” إن المنزل بمكة من أحكام الشريعة هو ما كان من الأحكام الكلية والقواعد الأصولية في الدين غالب الأمر[35].”
وبما أن الجزئي لا يفهم إلا في إطار كليه، وجب إرجاع المدني في الفهم إلى الأصول المكية قال الشاطبي رحمه الله: “المدني من السور ينبغي أن يكون منزلا في الفهم على المكي وكذلك المكي بعضه مع بعض والمدني بعضه مع بعض على حسب ترتيبه في التنزيل، وإلا لم يصح، والدليل على ذلك أن معنى الخطاب في المدني في الغالب مبني على المكي، كما أن المتأخر من كل واحد منهما مبني على متقدمه، دل عل ذلك الاستقراء، وذلك يكون ببيان مجمل أو تخصيص عموم أو تقييد مطلق أو تفصيل ما لم يفصل أو تكميل ما لم يظهر تكميله[36].” فالقرآن الكريم بنية لا يمكن فصل بعض وحداته عن الأخرى في الفهم، ولا السابق عن اللاحق، فالمكيات أصول وكليات والمدنيات فروع وجزئيات منبثقة عما تقدم عنها، وهو تقديم معياره السبق الزمني في التنزيل.
وبيان هذا المعنى عند الشاطبي له شواهد كثيرة، وأول شاهد على ذلك “أصل الشريعة فإنها جاءت متممة لمكارم الأخلاق، ومصلحة لما أفسد قبل من ملة إبراهيم عليه السلام، ويليه تنزيل سورة الأنعام فإنها نزلت مبينة لقواعد العقائد، وأصول الدين، وقد خرج العلماء منها قواعد التوحيد التي صنف فيها المتكلمون من أول إثبات واجب الوجود إلى إثبات الإمامة. هذا ما قالوا وإذا نظرت بالنظر المسوق في هذا الكتاب تبين به من قريب بيان القواعد الشرعية الكلية التي إذا انخرم منها كلي واحد انخرم نظام الشريعة أو نقص منها أصل كلي[37].
فكل قواعد أصول الدين تبنى على هذا الأساس، وحظ الأصولي من هذا ما أشار إليه الإمام الشاطبي في النص المتقدم، “وذلك إنما يكون ببيان مجمل، أو تخصيص عموم،أو تقييد مطلق، أو تفصيل ما لم يفصل، أو تكميل ما لم يظهر تكميله[38].” وغالب هذا يتعلق بالمجال التشريعي ولذلك أردف قائلا كزيادة بيان: “ثم لما هاجر رسول الله إلى المدينة كان من أول ما نزل عليه سورة البقرة، وهي التي قررت قواعد التقوى المبنية على قواعد سورة الأنعام فإنها بينت من أقسام أفعال المكلفين جملتها، وإن تبين في غيرها تفاصيل لها، كالعبادات التي هي قواعد الإسلام، والعادات من أصل المأكول والمشروب وغيرهما، والمعاملات من البيوع والأنكحة وما دار بها، والجنايات من أحكام الدماء، وما يليها. وأيضا فإن حفظ الدين فيها، وحفظ النفس، والعقل، والنسل، والمال مضمن فيها، وما خرج عن المقرر فيها فبحكم التكميل[39].”
وهذا الكلام مفيد في بيان أن الأحكام القرآنية نفسها ليست سواء ولا هي على وزان واحد، فمن أخل بالجزئي لا يكون من حيث الوزر كمن أخل بالكلي تماما ككون من أنكر البعث ليس سواء مع من زنى أو سرق دون أن ينكر ما أنكره الأول وإن كان الفعلان كلاهما وزرا موزورا وخطئا كبيرا.
ويلحق بهذه القاعدة الترتيبية الكلية قاعدتان:
الأولى؛ مفادها أن ما كان مقصودا للشارع أصالة كان تشريعه تصريحا لا تلميحا. ومن هنا لزم عند الأصوليين أن “تكون التكاليف الاعتقادية والعملية مما يسع الأمي تعقلها ليسعه الدخول تحت حكمها[40].
ولذلك سمى الشارع أصول الواجبات والمحرمات بأسمائها صراحة وعبارة، ولم يُكَن عنها إيماء أو إشارة، ولذلك كانت أقوى طرق الدلالة الأصولية المعنى العباري قبل المعنى الإشاري، كما كان المنطوق أولى من المفهوم باصطلاح الأصوليين.
والثانية؛ مما يلحق بالقاعدة الترتيبية الكلية (أن ما كان مقصودا للشارع بالأصالة فصل تشريعه تفصيلا)؛ أي فصله نصا، ولم يكد يترك منه للاجتهاد إلا قليلا قال عز وجل: ﴿وقد فصل لكم ما حرم عليكم﴾ (الأنعام: 120). وقال سبحانه ﴿الر، كتاب أحكمت ـاياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير﴾ (هود: 1). وذلك شأن أحكام أركان الإسلام جملة فقد فصلتها السنة النبوية تفصيلا، وكذلك الكثير من الأحكام المقصودة للشارع بالأصالة، كأحكام الزواج والطلاق والميراث… قد فصلها القرآن تفصيلا[41].”
و. السؤال عما ينبني عليه العمل
وفي سياق التركيز دائما على ما يترتب على المادة العلمية من فائدة عملية قال الشاطبي: “كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي وأعني بالعمل عمل القلب، وعمل الجوارح من حيث هو مطلوب شرعا[42].
ثم استدل لذلك باستقراء الشريعة قال: فإنا رأينا الشارع يعرض عما لا ينبني عليه تكليف، ففي القرآن الكريم: ﴿يسئلونك عن الاَهلة، قل هي مواقيت للناس والحج﴾ (البقرة: 189). فوقع الجواب بما يتعلق به العمل إعراضا عما قصده السائل من السؤال عن الهلال لما يبدو في أول الشهر دقيقا كالخيط ثم يمتلئ حتى يصير بدرا ثم يعود إلى حالته الأولى[43].
ولذلك كان هذا الأسلوب أسلوبا حكيما لأنه أليق بحال السائل لمعنى عرفه صلى الله عليه وسلم فيه وعليه فلو أجابه بما يطلب لكان فيه فائدة عملية قلبية إلا أنه رأى الأليق بحاله توجيه فكره إلى ثمرات طريقة سير الهلال، بدل بيان نفس الطريقة التي لا يفهمها هو، وقد يعسر فهمها على كثير من العرب ومثله لا يناسب منصب النبوة، فالعدول لحال السائل وأمثاله كما هو، هو اللائق بمنصب النبوة، وإن كان الجواب المطابق للسؤال قد يؤدي إلى فائدة عملية قلبية[44].”
وقال تعالى: ﴿وليس البر أن تاتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، واتوا البيوت من اَبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون﴾ (البقرة: 188). بناء على تأويل من تأول أن الآية كلها نزلت في هذا المعنى.فكان من جملة الجواب أن هذا السؤال، في التمثيل، إتيان للبيوت من ظهورها. والبر إنما التقوى لا العلم بهذه الأمور التي لا تفيد نفعا في التكليف ولا تجر إليه. وقال بعد سؤالهم عن الساعة ﴿أيان مرسيها. فيم أنت من ذكراها﴾ (النازعات: 41-42)؛ أي إن السؤال عن هذا سؤال عما لا يعني، إذ يكفي من علمها أنه لابد منها، ولذلك لما سئل، صلى الله عليه وسلم، عن الساعة قال للسائل: “ما أعددت لها[45].” إعراضا عن صريح سؤاله إلى ما يتعلق بها مما فيه فائدة، ولم يجبه عما سأل. وقال ابن عباس في سؤال بني إسرائيل عن صفات البقرة لو ذبحوا بقرة ما لأجزأتهم ولكن شددوا فشدد الله عليهم. وهذا يبين أن سؤالهم لم يكن فيه فائدة. وقد سأله جبريل عن الساعة فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل[46]“؛ فأخبره بأن ليس عنده من ذلك علم وذلك يبين أن السؤال عنها لا يتعلق به تكليف وقرأ عمر بن الخطاب: ﴿وفاكهة وأبا﴾ (عبس: 31). وقال هذه الفاكهة فما الأب ثم قال نهينا عن التكلف وفي القرآن الكريم: ﴿ويسئلونك عن الروح، قل الروح من اَمر ربي﴾ (الإسراء: 85). وهذا بحسب الظاهر يفيد أنهم لم يجابوا وأن هذا مما لا يحتاج إليه في التكليف. وقد كان مالك يكره الكلام فيما ليس تحته عمل ويحكي كراهيته عمن تقدم.[47]
هذا وجه الاستدلال على هذه المسألة وهو عدم الاهتمام بما لا يمت إلى عدم فهم الشريعة بوجه من الوجوه، أو الاشتغال بما هو خارج عن قضاياها فقسه على غيره من العلوم الطبيعية والإنسانية؛ إذ لابد من توجيه الاهتمام إلى ما تحقق نفعه وتأكدت ضرورة تعلمه مما تفرضه ضرورة الواقع وظروفه الزمانية.
هكذا راعى القرآن الكريم الأساليب اللغوية للبيئة العربية، كما استحضر قاموسها المفاهمي وعرفها الاستعمالي الذي تضمن أذواقها النفسية والاجتماعية ومقاصدها التعبيرية التي تراعي عموم المخاطبين. وفق منهج يهتم بالمعنى قبل المبنى، ويعتمد اللغة التجريبية الواصفة عوض اللغة التجريدية متتبعا مبدأ التدرج في التربية، آخذا بقاعدة الاتصال الانفصال أحد استراتيجيات التواصل، منطلقا بالإنسان العربي من بيئته مستدرجا إياه إلى بيئة النص التشريعي، مقتدرا على تهيئة المخاطبين للدخول في مواجهة ايجابية مع ذواتهم لاستيعاب حقائق جديدة، متتبعا بناء الجزئيات على الكليات في تاريخه التشريعي ومنهجه الدلالي. مركزا في خطابه على ما ينبني عليه العمل.
الهوامش:
[1]. فريد الأنصاري، المصطلح الأصولي عند الشاطبي، تقديم: الشاهد البوشيخي، دار السلام للطباعة والنشر والترجمة، ط1، 18-03-2010م، ص 227.
[2]. أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البيان والتبيين، 1/14.
[3]. محمد عبد العظيم الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، دار الفكر، 2/218.
[4]. المرجع نفسه، 2/225.
[5]. وليد منير، النص القرآني من الجملة إلى العالم، سلسلة المنهجية الإسلامية 14 المعهد العالمي للفكر الإسلامي.، ص21.
[6]. الرسول المعلم ومنهجه في التعليم ص78، نقلا عن إلجام العوام عن علم الكلام، ص20.
[7]. الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، 2/64.
[8]. البيان والتبيين، م، س، 2/5.
[9]. الموافقات، م، س، 2/65.
[10]. المصدر نفسه، 4/249.
[11]. المصدر نفسه، 2/82.
[12]. الشيخ علي حب الله، “أثر البيئة العربية في بيئة النص القرآني”، مجلة الحياة الطيبة، ع 13 سنة 2003، ص 130.
[13]. المصدر نفسه.
[14]. المصدر نفسه، ص131.
[15]. محيي الدين الدرويش، إعراب القرآن الكريم وبيانه، دمشق/بيروت: دار ابن كثير، ط 6، (1419ﻫ/1999م)، 4/722.
[16]. الموافقات، م، س، 1/58
[17]. المصدر نفسه، 4/180.
[18]. المصدر نفسه، 3/231.
[19]. المصدر نفسه، 1/57.
[20]. المصدر نفسه، 2/87
[21]. المصطلح الأصولي عند الشاطبي، م، س، ص189.
[22]. الموافقات، م، س، 3/410-411.
[23]. وليد منير، النص القرآني من الجملة إلى العالم، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، (1418ﻫ/1997م)، ص17.
[24]. المصدر نفسه، ص18.
[25]. إشارة إلى ما ورد من الأنكحة التي كانت سائدة في الجاهلية: نكاح الأبضاع ونكاح الشغار ونكاح الناس فحرمت كلها إلا نكاح الناس اليوم.
ومنه قول النبي، صلى الله عليه وسلم، بعد بعثته “شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم ولو دعيت به في الإسلام لأجبت”. وهو حلف الفضول القائم على نصرة المظلوم. كتاب مع الأنبياء في القرآن تأليف عبد الفتاح عفيف طبارة ص 349.
[26]. منها قول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: “اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا”.
[27]. النص القرآني من الجملة إلى العالم، م، س، ص20.
[28]. المرجع نفسه، ص20-21.
[29]. أثر البيئة العربية في بنية النص القرآني، م، س، ص127.
[30]. جلا الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن للإمام، ط4، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر، (1398ﻫ/1998م)، 1/79.
[31]. ثبت في حق غيلان الثقافي قوله صلى الله عليه وسلم: “أمسك أربعا وفارق سائرهن” الموطأ كتاب الطلاق باب جامع الطلاق.
[32]. عز الدين بن عبد السلام السلمي، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، بيروت: دار الكتب العلمية/لبنان، 1/45-46.
[33]. السيد قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق، ط17، (1412ﻫ/1992م)، 1/139.
[34]. المرجع نفسه، 4/222.
35. الموافقات، م، س، 3/114.
36. المصدر نفسه، 3/304.
[37]. المصدر نفسه.
[38]. المصدر نفسه، 2/304.
[39]. المصدر نفسه، 3/305.
[40]. المصدر نفسه، 2/88.
[41]. فريد الأنصاري، البيان الدعوي وظاهرة التضخم السياسي، ص53.
[42]. الموافقات، م، س، 1/32.
[43]. المصدر نفسه.
[44]. عبد الله دراز، حاشية الموافقات، 1/31-32.
[45]. البخاري كتاب الأحكام باب القضاء والفتيا في الطريق رقم: 6734.
[46]. رواه البخاري كتاب الإيمان باب سؤال جبريل النبي، صلى الله عليه وسلم، عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة رقم 50.
[47]. الموافقات، م، س، 1/32-34.