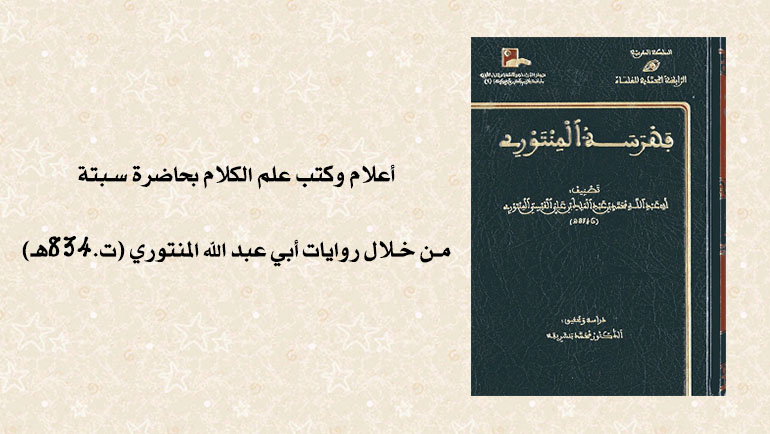أفق البحث المقاصدي
كَثرت الدراسات المقاصدية في العقدين الأخيرين كثرةً جعلت من الكتابة فيها وعنها أمرًا شديد الصعوبة؛ ومنشأ الصعوبة عواملُ عدّة؛ فالبحث المقاصديّ استوفى، إلى حدٍّ كبير، الشخصيات والأفكار قبل الشاطبي وبعده[1] عبر مسارين رئيسيين: الأول؛ الدَّرْس الفقهي من خلال الدراسات الجامعية والأنشطة البحثية، والثاني؛ القراءات الفكرية الحديثة التي تمحورت تحديدًا حول محطات ثلاث هي: الجويني، ثم الشاطبي، ثم العصر الإصلاحي سواءٌ المغاربي أم المصريّ، وقد قدّم مجموع المسارين قراءات مختلفة، إلى حدٍّ كبير، لفكرة المقاصد، ولطبيعة عمل الشاطبي تحديدًا، وهو ما يثير التساؤل ويجعل من القراءات التأويلية للمقاصد أمرًا موضع بحث بذاته، ويَزيدُ، كذلك، من الالتباس والاشتباه الذي يَسكن بعض التقليديين تجاهها.
ومع أن تلك الكثرة قدّمت لنا إرثًا مقاصديًّا ضخمًا ومتنوّعًا، وفتحت آفاقًا جديدة للبحث والنظر الفقهي والفكريّ، فقد أبقت على غموض المقاصد نفسها بالنسبة للتقليديين، على الأقل. كما أن تلك الدراسات المتكاثرة لم تُفلح في إحداث تجديد بارز أو جذريّ في البحث الفقهي ومسائله العملية بشكلٍ يُقنع الآخرين بتَجَاوز فقههم المذهبيّ والأحكام القارّة في الفقه الموروث، فقد جرى توظيف المقاصد في “تثبيت” ما سبق من أحكام فقهية عبر إضفاء طابع العقلانية عليها، فغدت المقاصد وكأنها لاحقة للأحكام لا معرفةٌ سابقة عليها مُسهمةٌ في بنائها.
وإذا ما جرت المقارنة بين الغموض في أصول الفقه والغموض في المقاصد يمكن القول: إن الغموض في علم الأصول غيرُ ناتج عن غموض مصطلحات العلم ومبناه بوصفه علمًا، خصوصًا مع تطور صياغاته منذ القرن الخامس الهجري من جهة، وتساوقه مع الفقه نفسه الذي وُلد من رَحِمه فأَكسبه طبيعته العملية، وأَوجدَ هذا الانسجامَ العميق بين آليات الاستنباط والفقه المُستَنبَط نفسه من جهة أخرى.
أما غموض المقاصد فيرجع إلى مصطلحات المقاصد نفسها، ومبناها الكلامي والأصوليّ النظريّ من جهة قيامها على “مسلَّمة” التعليل، ونحن نعرف من الجدالات الكلامية القديمة الانقسام الذي وقع تجاه مسألة التعليل بين المعتزلة والأشاعرة الذين نفَوا التعليل جملةً، كما نفَوا التحسين والتقبيح العقليّين، ولكن مقالة المقاصد إنما بُنيت على التسليم بتعليل “أحكام الله”، ولكن السؤال الذي يُطرَح هنا: هل الخلاف في تعليل الأفعال يَسري على تعليل الأحكام؟ وهل يمكن نفي تعليل الأفعال وإثباتُ تعليل الأحكام؟ بل إن السؤال يذهب بنا أبعد من ذلك؛ إذ إن أُسَّ التعليل وأساسه مبنيٌّ على مبدأ التحسين والتقبيح العقليّين فكيف تُبنى نظرية المقاصد، وجوهرها وأساسها التعليل، مع رفض أُسّها العقليّ؟
ثم إن كان فقهاء المقاصد قدّموا مفهومًا خاصًّا للمصلحة يتجاوز هذا الإشكال عبر جَعْل المصلحة اصطلاحًا خاصًّا يَرهنها للنص؛ على معنى “المحافظة على مراد الشارع” فلا مصلحة إلا بنصّ، فالسؤال الذي يُطرح هنا هو ما موقع العقل من دَرْك المقاصد؟ وأيُّ أُفقٍ تفتحه المقاصد نفسها بالمقارنة مع الأفق الذي رسمه وحدّه علم أصول الفقه الذي يدور حول أفق النص أولاً، ثم الاستنباط بناءً على النص ثانيًا عبر تسييج الوقائع غير المتناهية بالنص المتناهي وفق آلية القياس ابتداءً، ثم الاجتهاد الذي صار لاحقًا أوسع من مجرد القياس؟
ويرجع غموض المقاصد أيضًا إلى صفتها: هل هي علمٌ أو مبحث من علمٍ، وهل هي علم مختصٌّ بالتشريع أم متجاوِزٌ له إلى مساحات أوسع كالعلوم الإنسانية كما تريد لها بعض القراءات التأويلية المعاصرة؟ ثم ما علاقتها بعلم أصول الفقه الذي وُلدت من رَحِمه ووفق منطقه ولغته؟ فقد شكّل نشوء المقاصد علمًا قائمًا برأسه إشكالاً أصوليًّا حقيقيًّا، طرح جملة من التساؤلات لا تقتصر على الطابع الإجرائي الفني الذي انشغل به بعض المعاصرين، بل تجاوز ذلك إلى فهم السياق المعرفي؛ أي دواعي انتهاض المقاصد علمًا برأسه، وانفصاله بالتصنيف عن مباحث أصول الفقه، وهل يُعبر حقًّا عن تأزم معرفي في منهجية أصول الفقه جعلها غير وافية بعملية الاجتهاد الذي انغلق بابه فتعثرت عملية تكيُّف الفقيه مع متغيرات العصر وحاجاته؟
ومن أوجه الغموض كذلك، حدود الدور المنوط بالمقاصد، هل هو دور داعم لعملية الاستنباط المستندة إلى علم أصول الفقه لكونه يُعزز تَقَبل الأحكام عبر توضيح معقوليتها وحِكَمها، أم هو منهجية موازية تنهض لاستنباط الأحكام استنادًا إليها؟ وهل تغني المقاصد عن أصول الفقه أم لا بد منها ضميمةً إليه؟ وإذا كان الاجتهاد محتاجًا إليهما معًا فكيف يشتغلان معًا في النسق المعرفي التشريعي؟
هذه جملة تساؤلات مركزية آثرت طرحها، على سبيل التقديم على خلاف المألوف، لإثارة التفكير من جديد في المقاصد وسط هذا الركام من الدراسات التي غلب عليها المنطق التقريري أو الوصفي. فتوجيه البحث المقاصدي نحو هذه الأسئلة سيعيد تحديد القيمة المعرفية لها، وهو ما سيُفيد في عملية التأريخ لتطور الفكر الأصولي في إطار سعيه لتطوير أدوات النظر الاجتهادي. فمع كثرة الكلام عن تاريخ الفكرة المقاصدية والمصنفات فيها وتَطَوّرها تطورًا جعل منها نظرية لدى البعض، لا تزال ثمة حاجة بحثية لكتابة تاريخ للمقاصد على نهج تاريخ الأفكار دون التورط في الرؤى التبجيلية على شاكلة القول مثلاً: إن الفقه وُلد من أول يوم مقاصديًّا!
أولاً: المقاصد ومأزق تعدد القراءات
وبالعودة إلى المسلكين المُشار إليهما سابقًا، اللَّذين طَبَعا بحوث المقاصد، يمكن القول: إن الاختلاف بينهما يرجع، في الأصل، إلى اختلاف مدارك النظر بين المشتغلين بالفقه ومسائله، وبين المشتغلين بالفكر. فالمتفقّهة تأملوا المقاصد بالنظر إلى بِنية أصول الفقه نفسه، وعبر مساره التاريخي، وبالنظر إلى الفقه المتولد عنه، فاعتبروا المقاصد “إضافة” تساعد في ضبط الاجتهاد وتقويم مساره، أما المشتغلون بالفكر فبحثوا في الدلالات التاريخية والمنهجية التي انطوى عليها ظهور فكرة المقاصد، فخرجوا بقراءات هي في واقع الأمر قراءات تأويلية يختلط في بعضها التأمل والأيديولوجيا بالتاريخ.
1. القراءة الفقهية
ففي المسلك الأول نجد الاهتمام ينصب كثيرًا على “أعلام” المقاصد بدءًا من الشاطبي وابن عاشور أساسًا، ثم يلحق بهم غيرهم من أمثال الجويني والعزّ بن عبد السلام وغيرهما، وصولاً إلى ابن تيمية نفسه؛ بغرض البحث عن المنحى المقاصدي النظري في كتابات هؤلاء وتجلياته التطبيقية، وتتفاوت هذه الانشغالات من الحديث عن “نظرية المقاصد” عند الشاطبي وابن عاشور تحديدًا[2]، وصولاً إلى إعداد الببليوغرافيا للكتب والدراسات المقاصدية الصريحة والضمنية عبر قرون.
وهذا المنحى الذي شغل نحو عقدين منذ التسعينيات من القرن الماضي، مردّه إلى ما سمي “اكتشاف” المقاصد من قِبل الإصلاحية الإسلامية في مصر وتونس[3]. وإذا كانت الإصلاحية استنجدت بالمقاصد في سياق مشروعها الإصلاحي لتوطين فكرة المؤسسات والاقتباس عن الغرب[4]، فإن الانشغال بالمقاصد أخذ منحى فقهيًّا أصوليًّا مع بعض تلامذة محمد عبده في مصر ومع الطاهر بن عاشور في تونس، فَبِوَصية من الشيخ محمد عبده انصرف عبد الله دراز إلى العناية بالكتاب والتعليق عليه وإخراجه في طبعة جديدة، في حين انصرف محمد الخضري إلى الاقتباس منه وضمّ نُتَفٍ منه إلى كتابه في “أصول الفقه”، على حين ذهب ابن عاشور إلى نقده والتأليف فيه من جديد كما فعل علّال الفاسي في المغرب.
الرؤية الفقهية الأصولية لم تستقبل المقاصد على شكل “قطيعة” مع علم الأصول أو تَجَاوز له، بل جعلتها “تكميلاً” لمباحثه، بناءً على اعتبارين:
الاعتبار الأول؛ ينظر إلى مسار علم أصول الفقه وتطوره لإعادة مَوْضَعَة المقاصد في هذا التاريخ، فابن عاشور، مثلاً، يعود إلى لحظة التدوين وبناء علمي الأصول والفقه ليشخص وجه القصور الذي حفّ بعلم الأصول، ذلك أن علم الأصول لم يدوّن إلا بعد تدوين الفقه بزهاء قرنين، وهو ما يشكّل، عنده، الأساس التاريخي لاستمرار الاختلاف في معظم مسائله بين النظّار، فالخلاف في الأصول جاء تبعًا للاختلاف في الفروع، والخلاف في الأصول مستمرّ؛ لأن قواعد الأصول انتُزعت من صفات تلك الفروع[5]؛ أي أن مشكلة أصول الفقه بنيوية منذ نشأته وتركيبه على الفروع وتَأَخره عن الفقه، وهو ما يفسر لاحقًا دعوته إلى إعادة صَوغه من جديد ضمن علم مقاصد الشريعة.
في حين يرى عبد الله دراز أن فن أصول الفقه “وقف منذ القرن الخامس عند حدود ما تكوّن منه في مباحث الشطر الأول [علم لسان العرب]، وما تَجَدّد من الكتب، بعد ذلك، دائرٌ بين تلخيص وشرح ووضع له في قوالب مختلفة”، والجميع بقي مفتَقرًا إلى الشطر الثاني من علم الشريعة وهو معرفة مقاصدها وأسرارها[6]؛ أي أن مشكلة علم الأصول قصورُه أو تقصيرُه بالعناية بالمقاصد، وعدم تطوره لاحقًا بعد القرن الخامس إلى أن جاء الشاطبي فكمّله بالشطر الآخر من علوم الشريعة.
أما محمد الخضري فيستغرب “أنه على كثرة ما كُتِب في أصول الفقه لم يُعْنَ أحد بالكتابة في الأصول التي اعتبرها الشارع في التشريع، وهي التي تكون أساسا لدليل القياس،… [مع أن] الاشتغال بها خير من قَتْل الوقت في الخلاف والجدل في كثير من المسائل التي لا يترتب عليها ولا على الخلاف فيها حكم شرعي، ولعلهم تركوا ذلك للفقهاء مع أن هذه القواعد بعلم أصول الفقه ألصق[7]“، فكأنه يُحيل المسألة إلى تنازع في التخصص هل هي من عمل الأصول أم من عمل الفقه.
الاعتبار الثاني؛ اعتبار بنيوي، ينظر إلى بنية علم أصول الفقه ويحاول تسكين المقاصد فيه وهي التي كانت موضع إهمال، فابن عاشور يحكم بأن “معظم مسائل أصول الفقه لا ترجع إلى خدمة حكمة الشريعة ومقصدها، ولكنها تدور حول محور استنباط الأحكام من ألفاظ الشارع بواسطة قواعد تمكّن العارف من انتزاع الفروع منها، أو من انتزاع أوصاف تُؤْذن بها تلك الألفاظ ويمكن أن تجعل تلك الأوصاف باعثًا على التشريع فتقاس فروع كثيرة على مَورد لفظ منها باعتقاد اشتمال تلك الفروع كلها على الوصف الذي اعتقدوا أنه مراد من لفظ الشارع، وهو الوصف المسمى بالعلة”؛ فهم “قصروا مباحثهم على ألفاظ الشريعة وعلى المعاني التي أنبأت عنها الألفاظ؛ وهي علل الأحكام القياسية[8]“.
ويصف دراز عمل الشاطبي بأنه “تجديد وعمارة” عبر تأصيل القواعد وتأسيس الكليات المتضمنة لمقاصد الشارع في وضع الشريعة، وأن ما قام به الشاطبي هو استقراء تفاصيل مباحث الكتاب توصل به إلى استخراج ما له “أوثق صلة بروح الشريعة وأعرق نسب بعلم الأصول”. فهو استكمال للشطر المفقود من علم أصول الفقه[9]، فقد “انتصب لتدوين هذه القواعد جملة من الأئمة، بين مقلّ ومكثر، وسموها (أصول الفقه).
ولما كان الركن الأول هو الحذق في اللغة العربية أدرجوا في هذا الفن ما تمس إليه حاجة الاستنباط بطريق مباشر، مما قرره أئمة اللغة، حتى إنك لترى هذا النوع من القواعد هو غالب ما صُنف في أصول الفقه، وأضافوا إلى ذلك ما يتعلق بتصور الأحكام، وشيئًا من مقدمات علم الكلام ومسائله… ولكنهم أغفلوا الركن الثاني إغفالاً فلم يتكلموا على مقاصد الشارع؛ اللهم إلا إشارة وردت في باب القياس… مع أن هذا كان أولى بالعناية والتفصيل والاستقصاء والتدوين من كثير من المسائل التي جُلبت إلى الأصول من علوم أخرى[10]“.
ويؤكد أن صاحب الموافقات “لم يغضّ من فضل المباحث الأصولية، بل تراه يقول في كثير من مباحثه: إذا أضيف هذا إلى ما تَقَرّر في الأصول أمكن الوصول إلى المقصود”، ليخلص إلى القول: إن كل ما ذُكر في كتب الأصول وفي “الموافقات” “يُعتبر كوسيلة لاستنباط الأحكام من أدلة الشريعة”، وأن ما “ذكره الشاطبي في الأجزاء الأربعة من كتابه هو وإن كان كجزء من وسيلة الاستنباط يُعرف به كيف استنبط المجتهدون أيضا؛ إلا أنه في ذاته فقه في الدين، وعلمٌ بنظام الشريعة، ووقوف على أسس التشريع، فإن لم نصل منه إلى الاتصاف بصفة الاجتهاد، والقدرة على الاستنباط؛ فإنا نصل منه إلى معرفة مقاصد الشارع، وسر أحكام الشريعة، وإنه لهدى تسكن إليه النفوس[11]“.
أما محمد الخضري فيؤكد أن الأصول التي اعتبرها الشارع في التشريع “هي التي تكون أساسًا لدليل القياس؛ لأن هذا الدليل روحُه العللُ المعتبرة شرعًا، وهذه العلل منها ما نصّ الشارع على اعتباره، ومنها ما ثبت عنده اعتباره في تشريعه”، وتقعيد هذا ينبغي أن يكون نبراسًا للمجتهدين، وهو بهذا يُبقي المقاصد ضمن دليل القياس ولكنه يعيب عدم التوسع فيها وتبيينها.
2. القراءات الفكرية
تعددت القراءات الفكرية التأويلية للمقاصد، ولكن حسبُنا هنا أن نركز على أبرزها متمثلة في أربع قراءات مختلفة هي:
القراءة الأولى؛ عقلنة المقاصد، بمعنى قراءة المقاصد بوصفها جزءًا من العقلانية البرهانية الأرسطية في تجليها الفقهي إلى جانب تجلياتها الفلسفية والتاريخية، ويمثلها محمد عابد الجابري الذي انتهى إلى أن الغرب الإسلامي هو موطن العقلانية الأرسطية التي تتجلى في فروع علمية مختلفة، فـ”المعقولية في الفلسفة مبنية على ما يشاهَد من نظام وترتيب في العالم، وبالتالي مبدأ السببية، أما المعقولية في الدين فتنبني على قصد الشارع الذي يرمي في نهاية الأمر إلى حمل الناس على الفضيلة. إن فكرة قصد الشارع في مجال النقليات توازن فكرة الأسباب الطبيعية في مجال العقليات”.
فاعتماد المقاصد كمبدأ لبناء المعقولية حيث لا يستقيم العمل بمبدأ السببية الفاعلة الميكانيكية هو عنصر مميز ومؤسس للتفكير النظري في الأندلس، فالتفكير الذي أنضجه ابن رشد في مجال الكلام والفلسفة، تبناه الشاطبي في محاولته “إعادة تأصيل أصول الفقه”، ويحاول الجابري هنا المطابقة بين النموذج الأرسطي للمعقولية البرهانية والبناءات الفكرية الإسلامية، سواء ما له طابع فكري محض كالعقليات (ابن رشد)، أو ما يؤطره العقل كأصول الفقه (الشاطبي) والتفسير التاريخي (ابن خلدون)[12]. ومعقولية المقاصد عنده ناتجة عن تأسيس المرجعية المعرفية في العلوم النقلية من خلال تأسيس الكليات الشرعية القطعية، وهي ما يقوم مقام الكليات العقلية في العلوم النظرية، بينما تقوم مقاصد الشرع بدور السبب الغائي الناظم للمعقولية.
القراءة الثانية؛ القراءة التاريخية الاجتماعية، والتي تحاول فهم أصول الفقه والمقاصد في سياق الاجتماع السياسي للمسلمين وتحولاته، ويمثلها عبد المجيد الصغير الذي يقرر أن الغرض من المقاصد عند الشاطبي بالدرجة الأولى معالجة مشكلة منهجية؛ لأن مقدماته الطويلة التي بنى عليها “ذات صلة وثيقة بمشكلة طرق الفهم والمعرفة، وبمشكلة المنهج بوجه عام”، وفي سياق التراجع الحضاري والانهيار السياسي للأمة، وما أصاب المرجعية السياسية والدينية من تحلل جراء ذلك، “لن تستطيع قواعد ومبادئ علم أصول الفقه مسايرة هذا التراجع أو التكيف معه وضبط مساره، لذا كان لابد من تأسيس قول أو اجتهاد جديد في الشريعة يضمن القدرة على التكيف و(نَخْل الشريعة من مطلعها إلى مقطعها)[13] حتى تساير ظروف الانحدار الشامل والسريع. ولن يكون ذلك القول الجديد مؤسسًا إلا على مقاصد شرعية عامة، وعلى قواطع أدلتها بدل أصول الفقه وظنية مسائله[14]“.
وقريبٌ منه يذهب محمد أركون إلى أن الشاطبي “استعاد أحد مصطلحات الفكر القانوني في الإسلام؛ أي مصطلح المصلحة العامة (مصلحة الأمة)، ويقصد من وراء ذلك إلى هدف أبعد: ألا وهو تخفيف حدة النظرية الصارمة لأصول الفقه، وذلك باستبدالها بمفهوم جديد هو مقاصد الشريعة”، وبما أن “التطور النظري والتأملي” الذي طرأ على علم أصول الفقه قد أبعده عن صفة “القانون الإيجابي الواقعي”، فإن لفْت الانتباه إلى مفهوم المصلحة أراد به الشاطبي “أن يصالح ما بين ضرورة الحفاظ على الجوهر الإلهي للشريعة (التي هي ذروة سيادية تتجاوز حتى الإمام والخليفة) من جهة، وإمكانية تَمثل وهضم التغير الاجتماعي – التاريخي على طريقة المدراس اليهودي من جهة أخرى[15]“، ثم يعود في كتاب آخر فيقرر أن “التركيبة الذهنية لعلم أصول الدين وأصول الفقه قد قوّت من مزاعم الفقهاء على إمكانية قول القانون وفرض الأرثوذكسية [التفسير الصحيح المستقيم] طبقًا لما دعاه بعض فقهاء القانون بمقاصد الشريعة[16]” في محاولة لنقض أساس الفكرة المقاصدية التي تسلم بمقاصد قارّة للشارع.
وإذا كانت القراءة الثانية ترى في المقاصد بديلاً عن علم الأصول، فإن القراءة الثالثة تراها تطويرًا لأصول الفقه، ويمثلها وائل حلاق الذي رأى في عمل الشاطبي “صياغة فلسفة شرعية وسطى بين مقاربتين قصويين وممارستين شرعيتين، أي الممارسات الشرعية التي اعتمدها الصوفيون، أو على الأقل البعض منهم، ومجموعة من المجتهدين لا يمكن تحديدها”، وأن خطابه كان خطاب إقناع يهدف إلى التصويب والتصحيح[17]“، ويؤكد، في أكثر من موضع، توافق الشاطبي في صياغته لنظريته مع أصوليين آخرين، ويوضح أن الشاطبي قدم في “نظريته” إضافات جديدة من مثل إضافته إلى (الأحكام التكليفية الخمسة) المعروفة لدى الفقهاء القاعدة الشرعية السادسة وهي “العفو”[18].
ونحوه يرى عبد المجيد تركي الذي يصل في بحثه إلى أن الشاطبي اهتدى إلى “صياغة جديدة محكمة الفصول واضحة البيان لعلم أصول الفقه التقليدي[19].
أما القراءة الرابعة ويمثلها طه عبد الرحمن فترى أن “ما تناوله علم المقاصد بالبحث هو جملة ما يختص بالنظر فيه علم الأصول بحسب وضعه الاصطلاحي؛ فمن الخطأ المنهجي إنزال المقاصد منزلة باب من أبواب الأصول كما يقع في كتب الأصوليين المتأخرين”، ولكن ما قام به الشاطبي هو “بناء نسق متداخل يحقق وجهًا من وجوه التكامل لم ينتبه إليه الأصوليون الذين سبقوا الشاطبي[20]“، وأن الشاطبي هو أب التداخل بين علم الأخلاق وعلم الأصول فاتحًا بذلك طريقًا في بناء العلم الإسلامي على أسس التنسيق المتكامل، “وعلى هذا يكون علم المقاصد هو الصورة التي اتخذها علم الأخلاق للاندماج في علم الأصول[21]“.
إننا هنا أمام أربع قراءات مختلفة لعمل واحد في لحظة تاريخية محددة هي هي، فقراءة الجابري تجعل منها عقلنة للفقه يحذو حذو البرهان الأرسطي النظري ولكن في المجال النقليّ، وقراءة طه عبد الرحمن، وهي قريبة من حقيقة عمل الشاطبي، إلى حد كبير، تهدمُ هذه المشابهة وتبرهن على المفارقة التامة بين عقلانية الشاطبي والعقلانية الأرسطية بأن الأولى عملية والثانية نظرية تجريدية، وتثبت أن المقاصد هي لحظة التداخل التكاملي بين الأصول والفقه والأخلاق، ولكن قراءة عبد المجيد الصغير وأركون تراها انفصالاً وتجاوزًا لعلم الأصول الذي عجز عن التكيف مع لحظة التراجع الحضاري والسياسي، فولدت المقاصد لتقوم بدور المواءمة التاريخية والتخفيف من حدة وصرامة أصول الفقه الذي وضع أساسه الشافعي، في حين أن قراءة حلاق وتركي تجعل منها تطويرًا لأصول الفقه نفسه وتجديدًا لمباحثه!
إن مشكلة مجمل القراءات الفكرية للمقاصد أنها تعزلها عن بيئتها المعرفية التي نشأت فيها أولاً وهي علم أصول الفقه والفقه؛ لأن المقاصد إنما تتكلم لغة الأصول وتخضع لمنطقه ولغته ومفاهيمه، بل وتحتكم إلى أصله الكلامي كما سبق في مقدمة هذا المقال، وما لم يُقرأ عمل الشاطبي وفق منطقه الداخليّ وبناء على مسلماته التي تنتمي إلى حقول: الكلام، وأصول الفقه، واللغة، فإن أي قراءة ستكون عرضة للانتقاد. وثانيًا أن هذه القراءات تتناقض بين من يعزلها عن سياقها التاريخي فيجعلها مجرد صدى لفلسفة أرسطية نظرية فقط (مع أن الشاطبي يلح على تجريد أصول الفقه لمسائل العمل) بمعزل عن التطور الاجتماعي والتاريخي، وبين من يرهنها للتطور التاريخي فقط بمعزل عن بعدها النصيّ المحكوم لمعرفة نظرية تراكمت عبر أجيال متعددة من العلماء يصعب القطع معها، والشاطبي يلح في كتابه على احترام الإجماع، والمشايخ السابقين، وأن العقل لا يُسرّح إلا بأمر من النصّ.
وثالثًا: أنه لا يمكن قراءة عمل الشاطبي نفسه بمعزل عن مصادره المستترة، والتي نادرًا ما يصرح بها، وهو قد نقل عن كتب كثيرة لم يُسمّها، وطور مقولات الجويني والغزالي والعز بن عبد السلام والقرافي وغيرهم من السابقين.
وسنحاول بيان مشكلة تلك القراءات بالنظر إلى سياق التطورات التي شهدها علم أصول الفقه من جهة، وفي سياق تحليل شخصية الشاطبي نفسه، وهو ما يكشف عن جوانب أخرى غابت عن مجمل تلك القراءات التي اعتبرت الموافقات لحظة استئناف القول أو قطيعة مع علم الأصول، أو تجاوز للمنهج النصيّ.
ثانيًا: الشاطبي في نظر نفسه
فمن جهة قراءة شخصية الشاطبي نفسه وتصرفاته، نجد أنه منذ البداية يحاول دفع شبهة رميه بالابتداع قائلاً: “إنه بحمد الله أمرٌ قَرَّرَتْهُ الآيات والأخبار، وشَدَّ مَعَاقِدَهُ السَّلَفُ الأخيار، ورسم معالمه العلماء الأحبار، وشَيَّدَ أركانه أنظار النُّظَّار[22]“، وهو يكثر فيه من الاستشهاد بالآيات والأحاديث والإجماعات، وفي المقدمة (12) يتحدث عن حسن التأدب مع الشيوخ والاقتداء بهم، وأن من أماارات العالم المتحقق بالعلم “أن يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم؛ لأخذه عنهم وملازمته لهم”، وأنه “قلّما وُجدت فرقة زائغة ولا أحدٌ مخالفٌ للسنة إلا وهو مفارقٌ لهذا الوصف، وبهذا الوجه وقع التشنيع على ابن حزم الظاهري، وأنه لم يلازم الأخذ عن الشيوخ ولا تَأدّب بآدابهم[23]“.
وحرص الشاطبي على تأكيد أسبقية النقل على العقل، فقال: “إذا تَعَاضَدَ النقل والعقل على المسائل الشرعية؛ فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعًا، ويتأخر العقل فيكون تابعًا، فلا يَسْرَحُ العقل في مجال النظر إلا بِقَدْرِ مَا يُسَرِّحُهُ النقل[24]“، وهو لشدة التزامه بالمنصوص يخشى من اتهام البعض له بـ”عدم اعتبار المعقول جُمْلَةً”، وبـ”نفي القياس الذي اتفق الأولون عليه”، ثم يدفع تلك التهمة بتقرير أن “القياس ليس من تصرفات العقول محضًا، وإنما تَصَرَّفَتْ فيه تحت نظر الأدلة، وعلى حسب ما أَعْطَتْهُ من إطلاق أو تقييد”، وأن العقل لا يستقل بذلك، بل “هو مهتدٍ فيه بالأدلة الشرعية، يجري على مقدار ما أَجْرَتْهُ، وَيَقِفُ حيث وَقَفَتْهُ[25]“.
بل إنه يقرر في مقدمة الاعتصام “أن كتاب الله وسنة نبيه لم يَتْرُكَا في سبيل الهداية لقائل ما يقول، ولا أَبْقَيَا لغيرهما مجالاً يُعْتَدُّ فيه، وأن الدين قد كَمُلَ، والسعادة الكبرى فيما وَضَعَ، والطِّلْبَةَ فيما شرَع، وما سوى ذلك فَضَلَالٌ[26].”
ويقرر في موضع آخر أنه مقلِّد فيقول: “مراعاة الدليل أو عدم مراعاته ليس إلينا، معشر المقلدين، فحسبنا فَهْم أقوال العلماء والفتوى بالمشهور منها، وليتنا ننجو، مع ذلك، رأسًا برأس لا لنا ولا علينا[27]“، وأن “العمل إنما يكون في المسائل الخلافية على ما هو المشهور كما تَقَرر[28]“، وقال: “أنا لا أستحل، إن شاء الله، في دين الله وأمانته أن أجد قولين في المذهب فأفتي بأحدهما على التخيير مع أني مقلّد، بل أتحرى ما هو المشهور والمعمول به فهو الذي أذكره للمستفتي، ولا أتعرض له إلى القول الآخر، فإن أشكل علي المشهور ولم أر لأحد من الشيوخ في أحد القولين ترجيحًا توقفت[29].”
فمن يقف على مجمل هذه الأفكار والتصرفات والأقوال، مع اختلاف زمانها، قبل كتاب الموافقات وأثناءه وبعده، يدرك حجم التهويل الذي تقوم به تلك القراءات التأويلية للمقاصد، وأنها كثيرًا ما تُسقط أفكارها على عمل الشاطبي.
ثالثًا: المقاصد في سياق تطورات علم الأصول
إن تسكين الموافقات/المقاصد في سياق تاريخ علم أصول الفقه، من شأنه أن يساعدنا على تقديم قراءة دقيقة لعمل الشاطبي على أهميته. وسنحاول هنا في عجالة قراءة موقع عمل الشاطبي من خلال ثلاث محطات: الأولى؛ مصادره والكتب اللصيقة بعمله، والثانية؛ كتب المقاصد الأولى في القرن الرابع الهجري، والثالثة؛ أفق النظر الاجتهادي الأصولي منذ الشافعي.
1. مصادر الشاطبي
أعتقد أن مصادر الشاطبي في كتاب الموافقات، وهي مستترة في الغالب الأعم كما سبق[30]، شديدة الأهمية هنا في تقويم أطروحة الشاطبي ونسبها العلميّ، خاصةً وأننا نجد فقرًا في ترجمة الشاطبيّ وتفاصيل حياته، كما أننا لا نكاد نعثر له على ذِكر في كتب المالكية بعد البحث والتقصيّ، وهو ما يعكّر على ادعاء البعض أن “الموافقات” كانت حاضرة ومستمرة بعده؛ لأن تقرير الحضور والتأثير لا يكفي فيه عدد النسخ، وهي على كل حال قليلة جدًّا، وإنما يتم بناء على قدرتها على اقتحام المجال العلمي نفسه نقلاً أو نقدًا أو مناقشة من قبل أهل الفنّ.
والصلة القريبة والمتينة بين أطروحة الشاطبي وأفكار الجويني والغزالي والعزّ واضحة، رغم أنه لم يذكر الجويني إلا مرتين أو ثلاثة، كما أنه نقل عن الغزاليّ وأكثر من ذكره، فنقل من إحياء علوم الدين كثيرًا، وإلجام العوام، وجواهر القرآن، وفضائح الباطنية، ومشكاة الأنوار، والمنقذ من الضلال، وشفاء العليل، كما نقل عن المستصفى دون ذكره، ونقل عن القرافي وذكره مراتٍ، والعز بن عبد السلام ولم أره ذكره.
وقراءة مصادر الشاطبي لتقويم عمله أمر ليس بالسهل ويحتاج منا إلى عودة لاحقة مستقبلاً، فالتعجّل فيه أو الاجتزاء فيه من شأنه أن يؤدي إلى نتائج مُخلّة بميزان القراءة المعرفية، فعلى سبيل المثال رأى بعض الباحثين في ذِكر الغزاليِّ في الموافقات “ما يُبرر العلاقة بين المنطق الأرسطي والاستقراء عند الإمام الشاطبي، بما أن الغزالي قد دمج المنطق الأرسطي بالمنطق الأصولي دمجًا تأصيليًّا ليكون علم أصول الفقه مبنيًّا على الكليات[31]“، في حين ذهب آخر إلى سَوق التشابهات بين الغزالي والشاطبي وأن الفرق في العرض فقط وفي الكمّ[32].
والنَّسَب بين أفكار الشاطبي وأفكار من سبقوه واضحٌ، فالأفكار الرئيسية للمقاصد: الضرورات الخمس ومراتبها، سبق إلى تحديدها الجويني وتلميذه الغزالي، والتنظير في المصالح والقواعد الكلية القطعية سبق إليه العز والقرافي والمقّريّ وقد أفاد منهم الشاطبي، ولكنه أول من أفرد المقاصد بالتصنيف وجعل منها نظرية مكتملة الأركان متينة البنيان.
2. كتب المقاصد الأولى
والنظر التاريخي يُوقفنا على أن القرن الرابع الهجري شهد اهتمامًا لافتًا بالمقاصد، نجد هذا في عدة كتب، لعل ما كتبه أبو زيد البلخي (322ﻫ) يقع في مقدمتها فقد قدم كتابين، الأول سماه “مصالح الأبدان والأنفس” (مطبوع) بدأه بمقدمة نظرية تحدث فيها عن المصلحة (جلب المنفعة ودفع المفسدة)، وأن الغاية هي الصلاح في المعاش والمعاد، ثم أورد تطبيقات عملية غايتها حفظ النفس والبدن وهو موضوع كتابه. والثاني، ولم يُعثَر عليه، سماه “الإبانة عن علل الديانة”، وعنوانه كافٍ لبيان موضوعه وهو الأصل الذي قامت عليه نظرية المقاصد.
ثم يأتي القفّال الشاشي الكبير (365ﻫ) الذي كتب محاسن الشريعة، وأبو الحسن العامريّ (381ﻫ) الذي كتب الإعلام بمناقب الإسلام (مطبوع)، والإبانة في علل الديانة أيضًا ولم يُعثَر عليه. وإن كان أحمد الريسوني وصف هذا الإنتاج بأنه ذو “طابع جزئي، وتفصيلي وعفوي”، فإن محمد كمال إمام يدافع بشدة عن فكرة أن “الحكم الجزئية للتشريع تُعَد جزءًا أصيلاً من فقه المقاصد الشرعية، وواضح أنه اكتمل منهجًا وتصنيفًا في القرن الرابع الهجري[33]“، وأعتقد أن تقويم مثل هذه الجهود يبقى وقوفًا عند تخوم الظاهر ما لم نقف عليها وندرسها جيدًا لمعرفة بنائها وحدودها وتطبيقاتها.
3. أفق النظر الاجتهادي
أما فيما يخص أفق الاجتهاد الفقهي الذي يشكل غاية المقاصد والأصول فقد كان موضع جدل قديم منذ بنى الشافعي رسالته في محاولة تقعيد النظر التشريعي وضبط الخلاف الذي كان شائعًا، فوضع “الرسالة” لتشكل قانون الاجتهاد، ولكنها لم تحسم الاختلاف الفقهي الذي استمر وتعمق وشهد تطورات بقدْر ما أحدث الناس من حوادث استدعت تفاعل النظر الاجتهادي مع الوقائع، بالإضافة إلى تطورات التقعيد المذهبي والتنظير الأصولي الذي اكتمل في القرن الخامس الهجري مع بناء الحنابلة لأنفسهم منهجًا أصوليًّا متكاملاً مع أبي يعلى وابن عقيل والكَلْوذاني.
ومن اللافت أن الشاطبي وهو يفسر لنا أسباب عدوله عن تسمية الكتاب بـ”أسرار التكليف” إلى “الموافقات” يوضح، بناء على رؤيا صادقة لأحدهم وافقت مقصده، أن مراده به التوفيق بين “مذهبي ابن القاسم وأبي حنيفة”، وأن غرضه كان “تأسيس تلك المباني، فإنها الأصول المعتبرة عند العلماء، والقواعد المبنيّ عليها عند القدماء[34]“، فإذا ما وُضع هذا الكلام إلى جنب كلامه عن نفسه سابقًا بأنه ملتزم بالمذهب لا يخرج عن المشهور فيه، مع ما قرره في باب الاجتهاد من الموافقات، لا يبدو متناقضًا، كما أنه لا يبدو فتحًا لنسق جديد؛ قاطعٍ مع موروثِ علم الأصول وإن كان مصحِّحًا ومُجدِّدًا فيه.
ينقل الغزالي عن الشافعي تقريرَه لنَسَق النظر الاجتهادي، فيقول: “قال الشافعي: “إذا رُفعت إليه؛ [أي المجتهد] واقعةٌ فليعرضها على نصوص الكتاب، فإن أَعْوَزه، فعلى الأخبار المتواترة، فإن أعْوزه إذًا فعلى الآحاد، فإن أعْوَزه لم يَخضْ في القياس؛ بل يلتفت إلى ظاهر القرآن، فإن وجد ظاهرًا نظر في المخصّصات من قياس وخبرٍ، فإن لم يجد مخصّصًا حكم به، وإن لم يعثر على لفظٍ من كتاب ولا سنة نظر إلى المذاهب، فإن وجدها مُجْمَعًا عليها اتبع الإجماع، وإن لم يجد إجماعا خاض في القياس؛ ويلاحظ القواعد الكلية أولاً ويقدمها على الجزئيات… فإن عدَم قاعدةً كلية نظر في النصوص ومواقع الإجماع، فإن وجدها في معنى واحد ألحق به، وإلا انحدر إلى قياس مَخِيْل، فإن أعوزه تَمَسك بالشبَه ولا يُعوّل على طَرْدٍ إن كان يؤمن بالله العزيز ويَعرف مآخذ الشرع[35].”
فالشافعي يرسم هنا خط ومسار تدرج النظر الاجتهادي ومراحله، ولكن لا ينبغي أن يغيب عنّا هنا، كما وقع لبعض الدارسين الذين أُولعوا بالمقارنة بين عمل الشافعي وعمل الشاطبي، أن الشافعي هنا إنما يقرر مذهبه هو، وإن كان لابد من تقويم عمل الشاطبي فيجب قراءته ضمن المذهب المالكيّ الذي ينتمي إليه ويلتزم به، وفي سياق مقصوده في الجمع بين مذهبي ابن القاسم (تلميذ مالك وأحد أهم رواته) وأبي حنيفة.
وواضح من نص الشافعي تسكينه للقواعد الكلية ضمن القياس، وأنها مُقَدّمةٌ في القياس على الجزئيات، ومع ذلك فقد تطور النظر الأصولي الشافعي بعد الشافعي الذي كان موقفه حادًّا تجاه الاستحسان والمصالح؛ فقد آل مذهب أصوليي الشافعية بعده، الجويني والغزالي خاصة، إلى القول بها على نحو ما وضبط خاصّ. وأصل الخلاف القديم الذي نشير إليه يرجع إلى القرن الثاني الهجري حيث وقع الخلاف في الاجتهاد: المنصوص والمستنبط، وقد عرف التاريخ التشريعي ثلاث مدارس أشار إليها الشاطبي نفسه في مقدمة كتابه هي: الظاهرية، والباطنية، والمدرسة التي تعتبر الأمرين: الظاهر والباطن؛ على وجه لا يُخلّ فيه المعنى بالنص ولا العكس، وقال: إن المدرسة الثالثة هذه يقع عليها الاعتماد.
ولكن الخلاف في المستنبط (غير المنصوص) وقع بين المذاهب الأربعة نفسها، وهو ما أبهمه هنا الشاطبي، فالشافعية قالوا بالقياس، والظاهرية قالوا بالاستصحاب، والمالكية والحنفية والحنابلة قالوا بالقياس والاستدلال. والاستدلال هنا هو طلب الدليل مما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس، وتوسيع منهج الاستنباط في غير المنصوص من خلال المصالح المرسلة والاستحسان، وهما جوهر فكرة المقاصد، في مقابل تمركز أصول الشافعي على دلالات الألفاظ التي سماها “البيان”.
ثم إن القياس الفقهي، الذي تُصَوَّر المقاصدُ على أنها محاولة للخروج من ضيقه، لم يكن سياجًا صارمًا عند كل المذاهب، ومحاولة توسيعه قديمة، فقد وُجد في المذهب المالكي الأخذ بمصلحة جزئية في مقابل دليل كليّ، ومقتضاه تقديم الاستدلال المرسل على القياس[36]. وفي نص مهم ينقله الشاطبي نفسه عن ابن العربي، يقول: “وقال في أحكام القرآن: الاستحسان عندنا وعند الحنفية هو العمل بأقوى الدليلين، فالعموم إذا استمر والقياس إذا اطّرد، فإن مالكًا وأبا حنيفة يريان تخصيص العموم بأي دليل كان من ظاهر أو معنى، ويَستحسن مالك أن يَخصّ بالمصلحة، ويستحسن أبو حنيفة أن يخص بقول الواحد من الصحابة الوارد بخلاف القياس، ويريان معًا تخصيص القياس ونقض العلة، ولا يرى الشافعي لعلة الشرع إذا ثَبتت تخصيصًا”، ويعقب عليه الشاطبي بالقول: “وهذا الذي قال هو نظرٌ في مآلات الأحكام؛ من غير اقتصار على مقتضى الدليل العام والقياس العام. وفي المذهب المالكي من هذا المعنى كثيرٌ جدًّا[37].”
ومما يتصل بتوسيع النظر الاجتهادي خارج سياج النص: نصٌّ مهم لابن العربي المالكي يقول فيه: “إذا كان الحرج في نازلة عامة في الناس فإنه يسقط، وإذا كان خاصًّا لم يُعتَبر عندنا، وفي بعض أصول الشافعي اعتبارُه”، ولكن الطريف أن الشاطبي نفسه ينتقد هذا التوسيع، فيقول: “وهو مما يُنظَر فيه، فإنه إن عنى بالخاص الحرج الذي في أعلى مراتب المعتاد فالحكم كما قال، ولا ينبغي أن يُختَلف فيه؛ لأنه إن كان من المعتاد فقد ثَبت أن المعتاد لا إسقاط فيه وإلا لَزِمَ في أصل التكليف، فإن تُصُوِّرَ وقوع اختلاف فإنما هو مبنيٌّ على أن ذلك الحرج من قبيل المعتاد، أو من قبيل الخارج عن المعتاد، لا أنه مُخْتَلَفٌ فيه مع الاتفاق على أنه من أحدهما. وأيضًا فتسميته خاصًّا يُشاحّ فيه؛ فإنه بكل اعتبار عامٌّ غير خاصّ[38].”
واللافت في نص الشافعي السابق: تركيزُه على القواعد الكلية وتقديمها على القياس الجزئي وهو جوهر عمل المقاصد في الجملة، والعمل بهذا المنحى قديم لم يبتكره الشاطبي وإن ساهم في بلورته وضبطه، وسبق للقرافي أن اعتبر أن أصول الشريعة “قسمان: أحدهما المسمى بأصول الفقه… والقسم الثاني قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد، مشتملة على أسرار الشرع وحِكَمه…[39]“؛ أي أنه جعلها المعبّرَ عن مقاصد الشرع وحكمه، ثم جعلها ركنًا من أركان علم الشريعة، والقواعد جعلها ابن نجيم الحنفي (970ﻫ) “هي أصول الفقه في الحقيقة”[40]، وقد سبق لمتقدمي الحنفية بحثها فيما أسموه “أصول المذهب” كما فعل الدبوسي (430ﻫ) وغيره، وفكرة المقاصد لا تَبْعد كثيرًا أن تكون تطورًا آخر في بنية أصول الفقه، فالمقاصد والقواعد ترجعان إلى مصطلحات أصولية ضمن مباحث الأدلة المختلف فيها أو التبعية، وكلاهما في الحقيقة قواعد مصلحية مقصدية يُقرّب الأصول من الفقه وتطبيقاته، في ترابط يجمع بين الأصول والقواعد والمقاصد، وفي نصوص الشاطبي ما يشير إلى مثل هذا.
مثل هذه المسائل يحتاج إلى إيضاح أكبر، وهو ما سنعود إليه مستقبلاً بمشيئة الله، ولكنني أردت لهذه الورقة العجلى أن تكون دافعًا لإثارة النظر من جديد في أفق المقاصد ومساراتها وقراءاتها، للتمييز بين رغبات القراء وإمكانات المقاصد، خاصة في نص الشاطبي، فقد وقع الشاطبي رهينة قرائه في كثير من الأحيان، وتم اختزال التاريخ التشريعي، من خلاله وليس منه، بشكل مشوه. فالعزمُ أن أعود للتفصيل في هذا الموضوع لاحقًا، ولكنني جعلت هذه الورقة متنًا بين يدي ما أقصد له مستقبلاً.
الهوامش
[1]. انظر مثلاً العمل الببليوغرافي الضخم الذي أحصى دراسات المقاصد (كتب ورسائل وبحوث): محمد كمال إمام، الدليل الإرشادي إلى مقاصد الشريعة، لندن: مركز دراسات مقاصد الشريعة، 2008-2012، 9 مجلدات.
[2]. وهو العنوان الذي كتب فيه د. أحمد الريسوني عن الشاطبي، ود. إسماعيل الحسني عن ابن عاشور مثلاً.
[3]. طُبع كتاب الموافقات للمرة الأولى في تونس سنة 1884م، والشائع بين الدارسين أن محمد عبده اطلع على هذه النسخة أثناء زيارته لتونس، ولكن عبد الله دراز يُشير في مقدمة طبعته إلى وجود نسخة عسيرة القراءة وبخط مغربي كان يتداولها طلبة العلم في عصره، ومنهم عبد الله دراز نفسه، ولعل هذا ما دفع محمد كمال إمام إلى الجزم بأن محمد عبده كان بين يديه نسخة خطية من الكتاب قبل رحلته إلى تونس، ورجّح أنها نسخة محمد محمود بن التلاميذ التركزي (توفي سنة 1323ﻫ)، وهو فقيه موريتاني شنقيطي، عاش فترة في مصر، وطبع بعض كتبه بها، واتصل بالإمام محمد عبده وأوصى بنقل مكتبته، وبها مخطوطات نادرة، إلى دار الكتب المصرية. انظر: محمد كمال إمام، الدليل الإرشادي، ج1، م، س، ص16. ويجادل محمد كمال إمام في مقال له بعنوان: “نحو قراءة مقاصدية أصولية” بأن كتاب “الموافقات” ذاته لم يكن غائباً أو مجهولاً كما قيل، “بل إن الإقبال عليه استمر من عهد مؤلفه إلى اليوم”، وذلك بالاستناد إلى مقال لمحمد المنوني يشرح فيه تأثير الشاطبي فيمن بعده.
[4]. كما أوضحت ذلك في: معتز الخطيب، الوظيفة المقاصدية: مشروعيتها وغاياتها، مجلة إسلامية المعرفة، عدد 48، ص9-34. وقال محمد الفاضل بن عاشور عن تأثير كتاب الموافقات: ” ظهرت مزية كتابه ظهورا عجيبا في قرننا الحاضر والقرن قبله؛ لما أشكلت على العالم الإسلامي عند نهضته من كبوته أوجه الجمع بين أحكام الدين ومستجدات الحياة العصرية، فكان كتاب “الموافقات” للشاطبي هو المفزع، وإليه المرجع لتصوير ما يقتضيه الدين من استجلاب المصالح، وتفصيل طرق الملاءمة بين حقيقة الدين الخالدة وصور الحياة المختلفة المتعاقبة”. محمد الفاضل بن عاشور، أعلام الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب العربي، ص76.
[5]. انظر: ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص166.
[6]. عبد الله دراز، مقدمة تحقيقه لكتاب الموافقات للشاطبي، بيروت: دار الكتب العلمية/لبنان، ج1، ص6.
[7]. محمد الخضري بك، أصول الفقه، المكتبة التجارية الكبرى، ط6، (1389ﻫ/1969م)، ص12.
[8]. محمد الطاهر ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، تحقيق الطاهر الميساوي، الأردن: دار النفائس، ط2، 2001م، ص167.
[9]. أما القرافي فقد اعتبر أن أصول الشريعة “قسمان: أحدهما؛ المسمى بأصول الفقه … والقسم الثاني؛ قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد، مشتملة على أسرار الشرع وحكمه …”. القرافي، الفروق، عالم الكتب، ج1، ص2-3.
[10]. دراز، مقدمة الموافقات، ج1، م، س، ص5-6.
[11]. انظر: دراز، مقدمة الموافقات، ج1، م، س، ص7-10.
[12]. انظر: الجابري، التراث والحداثة، تقديم محمد الداهي، منشورات دار التوحيدي، 2012، ص209-211. وانظر: الجابري، بنية العقل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، ص551 حيث يؤكد تبعية الشاطبي لابن رشد، ويقارن بين عمل ابن خلدون وعمل الشاطبي ويصفه بأنه “تأصيل أصول علم الشريعة”.
[13]. الجويني، الغياثي، فقرة 567.
[14]. عبد المجيد الصغير، الفكر الأصولي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، ط1، 1994، ص382-383.
[15]. محمد أركون، تاريخية الفكر العربي الإسلامي، المركز الثقافي العر بي، ص170.
[16]. محمد أركون، من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي، دار الساقي للطباعة والنشر، 1993، ص16-17.
[17]. وائل حلاق، تاريخ النظريات الفقهية في الإسلام، تحقيق: أحمد موصللي، فهد بن عبد الرحمن الحمودي دار المدار الإسلامي، ط1، 2007، ص266.
[18]. المرجع نفسه، ص233.
[19]. عبد المجيد تركي، الشاطبي والاجتهاد التشريعي المعاصر، مجلة الاجتهاد، عدد 8، ص239.
[20]. طه عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم التراث، ص97.
[21]. المرجع نفسه، ص97، 103، 122.
[22]. الشاطبي، الموافقات، طبعة مشهور، وعليها الاعتماد في الاقتباسات اللاحقة، ج1، ص13.
[23]. أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، بيروت: دار الكتب العلمية/لبنان، المجلد الأول، ج1، ص141، و144.
[24]. المرجع نفسه، ص125.
[25]. الشاطبي، الموافقات، ج1، م، س، ص131-133.
[26]. الشاطبي، الاعتصام، تحقيق الشيخ مشهور حسن سلمان، الرياض: دار ابن عفان، ط1، 1412ﻫ، ج1، ص31. وانظر خاتمة الكتاب وفيها إشارات قوية لهذا المعنى وانتقاد لكتب المتأخرين، والتمسك باتباع الأدلة وأقوال الأئمة السابقين.
[27]. الشاطبي، فتاوى الشاطبي، تحقيق محمد أبو الأجفان، تونس، ط2، (1406ﻫ/1985م)، ص119.
[28]. المرجع نفسه، فتوى رقم 7.
[29]. المرجع نفسه، فتوى 40.
[30]. بذل أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان جهدًا واضحًا في طبعته للموافقات في الوقوف على كثيرٍ من مصادر الشاطبي في كتابه التي نقل عنها ولم يُسمّها.
[31]. نورة بوحناش، الشاطبي: قراءة معاصرة لنص قديم، ص60.
[32]. انظر: عبد المجيد تركي، الشاطبي والاجتهادي التشريعي المعاصر، ص246.
[33]. انظر: محمد كمال إمام، الدليل الإرشادي، ج1، م، س، ص10-11.
[34]. الشاطبي، الموافقات، ج1، م، س، ص11.
[35]. الغزالي، المنخول في تعليقات الأصول، تحقيق محمد حسن هيتو، دمشق: دار الفكر، ط2، 1400ﻫ، ج1، ص576، وانظر ص611.
[36]. انظر: عبد الله بن بيه، علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه، لندن: مركز الفرقان للتراث الاسلامي، 2006 ص139-140.
[37]. الشاطبي، الموافقات، ج5، م، س، ص196-198.
[38]. الشاطبي، الموافقات، ج2، م، س، ص273.
[39]. القرافي، الفروق، ج1، ص2-3.
[40]. ابن نجيم، الأشباه والنظائر، وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، بيروت: دار الكتب العلمية/لبنان، ط1، (1419ﻫ/1999م)، ج1، ص14.