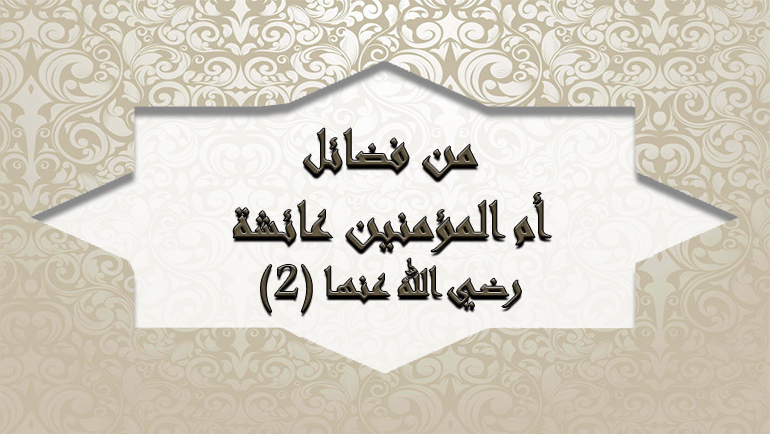تمثل الأخلاق الفاضلة والخصال الحميدة غاية الدين الكبرى التي تروم تحقيقها عقيدته وعبادته ومعاملاته، وكل تشريعاته في مجال الحياة. فهي بذلك ثمرة لمجاهدة النفس في القيام بتكاليف الدين والائتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه، كما أنها تحتاج جهدا خاصا لترسيخ كل صفة كريمة وتنمية كل خصلة طيبة، ومداومة الحفاظ عليها والتطبع بها.
مسؤولية الفرد عن أخلاقه
يبدو أن أول صعوبة تواجه الباحث في موضوع الأخلاق وعلاقتها بالمسؤولية الفردية، تكمن في تعريفها ذاته، والذي قد يحمل على اعتبارها صفات نفسية موهوبة، شأنها كشأن الصفات الجسمية التي لا دخل للإرادة الإنسانية في تحديدها.
فلقد عرفها الإمام الغزالي بقوله: “فالخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة، عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية، فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلا وشرعا، سميت تلك الهيئة خلقا حسنا، وإن كان الصادر عنها، الأفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي المصدر خلقا سيئا”[1]. وتأكيد هذا التعريف على خاصية الرسوخ والاستمرار في الخلق، وإرجاعه إلى صفة ثابتة في النفس؛ يعني زوال المشقة من فعله والاتصاف به، وهذا ما اتضح أكثر من قول الغزالي” وإنما قلنا إنها هيئة راسخة لأن من يصدر منه بذل المال على النذور لحاجة عارضة لا يقال خلقه السخاء ما لم يثبت ذلك في نفسه ثبوت رسوخ، وإنما اشترطنا أن تصدر منه الأفعال بسهولة من غير روية لأن من تكلف بذل المال أو السكوت عند الغضب بجهد وروية لا يقال خلقه السخاء والحلم”[2].
وهذا الكلام يحصر الخلق في ما استقر في النفس من الأوصاف وصدر عنها بعفوية،سواء كان مصدره الفطرة أو الاكتساب، وتزداد هذه الحقيقة جلاء في التعريف الذي ساقه الدكتور محمد عبد الله دراز وهو أن “كلمة (خلق أو أخلاقية) بالمعنى الصحيح؛ تعني تلك القدرة الفطرية أو المكتسبة التي ينبثق عنها السلوك تلقائيا، وبعبارة أخرى الخلق هو الشكل الثابت لوجودنا الباطني، في مقابل الخلق وهو الشكل الظاهري الذي وهبه الله لكل مخلوق.
وطالما لم نحصل على هذا الثبات الذي بفضله تفيض الأعمال في دفعة كريمة وتلقائية، فإننا نظل في حالة التخلق، أعني حالة الاختبار والمحاولة من أجل أن نسلك بطريقة أو بأخرى”[3].
واعتبار خاصية الثبات في الأخلاق ويسر صدورها عن النفس المتصفة بها، أدى ببعض المفكرين إلى القول بفطرية الأخلاق، فهذا شوبنهورSchopenhauer (1788–1860) يقول: “هناك أناس طيبون وآخرون خبثاء، مثلما يوجد حملان ونمور؛ فالأولون يولدون بمشاعر إنسانية، والآخرون يولدون بمشاعر أنانية، وعلم الأخلاق يصف أخلاق الناس، مثلما يصف التاريخ الطبيعي خصائص الحيوانات[4].
ويذهب سبنوزا Spinoza (1632–1677) إلى حد القول بأن الأعمال الإنسانية، شأن جميع ظواهر الكون، تنتج وتستنبط بنفس الضرورة المنطقية التي يستنتج بها من جوهر المثلث أن زواياه الثلاث تساوي قائمتين”[5].
أما كانط Kant (1724–1804) فإنه يؤكد أننا لو كنا نعرف جميع الظروف والسوابق فإن أعمال الإنسان يمكن التبوء بها بنفس الدقة التي يحدد بها كسوف الشمس، وقد كان عليه لكي ينقذ الحرية ومعها المسؤولية أن يخرجهما كلية من مجال التجربة، ومن عالم الظواهر”[6].
فنظرة هؤلاء إلى الأخلاق تحكمها حتمية صارمة لا مجال فيها لحرية الإنسان، ومسؤوليته عن اختيار أخلاقه أو تعديلها، في حين” أن علم النفس المقارن يثبت على العكس أن الغرائز الإنسانية أقل صرامة، وأكثر قابلية للتغيير والتربية، يؤثر بعضها في بعض لأكثر من غريزة الحيوان، بسبب عددها الكبير وتعقدها البالغ. فإذا كان الإنسان قد باشر، منذ الأزل، سلطانه على الصفات الطبيعية للحيوانات غير المستأنسة، التي أصبحت بالترويض طبيعة مستأنسة بعد أن كانت متوحشة متمردة، فكيف لا يكون لدينا سلطان مباشر أو غير مباشر على طباعنا الخاصة كي نغيرها إلى خير أو إلى شر؟”[7]. ولقد تصدى الإمام الغزالي لمنكري تغيير الأخلاق فقال: “لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير لبطلت الوصايا والمواعظ والتأديبات، ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “حسنوا أخلاقكم”[8]. وكيف ينكر هذا في حق الآدمي وتغيير خلق البهيمة ممكن؛ إذ ينقل البازي من الاستيحاش إلى الأنس والكلب من شره الأكل إلى التأدب والإمساك والتخلية، والفرس من الجماح إلى السلاسة والانقياد وكل ذلك تغيير للأخلاق”[9].
ثم ساق مثلا موضحا من عالم النبات فقال: “إن النواة ليست بتفاح ولا نخل إلا أنها خلقت خلقة يمكن أن تصير نخلة إذا انضافت التربية إليها، ولا تصير تفاحا أصلا ولا بالتربية، فإذا صارت النواة متأثرة بالاختيار حتى تقبل بعض الأحوال دون بعض، فكذلك الغضب والشهوة لو أردنا قمعهما وقهرهما بالكلية حتى لا يبقى لهما أثر لم نقدر عليه أصلا، ولو أردنا سلاستهما وقودهما بالرياضة والمجاهدة قدرنا عليه، وقد أمرنا بذلك وصار ذلك سبب نجاتنا ووصولنا إلى الله تعالى[10].
فالإنسان مطالب بتنمية ما جبلت عليه نفسه من الخصال الحميدة، والأخلاق الفاضلة، ومسؤوليته في الحفاظ عليها تعظم بقدر ما يتيسر له التخلق بها، كما أنه مطالب بمجاهدة نفسه لاكتساب ما ليست مفطورة عليه من الطباع الكريمة والتخلي عما يكون ميلها إليه شديدا من الأخلاق الذميمة.
فالتكليف يشمل الأخلاق الحسنة كلها سواء منها ما طبعت عليه النفس وقهرت على الاتصاف به، أو ما أمر به الشرع مما يشق عليها التحلي به ولا يصير لها خلقا إلا بعد طول مجاهدة. هذا ما ذهب إليه الإمام الغزالي حيث قال: “إن الأخلاق الحسنة تارة تكون بالطبع والفطرة، وتارة تكون باعتياد الأفعال الجميلة، وتارة بمشاهدة أرباب الأفعال الجميلة ومصاحبتهم وهم قرناء الخير وإخوان الصلاح؛ إذ الطبع يسرق من الطبع الشر والخير جميعا”[11].
إن اتصاف الإنسان بما جبل عليه من الفضائل والمزايا أيسر للنفس وأقرب إلى الكمال، كما أكد ذلك الإمام ابن قيم الجوزية بقوله: “فحياة من قد طبع على الحياء والعفة والجود والسخاء والمروءة والصدق والوفاء ونحوها أتم من حياة من يقهر نفسه، ويغالب طبعه، حتى يكون ذلك”[12]. وهذا الكلام لا يعني أن من كان حاله كذلك أفضل درجة عند الله ممن اجتهد في تحسين أخلاقه وعانى مشقة التربية والاكتساب، وإنما يعني أن صدور الأخلاق عن توجه فطري في النفس يجعلها أكثر ثباتا، وأبعد عن النقصان والضعف المؤدي أحيانا إلى التراجع والانقطاع.
ولهذا، فإن “من تظاهرت في حقه الجهات الثلاث حتى صار ذا فضيلة طبعا واعتيادا وتعلما فهو في غاية الفضيلة”[13].
فالنفس الإنسانية فطرها الله تعالى على حب الفضائل وبغض الرذائل، وجعل بعض الخصال الحميدة المنطبعة في نفوس أكثر من أخرى، وذلك ما يجعل تحسين الأخلاق مجالا واسعا لمسؤولية الإنسان عن بناء نفسه وإصلاحها وتزكيتها.
الإحساس بالمسؤولية أساس التغيير الأخلاقي
عندما يوقن الإنسان بأن مسؤوليته في هذه الحياة تتمحور حول تزكية النفس، وحملها على امتثال شرع الله عقيدة وعبادة وأخلاقا، فإن الشعور بهذه المسؤولية يلازم نفسه، ويكون باعثا لها باستمرار على التخلق بالأخلاق الإسلامية والتأدب بآدابها الرفيعة.
ولقد تضافرت أدلة الشرع لتكوين هذا الشعور في النفس، وتنميته على الدوام، قال تعالى: (ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها) ( الشمس: 7– 10). وقال: (فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى) ( النازعات: 40–41).
وفي الحديث: “إذا أراد الله بعبد خيرا جعل له واعظا من نفسه يأمره وينهاه”[14]. وما لم يكن إحساس الإنسان بمسؤوليته عن أخلاقه وسلوكه قويا ومتزايدا، فإنه يعجز عن تغيير ما بنفسه من نقص واعوجاج، ويذهل عن معاييبها المتراكمة وهفوتها المستحدثة.
ومن هنا، فليس غريبا أن نجد بعض المذاهب الوضعية تربط الأخلاق بتقدير الواجب واستشعاره. فهذا العالم الاجتماعي دوركايم durcheim (1858-1917) يعتبر فكرة الواجب أساس التربية الأخلاقية؛ أي أن يكون الفرد “سيد نفسه يتصرف بتعقل” لأن العقل هو ارتقاء بالمعرفة وضبط للحواس والغرائز قصد الاقتراب من مبدئي الحق والواجب[15].
وهذا فخته fichte (1762–1814) يؤسس نظريته في الأخلاق على مبدأ الواجب؛ “فالفاعلية الأخلاقية هي التزام الإرادة الحرة بما هو مثالي، فالإرادة الصالحة هي الإرادة التي تصبو للغايات العليا.
فالإنسان وهو يحقق لنفسه المزيد من الحرية، يستطيع أن يكرس نفسه أكثر لمثالياته الروحية ولمفهوم الواجب، فالوجود هو محاولة تحقيق هذا الواجب، فعلى الإنسان أن يعمل دوما بما يوافق فهمه الأمثل لواجبه ولضميره”[16].
ويرى وليام كاي william Kay أن الشخص الناضج أخلاقيا لابد أن يتصف بصفات أربع هي: الاستقلالية، والعقلانية، والإيثار، والشعور بالمسؤولية. والسبب في وجود هذه الصفات هو أن كل عمل يتم تحت الإكراه لا يسمى عملا أخلاقيا، وكل عمل مستقل يحتاج إلى أن يخضع لمتطلبات العقل، وطالما أن كل قرار أو عمل يؤثر في حياة الآخرين، فيجب أن يراعي سعادتهم ويؤثر نفعهم، وأخيرا فكل قرار أو عمل أخلاقي يتصف بالاستقلالية والعقلانية والإيثار يظل عقيما واهنا حتى ينفذ ويمارس، ولذلك من الضروري أن يعمل على تنفيذه وممارسته[17]. وذلك ما يحتاج إلى شعور قوي بالمسؤولية.
ويتحدث علماء الأخلاق عن علاقة الأخلاق بالضمير، الذي يتولد عن وجود إحساس شخصي بالمسؤولية في اختيار السلوك القويم. “والشخصية الأخلاقية هي محصلة الكيفية التي تتكامل بها مكونات السلوك الأخلاقي الخمسة في شخصية الإنسان وهذه المظاهر هي: مقاومة إغراء الخطيئة، ودرجة الشعور بالذنب، والإيثار وبعد النظر الأخلاقي، والاعتقاد الأخلاقي، ويعبر عن قوة هذه المظاهر أو ضعفها بـ”الضمير” فإذا ارتفعت درجة هذه المظاهر كان الضمير قويا، وإذا انخفضت درجة قوتها كان الضمير ضعيفا، وإذا لم تكن قوة على الإطلاق كان الضمير غائبا أو ميتا”[18].
وبناء الضمير وتقويته هو الأساس المكين لتحقيق استقامة الفرد وصلاح المجتمع في المنظور الإسلامي حيث أن الشريعة الإسلامية “تعتمد قبل كل شيء على وجدان الإنسان لا على قوة السلطان، فبعض التنظيمات القضائية أو الدولية، ليست في نظره إلا وسائل تنظيم إداري، تتعلق بالاهتمام بشؤون الناس أكثر مما تتعلق بحكمهم، إنها ذات مهمة هي إسعاد الناس وتدبير مصالحهم لا مراقبتهم والتدخل في شؤونهم الخاصة، والعقوبات التي شرعها الإسلام، هي قليلة العدد بالنسبة لعموم الجرائم، ثم هي في نظر الكثير من العلماء كفارات لما ارتكب الإنسان من إثم، فيرجع إليه إذن واجب التقدم لتنفيذها عليه حتى يطهر نفسه مما اقترفه، أو هي زواجر لإصلاح حالة المجتمع وحمايته من ضعف الوجدان الإنساني فيه. فسلطة القانون إذن وجدانية قبل أن تكون حكومية. وتدخل الدولة في أعمال الإنسان الشخصية ضرورية لا ينبغي أن تتجاوز محلها.
إن غاية الشريعة هي مصلحة الإنسان كخليفة في المجتمع الذي هو منه، وكمسؤول أمام الله الذي استخلفه على إقامة العدل والإنصاف، وضمان السعادة الفكرية والاجتماعية والطمأنينة النفسية لكل أفراد الأمة”[19].
فما لم تتطلع نفس الإنسان إلى اكتساب ما ليس فيها من الصفات الحميدة والتخلي عما فيها من الخصال الكريهة، وطلب كمالها البشري بذلك في هذه الحياة، وابتغاء مرضاة الله ونعيمه الأخروي، فإن ما توهب من السجايا الطيبة يظل محدودا لا يرضي طموحها إلى الجمال الخلقي الذي هو غاية التدين، ومقصده الأسمى، على اعتبار أن المفهوم الواسع للأخلاق يستوعب تكاليف الدين كلها، سواء منها ما اتصل بعلاقة العبد مع الخالق أو علاقته مع غيره من المخلوقات.
اتهام النفس أساس البناء الأخلاقي
انطلاقا من شمولية الأخلاق، وكون النفس أقوى عائق عن تحقيق الاكتساب الأخلاقي، فإن منهج التغيير لابد أن يتأسس على توجيه أصبع الاتهام إلى النفس في كل ما يتصل بالسلوك نية وعملا.
ومسوغات هذا الاتهام كثيرة، والأدلة عليه من الشرع متضافرة، فهو خير طريقة لتأكيد مسؤولية النفس، وتنبيهها إلى الإخلال بها، وتوجيهها للقيام بها على أتم وجه، وإدامة يقظتها وحذرها من التهاون والتقصير والغفلة عن التزام الصواب، فالإنسان حينما يتهم نفسه يتجه إلى تدارك ما وقعت فيه من أخطاء؛ لأن اتهامه لها يمثل قمة الوعي بمسؤوليتها وما يتعين في حقها من أعباء وواجبات، مما يستنفرها لبذل غاية الجهد في إبراء الذمة من التبعات العالقة بها وتجنب التعرض لما ينتج عنها من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ويتخذ اتهامه النفس صورا مختلفة نعرضها فيما يلي:
1. المحاسبة والمراقبة
فبقدر ما يزداد اتهام الإنسان لنفسه يشدد عليها المحاسبة في كل صغيرة وكبيرة وفي كل حال من أحوالها، حتى وهي مطاوعة لعمل الخير، ومقبلة عليه، فإنه يخشى أن يخالطه قصد منها يحبطه أو شائبة تفسده.
فعن شداد بن أوس عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: “الكيس من دان نفسه؛ (أي حاسبها) وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله”[20].
فأول ما يحاسبها عليه عند الخواطر التي هي منشأ العمال وأصل السلوك ويردها إلى الشرع ويلزمها حدوده. يقول الحارث المحاسبي: “فبالفعل والعلم والتثبت يبصر الضرر والنفع من دواعي القلوب بالخطرات، وإلا لم يؤمن عليه أن يقبل خطرة من نزعات الشيطان أو تسويل النفس، يحسبها ولا تنبيها من الرحمن جل ثناؤه، أو ينفي خطرة من التنبيه على الخير، يحسبها من تسويل النفس أو تزيين الشيطان، فلن يميز بين ذلك، ولا يعرفه إلا بالعلم والتثبت بالعقل”[21].
ويقدم محاسبة النفس على مستقبل الأعمال قبل مستدبرها فيقول: “فهذه المحاسبة في مستقبل الأعمال، وهي النظر بالتثبت قبل الزلل، ليبصر ما يضره مما ينفعه، فيترك ما يضره على علم، ويعمل بما ينفعه على علم، فمن اتقى العجلة وتثبت قبل فعله واستدل بالعلم أبصر ما يضره مما ينفعه قبل العمل بهما”[22].
واتهام النفس إذا كان يحمل على محاسبتها، فإنه لا مناص للمحاسبة من مراقبة دائمة، تكشف عن الأهواء الخفية والانحرافات الدقيقة. وتفحص النيات والأعمال، وتقيسها بمقياس الشرع، وتزنها بموازينه الثابتة. قال الحسن البصري: “رحم الله عبدا وقف عند همه، فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر، فهذه مراقبة العبد في الطاعة وهو أن يكون مخلصا فيها، ومراقبته في المعصية تكون بالتوبة والندم والإقلاع، ومراقبته في المباح تكون بمراعاة الأدب والشكر على النعم، فإنه لا يخلو من نعمة لابد له من الصبر عليها، وكل ذلك لا يخلو من المراقبة”[23].
فاتهام النفس خطوة ضرورية، في اعتماد المراقبة الذاتية، سلوكا ثابتا وخلقا مطردا، تسبق الأعمال الظاهرة والباطنة، وتتبعها ولا تغفل شيئا منها في أي وقت من الأوقات، وعن طريقها تتقوى في النفس إرادة التزكية الخلقية، التي تنقل الإنسان من مرتبة إلى مرتبة أعلى منها.
2. رفض أعذار النفس
إن بالنفس ميلا طبيعيا إلى تسويغ إخلالها بالواجبات، وانتحال ما يكفي من الأعذار، للتستر على عجزها وتقصيرها في القيام بما يلزمها به الشرع، ويستحثها عليه الضمير، لكي توقف لومه وتأنيبه، وتواجه عتاب الناس عما بدا من تقاعسها وتفريطها، بما يناسب من الأعذار الزائفة.
ولا ينفع في الحد من ميل النفس إلى الدفاع عن انحرافاتها، والإمعان في غيها، إلا اعتماد أخلاق تقتدر بها على رد أعذارها الواهية، والإبقاء على حال الاتهام، الذي يطهرها من أدران العجز والقصور، ويحملها على الفعل والانجاز، وأداء الأمانات والمسارعة في الطاعات، ولقد قرر القرآن الكريم منهج أعذار النفس ومواجهتها بالصدق والمصارحة. فقد جاء في سورة القيامة المبدوءة بقوله تعالى: (لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة) و قوله تعالى: (بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره) (القيامة: 14–15).
وإذا كانت الآية إخبارا عن حال الإنسان يوم القيامة، فإنها تقتضي أن يمارس لوم نفسه في الدنيا وإبطال معاذيرها، ما دام ذلك متاحا له ومقدورا، استعدادا منه ليوم الحساب، الذي لا تقبل فيه معذرة، كما تؤكد ذلك مرارا في القرآن الكريم، (يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم) (غافر: 52). (هذا يوم لا ينطقون. ولا يوذن لهم فيعتذرون) (المرسلات: 35 – 36).
وباستعراض موارد الاعتذار في القرآن، يتبين أن الالتجاء إليه، كان دائما من شيم ضعاف الإيمان والمنافقين والظالمين. وفي ذلك دليل على أن أهل الإيمان الحق، لا يسلكون مسلك الاعتذار، ولا يجارون أنفسهم في ميلها إلى القعود والتبرم بالمسؤوليات[24].
وفي مقابل رفض أعذار النفس، يحمد قبول أعذار الناس وحمل ظاهر أعمالهم على خير محمل، وإذا جمعته بهم أعباء مشتركة، وحصل فيها خلل أو قصور، تحرى رد مسؤولية ذلك إلى نفسه أولا، وتساهل في تقرير مسؤولية غيره ما استطاع إلى ذلك سبيلا، حتى يكون حظ نفسه من العتاب كبيرا، ويقطع عنها أسباب الاعتذار، ويستعين بذلك على استنهاض همتها وتجديد عزيمتها.
قال الفضيل بن عياض (ت 187ﻫ): “الفتوة الصفح عن عثرات الإخوان” وقيل الفتوة أن لا ترى لنفسك فضلا على غيرك…” وقال محمد بن علي الترمذي: “الفتوة أن تكون خصما لربك على نفسك”[25].
ومما يقوي هذا المسلك، ويدعمه أن ينظر إلى فضل غيره عليه بعين التقدير، وينظر إلى فضله على الناس بعين التحقير. قال الإمام ابن قيم: “وأما رؤية فضل كل ذي فضل عليك، فهو أن تراعي حقوق الناس فتؤديها، ولا ترى أن ما فعلوه من حقوقك عليهم فلا تعاوضهم عليه، فإن هذا من رعونات النفس وحماقاتها، ولا تطالبهم بحقوق نفسك، وتعترف بفضل ذي الفضل منهم، وتنسى فضل نفسك. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية، قدس الله روحه، يقول: “العارف لا يرى له على أحد حقا، ولا يشهد له على غيره فضلا، ولذلك لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب”[26].
إن تبرئة النفس من مسؤولياتها، وإلصاقها بآخرين، وتوظيف كل منهج، وامتطاء كل سبب يؤدي لذلك، كان دائما خلقا متميزا للمبطلين في كل زمان ومكان. ولقد ركز القرآن الكريم على كشف هذا النهج السقيم لدى طائفة الكفار والعاصين والمنافقين، فنجد المشركين ينسبون لله إرادة الشرك منهم، (سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا) (الأنعام: 148). كما أن العصاة ينزعون عن رقابهم مسؤولية المعاصي التي ارتكبوها وينسبون الأمر بها إلى الله تعالى (وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون) (الأعراف: 28).
وامتدادا لمنهج التملص من المسؤولية، الذي يحكم مواقف أهل الضلال، فإنهم ينسبون إلى أنفسهم الحسنات، وينسبون إلى أنبيائهم المعصومين السيئات، (فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيّروا بموسى ومن معه) (الأعراف:131).
وأما أهل التقوى والاستقامة الذين دأبهم تحمل الأمانات المنوطة بهم على أحسن وجه مستطاع، فإنهم ينسبون إلى الله كل خير وإحسان، ويردون ما ينالهم من سوء إلى كسب أيديهم، وانحراف ما بأنفسهم. ويرى عبد الله بن محمد الرازي (ت 353ﻫ) أن هذا السلوك هو أساس كل خلق سام فيقول: “الخلق استصغار ما منك، واستعظام ما منه إليك”[27]. وذلك ما ترجمه يحيى بن معاذ (ت 258ﻫ) حيث قال مناجيا الله تعالى: “يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلب لك مع الأعمال، لأنني أعتمد في الأعمال على الإخلاص، وكيف أحرزها وأنا بالآفة معروف، وأجدني في ذنوبي أعتمد على عفوك، وكيف لا تغفرها وأنت بالجود موصوف”[28].
وتبرز معاني نكران الذات وإقالة عثرات الآخرين في حقيقة الخلق الحسن، وممارسته العملية، وتبنى عليها تعاريفه عند علماء السلوك، من ذلك قولهم “الخلق قبول ما يرد عليك من جفاء الخلق وقضاء الحق بلا ضجر ولا قلق”[29]. وقولهم: “الخلق أن تكون من الناس قريبا وفيما بينهم غريبا”[30].
ويرتبط بغلبة هذا الاتجاه على الإحساس والسلوك، أن يغلب على المكلف الاهتمام بإنجاز الواجبات أكثر من تحصيل الحقوق، لتعلق الواجبات بمسؤوليته التي قد يتوقف عليه وحده القيام بها، أما الحقوق فتدخل في نطاق مسؤوليات غيره التي ليس محاسبا عليها، ويحسن به أن يعذره إن تقاعس في أدائها، وأن يتصدق بحقوقه على من وجبت عليه أو يتنازل عن بعضها تفضلا وتكرما.
ولقد امتدح الله تعالى هذا السلوك في مواضيع كثيرة، منها التيسير على المدين المعسر، أو التصدق عليه بالدين، (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون) (البقرة: 280).
ومنها العفو عن الظالم في أخذ الحق منه، (والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين) (الشورى: 39–40). ومنها أن تسامح الزوجة المطلقة زوجها في حقها من الصداق، (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير) (البقرة: 237).
ففي ظل رفض أعذار النفس وقبول أعذار الناس، يتأتى للإنسان أن يتخلق بأخلاق عالية مثل الحلم والصبر والإيثار، والسماحة وسعة الصدر والكرم والعفة، والورع والتقوى والأمانة، والتواضع، والتجرد والرحمة والعدل… لأنها كلها أخلاق تقوم على تزكية النفس، وتطهيرها من أخطر أدوائها، وهو التصالح معها، بالتغاضي عن عيوبها، والتقصير في الواجبات.
3. مخالفة النفس
يتأسس مبدأ المخالفة في تربية النفس وتزكيتها على الاعتقاد بأن النفس نزاعة إلى مخالفة أوامر ربها والخروج على قواعد الفضل والخلق الكريم. قال تعالى: (وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء) (يوسف: 53). قال الجنيد (توفي 297ﻫ): “النفس الأمارة بالسوء هي الداعية إلى المهالك المعينة للأعداء، المتبعة للهوى، المتهمة بأصناف الأسواء”[31].
فالنفس دائما موضع تهمة، فيما تحب وتكره، بحيث إن مضادتها في ذلك كله، هو المنهج الأقوم لمجاهدتها، وتحقيق صلاحها واستقامتها.
وهذا ما أكده أحمد بن عطاء الروذباري (ت 369ﻫ) قوله: “النفس مجبولة على سوء الأدب، والعبد مأمور على ملازمة الأدب، فالنفس تجري بطبعها في ميدان المخالفة، والعبد يردها بجهده عن سوء المطالبة، فمن أطلق عنانها فهو شريكها معها في فسادها”[32]. فساحة الابتلاء الواسعة، هي النفس الإنسانية بشهواتها العاتية وأهوائها الخفية ونزواتها المنحطة، إنها المجال الأساس للاجتهاد والمجاهدة أما ما يوجد خارجها من مصادر المتع والملذات، فإنها لا تكون فتنا إلا تبعا لانحراف النفس وقلة رشدها.
ومن ثم فلا مناص لمن رام تهذيب نفسه وتحسين أخلاقها، من ملازمة المخالفة لها، فيما تقبل عليه أو تحجم عنه. قال ذو النون المصري (ت 245م): “لا تصحب مع الله تعالى إلا بالموافقة، ولا مع الخلق إلا بالمناصحة، ولا مع النفس إلا بالمخالفة، ولا مع الشيطان إلا بالعداوة”[33]. ونقل عن إبراهيم بن أدهم (ت 161ﻫ) أنه قال: “لن ينال الرجل درجة الصالحين حتى يجتاز ست عقبات أولها: أن يغلق باب النعمة ويفتح باب الشدة، والثاني: أن يغلق باب العز ويفتح باب الذل، والثالث: أن يغلق باب الراحة ويفتح باب الجهد، والرابع: أن يغلق باب النوم ويفتح باب السهر، والخامس: أن يغلق باب الغنى ويفتح باب الفقر، والسادس: أن يغلق باب الأمل ويفتح باب الاستعداد للموت”[34].
فهذا الكلام الحكيم فضلا عن كونه يقوم على نهج المخالفة، فإنه أكثر من ذلك يغلق على النفس أبواب الانغماس في المتاع الدنيوي، ويفتح لها أبواب المجاهدة النفسية التي يلجها السائرون على درب الآخرة، القائمون على حدود الله.
فاعتماد نهج مضادة النفس في السلوك العام، وعندما ينبهم الصواب وتختل مقاييسه الشرعية، يجنب المكلف الزيغ والغواية كما أنه المسلك القويم والوسيلة الفعالة لتغيير ما اعوج من السلوك وانحرف من الأخلاق. “وكما أن العلة المغيرة لاعتدال البدن الموجبة للمرض لا تعالج إلا بضدها، فإن كانت من حرارة فبالبرودة، وإن كانت من برودة فبالحرارة، فكذلك الرذيلة التي هي مرض القلب، علاجها بضدها. فيعالج مرض الجهل بالتعليم، ومرض البخل بالتسخي، ومرض الكبر بالتواضع، ومرض الشره بالكف عن المشتهى تكلفا… وليس غرضنا ذكر دواء كل مرض… وإنما غرضنا الآن التنبيه على أن الطريق الكلي فيه سلوك المضادة لكل ما تهواه النفس وتميل إليه، وقد جمع الله ذلك في كتابه العزيز في كلمة واحدة فقال (وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى)[35].
وتطبيق هذا المنهج يتطلب دوام المراقبة وحسن اليقظة، حتى يتأتى التفريق بين نداء الفطرة المحمود، ونزعات الشيطان وتسويلات النفس المذمومة.
كما يحتاج إلى العلم بالشرع ومقاصده العامة، وصدق التوجه إلى الله، واستنزال هدايته وتوفيقه. وإذا أحكمت هذه الأسباب وتيسرت، أمكن انتهاج طريقة المضادة في كل خطرة وعند كل خطوة. ولقد كان بشر بن الحارث الحافي (ت 227ﻫ) يقول محيلا على هذا المنهج التربوي: “إذا أعجبك الكلام فاصمت، وإذا أعجبك الصمت فتكلم”[36]. بل إن انتهاجه قد يسري على ما أنجز من الأعمال وفرع منه، إذا شابه فساد من جهة القصد، أو من جهة موافقة الشرع، وذلك عن طريق التوبة النصوح، التي تعني مخالفة توجه النفس الراهن لتوجهها السابق، بخصوص عمل محدد أو سلوك عام.
4. إتقاء حظوظ النفس
تتجه أحكام الإسلام وشريعته إلى تحقيق إسلام القلب لله، وتحرير النفس من أهوائها وتطويع مراداتها، لتكون طاعة وامتثالا واستسلاما تاما لله، وربط حركة الإنسان في كل اتجاهاتها على الأرض، إلى إفراد الله بالعبودية الحقة، التي لا يكون معها حظ النفس، تشذ به عن دائرة العبادة الواجبة للخالق سبحانه.
فعلى المكلف أن يراقب نواياه، ويتفحص اختلاجات نفسه عند الإقدام على كل عمل يقصد به وجه الله تعالى، حذرا من أن ينحرف قصده إلى حظ من حظوظ النفس، فيرد عليه عمله، ويكون من الخاسرين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “قال الله تبارك وتعالى: “أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه”[37]. قال النووي: “والمراد أن عمل المرائي باطل ولا ثواب فيه ويأثم به”[38].
وحظوظ النفس “لا يعرفها إلا المعتنون بمعرفة الله ومراده، وحقه على عبده، ومعرفة نفوسهم وأعمالهم وآفاتها. ورب مطالب عالية لقوم من العباد، هي حظوظ لقوم آخرين يستغفرون الله منها، ويفرون إليه منها، ويرونها حائلة بينهم وبين مطلوبهم”[39].
ويبدو أن خير ما يستعان به على الوعي بحظوظ النفس وتخليص الإرادات والأعمال منها، هو اتهام النفس في كل حال حتى تثبت براءتها من انحراف القصد عن ابتغاء الله وطلب رضاه. ولقد أشار الإمام الشاطبي إلى أن عباد هذه الأمة، أخذوا أنفسهم بتخليص الأعمال عن شوائب الحظوظ، حتى عدوا ميل النفوس إلى بعض الأعمال الصالحة من جملة مكائدها، وأسسوها قاعدة بنوا عليها في تعارض الأعمال وتقديم بعضها على بعض، أن يقدموا ما لا حظ للنفس فيه أو ما ثقل عليها، حتى لا يكون لهم عمل إلا على مخالفة ميل النفس، وهم الحجة فيما انتحلوا لأن إجماعهم إجماع”[40].
فتدخل حظوظ النفس في العمل يفرغه من مضمونه الأخلاقي الرفيع ويحيله إلى مظهر كاذب يورث في النفس النفاق ويجعل أخلاقها زائغة مفتقرة إلى الصدق النفسي.
وهذا حال يعاني منه الإنسان دائما. فهذا أحد علماء الغرب إريك فروم Erich Fromm (1900–1979) يقول: “ولكن ثمة جوانب لا تقل أهمية في معنى الكينونة يمكن الكشف عنها بمقابلتها بالمظهرية. فإذا ظهرت للآخرين بمظهر العطف، ولم يكن عطفي إلا قناعا أخفي به استغلاليتي، أو إذا ظهرت بمظهر الشجاعة، بينما لست إلا شخصا شديد الغرور، أو ربما لدي نزوع انتحاري، أو إذا ظهرت بمظهر المحب لبلدي بينما أسعى لتحقيق مصالح شخصية، فإن هذا المظهر أي هذا السلوك المعلن، يتعارض تعارضا تاما مع حقيقة الدوافع التي تحركني، وسلوكي يختلف عن شخصيتي، ولكن يناء الشخصية، أي الدوافع الحقيقية للسلوك هي التي تشكل الكينونة الحقيقية للإنسان”[41].
وعلى قدر يقظة النفس واستشعارها العميق لحق العبودية لله عليها، يكون تدرجها في اتقاء حظوظ النفس حتى يغدو أمرها كله خالصا لله من شوائب الأغراض ولو تأت الأهواء، مجردا عما سوى الطاعة المحضة. فصاحب هذا التجريد “لا يقنع من الله بأمر يسكن إليه دون الله، ولا يفرح بما حصل له دون الله، ولا يأسى على ما فاته سوى الله، ولا يستغني برتبة شريفة، وإن عظمت عنده أو عند الناس. فلا يستغني إلا بالله، ولا يفتقر إلا إلى الله، ولا يفرح إلا بموافقته لمرضاة الله. ولا يحزن إلا على ما فاته من الله… فكله بالله، وكله لله، وكله مع الله وسيره دائما إلى الله”[42].
الهوامش
1. إحياء علوم الدين، دار إحياء الكتب العربية، مكتبة عيسى البابي الحلبي وشركائه، مصر، د، ت، ج، 3 ص: 52.
2. المرجع نفسه.
3. دستور الأخلاق في القرءان، تعريب الدكتور عبد الصبور شاهين، مراجعة السيد محمد بدوي، مؤسسة الرسالة، دار البحوث العلمية، بيروت، ط، 3، 1980م ص650.
4. المرجع نفسه، ص181.
5. المرجع نفسه.
6. المرجع نفسه ص182.
7. المرجع نفسه، ص183–184.
8. أورد مالك في الموطأ حديثا في هذا المعنى أن معاذ بن جبل قال: آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغرز أن قال أحسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل، كتاب حسن الخلق باب ما جاء في حسن الخلق.
9. إحياء علوم الدين، م، س، ص: 54.
10. المرجع نفسه.
11. المرجع نفسه، ص58–59.
12. مدارج السالكين، بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، تحقيق محمد حامد الفقي، الدار البيضاء: دار الرشاد الحديثة، د، ت، ج 3 ص265.
13. المرجع السابق، ج 3 ص58–59.
14. أخرجه الديلمي في مسند الفردوس، صحيح عن طريق أم سلمة، ذكره السيوطي في الجامع الصغير ج 1 ص17.
15. عبد اللطيف الفارابي وآخرون، معجم علوم التربية، مطبعة النجاح الجديدة، ط 1، 1994 ص95.
16. قاموس الفلاسفة، سلسلة قواميس العلوم الإنسانية 1، جمال هاشم، دار الخطابي، ط 1، 1991 ص80.
17. اتجاهات معاصرة في التربية الأخلاقية، الدكتور ماجد عرسان الكيلاني، دار البشير، ط1، (سنة 1412ﻫ/1992م)، ص17.
18. المرجع نفسه، ص54.
19. علال الفاسي، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، مؤسسة علال الفاسي، ط 4، 1991م، ص11.
20. جامع الترمذي، صفة القيامة، باب 25 وقال حديث حسن.
21. الحارث بن أسد المحاسبي، الرعاية لحقوق الله، تحقيق: عبد القادر أحمد عطا، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، سنة 1990م، ص95.
22. المرجع نفسه ص49.
23. مختصر منهاج القاصدين، ابن قدامة المقدسي، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، ط 4، 1394ﻫ، ص400.
24. الآية الوحيدة التي يبدو أنها خلاف ذلك هي قوله تعالى: (وجاء المعذبون من الأعراب ليوذن لهم) (التوبة: 90)، ومع ذلك فقد تضمنت التفاسير عدة أقوال تلحقها هي أيضا بنسق غيرها.
25. عبد الكريم القشيري، الرسالة القشيرية، تحقيق وإعداد معروف زريق، علي عبد الحميد بلطجي، دار الجيل، بيروت، ط 2، 1990م، ص 226–227.
26. مدارج السالكين، م، س، ج 1، ص523.
27. الرسالة القشيرية، م، س، ص 242.
28. المرجع نفسه.
29. المرجع نفسه، ص: 245.
30. المرجع نفسه.
31. المرجع نفسه، ص152.
32. المرجع نفسه، ص150.
33. المرجع نفسه، ص296.
34. المرجع نفسه، ص98–99.
35. انظر إحياء علوم الدين، م، س، ج 3 ص: 59–60.
36. المرجع السابق، ص: 121 يقول الشيخ البصيري: “وخالف النفس والشيطان واعصبهما”.
37. صحيح مسلم، الزهد، باب تحريم الرياء.
38. صحيح مسلم، بشرح النووي، مرجع مذكور، ج 18 ص: 116.
39. مدارج السالكين، م، س، ج 1 ص473–474.
40. الموافقات، تعليق محمد الخضر حسين التولسي، دار الفكر، د. ت، ج 1، ص134.
41. إريك فروم، الإنسان بين الجوهر والمظهر، ترجمة سعد زهران، مراجعة وتقديم: لطفي فطيم، سلسلة عالم المعرفة، العدد 140، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، (1409ﻫ/1989م) ، ص102.
42. مدارج السالكين، م، س، ج 1، ص474.