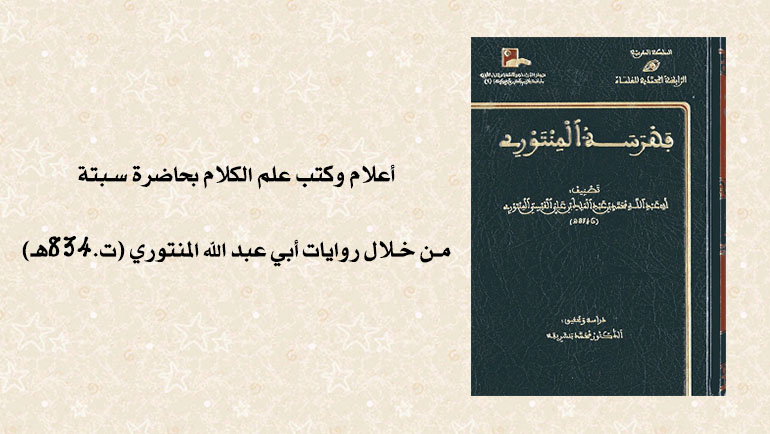من المعلوم أن العلم أعظم ما يمتاز به العالم الغربي والحضارة المعاصرة؛ فلقد فرض الغرب نفسه على كل العالم، وعلى كل الحضارات الأخرى، كقوة مادية وفكرية لا يمكن الاستهانة بها أو إنكارها، بفضل علومه؛ “ففيه حدثت الاكتشافات التقنية الكبرى التي غيرت وجه العالم: الطاقة البخارية، الطاقة الكهربائية، ووسائل المواصلات المختلفة: الدراجة النارية، السيارة، القطار، الطائرة، أدوات التواصل المختلفة، الهاتف، التلغراف، الإذاعة، التلفزة، الأقمار الاصطناعية، الإنترنت… وهو الذي حقق معجزة النزول على سطح القمر وارتياد الكواكب الأخرى، هذا ناهيك عن إنجازاته العسكرية الباهرة، وإنجازاته في مجال الطب والبيولوجيا وكذا إنجازاته في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية…”[1].
أمام هذه الحقيقة، يواجهنا السؤال التالي: ما الذي يمكن أن يقدمه الإسلام لحضارة الغرب، وهي حضارة علمية، لولاه ما بزغ نورها، أساسا؟ هل من نظام معرفي قرآني؟ وما هي معالم هذا النظام؟ وكيف يسهم النظام المعرفي القرآني في تقويم اعوجاج النظام المعرفي الغربي؟
الحق أن محاولة الإجابة عن هذه الأسئلة تعتبر محاولة تأسيسية وخطرة في آن واحد، أما تأسيسيتها فترجع إلى أنها محاولة لبناء منهج علمي متكامل الأبعاد انطلاقا من النص القرآني، وهو النص المركزي الأكبر في الثقافة العربية الإسلامية. وأما خطرها فينبع من كونها مبادرة نحو ربط الدلالة القرآنية بالدلالة الكونية الشاملة في تعبيرها، وفقا لمنظور كثير من العلماء المجتهدين، عن قوانين الله، سبحانه وتعالى، في خلقه، وعن غاية الله سبحانه من إيجاده الوجود على النحو الذي وجد به تحديدا، وبالتالي عن وجوب صدور الفعل الإنساني عن فاعله، وهو الإنسان، ممثلا لطبيعة القانون والغاية، وإلا صار انحرافا عن مسؤولية الحفاظ على تناغم العالم في معزوفة الخلق.
ولذلك فإننا نستحسن التريث قليلا عند هذه الأسئلة، مقترحين تبين خصائص الإطار النظري الغربي الذي حكم نشأة وتطور علوم الغرب أولا. ونشير إلى أن العلوم في الغرب “قد نشأت في خضوع تام لتصورات الغرب عن الإله والإنسان والحياة والطبيعة، ولتجربته مع الدين ولمسار علاقته ببقية المجتمعات الإنسانية وفي مقدمتها المجتمع العربي والإسلامي. ويمكن تحديد أهم خصائص هذا الإطار النظري الغربي في:
1. الدنيوية؛ أي القطع مع الغيب، واعتبار الحياة الراهنة هي الوجود الحق والأهم للإنسان، ومن تم فهي فرصته الأولى والأخيرة للاستمتاع بأكثر قدر ممكن من الملذات والمتع.
2. تأليه العقل أو العقلانية المفرطة؛ أي الإيمان بالقدرة المطلقة لعقل الإنسان على تحصيل المعرفة وإدراك كنه الأشياء والظواهر.
3. البرغماتية المطلقة؛ ونقصد بها هنا انفصال الأخلاق عن مجالات استخدام العلوم وتطبيقاتها: أي عدم التقيد بالمعايير الأخلاقية عند تحديد مجالات تطبيق العلوم”[2].
ونستطيع التعبير، بإجمال، عن الخلفية العقائدية المشتركة بين فروع المعرفة والثقافة الغربية، بقولنا: “الوجود كله منحصر في الإنسان والطبيعة وهو جزء منها ونوع من أنواعها والطبيعة وجدت هكذا بنفسها وكذلك سننها أو قوانينها فهي مقدرة بنفسها من غير مقدر لها، والعقل وحده طريق معرفة الحقائق وليس ثمة طريق آخر، وليس المثل الأخلاقية والقيم والمفاهيم الحقوقية إلا وقائع أو حوادث كالحوادث الطبيعية نشأت وتطورت، فهي ليست ثابتة، والإنسان نفسه إنما هو حيوان اجتماعي مفكر فحسب، وليست النفس الإنسانية إلا مجموعة من الغرائز”[3].
وكنتيجة لهذه الفلسفة التي تؤطر العلوم في الغرب، ارتهن العلم عنده بما هو مادي، وبما هو واقع في التجربة الحسية[4]، فمهما تكن النظرية العلمية ومهما يكن موضوعها، فما لم تكن قابلة للرد إلى ما هو واقع في التجربة الحسية، تجردت من عمليتها وأصبحت لغوا… وكنتيجة لذلك، فقد عمل العلم في الغرب على التخلص من النظريات العلمية التي لم تكن قائمة على أساس ملاحظات وتجارب دقيقة، عن طريق تحرير العقل من قيوده المتمثلة في الأنساق المنطقية أو الأفكار الفلسفية القديمة.
ولعل أوجست كونت، أبلغ من عبر عن هذا التوجه بقوله: “إن العلوم الوضعية التي يجب أن تحتكر وتستأثر بدراسة الظواهر كافة، الطبيعية والعقلية والاجتماعية بمناهج تجريبية محضة هي وحدها الجديرة بأن تسمى علوما، وعلى نحو مقابل، فإن الفلسفة لا تعدو أن تكون تأملات مجردة، أما الدين فخرافة وشعوذة”[5].
وقبل أوجست كونت أكد “ديفيد هيوم” المنهج الوضعي التجريبي نقيضا للدين والفلسفة فقال: “إذا أخذنا بين أيدينا كتابا في اللاهوت (الدين) أو الميتافيزيقيا (الفلسفة) الموجهة إلى الطلاب فلنتساءل: هل يشتمل على أي استدلال بخصوص الكم والعـدد (الرياضيات)؟ لا هل يشتمل على أي استقراء تجريبي بخصوص الوقائع والوجود؟ لا إذن ألق به إلى الجحيم”[6].
وجاء “فرويد” من بعد هؤلاء يكرس المنهج الوضعي في مجال الدراسات النفسية، ليعلن أن العلم لا يمكن له أن يتعايش أو يتسامح مع الدين والفلسفة، مؤكدا أنه لا مصدر لمعرفة الكون سوى الملاحظة العلمية الدقيقة، وأنه لا يمكن أن نستقي أية معرفة معتبرة من الوحي أو الإلهام فيقول: “… إن الدين هو أشد الأخطار التي تهدد سلطان المعرفة العلمية وحدودها، لما للدين من أثر فعال في المجتمع”[7].
وبهذا تخلص العلم في الغرب من كل جانب روحي ومعنوي في الإنسان والكون برمته، فارتبطت نتائج العلم وثمراته بأسبابها الفاعلة مقدمات وعللا، وألغت الجانب الغائي والمقاصدي والقيمي بدعوى أنه “لا علم إلا بالبرهنة والتجريب”[8].
فحلت النزعة العلمية المعتمدة على العقل البشري محل الدين، فتم فصل العلم “عن المبادئ والقيم الدينية وعدم الاعتراف بصلاحية الدين، أي دين لتوجيه العملية التعليمية وإرشادها، وذلك انطلاقا من المبدأ المعكوس الذي يفترض وجود صراع مرير بين الديني والعلمي، وبالتالي لا يمكن أن يجتمعا في شيء واحد في آن واحد، فذكر الديني في البحث العلمي، إفساد للروح العلمية ومدعاة إلى طرح جميع النتائج التي توصل إليها، لذلك فإنه لابد من إقصاء الديني عن العلمي، ولا حاجة إلى التعرض للقيم التي ينبغي ترسيخها في عقول النشء قبل أن يكبروا”[9].
و”فصل الأخلاق على هذا النحو، هو فصل مقبول كل القبول في مجال العلم… إنه من المتعذر وجود… أخلاق علمية”[10]. ويجد هذا الفصل مبرره في نظر علماء الغرب تحت حجة أن العلم يهدف إلى السيطرة والتحكم في الطبيعة، وتحقيق سيادة الإنسان عليها. وهذا هدف إن أخذ بما هو أخلاقي لن يتحقق، فكان بذلك ضرورة الفصل بين العلم والأخلاق، والاعتراف فقط بما يحقق النفع الموصل إلى تحقيق الهدف المنشود.
بناء عليه فالإطار الإبستيمولوجي للعلم في الغرب، بني في جملته على الأساس المادي الذي لا يعترف إلا بما هو قابل للبرهنة والتجربة، كما لا يعترف بتأثير الأخلاق في العلم ولا في التقنية”[11].
وقد حقق العلم “الغربي” نتيجة لذلك نتائج باهرة على المستوى المادي، أفادت الإنسانية، وحلت معضلات بشرية كانت من قبيل المستحيلات… نجاح الغرب العلمي وتفوقه فيه… أدى بالغرب إلى الاعتداد بالعلم في صفته المادية، والاغترار بقدراته على اخترق المجهول وتحطيم الحواجز… ليصحب البعد المعرفي في العلم الغربي بعد الهيمنة والسيطرة؛ “فالعلم القاعدة التحتية لقوة الغرب قد ارتبط منذ البداية بالسيطرة، داخليا وخارجيا، كما تعبر عن ذلك قولة “بيكون” العلم قوة أو قدرة “Savoir c’est pouvoir”[12]. بعد الهيمنة والسيطرة دفع الغرب إلى توجيه العلم نحو مسار تحفه الأخطار والأهوال من كل جانب… لما أصبح العلم يشكله من خطر على البشرية جمعاء نتيجة تحويله للإنسان إلى رخاء لا قيمة له.
ولعل أبرز الميادين العلمية، التي تدل على خطورة المأزق الذي وصل إليه العلم في الغرب:
ـ ميدان العلوم البيولوجية وخاصة موضوعة الاستنساخ التي حولت الإنسان إلى مجرد سلعة خاضعة للعرض والطلب تسري عليها أهواء العلماء وتتحكم فيها مختبراتهم، الأمر الذي جعل نتائج البحث العلمي تستعمل لأغراض مادية وسياسية صرفة وليست إنسانية…
ـ ميدان العلوم العسكرية، وما يرتبط بها من صناعة للأسلحة الفتاكة، كالأسلحة النووية، والقنابل الذرية والهيدروجينية… التي تهدد حياة الإنسان، والكوكب الذي يعيش فيه.
ينضاف إلى هذه الأخطار، الفشل الذريع في معالجة المشكلات الاجتماعية الجديدة والمتفاقمة التي تمر بها المجتمعات الصناعية وما بعد الصناعية. “فمع كل ما حققه العلم، إلا أنه لا يستطيع أن يحقق كل شيء للإنسان ولا يمكن أن يعوض الإنسان عن القيم والأخلاق، وليس هناك ما يعوض الإنسان عن القيم والأخلاق إلا القيم والأخلاق نفسها. وأكبر خطأ كان له أكبر ضرر، حينما وضع الغرب، العلم في نزاع مع القيم أو الدين، لأن العلم لا يكون بديلا عن الدين والقيم، ولا القيم يمكن أن تكون بديلا عن العلم، وليس بينهما أي تضاد أو تناقض… فالخطأ في الفكر والفلسفة التي لم تستطع أن توازن ما بين العلم والقيم وما بينهما من تكامل، وحاولت أن تعالج هذه الإشكالية بمنظار الحداثة بالفصل بينهما، بين حقبتين زمنيتين، حقبة سابقة، وحقبة لاحقة، وبينهما صراع القديم والجديد، فكان من المؤكد أن يكون الانتصار للجديد الذي يفترض فيه أن يلغي القديم ولا يتوافق معه.
وكان لهذا الصدام أثره الخطير على انهيار القيم وانحسارها داخل المجتمعات الغربية. فقد أثرت بطريقة سلبية على نظرة الفرد إلى ذاته وعلاقاته بالناس والمجتمع من حوله، كما أثرت على واقع الأسرة والروابط العائلية، وبدأنا نلمس الشعور المتزايد بالقلق في الغرب من جراء تراجع القيم”[13].
يقول العالم الإسباني فيلاسبازا: “إن جميع اكتشافات الغرب العجيبة ليست جديرة بكفكفة دمعة واحدة ولا خلق ابتسامة واحدة”[14] للإنسان الغربي الذي يعيش حالة من الكآبة والقلق والحيرة مما يدفع به إلى وضع حد نهائي، مأساوي، لحياته عن طريق الانتحار.
ويعزو روزاك انتشار الاغتراب في الحياة المعاصرة إلى النزعة العلمية، التي وضع أسسها: ديفيد هيوم، وأوكست كونت وفرويد… وغيرهم، إذ يقول: “بينما تشير الآداب والفنون في يومنا الحاضر، في يأس متزايد، إلى أن المرض الذي سيؤدي إلى وفاة عصرنا الحالي هو الاغتراب… نجد العلوم في دأبها الدائم لتحقيق الموضوعية ترفع الاغتراب إلى أعلى درجات الأهمية. وكأنه السبيل الوحيد لتحقيق علاقة صادقة مع الحقيقة، ويصبح الضمير الموضوعي بمثابة حياة اغتراب، وصلت إلى أعلى مستوياتها من التقدير وسميت “بالطريقة العلمية”، وتحت لواء هذه الطريقة، تخضع الطبيعة لإرادتنا، وذلك بالابتعاد عن أنفسنا، وبشكل متزايد، عن خبراتنا الذاتية حتى تصبح الحقيقة في النهاية عالما من الاغتراب المتحجر”[15].
لقد لاحظ علماء اجتماع كثيرون أن العلم التجريبي الذي يرفض الدين كمصدر للمعرفة العلمية، سيستهزئ بالمعاني الذاتية، ويسخر من بحث الإنسان عن المعنى والغاية وراء الظواهر الكونية والقوانين الطبيعية. ونورد، هاهنا، استشهادا لواحد منهم:
كتب هولبروك يقول: “لم تنتج دراساتنا، إلى اليوم، للإنسان شيئا يذكر، بل هي في حكم العدم، وذلك لخضوعها لحركة الوضعية أي لمدخل الدراسة الذي يقول: بأنه لا يمكن اعتبار أي شيء حقيقة إذا لم نستطع إثباته بالعلم التطبيقي وباتباع الطريقة المنطقية؛ أي بموضوعية.
وحيث إن مشكلة دراسة الإنسان تنتمي إلى الحقائق النفسية، وإلى عالم الإنسان الداخلي، وظروفه المعنوية والخلقية وحياته الذاتية، فلابد أن نعترف بإفلاس الوضعية، وفشل الموضوعية في إعطائنا حسابا دقيقا عن وجود الإنسان، ولابد كذلك من أن نعمل على إيجاد طرق أخرى للبحث والاستقصاء”[16].
وفي نفس الاتجاه يسير ألكسيس كاريل؛ إذ يصرح في كتابه: “الإنسان ذلك المجهول” الذي تزداد قيمته الأخلاقية والعملية كلما ازدادت البشرية مكابدة وتلظيا بويلات تسلط الحضارة المادية الصناعية على الوجود… يقول كاريل: “… إن الحضارة العصرية لا تلائم الإنسان كإنسان… وعلى الرغم من أنها أنشئت بمجهوداتنا إلا أنها غير صالحة… إننا قوم تعساء لأننا ننحط أخلاقيا وعقليا… إن الجماعات والأمم التي بلغت فيها الحضارة ذروة النمو والتقدم، هي الآخذة في الضعف، والتي ستكون عودتها إلى الهمجية والوحشية أسرع من سواها… إن العلم والتكنولوجيا ليسا مسؤولين عن حالة الإنسان الراهنة، وإنما نحن المسؤولون، لأننا لم نميز بين الممنوع والمشروع… يجب علينا أن نعيد إنشاء الإنسان من جديد في تمام شخصيته، الإنسان الذي أضعفته الحياة العصرية ومقاييسها”[17].
وهكذا نرى أن الإنسانية جمعاء تتطلع إلى مناهج معرفية جديدة بديلة عن المناهج المعرفية الغربية، تمكن من معالجة الإنسان كإنسان آدمي، له خصوصياته التي تميزه عن الطبيعة، والمخلوقات الأخرى… وإنه ليس غير النظام المعرفي القرآني نظاما قادرا على إعادة الاعتبار للإنسان كإنسان، وإنقاذه من حياة الاغتراب واللامعنى إلى حياة الغائية والقصدية.
القرآن ومنهجيته المعرفية البديلة
يحتل هذا الاستنتاج، أو بالأحرى التفكير النظري النقدي حول المعرفة، مكانة مركزية ضمن المتن الفكري لكل من محمد أبي القاسم الحاج حمد وطه جابر العلواني.
يؤسس أبو القاسم مقاربته لإشكالية المنهجية المعرفية بنقده للنظريات المعرفية السائدة في الحضارة الغربية معتبرا “أن المنهاج العلمي لحياة البشر أو الذي كرست الحضارة الأوروبية تطبيقه حياتيا، قد أدى ويؤدي وسيؤدي إلى نتائج وخيمة أقلها انسحاق الإنسان في عالم الأشياء وارتباطه بالجبرية المادية. وتحوله إلى كائن بلا تاريخ وبلا حاضر وبلا مستقبل، كائنا مستلبا ومنفعلا”[18]. مؤكدا أن “العالم قد دخل في مأزق فكري وحضاري بما فيها الحضارة الغربية نفسها؛ فبعد تكريس البعد المنهجي في التفكير واجهت الحضارة الغربية، قبل غيرها، مشكلة تحديد الصياغة المنهجية لحضارتها ومعرفتها. توقفت ولا زالت متوقفة بقلق شديد أمام نهايات فلسفة العلوم الطبيعية والتي لا تؤدي ضمن مساقات الفكر الأوروبي إلا إلى نهايات مادية ولو حاول الوضعانيون الانتقائيون التفلت من هذه النهايات، فالمادية الجدلية والتطورية والنسبية والفرودية وما انبنى على كل ذلك من دراسات متقدمة وحتى ناقدة، ولكن في نفس الإطار، لا تنفك عن كونها البناء الفوقي للحضارة الغربية المستمدة من فلسفة العلوم الطبيعية، وليس لدى الحضارة الغربية ما تضبط به هذه النهايات المنهجية، إلا المحاولات الوضعية الانتقائية أو المواعظ الأخلاقية، أو القلق الذي تعبر عنه الوجودية. فالحضارة الغربية تعيش قمة مأزقها؛ إذ ليس لديها التصور المنهجي والمعرفي البديل للكون”[19].
ويخلص حاج حمد من تحليله العميق لبنية الحضارة الأوربية إلى أنها “حضارة اتحاد بالطبيعة ضمن الشكل التحليلي والتركيبي للظاهرة، والتحول بالإنسان من معناه الخلقي إلى معناه الطبيعي ككائن طبيعي، والتحول بالكون من معناه الإنساني إلى معناه المادي المجرد؛ إذ تتلاشى قيم التسخير والعمران، ومقابلاتها الأخلاقية في عالم المثل، ويحل بديلا عنها إنسان المطلق والقوة عبر شروط البقاء والاستمرار المادي؛ أي عبر المثل الطبيعية القائمة على فلسفة البقاء بالقوة، وفلسفات اللذة والمنفعة”[20].
والواقع أن العلواني لا يختلف كثيرا عن أبي القاسم في نقده للحضارة الغربية، كاشفا أن الحضارة الغربية لازالت أسيرة التقدم التكنولوجي، وهي نتيجة ذلك “تعاني تدهورا اجتماعيا وحضاريا وقيميا بشكل متواصل، فالرقي التقني لم يؤد إلى رقي إنساني بل قابله ولا يزال يقابله انهيار إنساني. ولم تستطع الحضارة الغربية، حتى الآن، حل هذا الذي يبدو لها وكأنه لغز حضاري؛ فالتقدم الحضاري كان يجب أن يكون أفقيا ومتصاعدا، وبذات الوقت يفترض أن يتطور الإنسان بموجبه قيميا وأخلاقيا كما تتطور تقنيته بقدر حاجته إلى ذلك التطور. غير أن الذي يحدث في الحضارة الغربية هو العكس تماما العلوم تتقدم والإنسان ينهار، وقيمه تتلاشى وعذابه واستلابه ومآسيه تتزايد”[21]. ولأن إشكالية المنهجية المعرفية لابد أن تتجاوز أساسا بمنهج مطلق، فإن اهتماما مضاعفا بنقد سياقات المنهج الغربي المعاصر كان لابد أن يجد سعته من البسط والتفسير والتحليل في مختلف أبحاث ودراسات العلواني، وأهم هذه الانتقادات ما أثاره عن العقل الفطري والعقل الوضعي أو عن ملابسات التطور والتحكم في العلوم الطبيعية والرياضية، أو عن طبيعة التفكير والعقل والانحياز المادي[22]، كما أنه وجه نقدا مهما لأزمة الانحراف في تسخير العلم والمعرفة، وأزمة المنهج العلمي التجريبي[23].
يظهر من خلال تتبع المتن الفكري لكل من أبي القاسم والعلواني أن مجهودهما لم يقف عند حدود التقاط عناصر الانسداد الفلسفي والوجودي الذي تعيشه الحضارة الغربية، ومنهجيتها المعرفية، بل حاولا تقديم بديل حضاري، يتجاوز التأويل الفلسفي للعلم الذي كرسته الحضارة الغربية، وجنة الجحيم التي اندحر إليها الوجود الشخصي للإنسان الأوروبي.
هذا البديل يشكل القرآن الكريم جوهره ومنطلقه[24]؛ إذ يشتركان، معا، في اعتبار القرآن الكريم “وحده يملك التصور المنهجي والمعرفي البديل على مستوى كوني”[25]، وهو “وحده الكتاب الكوني الذي يستطيع أن يستوعب المنهجية العلمية، ويقوم بتنقيتها وترقيتها، ووضعها باتجاه “المنهجية الكونية”، وهو وحده الذي يستوعب المنهج العلمي ويستطيع أن يقوم بتنقيته وترقيته وإخراجه من أزمته، ويحميه من تهديدات ومخاطر النسبية والاحتمالية والنهايات”[26].
أكثر من ذلك، فالعلواني يعتبر “أن منهجية القرآن هي حل لـ”إشكاليات العلم المعاصر” نفسه وترقية لبحوثه المنهجية، وجعلها قادرة على أن تنتج فهما كونيا جديدا لفلسفة العلوم الطبيعية، فهما يرتبط من خلال العلم بعقيدة التوحيد حيث يتأهل ويتضح معنى الآية: “إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ” (فاطر: 28)[27]. إذ “لا تقتصر منهجية القرآن على دراسة الظواهر الطبيعية التي تستمد مؤشراتها الكونية من القرآن، إنما تمضي لتمد نطاق البحث إلى الظواهر الإنسانية التي تتفاعل مع الظواهر الطبيعية.
فإذا كان العلم المعاصر يتفادى البحث في هذا الإطار الكوني أو يتفادى البحث في الظواهر المعقدة، فإن مهمة “منهجية القرآن” من خلال جهود العلماء والباحثين المسلمين الواعين بها كسر هذا الحاجز. وبهذا تصل إلى البشرية بالطريق العلمي في دائرة النسق الحضاري، فهذا الدين قائم على كتاب منهجي مطلق، ودعوة شاملة”[28].
كما جرى التنويه، فإن أبا القاسم والعلواني، لم يقفا عند مستوى النقد المنهجي للحضارة الغربية، وإنما تجاوزاه إلى محاولة بلورة منظور منهجي معرفي بديل يشتركان في العديد من مبادئه، ولو أن قدرة وملكة التنظير عند أبي القاسم تبدو أنضج وأعمق من نظيرتها عند العلواني.
لقد أفضى نقد أبي القاسم لواقع الحضارة المعاصرة، وكذا نقده للمناهج المعرفية الغربية إلى بلورة منهجية معرفية إنسانية استنباطا من المنهجية المعرفية القرآنية، وقد أفرد أبو القاسم للكشف عن هذه المنهجية وتوضيح أبعادها ودراسة خصائص القرآن المنهجية والمعرفية كتابا بأكمله بعنوان: “منهجية القرآن المعرفية: أسلمة فلسفة العلوم الطبيعية والإنسانية”[29]، أما عن المبادئ التطبيقية لهذه المنهجية فقد حددها أبو القاسم في ستة:
المبدأ الأول: منهجية المعرفة الوظيفية؛ عدم الفصل بين مناهج العلوم الطبيعية ومناهج العلوم الإنسانية والاجتماعية.
المبدأ الثاني: المعرفة الوظيفية وليست النسبية في المنهج القرآني؛ ويعني التكوين الإنساني في الإطار الطبيعي الكوني ضمن قوانين التشيؤ الوظيفي المرتبطة بمنهجية الخلق.
وهما المبدآن الكفيلان بتجريد فلسفة العلوم الطبيعية وتطبيقاتها الاجتماعية والإنسانية عن نهاياتها المادية والوضعية الانتقائية ودراستها ضمن منهجيتها الطبيعية الوظيفية باعتبارها مصدر لقوانين ونظريات التشيؤ وليس الخلق[30].
المبدأ الثالث: العلاقة بين منهجية الخلق ومنهجية التشيؤ؛ وهو مبدأ نفهم من خلاله علاقة منهجية الخلق بمنهجية التشيؤ، فهي علاقة تدامجية وتكاملية، فحيث تكون منهجية التشيؤ قابلة للتحديد لارتباطها بالعلوم الطبيعية الوظيفية فإن منهجية الخلق تحتويها وتمضي بها إلى نقطة التلاشي..نقطة الانفجار[31].
المبدأ الرابع: منهجية الخلق والمعرفة الوظيفية (الصيرورة)؛ مبدأ لا يمكن من خلاله الفصل بين قوانين ونظريات العلوم الطبيعية والوظيفية في منهج التشيؤ عن أطر المعرفة الاجتماعية والإنسانية، فمنهجية الخلق متضمنة لمناهج المعرفة الإنسانية والاجتماعية في وحدتها مع مناهج العلوم الطبيعية الوظيفية والتي تفتح لنا آفاقا لمعرفة “علم الإنسان” وثقافاته المقارنة وفق المنظور الكوني لوحدة خصائص الإنسان بحكم وحدة خصائص التركيب[32].
المبدأ الخامس: التركيب الطبيعي للإنسان في علاقته بالزمن والصيرورة وإنتاج الأفكار؛ مبدأ يخلص من خلاله حاج حمد إلى القول أن فهم الإرادة الإلهية ضمن منهجية الخلق فهما يعزلها عن التشيؤ في قوانين الوجود والحركة الوظيفية إنما هو إسقاط للصيرورة، وحين تسقط الصيرورة التي شيأ الله بها الخلق، وأحاط بها التاريخ، تسقط علاقة الإنسان الموضوعية والعلمية والمنهجية مع الكون ومع نفسه فلا يعود قادرا على اكتشاف الكون، ولا على اكتشاف قوانينه الطبيعية والاجتماعية، معطلا، بذلك، قواه الإدراكية والنفسية المستمدة من ذات النسيج الطبيعي الكوني المتحول والمتحرك. فلا يكون بمقدوره اكتشاف قوانين الكون لإنجاز حضارة علمية توظف الطاقة، ولا فهم قوانين المعرفة وتطور الإنسان والمجتمعات، ولا فهم التاريخ والمتغيرات، ولا ثقافات الشعوب والقوانين الضابطة لها[33].
المبدأ السادس: الغائية الكونية المزدوجة؛ يشير من خلاله حاج حمد إلى أن المنهجية المعرفية القرآنية لا تأخذ بمبدأ الغائية الأحادية الساذجة، كما درجت الفلسفات اللاهوتية على استلاب الطبيعة والإنسان معا في سعيها لمعرفة توحيدية جاءت مشوهة في النهاية. ولكنها تأخذ بغائية مزدوجة أساسها الخلق والتشيؤ معا، مما يمكن من كشف المبادئ والقيم التي تبثها في الوجود غائية الخلق مع التشديد على أن القرآن هو المعادل بالوعي للوجود وحركته إذ لا يمكن ضبط مقولات المنهج دون الرجوع إلى القرآن والقدرة على استكشاف دلالات القضايا في ثناياه[34].
يدرك أبو القاسم حاج حمد أكثر من غيره أن مبادئه الستة تحتاج إلى تحديد نماذجي يرفع أي التباس أو غموض أو سوء فهم[35]. والواقع أننا سرعان ما نجد ضالتنا حينما نجد حاج حمد يقدم نماذج تطبيقية للبديل المنهجي القرآني، حيث عمد إلى طرح نماذج إرشادية تطبيقية في العلوم الإنسانية كالتاريخ والاجتماع والنفس.
إن النموذج المنهجي الذي يطرحه حاج حمد، لا يغفل عن اللحظة التاريخية التي يمر بها الإنسان العربي، ولكنه واثق من أن المرحلة هي مرحلة العالمية الثانية التي سيكشف فيها القرآن عن مكنونات المنهج الإلهي الكلي في الحركة والطبيعة والتاريخ البشري، وهي العملية التي ستحمل للإنسان كله البديل الحضاري الذي يرسي دعائم السلام كما هي حقائقه الكونية الإلهية والعلمية والفلسفية، بديلا عن فلسفة الصراع التي يغرق فيها العالم اليوم[36].
وينطلق العلواني من النتيجة ذاتها إذ يعتبر منهجية القرآن المعرفية “دعامة أساسية وضرورة معرفية وحضارية لا على المستوى الإسلامي وحده، بل على المستوى كله للخروج من المأزق المعرفي المعاصر والأزمة الفكرية العالمية المعاصرة[37]“[38].
ويعني العلواني بـ”منهجية القرآن المعرفية”: المنهج الذي يقدمه لنا القرآن المجيد في شكل محددات وسن قوانين يمكن استنباطها من استقراء آيات الكتاب الكريم تلاوة وتدبرا وترتيلا وتنزيلا وتفكرا وتعقلا وتذكرا، ثم التعامل مع هذه المحددات تعاملا يسمح لنا بأن نجعل منها محددات تصديق وهيمنة، وضبط لسائر خطواتنا المعرفية، ومنها: تصحيح مسار المنهج العلمي، وإخراج فلسفة العلوم الطبيعية والاجتماعية من مضايق النهايات التي تتوقف عندها الآن”[39].
ويأتي في مقدمة هذه المحددات: التوحيد، فالجمع بين القراءتين، ثم الوحدة البنائية للقرآن.
المحدد الأول: التوحيد محور الرؤية الكلية القرآنية؛ فالتوحيد عنده: “مدخل تفسيري ذو قابليات هائلة، وقدرات متنوعة لتفسير آلاف الظاهرات النفسية، والسلوكية، والنظمية، والمعرفية، في مختلف المستويات، والتفسير الذي يقدمه القرآن المجيد يؤدي إلى الفهم العميق لتلك الظاهرات، ويمكن من صياغة الأسئلة المعرفية، وتعليم الإنسان طرق الإجابة عنها، كما يمكنه من وضع المقدمات بأدق ما يستطيعه العقل البشري، وتجنيبه الخطأ؛ فتصبح عملية الوصول إلى النتيجة منضبطة تستوعب “التنبؤ المنهجي” وتتجاوزه..وبذلك أسس القرآن للعقلانية التوحيدية[40].
المحدد الثاني: الجمع بين القراءتين: قراءة الوحي وقراءة الكون؛ وهو محدد يربط بين الغيب والواقع ويمكن من استخلاص محددات يقرأ الواقع بها، ويمكن من الصياغة الدقيقة لإشكاليات الواقع والعروج بها إلى القرآن المجيد في “وحدته البنائية” للوصول إلى هديه في معالجتها[41]. ويعتبر العلواني أن الجمع بين القراءتين أهم خطوة منهجية وأبرز محدد منهاجي يساعد على كشف وتحديد بقية المحددات المنهاجية القرآنية[42].
المحدد الثالث: الوحدة البنائية للقرآن الكريم والاستيعاب الكوني؛ ومن هذا المنطلق يدعو العلواني إلى اعتبار القرآن الكريم “مصدر المنهجية الكونية، فلا تجوز تجزئته بحال، ولا يجري تجاوز شيء منه”[43].
ويؤكد العلواني أن المنهجية المعرفية القرآنية المستندة إلى المحددات الثلاثة، بإمكانها بناء وتأسيس “الإطار الكوني الشامل للفكر الإنساني”، ويصدق على العلم ومنهجه ومنطقه، ويهيمن ويوجه الجهود الإنسانية بشكل جماعي لتطوير الأرض وإعمارها وإنماء ما فيها، ويمكنها من مواجهة الأزمات العالمية الراهنة”[44].
بناء على كل ما سبق؛ نستنتج أن مقاربة أبي القاسم والعلواني لمنهجية القرآن المعرفية البديلة، تتميز بزخم نظري ومعرفي عميق، ومع أن الملكة التنظيرية عند أبي القاسم تتجاوز نظيرتها لدى العلواني، إلا أن ميزة العلواني الكبرى تتمثل في قدرته اللافتة على توظيف العديد من المفاهيم التي وظفها أبو القاسم، وإدخالها إلى المجال التداولي الإسلامي بالشكل الذي لا تثير معه عديد الردود والتعليقات العنيفة أحيانا.
تبقى محاولات أبي القاسم حاج حمد، وطه جابر العلواني في الكشف عن منهجية القرآن المعرفية البديلة من أعمق ما قدم، بنظري المتواضع. فمجهودات الرجلين تروم توضيح أن القرآن الكريم العظيم يشتمل على منهجية معرفية متكاملة، وأن هذه المنهجية المعرفية تنسجم تمام الانسجام، بل تهيمن على منهجية العلوم الطبيعية، وتستطيع أن تقودها وتعطيها نهاياتها الفلسفية التي تجعل منها منهجية معرفية متجاوزة لكل المنهجيات المعرفية الوضعية.
على سبيل الختم: المهمة قرآنية وكذلك عالمية
في الختام نؤكد أن بيان منهجية القرآن المعرفية مهمة عالمية: تهم العالم كله، ويحتاج إليها العالم كله، وإن تصورها البعض مهمة في إطار الخصوصية الجغرافية والبشرية الإسلامية، ومع كون المهمة عالمية يتأكد أيضا كونها قرآنية محضة، فأمام التدافع الديني، وإفلاس الأنساق الحضارية العالمية، وختم النبوة وبروز الأزمات الفكرية والمعرفية عالميا ومحليا، يتصدى القرآن وحده لخوض معركة شاملة بحسبانه كتاب وحي مطلق.
وأعتقد أننا أمام تحد كبير ومهمة صعبة تتجلى في الكشف عن منهجية القرآن المعرفية والكشف عن جوانبها الكثيرة والبناء عليها وضرورة تفعيلها؛ بما يمكن من إنقاذ البشرية ويدخل الناس في السلم كافة، سالكين طريق القرآن. فهل علاقتنا الحالية بالقرآن تمكننا من تحقيق مقصدنا هذا؟
الهوامش
[1] . محمد سبيلا، النزعات الأصولية والحداثة، سلسلة المعرفة للجميع، ع 13 فبراير– مارس، ط1، 2000م، ص84.
[2] . علي سيف النصر، من مقدمة كتاب، الصحوة الإسلامية المعاصرة والعلوم الإنسانية، أوراق في الممارسة النظرية المستقلة، تونس: المطبعة العربية، ط1، 1990م، ص12-14 بتصرف واختصار.
[3] . حميد المبارك، نحو صياغة إسلامية لعلم الاجتماع، ضمن كتاب: الصحوة الإسلامية، م، س، ص231.
[4] . تعرف اليونيسكو العلم بأنه: “كل معلوم خضع للحس والتجربة”. والوحي ومعارفه لا تخضع للحس والتجربة، ومن تم فهو ليس علم بحسب تعريف اليونسكو.
[5] . محمود عايد الرشدان، حول النظام المعرفي في القرآن الكريم، مجلة إسلامية المعرفة، ع 10 السنة الثالثة خريف، (1418ﻫ/1987م)، ص33.
[6] . نفسه، ص 34.
[7] . نفسه، ص34.
[8] . طه عبد الرحمان، سؤال الأخلاق: مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية، البيضاء: المركز الثقافي العربي، ط1، 2000م، ص119 وما بعدها.
[9] . قطب مصطفى سانو، النظم التعليمية الوافدة في إفريقيا: قراءة في البديل الحضاري، كتاب الأمة، الدوحة قطر، ع63، المحرم 1419ﻫ، السنة 18، ص56.
[10] . فرانسوا سليه، الأخلاق والحياة الاقتصادية، ترجمة: عادل العوا، بيروت-باريس: منشورات عويدات، ط1، 1980م، ص98.
[11] . راجع، طه عبد الرحمان، سؤال الأخلاق.. م، س، ص119 وما بعدها.
[12] . محمد سبيلا، النزعات الأصولية والحداثة، م، س، ص86.
[13]. زكي الميلاد، جمال باروت، الإسلام والغرب: الحاضر والمستقبل، ضمن سلسلة حوارات لقرن جديد، بيروت: دار الفكر، ط2، (1422ﻫ/2001م)، ص67-68.
[14]. عمر بهاء الدين الأميري، الإسلام وأزمة الحضارة الإنسانية المعاصرة في ضوء الفقه الحضاري، الدار العالمية للكتاب الإسلامي، ط1، (1414ﻫ/1993م)، ص20.
[15] . محمود عايد الرشدان، حول النظام المعرفي في القرآن الكريم، م، س، ص35.
[16] . المرجع نفسه، ص37.
[17] . عمر بهاء الدين الأميري، الإسلام وأزمة الحضارة الإنسانية المعاصرة في ضوء الفقه الحضاري، م، س، ص 19.
[18]. أبو القاسم حاج حمد، العالمية الإسلامية الثانية: جدلية الغيب والإنسان والطبيعة، بيروت: دار ابن حزم، ط2، (1416ﻫ/1996م)، ج1، ص365-366.
[19]. أبو القاسم حاج حمد، منهجية القرآن المعرفية: أسلمة فلسفة العلوم الطبيعية والإنسانية، بيروت: دار الهادي، ط1، (1424ﻫ/2003م)، ص38.
[20] . محمد همام، المنهج والاستدلال في الفكر الإسلامي: مساهمة في النقد، بيروت: دار الهادي، ط1، (1424ﻫ/2003م)، ص40-41.
[21]. طه جابر العلواني، الخصوصية والعالمية في الفكر الإسلامي المعاصر، بيروت: دار الهادي، ط1، (1424ﻫ/2003م)، ص81-82.
[22]. طه جابر العلواني، معالم في المنهج القرآني، القاهرة: دار السلام، ط1، (1431ﻫ/2010م)، ص34-37.
[23]. طه جابر العلواني، أفلا يتدبرون القرآن: معالم منهجية في التدبر والتدبير، القاهرة: دار السلام، ط1، (1431ﻫ/2010م)، ص191-194.
[24] . محمد همام، المنهج والاستدلال في الفكر الإسلامي: مساهمة في النقد، م، س، ص41.
[25] . أبو القاسم حاج حمد، منهجية القرآن المعرفية، م، س، ص38.
[26] . طه جابر العلواني، معالم في المنهج القرآني، م، س، ص77.
[27] . طه جابر العلواني، الخصوصية والعالمية في الفكر الإسلامي المعاصر، م، س، ص106.
[28] . المرجع نفسه، ص106.
[29] . المرجع السابق.
[30] . أبو القاسم حاج حمد، منهجية القرآن المعرفية، م، س، ص116.
[31] . المرجع نفسه، ص119.
[32] . المرجع نفسه، ص121.
[33] . المرجع نفسه، ص139.
[34] . المرجع نفسه، ص140-141.
[35] . للاطلاع على ما أثاره هذا النموذج المنهجي من ردود وتعليقات والتي كانت في غالبها عنيفة. يرجى الرجوع إلى أعمال الندوة التي عقدها مكتب المعهد العالمي للفكر الإسلامي بالقاهرة بتاريخ 11/03/1992م، لمناقشة كتاب أبى القاسم، منهجية القرآن العرفية، والمنشور كملحق بنفس الكتاب، م، س، ص255 وما بعدها.
[36] . محمد همام، المنهج والاستدلال في الفكر الإسلامي: مساهمة في النقد، م، س، ص44.
[37] . طه جابر العلواني، الجمع بين القراءتين: قراءة الوحي وقراءة الكون، القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، ط1، (1427ﻫ/2006م)، ص27.
[38] . وفي السياق ذاته يؤكد أن: “والقرآن وحده هو الذي يستطيع تخليص الاتجاهات العلمية والضوابط المنهجية وإعادتها إلى جادة الهدى والحق من جديد لتحقيق عالمية القيم: الهدى، والحق، والتوحيد، والتزكية، والعمران، والعدل، والحرية، والإحسان، وتحمل أداء الأمانة، ونبذ الخبائث، ووضع الإصر والأغلال عن البشرية، واعتبار الأرض منزلا واسعا للبشرية يتسع لها كلها، فلا تحتاج إلى الحروب، بل تدخل في السلم كافة. وبذلك يحقق القرآن المجيد “عالمية الانتماء الإنساني والتفاعل” و”عالمية القواعد المنهجية المشتركة الضابطة للتفكير الإنساني” طه جابر العلواني، معالم المنهج القرآني، م، س، ص78-79.
[39] . طه جابر العلواني، الجمع بين القراءتين، م، س، ص27.
[40]. طه جابر العلواني، معالم المنهج القرآني، م، س، ص83.
[41]. المرجع نفسه، ص84.
[42]. المرجع نفسه، ص89.
[43]. المرجع نفسه، ص88.
[44]. المرجع نفسه، ص80-81.