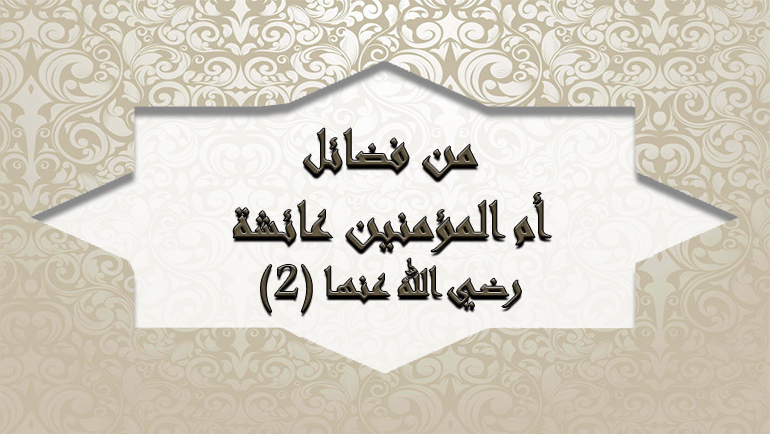منذ اكتمال نزول الوحي والتحاق الرسول، صلى الله عليه وسلم، بالرفيق الأعلى. عكف المسلمون خلفا عن سلف على كتاب الله تعالى وسنة رسوله، عليه السلام، تدبرا وتفكرا واستنباطا واستلهاما باعتبارهما مصدري التشريع اللذين ينبغي أن تدار أمور الحياة كلها وفقا لهدايتهما وإرشادهما.
وقد اختلفت علاقة المسلمين بكتابهم وسنة نبيهم تمثلا وتأسّيا باختلاف العصور والأجيال، فلم تكن الحاجة قائمة على عهد الصحابة، رضي الله عنهم، إلى تدوين العلوم وضبطها وتقعيدها؛ إذ كان العلم سلوكا والتزاما، فلما دعت الحاجة إلى التدوين حين كثر اللحن وتجرأ أناس على النصوص، نهضت همم العلماء لتدوين هذه العلوم، فكانت الكتب والمدونات الأولى المؤسسة في كل علم، ثم تواتر التأليف بعد ذلك شرحا واختصارا واستدراكا واستئنافا للنظر، غير أنه حريّ بالذكر أن النشاط التأليفي المتصل باستئناف النظر، كان هو الأقل.
ولقد كان مدار كل هذه العلوم في البداية على النص نشأة وتداولا، حيث كانت في منطلقها متمثلة له علما وعملا، مما جعلها تنفتح بهدايته على الكون وعلومه وعلى الإنسان ومعارفه وتشيد عالميتها الرائعة الأولى. والتي تجلت فيها فعلا أبرز خصائص الوحي وعكست بقدر طيب نوره وإشعاعه في الهداية والرحمة والعدل والحرية والأمن… كما تجلت فيها أيضا كثير من القيم العليا المزكية للإنسان والبانية للعمران.
وهذه العلوم اليوم على الفضل والخير الكبيرين اللذين فيها، أضحت تُكِنُّ مجموعة من العوائق الذاتية تحول دون استئناف العمل البنائي والتجديدي فيها، ويمكن ترتيبها كما يلي:
أول هذه العوائق؛ أن علومنا الإسلامية دلفت نحو قُطب التقليد، فحينَ مُورست على الإنسان المسلم مجموعة من الضغوط والتقليصات؛ سواء معنوية أو مادية. وحين استُبدل واقع “قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك” (الذي كان يُمارس في الصدر الأول حين قال عمر بن الخطاب هذه الجملة الرائعة لعبد الله بن عباس وكان فتى ساعتئذ)، بواقع “صه! بدأنا نرى أن بعض العلماء شرعوا في تبوّء مقامات فيها الإطلاق والكليانية ودعوى امتلاك الحقائق… مما قلص الهوامش النقدية، وضيّق مجالات الاجتهاد، وأدى إلى ظهور عبارات من مثل قولهم: ليس في الإمكان أبدع ممّا كان! وظهور أنماطٍ من التبعية تحت دعوى القداسة في بعض الأحيان. إلى غير ذلك من الفهوم التي حين توضع في غير موضعها وتورد في غير موردها تجعل الإنسان المسلم ينسحب من ساحات الإبداع المباركة نحو ساحات التقليد والانكماش الاستهلاكي لما يُعْرَض! فالإبداع وحرية الفكر صنوان. والإبداع والكرامة صنوان.
في الصدر الأول كنا نجد سلوك الإمام المعلم مع تلامذته فيه التشجيع على القول، وقد تقدم مثال عمر بن الخطاب. لكن التاريخ ينقل لنا كذلك أن أبا حنيفة كان يُعجبهُ حين تتعالى أصوات تلامذته محمد بن الحسن الشيباني وأبي يوسف وزفر.. كما كان ذلك يعجب الإمام مالك والإمام الشافعي مع أصحابهما… لما كان ينتجه هذا التعاطي من مداولات وسؤالات وأخذ ورد وثمار. حين استُبدل بهذا الواقع واقع آخر فيه الكليانية والإطلاقية، وعدم المشاركة مع الأستاذ في البحث عن المعلومة وصوغها بدل الاقتصار على التلقي غير التفاعلي… بدأت علومنا تدلف نحو التقليد والترداد.
وثاني هذه العوائق؛ أن هذه العلوم قد انفكت من النص المؤَسِّس، الوحي ومعطياته، فالعلوم في فترة تأسيسها كانت عبارة عن حوار مع الكتاب والسنة للاتصال الوثيق والمبدئي معهما، وهذا الحوار كان يُعطي بالفعل القابلية لاكتشاف مجموعة من الآفاق، استنادا إلى استثمار المعطيات الموجودة فيهما، واستنادا إلى المقاربة الآياتية للوحي وللكون، ممّا جعل هذا الحوار في الفترة الأولى يُولِّد مجموعة من المعارف المتعلقة بالإنسان والعمران والطبيعة والكون المحيط. ولكن حين كَفَّ هذا الحوار بقيت العلوم الإسلامية منحسرة فيما أنجز خلال تلك الفترات الوضيئة الأولى، دون البناء على مكتسباتها، وقيام اللاحقين بما عليهم هم أيضا من الواجب إزاء هذا الوحي المبارك، وإزاء متطلبات الواقع. وإنه ليتعيّن على المسلمين اليوم استئناف هذا الحوار لسد الثغرات المترتبة عن هذا العطل المنهجي العميق.
وثالث هذه العوائق؛ أن هذه العلوم قد توزعتها نزاعاتٌ مذهبية خلال بعض الفترات، نزاعات قد أدت إلى سجالات لم تكن دائما إيجابية. حيث تحول النص المؤسس إلى حلبة لاقتناص الشواهد والمبررات السجالية والحجاجية التي يستقوى بها طرف على آخر، أو تعزز بها أطروحة على أخرى ولو على حساب وحدة النص البنائية والسياقية، أو على حساب وظيفة العلم البيانية. الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في توجيه حركة تدوين العلوم والتأريخ لها من جهة، وعلى مناهج ومقررات التربية والتكوين التي تلقتها أجيال متتالية في الأمة مما أضعف فكر الوحدة والتكامل على مستوى بنيات العلوم وعلى مستوى قضايا الأمة الاجتماعية والسياسية والثقافية.
ورابع هذه العوائق؛ أن هذه العلوم، قد تسربت إليها خلال تاريخنا مناهج دخيلة كالمنطق الصوري الأرسطي، مثلا، ممّا أدخل عليها إفسادا جوهريا من الجانب المعرفي؛ لأن المقاربة الأرسطية تعتبر أن العقل هو المولِّد للمعرفة، في حين أن العلوم الإسلامية تأسّست انطلاقا من النقلة الكبيرة التي في الوحي، والتي تَعرض العقل باعتباره مكتشِفًا لهذه المعرفة ومستنبطا لها، وشتان بين المقاربتين: مقاربة التوليد ومقاربة الاكتشاف والاستنباط!
وخامس العوائق، أن هذه العلوم غدت في بعض مراحل تاريخها علوما يغلب عليها التجريد والصورية مما جعلها تنأى كليا أو جزئيا عن هموم ومشكلات الواقع والإنسان، وهي ما جعلت إلا لتيسير حياته وإسعاده في معاشه ومعاده. فتاريخنا متصل من حيث انطلاق هذه الدورة الحضارية الإسلامية بالرسول الأكرم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبصحبه المنتجبين الذين أسسوا الأنموذج المشكّل للوحدة القياسية؛ أي المعيار وحالة السواء التي وجب ردُّ الأمور إليها في المجالات المعرفية والحياتية. ولاشكّ أن هذا كان وراء كثير من الاختلال في جانب ارتباط العلوم الإسلامية ارتباطا وظيفيا بواقع الإنسان فردا واجتماعا، وهو ارتباط يصعب تصوره إذا لم يتم تجريدُ حالة السواء هذه وتجلية معالم الوحدة القياسية التي تحدثنا عنها، ولم تتم “مَنهَجَة” كيفية التعاطي معهما والاستمداد منهما، بكل الواقعية وكل المرونة اللتين تجعلان هذا الارتباط يجري في إطار منهج قائم على خطوات ثلاث: الخطوة الأولى هي تَمثُّل الوحدة القياسية وحالة السواء، بطريقة علمية بحيث تكون مبوّبةَ وممفصلةً وممنهجة. والخطوة الثانية هي النظر إلى الواقع وتحليله، والوقوف على مقوماته ومكوناته وأدواره وسُلطه ومراكزه.. وحين يعي الإنسان واقعه في استحضارٍ للوحدة القياسية ولحالة السواء، تكون الخطوة الثالثة خطوةً تلقائيةً وهي تجاوز الواقع في استلهامٍ لحالة السواء. مع استدامة الوعي بأن هذه الحالة أيضا كانت محكومةً بواقعها وبأسيقتها في ما عدا الثوابت.
فإذا لم تُلحظ الفوارق وأريدَ استعمال القياس بشكل آلي فإن ذلك سوف يؤدي إلى الخطأ في التقدير. و”مفهوم الأسوة” قائم أساسا على هذا الوعي، ولذلك فثمة فرق بين التأسّي والاقتداء. فالقدوة في القرآن المجيد مرتبطة بالهدى ﴿أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده﴾ (الأنعام: 91). أمّا بالنسبة للرسول الأكرم، عليه الصلاة والسلام، فهو أُسوة؛ أي أنك تعي واقعك وتتمثّل نموذجية المتأسَّى به في وعي بالفوارق. وهذا أمر محوري في هذا الباب.
فحين ذهلنا عن هذه المنهجية في التعاطي مع تاريخنا أصبحنا نجعل كل فترات هذا التاريخ نموذجية تتركب بعضها على بعض! وحين لم نُحكم الفصلَ بين الوحدة القياسية (حالة السواء) وبين سائر المراحل، ولم نجعل كل المراحل الأخرى خاضعةً لهذه الخطوات الثلاث التي أشرنا إليها… حدثت أزمة.
وحين اعتقدنا لفترة أن المراد هو الاقتداء وليس هو التأسي حدثت أيضا أزمة؛ لأننا أردنا، في فترات معينة، إعادة إنتاج هذا الواقع بكل حيثياته. في حين أن هذا منالٌ يستحيل؛ لأن الأسيقة الكونية والمحلية والنفسية والفكرية، والأفق المعرفي، كل ذلكم يتغيّر. فلا يُمكن أبدًا أن إعادة إنتاج هذا الواقع بحذافيره، مما أدى ويؤدي لأضرب من الاختلال المضرة بالنص وبالواقع.
وبوعي ما سلف يصبح لتاريخنا حضور استلهامي واعتباري هادٍ، بعيد كل البعد عن أي حضور تأزيمي.
وسادس هذه العوائق، أن هناك إشكالا نجده منسابا في كل فصول تاريخنا العلمي والمعرفي، يتعلق بقضية الثابت والمتحول، وما هي الطريقة والمنهجية التي بها نُمقدرُ Le dosage الثابت ونعرفه ونعرّف حدوده، حتى لا نصادمه ولا نتجاوزه. ثم نعرف ونُمقدرُ المتحوِّل الذي سيكون موضوعًا للاجتهاد المستأنَف في كل عصر كما نصّ عليه العلماء. حين لم نستثمر الجهد المطلوب واللازم في هذه القضية، وتركناها منتثرة في كتب النابغين من علماء الأمة دون جمع، ولم تُتَلَقَّ الإشارات الكثيرة الموجودة في القرآن والسنة إلى هذه القضية فبقيت غير بينة المعالم حصلت مشاكل كثيرة. وقد أورد ابن القيم -رحمه الله- في كتابه “أعلام الموقعين” فصلا سماه “في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد”. فنحن الآن مطالبون مرة أخرى بفتح ملف الثابت والمتحول في مجال العلوم الإسلامية… بما يلزم من مقدرة Dosage واتزان وتشرّع حتى نستطيع تجاوز جانب من هذه الأزمات التي نعيشها اليوم.
وهنا وجب الانتباه إلى العائق السابع، والذي يفرض ذاته ويتمثل في قضية الباراديغمات؛ أي الأنساق والأطر المرجعية والمركبات المفاهيمية التي تقود عمليتنا التفكيرية والتحليلية، وتؤطر أضرب النظر الذي نستعمله ونوظفه. هذه الباراديغمات أمرٌ لم يُعطَ حقه، في أفق تحرير وتجريد الباراديغمات الكامنة من جهة وراء العلوم الإنسانية حتى نتعامل معها برشد وفاعلية واتزان، ونجرّد من جهة ثانية الباراديغمات الكامنة وراء علومنا ومعارفنا الإسلامية حتى نتأكد من قرآنيتها وسلامتها، حتى لا تبقى علومنا خاضعة لباراديغمات غير سليمة نُضفي عليها سربال القداسة ويكون لها من التأثير السلبي علينا وعلى تاريخنا ما يكون. ومن ذلك إدراك النواظم المنهجية الكلية بين العلوم الإسلامية التي توحدها في أصل انبثاقها الأول وتزيح عنها توهم الاكتمال والشرف والأفضلية والاستقرار.. وتجسر علاقتها التكاملية مع دوائر العلوم الأخرى في ضوء مقاصد وفلسفات العلوم كما يقرها القرآن المجيد في أبعادها الإنسانية والكونية التواصلية والتعارفية من غير نزوع نحو هيمنة أو استبداد معين.
هذه العوائق حين استحكمت صيرت هذه العلوم كما استقرت بعدُ، في كثير من مناحيها وأبوابها تنسدّ مناهجها دون الاجتهاد والإبداع، مما يستدعي مراجعات في ضوء هذه العوائق بغرض تخليص علومنا من آثارها السلبية، وإزاحة الشوائب العالقة بها وجعلها قادرة وحاضرة في موكب التدافع الكوني الراهن تسهم فيه ولو بمقدار في ظل ظروف وتحولات قاهرة لاترحم المتخلف عنها.