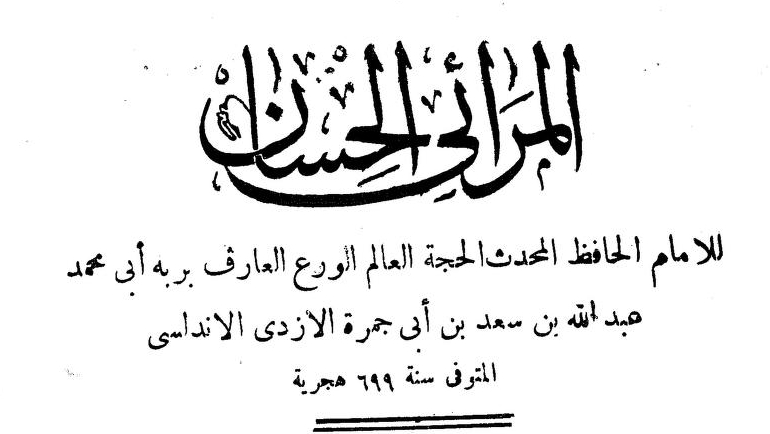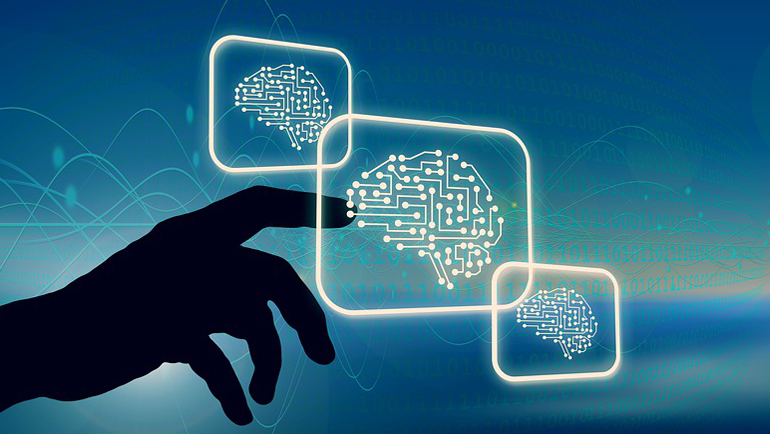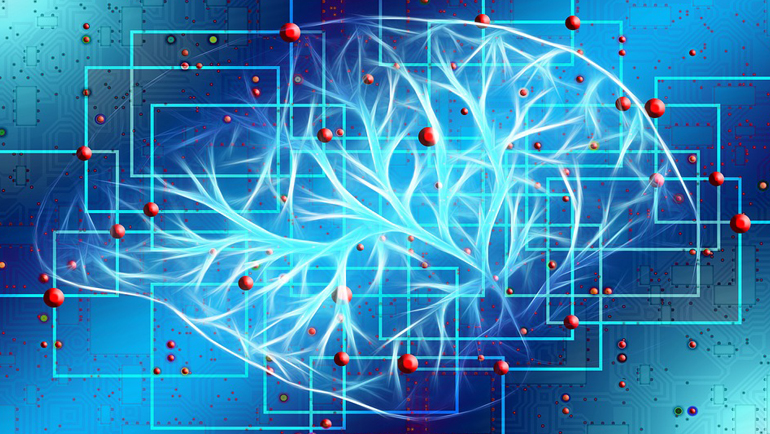أولا: الحاكمية في المشهد الإسلامي المعاصر
من الخطأ أن نقرأ الأفكار وكأنها مجرد ردود أفعال، فيتم تحليل الأقوال، وينحى عن المشهد تأصيل الأحوال. ولعل الحاكمية، تاريخًا ومصطلحًا ونسقًا، هي الأَوْلى بقراءتها بعيدًا عن هذا المأزق المنهجي الذي يحبسها في فكرة مأزومة قبل ارتياد الآفاق التي حركتها من رحم التاريخ النائم إلى جدل الحاضر المتلاحم.
قيل عن القرن السابع عشر الميلادي في تاريخ الفكر الأوروبي؛ إنه “عصر الإلحاد”، وبذات لغة التحقيب التاريخي يمكن أن يسمى القرن التاسع عشر في تاريخ الفكر الإسلامي بأنه “عصر الاضطراب”؛ الاضطراب في كل شيء في الدولة وسلطاتها، وفي المجتمع وتنظيماته، وفي الإنسان التائه بين الواقع الرديء والمأمول الذي يبدو وكأنه لن يجيء، ظلمات بعضها فوق بعض.
كانت الدولة العثمانية هي الإطار الذي تلتقي في داخله هموم الأمة وطموحاتها، وكان الإسلام هو مصدر شرعيتها، وأساس ترابط شعوبها رغم تفرع انتماءاتهم، وتنوع لغاتهم، وتباين تصوراتهم للمستقبل المنشود، وكانت الدول الأوربية ترى في انكسار هذه الدولة، فكرًا وسياسة، هي الطريق الأوحد لإفساح الطريق أمامها في مجال حيوي لا حياة لها فيه إلا بتكسير عظام هذه الدولة وتدمير بنيتها الثقافية والسياسية والاجتماعية.
وكانت فكرة الخلافة هي القلب الذي ينبغي إيقافه عن العمل، فنبضه يغذي حركة الصمود، فبقاء الخلافة يعني تراجع المشروع الغربي عن بلوغ غايته، وتلك خطوط حمراء في نظر دوله ومفكريه، لم تكن الفكرة دينية وإن أفرزت تعصبًا دينيًا، واستخدمت من الجدل الطائفي ما يعزز أهدافها، ويحقق مراميها، كان الدين ملاذاً يُستغاث في أجواء الصراع؛ لأن فكرة الدين الحق تُعد فكرة رئيسية عند القديس أوغسطين، كما هي فكرة جوهرية في مذاهب الإسلاميين.
وهكذا بدأت حرب الأفكار تتغيا تفكيك الدولة العثمانية، وسحب الشرعية عن خلافة آل عثمان لإسقاط شرعيتها، وكسر شوكتها، منطلقة من فكرة تذويب الأديان، مرحليًا، حيث لا فرق بين مسلم ومسيحي ويهودي، وهي الفكرة التي تبنتها مجلة “النادي” التي تصدر عن النادي الإيطالي بمصر بإدارة “إنريكو أنساباتو” مدير الجريدة ورئيس تحريرها وصاحب كتاب (الإسلام وسياسة الخلفاء) الذي خاض معارك فكرية للتأكيد على أمرين:
لأول؛ أن الإسلام ربط السلطة العامة بالدين، ولم يفصل بين الرئيس السياسي والرئيس الديني في حدود عملية وواجبات قومية واجتماعية، فليس مذهب “ما لله لله وما لقيصر لقيصر” مرعيًا في الإسلام، بل الرئاسة الدينية هي بعينها الرسالة المدنية، والإمام قابض بكلتيّ يديه على أزِّمة الشؤون العامة المتعلقة بحياة الدين وحياة الأمة، فهو يعاقب على من يترك الصلاة والصوم ويمنع الزكاة، كما يعاقب السارق والقاتل والمعتدي بأي وجه من وجوه الاعتداء، والمجلس الذي يعاقب الإمام فيه على المخالفات التعبدية هو بعينه المجلس الذي يقيم فيه الحدود العامة عن المخالفات الاجتماعية والمدنية.
الثاني؛ التأكيد على أن الخلافة عثمانية، وعلى المسلمين أن يكونوا معها قلبًا وقالبًا، ويقول “إنريكو أنساباتو” أن الإمامة الكبرى والرياسة الشرعية أصبحت حقًا شرعيًا من حقوق العرش الشاهاني المقدس الذي انتهت إليه في نظر أهل الحق والرجاحة كل شعائر الرياسة والزعامة الشرعية المختصة بالإمامة الكبرى والخلافة العامة.
وهكذا أسفر النصف الثاني من القرن التاسع عشر عن ثقوب في نسيج الخلافة، ولد عنه اتجاهان:
اتجاه يرى أن الخلافة عثمانية، وشروطها لا تتوافر إلا في آل عثمان، بما يؤكد صحة انتهاء الخلافة إليهم، وكان في مقدمة هذا الاتجاه حسن باشا حسني الطويراني صاحب جريدة النيل المصرية والذي كتب رسالة في موضوع الخلافة محورها صحة خلافة آل عثمان، وعلى نهجه سار “يوسف أفندي كامل البخاري” المحرر في مجلة النادي الإيطالية والذي كتب دراسة مطولة نُشرت تحت عنوان: “البراهين القوية في دحض من يقول إن الخلافة عربية”.
واتجاه ثان يرى أن الخلافة عربية مستهدفًا قطع العلاقة بين العرب والدولة العثمانية، وإثارة النعرات القومية التي تنخر الدولة من داخلها، ولا غرابة في أن يبدأ هذا الاتجاه، رغم وجوده القوي في النظرية الإسلامية ممارسة وفقها، على أيدي الصحافة الغربية، ثم أصّل له كتاب لمؤلف مسيحي عربي في كتاب عنوانه: “سوريا غدًا” صدر في باريس سنة 1915 وموضوعه بحث مستقبل سوريا بعد الحرب، والطعن على الأتراك، وتحريض العرب عليهم، والبحث في الخلافة وشرط عربيتها كما هو مدوّن في مؤلفات المسلمين، وقد ذكر “أحمد الرجيبي” شيخ رواق المغاربة بالأزهر الشريف في كتابه “الخلافة في الإسلام” ما يلي: “في سنة 1915 أخبرني المسيو “كرللا” السكرتير الأول بدار المفوضية الإيطالية بالقاهرة إذ ذاك بأن إنجلترا تتخابر سرًا مع شريف مكة للوصول إلى اتفاق يبنى على تعهدها باستقلاله، وانتقال الخلافة إليه بعد انتهاء الحرب في مقابل انضمامه إليها في محاربة الأتراك وتقبيح حكمهم بين المسلمين، ورجا مني أن أبيّن له موافقة عمل الشريف المنتظر للشرع الإسلامي من عدمه، لأن وزارة الخارجية الإيطالية يهمها معرفة هذا، فأفهمته فورًا بأن الشرع الإسلامي ينكر عملاً كهذا مطلقًا خصوصًا في ظروف كهذه، وأن المسلمين سيرفضون مبايعة أي شخص يرتكب هذا الجرم…، فقال: “المعروف في شريعتكم أن الخلافة في العرب لا الترك”.
وفي ذلك التاريخ (1915) بدأ الشيخ “أحمد الرجيبي” كتابة مؤلفه: “الخلافة في الإسلام” وهو ذات التاريخ الذي بدأ فيه “علي عبد الرازق” تأليف كتابه “الإسلام وأصول الحكم”.
ولم تشهد هذه المساحة الزمنية التي امتدت من منتصف القرن التاسع عشر إلى أوائل القرن العشرين هذا الصراع الإسلامي حول فكرة الخلافة فحسب، بل شهدت صراعًا آخر حول مدنية الدولة وعقلانية البحث في الإلهيات، بل وظهرت لأول مرة اتجاهات الفكر العلماني، فكتب “قدري باشا” كتابه في “التمدن”، وكتب “ميخائيل عبد السيد” كتابه: “بث المعارف، ونث العوارف” دعوة إلى تحليل ثقافي بعيد عن الغيبيات، وكتاب “رسالة الصديق” لـ”عبد الله النديم” والذي طرح فيه، كما يقول “فاروق أبو زيد”، معظم الأفكار التي طرحها من بعده بخمسة وأربعين عامًا الشيخ “علي عبد الرازق” في كتابه: “الإسلام وأصول الحكم”، وكتاب: “الحاكم والمحكوم” لـ“عبد الله البستاني” والذي سبق “عبد الرحمن الكواكبي” في كتابه: “طبائع الاستبداد”، ويوتوبيا “العصر الجديد” لـ“أديب إسحق” والذي سبق بها أم القرى لـ“عبد الرحمن الكواكبي” بأكثر من خمسة وعشرين عامًا. و“محمد أفندي عمر” في كتابه: “سر تأخر المصريين” الذي يقدم تحليلاً اجتماعيًا تمتد جذوره إلى الفكر الاشتراكي في نقده للمجتمع المصري وسياساته وطبقاته[1].
وفي هذا الحراك الإيجابي والسلبي معًا وجدت فكرة الحاكمية مكانًا لها في محاولة للتعامل مع واقع يموج بكل هذه الأفكار المتعارضة، والتيارات المتصارعة، في جدلية يمكن تلخيصها في الخوف على الإسلام، والخوف من الإسلام.
ولا تعني النماذج التي قدمناها من الفكر المصري أنها حركة محلية، بل هي فكر إسلامي عام، فالمفكر التونسي “أحمد السقا” أنجز في باريس عام 1916 رسالته للدكتوراه في موضوع: “السيادة في القانون العام الإسلامي السني” وأغلبها بحث في “نظام الحكم في الإسلام” متأثرًا بالحركة الإصلاحية عند خير الدين التونسي، والأفغاني، ومحمد عبده، مؤكدا أن “تنظيم الأمة للقيام بمهمتها لدى الحاكم، والسهر على ضمان الشرعية، لهو من الضرورات الحيوية والحتمية التي لقننا إياها التاريخ، وأن الشعوب العربية والإسلامية قد بدأت تستعيد وعيها بعد سبات دام قرون”، وكان ذلك قبل سقوط الخلافة العثمانية بسبع سنوات وقبل صدور كتاب: “علي عبد الرازق” “الإسلام وأصول الحكم” بثماني سنوات..
وفي السياق ذاته يقرأ الفكر الإيراني في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ما بين أنصار المشروطية وخصومها، حتى انتهى الأمر إلى “محمد حسين النائيني” ورسالته “تنبيه الأمة وتنزيه الملة”، والذي قدم أفضل دفاع إيراني عن المشروطية وأهميتها، والغريب أنه عاد في أواخر أيامه إلى نقض موقفه من المشروطية، ومخاصمة من حاول نشر كتابه.
كما أصدر “عبد الحميد الزهراوي” بحثًا عن الخلافة، وترجم “عبد الغني سني” عن التركية كتاب “الخلافة وسلطة الأمة”، وأصدر “محمد بركات الله” في زيورخ عام 1924 دراسته عن “الخلافة” والتي جوهرها أنها سلطة روحية وليست نظامًا سياسيًا.
وبعده أصدر عام 1926 العلاَّمة “السنهوري” رسالته من جامعة “ليون” عن الخلافة، واتخذ من الإجماع منهجًا لتطويرها وهاجم مقولة فصل الدين عن الدولة.
وقد سجل المفكر المغربي “عبد الله كنون” رؤيته في الخلافة وهو بصدد الرد على رسالة كتبها مغربي وردت إليه من القاهرة فيها هجوم عنيف على السياسة الإسلامية، وعلى الخلافة، وجاء رده في ثلاثة محاور أساسية:
- هل صحيح أن الخلافة ذهبت إلى غير رجعة؟
- هل صحيح أن الارتباط بالجامعة العربية لا يصح مع التعلق بالدين؟
- هل صحيح أن التمسك بالسياسة الإسلامية رجوع إلى عهد الحروب الصليبية؟
وقد وصف كنون ما ورد في هذه الرسالة بأنها أفكار زائغة جدًا عن الحق والصواب؛ فـ“عبد الرحمن عزام” أول أمين للجامعة العربية كان محاربًا في جيش الخلافة ضد إيطاليا في حرب طرابلس الغرب، وفي هذا أبلغ رد على السؤال الأول والثاني، أما حكومة مصر والتي فيها أكبر جامعة إسلامية في العالم فهي بلد إسلامي طُبعت حكومة وشعبًا بالطابع الإسلامي.
وهكذا كانت الساحة الإسلامية في الربع الأول من القرن العشرين، وهي تعاني ضغوط الاستعمار، ساحة مفتوحة لآراء متصارعة حول الدستور والحكم والمرأة والعلمانية، وهي ساحة ازدحمت بالتطرف والتطرف المضاد وحمل لواءها مع الفقهاء والمفكرين، أدباء متفلسفون مثل “الزهاوي” ومقالاته عن العلمانية وعن المرأة والحجاب، وكلٌ يدعي الأصالة أو يدعو إلى الحداثة في حياة فكرية قلقة لا يرتفع بها نسق ولا يستقر على أساسها اجتماع..
وفي النصف الثاني من القرن العشرين ابتلي الإسلام باتجاهين كلاهما بعيد عن حقيقة الإسلام؛ اتجاه علماني غايته إقصاء الإسلام حيث لا مكان له في الحياة العامة والمجتمع، واتجاه شمولي دعواه احتكار الفهم للإسلام تحت مسمى الحاكمية لله والتي أصبحت لدى تيارات التشدد والغلو من مصطلح له مفاهيمه ومرجعياته، إلى “شرك” غايته السلطان، وتراجعت أسس الوسطية وتكريم الإنسان إلى قراءات للقرآن لحمتها القتال المستمر، والعدوان السافر على النفس والأموال والأعراض، وقسمة العالم إلى محورين: محور الخير، ومحور الشر، ولأهمية مفهوم الحاكمية، ولأنه قضية محورية عند دعاة التطرف العلماني ودعاة التطرف الديني، فسوف نتناول الحاكمية بمنهج يقرأ المصطلح في سياق توظيفه، ومنذ البداية فإن الورقة لا تخفي موقفها الرافض لمنهجين في تناول الحاكمية.
الأول؛ المنهج التبريري الذي ينصب نفسه حكمًا على الدين والعقل والمجتمع، من خلال عرض غير أمين لحقائق الإسلام. تتبناه جماعات تستهدف المغالبة من أجل الحكم، وترفع لواء المشاركة الغامضة وهي لا تعرف في أساليبها الحكمية سوى تصفية الحسابات، وتمكين أتباعها من امتلاك مفاصل الدولة والمجتمع، تحت وطأة ديمقراطية هشة ترفع من شأن الصندوق الصامت، ولا تتبنى ثقافة الديمقراطية الناطقة.
الثاني؛ المنهج الإقصائي الذي يتلاعب بآيات الله، وأحاديث الرسول، صلى الله عليه وسلم، يفسر القرآن على هواه، ويقبل من الأحاديث ما يوافق مبتغاه، ويسقط من الوجود العلمي منظومة معرفية محكمة المنهج مكتملة الأدوات، حتى يرفض الأحكام الإسلامية التي هي من وجهة نظره استبداد ديني، لا تتوافق مع حرية البشر وكرامة الإنسان، فالحاكمية في هذا المنهج حاكمية كونية تؤسس على القوانين العلمية، بل على نظريات العلم بما فيها من خطأ وصواب، وليست حاكمية تشريعية تضع الأوامر والنواهي وفي قواعدها فصل الخطاب، فالكون مملكة الله من مقام الربوبية، والتشريع حاكمية البشر؛ لأن الشرائع مراحل تاريخية لها أوامر ونواه عينية زمنية، فحاكمية الله سنن وأخلاق، وحاكمية البشر شعب يقرر وتقنينات تصدر.
والمنهجية التي نعتمدها ترى أن العلاقة بين الدين والدولة في العالم الإسلامي لم تكن مجرد هم أساسي للمشروع التحديثي العربي لم يطرح سلفًا، كما يقول طلال أسد، بل هي علاقة مستمرة تحكمها ثقافة المغايرة عندما تحاول تهذيب موقفها المعارض، ولم تكن ثنائية التوفيق بين العقل والنقل عند رواد الفكر الفلسفي الإسلامي إلا مرحلة تاريخية لموقف العقل الإسلامي من كل محاولات “أنسنة القرآن” و”أدلجة الحديث النبوي”.
إن أدلجة الإسلام كما يقول “أشرف الشريف” على يد المشروع السياسي الإسلامي لاحقًا، جاءت متسقة مع مشروع متعثر لدولة حداثة فاشلة، جعلت من سياسات الهوية خيارًا جذابًا ومقبولاً، بل وضروريًا على المستوى الوجودي أمام أخطار التغريب الحضاري الحقيقية والمتوهمة.
ثانيا: الحاكمية عند المفكرين المعاصرين
في زمن الاضطراب الذي أشرنا إليه كثرت الأطروحات حول الإسلام المعاصر، فهي لم تعد تيارات تتفاعل أو تتقاتل، ولكنها أفكار أشخاص لا تكاد تتعداهم حتى إلى تلاميذهم.
فـ“رضوان السيد”، وهو مفكر معروف بقدرته على حسم موقفه، يفصل في أطروحته بين الفكر الإسلامي الحديث الذي إشكاليته الرئيسة هي النهوض، والفكر الإسلامي المعاصر الذي إشكاليته الحاكمة هي الهوية، والقطيعة بينهما عند الدكتور “رضوان” هي حتمية ضرورية لاختلاف في طبيعة الإشكالية مفترضًا التعارض بين النهوض والهوية وهو ما لا نسلم به، ويلخص الدكتور “رضوان” أطروحته بأسلوبه الواضح بقوله: “إن وعي الأفغاني وعبده والعظم ورضا وأرسلان لأحداث العالم وتركيباته وترتيباته، ومواقع المسلمين فيه، حددوا إشكالية التخلف في سائر المجالات، كما حددوا الحل وهو التقدم، على أن المفكرين الإسلاميين بدؤوا يتخلون عن هذه الفكرة، أو عن التحديد للإشكالية منذ القرن العشرين… وأصبحت الرؤية السائدة للعالم لدى الإسلاميين تتمحور حول الهوية، وتتسم بالقطيعة”.
ومنهجية “رضوان السيد” وجدت قبولاً عند “عبد الإله بلقريز” الذي أكد على القطيعة الفكرية بين خطاب الإصلاحية الإسلامية الذي غايته التقدم وخطاب الصحوة الإسلامية الذي هو محور الهوية وطريقها العودة إلى التراث، وأيًا ما كانت أهمية ما طرحه رضوان السيد، وطوره بلقريز فإن كلاهما لم يضبط مفهوم التقدم لدى الإصلاحيين ومفهوم الهوية لدى الراديكاليين، ولم يفترض كلاهما إمكانية صعود أي منهما إلى السلطة، وإمكانية تطورهما الفكري تحت وطأة الممارسة الواقعية، ولعل الخلفية العلمانية الكامنة وراء أطروحة هذين المفكرين. تفضي إلى تصورات متحيزة ترفض الديني من موقف لا من استيعاب، وتعلي من “النمط العلماني” الذي هو في نهاية المطاف منتج غربي أساسه الحرية الفردية باعتبارها “المقدس” في المشروع الحضاري الغربي، إلا أن هذه الرؤية تتميز بالتماسك، وفيها من وشائج النسب العاطفي للوطن ما يسمح بإمكانية الحوار رفعًا للجفوة وليس تجسيرًا للفجوة.
وفي تصور غربي للحاكمية يقول “برنارد لويس” في محاضرة له ألقاها في الندوة الدولية حول “رؤية الإسلام الخلقية والاجتماعية” باليونسكو: “هناك تصوران خاطئان خطأً شديد الشيوع فيما يتعلق بالفكر السياسي الإسلامي والحكم الإسلامي، حيث يوصف أولهما بأنه ثيوقراطي، ويوصف الثاني بأنه استبدادي بل وديكتاتوري، وكلا التصورين يرتكزان على فهم خاطئ، فالسؤال عما إذا كان الإسلام ثيوقراطيًا أم غير ثيوقراطي يتعلق بدلالات الألفاظ أكثر مما يتعلق بجوهر الموضوع، وتتوقف الإجابة عنه، إلى حد كبير، على التعريف المستخدم..
فالثيوقراطية وفقًا لأحد التعاريف هي دولة تحكمها الكنيسة؛ أي الكهنة، ومن الواضح أن الإسلام ليس ثيوقراطيًا بهذا المعنى ولا يمكن أن يكون، فليس في الإسلام كنيسة ولا كهنوت، لا من الوجهة اللاهوتية؛ إذ ليس هناك منصب كهنوتي أو وساطة كهنوتية بين الله والفرد المؤمن، ولا من الوجهة المؤسسية، إذ ليس هناك أساقفة، ولا سلطة هرمية من رجال الدين… لكن هناك لكلمة الثيوقراطية معنى آخر يستند إلى مدلولها الحرفي، وهو حكم الله، فالله وفقًا للمفهوم الفقهي للدولة الإسلامية هو وحده الحاكم الأعلى، وهو المصدر النهائي، بل والوحيد المشروع للسلطة، والله وفقًا لهذا المفهوم هو المشرع الوحيد، وهو وحده الذي يهب السلطة أو الذي يسبغ عليها المشروعية على الأقل، بيد أن هذا لا يعني أن الحكم لرجال الدين، فليس في الإسلام رجل دين إلا بمعنى سوسيولوجي محدود وليس بمعنى كهنوتي، وليس من المألوف في معظم البلدان الإسلامية أن يتقلد رجال الدين المحترفون مناصب سياسية.
وأوهى من ذلك أساسًا أن يصور الحكم الإسلامي على أنه نظام يكون فيه الحاكم مستبدًا مطلق السلطان، وتكون الرعية عبيدًا خاضعين لا حول لهم ولا قوة، فهذه صورة زائفة على كل من الصعيدين النظري والعملي؛ فالشريعة الإسلامية لم تخول قط للحاكم السلطة المطلقة، كلا ولم يتمكن الحكام المسلمون، إلا في فترات استثنائية، من ممارسة تلك السلطة”.
1. الحاكمية في التطرف العلماني
أ. الحاكمية عند “محمد شحرور”
الحاكمية عند “محمد شحرور” لا تعني مساحة أكبر للعقل في مواجهة النقل، بل هي حاكمية إنسان بلغ سن الرشد في التعامل ضمن المحيط الذي يعيش فيه، وفيها تكمن الخاتمية، لذا يرى أن حاكمية الله بالمفهوم التشريعي قد وضعت مقابل العلمانية بطريقة قسرية تمامًا.
إن هناك توترًا نفسيًا غير مبرر لدى العلمانيين جميعًا يمثل حاجزًا صلدًا يرفض الإسلام التشريعي.
يقول “شحرور” في كتابه الرئيس (الكتاب والقرآن قراءة معاصرة)[2]: “إذا سألني سائل: ما هي المواد التي يجب أن يحتويها دستور أية دولة لكي تصبح إسلامية؟ إنني أنوه بالخطأين الشائعين جدًا من قِبَل المسلمين وهما:
- المناداة بأن دستور الدولة القرآن، وهذا خطأ لأن القرآن لا يحتوي على أي تشريع.
- المناداة بتطبيق أحكام الشرعية الإسلامية؛ لأن الشريعة الإسلامية لا تحتوي على أحكام، بل على حدود،… إن التشريع في الدولة العربية الإسلامية مبني على أنه لا يوجد شيء اسمه الشريعة الإسلامية، ولكن يوجد شيء اسمه حدود الله التي وردت في أم الكتاب، والتشريع الإسلامي هو تشريع إنساني ضمن حدود الله.
والخطأ المنهجي الأول عند “شحرور” إيمانه بأن كل الأمة قبله كانت على خطأ، وأنه وحده على صواب، وبالتالي فقد أسقط بكل سهولة تراثها اللغوي والفقهي والأصولي ومفاهيمها ومصطلحاتها، وصاغ تعاريف ومفاهيم هي في مقياس العقل السليم مجرد ثرثرة ليس لها قانون لغوي يضبطها، أو قاعدة أصولية تحكمها، أو مقياس في علوم القرآن والحديث يجعلها علمًا بأي معنى من المعاني، ولم يكن أمامه إلا أن يصوغ نظرية معرفية تشرعن فكره، وتحمي تأويلاته من السقوط، لأنها مجرد تنجيم كما يقول بحق “سليم الجابي”[3] وإذا كانت قراءة “محمد أركون” محاولة للتشكيك في القرآن الذي هو بتعبيره “مدونة رسمية مغلقة وناجزة”، “وهو مجموعة من العبارات الشفوية في البداية، ولكنها جُمعت ضمن ظروف تاريخية لم توضح حتى الآن ولم يُكشف عنها النقاب”.
فإن قراءة “محمد شحرور” الجديدة هي تفكيك للنص، وتجفيف لمنافع الأحكام، ورفض للغيب والسمعيات والنبوات، بل هي رفض للإسلام كله بدعوى القراءة الجديدة، والتي هي في أفضل الأحوال رجم بالغيب.
ب. الحاكمية عند “محمد أبو القاسم حاج حمد”
ينطلق المفكر السوداني “حاج حمد” من نقد عنيف يوجهه إلى فكرة الحاكمية عند المودودي وسيد قطب ويرى أنهما أشاعا بين المسلمين ما هو ليس من دينهم ونهجهم دون أن يدركا ذلك.
“فالقرآن الكريم يقدم ثلاثة أنماط من الحاكمية: الحاكمية الإلهية، وتعني التدخل الإلهي المباشر، وهي ليست لنا، وحاكمية الاستخلاف وأساسها التسخير؛ والتي شملت الطبيعة والكائنات المرئية كالطير، وغير المرئية كالجن، وهي أيضًا ليست لنا، والحاكمية البشرية تتجاوز بنا ضيق اللاهوت الجبري وضيق الوضعية العلمانية باتجاه الوعي الكوني المطلق.
وقد أخطأ الفكر الإسلامي الذي وضع الحاكمية الإلهية في مقابل الحاكمية الوضعية، وبما أن الحاكمية الإلهية تلتزم ضرورة بشرع الله، والحاكمية الوضعية تلتزم بخطاب العقل البشري، فهي جاهلية ينقلها منطق التداعي لتترادف العلمانية مع الكفر، وهكذا تتكرس دائرة التناقض ضمن ثنائية حادة، فإما الحاكمية الإلهية وإما الكفر.
وعلى هذا الأساس تُعد جميع المجتمعات ذات النهج العلماني والوضعي مجتمعات جاهلية كافرة ولا توسط بين الأمرين، وبهذا “المعتمد الفكري” تتجه بعض الحركات الإسلامية إلى تمييز نفسها عن الآخرين في مجتمعاتها بوصفها؛ أي هذه الحركات، مجسدًا في ذاتها وتكوينها إطارًا لحاكمية الله؛ أي أن في داخلها الحركي يكمن “الخلاص”؛ فهي دون غيرها “مدينة الله” والآخرون “مدن الشيطان”، ويتداعى المنطق فيسبغ هذا الإطار على نفسه “مشروعية التصرف” باسم الله وحاكميته، فيرى في سبيل غاياته تبريرًا لكل الوسائل، مستحلاً الأنفس والدماء والأموال، فكل شيء يتم بمضمر المشروعية الإلهية، وفي مواجهة الكفر والجاهلية، وكل ذلك حسن وجميل في ذاته لو كان مجرد توصيف لواقع، ولكن “حاج حمد” يستخدم هذه الأسلوبية الجاذبة إلى مشروعية كاذبة تفرغ القرآن من كل أبنيته التشريعية ليصبح فضاءً يتحرك بعيدًا عن النص. يقول “حاج حمد”: “فالمنهجية القرآنية تكشف ضمن كلية القرآن ووحدته العضوية عن “ما ورائية” الأحكام الإلهية واتجاهات التشريع بحيث يصبح الإنسان قادرًا على ممارسة أقصى حالات القدرة على التصرف، فلا نتناول القرآن كمجرد نصوص وأحكام ولكن تتناوله كمنهج محيط بهذه الأحكام، ودال على خلفيتها وضابط لمفهوميتها، فينفذ إلى “ما ورائيات” النص عوضًا عن محاولات التأويل الذاتي لبعض النصوص لكي تتلاءم قسرًا مع محدثات الأمور، فالقدرة البشرية على الإبداع الملتزم كامنة في منهجية القرآن”.
هكذا يوجه “الحاج حمد” في كتابه “الحاكمية” “ميتافيزيقا” قراءاته الجديدة بعد تدويرها في نسق فلسفي متوتر وغامض يستهدف إسقاط كل الأحكام التشريعية في القرآن، فقد غادرنا بمنطق الحاكمية البشرية عالم النص إلى آفاق ما وراء النص، وهكذا يستعيد “الحاج حمد” موقعه في خريطة الحزب الجمهوري لمحمود طه ليكمل مسيرته في تحقيب الأحكام التشريعية بين رسالة أولى ورسالة ثانية، وكتابات “حاج حمد” كلها هي العالمية الإسلامية الثانية بدأت ماركسية وانتهت بالعودة إلى حاضنة الحزب الجمهوري لتصبح غاية الرسالة كلها “الترقي لدرجة المثالية الإنسانية” هو المطلوب دينيًا ليكون الإنسان “بحاكميته البشرية” متكافئًا مع الكون، مع أن الكون مجال إنساني يكتسب في رحابه الإنسان ميراث الأرض عندما يعود إلى خالق الإنسان وخالق الأكوان.
2. الحاكمية من منظور التطرف الديني
وُجدت الحاكمية، باعتبارها كلمة حق أُريد بها باطل، مع الانشقاق الخارجي في عهد الخليفة الثالث عليّ بن أبي طالب، وظلت تستدعى في تاريخ الفكر الإسلامي عند كل صدام بين الدين والسياسة، وعندما نشأت الدولة القومية الحديثة بتوجهاتها العلمانية، ظهر المصطلح من جديد بعد تعبئته بمواد متفجرة جعلته أقرب إلى القنابل الموقوتة أو حقول الألغام في المجتمعات المعاصرة.
أ. الحاكمية عند “أبي الأعلى المودودي”
لم تكن ثقافة “المودودي” المدنية تؤهله لتنظير الحالة الإسلامية في الهند، ولكن بيئة الصراع الاجتماعي المرتبط أصلاً بالدين، جعلته يستدعي فكرة الحاكمية لتكون الأساس النظري لدولة المسلمين في شبه القارة الهندية، فولادة باكستان، كانت ولادة عسيرة، وإسلامها مشوب بغموض توجهات قادتها من الإسلاميين ما بين أحمدي وإسماعيلي وسني، ولا شك أن “المودودي” كان يعلم أن ولادة الدولة تعني صراعًا بين النخب على الصيغة الإسلامية للدولة الجديدة..
ومن الخطأ عرض نظرية “المودودي” في الحاكمية باعتبارها المعادل الموضوعي لفكرة السيادة كما تمثلت عند الفقيه الإنجليزي “بودان”؛ فالمودودي يتحدث عن نظرية في السلطة، و”بودان” يتحدث عن نظرية في الدولة وبين الأمرين فروق واختلافات، وقد نجح “المودودي” في صياغة نظرية سياسية إسلامية، حاول أن يترجمها عمليًا في دستور دولة باكستان الوليدة، ولكن سيرة المصطلح كما أراده “المودوي” لم تكن هي سيرة السلطة السياسية كما أرادتها النخب الحاكمة، لقد رأى “المودوي” في الانفصال عن الهند ضرورة دينية لأن حزب المؤتمر يطرح دولة علمانية على النمط الغربي، لا تتلاءم مع التكوين الثقافي للمسلمين، بل ربما لا تلائم الطبيعية الدينية للمجتمع الهندي بكل طوائفه، والحاكمية عند “المودودي” حاكمية أصلية وحاكمية تبعية حيث يقول: “إن الحق تبارك وتعالى حاكم بذاته وأصله، وإن حكم سواه موهوب وممنوح” ويقول أيضًا: “إن أول أساس من أسس الإيمان هو الإيمان بحاكمية الله؛ فهو مالك السماوات والأرضين، وكل ما فيهما ملك لله وحده”.
والحاكمية في المفهوم السياسي والقانوني هي لله وحده، ولكنه يريد أن يقترب بها من الواقع السياسي المعاصر فيراها ديمقراطية ابتداءً بنوع من الخيار الإنساني لحكامه وممثليه، وثيوقراطية انتهاء باعتبارها لا تعطي خيارًا لحاكم أو محكوم أن يتفلت من قوانين الله وشرعه.
والرأي عندي أن “المودودي” جانبه التوفيق في جانبين:
الأول؛ أن الحاكمية التي تعني السلطة لا ينبغي أن تكون جزءًا من العقيدة لأنها جزء من التكليف الإلهي للبشر، وهي بالضرورة قائمة على الاختيار ككل تكليف، وميزانها الشرعي قائم على المعصية والطاعة وليس على الإيمان والكفر.
ثانيًا؛ أن “المودودي” حاول أن يسخر ثقافته الغربية من أجل صياغة فقه سياسي أقرب إلى عقول أهل وطنه، وكان يمكنه أن يعتمد على التجربة النبوية في صياغة فكر سياسي لا يتجاوز الشريعة، ولا يجرد الإنسان من دوره في اختيار حكامه واجتهادات فقهائه.
وحسب “المودودي” فإن نظريته لم تخرج عن كونها كفاحًا سلميًا من أجل إسلامية باكستان، وأظنه لن يكون راضيًا عما آلت إليه في الخطاب الحركي المعاصر لتصبح حاكميته هي المفهوم الذي يغذي العنف والكراهية في الخطاب الإسلامي الراديكالي وفي أفعاله على السواء.
ب. الحاكمية عند “سيد قطب”
الحاكمية عند “سيد قطب” تجربة تحولت إلى مذهب، وليست مذهبًا تحول إلى تجربة، لم يكن “المودودي” غريبًا عن “سيد قطب” فقد اشتركا معًا في أوائل الخمسينات في تأليف أكثر من كراسة، وشهد فكر سيد قطب تغيرًا جذريًا بين سنواته الأولى التي جعلت تصوره الإسلامي يقوم على منطلقات اجتماعية أولاً وسياسية شاحبة ثانيًا، وبين سنواته الأخيرة التي شهدت صياغة نظرية للحاكمية عبّر عنها في ثلاثيته الفكرية التي صدرت على التوالي في أوائل الستينيات وهي “المستقبل لهذا الدين”، و“هذا الدين”، و“معالم في الطريق”، الذي أصدره باعتباره جزءًا أول يحمل رقم (1) على صفحة الكتاب الأولى في طبعته الأولى.
ونظرية “سيد قطب” في الحاكمية تقوم على قواعد ثلاث بينها اتصال عضوي.
قاعدتها الأولى؛ أن السياسة هي الدين وأن الدين هو السياسة، وتحدد حركة الإنسان في الواقع حقيقة تدينه الذي لا يعرف التدرج؛ فهو إما مؤمن يلتزم التزاماً كاملاً بمنهج الله، وإما كافرًا يعيش جاهلية عمياء، والجاهلية هنا صفة مجتمع قبل أن تكون سمات فرد، حق الله في الحاكمية حق مطلق من ينازعه فيه فقد كفر فردًا كان أو جماعة، ولكن معركة سيد قطب كانت مع السلطة، فلم يأل جهدًا في تكفيرها، والمجتمع الإسلامي لا يكون إسلاميًا لكون أفراده ممن يسمون أنفسهم مسلمين، بل لأنه يلتزم منهج الإسلام في كل جوانب الحياة.
أما القاعدة الثانية؛ فهي الجاهلية الشاملة التي تستوعب المسلمين وغير المسلمين فالجميع خارج عن منهج الله لا تهم الأسماء، ولا بطاقات الأديان، المهم أين مكان المنهج الإسلامي في المجتمع؟ وهي جاهلية القرن العشرين كما سماها حامل أختام التراث القطبي “محمد قطب” الشقيق الأصغر لـ”سيد قطب”، وهي جاهلية محورها “ادعاء حق وضع التصورات والقيم والشرائع والقوانين، والأنظمة والأوضاع بمعزل عن منهج الله” فالعالم كله في جاهلية هي حاكمية العباد للعباد. و“سيد قطب” يرفض كل نظم الحكم المعروفة سواء كان اسمها حكم الفرد، أو حكم الشعب، شيوعية أو رأسمالية، ديمقراطية أو ديكتاتورية، أوتوقراطية أو ثيوقراطية.
والأطروحة لا تترك مكانًا للتفكير؛ إما القطبية أو التكفير حتى الشعائر من صلاة وصوم وحج وزكاة فإنها لا تجدي لأن ميزان العقيدة لا يؤمن إلا بالصفقة الكاملة، إما كل العبادات وكل المعاملات، وإما الكفر والانسلاخ من العقيدة. وهذه النظرية القطبية بهذا التصور الحدي تنسف كل قواعد الفكر الإسلامي وأبجديات النظرية السنية في علميّ الكلام والفقه.
القاعدة الثالثة؛ الجماعة المؤمنة: وهي جماعة مغتربة عن واقعها فكريًا وجغرافيًا، إنها، رغم قلتها العددية، هي المسؤولة عن إقامة دين الله. بل ومنها قضاة الله الذين يحكمون على كل عباد الله فبأيديهم صكوك الكفر ولا يعترفون بصكوك الغفران، وأفراد هذه الجماعة لا ينتمون إلى أسرة، ولا إلى قبيلة، ولا إلى دولة أو نظام، إنهم جند الله فحسب؛ العقيدة تجمعهم فالعقيدة أولاً والعقيدة آخرًا.
وهكذا أقام “سيد قطب” نظرية مغلقة “سجن” فيها الإسلام، وحبسه عن معتنقيه، وحشره في زاوية البُعد الواحد، والرأي الوحيد، والمفكر الفرد، والمسلم الأوحد، فكان في أقصى صور الاتحاد مع منطلقاته، وأصبح يمثل الاستبداد الفكري في أسوأ مفاهيمه، وهذا الفيلق المختار لم يكن أمامه أي اختيار إلا الطاعة الكاملة للفكر القطبي المؤسس الذي جرّد الإنسان من كل فاعلية، حتى يصح إيمانه بالحاكمية الإلهية. ويكفي للحكم على نظرية “سيد قطب” ما يقوله الدكتور “محمد سليم العوا”[4] “ومهما يكن الأمر في تأويل “سيد قطب” فإنه كان من الخطورة وبُعد الأثر، في نفوس أعداد كبيرة ممن كانوا في السجون والمعتقلات، من شباب الحركة الإسلامية، حتى إنهم اعتنقوه بظواهره، فنشأت فكرة تكفير المجتمع، وتكفير الأفراد، وتكفير من لم يكفرونه”.
ثالثا: الاعتدال الإسلامي
يبدو مصطلح الاعتدال الإسلامي بحاجة إلى تحديد وضبط، فهو مصطلح شديد الالتباس، يحوطه الغموض من كل جانب، وإنه من الإغراق في التجريد أن يفلت هذا المصطلح من سيرته الحركية، ومن واقعه المُعاش. فليست هناك قراءة واحدة “للإسلام السياسي” وبالتالي ليس ثمة مفهوم واحد للاعتدال الإسلامي، ربما يمكنني القول كمفهوم إجرائي إن “الاعتدال السياسي” هو موقف يلتزم أصحابه، من الإسلاميين، بتداول السلطة، وأنها للشعب أساسًا، والاعتراف التام بالمواطنة الكاملة، والالتزام بحقوق الإنسان ونبذ العنف، وهو تعريف يتكون من عنصرين:
العنصر الأول؛ يغلب عليه الطابع السياسي؛ وهو الالتزام بتداول السلطة، وأن الشعب هو صاحب القرار الأخير، وهذا يعني القبول بالديمقراطية.
والعنصر الثاني؛ يغلب عليه الطابع الاجتماعي والقانوني، وهو الاعتراف التام بالمواطنة الكاملة، وهذا يعني تجاوز البعد الأيديولوجي أثناء الحديث عن الآخر المختلف إثنيًا أو عقائديًا لصالح التشريع الذي يتساوى أمامه المواطنون جميعًا.
والمعيار الحاكم في هذه المعادلة هو العودة إلى الأصول الإسلامية التي تستطيع وحدها الفرز بين المشروع والممنوع في المعادلة السياسية بما يؤدي إلى التفسير الصحيح للنص، والتحرير الحقيقي للعقل، فلا تختفي حرية الإنسان، ولا تتراجع أصالة الإيمان.
ولو استنطقنا علم تاريخ الأفكار لرأينا الفكرة الديمقراطية يكمن وراءها المنطلق النفعي والاقتصادي، والمفهوم الليبرالي وراءه رصيد مذخور من علائق العداء والمناورة مع المحيط الإسلامي فكرًا وجماعة، وصحيح ما قيل بأن أوروبا المسيحية شيدت أكبر نظام للصور النمطية المعادية للإسلام، وأقامت متخيلاً جماعيًا في منتهى القسوة في أحكامه على التجربة الدينية والحضارية العربية والإسلامية، على الرغم من أنها حاولت إنجاز حضارتها باستيعاب حضارة الإسلام ومحاولة امتلاكها وتجاوزها، وهو ما حاول أن يفلسفه “فردنان بروديل” بقوله: إن الكراهية قد تكون مولدة للحضارة، وأن التقدم ينجزه من يعبّر عن قدرة خاصة على تصريف كراهية الآخرين، وهي مقولة خاطئة تمامًا من وجهة نظري؛ لأن العداء قد يكسب حربًا ولكنه لن يصنع تقدمًا بالمعنى الأخلاقي للحرب وبالمعنى الأخلاقي للتقدم.
لقد اكتسبت هذه الصيغة العدائية أبعادًا تعبوية، لها فعلها حتى اليوم، حيث تمكنت الآلة الدعائية من تقديم الإسلام في صيغة تعادي ما قبله، وتعادي الحضارة والتقدم العلمي.
إن الحديث عن “المقدس” الذي يحيل إلى الجمود والعنف، باعتباره خصوصية إسلامية، يفتقر إلى الصحة العلمية، ولا يعني ذلك نفي “المقدس” عن الأطروحة الإسلامية، بل إنه يعني من الزاوية الإبستيمولوجية أن حضور “المقدس” في المنظومات الفكرية، وفي مقدمتها الديمقراطية، هو أمر حتمي بعيدًا عن فلسفة النهايات التي تؤمن بنهاية التاريخ، ونهاية الأيديولوجيا ونهاية الرأسمالية..
إن استخدام أسلوب الهجوم المباشر الذي هو أقرب إلى ردود الأفعال منه إلى البحث العلمي الرصين ونحن نتحدث عن الإسلام والديمقراطية، والمسلمون والحضارة، هذا الأسلوب يتنكر للمحددات العلمية لعلم السياسة التي تحتم تحليل المفاهيم والغوص إلى أعماق الإنسان لغة ومقاصد حتى نتمكن من رسم خرائط معرفية مفهومة ومقروءة.
ويأتي في مقدمة هذه المفاهيم “مفهوم الاعتدال الإسلامي” خاصةً وأن “الثورات العربية” التي اشتعلت مع نهايات عام 2010 ولا تزال مشتعلة دون أن يدعي فصيل سياسي أنه صاحبها أو صاحب اليد الطولى فيها، بل هي في حقيقتها ثورات جموع وليست انشقاقات جماعات، فرضت بالضرورة على كل الجماعات العاملة في الحقل السياسي والدعوى أن تراجع مرجعياتها، وتحاول أن تتوقف بصدق أمام لحظة حساب قد تكون ضدها لا معها.
لقد كشفت “الثورات” أن هذه الجماعات لم تكن كُتلاً متماسكة، بل بدا أن القيادات قد انفصلت عن قواعدها منذ فترة مبكرة، وأنها وإن استعادت حماسة جماهيرها وقواعدها فإنها لم تستطع مصادقة هذه القواعد أو التفاعل معها مما جعلها تتعرض للانقسام والتشظي عند أول اختبار مبكر.
وأضرب مثالاً على ذلك بالجماعة السلفية عندما اصطدمت بالمشهد السياسي الراهن في مصر وحاولت التفاعل معه، لقد بدا واضحًا أننا أمام سلفيات لا سلفية واحدة.
سلفية مُرَوَّضَة استخدمها “السياسي” في مقاومة خصومه من التيار الإسلامي الأكثر حدة، وأرخى لها العنان وهي تتحرك دعويًا خاصةً مع الفئات الأكثر فقرًا؛ أي في البؤر الهامشية لعله يحتفظ من خلالها بمفتاح حبس التوتر في جغرافيا المناطق العشوائية.
والنوع الثاني؛ وهي السلفية الرافضة التي اختارت الهجرة عن المجتمع وقد نظرت وراءها بسخط إلى كل أنساقه الدينية والفكرية والسياسية، وأصبحت في عزلتها تتبنى التكفير منهجًا والهجرة رباطًا قد يعيدها يومًا إلى مقدمة الصفوف.
أما النوع الثالث؛ فهي السلفية المعارضة التي اختارت النزول إلى المعترك السياسي، لها تحت لواء “الثورة” لافتة خاصة، وهتافات مميزة وكأنها خشيت من استدعاء ماضيها فحاولت دخول المعترك السياسي بحاضر لا ينسف تشددها المعلن، ولا يبعدها عن دائرة الضوء، متجاهلة أن المرتقى صعب، وأن قبولها، باعتبارها من نخب الحاضر والمستقبل، يحتاج إلى ثورة في التفكير وثورة في التفسير؛ من خلال اجتهاد جديد لا تمتلك أدواته؛ لأن أغلب قياداتها جاءت من خلفيات ثقافية وتخصصية مدنية، وتلاقت مع الفقه الإسلامي من باب “الجهد الشخصي” لا “التكوين العلمي الأكاديمي”، وهذا قاسم مشترك بين أغلب قيادات التيارات الإسلامية التي حاولت بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير أن تتدفق على الأزهر الشريف معلنة أنها تسير وراءه، وتتبع خطواته.
وحتى تحوز هذه الشرعية كان عليها أن تعلن انتماءها إلى الفكر الوسطي الذي يتبناه الأزهر عبر تاريخه الطويل، والذي هو مضمون مناهجه حتى في لحظات الذبول الفكري والتراجع الحضاري، وكان طبيعيًا أن يكون حضور الأزهر لافتًا وطاغيًا بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير؛ لأنه يحتل مكانه الطبيعي في التراث المصري..
وفي خضم هذه اللحظة التاريخية الفارقة بدا الأزهر وكأنه الأقدر على تحقيق التعايش مع كافة المنظومات ذات المرجعيات الدينية وذات المرجعيات الليبرالية، وهو ما بدا في وثيقة الأزهر الأولى، والتي لم يكن غريبًا فيها على الأزهر أن يقبل صيغة الدولة الوطنية الديمقراطية الدستورية الحديثة، ولم يكن سهلاً على التيار الليبرالي أن يتخلى عن مصطلح الدولة المدنية، ولم يكن سهلاً أيضًا على التيار الإسلامي أن يتخلى عن فكرة السيادة لله لصالح المصطلح القانوني الذي يؤكد السيادة للشعب، ليظل ما هو ديني في مكانه الثابت والمتعالي، وما هو دنيوي في موقعه المتغير والنسبي، ولكن سرعان ما تغيرت المواقف وتنابذ الفرقاء.
والحصيلة النهائية التي تصب في صالح “مفهوم الاعتدال الإسلامي”؛ أن كل هذه التيارات، في اللحظة “الثورية”، تراضت على إدخال عنصر الزمن في حركتها الواقعية، ولا ينبغي أن يخضع هذا التراضي لفكرة “الضرورة” التي ترتقي بها إلى الوضع الاستثنائي، بل إلى نظرية التطور التي تُعد أمرًا معتادًا في كل محاولة بشرية تنتقل فيها الأفكار من “التجريد” إلى “التحديد”، ومن “العمومية” إلى “التعيين”.
وفي هذه “اللحظة الثورية” أصبح الحديث حول التلاقي ممكنًا بين التيارات الإسلامية والتيارات الليبرالية، وأصبح الحديث عن الديمقراطية، موضوعاً وشكلاً، أمرًا مقبولاً من الطرفين، والصراع لم يعد حول مبادئ، وإنما حول خيارات بعضها لصالح حوار الأفكار، وبعضها لصالح رؤى واقعية تتعلق بقواعد بشرية ضاغطة أو وقائع انتخابية ملحة، ولكن انتصار الديمقراطية، كما يقول جاك رانسبير في كتابه كراهية الديمقراطية، لا يعني فحسب منح الشعب منافع الدولة الدستورية، والانتخابات الحرة، والصحافة الحرة، ولكن أيضًا منحه الفوضى، أو على حد تعبير وزير الدفاع الأمريكي في حرب الخليج الثانية إننا منحنا الشعب العراقي الحرية، والحرية الآن هي أيضًا حرية فعل الشر. وهذا ما تعاني منه “ثورات الربيع العربي”، ولهذا أسبابه ودواعيه التي ليس من هدف هذه الدراسة الحديث عنها.
إن التلاقي الذي كان ممكنًا بين الإسلاميين وغيرهم صنعه أمران:
الأمر الأول؛ الحضور اللافت للتيارات الإسلامية في لحظة التماهي مع الثورة وفي لحظة الإحساس بأنها انتصرت.
الأمر الثاني؛ الظهور الواقعي الذي تجسد في الانتخابات البرلمانية والذي لم يكن منظورًا ولا محسوبًا من كل التيارات الأخرى، خاصةً وأن التيار الإسلامي شهد مصادرة وغيابًا قسريًا عن المشهد العام وكان ظهوره مجرمًا، وإعلان فكره محرمًا، وهذا الظهور الواقعي يؤكد أن التجريف السياسي لكل صور الاعتدال، فيما قبل الخامس والعشرين من يناير، كان كبيرًا وصادمًا ولكن الوعي به كان ضعيفًا وقاصرًا، لقد ظن بعض أطياف التيار الليبرالي أن حضورهم على الساحة السياسية لا يمكن أن يفسر على أنه تبرير لنظام جائر، بل هي مقاومة بالأدوات السياسية المتاحة، وتجاهلوا أن حضورهم كان استدعاءً مقصودًا ومنظمًا، وأن إقصاءهم كان مقصودًا ومرتبًا. وبدا واضحًا أنهم يفتقدون إلى الخيال السياسي قبل الثورة وبعدها على السواء.
وعلى الرغم من أن تيار الإسلام السياسي قد أثبت أنه الأقدر على الحشد والتنظيم، فإنه لم يكن الأقدر على التأويل والاجتهاد. مما وضع جدارته السياسية على المحك، إما أن تكون التجربة إضافة إلى الرصيد أو خصمًا منه، وفي ظل الظروف الجديدة التي يعيشها العالم العربي اليوم، فإن الخصم من الرصيد سيكون ثمنه غالبًا، وفي المقابل، فإن الإضافة إلى الرصيد ستكون نتائجها الإيجابية بعيدة المدى محليًا وإقليميًا وعالميًا. وتستدعي بالضرورة توافقًا وطنيًا، وهذا لا يعني أن تيار الإسلام السياسي لا يعي قيمة الديمقراطية، بل إنه استفاد منها في عصر النظام السابق، واستطاع من خلال الصندوق الانتخابي أن يكتسح معظم النقابات الفاعلة ليشكّل قوة ضغط لم يستطع النظام السابق احتمالها وكان عنيفًا وإقصائيًا في المصادرة والرد.
إلا أن الصندوق الانتخابي وحده، رغم إغراءاته، لابد أن يتعثر إذا لم تصحبه ثقافة ديمقراطية تضع الكفاءة فوق الشخصنة، ومصلحة الوطن فوق الجماعة، وهو ما كان ينبغي أن يدركه قادة التيارات السياسية في مصر، حتى لا تفلت منهم صورة المستقبل، وكان على الإسلاميين أن يقدموا البدائل، وأن يجتهدوا في جعلها وعاءً عامًا يلتقي حوله كل ألوان الطيف السياسي، وأن يكون الخلاف حول التفاصيل وليس حول المبادئ، ولكن فشل التيار الإسلامي في إدارة الدولة، محاولاً إحكام قبضته من خلال منطق الجماعة، ليتراجع احترام القانون، ويستبعد فكرة المصلحة العامة، مثَّل انتحارًا سياسيًا فقدت معه الدولة استقرارها وأحست الأمة بغموض حاضرها ومستقبلها، فجاءت الثلاثين من يونيو نهاية لإسلام سياسي مأزوم وقيادات خائبة واعتمد الثلاثين من يونيو على شرعية محكمة، لا تستند فقط إلى الجماهير الحاشدة، بل تستند أيضًا إلى مقومات الدولة الحديثة في مصر منذ نشأتها في عهد محمد علي، في مواجهة شرعية متآكلة جاءت بها صناديق البطون الخاوية، وعصبية الجماعات، وآليات الحصول على الصوت الأجوف، وهي بضاعة مزجاة، بما لها وما عليها.
وفي النهاية أستطيع أن أقول إن الاعتدال السياسي كمفهوم يتجاوز جغرافيًا المناطق سياسيًا وفكريًا، إنه مسألة تاريخية لها حضور مستمر في الوعي الإسلامي العام حيث يختلط في ذاكرته الخاص والعام، والائتلاف والاختلاف، والمحاسن والأضداد بتعبير الجاحظ، ويبقى على المتصارعين في الحلبة السياسية أن يدركوا خطوط التمايز بين الاعتدال والتطرف..
وأعتقد أن الخلط بينهما مسألة نفسية ترفض حضور نموذج الاعتدال الإسلامي، وغياب نموذجيَّ التطرف العلماني، والتطرف الديني، إن روح الديمقراطية ترفض الإكراه السياسي، وتدين الإقصاء الفكري، وتنبذ العصبية الدينية والاجتماعية، وبدلاً من العودة إلى التاريخ للحديث بحثاً عن مواطنة منقوصة، علينا أن نبحث نحن المواطنين، مسلمين وغير مسلمين، عن حقوقنا في مواجهة إيديولوجيا الحاكمية.
وأختم بسؤال أراه مهمًا: هل يستطيع الإسلام السياسي بكل صوره وتياراته أن يراجع مقولاته الرئيسة، وأن يحاسب نفسه بأسلوب إعلان الحقيقة، ونقد الطريقة؟ وهل يستطيع أن يكون تيارًا يعمل لصالح الوطن بمنهجية الوفاق لا الشقاق؟
إن الإسلام السياسي وحده الذي يستطيع أن يجيب، ووحده الذي يستطيع أن يفعل، وأتمنى أن يفعل.
لسنا نريد أن نحجر على فكر، ولا نريد أن يستبد تيار بالمشهد، وهنا أريد أن نتذكر كلمة الحكيم غاندي “لا أريد لبيتي أن يكون مستورًا من جميع الجهات، ولنوافذي أن تكون مقفلة، أريد أن تهب على بيتي ثقافات كل الأمم بكل ما أمكن من حرية، ولكنني أنكر عليها أن تقتلعني من جذوري”.
الهوامش
[1]. راجع في كل ذلك بالتفصيل: فاروق أبو زيد، عصر التنوير العربي، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1978.
[2]. انظر: محمد شحرور، الكتاب والقرآن قراءة معاصرة، ثلاثة مجلدات، بيروت: المكتبة الثقافية، ط1، 1995، ص724-725.
[3]. لمعرفة ثقافة شحرور التراثية يراجع “الكتاب والقرآن قراءة معاصرة”، م، س.
[4]. محمد سليم العوا، المدارس الفكرية الإسلامية، بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2016، ص441.