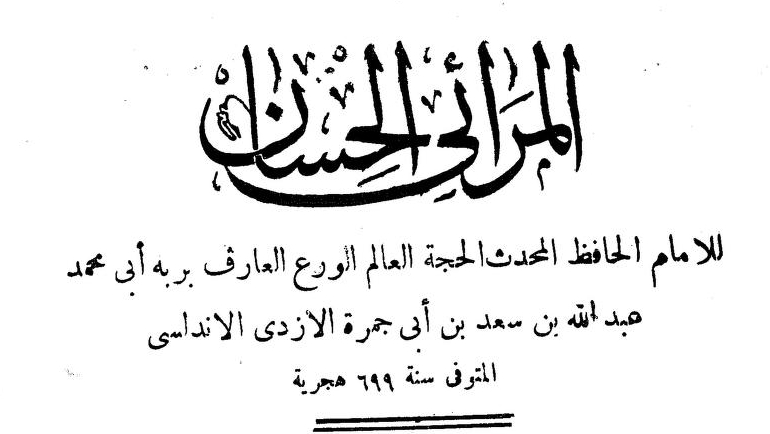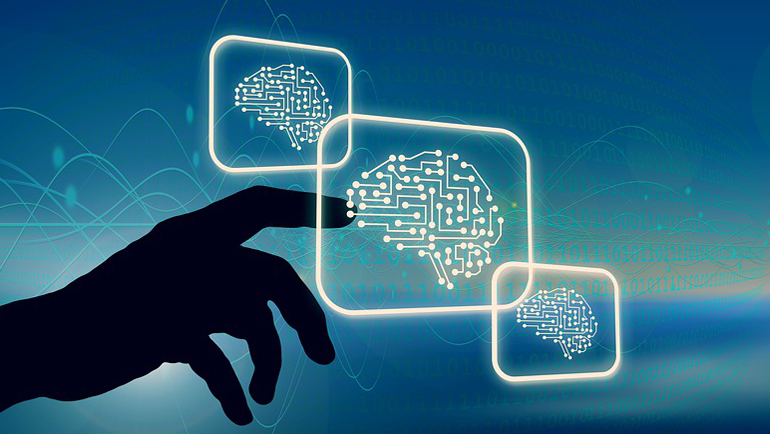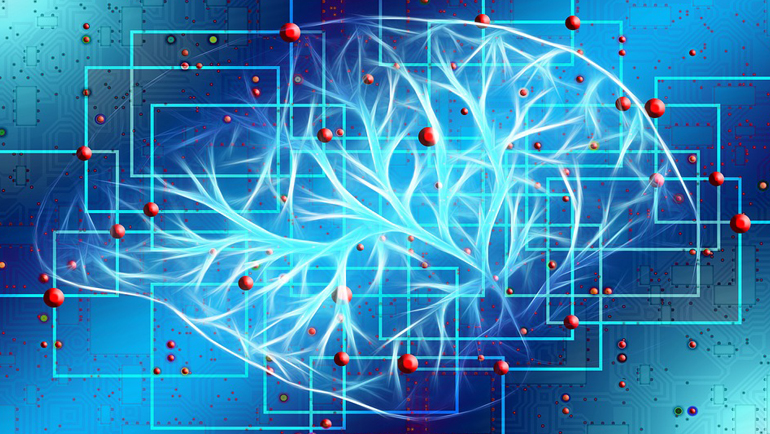إنه وإن اختلفت تعريفات العلماء لمقاصد التشريع من حيث العبارة، فقد اتفقت من حيث المعنى، فهي الغايات والحكم التي تتوخاها الشريعة في أحكامها، والعلل التي من أجلها أنزلت الشريعة أو قامت الأحكام، وقد ثبت عند جميع العلماء بالاستقراء وتتبع الأحكام المختلفة في الشريعة الإسلامية أن المقصد الأصلي منها هو تحقيق مصالح العباد وحفظ هذه المصالح عليهم ودفع المفاسد والأضرار عنهم
كما اتفق جميع العلماء منذ الإمام الغزالي (توفي 505ﻫ) إلى اليوم، على أن مقاصد الشرع تنقسم من حيث الأهمية إلى ثلاث مراتب: الضرورية والحاجية والتحسينية، ووضحوا المراد بكل مرتبة.. إلا أنه مما يشد الانتباه بقوة كلام أغلبهم في بيان المراد بالتحسينيات من حيث حصرهم مكارم الأخلاق ضمن هذه المرتبة التي تصنف من حيث الحاجة إليها وأهميتها في أدنى مراتب المقاصد الشرعية بعد الضروريات والحاجيات…
فهل مكارم الأخلاق، كما وصفوا، تقع موقع التحسين والتزيين، ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات بحيث لا يتضرر الناس بتركها، ولا يلحقهم حرج وضيق بفقدها؟ وهل يمكن أن تقوم قائمة للدين أو النفس أو العقل أو النسل أو المال بدونها؟ وهل يصح أن تكون البعثة المحمدية منحصرة في تتميم أوصاف زائدة على ما هو ضروري وحاجي متمثلة في مكارم الأخلاق؟
للإجابة عن هذه الأسئلة يقتضي المنهج العلمي السليم البدء بالتعريفات للمصطلحات الواردة أعلاه، وإيراد أقوال العلماء في شرحها وبيان معانيها.. ثم التحقيق في دعوى حصر مكارم الأخلاق ضمن قسم التحسينات.
أولا: تعريف المقاصد لغة واصطلاحا
المقاصدُ في اللغة[1]: جمع مَقْصِدٍ، والمقصد: مصدر ميمي مأخوذ من الفعل “قصد” يقال: قَصَدَ يقْصِد قصْداً وَمقْصدا.. وقد ذكر علماء اللغة أن القصْد يأتي لمعان أظهرها:
المعنى الأول: الاعتماد، والأمُّ، وإتيان الشيء، والتوجّهُ، تقول: قصده، وقَصَدَ له، وقصَد إليه، يقصده إذا أمَّه، ومنه أيضاً أقصده السهم إذا أصابه فقتل مكانه. ومن هذا المعنى ما في صحيح مسلم “فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصَدَ له فقتله[2].”
المعنى الثاني: الغرض والغاية، يقولون: تنجّزْتُ منه أغراضي ومقاصدي.
المعنى الثالث: استقامة الطريق. ومنه قوله تعالى: ﴿وَعَلَى اللهِّ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِر﴾ (النحل: 9) قال ابن جرير: “والقصد، من الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه”.. ويقال: طريق قاصد: سهل مستقيم، وسفر قاصد: سهل قريب، ومنه قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاتَّبَعُوكَ﴾ (التوبة: 42)؛ أي موضعا قريبا سهلاً.
المعنى الرابع: العدل، والتوسط وعدم الإفراط، ومنه قوله تعالى: ﴿وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ﴾ (لقمان: 19)، وقوله صلى الله عليه وسلم: “القصدَ القصدَ تبلغوا[3]“، وقول جابر بن سمرة: “كنت أصلي مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاته قصداً وخطبته قَصْداً[4]“؛ أي وسطاً بين الطويلة والقصيرة.
المعنى الخامس: الكسر في أي وجهٍ كان، تقول: قصدتُ العود قَصْداً كسرته، وقيل: هو الكسر بالنصف قصدته أقصده، وقصدته فانقصد وتقَصَّد والقِصْدة: الكِسْرة منه.
والظاهر من عرض المعاني اللغوية للمقاصد أن التي تتناسب مع المعنى الاصطلاحي كما سيأتي هي المعاني الأربعة الأولى: الأَمُّ، والاعتماد، وإتيان الشيء، والتوجه. وكلها تدور حول إرادة الشيء والعزم عليه، وملاحظ أيضا في مقاصد الشريعة معاني الاستقامة، والعدل والتوسط، أما المعنى الأخير فمستبعد قطعاً.
أما المقاصد من حيث الاصطلاح فلا يوجد لها تعريف متفق عليه، إلا أنه من المؤكد أن المعتمد في ذلك المآخذ اللغوية السابقة.
وسأقتصر على إيراد تعريفين اثنين أراهما الأفضل فيما ذكره العلماء المعاصرون من التعريفات، وهما:
- تعريف الدكتور أحمد الريسوني: “مقاصد الشريعة هي الغايات التي وُضِعَتِ الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد[5]“، وهذا تعريف أشاد به غير واحد من المعاصرين، إلا أنه لو استبدل كلمة “أنزلت” بكلمة “وضعت” لكان أفضل لما في الأولى من الإشارة الواضحة إلى تنزيل الشريعة من رب العزة.
- تعريف الدكتور عبد الرحمن الكيلاني لمقاصد الشريعة وهو أنها: “المعاني الغائية التي توجهت إرادة الشارع إلى تحقيقها عن طريق أحكامه[6]“؛ فخرج بقيد “الغائية” العلل التي تترتب عليها الأحكام، وعبارة “التي اتجهت إرادة الشارع إلى تحقيقها” مستفادة من المعنى اللغوي للفظ (مقصد)؛ أي سار اتجاهه، ثم للدلالة على أن العلل الغائية مقصودة للشارع وليست مجرد نتائج لتطبيق الأحكام الشرعية، وأيضا لبيان أن المقاصد المعتبرة ما اعتبره الشرع وليست المنبنية على مقتضى تشهي العباد وأغراضهم.
- وبينت عبارة “عن طريق أحكامه” أنه لا سبيل إلى تحقيق المقاصد المراعاة شرعا إلا سبيل الأحكام الشرعية، وأن هذه الأحكام شرعت وسائل لإقامة هذه المقاصد، وطرقا لتجسيدها في الواقع؛ بمعنى أن الأحكام هي وسائل لتحقيق غايات مرسومة لها شرعا، وليست هي غايات في حد ذاتها، وهذا ما ألمح إليه الإمام الشاطبي بقوله: “لأن الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسها وإنما قصد بها أمور أخرى هي معانيها، وهي المصالح التي شرعت لأجلها[7].”
ثانيا: أقسام المقاصد من حيث الأهمية
لما كانت مقاصد الشريعة تهدف إلى تحقيق مصالح الناس، ولما كانت هذه المصالح متفاوتة من حيث الأهمية، فقد قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: ضرورية وحاجية وتحسينية، قال الإمام الشاطبي رحمه الله (توفي 790ﻫ): “وتكاليف الشريعة كلها راجعة إلى مصالح العباد في دنياهم وأخراهم، ومصالح الدنيا والآخرة ثلاثة أقسام كل قسم منها في منازل متفاوتة[8]“، وقال: “وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: أحدها؛ أن تكون ضرورية، والثاني؛ أن تكون حاجية، والثالث؛ أن تكون تحسينية[9].”
- 1. المصالح الضرورية: قال الشاطبي: “هي ما لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الآخرة فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين[10]“، وقال بأن مجموع الضروريات خمسة، وهي: حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل[11]“، وذكر أن “الأمة اتفقت، بل سائر الملل، على أن الشريعة وضعت لحفظ هذه الخمس، وعلمها عند الأمة ضروري، ولم يثبت ذلك بدليل معين ولا شهد لذلك أصل معين يمتاز برجوعها إليه، بل علمت ملاءمتها للشريعة بمجموع أدلة لا تحصر في باب واحد[12].”
- المصالح الحاجيّة: ومعناها المصالح الواقعة في محل الحاجة، قال الجويني (توفي 478ﻫ): “ما يتعلق بالحاجة العامة، ولا ينتهي إلى حد الضرورة[13]“. وقال الشاطبي: “هي المصالح التي يُفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوات المطلوب، فإذا لم تراع، تلك الحاجيات، دخل على المكلفين، على الجملة، الحرج والمشقة ولكن لا يبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة[14]“؛ (أي المصالح الضرورية).
وقوله “على الجملة”؛ لأن الحرج والمشقة قد يلحق بعض الناس دون بعض بخلاف الضروريات، فإن الفساد الناجم عن الإخلال بها يطال كل الناس.
والمقاصد الحاجية كما قال الشاطبي جارية في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات. ومثالها من المعاملات تجويز الإجارة قال الجويني: “.. فإنها مبنية على مسيس الحاجة إلى المساكن مع القصور عن تملكها، وضنة ملاكها بها على سبيل العارية، فهذه حاجة ظاهرة غير بالغة مبلغ الضرورة المفروضة في البيع وغيره[15].”
- المصالح التحسينية: وهي التي إذا فقدت لا يقع الإخلال بأمر ضروري ولا حاجي، وذلك لأنها جرت مجرى التحسين والتزيين[16]“. وقد عرفها إمام الحرمين الجويني بقوله: “.. ما لا ينتسب إلى ضرورة ولا إلى حاجة وغايته الاستحثاث على مكارم الأخلاق[17]“. وبقوله أيضا: “ما لا يتعلق بضرورة خاصة ولا حاجة عامة، ولكنه يلوح فيه غرض في جلب مكرمة أو نفي نقيض لها[18]“. وقال الرازي (توفي 606ﻫ) في المحصول: وأما التي لا تكون في محل الضرورة ولا الحاجة فهي التي تجري مجرى التحسينات؛ وهي تقرير الناس على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم[19]، وقال الشاطبي: “وأما التحسينات فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق[20].” وبنحو هذا قال ابن السبكي (توفي 771ﻫ) والزركشي (توفي 794ﻫ) وابن أمير الحاج (توفي 879ﻫ) والأمير بادشاه (توفي 972ﻫ) والشوكاني (توفي 1250ﻫ)[21] وغيرهم كثير.
وعرفها من المعاصرين الدكتور الخادمي والدكتور محمد اليوبي بقولهما: “وهي التي تليق بمحاسن العادات ومكارم الأخلاق، والتي لا يؤدي تركها غالباً إلى الضيق والمشقة[22]” والدكتور البوطي بقوله: “وأما التحسينات: فإن تركها لا يؤدي إلى ضيق، ولكن مراعاتها متفقة مع مبدأ الأخذ بما يليق، وتجنب ما لا يليق، ومتمشية مع مكارم الأخلاق ومحاسن العادات[23].” وقال الدكتور حمادي العبيدي: “المصالح التحسينية هي كل ما يعود إلى العادات الحسنة، والأخلاق الفاضلة، والمظهر الكريم والذوق السليم، مما يجعل الأمة الإسلامية أمة مرغوبا في الانتماء إليها والعيش في أحضانها[24]” وبنحو من هذا قال غيرهم من المعاصرين[25].
ومثالها قال الشاطبي: “كالطهارات بالنسبة إلى الصلوات، على رأي من رأى أنها من هذا القسم، وأخذ الزينة من اللباس ومحاسن الهيئات والطيب وما أشبه ذلك، وانتخاب الأطيب والأعلى في الزكوات والإنفاقات، وآداب الرفق في الصيام، وبالنسبة إلى النفوس؛ كالرفق والإحسان، وآداب الأكل والشرب، ونحو ذلك، وبالنسبة إلى النسل؛ كالإمساك بالمعروف، أو التسريح بالإحسان، من عدم التضييق على الزوجة، وبسط الرفق في المعاشرة، وما أشبه ذلك، وبالنسبة إلى المال؛ كأخذه من غير إشراف نفس والتورع في كسبه واستعماله، والبذل منه على المحتاج، وبالنسبة إلى العقل؛ كمباعدة الخمر ومجانبتها وإن لم يقصد استعمالها بناء، على أن قوله تعالى: ﴿فاجتنبوه﴾، يراد به المجانبة بإطلاق[26].”
وقد نص غير واحد من العلماء على أن المقاصد الضرورية في الشريعة الإسلامية أصل للحاجية والتحسينية، والحاجية مكملة للضرورية، والتحسينية مكملة للضرورية، أو مكملة للحاجية وهي مكملة للضرورية[27]، والمطلوب شرعا المحافظة على الضروريات في كمالها، وكمالها في الحفاظ على الحاجيات والتحسينيات، ولذلك اعتبر الشاطبي الحاجيات والتحسينيات من أفراد الضروريات وأن توافرها من كمال الضروريات[28]، وقال “بأنه ينبغي المحافظة على الحاجي وعلى التحسيني للضروري[29].”
ذلك أن الأمور الحاجية والتحسينية حائمة حول هذا الحمى؛ إذ هي تتردد على الضروريات تكملها[30]، فالتحسينيات تتخذ وصف الحائل دون تسرب أسباب الإهدار للحاجي، وتعمل على زيادة الإكمال والتتميم، وكذلك نفس الأمر في الحاجيات مع الضروريات، فيكون بحفظ التحسيني صون للضروري انتهاء.
أما فائدة هذا الترتيب، فحيث تعارضت مصلحتان وجب تقديم الأصل على ما هو مكمل.
والحاصل أن المقاصد في الشريعة الإسلامية لا تقتصر على الضروري، وإنما تشمل المرتبتين الحاجي والتحسيني كذلك في وحدة واحدة، يمثل فيها الضروري الحد الأدنى للمقصد الذي لا تقف الشريعة عند تطلب تحقيقه، وإنما تتطلع إلى كماله في حدود الإمكان دون إفراط أو تفريط.
تعريف الأخلاق
الأخلاق في اللغة: جمع خُلُق، والخُلُق: هو السجية والطبع، مأخوذ من مادة: (خ ل ق) وقد جاء في معناها: قال الجوهري في مختار الصحاح[31]: “الخَلْق: التقدير… والخلِيقَة: الطبيعة… والخِلْقة بالكسر: الفطرة… والخُلْق والخُلُق: السجيّة” يقول ابن فارس: ومن هذا المعنى؛ (أي تقدير الشيء) الخلق: هو السجية؛ لأن صاحبه قد قُدَّر عليه. يقال: فلان خليق بكذا؛ (أي قادر عليه وجدير به)، والخلاق: النصيب؛ لأنه قد قدر لكل أحد نصيبه[32]، وعند الفيروزآبادي: “الخَلْق” التقدير… الخُلق بالضم وبضمتين: السجية والطبع والمروءة والدين[33].
وقال ابن منظور: “الخُلُق هو الدين والطبع والسجية، وحقيقته: أنه وصف لصورة الإنسان الباطنة، وهي نفسه، وأوصافها ومعانيها المختصة بها، بمنزلة الخُلُق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها[34].”
وقال الراغب الأصفهانى: الخَلْق أصله: التقدير المستقيم، والخَلْقُ والخُلُق فى الأصل واحد لكن خص الخَلْقُ بالهيئات والأشكال والصور المدركة بالبصر، وخص الخُلُقُ بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة[35]، وقال الغزالي: “الخَلق والخُلق عبارتان مستعملتان معا يقال فلان حسن الخلق والخلق؛ أي حسن الباطن والظاهر فيراد بالخَلق الصورة الظاهرة ويراد بالخُلق الصورة الباطنة، وذلك لأن الإنسان مركب من جسد مدرك بالبصر ومن روح ونفس مدرك بالبصيرة، ولكل واحد منهما هيئة وصورة إما قبيحة وإما جميلة فالنفس المدركة بالبصيرة أعظم قدرا من الجسد المدرك بالبصر..[36]“، فالإنسان على هذا خَلقٌ مُتَخلّق. والخلاق: ما اكتسبه الإنسان من الفضيلة بخلقه[37]، قال تعالى: ﴿مَا لَهُ فِي الْاَخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ﴾ (البقرة: 102)، والخلاق أيضاً قيل: النصيب، وقيل: الدين، وقيل: القوام، وقيل الخلاص، وقيل القدر[38].
والأخلاق اصطلاحاً: عرفها الغزالي بأنها “عبارة عن هيئة في النفس راسخة، عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية، فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلاً وشرعاً، سميت تلك الهيئة خلقاً حسناً، وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة، سميت الهيئة التي هي المصدر خلقاً سيئاً، وإنما قلنا إنها هيئة راسخة؛ لأن من يصدر منه بذل المال على الندور لحاجة عارضة، لا يقال خلُقه السخاء ما لم يثبت ذلك في نفسه ثبوت رسوخ. وإنما اشترطنا أن تصدر منه الأفعال بسهولة من غير روية؛ لأن من تكلف بذل المال أو السكوت عند الغضب بجهد وروية، لا يقال خلقه السخاء والحلم[39].”
وكذا قال الجرجاني[40] وربما نقله عن الغزالي، وقال الشيخ ابن عاشور: “الخلق: السجية المتمكنة في النفس، باعثة على عمل يناسبها من خير أو شر، وتشمل طبائع الخير وطبائع الشر، ولذلك لا يعرف أحد النوعين من اللفظ إلا بقيد يضم إليه، فيقال: خلق حسن، وفي ضدّه: خلق قبيح، فإذا أطلق عن التقييد انصرف إلى الخلُق الحسن[41].”
وقد حاول عبد الرحمن الميداني من المعاصرين تلخيص وتسهيل العبارة في تعريف الأخلاق اصطلاحاً، فقال: “الخلق: صفة مستقرة في النفس فطرية أو مكتسبة، ذات آثار في السلوك محمودة أو مذمومة[42].”
فالحاصل من كل التعاريف أعلاه أمران:
- أن من الأخلاق ما هي صفات طبيعية في خِلقة الإنسان الفطرية، وأخرى صفات مكتسبة بحيث تصبح سجية ملازمة له لا تنفك عنه إلا فيما ندر.
- أن للأخلاق جانبين؛ جانبا نفسيا باطنيا، وجانبا سلوكيا ظاهريا.
والأخلاق الإسلامية هي الصفات والسلوكيات التي أقرها الاسلام في طريقة التعامل مع الله تعالى والنفس والمجتمع، فيشمل هذا أحكام الدين كله عقيدة وشريعة.
ولما كان سلوك الإنسان موصولا بما هو مستقر فى نفسه من معانِ وصفات، قال الغزالي: “فإن كل صفة تظهر فى القلب يظهر أثرها على الجوارح حتى لا تتحرك إلا على وفقها لا محالة…[43]“، فقد أكد الإسلام على إصلاح النفوس وتزكيتها ليكون السلوك قويما ومحققا لمصلحة المكلف في العاجل والآجل..
التحقيق في دعوى حصر الأخلاق ضمن التحسينيات
عودا على بدء، فقد ذكرنا صنيع العلماء في عد مكارم الأخلاق من جملة المقاصد التحسينية للشريعة الإسلامية[44] مما يعطي انطباعا أن الأخلاق هي من الكماليات، وهنا نحن من حيث الفهم لهذا الصنيع بين أمرين اثنين؛ فإما أن يحمل كلامهم على الظاهر وهذا لا يسلم من الاعتراض، ولا يصح بإطلاق للأسباب التي ستأتي، وإما أن يكون هؤلاء الأعلام قد أغفلوا حقيقة الأخلاق في شريعة الإسلام، وهذا لا يستقيم، فهم في العلم بالشرع قامات عالية وقمم شامخة.
ولما لا يصح في الاعتبار هذا ولا ذاك، وجب بيان معنى كلام العلماء الأعلام في حصر مكارم الأخلاق في مرتبة التحسينيات ليظهر وجهه وتتبين حقيقته بحول الله تعالى، فنقول والله المستعان: “لقد عرف العلماء المعاصرون المقاصد بعبارات مختلفة، لكنها تتفق في كونها غايات أنزلت الشريعة الإسلامية لأجل تحقيقها لمصلحة العباد في الدارين”.
ولقد نص القرآن المجيد في كثير من آياته على كون تزكية الإنسان وتهذيب نفسه والسمو بها إلى الغاية التي خلق لأجلها، إفراد الخالق سبحانه بالعبودية، مقصود بعث الرسل عمومًا، وخاتمهم رسول الإسلام خصوصًا، قال تعالى: ﴿هو ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْاُمِّيِّينَ رَسُولاً مّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمُ ءايَـٰتِهِ وَيُزَكّيهِمْ وَيُعَلّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ﴾ (الجمعة: 2)؛ ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ ءايَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: 151)؛ ﴿لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُومِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ اَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمُ ءايَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِين﴾ (ءال عمران: 164).
فمنطوق هذه الآيات دلالة واضحة في كون الرسول، صلى الله عليه وسلم، بُعث إلى الناس لتزكيتهم، وإذا كانت تلاوة آيات الكتاب وتعليم معانيه وأحكامه وحكمته هي نفسها وسائل ومعابر للتزكية، فالنتيجة أن التزكية هي العلة الغائية والمقصد الشرعي لإرسال الرسل وتنزيل الرسالات في هذه الحياة[45].
والتزكية هي عينها التحلي بمكارم الأخلاق والتخلي عن سيئها، قال ابن كثير، رحمه الله، في معنى هذه الآيات السالفات: “.. ويزكيهم؛ أي يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية”[46]، وبهذا أيضا قال السعدي رحمه الله: “(ويزكيكم)؛ أي يطهر أخلاقكم ونفوسكم بتربيتها على الأخلاق الجميلة وتنزيهها عن الأخلاق الرذيلة، وذلك كتزكيتهم من الشرك إلى التوحيد، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الكذب إلى الصدق، ومن الخيانة إلى الأمانة، ومن الكبر إلى التواضع، ومن سوء الخلق إلى حسن الخلق، ومن التباغض والتهاجر والتقاطع إلى التحاب والتواصل والتوادد، وغير ذلك من أنواع التزكية[47].”
وأبلغ وسيلة وأهمها لتحصيل تزكية النفس للإنسان، بعد الإيمان بالله تعالى، هي ما شرعه، جل وعلا، من العبادات والقربات؛ كالصلاة والزكاة والصوم والحج ودوام الذكر وسائر الواجبات.فلم تشرع العبادات بكافة صورها طقوسا ولا شعائر مجردة من الآثار والمعاني، بل ذلك أن كل عبادة تحمل في جوهرها قيمة أخلاقية مطلوب أن تنعكس على تصرفات المتدين كلها، فهي؛ (أي العبادات) لها آثار ذات طبيعة سلوكية، والآثار السلوكية، يقول الدكتور طه عبد الرحمن: “هي بالذات المسمى الذي وضع لفظ “الأخلاق” للدلالة عليه، وإذا كان الأمر كذلك، وجب أن يكون الغرض الأول من الشعائر هو تحصيل الأخلاق، بحيث تكون قيمة الشعيرة معلقة بقيمة الخلق الذي تحتها، إذا زاد فضل الخلق زادت درجة الشعيرة، وإذا نقص نقصت. كما تكون قيمة أداء الشعيرة معلقة بمدى تحقق هذا الخلق في سلوك مؤديها، إذا حسن السلوك حسن الأداء، وإذا ساء السلوك ساء الأداء[48].
فالحاصل أن الغاية الخلقيَّة والسلوكيَّة هي المبتغَاة من وراء التكليف بالعبادة في إجمالها وفي تفصيلها، بل الأمر أعم من ذلك، فتزكية النفس تكون بالدين وإقامة الدين بتزكية النفس والدين هو حسن الخلق، قال الشاطبي: “الشريعة كلها إنما هي تَخَلُّقٌ بمكارم الأخلاق[49]“، وقال مصطفى صادق الرافعي: “وما الإسلام في حقيقته إلا مجموعة أخلاق قوية ترمي إلى شد المجموع من كل جهة[50].”
فليست الأخلاق فضائل منفصلة، وإنما هي حلقات متصلة في سلسلة واحدة هي دين الاسلام فمن العقيدة تنشأ الأخلاق، وهي بدورها تسري في العبادات وتتفاعل مع المعاملات، ولم ينفك حكم شرعي عن واحدة أو أكثر من القيم الأخلاقية، كما لم ينفك أبدا خلق عن حكم شرعي، وقد كانت دائما جهود الفقهاء والأصوليين في الاجتهاد منصبة على إقامة الفقه على الأخلاق وتوجيه الأخلاق بالفقه. فهذان الأخلاق والفقه ينزلان مرتبة واحدة، فبقدر ما يكون هناك فقه يكون هناك تخلق وبقدر ما يكون هناك تفقه يكون تخلق…
والخلق، كما أسلفنا، كلمة تعني في لسان العرب: الدين[51]، والدين حسن الخلق[52]، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: “ما مِن شيءٍ أثقل في الميزان مِن حُسن الخُلق[53]“، وروى الإمام مسلم عن النواس بن سمعان الأنصاري، رضي الله عنه، أنه سأل رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن البر، فقال: “البر حسن الخلق[54]“. والله تعالى يقول في محكم كتابه: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وَلَكِنَّ الْبِرُّ مَنْ ـامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيئينَ وَءاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءاتَى الزَّكَاةَ، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ (البقرة: 177).
يقول ابن القيم رحمه الله: “وهذا يدل على أن حسن الخلق هو الدين كله، وهو حقائق الإيمان وشرائع الإسلام[55]“، ويقول رحمه الله: “الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين[56]” وقال ابن حزم رحمه الله: “من جهل معرفة الفضائل، فليعتمد على ما أمره الله تعالى ورسوله، صلى الله عليه وسلم، فإنه يحتوي على جميع الفضائل[57].”
فالدين هو الأصل في مكارم الأخلاق؛ وهو الأصل في التقويم الأخلاقي للأفعال؛ والقواعد الخلقية موصولة بالقواعد الدينية وصلا لا انفصام فيه، فالدين كله أخلاق، أحكاما ومقاصد.
ولما كانت مراتب مقاصد الدين الإسلامي عند العلماء ثلاثة: الضرورية والحاجية والتحسينية، فكذلك هي المراتب في لازمه وفي ما لا ينفك عنه أي حسن الخلق، فمنه الضروري الذي يختل بفقده ليس نظام السلوك فحسب، بل نظام الحياة كلها، كما منه ما يعد في مرتبة الحاجي ومنه ما يقع موقع التحسين والتكملة والتزيين، وهذا ما اعتبره علماء الأصول من المقاصد التحسينية والكمالية.
فليست كل الأخلاق جملة من الصفات الحسنة التي تكمل سلوك الأشخاص، وإنما منها مجموعة من الصفات الضرورية لهذا السلوك، بحيث إذا فقدها الفرد، نزل عن رتبته في الأنام وعد في صفات الأنعام، كما ليست الأخلاق كلها جملة من محاسن العادات التي يتصف بها تعامل المجتمعات فيما بينها، وإنما منها مجموعة من العادات الضرورية لهذا التعامل، بحيث إذا فقدها المجتمع اختل نظام الحياة فيه وأصبح معدودا في القطعان..
فالأخلاق هي الأساس في بناء الأمة، وهدف عباداتها، ومجال تفاخرها وسبب بقائها والأمن من هلاكها وفنائها؛ إذ ورد الوعيد بهلاك الناس في الدنيا لفساد أخلاقهم، قال تعالى: ﴿وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون﴾ (القصص: 59)، وقال أيضا جل وعلا: ﴿وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون﴾ (هود: 177)، “بظلم”؛ أي بشرك وكفر، “مصلحون”؛ أي محققون لمعنى العدل فيهم رغم كفرهم، ويتعاطون الحق فيما بينهم، ولذلك كان هلاك قوم لوط لا لكفرهم فحسب، بل لانضمام ذلك إلى جور وفساد متفش بينهم حتى انقلبت قيم الفضيلة فيهم إلى الرذيلة: ﴿قالوا أخرجوا ءال لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون﴾ (النمل: 56)، وأيضا كان هلاك قوم شعيب لإصرارهم على نقصهم الميزان والمكيال وبخس الناس أشياءهم؛ أي أنهم أساؤوا في المعاملات وسعوا في الإيذاء والظلم[58]… ومن قرأ التاريخَ وتأمَّلَ مصارِعَ الغابرين وجدَ أن الانحلال الخلقي، والفساد السلوكي، والظلم والخيانة كانت أسباب هلاكهم على الإطلاق.
فأمور الناس كما يقول ابن تيمية، رحمه الله، إنما تستقيم في الدنيا مع العدل الذي قد يكون فيه الاشتراك في بعض أنواع الإثم، أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم يشترك في إثم؛ ولهذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة، ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام.[59]
فالحاصل أنه لابد في حياة الأفراد والجماعات من أخلاق ضرورية، قوامها الصدق والعدل والرحمة والأمانة.. بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة.. ذلك أن هذه الأخلاق في أفراد الأمم والشعوب تمثل المعاقد الثابتة التى تعقد بها الروابط الاجتماعية، ومتى انعدمت هذه المعاقد أو انكسرت في الأفراد لم تجد الروابط الاجتماعية مكاناً تنعقد عليه[60]“، وأدى هذا بالمجتمع إلى الانهيار ثم الدمار؛ لأنه لا يصلح للبقاء ولو بقي لا يصلح للتشييد والبناء، وبناؤه لا يصلح للسكن والطمأنينة.
فمثلا لا حصرا: كيف تكون الثقة بالعلوم والمعارف والأخبار لولا فضيلة الصدق، وكيف يكون التعايش والتعامل بين الناس لولا فضيلتي العفة والأمانة، وكيف تكون أمة قادرة على إنشاء حضارة مثلى لولا فضائل العدل والرحمة والإحسان؟
ثم إن قوام الدين خلق الصدق ﴿ومن أصدق من الله قيلا﴾ (النساء: 122) ﴿ومن أصدق من الله حديثا﴾ (النساء: 87) وسمى، جل وعلا، القرآن المجيد صدقا:﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ (الزمر: 33) ﴿فمن اَظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين﴾ (الزمر: 31) وقوام التدين الصدق[61]: “الصدق في الإيمان والصدق في الإسلام والصدق في الإحسان”.
والدين الذي هو خطاب التكليف سماه الله، عز وجل، أمانة: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الاَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الاِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولا﴾ (الاَحزاب: 72)، وإذا انقرضت الأمانة، فقد اضمحلت الديانة وكانت القيامة، كما جاء في الحديث الشريف “إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة[62].”
وفي كلام الإمام الشاطبي، رحمه الله، ما يفيد هذا المعنى في كون الأخلاق رتب متفاضلة، منها الضروري والحاجي فالتحسيني، قال الإمام الشاطبي (ونص كلامه طويل جدا): “كل خصلة أمر بها، أو نهي عنها مطلقا من غير تحديد ولا تقدير فليس الأمر، أو النهي فيها على وزان واحد في كل فرد من أفرادها؛ كالعدل والإحسان، والوفاء بالعهد، وأخذ العفو من الأخلاق، والإعراض عن الجاهل، والصبر والشكر، ومواساة ذي القربى والمساكين والفقراء.. والتوفية في الكيل والميزان.. وخفض الجناح للمؤمنين.. والإخلاص.. والإعراض عن اللغو وحفظ الأمانة.. والتقوى والتواضع.. والتوبة والإشفاق.. وتعظيم الله.. والتعاون على الحق.. وكذلك الصدق.. وكظم الغيظ وصلة الرحم.. وإصلاح ذات البين.. والرحمة للمؤمنين والصدقة هذا كله في المأمورات، وأما المنهيات فالظلم والفحش وأكل مال اليتيم.. والإسراف والإقتار والإثم.. والاستكبار والرضى بالدنيا من الآخرة.. والبغي واليأس من روح الله وكفر النعمة.. ونقص المكيال والميزان والإفساد في الأرض..ونقض العهد والمنكر وعقوق الوالدين.. والإشراك في العبادة واتباع الشهوات.. والعدوان وشهادة الزور والكذب.. والخيلاء.. واتباع الهوى والتكلف والاستهزاء بآيات الله.. والنميمة والشح.. والبخل والهمز واللمز.. والرياء.. واتباع الصدقة بالمن والأذى.. وحب الحمد بما لم يفعل، والحسد والترفع عن حكم الله والرضى بحكم الطاغوت.. والخيانة ورمي البريء بالذنب، وهو البهتان.. والجهر بالسوء من القول.. والارتشاء على إبطال الأحكام.. والنفاق وعبادة الله على حرف والظن والتجسس والغيبة والحلف الكاذبة وما أشبه ذلك من الأمور التي وردت مطلقة في الأمر والنهي لم يؤت فيها بحد محدود، إلا أن مجيئها في القرآن على ضربين:
أحدهما؛ أن تأتي على العموم والإطلاق في كل شيء وعلى كل حال، لكن بحسب كل مقام وعلى ما تعطيه شواهد الأحوال في كل موضع، لا على وزان واحد ولا حكم واحد…. فقول الله تعالى: ﴿إن الله يامر بالعدل والاِحسان﴾؛ ليس الإحسان فيه مأمورا به أمرا جازما في كل شيء ولا غير جازم في كل شيء بل ينقسم بحسب المناطات، ألا ترى أن إحسان العبادات بتمام أركانها من باب الواجب وإحسانها بتمام آدابها من باب المندوب… وكذلك العدل في عدم المشي بنعل واحدة، ليس كالعدل في أحكام الدماء والأموال وغيرها، فلا يصح إذا إطلاق القول في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان؛ إنه أمر إيجاب أو أمر ندب حتى يفصل الأمر فيه….
والضرب الثاني؛ أن تأتي في أقصى مراتبها، ولذلك تجد الوعيد مقرونا بها في الغالب، وتجد المأمور به منها أوصافا لمن مدح الله من المؤمنين والمنهى عنها أوصافا لمن ذم الله من الكافرين.. فكان القرآن آتيا بالغايات تنصيصا عليها من حيث كان الحال والوقت يقتضي ذلك ومنبها بها على ما هو دائر بين الطرفين حتى يكون العقل ينظر فيما بينهما بحسب ما دله دليل الشرع فيميز بين المراتب.. قد يدل اللفظ على القليل والكثير من مقتضاه فيزن المؤمن أوصافه… مثال ذلك أنه إذا نظر فى قوله تعالى: ﴿إن الله يامر بالعدل والإحسان﴾، فوزن نفسه في ميزان العدل عالما أن أقصى العدل الإقرار بالنعم لصاحبها وردها إليه ثم شكره عليها، وهذا هو الدخول في الإيمان والعمل بشرائعه والخروج عن الكفر وإطراح توابعه…
إن العدل كما يطلب في الجملة يطلب في التفصيل؛ كالعدل بين الخلق إن كان حاكما، والعدل في أهله وولده ونفسه حتى العدل في البدء بالميامن في لباس النعل ونحوه، كما أن هذا جار في ضده وهو الظلم فإن أعلاه الشرك؛ بالله إن الشرك لظلم عظيم، ثم في التفاصيل أمور كثيرة أدناها، مثلا، البدء بالمياسر وهكذا سائر الأوصاف وأضدادها..”.
وكلام الشاطبي هذا ينحصر في ذكر مكارم الأخلاق في المأمورات ومساوئها في المنهيات، وكما قال فالأوامر في الأولى ليست على وزان واحد ولا مرتبة واحدة، وكذلك النواهي في الثانية ليست متساوية.. والضابط في معرفة مراتبها في كلتيهما النظر إلى درجة المصلحة أو المفسدة التي تعلقت بكل أمر وبكل نهي، فعلى قدر تحصيل الأولى ودرء الثانية يأخذ الحكم التكليفي درجته من حيث الترتيب المقاصدي، فإن كان ذلك مهما جدا عد من الضروريات وإن كان قليل الأهمية فمن التحسينيات وما كان متوسطا بين ذلك فمن الحاجيات..
قال الشاطبي: “فالأوامر والنواهي من جهة اللفظ على تساو في دلالة الاقتضاء والتفرقة بين ما هو منها أمر وجوب أو ندب، وما هو نهي تحريم أو كراهة لا تعلم من النصوص، وإن علم منها بعض، فالأكثر منها غير معلوم وما حصل لنا الفرق بينها إلا باتباع المعاني والنظر إلى المصالح وفي أي مرتبة تقع وبالاستقراء المعنوي ولم نستند فيه لمجرد الصيغة..[63]. وقال أيضا: “إن كانت الطاعة والمخالفة تنتج من المصالح أو المفاسد أمرا كليا ضروريا كانت الطاعة لاحقة بأركان الدين والمعصية كبيرة من كبائر الذنوب، وإن لم تنتج إلا أمرا جزئيا، فطاعة لاحقة بالنوافل واللواحق الفضلية والمعصية صغيرة من الصغائر وليست الكبيرة في نفسها مع كل ما يعد كبيرة على وزان واحد ولا كل ركن مع ما يعد ركنا على وزان واحد أيضا كما أن الجزيئات في الطاعة والمخالفة ليست على وزان واحد، بل لكل منها مرتبة تليق بها[64]” وبنحو من هذا قال من قبل الإمام العز بن عبد السلام: “طَلَبُ الشَّرْعِ لِتَحْصِيلِ أَعْلَى الطَّاعَاتِ، كَطَلَبِهِ لِتَحْصِيلِ أَدْنَاهَا فِي الْحَدِّ وَالْحَقِيقَةِ، كَمَا أَنَّ طَلَبَهُ لِدَفْعِ أَعْظَمِ الْمَعَاصِي كَطَلَبِهِ لِدَفْعِ أَدْنَاهَا؛ إذْ لَا تَفَاوُتَ بَيْنَ طَلَبٍ وَطَلَبٍ، وَإِنَّمَا التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْمَطْلُوبَاتِ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ وَدَرْءِ الْمَفَاسِدِ، لِذَلِكَ انْقَسَمَتْ الطَّاعَاتُ إلَى الْفَاضِلِ وَالْأَفْضَلِ، لِانْقِسَامِ مَصَالِحِهَا إلَى الْكَامِلِ وَالْأَكْمَلِ، وَانْقَسَمَتْ الْمَعَاصِي إلَى الْكَبِيرِ وَالْأَكْبَرِ لِانْقِسَامِ مَفَاسِدِهَا إلَى الرَّذِيلِ وَالْأَرْذَلِ…”.
ولقد اجتهد الإمام الشاطبي في بيان الضابط المعتمد في كل ذلك، حيث قال: “إن الأوامر في الشريعة لا تجري في التأكيد مجرى واحدا، وأنها لا تدخل تحت قصد واحد؛ فإن الأوامر المتعلقة بالأمور الضرورية ليست كالأوامر المتعلقة بالأمور الحاجية ولا التحسينية… فالضابط في ذلك أن ينظر في كل أمر هل هو مطلوب فيها بالقصد الأول أم بالقصد الثاني، فإن كان مطلوبا بالقصد الأول فهو في أعلى المراتب في ذلك النوع، وإن كان من المطلوب بالقصد الثاني نظر هل يصح إقامة أصل الضروري في الوجود بدونه حتى يطلق على العمل اسم ذلك الضروري أم لا، فإن لم يصح فذلك المطلوب قائم مقام الركن والجزء المقام لأصل الضروري وإن صح أن يطلق عليه الاسم بدونه فذلك المطلوب ليس بركن ولكنه مكمل ومتمم إما من الحاجيات وإما من التحسينيات فينظر في مراتبه على الترتيب المذكور[65].
ومقتضى هذا الكلام أن الضروريات هي المقاصد الأصلية للشارع[66]، والمقاصد الأخرى ينظر فيها: فإن كانت مما لا يقوم الضروري إلا بها فهي من الضروريات في ذلك النوع الذي لا يقوم إلا بها، فإقامة الأركان الخمسة لا يحفظ الدين بفقدها، لذلك فهي من الضروريات في حفظ الدين، وكذلك حرمة القتل والقصاص لا يقوم الضروري وهو حفظ النفس إلا بها، فهي من الضرويات في هذا النوع (حفظ النفس)، وهكذا في سائر الأنواع، أما إن كان ذلك النوع من الضروريات لا ينتقض أو يفقد بفقد مقصد ما، فإن هذا المقصد لا يكون من الضروريات وإنما يكون من مكملاتها؛ أي قد يكون من الحاجيات أو التحسينيات.
وقد بين الإمام الشاطبي معنى المقاصد الأصلية بأنها التي لا حظّ فيها للمكلف وهي الضروريات المعتبرة فى كل ملة، وقال: وإنما قلنا إنها لا حظ فيها للعبد من حيث هى ضرورية؛ لأنها قيام بمصالح عامة مطلقة لا تختص بحال دون حال ولا بصورة دون صورة ولا بوقت دون وقت[67].
وقال أيضا رحمه الله: “المفهوم من وضع الشارع أن الطاعة أو المعصية تعظم بحسب عظم المصلحة أو المفسدة الناشئة عنها، وقد علم من الشريعة أن أعظم المصالح جريان الأمور الضرورية الخمسة المعتبرة فى كل ملة وأن أعظم المفاسد ما يكر بالإخلال عليها، والدليل على ذلك ما جاء من الوعيد على الإخلال بها كما فى الكفر وقتل النفس وما يرجع إليه والزنا والسرقة وشرب الخمر وما يرجع إلى ذلك مما وضع له حد أو وعيد، بخلاف ما كان راجعا إلى حاجى أو تكميلي فإنه لم يختص بوعيد فى نفسه ولا بحد معلوم يخصه[68].”
فالحاصل من تتبعي لكلام الشاطبي أنه جعل للمقاصد الضرورية معايير أربعة:
أولها؛ أن تحقق أعظم المصالح، وفي الإخلال بها أعظم المفاسد.
ثانيها؛ أن تكون مطلوبة بالقصد الأول أي أصالة، دون نظر المكلف الى تحصيل حظه أو سعي في نفع نفسه في الامتثال.
ثالثها؛ أن تكون مطلوبة بحيث لا تختص بحال دون حال ولا بصورة دون صورة ولا بوقت دون وقت.
رابعها؛ أن يقترن على الإخلال بها وعيد أو حد من الحدود.
وبالنظر إلى مكارم الأخلاق يبدو جليا أن منها ما تتحقق فيها هذه المعايير جميعها، فالصدق والأمانة والعدل والإحسان والعفة والوفاء، مثلا، ورد الأمر بالتزامها في كل حال وفي كل وقت وفي كل صورة دون نظر إلى ما قد يترتب عليها من حظوظ وغيرها، كما ورد الوعيد على الإخلال بها، كما ورد النهي عن أضداد هذه الأخلاق وعن العجب والكبر والرياء والبخل والظلم والحسد وغير ذلك مع دوام الانتهاء عنها في كل حال ووقت ومكان دون نظر المكلف الى ما ينشأ عن هذا الكف والامتناع من الحظوظ والنتائج، وفي بعض نصوص الشرع الوعيد على الاتصاف بها[69]. مما يدل دلالة واضحة لا مرية فيها على أن من مكارم الأخلاق ما يعد من قسم الضروريات.
ولما كانت الضروريات منحصرة في الكليات الخمسة، فإن واسطة العقد التي تجمعها كلها وتحفظها هي الدين، ولما كان الدين هو حسن الخلق فلا يمكن بحال حفظ النفس والنسل والعقل والمال بغير مكارم الأخلاق.
وقد نص الإمام الشاطبي وغيره من العلماء السابقين واللاحقين على أن هذه الضروريات لها مكملات ترتبت من حيث الأهمية إلى الحاجيات وبعدها التحسينيات، قال الشاطبي: “إن الحاجيات كالتتمة للضروريات وكذلك التحسينات كالتكملة للحاجيات فإن الضروريات هي أصل المصالح[70]” وقال: “إن كل واحدة من هذه المراتب مختلفة في تأكد الاعتبار فالضروريات آكدها ثم تليها الحاجيات والتحسينات[71].”
ولما ثبت أن حسن الخلق هو الدين أحد الكليات الخمسة الضرورية، فإن له أيضا مكملات من الحاجيات والتحسينيات، ومقصود الشرع تحصيل محاسن الأخلاق في كمالها، ذلك أن الشريعة الإسلامية أتت بكمال المكارم قال عليه الصلاة والسلام: “إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق[72]“، وقد كان الرسول، صلى الله عليه وسلم، بالغا الكمال في حسن الخلق، وقد شهد له رب العزة بذلك في قوله جل جلاله: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ (القلم: 4)، وجعله سبحانه أسوة حسنة لجميع المسلمين، بل للناس أجمعين إلى قيام الساعة: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْاَخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ (الاَحزاب: 21)، وكان الصحابة، رضوان الله عليهم، أقرب الناس إلى خلقه، صلى الله عليه وسلم، نزل مدحهم والثناء عليهم في مواضع من كتاب الله ورفع رسول الله، صلى الله عليه سلم، من أقدارهم وجعلهم في الدين أئمة فكانوا هم القدوة العظمى في أهل الشريعة، وكانوا مع كل ذلك يتفاضلون في ما بينهم في بعض مكارم الأخلاق ولكن ليس على منحى التنقيص لأي منهم فقد كانوا أفضل الناس وخيارهم في كل زمان، قال الشاطبي: “قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم[73]، وقال عبد الله بن عمر: كنا نخير بين الناس في زمان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان[74].. وقال عليه السلام: خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الله الأشهل، ثم بنو الحرث بن الخزرج، ثم بنو ساعدة وفي كل دور الأنصار خير[75] وقال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياءً عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرؤهم أبي بن كعب، ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح[76].
وقال عبد الرحمن بن يزيد سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والهدي من النبي، صلى الله عليه وسلم، حتى نأخذ عنه فقال: ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي، صلى الله عليه وسلم، من ابن أم عبد.. وقال عليه الصلاة والسلام: “اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر[77]، وما جاء في الترجيح والتفضيل كثير لأجل ما ينبني عليه من شعائر الدين، وجميعه ليس فيه إشارة إلى تنقيص المرجوح[78].”
وعن عبد الله بن عمرو أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: “ما أظلت الخضراء، ولا أقلت الغبراء، أصدق من أبي ذر[79].”
الشاهد من هذه النصوص كلها؛ أن مكارم الأخلاق ليست مرتبة واحدة، بل هي مراتب بعضها أفضل من بعض، ومطلوب الشرع السعي إلى تحصيل أعلاها، وقد ورد في سبب نزول قوله تعالى: ﴿ولا ياتل أولو الفضل منكم والسعة أن يوتوا أولي القربى والمساكين وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (النور: 22) أن أبا بكر، رضي الله عنه، كان ينفق على مسطح بن أثاثة المطلبي إذ كان ابن خالته، وكان من فقراء المهاجرين فلما علم بخوضه في قضية الإفك أقسم أن لا ينفق عليه، ولما تاب مسطح وتاب الله عليه، لم يزل أبو بكر واجدا في نفسه على مسطح فنزلت هذه الآية، فالمراد من أولي الفضل ابتداء أبو بكر..[80] قال الشاطبي: “وقوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم قضية عين لأبي بكر الصديق نفس بها من كربه فيما أصابه بسبب الإفك المتقول على بنته عائشة، فجاء هذا الكلام كالتأنيس له والحض على إتمام مكارم الأخلاق وإدامتها بالإنفاق على قريبه المتصف بالمسكنة والهجرة، ولم يكن ذلك واجبا على أبي بكر ولكن أحب الله له معالي الأخلاق[81].”
ومعالي الأخلاق هي ما عده الأصوليون في مرتبة التحسينيات؛ لأنها محاسن زائدة على أصل الضروري والحاجي جرت مجرى التحسين والتزيين له، قال الشاطبي: “وأما التحسينات فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق[82]“، وقال بأنها جارية في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات[83].
تحقيق معنى حصر البعثة المحمدية في تتمة المكارم الخلقية
وبعد هذا، أرى أنه من الجدير إيضاح الإشكال في شأن الاستدلال بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: “بعثت لأتمم حسن الأخلاق “أو “إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق” أو “إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق[84]“، من حيث ما يفيده ظاهرها أن البعثة النبوية محصورة في إكمال حُسْنِ الأخلاق وصَالِحِها ومكارمها، فهل يصح أن تكون الرسالة المحمدية منحصرة في أوصاف زائدة تقع موقع التكميل والتتمة والتحسين لما هو ضروري وحاجي مما كان من قبل في الشرائع والملل السابقة؟
أقول والله الموفق:
إنه من المعلوم أن أعظم ما في البعثة النبوية: القرآن الكريم، وهو جامع الدين على الإطلاق. وقد أنزله، جل وعلا، على الرسول الكريم منجما، وقد ميز العلماء في ذلك بين مرحلتين المكية والمدنية، وكان ما نزل في مكة متسما بالكلية وتقرير أصول عامة للدين الإسلامي وبتصحيح وتقويم أحكام كانت معلومة عند العرب من بقية ملة إبراهيم عليه السلام، ثم كان التفصيل والبيان بعد ذلك في ما نزل بالمدينة.
قال الشاطبي: “اعلم أن القواعد الكلية هي الموضوعة أولا، والذي نزل بها القرآن على النبي، صلى الله عليه وسلم، بمكة ثم تبعها أشياء بالمدينة كملت بها تلك القواعد التي وضع أصلها بمكة وكان أولها الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر ثم تبعه ما هو من الأصول العامة كالصلاة وإنفاق المال وغير ذلك، ونهى عن كل ما هو كفر أو تابع للكفر.. وأمر، مع ذلك، بمكارم الأخلاق كلها؛ كالعدل والإحسان، والوفاء بالعهد، وأخذ العفو والإعراض عن الجاهل، والدفع بالتي هي أحسن، والخوف من الله وحده والصبر والشكر ونحوها.
ونهى عن مساوئ الأخلاق؛ من الفحشاء والمنكر والبغي والقول بغير علم، والتطفيف في المكيال والميزان، والفساد في الأرض والزنا والقتل والوأد وغير ذلك مما كان سائرا في دين الجاهلية، وإنما كانت الجزئيات المشروعات بمكة قليلة والأصول الكلية كانت في النزول والتشريع أكثر ثم لما خرج رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إلى المدينة، واتسعت خطة الإسلام كملت هنالك الأصول الكلية على تدريج؛ كإصلاح ذات البين والوفاء بالعقود، وتحريم المسكرات، وتحديد الحدود التي تحفظ الأمور الضرورية وما يكملها ويحسنها ورفع الحرج بالتخفيفات، والرخص وما أشبه ذلك كله تكميل للأصول الكلية”[85].
فالحاصل أن الأمر بمكارم الأخلاق كان من جملة ما نزل من الكليات والأصول بمكة؛ لأن العرب كان لهم بها اعتناء، ومن أجل ذلك فهي أول ما خوطبوا به قال الشاطبي: “.. وأما ما يرجع إلى الاتصاف بمكارم الأخلاق وما ينضاف إليها فهو أول ما خوطبوا به، وأكثر ما تجد ذلك في السور المكية من حيث كان آنس لهم وأجري على ما يتمدح به عندهم كقوله تعالى: ﴿إن الله يامر بالعدل والاِحسان وإيتاء ذي القربى..﴾ وقوله تعالى: ﴿قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا﴾ إلى انقضاء تلك الخصال وقوله: ﴿قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده﴾ وقوله: ﴿قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق﴾..
إلى غير ذلك من الآيات التي في هذا المعنى لكن أدرج فيها ما هو أولى من النهي عن الإشراك والتكذيب بأمور الآخرة وشبه ذلك مما هو المقصود الأعظم وأبطل لهم ما كانوا يعدونه كرما وأخلاقا حسنة وليس كذلك… والشريعة كلها إنما هي تخلق بمكارم الأخلاق، ولهذا قال عليه السلام: “بعثت لأتمم مكارم الأخلاق”. إلا أن مكارم الأخلاق إنما كانت على ضربين: أحدهما؛ ما كان مألوفا وقريبا من المعقول المقبول كانوا في ابتداء الإسلام إنما خوطبوا به ثم لما رسخوا فيه تمم لهم ما بقي وهو الضرب الثاني وكان منه ما لا يعقل معناه من أول وهلة فأخر حتى كان من آخره تحريم الربا وما أشبه ذلك، وجميع ذلك راجع إلى مكارم الأخلاق وهو الذي كان معهودا عندهم على الجملة[86].”
وعلى هذا، فإن التتميم لمكارم الأخلاق يرد عند الإمام الشاطبي بإزاء معنيين، مع التنبيه إلى أن المراد بمكارم الأخلاق الدين كله:
الأول؛ معنى خاص؛ أي إن الشريعة نزلت أولا بمكة مقررة لقواعد كلية وأصول عامة، ثم جاءت تتمة ذلك وتكملته بالمدينة “اعلم أن القواعد الكلية هي الموضوعة أولا، والذي نزل بها القرآن على النبي، صلى الله عليه وسلم، بمكة ثم تبعها أشياء بالمدينة كملت بها تلك القواعد التي وضع أصلها بمكة”.
الثاني؛ معنى عام؛ أي إن البعثة المحمدية جاءت بمكامل مكارم الأخلاق مقارنة بالأديان السماوية السابقة، ذلك أن جميع الشرائع التي شرعها الله للعباد قبل شريعة الإسلام جاءت بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات، ولهذا ذكر أهل العلم أن الأخلاق الفاضلة مما طبقت الشرائع على طلبه[87]، ولكن الشريعة الإسلامية تمتاز عن غيرها بشمولها وعمومها وخاتميتها؛ فقد حوت كلّ ما جاءت به تلك الشرائع مما هو من الأصول والقواعد الكلية، مع الزيادة عليها بعد نسخ وتغيير ما كان لا يصلح إلا لظرف معيّن وأجل محدود، فأتت الشريعة الإسلامية كاملة بتمام مكارم الأخلاق ومحاسن الخصال..
قال الشاطبي: “الشريعة جاءت متممة لمكارم الأخلاق ومصلحة لما أفسد قبل من ملة إبراهيم عليه السلام[88]“، وقال ابن كثير رحمه الله: “إن العرب كانوا قديما متمسكين بدين إبراهيم الخليل، عليه السلام، فبدلوه وغيروه وقلبوه وخالفوه واستبدلوا بالتوحيد شركا، وباليقين شكا، وابتدعوا أشياء لم يأذن بها الله، وكذلك أهل الكتاب قد بدلوا كتبهم وحرفوها وغيروها وأولوها، فبعث الله محمدا، صلى الله عليه وسلم، بشرع عظيم كامل شامل لجميع الخلق فيه هدايتهم والبيان لجميع ما يحتاجون إليه من أمر معاشهم ومعادهم والدعوة لهم إلى ما يقربهم إلى الجنة ورضا الله عنهم، والنهي عما يقربهم إلى النار وسخط الله تعالى حاكم فاصل لجميع الشبهات والشكوك والريب في الأصول والفروع، وجمع له تعالى وله الحمد والمنة جميع المحاسن ممن كان قبله وأعطاه ما لم يعط أحدا من الأولين ولا يعطيه أحدا من الآخرين فصلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين[89].”
لذلك، فإن وجوب تحصيل المصالح الكبرى، ودرء المفاسد العظمى مما اتفقت عليه جميع الشرائع السماوية، قال الزركشي: “فَإِنْ قُلْتَ: إذَا كَانَتْ كُلُّ شَرِيعَةٍ انْبَنَتْ عَلَى مَصَالِحِ الْخَلْقِ إذْ ذَاكَ فَبِمَاذَا اخْتَصَّتْ شَرِيعَتُنَا حَتَّى صَارَتْ أَفْضَلَ الشَّرَائِعِ وَأَتَمَّهَا؟ قُلْت: بِخَصَائِصَ عَدِيدَةٍ: مِنْهَا: نِسْبَتُهَا إلَى رَسُولِهَا وَهُوَ أَفْضَلُ الرُّسُلِ. وَمِنْهَا: نِسْبَتُهَا إلَى كِتَابِهَا وَهُوَ أَفْضَلُ الْكُتُبِ: وَمِنْهَا اسْتِجْمَاعُهَا لِمُهِمَّاتِ الْمَصَالِحِ وَتَتِمَّاتِهَا وَلَعَلَّ الشَّرَائِعَ قَبْلَهَا إنَّمَا انْبَنَتْ عَلَى الْمُهِمَّاتِ وَهَذِهِ جَمَعَتْ الْمُهِمَّاتِ وَالتَّتِمَّاتِ، وَلِهَذَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: “بُعِثْت لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ” “وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا” إلَى قَوْلِهِ: “فَكُنْتُ أَنَا تِلْكَ اللَّبِنَةُ”؛ يُرِيد،ُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَنَّ اللَّهَ، عَزَّ وَجَلَّ، أَجْرَى عَلَى يَدِهِ وَصْفَ الْكَمَالِ وَنُكْتَةَ التَّمَامِ، وَيَلْزَمُ مِنْ حُصُولِ نُكْتَةِ الْكَمَالِ حُصُولُ مَا قَبْلَهَا مِنْ الْأَصْلِ دُونَ الْعَكْسِ[90].”
وقال العز بن عبد السلام: “إذَا عَظُمَتْ الْمَصْلَحَةُ، أَوْجَبَهَا الرَّبُّ فِي كُلِّ شَرِيعَةٍ، وَكَذَلِكَ إذَا عَظُمَتْ الْمَفْسَدَةُ، حَرَّمَهَا فِي كُلِّ شَرِيعَةٍ[91]“، والضروريات من هذا النوع من حيث وجوب تحصيلها وتحريم الإخلال بها، قال الشاطبي: “.. إن الضروريات مراعاة في كل ملة وإن اختلفت أوجه الحفظ بحسب كل ملة… وأما قوله:﴿ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا﴾ فإنه يصدق على الفروع الجزئية وبه تجتمع معاني الآيات والأخبار، فإذا كانت الشرائع قد اتفقت في الأصول مع وقوع النسخ فيها؛ (أي الشرائع) وثبتت ولم تنسخ؛ (أي الأصول) فهي في الملة الواحدة؛ (أي الإسلام) الجامعة لمحاسن الملل أولى والله تعالى أعلم[92].”
خاتمة
وبهذا يرتفع الإشكال في شأن الاستدلال بالحديث الشريف “إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق”، من حيث ما يفيده ظاهره أن البعثة المحمدية منحصرة في تتميم أوصاف زائدة على ما هو ضروري وحاجي.
فالتتميم لمكارم الأخلاق معناه تتميم الدين كله، ذكر تفضيلا وتمييزا للإسلام عن جميع الشرائع التي كانت قبله من حيث أنه جمع وأوعى كلّ ما جاءت به تلك الشرائع مما هو من الأصول والقواعد الكلية مع الزيادة عليها بعد نسخ وتغيير ما لم يعد صالحا، فأتى الدين الإسلامي كاملا بتمام مكارم الأخلاق ومحاسن الأحكام، ليظهر بذلك على الأديان كلها وناسخا لها ومهيمنا عليها، قال جل وعلا: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً﴾ (الفتح: 28)، وقال سبحانه: ﴿وأنزلنا إليك الكتاب بالحقِّ مُصَدِّقاً لما بين يديهِ من الكتاب ومهيمناً عليه﴾ المائدة: 48).
وخلاصة القول في نهاية هذا البحث: إن مكارم الأخلاق هي الدين كله، الذي هو أحد الكليات الخمسة الضرورية، وأن ما عده الإمام الشاطبي وغيره في مرتبة التحسينيات إنما هي فضائل مكارم الأخلاق، وأعني بالفضيلة المعنى المشتق من الفضل؛ أي ما زاد على الحاجة، أو ما بقي من الشيء بعد الوفاء بالحاجة وحد الضرورة، وهي الآداب الشرعية العامة وما يحسن في مجاري العادات..
وتلك هي زينة الإنسان وحليته في كل جوانب حياته في عباداته ومعاملاته وعلاقاته وحتى في تحقيق حاجته الطبيعية.. فهو خلق مميز عن الحيوان بل مكرم من الله، جل وعلا، مصداقا لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ءادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً﴾ (الإسراء: 70)، وإنه على قدر تخلقه تتحدد قيمته الإيمانية[93] وكرامته الإنسانية التي ما حازها إلا لأنه جمع بين المظهرين الخلقي المقوم المسوّى المكرم به فضلا دون تكليف والخلقي العظيم المكلف به حفظا ورعاية وارتقاء نحو الكمال، لكنه إن خان الأمانة، أمانة التكليف، انسلخ عن كرامته الإنسانية وارتد إلى أسفل المخلوقين والسافلين: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الاِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. إِلَّا الَّذِينَ ءامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ (التين: 4-6).
الهوامش
[1]. ينظر الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص396. والزبيدي، تاج العروس، 9/35، والمفردات للراغب الأصفهاني 404.
[2]. صحيح مسلم رقم الحديث 289.
[3]. صحيح البخاري رقم الحديث 6463.
[4]. صحيح مسلم رقم الحديث 2040.
[5]. أحمد الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، تقديم: طه جابر العلواني، سلسلة الرسائل الجامعية 1، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، (1416ه/1995م)، ص19.
[6]. عبد الرحمن إبراهيم الكيلاني، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي عرضاً ودراسة وتحليلاً، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط1، (1421ھ/2000م)، ص47.
[7]. أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، بيروت: دار الكتب العلمية/لبنان، 2/385.
[8]. الموافقات، م، س، 2/8.
[9]. المصدر نفسه.
[10]. المصدر نفسه.
[11]. المصدر نفسه، 2/10.
[12]. المصدر نفسه. 1/38.
[13]. الجويني، البرهان في أصول الفقه، تحقيق: عبد العظيم محمود الديب، الناشر: الوفاء – المنصورة – مصر، ط4، 1418ﻫ، 2/602.
[14]. المصدر نفسه، 2/11.
[15]. البرهان في أصول الفقه، م، س، 2/602.
[16]. الموافقات، م، س، 2/12.
[17]. البرهان في أصول الفقه، م، س، 2/610.
[18]. المصدر نفسه، 2/603.
[19]. 5/222.
[20]. الموافقات، م، س، 2/11.
[21]. ينظر: ابن السبكي، الإبهاج، 3/56 والزركشي، البحر المحيط، 4/191 وابن أمير الحاج، التقرير والتحبير، 3/192-193 والشوكاني، إرشاد الفحول، 1/367-368 ومحمد أمين المعروف بأمير بادشاه، تيسير التحرير، 3/442.
[22]. نور الدين الخادمي، علم المقاصد الشرعية، مكتبة العبيكان، ط1، (1421ﻫ/2001م)، ص72. ومحمد اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة، الرياض: دار الهجرة للنشر والتوزيع/المملكة العربية السعودية، ط1، (1418ﻫ/1998م)، ص329.
[23]. سعيد رمضان البوطي، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، ص120.
[24]. الشاطبي ومقاصد الشريعة، سورية: دار قتيبة، 2010، ص122.
[25]. ينظر مثلا الدكتور يوسف حامد العالم في كتابه المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، ص164.
[26]. الموافقات، م، س، 4/32.
[27]. المصدر نفسه، 2/18.
[28]. المصدر نفسه، 2/23.
[29]. المصدر نفسه، 2/17.
[30]. المصدر نفسه.
[31]. الجوهري، مختار الصحاح، 4/ 1470-1471.
[32]. أحمد ابن فارس، مقاييس اللغة، 2/214.
[33]. المرجع نفسه.
[34]. ابن منظور، لسان العرب، 2/245.
[35]. الراغب الأصفهانى، المفردات في غريب القرآن، تحقيق: صفوان عدنان داودى، دمشق/بيروت: دار العلم الدار الشامية، 1412ﻫ، ص164.
[36]. محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، إحياء علوم الدين، بيروت: دار المعرفة، ج4، 3/53.
[37]. المفردات، م، س، ص164.
[38]. ابن حيان، تفسير البحر المحيط، 1/503.
[39]. إحياء علوم الدين، م، س، 3/58.
[40]. الجرجانى، التعريفات، ص104.
[41]. الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، تونس: الدار التونسية للنشر، 1984م، 19/171-172.
[42]. عبد الرحمن الميداني، الأخلاق الإسلامية وأسسها، دمشق: دار القلم، ط1، 1399ﻫ، 1/10.
[43]. إحياء علوم الدين، م، س، 3/57.
[44]. ينظر: الرازي، المحصول، 5/222. وابن السبكي، الإبهاج، 3/56. والشاطبي، الموافقات، م، س. والزركشي، البحر المحيط، م، س. وابن أمير الحاج، التقرير والتحبير. والشوكاني، إرشاد الفحول. محمد أمين المعروف بأمير بادشاه، تيسير التحرير، م، س.
[45]. ينظر: أحمد الريسوني، الإنسان محور مقاصد الشريعة الإسلامية، ص56.
[46]. ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، دار طيبة، (1422ﻫ/2002م)، 1/201.
[47]. السعدي، تيسير الكريم الرحمن، 1/115.
[48]. طه عبد الرحمن، سؤال الأخلاق.. مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية، ص53.
[49]. الموافقات، م، س، 2/77.
[50]. المقال “نهضة الأقطار العربية” من كتاب مصطفي صادق الرافعي، وحي القلم، 3/201.
[51]. لسان العرب، مادة: خلق، حـ2، ص 1244-1245 والقاموس المحيط، فصل الخاء: باب القاف، ص236.
[52]. فقد جاء رجل إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله: ما الدين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: “حسن الخلق” الحديث أخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة من رواية أبي العلاء بن الشخير مرسلا.
[53]. أخرجه الترمذي في سننه عن عويمر بن مالك، حديث رقم: 2002.
[54]. رواه مسلم في صحيحه حديث رقم: 4632.
[55]. مدارج السالكين، 2/319.
[56]. المرجع نفسه، 2/320.
[57]. ابن حزم، مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق، ص179.
[58]. التحرير والتنوير، 8/239.
[59]. الفتاوى، 28/146.
[60]. عبد الرحمن الميدانى، الأخلاق الإسلامية وأسسها، 1/34-35.
[61]. كما في قوله تعالى: ﴿ليجزي الله الصادقين بصدقهم﴾ (الاَحزاب: 24). وقوله سبحانه: ﴿هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جناتِ تجري من تحتها الاَنهار…﴾ (المائدة: 119).
[62]. صحيح البخاري رقم الحديث 59.
[63]. الموافقات، م، س، 3/153.
[64]. المصدر نفسه، 2/299-300.
[65]. الموافقات، م، س، 3/210-211.
[66]. مقاصد الشارع ضربان: أصلية وتابعة، أما الأصلية فهي التي لا حظ فيها للمكلف. وهي تعني إيقاع الفعل أو الكف عنه بناء على الأمر أو النهي من غير نظر إلى الحظوظ أو النتائج، والحظوظ إنما تحصل ضمن التزام التكليف. أما المقاصد التابعة، فهي مقاصد شرعية روعي فيها حظ المكلف فمن جهتها يحصل له مقتضى ما جبل عليه من نيل الشهوات والاستمتاع بالمباحات وسد الخلات وما إلى ذلك. انظر: الموافقات، م، س، 2/178.
[67]. الموافقات، م، س، 2/176.
[68]. الموافقات، م، س، 2/298-299.
[69]. ومما يستدل به في هذا المقام قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَئانُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ (المائدة: 8) وقوله سبحانه: ﴿يأيها الذين ءامنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء للّه ولو على أنفسكم أو الوالدين والاَقربين﴾ (النساء: 135) وقوله صلى الله عليه وسلم: “آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ”؛ من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رواه الإمام البخاري في صحيحه رقم الحديث: 5659، وفي رواية في مسند أبي يعلى برقم 4098 “وإنْ صام وصلَّى وحجَّ واعتمر وقال: إنِّي مسلم” ولا ريبَ أنَّ النِّفاقَ يناقضُ الإيمان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا” من حديث ابن مسعود رواه البخاري في صحيحه برقم 6094 ومسلم في صحيحه برقم 2607، وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم، قَالَ: “أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ”. قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ. فَقَالَ: “إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِى يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِى قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ في النَّارِ” صحيح مسلم برقم 2581 وسنن الترمذي رقم 2418، وقال: حسن صحيح. وعن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “خصلتان لا يكونان في مؤمن: سوء الخلق، والبخل” أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 7/51 وعَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِىِّ، صلى الله عليه وسلم، قَالَ: “دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ في هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خِشَاشِ الأَرْضِ” صحيح البخاري برقم 3318 واللفظ له وصحيح مسلم برقم 2138 وعن أبي هريرة أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: “لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه”. رواه مسلم في صحيحه برقم 69، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم 116، وعن أبي هريرة قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله! إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار، وتفعلُ، وتصدقُ، وتؤذي جيرانها بلسانها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا خير فيها، هي من أهل النار”. قالوا: وفلانة تصلي المكتوبة، وتصدق بأثوار (وهو الجبن المجفف)، ولا تؤذي أحداً؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “هي من أهل الجنة”، الأدب المفرد للبخاري برقم 119 واللفظ له ومسند الإمام أحمد برقم 9673 والمستدرك للحاكم برقم 7305 وروى النسائي في سننه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد) سنن النسائي برقم 3109، وعَنْ عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود، رَضِيَ اللَّه عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يَدْخُل الْجَنَّة مَنْ كَانَ فِي قَلْبه مِثْقَال ذَرَّة مِنْ كِبْر قَالَ رَجُل: إِنَّ الرَّجُل يُحِبُّ أَنْ يَكُون ثَوْبه حَسَنًا وَنَعْله حَسَنَة قَالَ: إِنَّ اللَّه جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَال الْكِبْر بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمْط النَّاس” رواه مسلم في صحيحه برقم 91، وفي الصحيحين أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: “سباب المسلم فسوق وقتاله كفر” صحيح البخاري برقم 48، وصحيح مسلم برقم 64..وذكر هذه النصوص يطول لكن أذكر بعضها مما ينبه على ما سواها مما هو في معناها، كما ينبه على ما نحن بسبيله.
[70]. الموافقات، م، س، 2/13.
[71]. المصدر نفسه، 2/21.
[72]. هذا الحديث جاء بألفاظ متقاربة منها: “إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق” “إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق” “إنما بعثت لأتمم مكارم حسن الأخلاق” وهي من قبيل اختلاف التنوع الذي لا يقدح في صحة الحديث؛ هذا وقد أخرج الحديث: أحمد (8595)؛ و الحاكم في “المستدرك” (4221) والبخاري في “الأدب المفرد” والبيهقي في “السنن” وغيرهم من طريق عبد العزيز بن محمد الداروردي عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي هريرة… فذكره قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وتابعه الذهبي. قال في مجمع الزوائد: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. قال ابن عبد البر: هو متصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة؛ وأخرجه: ابن أبي شيبة (31773) عن زيد بن أسلم مرسلاً من طريق معاوية بن هشام عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم.
[73]. اشتهر بهذا اللفظ (خير القرون قرني) في عدد من الكتب، وهو مما رواه ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق بسنده إلى أكثم بن الجون، رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم “خير القرون قرني “وقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: “خيرُ الناسِ قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة قال: ثم يَتَخَلَّفُ من بَعْدِهِم خَلًفٌ تَسْبِقُ شهادةُ أحدهم يمينَه ويمينُه شهادتَه “.وروى مسلم عن أبي هريرةَ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “خير أمتي القرنُ الذين بُعِثْتُ فيهم ثم الذين يلونهم، واللهُ أعلمُ أَذَكَرَ الثالثَ أم لا، قال: ثم يَخْلُفُ قومٌ يُحِبُّونُ السَّمانةَ يشهدون قبلَ أن يُسْتَشْهَدوا “وروى البخاري عن عمرانَ بنِ حُصَينٍ، رضي الله عنهما، قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: “خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال عمرانُ: لا أدري أذكر النبي، صلى الله عليه وسلم، بعدُ قرنينِ أو ثلاثةً، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنَّ بعدَكُم قوماً يخونون ولا يُؤْتَمنونَ، ويشهدون ولا يُسْتَشهدون، ويَنْذِرونَ ولا يِفونَ، ويَظْهَرُ فيهِمُ السِّمَنُ” وقد روى هذا الحديث من الصحابة أكثر من اثني عشر صحابياً..
[74]. أخرجه البخاري في صحيحه برقم 3455.
[75]. أخرجه البخاري في صحيحه برقم 3578 ومسلم في صحيحه برقم 2511.
[76]. رواه أحمد في مسنده رقم 13711 والترمذي في السنن رقم 3753.
[77]. أخرجه الترمذي في سننه رقم 3771 وأحمد في مسنده رقم 22640.
[78]. الموافقات، م، س، 4/270.
[79]. سنن الترمذي، الحديث رقم 3801
[80]. ينظر: التحرير والتنوير، م، س، 9/458
[81]. الموافقات، م، س، 3/364.
[82]. المصدر نفسه، 2/11.
[83]. المصدر نفسه.
[84]. تم تخريجه سابقا.
[85]. الموافقات، م، س، 3/102.
[86]. الموافقات، م، س، 2/77.
[87]. قال تعالى: ﴿وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً﴾ (النساء: 36) فأمر الله، جل وعلا، بعبادته وبالإحسان إلى خلقه من الوالدين وذي القرابة والجيران والأصحاب والضعفاء والمساكين، كل بحسب قربه ومنزلته وبحسب ما يناسبه ويصلح لمثله وبهذا أيضا أمرت جميع الرسالات السابقة، قال الله، عز وجل، في سورة البقرة: ﴿وَإِذْ اَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَاءيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً، وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَءاتُواْ الزَّكَاةَ، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنكُمْ وَأَنتُم مِّعْرِضُونَ﴾ الآية: 82.
[88]. الموافقات، م، س، 3/406.
[89]. تفسير القرآن العظيم، 4/364.
[90]. البحر المحيط، م، س، 4/111-112.
[91]. قواعد الأحكام في مصالح الأنام، 1/61.
[92]. الموافقات، م، س، 3/118.
[93]. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا” (أخرجه الترمذي 2/)204؛ و(ابن حبان 2/227)؛ و(الحاكم1/3) وقال صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي. وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا” (أخرجه احمد 5/89).