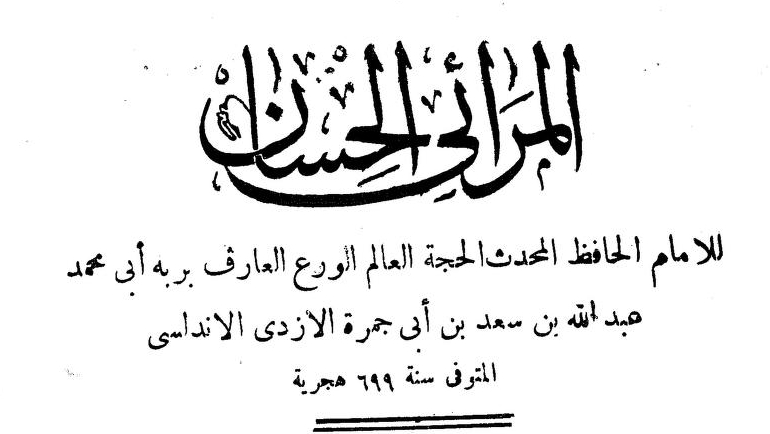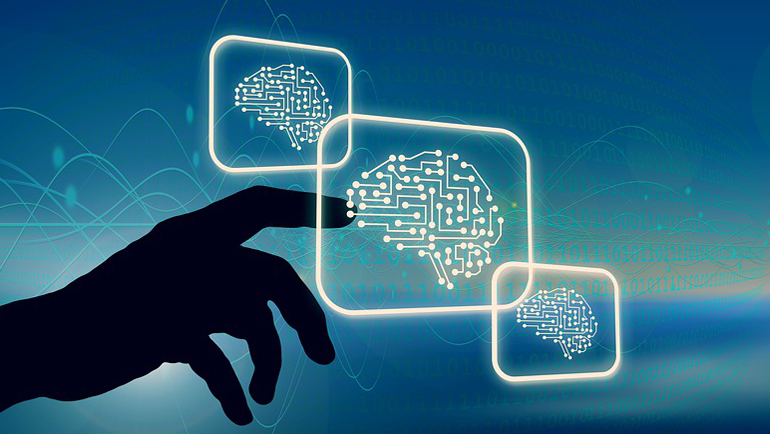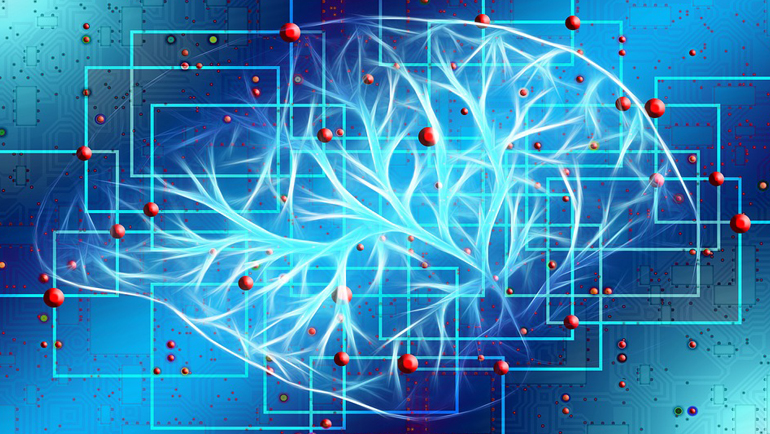سبق للرابطة المحمدية للعلماء أن نظمت ندوة دولية حول موضوع: “العلوم الإسلامية أزمة منهج أم أزمة تنزيل؟” وهي الندوة التي صدرت أعمالها في طبعتين. وقد حصل الاتفاق بين سائر المشاركين فيها على أن علومنا الإسلامية، رغم الجهود التي بذلت، تعيش أزمة جرى حصر أسبابها في جملة من العوائق، تم بسطها في المدخل التقديمي للندوة/الكتاب.
غير أن أكثر ما يهمنا من هذه العوائق، هو ما يتصل بأزمة البارديغمات؛ أي الأنساق والأطر المرجعية والمفاهيمية المحددة للتجديد المنهاجي، سعيا لـ”إدراك النواظم المنهجية الكلية بين العلوم الإسلامية التي توحدها في أصل انبثاقها الأول..” (ص7).
كما إنه من الوظيفي، استحضار الوعي بأن هذه العوائق حين استحكمت، صيرت العلوم الإسلامية كما استقرت بعدُ، في كثير من مناحيها وأبوابها، تنسد مناهجها دون الاجتهاد والإبداع، مما يستدعي مراجعات في ضوء إدراك هذه العوائق واستحضارها، بغرض تخليص علومنا من آثارها السلبية، وإزاحة الشوائب العالقة بها، وجعلها قادرة وحاضرة في موكب التدافع الكوني الراهن، تسهم فيه ولو بمقدار، في ظل ظروف وتحولات قاهرة لا ترحم المتخلف عنها.
وسعيا لتجاوز هذه الأزمة، انبثق من رحم الندوة المذكورة، مقترح باعتبار التأويل، من المداخل الأساسية لاستئناف حركة الأمة في الاجتهاد والتجديد.. خاصة في مرحلة تاريخية شهد فيها العالم، متغيرات وتحولات جذرية عميقة، فيما يتصل بنظريات المعرفة، وتطور العلوم، والتقنيات، والمناهج..
الأمر الذي بات يفرض تحديا مزدوجا على علماء الأمة وباحثيها؛ وهو التحدي الذي يتمثل من جهة أولى، في بذل قصارى الجهد لردم الهوة العميقة التي باتت تفصلنا عن تراثنا العلمي، في مجال التعامل مع النص المؤسس، تفسيرا، وقراءة، وتدبرا، وتأسيا، وتأويلا.. ودرءًا لما يبدو من تعارض بين العقل والنقل، أو بين الحكمة والشريعة، خاصة مع جهابذة التأويل، وفي مقدمتهم كل من الأئمة المحاسبي، والغزالي، وابن العربي، وابن رشد، وابن تيمية،.. الذين جهدوا لبلورة قانون للتأويل..
كما يتمثل هذا التحدي من جهة ثانية، في وجوب استيعاب الكسب الإنساني المعاصر، في مجال المنهجيات التأويلية، وما يقتضيه ذلك من بذل الجهد النظري المطلوب، لتفكيكه وفهم أسسه ومقاصده، والإفادة منه بما ينسجم ومقومات التصور الإسلامي المعرفية، وخصوصية القرآن الكريم، من حيث مصدريته الإلهية العلوية، ومرجعيته الحاكمة، وروحه الناظمة.. وبما لا يتعارض مع مقاصد الإسلام الكلية ومنظومة قيمه القرآنية..
كل ذلك في مراعاة تامة لمقتضيات السياق التاريخي والحضاري، المحدد للعلاقة بين نظرية المعرفة، ومسألة المنهج في صلتهما بالمرجعية..
لا يمكن في سياقنا الراهن الحديث عن التأويل، دون الحديث عن رهانات التأويل؛ ذلك أننا لسنا بصدد تأويل بصيغة المفرد وإنما بصدد تأويلات، وهو ما جعل تأويليا غربيا، من حجم “بول ريكور”، يتحدث، بحق، عن “صراع التأويلات”. الأمر الذي يبرز أهمية التشديد على الضوابط اللازم مراعاتها لتبيئة هذه المنهجيات بما يجعلها منسجمة مع طبيعة نظامنا المعرفي الإسلامي..
أكثر من ذلك، فبالإضافة إلى كون الإنسان الذي يقوم بالتأويل يكون حاضراً في مختلف مراحله، بكل أبعاده النفسية والاجتماعية والفكرية، مما ينسّب التأويل، فإن مسألة التأويل تقع في قلب التحولات العلمية والتاريخية التي يعرفها العالم المعاصر، والعالم الإسلامي في موقع القلب منه.
وفي هذا الإطار يمكن التمييز في سياقنا الحضاري الإسلامي المعاصر، بين أربعة أضرب من التأويل؛ “التأويل النصي” الذي من ثوابته الإناطة بظاهر النص، وتمثله الحركات السلفية، و”التأويل التوفيقي” وتمثله مختلف أطياف الحركات الإسلامية، و”التأويل العرفاني” وتمثله الحركات الصوفية، و”التأويل الخروجي” وتمثله السلفية الجهادية؛ بحيث إن كل تأويل يعبر عن منظور مخصوص لطبيعة الاجتماع السياسي، كما أن كل ضرب من هذه الأضرب من التأويل يعبر عن إستراتيجية للفعل والتأثير في التاريخ. وهو ما يؤكد أن الانشغال والتفكير في موضوع التأويل ليس من باب الترف الفكري، وإنما هو من باب “ما تحته عمل”، ذلك أن أدواره الوظيفية بالغة الجلاء والأهمية..
كان في مقدمة ما عُني به الفكر الإسلامي في بيئاته المتعددة، عند أهل التفسير، وأهل الأصول، والفقهاء، والمحدِّثين، واللغويين، والصوفية، والفلاسفة والمتكلمين.. على اختلافها وتشعبها، تأسيسُ البيان؛ المؤدّي إلى فهم الخطاب الشرعي، ووضعُ ضوابط الفهم للنص (قرآنًا وسنة) ، وبيانُ كيفية الفهم عنه، واستنباط معانيه ومقاصده، وضبطُ طريقة تأويله.
وفي المجال التداولي الغربي كان التأويل في الأصل مقتصراً على تفسير الكتب المقدسة، لكن مجاله اتسع خلال القرن التاسع عشر ليشمل قضية التفسير النصي برمتها، من خلال بروز “تيار هيرومينوطيقا التحليل الذاتي” مع “شلايرماخر” و”فيلهلم ديلتاي” سلفا “هايدغر” الأكثر شهرة في هذا المجال.. وهو ما مهّد لظهور “نظرية التأويل” التي اهتمت في بادئ الأمر بكيفية تفسير النصوص، ثم أخذت بالتطور بوصفها فرعاً رئيسا في دراسات الكتاب المقدس.
فظهر الحديث عن “التأويل الهذياني“، وعن”التأويل الفيلولوجي”، و”الجماعة المؤوِّلة” (interpretive community)، و”التخمين التأويلي” (conjecture interpretative)، وغيرها من المركبات المفاهيمية.
وهو ما يؤكد أن نشأة التأويل في الفضاء اليهودي-المسيحي، تمت في تربة النصوص الدينية؛ ففي الثقافة اليهودية نجد تراثا تأويليا حاضرا عند معالجة نصوص من التلمود والمدراشيم، من قبيل ما نجده عند فيلون السكندري؛ الذي دوَّن قواعد تتبع عند التأويل المجازي، والتمييز بين المعنى الروحي والمعنى الحرفي، وعند موسى بن ميمون القرطبي الأندلسي المتوفى سنة (ت602ﻫ) خصوصا في كتابه (دلالة الحائرين)؛ وفيه تأويل لكثير من المجازات والاستعارات التي وردت باللغة العبرية، أخذ فيه ابن ميمون من الأرسطية والأفلاطونية المحدثة. وابن باقودة في كتابه “نحو القلوب” والذي نحى فيه منحى عرفانيا ظاهرا.
وعلى هذا الغرار تفتّحت آفاق تأويلية دارت الأناجيل في فلَكها، لاسيما عند آباء الكنيسة الذين قدّموا تأويلا رمزيا في ضوء مذاهب الإسكندرانيين من الآخذين بالأفلاطونية المحدثة. فعند ديونسيوس الأريوفاغي تم مزج اللاهوت المسيحي بالفلسفة الهلينية، كما تم وضع الأناجيل في سياق التأويلات الرمزية.
وفي المجال الإسلامي عني المشتغلون بعلوم القرآن بإيراد معان متعددة لمصطلح التأويل، في مقابل التفسير، كما فطن القدماء لما نطلق عليه اليوم “المبحث السيمانطيقي” الذي يعنى بمعرفة دلالات الألفاظ، لشدة تعلقه بالتأويل، حيث عملوا على جمع المادة اللغوية من القرآن الكريم، وبينوا مصارفها ودلالاتها وحقول معانيها؛ مما أثار جدلا واسعا بين تيارين رئيسين، تمثلا في الأشاعرة والمعتزلة من حيث مناط الاتفاق في مسائل، ومناط الاختلاف في أخرى، ولم يلبث تيار التأويل أن اشتد اندفاعه لدى الشيعة ولدى الصوفية بأشكال متباينة.
وقد صاغ القدماء فهْمَهم للنشاط التأويلي، بعد وضعه في مجال حيوي يضم اللغة، والدلالة، والقرينة، والسياق، فضلا عن مباحث أخرى من المعاني المفردة والمعاني المؤلفة، مما يسميه المناطقة العرب “التصورات والتصديقات”، بل إن التأويل امتد عند القدماء ليشمل الأحلام، وقد اتسع التأويل فلم يقف عند حدود النصوص وإنما تجاوزها إلى تأويل الظواهر الثقافية الكبرى، على نحو ما نجد في رسائل الجاحظ، وكتابات أبي حيان التوحيدي، و كذا تأويلات ابن خلدون لحركة التاريخ والعمران.
ولا يخفى أن أقسى ما يتعرض له أي “نص“ أن يُقرأ بـ”منهجية“ غريبة عن معهود خطابه، في لغة أخرى، عند قوم آخرين؛ فتكون قراءة مهدِرة لسياقه ومقاصده، مُغّيِّبة للعديد من خصوصياته.
وقد ازدهرت في الثقافة العربية والإسلامية المعاصرة العديد من أضرب التأويلية الجديدة، التي عملت على تطبيق بعض مبادئ اللسانيات ومنهجيات التأويل على النصّ القرآني؛ وهي القراءات التي لم تخل من مزالق نظرية ومنهجية، أثارت العديد من الانتقادات والاعتراضات، في حقل المشتغلين بالعلوم الإسلامية، حيث برز الحديث عن “حدود التأويل” les limites de l’interprétation في مقابل دعاوى الانفتاح اللامقبول، وعن “المعنى الذاتي وانحراف التأويل” Individual meaning، وعن محاولة إيجاد إجراءات تَعصم المؤوِّل Interpretant والعملية التأويلية من الإفراط والتعسف، وتسهم في تمييز التأويلات المناسبة من غير المناسبة أو الخاطئة mésinterprétations، واشتد البحث عن التأويل المعتدل l’interprétation modérée، سعيا لإرساء قواعد “القراءة المنهجية للنصوص” lecture méthodique des textes.
الأمر الذي استدعى استحضار جملة من المقتضيات، والضوابط، أما المقتضيات فيمكن إجمالها فيما يلي:
ـ المقتضى المفاهيمي؛ يقتضي التدقيق التحليلي؛ أي القدرة على تفكيك الكليات إلى عناصرها، والتمحيص في الجزئيات؛ إذ ثمة علاقات ووشائج لا يمكن اكتشافها، إلا بالنظر إلى المعنى الكلي، من خلال أنماط التجاور والتقابل، ومن خلال متابعة إيقاعات الخطاب في حركاته.
ـ المقتضى المرجعي النسقي؛ المتمثل في بناء الأطر المرجعية والأنساق القياسية..
ـ المقتضى التنزيلي؛ من خلال استثمار طاقات النص (جدلية العلاقة بين المنطوق والمفهوم)، وهو ما حققت فيه أمة الختم كسبا إبداعيا فريدا؛ ظهر جليا في توضيح كيفيات التنزيل، بشروطها ومناطاتها، تخريجا وتحقيقا وتنقيحا، ومقاصدها ومآلاتها، والموازنات بين المصالح والمفاسد التي قد تنتج عن هذا التنزيل، كما تم تفصيل القول في وسائل ترتيب الأولويات، وميزوا بين الأولى في كل نازلة، وتتبعوا الاحتمالات والوجوه والأشباه والنظائر، فنتج من ذلك كله فقه تنزيلي ضاف ووضيء.
ـ المقتضى التكاملي؛ يتغيى تحقيق الانسجام بين الواقع والنص، والتجسير بين التطبيقي والنظري، أثناء عبور الأحكام والحِكَم، وتنزيلها على الواقع؛ ذلك أن التعدد في أوجه فهم النص، قد يكون راجعًا إلى لغته، ألفاظًا وعلاقات؛ وقد يكون راجعًا، لا إلى النص ذاته، بل إلى “الجهد التأويلي“.
ـ المقتضى الرؤيوي الشمولي؛ الذي ينطلق من الرؤية الكلية، النابعة من الرؤية القرآنية الكونية الحضارية، وقيمها، ومفاهيمها، ومبادئها، وثوابتها، مع التسلح بالعقلية الشمولية الناقدة والمبدعة.
ـ المقتضى التقويمي؛ بحيث إذا أردنا أن يكون التأويل ناجحا وجب أن نبلور معايير نظرية وإجرائية للتقييم.
ولتحقيق هذه المقتضيات في كل ممارسة تأويلية، لابد من الالتزام بجملة من الضوابط، في مقدمتها:
ـ الضابط المنهاجي؛ الذي يعد بمثابة خريطة طريق لاستبانة الخطوات أو الوسائط والوسائل التي يتحقق بها الوصول إلى الغاية على أفضل وأكمل ما تقتضيه الأصول وتتيحه الإمكانات.
ـ الضابط اللغوي؛ ومفاده الانضباط لقوانين اللسان العربي، ومعهود العرب في خطابها، ومسالكها في تقرير معانيها، وأن يُفهم كتابها وَفق مدلوله العربي، الذي يتبادر إلى الذهن، من دون ليٍّ ولا إغراب، ولا تعطيل لمغزي، أو إقحام لمعنى؛ لأن “لسان العرب هو المترجم عن مقاصد الشارع” (الموافقات، 4/324).
ـ الضابط المقاصدي؛ من خلال ضبط العلاقة بين منهج الاستنباط ومسألة القصد، وضبط التفاعل بين متطلبات “المواضعات” اللغوية، ومقتضيات “القرائن” المحيطة بها، والنظر في “مساقات” الكلام، ومقتضياته.
ـ الضابط المآلي الاستشرافي؛ عبر ضبط العلاقة بين القارئ وفقه النص؛ وقد قننت كتب الأصول، والتفسير آليات القراءة التفسيرية والتأويلية، ومعاييرها من خلال الضوابط الكفيلة بالارتباط بـ”النص” وبمآلات تنويله، واستثمار معناه..
ـ الضابط التمثلي؛ وهو في حقيقته تلك النظرة الكلية التي من شأنها أن تؤطر كل المقتضيات، والتي تزكو ثمراتها بمقدار ما تحققه من استيعاب لأبعاد النظرة الكلية المستمدة من طبيعة النص المؤسس، عبر مراعاة القرائن، ومقتضيات الأحوال المحيطة بالنص، و”أسباب النزول” في الآيات، و”أسباب الورود” في الأحاديث، التي تشكل شواهد تعين على فهم النص، وآليات للوقوف على مراد المتكلم، دون أن تؤول هذه الآليات إلى أسباب تاريخية، للتملص من أحكام ينبغي أن تكون ثابتة دائمة.
المقتضيات والضوابط، شرطان متلازمان لصحة أي ممارسة تأويلية؛ تجعل النص المؤسس في منأى عن أن يكون مجالًا للتزيد والإقحام، أو العبث واللهو، وتمكِّن من الفهم الصحيح لمقاصده.. نعتبرها معالم في استئناف القول، واستعادة السؤال حول التأويل.. وهو ما يؤهلنا لتجاوز ما علق من اختلالات في تاريخ الفكر، وبناء منهجيات جديدة تؤسس لعلاقة جديدة بالنص القرآني، وتسعف في تلقّ جديد لهادياته..
وهو ما يفتح أمامنا دروبا تنظيرية، لصياغة أكثر وضوحا للممارسة التأويلية المشبَعة بخصائص؛ المقصدية، والوظيفية، والواقعية، والتفاعلية، والاعتبارية، تكون في منأى عن تأويليات القطيعة، وعن التأويلية الوجودية، وتأويلية التقليد..