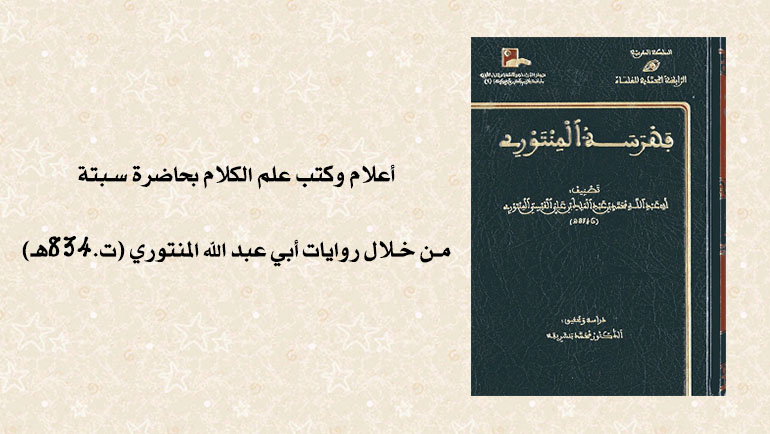تعرف المباحث التأويلية في الدراسات القرآنية تطورا مذهلا في أيامنا، سواء تعلق الأمر بالدراسات الاستشراقية الغربية([1]) أو بالمجال الإسلامي حيث يشكل المبحث التأويلي القرآني محورا رئيسيا من محاور إشكالية التجديد والإصلاح الديني.
نرمي في هذه الدراسة تقديم حصيلة أولية لهذه المجهودات التأويلية في دوائرها الثلاثة: التأويلية القرآنية الغربية، والتأويلية الإسلامية التجديدية (مع الوقوف على صلاتها بالتأويلية الكلاسيكية التراثية)، والتأويلية النقدية الحداثية.
أولا: التأويلية القرآنية في الغرب
من المعروف أن التقاليد التأويلية في الغرب خرجت إجمالا من هرمنوطيقا النص الديني في بعديها النقدي التاريخي؛ الذي استوجبه العمل على المدونة المقدسة من حيث الصحة والمرجعية والوجودي؛ الذي اقتضاه الخروج من ضيق اللفظ إلى العالم الرمزي الأوسع الذي يندرج فيه.
شكل النموذج الأول أساس التأويلية التاريخية-النقدية التي أسسها “شليامخر” و”دلتاي” في بحثها عن شروط تشكل النص من حيث المسافة التي تفصلنا عنه، وبالتالي يكون التأويل عملا أرشيفيا لاستعادة السياق الأصلي للدلالة، وشكل النموذج الثاني أساس التأويلية الوجودية لدى هايدغر وغدامير في تأكيدها لعلاقة الترابط العضوي بين الذات المأوّلة والعالم الذي تقصده بالفهم (الدائرة الهرمنوطيقية بعبارة هايدغر). وهكذا يتضح أن التأويلية الغربية تتأرجح بين بعدي الانتماء والمسافة، التقليد والقطيعة، الاعتقاد والانتقاد، الفهم والتفسير([2]).
كل هذه الأبعاد والمسالك مستمدة في جذورها من الخلفيات التأويلية اللاهوتية المسيحية من حيث الإشكال الذي طرحته في أفق الحداثة مسألة العلاقة بين الذات المعترفة (الاعتراف كصلب للاعتقاد والسلوك الديني) والذات العارفة؛ أي الواعية التي تتحكم في مساراتها النظرية والعملية من خلال أفكارها الذاتية.
ويمكن القول إجمالا أن الدراسات القرآنية في الغرب([3]) تتمحور حول مسلكين كبيرين: الاتجاه النقدي-التاريخي والاتجاه البلاغي-الأدبي، أولهما يشكل امتدادا للمشروع الفيللوجي الاستشراقي في تطبيق مناهج نقد النص التي طبقت على النص المقدس اليهودي-المسيحي، وثانيهما يندرج في سياق المنهجيات اللسانية والسيميولوجية الجديدة في تحليل الخطاب والنص.
في المسلك الأول، يمكن أن نصل في ضوء الدراسات التوثيقية والحفرية واستقصاء المخطوطات والنقوش إلى أن مشروع “المدونة القرآنية” الذي انطلق في بداية القرن العشرين (الطموح لإصدار نسخة نقدية محققة من القرآن الكريم) لم يفض إلى نتائج تدحض الرواية الإسلامية التقليدية حول جمع القرآن، على الرغم من الآمال التي كانت معلقة على “المخطوطات الألمانية” المجموعة في الثلاثينات (على يد برجستراسر وتلميذه بريتزل) وعلى مخطوطات صنعاء التي تعود إلى عصر البعثة النبوية.
بيد أن هذا الجهد كان مفيدا في الجانب المادي من توثيق المخطوطات القرآنية، بجمع ودراسة مئات الألواح والأوراق والنقوش التي تناولها الباحث الفرنسي “فرانسوا دي روش” بدراسات مفيدة تستدعي المتابعة([4]).
وفي غياب أي وثائق تاريخية موضوعية، يمكن الجزم بان أطروحة المراجعين الجدد حول النشأة المتأخرة والتدريجية للقرآن الكريم (في القرن الثاني أو الثالث الهجري وفي سياق المشروع الإمبراطوري الأموي) قد انهارت بالكامل([5])، مما حدا برائدة هذا الاتجاه “باتريشيا كرون” إلى مراجعة أطروحتها الأصلية التي تعود جذورها إلى المؤرخ الأمريكي “جون وانسبورو”([6]).
ونتيجة لفشل هذه النظرية، ظهرت أطروحة مختلفة تسير في الاتجاه نفسه ذهبت إلى أن القرآن الكريم نتاج للعصور الكلاسيكية المتأخرة (القرن الرابع والخامس الميلادي)، مستندة إلى بعض النصوص المتشابهة مع “الأناجيل المنحولة والمخفية” للتدليل على هذه الفرضية المثيرة.
ولعل أهم من يدافع عن هذه الأطروحة هي الباحثة الألمانية الشهيرة “أنجليكا نويفرت” التي أصدرت جملة أعمال وفق المنهج السياقي الذي اعتمدته، في إطار البحث عن مساره تشكل النص القرآني من منظور مجال تلقيه أي المجموعة المسلمة نفسها التي بقدر ما هي نتاجه، هي أيضاً بمعنى ما التي أنتجته. القرآن الكريم من هذا المنظور هو استعادة وتأويل وإعادة صياغة للنصوص التوراتية والإنجيلية التي شكلت مقوم الثقافة الدينية للأمة المتلقية للوحي، ومن هنا ضرورة النظر إليه كنص شفوي تداولته الجماعة المؤمنة وعكس أوضاعها بدل النظر إليه حسب الباحثة كنص يتعالى على التاريخ([7]).
ويمكن القول أن هذه النظرية التي تتقاسمها الباحثة الألمانية مع الفرنسي “كلود جيلو”([8]) والأمريكي “غابريلرينولد([9]) بوتيرة أكثر عدوانية لدى الأخيرين؛ لم تقدم من الأدلة الفيللوجية سوى بعض المقارنات المتعسفة في الغالب التي لا تثبت أكثر مما هو معروف من انتماء القرآن الكريم للنسق الإبراهيمي التوحيدي.
ومن نافل القول أن علاقة القرآن بالنصوص المقدسة السابقة من البديهيات التي لا تحتاج لبيان، بل إن بنية القرآن البرهانية تقوم على الإحالة إلى تلك النصوص وإبراز كونه مصدق ومصحح لما قبله، وما تفيده الدراسات المقارنة المذكورة هو إحاطة الكتاب الإسلامي المعظم بالكتابات اليهودية والمسيحية التي لم تكن متاحة لعموم الناس مما اعتبره الإسلام معجزة تثبت صدق الرسالة المحمدية.
أما الاتجاه البلاغي الدلالي فيمكن أن نقسمه إلى مسلكين ذهب أحدهما إلى تطبيق منهجية البلاغة السامية التي طبقت من قبل على العهدين القديم والجديد، واتجه ثانيهما إلى تطبيق أدوات التحليل اللساني والسيميولوجي باستكناه البنية التركيبية والحجاجية للقرآن.
تميز في الاتجاه الأول “ميشال كويبرز”؛ وهو باحث ورجل دين بلجيكي أصدر عملا متميزا بعنوان: “نظم القرآن”([10]) يكمل أعماله السابقة التي تناولت سورا من القرآن من بينها كتاب خاص بسورة المائدة.
البلاغة السامية، على عكس البلاغة اليونانية الخطية، تقوم على التوازي والبناء المحوري العكسي الذي لابد من استكشافه لفهم بنية المعنى([11])، وهو ما تنبه إليه جزئيا الجرجاني في نظريته للنظم، في حين بين “كويبرز” الآثار الخصبة لهذا المنهج الذي يثبت دقة تركيب النص القرآني وتماسكه المنطقي الصلب على عكس الأطروحة الاستشراقية التقليدية التي زعمت تفكك النص وعشوائية بنائه([12]).
أما التحليل اللساني الدلالي فقد ركز على جوانب التناص الداخلي في القرآن وتناصه مع النصوص الأخرى. ومن أبرز من اهتم بهذا الجانب من الدراسات القرآنية في الغرب الباحثة الفرنسية “أن سيلفي بواليفو” التي كتبت عملا جامعيا متميزا (في أصله رسالة دكتوراه) بعنوان: “القرآن كما يرى نفسه: المرجعية الذاتية في القرآن “توصلت فيه إلى أن البنية التركيبية للقرآن الكريم (على عكس الكتب المقدسة الأخرى) تؤسس من خلال الحوار والجدل مع أهل الكتاب لمرجعيته الذاتية، كما أنه يواكب بالتفصيل سياقات نزوله في مسار الرسالة مما ينفي فرضية جمعه المتأخر أو التفاوت التاريخي بين لحظة الجمع ولحظة التقنين المرجعي([13]).
ما نخلص إليه أن الدراسات القرآنية في الغرب تعرف راهنا حيوية عاليا في جوانبها الفيللوجية والتأويلية، في مرحلة تحطمت فيها النظريات الاستشراقية التقليدية والنقدية المتطرفة التي أرادت، تعسفا، تطبيق مناهج نقد النص اليهودي-المسيحي على الكتاب الإسلامي المقدس، وإن كانت رواسب هذه الأطروحات ما تزال تغذي الكتابات الإسلاموفوبية العدائية الخالية من الرصانة العلمية والمشحونة بأيدولوجيا الكراهية والتعصب.
ثانيا: التأويلية الإصلاحية (المقاربات التفسيرية الجديدة)
رغم المحاولات العديدة التي بذلت في حقل الدراسات القرآنية في الساحة العربية الإسلامية، يمكن القول أن هذا الجهد ما يزال ضعيفا محدودا وارتجاليا في الغالب، بالمقارنة مع التراث التأويلي والتفسيري الثري والمتشعب الذي ما يزال هو الأرضية المرجعية لعموم المسلمين.
يتمحور هذا التراث حول كتب ثلاثة أساسية هي: “جامع البيان في تأويل “آي القرآن” لأبي جعفر الطبري (ت 310)، و”الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل” للزمخشري (ت 538)، و”مفاتيح الغيب” لفخر الدين الرازي (ت 606).
شكل كتاب الطبري النموذج التأسيسي للتقليد التفسيري الإسلامي في استقلاليته عن السير والمأثورات، واستثماره للجوانب الفقهية في الكتاب المعظم. وقد اعتمد الطبري في تفسيره منهج التفسير بالمأثور باستخدام ثلاث آليات مترابطة هي: تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة أقوال الصحابة والسلف الأول من التابعين، وتفسير النص بظاهر دلالته حسب مألوف العرب في التعبير، معتبرا أن دائرة التأويل المقبول محدودة بالرواية الصحيحة دون قول بالرأي.
ومن هنا تمييز الطبري بين ثلاثة مستويات في النص المنزل: مستوى الغيب الذي اختص الله بتأويله، ومستوى الأحكام التي بينتها السنة النبوية، ومستوى التعبير اللغوي الذي يؤول على أساس مألوف العرب في التعبير([14]).
وإذا كان الغرض الأساس للطبري هو تقديم نموذج تفسيري سماعي بالتزام المأثور من التأويل، إلا أنه بلور بداية المقاربة البلاغية في التفسير من خلال تصوره الدلالي لمرجعية التعبير القرآني في السياق التداولي الجاري لأمة الاستجابة والتلقي التي نزل القرآن بلغتها وحسب تقاليدها التأويلية.
“فالواجب أن تكون معاني كتاب الله المنزل على نبينا محمد، صلى الله عليه وسلم، لمعاني كلام الله موافقة وظاهرة لظاهر كلامها ملائما”([15]).
أما كتاب الزمخشري المعتزلي فهو الذي كرس المقاربة البلاغية في تأويل القرآن الكريم بتطبيق نظرية كبير اللغويين العرب “عبد القاهر الجرجاني” (ت 471) في النظم، وقد حظي الكتاب بقبول واسع لدى أهل السنة رغم تحفظهم على مواقفه الكلامية، فانساقوا من بعده إلى المنهج البلاغي مسلكا أساسيا للتفسير.
النموذج البلاغي الذي يصدر عنه تفسير الزمخشري يقوم على مبدأ العلاقة ما بين الكلام ومقتضى الحال؛ أي أن بلاغة الكلام هي “مطابقته لمقتضى الحال”، ومن ثم فإن التحليل البلاغي هو “تحليل ما يشتمل عليه القول من اعتبارات مقامية”([16]). وفق هذا النموذج تتوزع البلاغة إلى قسمين كبيرين: مبحث بياني يتعلق بالدلالة والمعنى، ومبحث بديعي يتعلق بالجانب الجمالي في الكلام.
ولقد انطلق الزمخشري في تفسيره من أن علم التفسير يستوعب كل العلوم الشرعية، واعتبر أن المسلك التأويلي للقرآن يختص به علمان بلاغيان هما علم المعاني وعلم البيان([17]).
أما الرازي فهو إمام الأشعرية المتأخرة ويتميز كتابه بالمنهج التكاملي الموسوعي الجامع بين التأويلية البلاغية والمباحث الكلامية الفلسفية والأحكام الفقهية.
ودون الخوض بالتفصيل في هذا الموضوع العصي الذي يحتاج لدراسات معمقة وجهد علمي واسع، نكتفي بالقول أن المنظور التأويلي في التقليد الإسلامي الوسيط تأرجح بين نمطين من التأويلية: تأويلية العبارة وتأويلية الإشارة، يحيلان إلى تصورين متمايزين للدلالة والمعنى، وعلاقة النص بالوجود والذات.
النموذج الأول هو الذي قننته علوم البلاغة منذ تحدد التصنيف الثلاثي بين البلاغة (تطابق اللفظ مع مقتضيات الحال) والبيان (تلازم اللفظ وملزومه غير المباشر) والبديع (تزيين الكلام وتحسينه).
ويقوم هذا النموذج على أطروحتين كبيرتين لهما مرجعيتهما الكلامية والفلسفية هما:
- نظرية الوضع في اللغة؛ أي اعتبار الكلام لاحقا على مرجعه الدلالي الأصلي، بمعنى أسبقية المعنى أنطولوجيا ودلاليا على اللفظ، مع التباين في تحديد أصل المواضعة وفق المصادرات والمسلمات الكلامية المتباينة.
ولقد تأرجح البلاغيون والمتكلمون بين موقفين أساسيين: موقف إشاري يعتبر اللفظ موضوعا للموجود الخارجي (جمال الدين الشيرازي) وموقف تصوري يعتبر اللفظ موضوعا للصورة الذهنية (الجويني والغزالي).
وقد دافع فخر الدين الرازي في تفسيره عن أطروحة الطبيعة التصورية للدلالة، مبينا أن الألفاظ دلالات على ما في الأذهان لا على ما في الأعيان”([18]).
اللفظ من هذا المنظور “تعريف لما في القلوب”، والكلام تعبير عن ما في الضمير “من الإرادات والاعتقادات”([19])؛ أي هو المعنى القائم في النفس.
إلا أن هذا التصور الذهني للألفاظ، الذي يكاد يجمع عليه البلاغيون، لا يلغي مصادرة انعكاس أعيان العالم في اللغة عن طريق التصور، بما يعني في كل الأحول مصادرة ترجمة اللغة للأعيان الموجودة حقيقة. المسألة اللغوية تتنزل في علاقة ثلاثية؛ بين الإشارة التي هي المستوى التعبيري الأول عن الموجودات، والكلام الذي يستوعب التصورات الذهنية عن الوجود، والكتابة التي هي الاستنساخ الناقص لمضامين الكلام([20]).
ويرتبط بهذا الموقف تصور أصل الوضع في مسار تشكل اللغة، مما عبر عنه الجدل المعروف بين القول بتوقيفية اللغة واصطلاحيتها. والمعروف أن خلفية هذا الإشكال كلامية تتعلق بمسالة كلام الله. ففي حين ذهب المعتزلة انسجاما مع مبدأ التوحيد إلى أن المواضعة اللغوية سابقة على كلام الله وجوبا لإمكانية الإدراك العقلي لدلالته، فالدلالة اللغوية تحيل إلى العقل الذي هو المؤهل لمعرفة قصد الله([21]).
ذهب الأشاعرة إلى أن الكلام صفة ذاتية، فاضطروا إلى التمييز بين الكلام النفسي الذاتي الذي هو المعنى القديم قبل نزول اللفظ، والكلام اللفظي من أصوات وحروف مترددين بين القول بأصله الإلهي واصله التواضعي آو التوقف في الموضوع.
والواقع أن الخلاف بين المتكلمين لا ينعكس جوهريا في نظرية الدلالة التي هي المبحث الأساس في “علم المعاني” من فروع البلاغة، حيث تسود مصادرة أولوية المعنى وأسبقيته على اللفظ، وهي الفكرة المهيمنة على أدبيات “إعجاز القرآن”، وقد صاغها الجرجاني بقوله: “جنس المزية.. من حيز المعاني دون الألفاظ”([22]).
- نظرية النقل في تحديد نظام استعمال اللغة وفق ثنائية الحقيقة والمجاز التي بلورها الجاحظ واعتمدها عموم البلاغيين بعده. وتقوم هذه النظرية على تعريف الحقيقة بأنها أصل الاستعمال اللغوي في أول الوضع والمجاز هو العدول عن هذا الاستخدام لغرض تبييني أو فني.
يوضح الجرجاني هذا التمييز بقوله: “كل كلمة أريد بها ما وقعت له في فن الوضع، وإن شئت قلت في مواضعة، وقوعا لا يستند فيه إلى غيره فهي حقيقة… وأما المجاز فكل كلمة أريد بها غير ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بين الثاني والأول فهي مجاز. وإن شئت قلت كل كلمة جزت بها ما وقعت له في وضع الواضع إلى ما لم توضع له من غير أن تستأنف فيها وضعا لملاحظة بين ما تجوز بها إليه؛ وبين أصلها الذي وضعت له في وضع واضعها فهي مجاز”([23]).
ويعني الأمر، هنا، أن المجاز هو انزياح عن المعنى الأصلي يقتضي فهمه إدراك المناسبة أو العلاقة التي تجيز التصرف في الدلالة من منطلق حصر المعنى في المرجع. وما ينبغي التأكيد عليه هو أن المفسرين الذين سلكوا المنهج البلاغي انطلقوا دوما من الوظيفة البيانية للغة، واعتبروا الصور البلاغية من حيث دورها في إجلاء المعنى من خلال تحسين استخدامات اللفظ انطلاقا من قرائن ضابطة ترجع إلى المعنى في نسقه الدلالي الثابت.
التشبيه، إذن، غير مؤثر في حركية المعنى، بل المجاز نفسه لا يخرج عن منطق المواضعة وليس إبداعا ذاتيا. ولا فرق في استثمار دلالة النص بين التأويل الكلامي في ربطه متشابه الآي بمحكمه، والقياس الأصولي في ربط فرع الحكم الشرعي بأصله([24]).
وهكذا يتضح الترابط العضوي بين نظرية الوضع ونظرية النقل، وبين ثنائيتي اللفظ، المعنى والحقيقة، المجاز، من منطلق تأويلية العبارة؛ أي الوحدة اللفظية المطابقة للأصل في حرفيته ووجوده الفعلي المباشر (بغض النظر عن النقاش حول طبيعته: الحقيقة العينية أو الذهنية).
ولا يخفى أن هذه التأويلية، التي تأثرت بالبلاغة الأرسطية ونظرية الحد المنطقية([25])، ارتبطت بالنقاش الكلامي المتشعب حول الصفات الإلهية، في اتجاه مفهوم لكبح خطري التجسيم الحسي والتفسير الباطني([26]). بيد أن هذه المقاربة أفضت إلى نقاش داخل المدرسة البيانية نفسها في اتجاهين: عبر عن أولهما شيخ البلاغيين العرب الجرجاني في نظريته حول نظم القرآن([27]) التي أراد فيها تجاوز ثنائية اللفظ والمعنى باستكناه دلالة النص في نظامه التركيبي وإن لم يتجاوز مستوى الآيات القصيرة (استمر هذا النهج عند الزركشي والبقاعي، وأعاد الاعتبار إليه في العصر الحاضر المفسر الباكستاني أمين أحسن إصلاحي وتجدد الاهتمام به حاليا في الدراسات القرآنية الغربية كما أشرنا سابقا).
وعبر عن ثانيهما ابن تيمية في نقده لنظريتي الوضع والنقل؛ أي أسبقية المعنى على اللفظ والتمييز بين الحقيقة والمجاز.
يذهب ابن تيمية إلى “أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ”([28])؛ فليست حدودا ثابتة في الدلالة، بل هي من سياقات الاستخدام اللغوي، ويقول صراحة “لا يمكن لأحد أن يقول عن العرب، بل ولا عن أمة من الأمم أنه اجتمع جماعة فوضعوا جميع هذه الأسماء الموجودة في اللغة، ثم استعملوها بعد الوضع”([29])، وإنما تنتقل اللغة عن طريق السياق الاجتماعي الذي ينشأ فيه الفرد. وهكذا يصل ابن تيمية إلى أن مرجع اللغة “حقيقة عرفية” لا وجودية أو طبيعية.
أما النموذج الإشاري فهو الذي تبلور في سياق التقليد التأويلي الصوفي، وبتأسيس على منطلقين في الدلالة:
أولا؛ النظر إلى دلالة اللغة من منظور أنطولوجيا الظهور والتجلي، من حيث هي إشارات لوجود متسع لا ينحصر في تصورات العقل الذاتي أو حدود المنطق، ومن ثم تجاوز ثنائية اللفظ والمعنى، والتأكيد على أهمية الحرف والدال اللفظي الذي لا يحيط به معنى، ولا ينحصر في وظيفة إجلاء المضمون القائم في النفس.
ثانيا؛ أولوية الإشارة على العبارة؛ لأن الأصل في اللغة هو المجاز، الذي هو السمة الغالبة على اللغة الطبيعية التي يتداخل فيها الخيال بالواقع، وأحكام الوجود بأحكام القيمة، في حين أن العبارة هي استدلال اصطناعي قائم على إجراءات اختزالية وتنميطية تفرغ الوجود من ثرائه وزخمه القيمي والجمالي([30]). ومن هنا تعدد مستويات الدلالة التي صنفها الصوفية عدة تصنيفات من أشهرها التمييز بين العبارات، والإشارات، واللطائف والحقائق (كما في تفسير السلمي وللقشيري عبارات مماثلة في تفسيره).
المجاز، بهذا المعنى، ليس قسيم الحقيقة؛ أي تحريفا في التعبير وانزياحا عن المعنى الأصلي، بل هو إبداع لا محدود في أفق الدلالة، ينتج عن الربط بين فضاءات دلالية متغايرة في ما وراء مرجعيات الاستعمال التقليدية أو المألوفة. ومن هنا خطأ اختزال بعد التمثيل في القرآن الكريم في آلية التشبيه التي تقيد المعنى، في حين أن التمثيل خروج عن الثنائيات الدلالية المعروفة وفسح لإمكانات الفهم بحسب حال المأوّل ومقاماته الوجودية والمعرفية، وهو ما يدخل في مفهوم “الخيال الخلاق” الذي عبر به ابن عربي عن نمط المعرفة الوحيد الممكن للحقائق الإلهية التي لا يمكن الوصول إليها في كنهها الباطن([31]). ومن هنا قول أبي علي الروباذي: “علمنا هذا إشارة فإذا صار عبارة خفي”.
ومع أن المبحث التفسيري شكل مشغلا رئيساً من اهتمامات الإصلاحيين النهضويين، إلا أنه لم يستطع تجاوز التراث التفسيري الوسيط الذي توقفنا عند بعض سماته ومكوناته.
وقد برز في هذا الباب تفسيران هامان هما “تفسير المنار” الذي بدأه “الإمام محمد عبده” واستكمله تلميذه “رشيد رضا”([32])، وكتاب “التحرير والتنوير” للطاهر بن عاشور([33]). وعلى الرغم أن الكتابين لم يخرجا إجمالا عن المقاربة التفسيرية الكلاسيكية، إلا أنهما حملا بوضوح الهموم التجديدية الإصلاحية التي ينضح بها الخطاب النهضوي الإسلامي الحديث، وظهرت فيهما إرهاصات الأنماط الجديدة من التفسير، وعلى الخصوص مبحث “الإعجاز العلمي”، التي انتشرت على نطاق واسع في النصف الثاني من القرن العشرين.
يمكن القول إجمالا أن الدراسات القرآنية الإسلامية تمحورت حول اتجاهين، تداخلا في بعض الأحيان، ذهب أحدهما إلى مسلك “تأويلية رؤية العالم” وذهب ثانيهما في اتجاه “التحليل الأدبي والدلالي” للخطاب القرآني.
أهم من سلك الاتجاه الأول هو المفكر الباكستاني الأشهر “فضل الرحمن” الذي يتميز بكونه أول عالم مسلم اطلع على التأويليات المعاصرة، وحاول تطبيقها على النص القرآني من منظور إيماني وإصلاحي ملتزم.
تقوم مقاربة فضل الرحمن على مبدأ الحركية المزدوجة: الدراسة الموضوعية للنص في مصدره وظروف تشكله، وإعادة صياغة مقاصده وغاياته العليا الثابتة وفق سياقات العصر ومقتضياته. في الجانب الأول، يتم النظر للكتاب الإلهي في ضوء ظروف ومحددات سياق التلقي الأصلي؛ أي المجتمع العربي الجاهلي الذي نزل القرآن بلغته وتعامل مع واقعه المجتمعي، وفي الجانب الثاني يتم تجريد النص من ملابساته التاريخية؛ أي فصل القيم الكونية السامية المتعالية عن معايير تنزيلها الظرفية وفق معايير المشروعية الدلالية الحالية.
يعتمد فضل الرحمن “المنهج التركيبي” في تفسيره؛ أي الربط بين الموضوعات لاستخراج المنظور الدلالي للنص بدل التركيز على الترتيب الزمني، معتبرا “أن الغرض التركيبي هو الوسيلة الوحيدة لتمكين القارئ من تذوق حقيقي للقرآن الكريم وفهم أوامر الله الموجهة للإنسان”([34]).
ومع أنه يصعب تصنيف المقاربة الجريئة التي قدمها “أبو القاسم حاج حمد” في إطار استكشاف ما أسماه بالمنهجية المعرفية القرآنية، إلا أنه من البديهي أنه أراد استكناه رؤية العالم في الكتاب العزيز من خلال ثنائية القراءتين: قراءة القرآن المنظور قراءة تحليلية متدبرة وقراءة الكون المنشور قراءة سننية عملية، باعتبار أن القرآن هو الوعي المعادل للوجود الكوني وحركته، “بما يعني انسياب معانيه مع الصيرورة المندفعة أبدا باتجاه المستقبل بحيث تتبدى قدرته دائما على الإحاطة بالمتغيرات واستيعابه لقوانينها الاجتماعية والتاريخية ضمن صياغة كونية للمناهج المعرفية المعاصرة واللاحقة”([35]).
ويمكن القول أن “الحاج حمد” أبدع نماذج تأويلية خصبة، كان لها تأثير سريع خصوصا منذ تلقفها مشروع “أسلمة المعرفة” ووظفها في سياقات لم تكن دوما منسجمة مع حدس المفكر السوداني الراحل.
أما المسلك الأدبي الدلالي فأهم ممثليه هو بدون شك المستعرب الياباني ” توشويهكو ايزوتسو” في كتابه الرئيسي “الله والإنسان في القرآن” الذي اعتمد فيه منهجا سيميولوجيا مبتكرا تناول من خلاله الأنساق الدلالية في القرآن عبر دراسة تحليلية للتعابير المفتاحية فيه ومستويات الدلالة القاعدية والسياقية، من أجل النفاذ من خلال التحليل اللغوي إلى عناصر الرؤية المفهومية والأخلاقية التي يحتويها النص المقدس. إنه بهذا المعنى “علم لرؤية العالم” weltanschauungslehre، أو “دراسة لطبيعة رؤية العالم وبنيتها لأمة ما، في هذه المرحلة أو تلك من تاريخها. وهذه الدراسة تستهدي بوسائل التحليل المنهجي للمفاهيم الثقافية التي أنتجتها الأمة لنفسها وتبلورت في المفاهيم المفتاحية للغتها”([36]).
ومع أن مدرسة الناقد واللغوي المصري “أمين الخولي” (من أبرز عناصرها زوجته عائشة بنت الشاطئ) قامت بمحاولات لبناء منهجية بيانية جديدة في تفسير القرآن([37])، إلا أنها لم تفض إلى نتائج دالة باستثناء الضجة الكبرى التي ولدتها أطروحة محمد أحمد خلف الله حول الفن القصصي في القرآن الكريم([38]).
ويمكن أن ندرج في هذا المنحى تفسير سيد قطب “في ظلال القرآن”([39]) الذي استقصى فيه ملامح “التصوير الفني” في القرآن، مع أن الكتاب قد طغى عليه التجييش الأيديولوجي والنغمة الإقصائية المتطرفة. نشير هنا إلى أن المنهج الأدبي الدلالي قد أصبح له حضور واسع في الحقل الأكاديمي، من خلال تطبيق النظريات الأسلوبية والسيميائية على القرآن الكريم باستكشاف بنيته التركيبية وأساليبه الحجاجية وتداخلاته التناصية، دون أن تكون لهذه الجهود الهامة دلالة فاعلة في المنظور التأويلي الحي أي نمط تلقي وفهم النص في الوعي المسلم.
لابد أن نضيف إلى هاتين المدرستين المحاولة التي قدمها “حسن حنفي” في كتابه “من النقل إلى العقل” (الجزء الأول) الذي طرح فيه منهجية تأويلية تقوم على مرتكز ين أساسيين هما: مخاطبة شعور المتلقي للنص، وإعادة بناء دلالته بحسب واقع الناس المعيش ومصالحهم الحيوية القائمة. ومع أن حنفي وظف عدة منهجية تنتمي للمعجم الفنمونولوجي؛ أي تحليل الشعور([40])، إلا أن مقاربته لم تتجاوز أفكاره المألوفة حول تثوير التراث وتجاوز المنظور النقلي في الدين لتكريس قيم العقلانية بمفهومها الاجتماعي النضالي الملتزم.
يتعين التنبيه هنا إلى أن موضوع تأويلية النص الديني الإسلامي تحول إلى موضوع أثير في الأدبيات الإعلامية التي امتلأت بالمقالات والمقابلات حول مسالك فهم وتفسير القرآن من منظور سيطرت عليه الإشكالات الراهنة المتعلقة بالعنف والتشدد والإرهاب.
ولقد تمحور هذا الجدل حول التأويلية القرآنية حول موضوعين أساسيين: علاقة القانوني-السياسي بالعقدي في بنية النص ونسقه الدلالي، وصورة الآخر المخالف في الدين وإطار الارتباط معه من حيث أحكام العلاقة والمعاملة.
الصورة السائدة في هذا السياق هي أن القرآن الكريم ينبني على القول بتماهي وتداخل الأبعاد العقدية بالجوانب التشريعية والسياسية مما يحول الإسلام إلى مدونة تشريع تفصيلي لا مكان فيها تأويلية إنسانية حرة ولا تسمح بالتالي بالتأقلم مع أسس وقيم الشرعية المدنية الحديثة، كما أنه من حيث منظوره للحقيقة والخلاص لا يمكن أن يتعامل مع غير المسلم إلا من منطق الإلغاء والحرب.
ليس من همنا التعليق على هذه الأطروحة المتهافتة، وإنما حسبنا الإشارة إلى أن العديد من الوجوه “الإصلاحية” المسلمة في الغرب التي تهيمن على الواجهة الإعلامية من أمثال مالك شبل([41]) ورشيد بن زين([42]) وغالب بن شيخ([43]) تسعى إلى مواجهة نزعة الخوف من الإسلام المتصاعدة بفتح أفق تأويلي جديد للنص من خلال آليتين لا تخرجان في العمق عن نفس المصادرة السائدة، سواء من خلال النقد التاريخي الذي يطبق على القرآن الكريم نفس مناهج النقد التي طبقت من قبل العهدين القديم والجديد للوصول إلى النتيجة نفسها؛ أي النظر إلى الكتاب الذي بين أيدي المسلمين كنتاج لتدوين الأمة وفهمها، وليس متماهيا بالضرورة مع الأصل المنزل، أو من خلال توسيع آلية التأويل البشري بحيث تكون ناسخة لمنطوق النص وأحكامه.
في الحالتين تظل “التأويلية الإصلاحية” المقترحة سجينة لنماذج التأويلية المسيحية التي تختلف في الخلفيات والمرجعيات والسياق، عن التأويلية الإسلامية في منحيين رئيسيين: منزلة النص وسلطة التأويل. الفرق واسع بين تقليد تأويلي يحول الكلمة إلى المستوى الإلهي (عقيدة التجسيد) وبين تقليد ينظر إلى النص كوحي إلهي؛ أي رسالة إلى البشر بلغتهم وأنماط تعبيرهم؛ تراعي سياقاتهم الثقافية والمجتمعية وتتفاعلا حيّا مع تاريخهم، فعلى الرغم من الخلاف الكلامي المعروف حول عقيدة خلق القرآن لا أحد من المسلمين يقول بتماهي الكلام الإلهي مع الذات الإلهية نفسها.
كما أن الفرق جلي بين تقليد يخول سلطة مؤسسية قائمة حق التأويل الشرعي للنص في ارتباط بإدارة الخلاص الروحي، وبين تقليد قائم على رفض السلطة الكهنوتية، مما يعني فتح آفاق التأويل للنص دون تحكم تعسفي.
صحيح أن التأويلية القرآنية المعاصرة ما تزال في خطواتها الأولى، ولم تستفد إلا بطريقة محدودة من المناهج التأويلية الحديثة الخصبة التي تسمح باستكشاف آفاق رحبة لدلالات النص، على عكس المسالك المستمدة من الهرمنوطيقا المسيحية التي تعد، على مسحتها النقدية، من أثار النقاش اللاهوتي الداخلي، ولا فائدة كبرى ترجى منها في تجديد التأويلية الإسلامية.
ومن المعروف أن السياق الأصلي للتأويلية الغربية التي تداخلت مع أفكار التنوير الأوروبي هو سياق المسألة اللاهوتية السياسية باعتبار أن الفصل المطلوب بين الكنيسة والدولة يقتضي حسم موضوع السلطة التأويلية للدين، ومن هنا التمييز بين حلول ثلاثة بارزة: حصر شرعية التأويل بالسلطة السيادية للدولة (هوبز)، ترجمة مضامين الملة بلغة العقل العمومي الكوني (سبينوزا وكانط)، كسر السلطة التأويلية من خلال فردية الفهم الذاتي (بايل).
علمنة القيم الدينية في منظومة الحقوق الطبيعية للإنسان وعقلنة مضامين النص من خلال أدوات الهرمنوطيقا التي تحولت في دلالتها الواسعة إلى أساس القول الفلسفي المعاصر.
لم تكن، إذن، هذه التأويلية التنويرية في جانبها النقدي خروجا عن التقليد المسيحي، بل كانت أثرا من آثاره، ومن هنا إذا كان من الضروري تجديد العدة التأويلية الإسلامية إلا أنه من الحيف تحميلها رهانات غريبة عنها.. فتنصير الإسلام ليس هو الحل.
ثالثا: التأويلية القرآنية في القراءات الحداثية
شغلت المباحث القرآنية في السنوات الأخيرة جل المفكرين العرب التحديثيين الذين اهتموا بالمسألة التراثية، بعد فترة تهيب من التعرض للنص المقدس المؤسس والاكتفاء بالنصوص الثانوية الشارحة أو المأوّلة التي ليست لها قدسية المصدر والمنبع، وكان “محمد أركون” الاستثناء الأوحد في هذه القائمة باعتباره اقترح مبكرا مقاربته المنهجية للتعامل مع القرآن في نص منشور بالفرنسية في سبعينيات القرن الماضي([44]).
من هذه القائمة نذكر “نصر حامد أبو زيد” الذي بدأ دراساته القرآنية بالمقاربات التفسيرية لدى المعتزلة والصوفية (ابن عربي) قبل أن يقدم أطروحته التأويلية المكتملة في كتابه “مفهوم النص” (1990)، في الوقت الذي نشر “عبد المجيد الشرفي” رؤيته في المسالة القرآنية في كتابه “الإسلام بين الرسالة والتاريخ” (2001)، وقدم “هشام جعيط” تفسيره للظاهرة القرآنية في كتابه “في السيرة النبوية: الوحي والقرآن والنبوة” (1999)، وبدأ “محمد عابد الجابري” مشروعه في “التفسير الواضح للقرآن حسب ترتيب النزول” من خلال كتابه التمهيدي “مدخل إلى القرآن الكريم” (2006).
يتعلق الأمر بمقاربات متمايزة في التوجه والمنهج: أنثربولوجيا نقدية مطبقة حسب توجه أركون، وهرمنوطيقا تحليلية لغوية حسب أبي زيد، وتاريخ أفكار حسب الشرفي، ومقاربة ظواهرية فينمونولوجية حسب جعيط، وابستيمولوجية نقدية ملتزمة حسب الجابري.
ومع ذلك، يمكن القول أن هذه الأطروحات تلتقي في خطوطها العامة بخصوص الموضوعين المحوريين اللذين شغلا الباحثين التحديثيين في المسألة القرآنية وهما: الظاهرة الوحيائية؛ (أي تفسير ظاهرة الوحي) والظاهرة القرآنية؛ (أي اعتبارات جمع وتدوين وتقنين النص المقروء)، مع اختلاف لا ينكر في الاستنتاجات القيمية من هذه المواقف النظرية.
بخصوص الظاهرة الوحيائية التي تهمنا أساسا هنا، تنزع مختلف هذه المقاربات إلى التفسير النفسي-الاجتماعي لعملية الوحي باعتبارها من جهة، تعبيرا عن حالة نفسية قصوى يمر بها النبي ومن جهة أخرى، محطة من محطات التقليد الميثي (من ميث التي تترجم عادة بالأسطورة) لديانات الكتاب تعكس معطيات الوضع التاريخي القائم في الوسط الذي ظهرت فيه الرسالة.
يختلف الباحثون المذكورون في تعبيراتهم لكنهم يتفقون في المضمون: الوظيفة النبوية في التقليد الشرقي الأدنى القائمة على الرؤية الميثية الخلاصية، والسلطة المؤسسية للكتاب المقدس حسب محمد أركون([45]) النص منتج ثقافي تاريخي يعكس الواقع المجتمعي حسب أبو زيد([46])، الوحي كحالة استلابية رؤيوية يقتضيها تأسيس الديانات الكونية الكبرى التي تتطور وفق نسق غائي لا واع حسب هشام جعيط([47])، الوحي كحالة تخمر ذاتي في شخصية النبي يتناسب مع الأفق الميثي القداسي لمجتمع التلقي، وتعكس مناخه الاجتماعي والقيمي حسب عبد المجيد الشرفي([48])، الوحي كتعبير مكتمل عن تحولات عقدية وفكرية من عناصرها الأساسية التيار التوحيدي الرافض لعقيدة التثليث والطائفة الأبيونية اليهودية، والدعوة الأريوسية التوحيدية، والحركة الحنفية دون التعرض لمصدر الوحي ذاته حسب الجابري([49]).
الملاحظ هنا أن هذا التفسير الاجتماعي التاريخي يبحث له دوما (لأسباب دفاعية وسجالية بديهية) عن تأصيل في عقيدة خلق القرآن الاعتزالية، والتمييز الأشعري بين الكلام النفسي والكلام اللفظي للتدليل على إمكانية القول ببشرية وتاريخية النص في عباراته وبناءاته الدلالية مما يقترب من أطروحة القبض والبسط في شخصية النبي لدى عبد الكريم سروش([50])، دون الانتباه إلى أن الموقف الكلامي ينطلق من مسلمة المصدر الإلهي للوحي ولا يتجاوز الاختلاف القائم بين المتكلمين مسألة الخلق، في الوقت الذي لا نجد، حتى عند القائلين بأن القرآن كلام الله الذاتي، فكرة التماهي بين الله وكلامه أو فكرة تجسد الله في الكلمة الذي هو تصور مسيحي معروف.
ما نود التنبيه إليه هنا هو أن التأويليات النقدية التي توقفنا عندها تصدر عن موقف منهجي ملتبس وإشكالي: ينطلق من المقاربة الأنثربولوجية الوصفية في رصد الظواهر القداسية الخارقة التي يطلق عليها التعبير الميثي الأسطوري، وهي تسمية ظهرت أساسا في تحليلية القصص الشعبي المعبر عن المخيال الجماعي، في حين أن المصطلح الأكثر حيادية وموضوعية هو مقولة الرمز التي لا تتعرض بالتقويم للاعتقاد الإيماني كما أنها تحيل إلى ثوابت مجتمعية كبرى لا تنحصر في عصر بعينه ولا يقوم انتظام بشري بدونها، في الوقت الذي تضاعف هذه المقاربة الوصفية بتحليلية إبستيمولوجية وضعية قصوى تقصي من دائرة المعقولية والبرهان المعطى الديني الصادر عن الوحي والتنزيل، بحيث يتم النظر إليه إما كحالة نفسية باتولوجية استنساخا لأطروحة ماكسيم رودنسون التي تتكرر لدى جل الباحثين المذكورين([51])، أو حالة تاريخية اجتماعية ظرفية يقتضيها التاريخ الديني والمجتمعي.
إن هذه الحيلة المنهجية تبدو هشة عندما ندرك أنها تصدر عن تصورات وضعية وتاريخانية تجاوزها حقل الدراسات الدينية في الغرب، على الرغم من التنويه الدائم بالرجوع لمستجداته لتحرير العقل الإسلامي من دوغمائيته المعيقة. فالعالم الرمزي لا يمكن فهمه من منظور الخيال الزائف أو الأسطورة، بل هو الأفق المنبع للتقاليد الثقافية بكاملها، وهو ما يسمح بالتفكير حسب عبارة شيخ التأويليين المعاصرين “بول ريكور”؛ بمعنى أنه هو لحظة الانبثاق الأصلي للمعنى والتعبير عن الخلفية المفارقة والغيبية للنظر بما فيه القول الفلسفي البرهاني، وذلك هو أحد مدلولات الإيحاء والوحي حتى بالمفهوم البشري؛ أي الثقة في المعنى وأهلية اللغة على الكشف عن حقائق الوجود والتواصل بين الناس التي عدها “دريدا” خلفية دينية لا محيد عنها.
كما أن التصورات البداهية والجذرية للحقيقة من حيث هي تحقق تجريبي واستدلال برهاني إطلاقي لم تعد تنسجم مع مستجدات الفكر الابستيمولوجي التي أعادت الاعتبار للحقائق الدينية في منطوقها العقدي والخطابي، في سياق ما أصبح يعرف بابستيمولوجيات الاعتقاد والشهادة التي أثبتت أن المعتقدات الدينية في جوانبها اللاهوتية والعقدية قابلة للصياغة البرهانية وفق الطرق التحليلية المنطقية، كما أنها تنتمي للحقائق الشهادية التي هي أساس المعارف الإنسانية المشتركة التي تنتقل في مجملها وفق “مبدأ القبول” (تيلوربورج) أو “مبدأ التضامن التأويلي” (دونالد دفيدسن)؛ أي أسبقية صدقية الشاهد على المضمون البرهاني للشهادة تجسيدا للطابع الجماعي لعملية التعقل، مما يطول شرحه ولا يتسع المقام لتفصيله.
الهوامش
([1]) من أبرز الأعمال الأخيرة التي ظهرت في السنوات الأخيرة الموسوعة القرآنية الصادرة بالإنجليزية في 6 مجلدات عام 2005. وانظر:
Encyclopedia of the Qur’an Brill, 2006.
([2]) راجع في الموضوع: السيد ولد أباه، رؤية الوجود والعالم في الفلسفات التأويلية المعاصرة، من الدين والسياسة والأخلاق، بيروت: دار جداول، 2014، ص227-240.
([3]) حول الدراسات القرآنية الغربية الحديثة راجع مقدمة مهدي عزيز للكتاب الجماعي الذي أشرف عليه:
Mahdi Azaiez: in “Le coran: nouvelles approches”, Cnrs Paris, 2013, pp.13-35.
-François Deroche, la transcription écrite du Coran dans les débuts de l’islam, le codex parisino-petropolitanusBrillLeiden–Boston, 2009, (conclusions, pp.161-169).
-François Deroche, Le coran Puf (que sais-je?) 2005 pp 71-88.
([5]) في نقد هذه الأطروحة راجع:
Michel orcel, l’invention de l’islam, Enquete historique sur les origines, Perrin 2012, (chap: les enigmes du coran pp41-69)
يبين المؤلف، بالرجوع لمصادر مسيحية سريانية ولمخطوطات صنعاء المكتشفة بداية في بداية ستينيات القرن العشرين، صدق الرواية الإسلامية حول المصحف العثماني، وزيف فرضية الجمع المتأخر في العصر الأموي. وفي حين يمكن التدليل بيقين تام حسب “أورسل” على وجود نبي الإسلام وعلى المدونة القرآنية الأصلية، فإن أول مصدر متوفر حول المسيح يرجع لقرابة قرن بعد “موته”، كما أن الأناجيل الأولى تعود لما بين 50 و110 سنة بعد رحيله.
([6]) كان وانسبرو قد بلور الأطروحة الغرائبية بأن القرآن الكريم لم يظهر في الحجاز، بل في الشام والعراق وأنه لم يقنن إلا بدءا من القرن الثالث الهجري من خلال الجمع بين قطع متناثرة.. راجع له في موضوع الرسالة وتدوين النص القرآني:
John Wansbrough, Quranic studies: sources and methods of scriptural interpretation Prometheus Books, 2004, (Revelation and canon pp 1-52).
“Qur’anic readings of the psalms” In The Qur’an in context> Edited by A. Neuwirth , N. Sinai, M. Marx. Brill 2010, pp. 733-778.
راجع أيضا دراستها:
“le coran, texte de l’antiquite tardive” in Le coran: nouvelles approaches pp.127-144.
([8]) راجع له في العمل الجماعي نفسه:
- Guillot, “le coran avant le coran. quelques réflexions sur le syncrétisme religieux en Arabie centrale”, Le coran: nouvelles approches, pp. 145-187.
([9]) G. Reynolds, The Qur’an in its historical context Routledge, London, 2008.
([10]) Michel Cuypers, la composition du coran Gabalda, Paris, 2012.
([11]) حول أدوات وأصول منهج البلاغة السامية:
– Michel Cuypers, Le Festin. une lecture de la sourate al-Mā’ida, Paris, Lethielleux, Rhétorique sémitique, 2007, pp. 21-28.
([12]) سبق للمستشرق الفرنسي “جاك بيرك” الذي ترجم للقرآن للفرنسية أن بين سطحية القراءة الاستشراقية السائدة بانعدام بنية نصية منسجمة في القرآن، معتبرا أنها تنم عن عجز جلي عن اكتشاف النسق الداخلي المتكامل في النص المقدس:
Jacques Berque, Relire Le coran, Albin Michel, Paris, 2012, pp.19-21.
([13]) Anne-Sylvie Boisliveau, le coran par lui-même: vocabulaire et argumentation du discours coranique auto référentiel Brill, 2014, pp. 357-383.
راجع على الأخص الفصل التركيبي المخصص للنظام الحجاجي الذاتي في القرآن الكريم.
([14]) تفسير الطبري، جامع البيان عن تأويل القرآن، تحقيق: عبد الله التركي هجر، القاهرة، 2001، ص87-88.
([15]) المرجع نفسه، ص12. ويضيف الطبري أنه من غير الجائز “أن يخاطب الله أحدا من خلقه إلا بما يفهمه”، ص13.
([16]) راجع في الموضوع: شكري المبخوت، الاستدلال البلاغي، بيروت: دار الكتاب الجديد المتحدة، 2006، ص18-19.
([17]) الزمخشري، الكشاف حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، بيروت: دار المعرفة، (مجلد واحد)، ط3، 2009، ص23.
([18]) فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، بيروت: دار الفكر، 1981، ج1، ص31.
قارن بـ: محي الدين محسب: علم الدلالة عند العرب: فخر الدين الرازي نموذجا، دار الكتاب الجديدة المتحدة، 2008، ص53-54.
([20]) تميز موقف أبي علي الجبائي من المعتزلة الذي أعطى الأولوية للكتابة في السلم اللغوي من منطلق تعريفه للكلام بالحروف وانه حال في السطور.
راجع: علي سالم الحسن، التفكير الدلالي عند المعتزلة، دار الكتاب الجديد المتحدة، 2002، ص84.
([21]) راجع: نصر حامد أبو زيد، الاتجاه العقلي في التفسير: دراسة في قضية المجاز عند المعتزلة، بيروت: دار التنوير، 1982، ص74-80.
([22]) عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، القاهرة: مكتبة الخانجي، تحقيق: محمد محمود شاكر، ص64.
([23]) عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، في علم البيان، بيروت: دار الكتب العلمية، 1988، ص303-304.
([24]) في علاقة القياس بالاستعارة راجع: محمد مفتاح، مجهول البيان، الدار البيضاء: دار توبقال، 1990، ص37-42.
([25]) أثار الموضوع جدلا واسعا بين من دافع عن الأصول اليونانية للبلاغة العربية (مثل طه حسين وأمين الخولي) ومن نفى هذا التأثير. وقد خصص عباس ارحيلة دراسة وافية للموضوع في كتابه “الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة العربيين، الرباط: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 1991. وقد ذهب ارحيلة إلى أن النحاة هم أصحاب الفضل في نشأة البلاغة العربية، وأن اللغويين والنحاة هم الذين بلوروا مباحث الدلالة التي اعتمد عليها البلاغيون، كما أن البلاغة وثيقة الصلة بالعلوم التأويلية الخالصة كعلم الكلام وأصول الفقه (ص263-266). وإذا كانت هذه المعطيات صحيحة إلا أنها لا تلغي حقيقة تأثير البلاغة الأرسطية والعدة المنطقية المرتبطة بها في نظرية الدلالة لدى البلاغيين العرب خصوصا في تصورهم لعلاقة الحقيقة بالمجاز.
([26]) راجع في الخلفيات الاعتزالية لمفهوم المجاز: أحمد أبو زيد، المنحى الاعتزالي في البيان وإعجاز القرآن، الرباط: مكتبة المعارف، 1986، ص209-244.
([27]) حول نظرية نظم القرآن عند الجرجاني راجع: حمادي صمود، التفكير البلاغي عند العرب: أسسه وتطوره إلى القرن السادس، تونس: كلية الآداب منوبة، ط2، 1994، ص491-529.
([28]) ابن تيمية، الإيمان، بيروت: المكتب الإسلامي، ط5، 1996، ص73.
([30]) راجع في تأويلية الإشارة: طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، بيروت/الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 1988، ص231-232.
([31]) راجع نصر حامد أبو زيد: فلسفة التأويل: دراسة في تأويل القرآن عند محي الدين بن عربي، بيروت/الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ط3، 1996، ص153.
([32]) محمد عبده ورشيد رضا، تفسير المنار، طبعة دار إحياء التراث العربي، 2002.
([33]) الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، 1984.
([34]) فضل الرحمن مالك، المسائل الكبرى في القرآن الكريم، ترجمة: محمد اعفيف، بيروت: جداول، 2013، ص8.
([35]) محمد أبو القاسم حاج حمد، القرآن والمتغيرات الاجتماعية والتاريخية، بيروت: دار الساقي، 2011، ص65.
([36]) توشيهيكو إيزوتسو، الله والإنسان في القرآن: علم دلالة الرؤية القرآنية للعالم، ترجمة وتقديم: هلال محمد الجهاد، بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2007، ص32.
([37]) أمين الخولي، التفسير: نشأته، تدرجه، تطوره، دار الكتاب اللبناني، 1982. وانظر أيضا: مناهج التجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب، الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة، 1995.
ـ عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ، التفسير البياني للقرآن الكريم، جزآن، القاهرة: دار المعارف، 1969.
([38]) محمد احمد خلف الله، الفن القصصي في القرآن الكريم، مؤسسة الانتشار العربي، ط 1999.
([39]) سيد قطب، في ظلال القرآن، (6 مجلدات)، دار الشروق، 1978.
([40]) حسن حنفي، من النقل إلى العقل، الجزء الأول: علوم القرآن (من المحمول إلى الحامل)، بيروت: دار الأمير، 2009، (الفصل الخاص بالتفسير، ص414-461).
([41]) مالك شبل عالم نفس واجتماع من أصل جزائري، له أعمال غزيرة بالفرنسية، ترجم القرآن إلى الفرنسية، وكتب معجم موسوعي للقرآن الكريم وعدة كتب تبسيطية للقرآن:
-Maleck Chebel, le coran Fayard paris, 2009.
– Dictionnaire encyclopédique coran Fayard, 2009.
([42]) رشيد بن زين، باحث من أصل مغربي يهتم بالتأويلية القرآنية ومتأثر بأدبيات المراجعين الجدد.
Rachid Benzine, le coran explique aux jeunes, le Seuil, 2013.
([43]) غالب بن شيخ: باحث وإعلامي من أصل جزائري.
Ghaleb Bencheikh, Le coran Eyrolles, 2009.
- Arkoun, comment lire le coran? In Lectures du coran Maisonneuve et Larose, Paris, 1982, pp:1-26.
([45]) محمد أركون، القرآن: من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، ترجمة: هاشم صالح، بيروت: دار الطليعة، ط2، 2005، ص11-29.
([46]) نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص: دراسة في علوم القرآن، المركز الثقافي العربي، مؤمنون بلاحدود ، 2014 (فصل مفهوم الوحي، 31-57).
([47]) هشام جعيط، في السيرة النبوية 1 الوحي والقرآن والنبوة، بيروت: دار الطليعة، 1999، ص56-57 وص80.
([48]) عبد المجيد الشرفي، الإسلام بين الرسالة، والتاريخ، بيروت: دار الطلية، 2001، ص34.
([49]) محمد عابد الجابري، مدخل إلى القرآن الكريم، الجزء الأول: في التعريف بالقرآن الكريم، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2006، ص59-76.
([50]) عبد الكريم سروش، بسط التجربة النبوية، ترجمة: أحمد القبانجي، بيروت: منشورات الجمل، 2009، ص9-36.