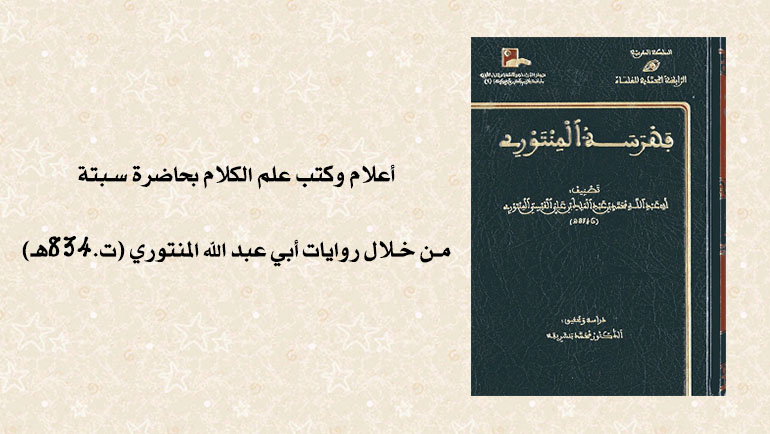استبطنت الدلالة القرآنية هاديات منهجية لما يحتمله اللفظ والمعنى من دلاء غائرة وفصوص ضامرة أو تجليات لائحة ظاهرة، يندر فيها الاستعصاء إلا على من حيل بينه وبين التبصّر بحجاب المعرفة، أوتكشّف ولم يتفيّأ بظلالها الوارفة، إذ ألقى به هواه في متاهات مقرفة، يصدق القول بعده أن المعارف مع صدق الطوية لكل أريب مؤلفة.
تُستمدّ تلك المعاني فتتماهى مع لوائح الملكة الفقهية والربّانية الإيمانية، لتؤسس لأصل المدد في تعدد المداخل وتنوع الفواصل، التي لا يزيد عطف معنى خفي فيها على معنى جليّ ظاهر على حدّها، سوى تثبيت حقيقة نفاد البحر مدادا، وإن جيء بمثله مددا.
هو نفسه ما تُمليه وظيفة البيان في سياق الاستمداد من الحد والمطلع والظاهر والباطن في الآي لتحقق معنى البلاغ في رسالة القرآن والإحسان في تنمية العمران، فلا يطال العجز حينها إلا من لم يسطع اللحاق لضمور مشربه الفقهي ومدركه الفكري بمعان مسترسلة أراها المولى سبحانه لمن عرف الكتاب فقدّره، وتلاه بالفكر والنظر ثم تدبره، وائتم بصدق السريرة فالسبيل إلى معانيه يسره، فحفظ له أسرار المعاني في كنّ تنفتح مغاليقه كلما جاور التجريد ونشد تحقيق التجديد في التوحيد، ذاك المدخل إليه كما نبه عليه العلماء: “بإسقاط حظوظه في الوجهة إلى الله تعالى وتصحيح العزم بإمحاض القصد في معاملة الربّ، وسداد السعي لموافقة القلب، حتى يجتمع القصد والسعي على منهاج التوحيد”.(1)
وإن خيف هول اقتحام مجال التفسير ابتداء لما اشتملت عليه كتب التفسير من الخلاف، وما حمّلته الآي والأخبار من التأويلات الضعاف، حتى قيل لمالك: لم اختلف الناس في تفسير القرآن؟ فقال: قالوا بآرائهم فاختلفوا.(2)
فإن الرأي بعد الأثر ما دام لم يلتبس بعدُ بنزعة هوى فهو تحقيق لمسار الاستمداد من مدد البيان، الثلاثي الأقطاب: العبارة، والإشارة، والمناسبة. فيتمخض عن دلالة العبارة فقه الاستنباط، ويتحصل بالإشارة سداد السلوك ومتانة الارتباط، وتنشد المناسبة تحقيق سر الإعجاز وتقريب المناط، فيتماهى ما استُمدّ من كلّ الأصول في قلائد تُسبَك في خرز منتظم في جيد حلي المعنى، ولم يك هنالك غرض تناضلت له سهام الأفهام ولا غاية تسابقت لها جياد الهمم فرجعت دونها حسرى واقتنعت بما بلغته من صبابة نزرى، مثل الورود على الفهم والذوق للآي، التي يحول الكدر بين مدارك العقول ومراسي الحقيقة والوصول، لتفريطها في مقاطع الحقوق، ومن ثم يعرف السر في العدول عن كل ما جادت به القرائح من فهوم لا يشذّ عنها إلا من لم يعرف باطنه المسايرة لظاهره.
واعلم أن أصل التقليد هو المعصية التي هي كالطبع لهذا النوع لأنه غلب عليه حب الخيال والوهم، وقلّ فيه طاعة العقل والفهم، فالإنسان بطبعه شاعر النفس، والمخالفة توجب صرف أكثر مدحه وذمه إلى الجنس.(3)
التعريف والتوصيف:
ويستدعي الوقوف في هذا البحث الإلمام بالهيئة الظاهرة للآي وما تحتمله من معان تنفذ إلى الحقيقة الاصطلاحية استنادا إلى الظاهر والباطن والحد والمطلع، والمراد من المطالع ما يصدق عليه القول كما سيأتي أنها مصاعد للمعاني بل ما يطلع منه على غوامض أسرار المعاني، ومن ثم ابتغيت الإلمام دون الإحاطة بجوانب البيان الإشاري من جملة مسالك البيان في الاستمداد من مطالع الآي.
أسند السلمي في تفسيره عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، لكل آية منه ظهر وبطن ولكل حرف حد ومطلع”.
وحكى عن جعفر بن محمد أنه قال: كتاب الله على أربعة أشياء: العبادة والإشارة واللطائف والحقائق. فالعبادة للعوام، والإشارة للخواص، واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء. وقال على بن أبي طالب كرم الله وجهه: ما من آية إلا ولها أربعة معان: ظاهر وباطن وحد ومطلع، قال: الظاهر التلاوة، والباطن الفهم، والحد هو عبارة وإشارة، وأحكام الحلال والحرام، والمطلع مراده من العباد بها. وجعل القرآن عبارة وإشارة ولطائف وحقائق، فالعبادة للسمع والإشارة للعقل واللطائف للمشاهدة والحقائق للاستسلام.(4)
قال ابن عجيبة: “ولكل حرف حد أي منتهى تنتهي العقول إلى ما يفهم منه من الأحكام والمعاني الظاهرة، ولكل حد مطلع بشد الطاء وفتح اللام وهو ما يطلع منه على غوامض أسرار المعاني، أي لكل حرف حد يقف معه أهل الظاهر ويطلع منه أهل الباطن على أسرار وغوامض لا تفهم من ظاهر اللفظ، وإنما تؤخذ بالإشارة..”(5)
قال البغوي: قوله (لكل حد مطلع) أي مصعد يصعد إليه من معرفة علمه، يقال المطلع الفهم، وقد يفتح الله على المتدبر والمتفكر في التأويل والمعاني ما لا يفتح على غيره: ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾[يوسف: 76] انتهى حاصل كلامه، قلت: وما مر من أقوال المفسرين ليس شيئا منها مرفوعا، ولا علما لا يدرك بالرأي حتى يكون في معنى المرفوع بل تأويلات لمعنى الأسماء على حسب آرائهم ومن ثم ترى الاختلاف وما ذكرت لكل كذلك، وأيضا قول ابن عباس: علمه اسم كل شيء حتى القصعة والقصيعة، وما قيل علمه أسماء ما كان وما يكون وأسماء ذريته وصفة كل شيء لا ينافي تعليمه الأسماء الإلهية وهي أفضل مما كان ويكون هو الأول لا يكون شيء قبله والآخر لا يكون شيء بعده والظاهر لا شيء فوقه والباطن لا شيء دونه، وإنما اقتصر ابن عباس على ذكر أسماء الممكنات خطابا لإفهام العوام، وكذلك شأن الأكابر يكلمون الناس على قدر عقولهم. والله أعلم.(6)
قد يلوح مما تقدم مدى ما تستبطنه المعاني المحتملة في الآي من إشارات خفية تخفي سعة الإعجاز في البيان، لا يَرِدُ عليها من لم يستكمل أدوات المعرفة وفقا لأقسامها ظاهرة وباطنة، فتكون كالمصاعد إلى معان تتلاءم وتتحد في قالب تأويل غير متناه مما يناسب أسرار التنزيل ومعاني القول الثقيل.
الدليل والدلالة:
يقول الشيخ المحدث عبد العزيز بن الصديق: تفسير الآية أو الحديث بمعنى زائد على ظاهر اللفظ مع بقاء دلالته الظاهرة على حالها: لا شيء فيه مطلقا، وإنما هو من باب الفهم الذي يؤتيه الله تعالى لعبده في أخذ الإشارة بمعنى من المعاني الدالة على الحقيقة أو غيرها من كتابه تعالى، كما قال علي بن أبي طالب عليه السلام. وإلى ذلك يشير قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت: ” لكل آية ظاهر وباطن وحدّ ومطلع” لأنه ما من لفظ في اللغة العربية التي جاء بها القرآن إلا ويمكن التجاوز من معناها الظاهر إلى معنى آخر باطن، مع بقاء معناه الظاهر على حاله.اهـ (7)
قلت، وقد فسر العلماء الإشارة بأنها تأويل القرآن بغير ظاهره لإشارة خفية تظهر لأرباب السلوك والتصوف ويمكن الجمع بينها وبين الظاهر المراد أيضا.
وكان هذا التدليل على معنى الإشارة في اصطلاح العلماء موح بالتفريق بين التفسير والتأويل، مما يستدل به على عدم إرادتهم من إشارات القوم ما يصير له معنى التفسير والتوضيح بقدر ما هو مناسب لمعنى الإيماء والتلويح، وهذا ما قصده ابن عجيبة في بيان معنى التفسير، بأنه: “العلم الباحث عن معاني القرآن الظاهرة إفرادا وتركيبا وما يتوقف عليه خاصا به أو كالخاص، وقيدناه بالمعاني الظاهرة احترازا عن فهوم أهل الإشارات فإنها ليست بالتفسير المتعارف بل هي خارجة عما تؤديه العبارة”.(8)
وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا التجاوز، ففسّر اللفظ بمعنى آخر غير المعنى الظاهر منه، مثال ذلك: الحديث الصحيح: «أتدرون من المفلس؟» قالوا: المفلس منا من لا درهم له ولا متاع، قال: «المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا، وأكل مال هذا».. الحديث”(9)
فقد فسر صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة لفظ : (المفلس) بغير المعنى الذي سبق إلى ذهنهم، وهو الذي يدلّ عليه ظاهر اللفظ.
وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني بسند لا بأس به عن معاذ بن جبل قال: بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أين السابقون؟» قالوا: مضى ناس وتخلّف ناس، قال: «أين السابقون الذين يستهترون بذكر الله؟ من أحبّ أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر الله تعالى».
وأورد الشيخ أحاديث أخرى فسر الشارع ألفاظها وظواهر نصوصها بمعان تخالف ما يؤلف عند سماعها، فيعتدّ بباطن اللفظ في الدلالة على معناه وبالخفي عن فحوى مبناه، ومنها تفسير (الصرعة) في الحديث بمعنى بعيد عن ظاهر اللفظ، وعلق عليه الشيخ أنه تفسير بطريق الإشارة والمعنى الباطن، لأن الصّرعة هو الذي يصرع الناس ويغلبهم، فصرفه صلى الله عليه وسلم إلى الذي يصرع نفسه ويغلبها عند الغضب وذلك ساعة قوة النفس وتسلطها على العقل. وهذا هو تفسير الإشارة بنفسه لمن تدبّر.
وفسر صلى الله عليه وسلم (الرقوب) على خلاف ظاهر اللفظ، بل فسّره من طريق الإشارة أيضا إذ جعل: (الرقوب) هو الذي له ولد ولم يقدّم منهم شيئا، مع أن المعروف عندهم أن (الرقوب) هو الذي لم يولد له كما أجابوا بذلك.
وليس معنى هذا أن التفسير أن ظاهر اللفظ اللغوي زال عن معناه المعهود في اللغة، فإن (الصرعة) و(المفلس) و(الرقوب) دلالتها اللغوية الظاهرة من اللفظ لا زالت على حالها. وإنما تجاوز صلى الله عليه وسلم من معنى هذه الألفاظ الظاهرة إلى معنى آخر باطن لا ينافي المعنى الظاهر.
وهذا هو تفسير أهل الإشارة بعينه، بل ربما كان تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم أبلغ من ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم أتى بعبارة يُفهم منها أن المعنى الذي ذكره هو المراد من اللفظ الظاهر للواضع.
وكذلك لما كان قلب المؤمن محلا للتجليات الربانية ومسكنا لها ومنه تتوزّع المكارم بسبب ذلك على الجوارح فيظهر عليها أثر تلك التجلّيات: كان هو الأولى بهذه التسمية من شجرة العنب التي تتفرّع منها الخبائث عند شرب عصيرها.
قال الشيخ: ومثل هذا كثير، لو تتبّعه الإنسان لخرج منه شيء كثير، وهو كله دليل واضح على أن أخذ معنى زائد عن ظاهر اللفظ من الآية أو الحديث: لا شيء فيه ولا اعتراض على صاحبه.
لأن فاعل ذلك لا يقول : أن المعنى المراد من الآية أو الحديث هو تلك الإشارة ولا دلالتهما محصورة فيها، وإنما يترك اللفظ على ظاهره في دلالته، ويؤمن بذلك من جهة التشريع وأحكام الشريعة، ولكن يستنبط من ظاهر اللفظ معنى آخر من طريق الإشارة يحتمله اللفظ أيضا.(10)
قلت، ومثله ما أومأ إليه ابن عطاء الله أن ليس ذلك بإحالة، وإنما يكون إحالة لو قالوا: لا معنى للآية إلا هذا، وهم لم يقولوا ذلك بل يقررون الظواهر على ظواهرها مرادا بها موضوعاتها ويفهمون عن الله ما ألهمهم. (11)
فيتنخل مما تقدم إقامة الضوابط الكفيلة بما يناسب حقيقة البيان الإشاري مستمدّا من إيحاءات المطالع لمن صفت سريرته لمخالطة المعاني والاستئناس بالمباني، وليس هي إلا:
ــ المؤالفة لما يستوحى من ظواهر الألفاظ دون المخالفة.
ــ عدم التحديد إلا بدليل في قصر المعنى عليه دون الظاهر من اللفظ.
ــ عدم الإغراق في التأويلات البعيدة والمعاني المدخولة.
ــ انتفاء المعارض شرعا وعقلا
ــ مناسبة معناه لما يستمد من الأصول التشريعية على وجه التأييد والتسديد.