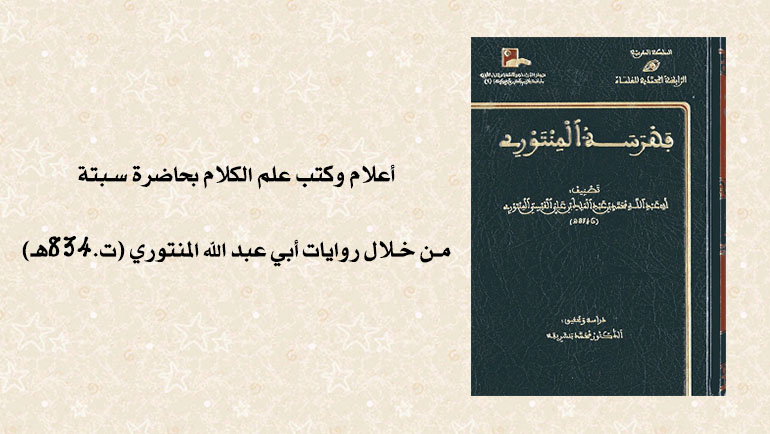مَعاني الأدَوات في سورَة المطفّفين : اسْتِقْراء ودِراسَة

إضاءة بين يدي القرآن الكريم :
القرآن الكريم، هو الوحي المنزل من عند الله ، على رسوله محمد بن عبد الله، خاتم الأنبياء والمرســلين ، المنقول عنه نقلا متواترا ، نظما ومعنى ، وهو آخر الكتب السماوية نزولا، وهو عمدة الشريعة الإسلامية ، وأصل أدلتها الشرعية، والغاية التي تنتهي إليها أنظار النُّظار ومداركُ أهل الاجتهاد، وليس وراءه غاية لمستزيد(1)، قال تعالى 🙁 وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ) النحل: 89، وقال سبحانـه ( مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ) الأنعام: 38.
وللقرآن الكريم وجوه كثيرة من الإعجاز، تشهد أنه وحي إلهي، منها:
فصاحة القرآن الكريم في كل المواضيع :
يرجع إعجاز القرآن، إلى عدة وجوه، منها فصاحة ألفاظه، وبلاغة أساليبه، وخفته على اللسان، وحسن وقعه في السمع، وأخذه بمجامع القلوب، واشتماله على أخلاق سامية فاضلة، وشريعة عادلة كاملة، صالحة لكل الناس في جميع البقاع والأجيال، وغيرها من شتى وجوه الإعجاز.. ولنستمع إلى الإمام الباقلاني، وهو يحدثنا عن بعض وجوه إعجاز القرآن، فيقول رحمه الله:” إن عجيب نظمه، وبديع تأليفه ، لا يتفاوت ولا يتباين على ما يتصرف إليه من الوجوه من ذكر قصص ، ومواعظ ، واحتجاج، وحكم وأحكام ، ووعد ووعيد ، وأخلاق كريمة ، وغير ذلك. وإننا نجد أن كلام البليغ، والشاعر المفلق، والخطيب المصقع، يختلف على حسب اختلاف هذه الأمور؛ فمن الشعراء من يجوّد في المدح دون الهجو، ومنهم من يسبق في التقريظ دون التأبين ، ومنهم من يجوّد في بعض النواحي من وصف الحرب، أو وصف الرّوض ، أو النسيب والغزل، أو الحِكَم أو غير ذلك.
ولذلك ضُرِب المثل بامرئ القيس إذا ركب ، والنابغة إذا رهب ، وبزهير إذا رغب ، ومثل ذلك يختلف في الْخـُطَب والرّسائل وسائر أجناس الكلام ، ومتى تأملت شعر الشاعر البليغ، رأيت التفاوت في شعره على حسب الأحوال التي يتصرف فيها، فيأتي بالغاية في البراعة في معنى، فإذا جاء إلى غيره قصر عنه ، وبان الاختلاف على شعره.ومتى تأملت نظم القرآن، وجدت أن جميع ما يتصرف فيه من الوجوه، لا تفاوت فيها ولا انحطاط، عن المنزلة العليا من البلاغة ” ( 2).
وناحية أخرى جديرة بالاعتبار، هي أن تخَيّر الألفاظ للمعاني المتداولة المألوفة، أسهل وأقرب من تخير الألفاظ لمعان مبتكرة، فمن المعترف به أن فصاحة العرب كان أكثرها في وصف الأطلال، والحنين إلى الأحبة، والإبل والصيد والغزل والمدح والفخر والهجاء.. وإذا نظرنا إلى القرآن الكريم، رأيناه لم يتعرض لهذه الأشياء البتة، ولكنه تعرّض لنواحٍ أخرى، لم تكن معهودة عند العرب، كالتحدث عن الله تعالى، وعظمته، ووصف قدرته، والدعوة إلى عبادته ، وتنزيهه عما لا يليق به ، ووصف ما أعده سبحانه من النعيم للذين يطيعونه ، والعذاب لمن يعصونه، وكذلك بقص القرآن أنباء الرسل مع قومهم، وما تحتويه من العبر وأنواع العبادات ، والحث على مكارم الأخلاق ، وتحريم القبائح وأسس التشريع في المال وشؤون الأسرة وغير ذلك. وأمثال هذه الأمور تستعصي على البليغ، فلا يستطيع التعبير عنها ببلاغته المعهودة.
وإذا أمعنا في آيات القرآن الكريم، وجدناه عالج هذه الأمور في نهاية الفصاحة واستخدم لذلك ضروب التأكيد، وغير ذلك من أدوات المعاني، وأنواع التشبيه والتمثيل، وأصناف الاستعارة وغيرها من فنون البلاغة، التي بهرت قراء اللغة العربية في جميع العصور.
غزارة معاني القرآن الكريم :
ومن خصائص إعجاز القرآن هي :” أننا نرى أسلوب القرآن من اللين، والمرونة في التفسير والتأويل .. فهو يُفَسَّرُ في كل عصر وزمان، وقد فهمه عرب الجاهلية الذين لم يكن لهم إلا الفطرة، وفهمه كذلك من جاء بعدهم من الفلاسفة وأهل العلوم ، وفهمه أئمة المذاهب، الجهابذة في العلم وفي التأويل.. وأثبتت العلوم الحديثة كثيرا من حقائقه التي كانت مغيبة … وأن ما عُهِد من كلام الناس لا يحتمل كل ذلك ولا بعضه ” (3).
وفيه من المعاني الكثيرة، والأغراض الوافرة، ما لو كان في كلام الناس لظهر عليه صبغ النفس الإنسانية ، لا محالة بأوضع معانيه ، وأظهر ألوانه وبصفات كثيرة من أحوال النفس” (4).
وليس شيء في أسلوب القرآن في مواضعه ، مما يدخله في شبه كلام أو يرده إلى طبع معروف من طباع البلغاء ، وإلى هذه الحكمة يشير الله سبحانه وتعالى : ( أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً). سورة النساء : 82
وتجدر الإشارة إلى أنه لا مجال للموازنة بين بلاغة القرآن وبلاغة الشعر؛ لأنه موازنة بين الذي هو أدنى، والذي هو خير.. ويكفي أن نشير في هذا الصدد، بما عبّر به الوليد بن المغيرة بعدما عرف حقيقة القرآن وغيره من الكلام، وهو الشعر، فقد قال – فيما رواه الحاكم وصححه – في سياق إلحاح قومه عليه أن يقول في الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، قولا يصرف الناس عنه، قال: ” وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجز ولا بقصيده مني، ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، وَوَاللَّهِ إنَّ لِقَوله الذي يقول حَلاوة، وإنَّ عليه لَطَلاوة، وإنه لَـمُثْمِرٌ أ عْلاه، مُغْدِقٌ أسفله، وإنه ليَعْلُو وما يُعْلَى ، وإنه ليَحْطِم ما تَحْتَه ” .
وقد أعْقبَ الحاكمُ الحديثَ بقوله: ” هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري.. ” المستدرك ( 3/ 339 )، ح.ر ( 3926 ).
الهوامش
(1) انظر: أصول التشريع الإسلامي، علي حسب الله، مبحث القرآن، وحجيته، وإعجازه، دار المعارف، بمصر، الطبعة الرابعة/1971م، ص: 17 وما بعدها.
(2) إعجاز القرآن، الباقلاني، ص: 39/40. دار المعارف بمصر/1971
(3)إعجاز القرآن والبلاغة النبوية الأستاذ مصطفى صادق الرافعي ،دار الكتاب العربي 1973م، ص:273/274.
(4) المرجع نفسه ،ص 273.