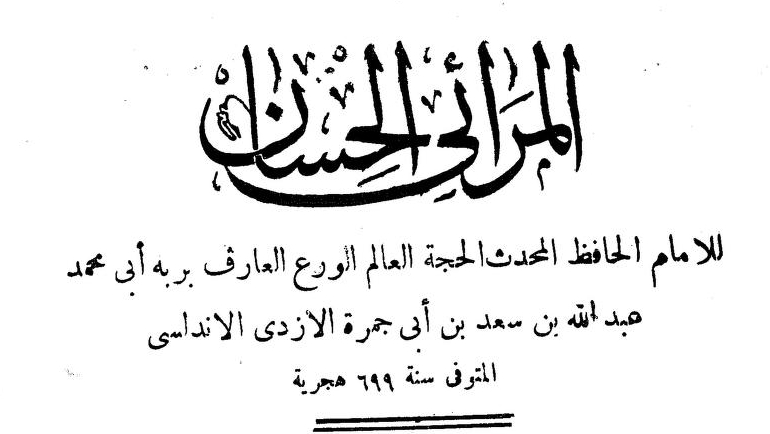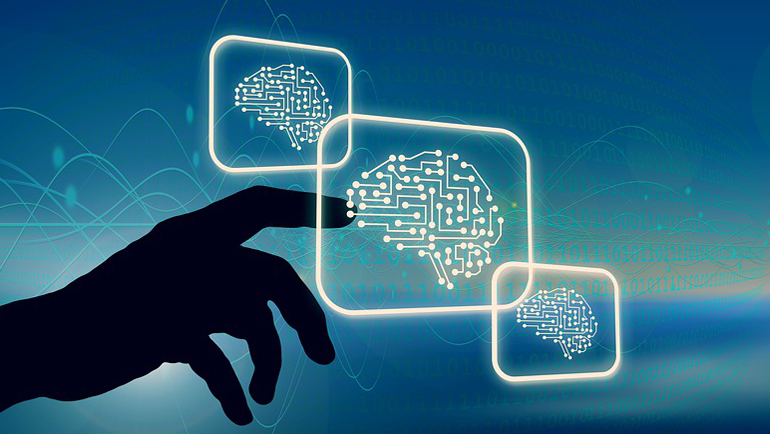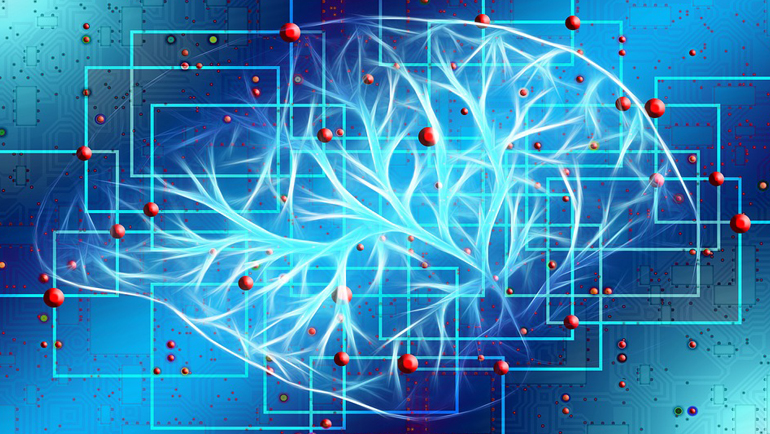العلم لغة:[1] «العين واللام والميم أصلٌ صحيح واحد، يدلُّ على أثَرٍ بالشيء يتميَّزُ به عن غيره.
من ذلك العَلامة، وهي معروفة…والعِلْم: نقيض الجهل،…وتعلّمت الشَّيءَ، إذا أخذت علمَه. والعرب تقول: تعلّمْ أنّه كان كذا، بمعنى اعلَمْ.» و«ما علمت بخبرك: ما شعرت به.» و«علمت الشيء أعلمه علما: عرفته. وعالمت الرجل فعلمته أعلمه بالضم: غلبته بالعلم. … ورجل علامة، أي عالم جدا، والهاء للمبالغة، …وتعالمه الجميع، أي علموه… والمعْلَم: الأثر يستدل به على الطريق.»
قال ابن جني: «لما كان العلم إنما يكون الوصف به بعد المزاولة له وطول الملابسة، صار كأنه غريزة، ولم يكن على أول دخوله فيه، ولو كان كذلك لكان متعلما لا عالما، فلما خرج بالغريزة إلى باب فعل صار عالم في المعنى كعليم، فكسر تكسيره ثم حملوا عليه ضده، فقالا جهلاء كعلماء، وصار علماء كحلماء، لأن العلم محلمة لصاحبه.
و«العلم: اليقين؛ يقال: علم يعلم إذا تيقن، وجاء بمعنى المعرفة أيضا كما جاءت بمعناه ضمن كل واحد معنى الآخر لاشتراكهما في كون كل واحد مسبوقا بالجهل، لأن العلم وإن حصل عن كسب فذلك الكسب مسبوق بالجهل .
وفي التنزيل:{مما عرفوا من الحق}[المائدة:85]؛ أي علموا، وقال تعالى:{لا تعلمونهم الله يعلمهم}[الأنفال:61]؛ أي لا تعرفونهم الله يعرفهم،…وأطلقت المعرفة على الله تعالى لأنها أحد العلمين والفرق بينهما اصطلاحي لاختلاف تعلقهما، وهو سبحانه وتعالى منزه عن سابقة الجهل وعن الاكتساب.
حَدُّ العِلْم عند علماء الأشاعرة:
مذهب أبي الحسن الأشعري في العلم هو ما حكاه تلميذه ابن فورك بقوله: «اعلم: أن الذي يدور عليه كلامه في ذلك وفي سائر حدود جملة المعاني شيء واحد وهو أنه يقول:” معنى وحقيقته ما به يعلم العالم المعلوم” وعلى ذلك عول في استدلاله على أن الله تعالى عالم بعلم من حيث إنه لو كان عالما بنفسه كان نفسه عالما.
لأن حقيقة معنى العلم ما به يعلم به العالم المعلوم، فلو كان نفس القديم سبحانه نفسا بها يعلم المعلومات وجب أن تكون علما وفي معناه.
وأجرى ذلك وأكد هذا القول وكرره في كثير من كتبه… ومن مذهبه أيضا أنه لا يفرق بين العلم والمعرفة، وكذلك اليقين والفهم، والفطنة والدراية، والعقل والفقه، كل ذلك عنده بمعنى العلم. وأن البارئ تعالى إنما اختص بوصف العلم اتباعا له في تسميته نفسه بذلك من دون هذه الأسماء.
وذكر في كثير من كتبه أيضا أن الحس هو العلم بالمحسوس»[2].
وحدَّه أبو بكر الباقلاني: بأنه «معرفة المعلوم على ما هو به، فكل علم معرفة، وكل معرفة علم.»[3]
وقال في تمهيد الأوائل: « فإن قال قائل ما حد العلم عندكم قلنا حده أنه معرفة المعلوم على ما هو به، والدليل على ذلك؛ أن هذا الحد يحصره على معناه، ولا يدخل فيه ما ليس منه، ولا يخرج منه شيئا هو منه، والحد إذا أحاط بالمحدود على هذه السبيل، وجب أن يكون حدا ثابتا صحيحا، فكل ما حد به العلم وغيره، وكانت حاله في حصر المحدود وتمييزه من غيره وإحاطته به، حال ما حددنا به العلم، وجب الاعتراف بصحته، وقد ثبت أن كل علم تعلق بمعلوم فإنه معرفة له، وكل معرفة لمعلوم فإنها علم به»[4] وقال أيضا: إنه [أي العلم]: « “معرفة المعلوم على ما هو به” وإن حد بأنه تبين المعلوم على ماهو به، جازَ ذلك لأن هذين الحدَّين يحيطان بجميع العلوم، فلا يدخلان فيها ما ليس منها، ولا يخرجان منها ما هو منها والحد إذا أبان المحدود مما ليس منه ودار وانعكس ولم ينتقض أحد طرفيه كان صحيحا ثابتا.
وقد حده بعض أصحابنا بأنه إثبات المعلوم على ما هو به.
وقال آخرون: بل هو إدراك المعلوم على ما هو به.
وقيل الثقة بأن المعلوم على ما هو به.
وقيل ما يستحق أن يشتق للعالم منه إسم عالم.»[5] ويقول الجويني في الارشاد: «العلم معر فة المعلوم على ما هو به، وهذا أولى في روم تحديد العلم من ألفاظ مأثورة عن بعض أصحابنا في حد العلم؛ منها قول بعضهم: العلم تبين المعلوم على ما هو به؛ ومنها قول شيخنا رحمه الله: العلم ما أوجب كون محله عالما؛ ومنها قول طائفة: العلم ما يصح ممن اتصف به إحكام الفعل وإتقانه…»[6].
ويقول أبو حامد الغزالي: بعد حكايته لحدودٍ في العلم وانتقادها: «…فإن قلت فما حد العلم عندك: فاعلم أنه اسم مشترك قد يطلق على الإبصار والإحساس، وله حد بحسبه، ويطلق على التخيل وله حد بحسبه، ويطلق على الظن وله حد آخر، ويطلق على علم الله تعالى على وجه آخر أعلى وأشرف، ولست أعني به شرفا بمجرد العموم فقط، بل بالذات والحقيقة، لأنه معنى واحد محيط بجميع التفاصيل ولا تفاصيل ولا تعدد في ذاته، وقد يطلق على إدراك العقل وهو المقصود بالبيان، وربما يعسر تحديده على الوجه الحقيقي بعبارة محررة جامعة للجنس والفصل الذاتي، فإنا بينا أن ذلك عسير في أكثر الأشياء، بل أكثر المدركات الحسية يتعسر تحديدها، فلو أردنا أن نحد رائحة المسك، أو طعم العسل لم نقدر عليه، وإذا عجزنا عن حد المدركات فنحن عن تحديد الإدراكات أعجز، ولكنا نقدر على شرح معنى العلم بتقسيم ومثال؛
أما التقسيم: فهو أن نميزه عما يلتبس به، ولا يخفى وجه تميزه عن الإرادة والقدرة وسائر صفات النفس، وإنما يلتبس بالاعتقادات، ولا يخفى أيضا وجه تميزه عن الشك والظن لأن الجزم منتف عنهما، والعلم عبارة عن أمر جزم لا تردد فيه ولا تجويز ولا يخفى أيضا وجه تميزه عن الجهل فإنه متعلق بالمجهول على خلاف ما هو به، والعلم مطابق للمعلوم وربما يبقى ملتبسا باعتقاد المقلد الشيء على ما هو به عن تلقف لا عن بصيرة وعن جزم لا عن تردد، ….فوجه تميز العلم عن الاعتقاد هو أن الاعتقاد معناه السبق إلى أحد معتقدي الشاك، مع الوقوف عليه من غير إخطار نقيضه بالبال، ومن غير تمكين نقيضه من الحلول في النفس، … وأما العلم فيستحيل تقدير بقائه مع تغير المعلوم، فإنه كشف وانشراح، والاعتقاد عقدة على القلب، والعلم عبارة عن انحلال العقد فهما مختلفان،…وبعد هذا التقسيم والتمييز يكاد يكون العلم مرتسما في النفس بمعناه وحقيقته من غير تكلف تحديد.
وأما المثال: فهو أن إدراك البصيرة الباطنة تفهمه بالمقايسة بالبصر الظاهر، ولا معنى للبصر الظاهر إلا انطباع صورة المبصر في القوة الباصرة من إنسان العين، كما يتوهم انطباع الصور في المرآة مثلا، فكما أن البصر يأخذ صور المبصرات أي ينطبع فيها مثالها المطابق لها لا عينها، فإن عين النار لا تنطبع في العين، بل مثال يطابق صورتها، وكذلك يرى مثال النار في المرآة لا عين النار، فكذلك العقل على مثال مرآة تنطبع فيها صور المعقولات على ما هي عليها، وأعني بصور المعقولات حقائقها وماهياتها، فالعلم عبارة عن أخذ العقل صور المعقولات وهيآتها في نفسه وانطباعها فيه، كما يظن من حيث الوهم انطباع الصور في المرآة، ففي المرآة ثلاثة أمور الحديد وصقالته، والصورة المنطبعة فيها، فكذلك جوهر الآدمي كحديدة المرآة، وعقله هيئة وغريزة في جوهره ونفسه بها يتهيأ للانطباع بالمعقولات، كما أن المرآة بصقالتها واستدارتها تتهيأ لمحاكاة الصور، فحصول الصور في مرآة العقل التي هي مثال الأشياء هو العلم، والغريزة التي بها يتهيأ لقبول هذه الصورة هي العقل، والنفس التي هي حقيقة الآدمي المخصوصة بهذه الغريزة المهيأة لقبول حقائق المعقولات كالمرآة، فالتقسيم الأول يقطع العلم عن مظنان الاشتباه، وهذا المثال يفهمك حقيقة العلم فحقائق المعقولات إذا انطبع بها النفس العاقلة تسمى علما »[7]
وقال الامام الرازي في حده: «لا شك أنا نعلم بالضرورة: أنَّا نعلم شيئا من الأشياء، ونعلم أيضا بالضرورة: أنَّ العلم إما تصور وإما تصديق، وهذا القدر معلوم لا نزاع فيه بين العقلاء.
ثم اختلفوا بعد ذلك، وطريق ضبط الأقوال في هذا الباب أن نقول: العلم إما أن يكون مفهوما إيجابيا أو سلبيا فإن كان مفهوما إيجابيا فإما أن يكون مجرد نسبة وإضافة وإما أن يكون صفة حقيقية وإما أن يكون مجموع صفة حقيقية مع نسبة مخصوصة أو صفة حقيقية مخصوصة من باب السلوب فهذه أقسام أربعة لا مزيد عليها.
أما القسم الأول: وهو أن يكون العلم والإدراك عبارة عن مجرد نسبة مخصوصة وإضافة مخصوصة فهذا قول قد ذهب إليه جمع عظيم من الحكماء والمتكلمين وهو المختار عندنا وهو الحق….
وأما القسم الثاني: وهو أن يقال: العلم صفة حقيقية فهذا قول جمهور الفلاسفة فإنهم يقولون: العلم عبارة عن حصول صورة المعلوم في العَالِـم…
وأما القسم الثالث: وهو أن يقال العلم صفة حقيقية مع إضافة مخصوصة، فهذا قول أكثر المتكلمين فإنهم قالوا: العلم صفة مخصوصة قائمة بذات العالم ولتلك الصفة تعلق بالمعلوم، وعنوا بهذا التعلق ما سميناه بالنسبة والإضافة…
وأما القسم الرابع: وهو لأن يقال: العلم صفة حقيقية مخصوصة من باب السلوب، والقائلون بهذا القول فريقان، فالفريق الأول: طائفة من قدماء المتكلمين قالوا لا معنى للعلم إلا عدم الجهل، … والفريق الثاني ما وقع في ألسنة الفلاسفة أن معنى كون الشيء عقلا هو كونه مجردا عن المادة. فهذه جملة الأقسام التي يمكن ذكرها في تفسير حقيقة العلم والإدراك والشعور.»[8]
وقال سيف الدين الآمدي في حدّ العلم وحقيقته؛ حكاية للأقوال فيه، ووضعا لتعريفه المختار: «أمّا حقيقة العلم: فقد اختلف العلماء في العبارات الدّالّة عليها.
فقال بعض المعتزلة: العلم اعتقاد الشيء على ما هو عليه…
ومنهم من زاد في الحدّ: إذا وقع عن ضرورة أو دليل.
وقال القاضى أبو بكر: العلم معرفة المعلوم على ما هو به…
وقال الشيخ الأشعرىّ: فيه عبارات:
الأولى: العلم هو الّذي يوجب كون من قام به يكون عالما.
الثانية: هو الّذي يوجب لمن قام به اسم العالم.
الثالثة: العلم إدراك المعلوم على ما هو به…
قال الأستاذ أبو بكر بن فورك: العلم ما صحّ بوجوده من الّذي قام به إتقان الفعل وإحكامه…
وقال الشيخ أبو القاسم الإسفرايينى: العلم ما يعلم به…
وقال بعض الأصحاب: العلم إثبات المعلوم على ما هو به…
وقال غيره من الأصحاب: العلم تبيين المعلوم على ما هو به…
وقال غيره: العلم هو الثّقة بأن المعلوم على ما هو عليه…
وقالت الفلاسفة: العلم عبارة عن انطباع صورة المعلوم في النّفس…
ولعسر تحديد العلم اختلف العلماء المتأخرون.
فقال بعضهم: إنّه لا طريق إلى تعريفه بالحدّ بل تعريفه إنّما هو بالقسمة، والمثال.
وقال بعضهم: العلم بالعلم بديهي، لأن ما عدا العلم لا يعرف إلا بالعلم، فلو كان غيره معرّفا له لكان دورا ولأن الإنسان يعلم بالضرورة وجود نفسه، والعلم أحد تصوري هذا التصديق البديهى، وما يتوقّف عليه البديهى يكون بديهيا فتصوّر العلم بديهي …
والأشبه في تحديده أن يقال:
العلم عبارة عن صفة يحصل بها لنفس المتّصف تمييز حقيقة ما، غير محسوسة في النفس احترازا من المحسوسات حصل عليه حصولا لا يتطرق إليه احتمال كونه على غير الوجه الّذي حصل عليه، ويدخل فيه العلم بالإثبات، والنفى، والمفرد، والمركب، وتخرج عنه الاعتقادات والظّنون، حيث إنه لا يبعد فى النّفس احتمال كون المعتقد والمظنون على غير الوجه الّذي حصل عليه في النفس، وهو وجودي لا سلبي، لأنّه لو كان سلبيا فسلبه يكون إثباتا، لأنّ سلب السّلب إثبات، ولو كان كذلك لما صحّ سلب العلم عن المعدوم المستحيل الوجود، لما فيه من اتّصاف العدم المحض بالصّفة الثبوتيّة وهو محال.»[9]
أقسام العلم وأنواعه:
يقول القاضي أبو بكر الباقلاني: «العلوم تنقسم قسمين: قسم منهما: علم الله سبحانه، وهو صفته لذاته، وليس بعلم ضرورة ولا استدلال، قال الله تعالى: {أنزله بعلمه}[النساء:165]، وقال:{وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه}[فاطر:11]،وقال: {فاعلموا أنما أنزل بعلم اللّه}[هود:14]، فأثبت العلم لنفسه، ونص على أنه صفة له في نص كتابه.
والقسم الآخر: علم الخلق. وهو ينقسم قسمين: فقسم منه علم اضطرار، والآخر علم نظر واستدلال: فالضروري ما لزم أنفس الخلق لزوماً لا يمكنهم دفعه والشك في معلومه؛ نحو العلم بما أدركته الحواس الخمس، وما ابتدي في النفس من الضرورات.
والنظري: منهما: ما احتيج في حصوله إلى الفكر والروية، وكان طريقه النظر والحجة. ومن حكمه جواز الرجوع عنه والشك في متعلقه…. »[10].
وقال في التمهيد: «فإن قال قائل: فعلى كم وجه تنقسم العلوم؟ قيل له: على وجهين؛ فعلم قديم وهو علم الله عز و جل وليس بعلم ضرورة ولا استدلال، وعلم محدث وهو كل ما يعلم به المخلوقون من الملائكة والجن والإنس وغيرهم من الحيوان»[11].
وقال إمام الحرمين الجويني: «العلم ينقسم إلى القديم والحادث فالعلم القديم صفة الباري تعالى القائم بذاته، المتعلق بالمعلومات غير المتناهية، الموجب للرب سبحانه وتعالى حكم الإحاطة المتقدس عن كونه ضروريا أو كسبيا، والعلم الحادث ينقسم إلى الضروري والبديهي والكسبي فالضروري هو العلم الحادث غير المقدور للعبد مع الاقتران بضرر أو حاجة والبديهي كالضروري غير أنه لا يقترن بضرر ولا حاجة وقد يسمى كل واحد من هذين القسمين باسم الثاني، ومن حكم الضروري في مستقر العادة أن يتوالى فلا يتأتى الانفكاك عنه والتشكك فيه، وذلك كالعلم بالمدركات وعلم المرء بنفسه والعلم باستحالة اجتماع المتضادات ونحوها والعلم الكسبي هو العلم الحادث المقدور بالقدرة الحادثة …»[13].
طرق العلم:
قال أبو بكر الباقلاني في طرق العلم: «وجميع العلوم الضرورية تقع للخلق من ستة طرق: فمنها: درك الحواس الخمس، وهي: حاسة الرؤية، وحاسة السمع، وحاسة الذوق، وحاسة الشم، وحاسة اللمس. وكل مدرك بحاسة من هذه الحواس من جسم، ولون، وكون، وكلام، وصوت، ورائحة، وطعم، وحرارة، وبرودة، ولين، وخشونة، وصلابة، ورخاوة فالعلم به يقع ضرورة. والطريق السادس: هو العلم المبتدأ في النفس، لا عن درك ببعض الحواس، وذلك نحو علم الإنسان بوجود نفسه، وما يحدث فيها وينطوي عليها من اللذة، والألم، والفم، والفرح، والقدرة، والعجز، والصحة، والسقم. والعلم بأن الضدين لا يجتمعان، وأن الأجسام لا تخلو من الاجتماع والافتراق، وكل معلوم بأوائل العقول، والعلم بأن الثمر لا يكون إلا من شجر، أو نخل، وأن اللبن لا يكون إلا من ضرع وكل ما هو مقتضى العادات.
وكل ما عدا هذه العلوم وهو علم استدلال لا يحصل إلا عن استئناف الذكر والنظر وتفكر بالنظر والعقل»[14].
ويحكي الامام الجويني المذاهب في مدارك العلوم فيقول: حكى أصحاب المقالات عن بعض الأوائل حصرهم مدارك العلوم في الحواس ومصيرهم إلى أن لا معلوم إلا المحسوسات؛
ونقلوا عن طائفة يعرفون بالسمنية أنهم ضموا إلى الحواس أخبار التواتر ونفوا ما عداها؛
وحكى عن بعض الأوائل أنهم قالوا لا معلوم إلا مادل عليه النظر العقلى وهذا في ظاهره مناقض للقول الأول؛ ومتضمنه أن المحسوسات غير معلومة؛
والذي أراه أن الناقلين غلطوا في نقل هذا عن القوم وأنا أنبه على وجه الغلط؛
قال الأوائل: العلوم كل ما تشكل في الحواس، وما يفضي إليه نظر العقل مما لا يتشكل فهو معقول، فنظر الناقلون إلى ذلك ولم يحيطوا باصطلاح القوم؛
وقال المطلعون من مذاهبهم على أن: لا معلوم إلا المحسوس من أصلهم أن المدارك تنحصر في الحواس.
وقال من رآهم يسمون النظريات معقولات من أصل هؤلاء أن: المدارك منحصرة في سبل النظر وهذا ظن ولا آرى خلافا في المعنى.
وقال قائلون: مدارك العلوم الإلهام.
وقال آخرون من الحشوية المشبهة: لا مدارك للعلوم إلا الكتاب والسنة والإجماع.
وقال المحققون: مدارك العلوم الضروريات التي تهجم مبادئ فكر العقلاء عليها ..
والمرتضى المقطوع به عندنا أن العلوم كلها ضرورية والدليل القاطع على ذلك أن من استد نظره وانتهى نهايته ولم يستعقب النظر ضد من أضداد العلم بالمنظور فيه فالعلم يحصل لا محالة من غير تقدير فرض خيرة فيه»[15]
وقال أيضا: «مدارك العلوم في الدين ثلاثة في التقسيم الكلي أحدها المعقول … والمدرك الثاني هو المرشد إلى ثبوت كلام صدق وهذا لا يتمحض العقل فيه فإن مسلكه المعجزات وارتباطها بالعادات انخراقا واستمرارا، …. والمدرك الثالث أدلة السمعيات المحضة »[16] أما الإمام الغزالي فجعل مأخذ العلوم من “المَيْزِ” وعنى به «مَيْزَ العقلاء ثم إنه – أي الميز – قد يفضي به إلى بعض العلوم بغير واسطة كالعلم بالذات وصفاتها، وقد يفضي بوسائط، والوسائط ثلاثة: الحواس وهي الوسيلة إلى المحسوسات، ونظر العقل وهي الوسيلة إلى العقليات، واطراد العادات وبه يعرف معاني الخطاب وقرائن الأحوال، ثم قد لا يفضي الميز إلى العلم إلا بواسطتين كالمعجزة تتوقف على واسطة العقل والعرف، فيستبان بالعقل كونه فعل مخترع صانع متصرف ويستبان بالعرف أنه دال على الصدق إذ لا يناسب انقلاب العصى ثعبانا صدق موسى في كونه رسولا، وأما السمعيات فإنها معلومات ولكنها لا تظهر في العقل ظهور العقليات ومستنده قول حق وخبر صدق وقول النبي عليه السلام صدق وكلام الله سبحانه كذلك، وقول أهل الاجماع بتصديق الرسول إياهم»[17] أما الامام الرازي فحدَّدَ مدارك العلوم في كتابه المحصول على طريق السبر والتقسيم فقال: «إن حكم الذهن على الشيء بأمر على أمر، إما أن يكون جازما، أو لايكون، فإن كان جازما: فإما أن يكون مطابقا للمحكوم عليه أو لايكون، فإن كان مطابقا فإما أن يكون لموجب، أو لايكون، فإن كان لموجب، فالموجب، إما أن يكون حسيا، أو عقليا أو مركبا منهما »
فتحصل له بهذا التقسيم أن حكم الذهن على الشيء حكما جازما مطابقا لموجب:
– حسي ( علم الحواس )
– عقلي ( البدهيات والنظريات )
– مركب من السمع والعقل ( المتواثرت )
– مركب من سائر الحواس والعقل ( التجريبيات والحدسيات )
أما حكم الذهن على الشيء حكما جازما غير مطابق لغير موجب فهو:
– اعتقاد المقلد
وإن كان غير مطابق فهو:
– الجهل .[18]
محل العلم:
يقول الامام الرازي في تفسير قوله تعالى: {ختم الله على قلوبهم}[البقرة:6]، يدل على أن محل العلم هو القلب واستقصينا بيانه في قوله:{ نزل به الروح الاَمين على قلبك}، [الشعراء 193].[19]أما قوله ذاك فهذا نصه: «وأما قوله على قلبك ففيه قولان؛ … الثاني: أن القلب هو المخاطب في الحقيقة لأنه موضع التمييز والاختبار، وأما سائر الأعضاء فمسخرة له، والدليل عليه القرآن والحديث والمعقول، أما القرآن: فآيات؛ إحداها: قوله تعالى في سورة البقرة:{فإنه نزله على قلبك}[البقرة:96] وقال ههنا:{نزل به الروح الأمين على قلبك} وقال:{ إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب} [ق: 37]، وثانيها: أنه ذكر أن استحقاق الجزاء ليس إلا على ما في القلب من المساعي، فقال:{ لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم} [البقرة: 223]، وقال:{لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم} [الحج: 35]، والتقوى في القلب لأنه تعالى قال:{أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى} [الحجرات:3]، وقال تعالى:{وحصل ما فى الصدور} [العاديات:10]، وثالثها: قوله حكاية عن أهل النار:{لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير} [الملك: 11]، ومعلوم أن العقل في القلب والسمع منفذ إليه، وقال: {إن السمع والبصر والفؤاد كل أولائك كان عنه مسؤولا} [الإسراء:36]، ومعلوم أن السمع والبصر لا يستفاد منهما إلا ما يؤديانه إلى القلب، فكان السؤال عنهما في الحقيقة سؤالا عن القلب، وقال تعالى: {يعلم خائنة الاَعين وما تخفى الصدور} [غافر:19]، ولم تخف الأعين إلا بما تضمر القلوب عند التحديق بها، ورابعها: قوله:{وجعل لكم السمع والاَبصار والاَفئدة قليلا ما تشكرون}، [السجدة:8]، فخص هذه الثلاثة بإلزام الحجة منها، واستدعاء الشكر عليها، وقد قلنا لا طائل في السمع والأبصار إلا بما يؤديان إلى القلب، ليكون القلب هو القاضي فيه والمتحكم عليه، وقال تعالى:{ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم} [الأحقاف:25]، فجعل هذه الثلاثة تمام ما ألزمهم من حجته والمقصود من ذلك هو الفؤاد القاضي فيما يؤدي إليه السمع والبصر، وخامسها: قوله تعالى:{ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم} [البقرة: 7]، فجعل العذاب لازما على هذه الثلاثة وقال:{لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم ءاذان لا يسمعون بها} [الأعراف: 179]، وجه الدلالة أنه قصد إلى نفي العلم عنهم رأسا فلو ثبت العلم في غير القلب كثباته في القلب لم يتم الغرض فهذه الآيات ومشاكلها ناطقة بأجمعها أن القلب هو المقصود بإلزام الحجة وقد بينا أن ما قرن بذكره من ذكر السمع والبصر فذلك لأنهما آلتان للقلب في تأدية صور المحسوسات والمسموعات.»[20]
الهوامش:
[1] معجم مقاييس اللغة لابن فارس (4/ 109)، و أساس البلاغة (1/ 321)، و الصحاح في اللغة (1/ 493)، و المحكم والمحيط الأعظم (2/ 174)، و المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (6/ 323)، مادة:”علم”.[2] مقالات الإسلاميين واختلاف المصليين، للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، تحقيق أحمد جاد/ دار الحديث القاهرة، (ص: 5-6).
[3] الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، للباقلاني، بتحقيق محمد زاهد الكوثري، طبعة المكتبة الأزهرية الطبعة الثانية لسنة 1421هـ/2000م، ( ص:12).
[4] تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، الباقلاني، تحقيق عماد الدين أحمد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية،ط1، 1408هـ/1987م، (ص:25).
[5] التقريب و الإرشاد ( الصغير)، لأبي بكر الباقلاني، قدم له وحققه وعلق عليه الدكتور: عبد الحميد بن علي أبو زنيد، مؤسسة الرسالة، ط:2 1418هـ/1998م، (ص:174-176).
[6] كتاب الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الإعتقاد، حققه وعلق عليه وقدم له وفهرسه الدكتور محمد يوسف موسى، وعلي عبد المنعم عبد الحميد، مكتبة الخانجي مصر، 1329هـ/ 1950م، (ص:12)
[7] المستصفى في علم الأصول، أبو حامد الغزالي، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى، 1413هـ،(ص: 21- 22- 23).
[8] المطالب العالية من العلم الإلهي للفخر للرازي، تحقيق أحمد حجازي السقا، دار الكتاب العربي بيروت، الطبعة الأولى، 1407هـ/1987م، (ج:3، ص: 103 -106).
[9] أبكار الأفكار في أصول الدين، للآمدي، تحقيق أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، ط1، 1424هـ/2003م، (ج:1ص: 16).
[10] الانصاف، (ص:13).
[11] تمهيد الأوائل، (ص:26 ).
[12] الانصاف، (ص:14).
[13] الارشاد، (ص:13/14)
[14] الانصاف،(ص:13).
[15] البرهان في أصول الفقه: أبو المعالي الجويني، تحقيق: د. عبد العظيم محمود الديب، الوفاء – المنصورة – مصر، الطبعة الرابعة، 1418(ج:1،ص: 102- 103).
[16] نفسه، (ص: 109 ج:1).
[17] المنخول في تعليقات الأصول، أبو حامد الغزالي،تحقيق د. محمد حسن هيتو، دار الفكر دمشق 1400 هـ،( ص: 50-51)
[18] المحصول في علم أصول الفقه لفخر الدين محمد بن عمر الحسين الرازي، دراسة وتحقيق طه جابر فياض العلواني، نشر مؤسسة الرسالة،( ج: 1، ص: 83-84).
[19] تفسير الفخرالرازي (مفاتيح الغيب من القرآن الكريم)، دار النشر/دار إحياء التراث العربى، (2/ 49).
[20] مفاتيح الغيب (24/ 142- 143).
[21] أبو الحسن الأشعري الدكتور حمودة غرابة، مجمع البحوث الإسلامية القاهرة 1393هـ/1973م، (ص:105).