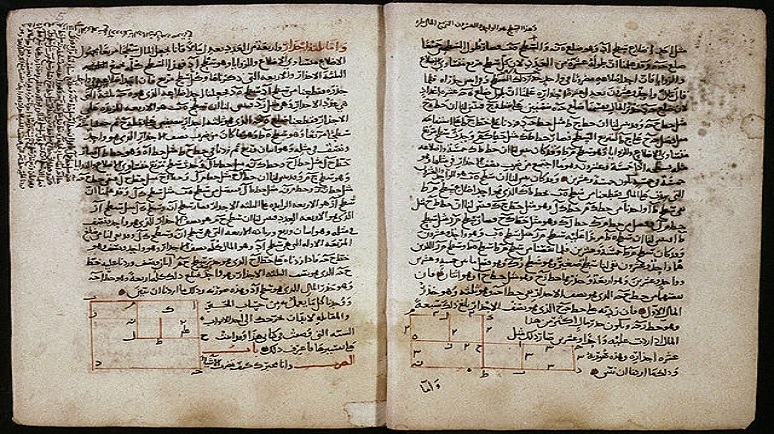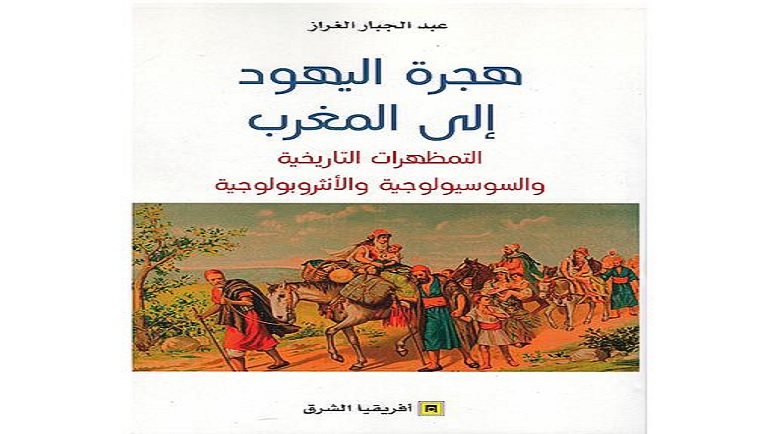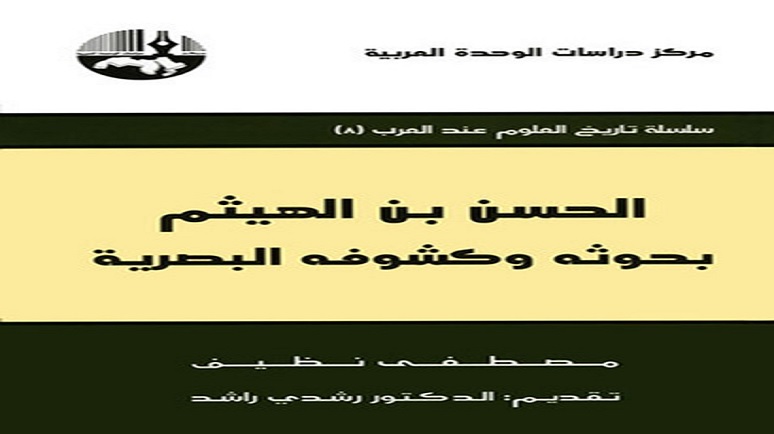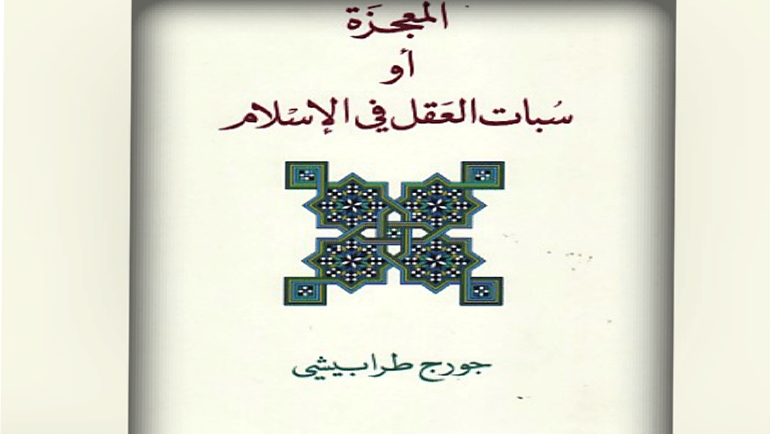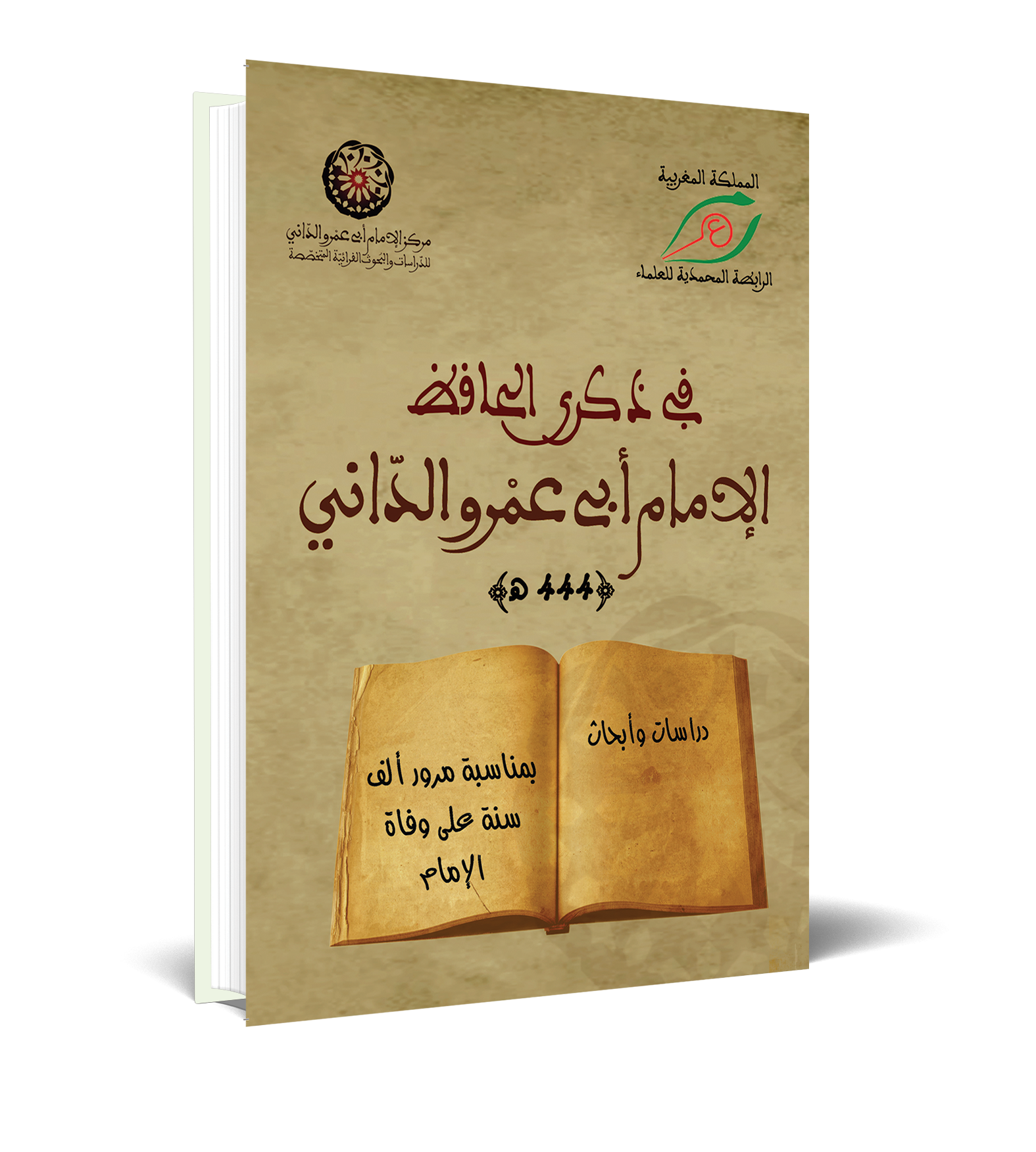صدر عن مركز نماء للبحوث والدراسات كتاب الدكتور الطيب بوعزة في دلالة الفلسفة وسؤال النشأة: نقد التمركز الأوروبي، في طبعته الأولى 2012، وهذا تقديم له بقلم صاحبه.
أولا
ما الحاجة إلى تسطير دراسة جديدة للفكر الفلسفي الغربي، مع وجود دراسات عربية عديدة تُقدم هذا الفكر وتؤرخ للحظاته وتحولاته ورموزه؟
جوابا عن هذا الاستفهام نقول:
إن الدافع الذي استوجب هذه الدراسة، وحفزنا إلى إنجازها، آت من أمرين اثنين:
أحدهما: غياب الحس النقدي من كثير من التآليف المنشغلة بتقديم هذا الفكر.
وثانيهما: ضعف منهجية النقد المنتهجة في بعضها الآخر.
وعندما نقول بغياب الحس النقدي وضعف منهجيته، فإننا بذلك نعبر عن “ما صدق” شامل يستوعب مختلف أنماط البحث العربي في حقل الفلسفة. حيث يمكن تصنيف الكثير من الكتابات العربية التي تناولت الفكر الفلسفي الغربي إلى صنفين اثنين، يشتركان على اختلافهما في غياب أو قصور الحس النقدي من الحيثيتين المعرفية والمنهجية. وأقصد بهما:
ـ صنف التآليف العربية المنبهرة بهذا الفكر: التي تنساق إلى عرضه والدعاية لمدارسه ومذاهبه دون أدنى موقف نقدي. وبهذا لم تستطع هذه الكتابات تجاوز موقف الدعاية والإشهار إلى موقف النقد؛ فظلت وثوقية في دفاعها وتبجيلها، مغتربة باستلابها وانبهارها.
ولا ينحصر هذا الانبهار بالفكر الفلسفي تحديدا، بل حتى بعموم الظاهرة الفكرية والأدبية الغربية، ويكفي النظر في المنشور في وسائل إعلامنا لنلقى هذا الانبهار شارطا للرؤية والتفكير:
فمقال أدبي لن يحظى بالنشر ما لم يستهل بكلمة لتودوروف، أو رولان بارت، أو كريستيفا… ومقال في علم الاجتماع لن يكون صالحا للنشر، في عرف مجلاتنا المتعالمة، ما لم يُفتتح أو يُضَمَّن عبارات لبارسونز، أو بيير بورديو، أو بول لازار سفيلد… أما الكتابات الفلسفية فحتى تلك التي تدعو عناوينها إلى إيجاد فكر فلسفي عربي، فلابد فيها من حضور هايدغر، ونيتشه، وفوكو، ودريدا… حضور الأسماء المقدسة التي لا يخدشها نقد ولا يطالها تصويب!
ولا ينتبه كُتَّابُ هذا النمط من الكتب المهتمة بتقديم النتاج الفلسفي الغربي، إلى أن أسلوبهم في تلقي الفلسفة مناشز لروح التفكير الفلسفي ذاته، من حيثية كونه تفكيرا مسكونا باستهجان حس التلقي والتقليد. وأن ما يغني الفكر الفلسفي ذاته هو أن يجتهد المثقف المشتغل بهذه الصناعة المعرفية في بلورة رؤية فلسفية تعكس خصوصية سياقه الثقافي والحضاري، فيبدع ويضيف، ويترقى من العقلية الاتباعية إلى العقلية الإبداعية.
وبناء عليه يتبدى وجوب إنجاز دراسة جديدة للفكر الفلسفي الغربي، تتجاوز هذا القصور في النظرة الذي يسم هذا الصنف، دراسة تعتمد منظورا نقديا لا منظورا اتباعيا.
وإذ نقول ما سبق، نؤكد في ذات الوقت أن عديدا من الكتابات التي قدمت الفكر الفلسفي الغربي كانت ذات عمق ورصانة في مستواها التحليلي، ولهذا فهي، رغم افتقارها إلى الحس النقدي، ذات قيمة بلا ريب. وتتحدد قيمتها من جهة كونها تنقل النتاج الفلسفي الأجنبي إلى اللغة العربية؛ مما يثري واقع لغتنا ويغنيه وتفتح لنا، من جهة أخرى، أفق التفكير أمام تجربة نظرية وبنى معرفية مغايرة، فتسهم في فهمنا لذاتنا الثقافية أيضا؛ ذلك لأننا نرى أن وعي الأنا مرهون بوعي الآخر، بوصفه مختلفا؛ إذ بالاختلاف والتمايز تُدرك الكينونة. ولذا نؤكد أن وجهة نظرنا النقدية السابقة، ليس الداعي إليها هو الانغلاق عن الآخر، بل هي راجعة إلى أن الأهم، في تقديرنا، هو استكمال نقل تجربته الفكرية ببلورة مقاربة علمية محايثة بموقف نقدي يعبر عن خصوصية فكرنا الحضاري. وهذا ما يغيب عن هذا النمط من الكتابات للأسف؛ لهذا ندعو إلى استكمال النقل بالنقد.
لكن قد يتساءل القارئ معترضا:
إذا كان من اللازم تجاوز الكتابة العربية المنبهرة بالفكر الفلسفي الغربي؛ لافتقارها إلى الموقف النقدي، فما الداعي إلى صياغة دراسة نقدية جديدة، بينما ثمة صنف ثان من الكتابات، يتسمى بعناوين النقد والدحض، من قبيل تلك الكتب المعنونة بـ”تهافت الإيديولوجيات الغربية”، أو “نقض الفلسفة…”، أو ما شاكل ذلك من تسميات وعناوين؟
ـ إن الداعي إلى عدم الاكتفاء بهذا الصنف الثاني الذي أنتجه الخطاب الإسلامي المعاصر، هو أن نقده لما يسمى بالأيديولوجيات والمدارس الفلسفية الغربية، يمكن أن نلحظ على معظمه أربع ملاحظات:
الملاحظة الأولى: السطحية في عرض مذاهب الفكر الفلسفي الغربي، حيث يقف العرض عند الخطوط المعرفية العامة دونما غوص إلى أعماق وتفاصيل هذه المذاهب. مما يشكك ابتداء في حقيقة اقتدار هذه الكتب على أداء دورها النقدي المزعوم. ولذا دعوت مرارا إلى الاعتبار بموقف أبي حامد الغزالي، الذي لم يكتب “تهافت الفلاسفة” إلا بعد أن كتب “مقاصد الفلاسفة”، حيث أبان فيه عن فهم متكامل لمجمل التراث الفلسفي الإغريقي المتداول في ساحة الثقافة العربية الإسلامية وقتئذ، فكان نقده لهذا الفكر بعد ذلك في كتابه “التهافت” نقدا مقتدرا في كثير من جوانبه.
والملاحظة الثانية هي: أن الكتابات التي أنجزها الخطاب الإسلامي أغلبها مثقل بلغة الهجاء، لا اللغة المعرفية القادرة على الغوص في تفاصيل هذا الفكر، والكشف النقدي عن نقائضه الداخلية.
الملاحظة الثالثة: اختزال هذه التآليف “الناقدة” مبادئ الفكر الفلسفي الغربي في عبارات أقرب إلى لغة الشعار؛ مما يؤكد أن أكثر هذه الكتب يعتورها نقص كبير من حيثية إدراك دقائق وتفاصيل الفكر الغربي وتاريخه واتجاهاته. حيث لا تجد فيها إلا معلومات مبتسرة، وانتقادات قلما تنفذ إلى العمق والصميم. فعندما تنتقد فرويد، مثلا، سرعان ما ترفع فكرة “الليبيدو الجنسي”، وتقيم الدنيا وتقعدها بكلمات وعبارات إنشائية متشنجة، ثم تخلص مباشرة إلى إعلان تهافت فرويد، هكذا بكل بساطة، وبلا حاجة إلى إحاطة شمولية بفكره وإسهاماته، وإبراز منظومتها المفاهيمية والمعرفية، وما يعتور بناءها الدلالي والمنهجي من اختلالات.
وحين تأتي إلى نقد داروين سرعان ما تنتصب فكرة “الأصل الحيواني المشترك بين القرد والإنسان”؛ فتنصرف عن قراءة معرفية نقدية لفكر داروين إلى نقد انفعالي لا طائل تحته. وعندما تذكر دوركايم تسارع إلى إبراز مفهومه عن كون الدين نتاجا مجتمعيا يعكس السلطة الجمعية؛ فتغفل عن باقي أطره المعرفية والمنهجية، فيصير نقدها له قاصرا عن شرط الإحاطة والاستيعاب.
أما الملاحظة الرابعة، الدالة على قصور نقد كثير من هذه الكتابات، فيكفي لتتبين مراجعة هوامش هذه الكتب؛ حيث قلما نجد مراجع ومؤلفات للفيلسوف المنتقد، بل نجد فقط بعض التصانيف الموجزة والمختصرة التي توضح ألف باء فلسفته.
ومثل هذا المستند لا نراه كافيا لتأسيس الفهم بله تأسيس النقد.
ثانيا
لكن ماذا نريد بـ”القراءة النقدية” البديلة التي نروم إنجازها في هذا المشروع؟
وما الموقف المعرفي الذي نرتكز عليه؟ وما فرضياته المنهجية؟
تتأسس رؤيتنا النقدية للفكر الغربي على فرضيتين اثنتين، نصوغهما فيما يلي صياغة غير استفهامية:
الفرضية الأولى، ناتجة عن تأملنا في صيرورة الفكر الفلسفي الأوربي، وبحث متونه، حيث انتهينا إلى فكرة صارت تشكل ناظم رؤيتنا إلى تاريخ الوعي الغربي، وهي أن علاقة هذا الوعي بالوجود شهدت ثلاثة أنماط مُمَنْهِجَةٍ لفعل التفكير في حقيقة الوجود، أصطلح عليها بما يلي:
ـ أولا: علاقة الإدراك (وأساسها اللوغوس).
ـ ثانيا: علاقة الحيازة (وأساسها التقنية).
ـ ثالثا: علاقة الالتذاذ (وأساسها الإيروس).
ونرى أن طبيعة النزعة الفلسفة موصولة بالكيفية التي تنهض عليها علاقة الوعي بالوجود عندها؛ حيث أن طبيعة هذا التعالق وكيفياته تُحَدِّدُ وتَتَحَدَّدُ على نحو يناغم طبيعة ذلك النزوع الفلسفي.
فإذا نظرنا بلحاظ المقاربة المُوجِزَةِ لخصائص المركَّب المعرفي الذي تبلور في تاريخ الفلسفة الغربية، سنلاحظ أن التقليد الفلسفي، منذ الإغريق حتى ديكارت، قام في رؤيته للوجود على أساس علاقة إبستيمولوجية تتقصد الإدراك المعرفي؛ وهذا ما اتضح لنا عند تحليلنا لصيرورة وتحولات فعل التفكير الفلسفي الأوروبي، كما تم إرساؤه مع أفلاطون وأرسطو، بناء على توليفهما بين الفلسفتين البارمينيدية والهيراقليطية، واعتمادهما مفهوم الحد الماهوي السقراطي؛ ثم تبين لنا بتتبع تلك الصيرورة، انتقال الجهاز المفاهيمي المؤسس للنظر إلى الوجود، وتحوله من نمط العلاقة الإدراكية، كما تم تثبيتها منطقيا مع الأرسطية، إلى نمط العلاقة الحيازية مع ديكارت وفرنسيس بيكون.
أجل، بدءًا من ديكارت انتظمت العلاقة الإدراكية وفق مقصد السيادة على الكون. وهنا لابد، لفهم حقيقة هذه العلاقة، من عدم الاقتصار في تحليل الفكر الديكارتي على مقولة الكوجيتو “أنا أفكر”، حيث يجب إدراك حقيقة أخرى ثاوية في الفكر الديكارتي هي “أنا أقدر”، التي إن ظهرت لاحقا، كأساس لمبحث القدرة الإبستيمولوجية عند كانط، فإنه مجرد مظهر خادع لحقيقتها كتغول تقني، وهي الحقيقة التي تبدو قبل الكانطية واضحة في “الأورغانون الجديد” لفرنسيس بيكون، وفي نزعة السيادة الأنثروبولوجية في الفلسفة الديكارتية. ولذا نعتقد أن الـ”أنا أفكر” موصول في قراءة ديكارت للوجود بمقصد الـ”أنا أقدر”، وهذا ما يفسر تحول مطلب إدراك الوجود من إشباع معرفي إلى قراءة تقنية للوجود تسعى إلى ضبط قوانينه بهدف السيطرة عليه؛ تلك السيطرة التي ستنتظم وفق علاقة الحيازة والسيادة على الكون بواسطة المنظومة التقنية؛ التي ستؤول في النهاية إلى الإخلال بنظامي الوجود الطبيعي والإنساني معا.
كيف نفسر عجز التفكير الفلسفي عن الاستمرار في تأسيس العلاقة الإدراكية، وانتهائه إلى العدمية، ثم المقام في تعالق جديد مع الوجود، يتمثل في “علاقة الالتذاذ”؟
يمكن تلخيص فرضيتنا التفسيرية في كون الفكر الفلسفي المعاصر يفتقد إلى الأساس الديني؛ وبيان ذلك:
أن ديكارت لما وضع العقل كمرجعية معرفية، بمعناه كجوهر مفكر قادر على بلوغ الحقيقة بمفرده وبمعزل عن أي سند ماورائي، فإنه، سواء وعى ذلك أم لم يع، أرسى لأوروبا عقيدة جديدة تم فيها تأليه العقل ورفعه إلى مقام المطلق.
لكن هذا المقام لن يستطيع العقل البقاء فيه طويلا؛ إذ سرعان ما بدأ النقد الإبستيمولوجي يشكك في قدرته وإمكانه المعرفي. وبيان ذلك أنه إذا تتبعنا صيرورة الفكر الفلسفي من بعد ديكارت، سنلاحظ أن القرن السابع عشر سار في ذات المسار الذي دشنه صاحب الكوجيتو؛ فانتشر تيار ما سمي بالديكارتيين، مع دنيال ليبستورب، وجولنكس، وكريستيان فيتيش… بل حظي هذا التيار بدعم مفكرين بارزين، يمكن أن ندرج من بينهم أسماء عمالقة الفكر الفلسفي في هذا القرن بدءًا من مالبرانش وانتهاء بلايبنز. إلا أن هذه الثقة المطلقة في العقل بوصفه جوهرا ومرجعا إبستيمولوجيا، التي أرستها الديكارتية، سيتم زعزعتها قليلا بفعل الفلسفة التجريبية، خاصة في نموذجها الشكي مع دفيد هيوم، الذي أظهر أن العقل، هذا الذي تم تأليهه مع ديكارت، لا يستحق هذا المقام. لكن هيوم لم يقدم بديلا للوعي الأوروبي، وإنما أيقظه من وثوقيته العقلانية فقط، فكان بشكيته مزعزعا للعقلانية ويقينها! ألم يقل كانط واصفاً تأثير كتب هيوم فيه: “أيقظني هيوم من سباتي الاعتقادي”! وهي كلمة إن كان كانط يعبر بها عن لحظات تطوره الفكري الذاتي، فهي عندنا حلقة معبرة عن صيرورة تطور فعل التفكير الفلسفي في لحظة حرجة من تاريخه، وهي لحظة بدء مراجعة أدواته ومعاييره المعرفية.
لقد كانت لحظة هيوم بداية التشكيك الفعلي في المرجعية العقلانية، لكنه لم يكن بإمكانه أن يرسي بديلا أفضل وأوثق من العقل، فالحس الذي تعلق به هيوم يؤول في النهاية إلى العقل الذي سيصوغ المعطيات الآتية من الحواس؛ ولذا كان من الطبيعي لهيوم الذي شك في العقل ألا يقدم أي بديل ينأى عن الشك.
إلا أن لحظة كانط كانت لحظة مشروع إبستيمولوجي أعمق، حيث كانت لحظة مساءلة شاملة لأرضية الحداثة سواء في مسندها العقلاني أو في مسندها التجريبي. والخلاصة التي انتهى إليها كانط هي أن العقل محدود بحدود عالم التجربة والظاهر، وليس قدرة معرفية مطلقة.
وهنا وجد الفكر الفلسفي الأوروبي ذاته أمام أزمة عميقة لا تطال فكرة أو مبحثا من مباحثه فحسب، بل تطال الأساس الذي ينهض عليه. فمع بدء النقد الكانطي لم يعد للعلاقة الإدراكية أي أساس يُنهضها، فرغم أن هذه العلاقة تم الاعتناء بتأسيسها منذ الأفلاطونية والأرسطية، وتم توثيقها وتوجيهها مع الديكارتية، نحو التأسيس لممارسة السيادة على الوجود، فإن النظر الكانطي في إمكان المعرفة أفقدها السند. وقد كانت الفكرة المنهجية التي قدمها كانط في كتابه “نقد العقل الخالص”، إرهاصاً بتبلور نقد جذري للوعي الفلسفي الحداثي؛ إذ أن المراجعة النقدية التي أرادها صاحب مشروع “النقد”، أن تكون مجرد تعيين لحدود اشتغال القدرة الفاهمة، ستنقلب إلى التشكيك في العقل بأكمله، لتخلص إلى تخطيه مع فلسفات ما بعد الحداثة التي بدأت في التبلور في نهاية القرن التاسع عشر. حيث انقلب الأمر إلى تأسيس علاقة إيروسية تتقصد الالتذاذ.
والانقلاب من علاقة الإدراك والحيازة إلى علاقة الالتذاذ هو في نظري نقلة جذرية في تمثل الوجود، وأسلوب التفاعل معه. غير أن الأمر ليس مجرد انتقال إلى صيغة جديدة في التعالق مع الوجود، بل هو في العمق تعبير عن أزمة عميقة تثوي داخل الفكر الفلسفي ناتجة عن فقدان الإمكان الميثافيزيقي لتأسيس العلاقة الإدراكية. فالتراجع عن العلاقة الإدراكية إلى العلاقة الالتذاذية الإيروسية يجد تفسيره في أزمة الحقيقة، وفقدان المعنى نتيجة تقويض الميتافيزيقا، سواء في أبنيتها الفلسفية التقليدية أو بنائها الديني. ولذا لم تجد فلسفة ما بعد الحداثة من مسلك سوى التوصية بالاكتفاء بالالتذاذ بالوجود، بعد أن عجز اللوغوس الفلسفي عن محاولة إدراكه وفهمه. ومن ثم فمدخل الإيروس ليس مدخلا إبستملوجيا، بل مدخلا للالتذاذ، بسبب ما يستشعره المتفلسف المعاصر من فراغ المفاهيم المؤسسة للتفكير، وعدم إمكان اليقين بوجود الحقيقة؛ وهو فراغ لا يمكن تعويضه، من منظورنا، إلا بإعادة تجديد الوعي الفلسفي تجديدا دينيا.
هذه باختزال وتكثيف فرضيتي الأولى، التي أشتغل بها في تحليل تطور فعل التفكير الفلسفي في السياق التاريخي الأوروبي.
أما الفرضية الثانية، فألخصها بالقول:
إن الإحالة إلى الماوراء شرط لضمان المعنى وتأسيس الإمكان الأنطولوجي للحقيقة، ومن ثم تسويغ بحث إمكانها الابستيمولوجي.
وهذا ما ينبغي أن تستفيده الفلسفة من الدين؛ إذ نعتقد أن ليس ثمة إمكان إبستيمولوجي لتأسيس الوعي الفلسفي خارج الدين. وقد أظهر لنا نظرنا في سعي الوعي الفلسفي ونمط المعرفة الدينية نحو بلورة دلالة الوجود، أن ثمة ثابتا منهجيا في عملية التأسيس الدلالي لهذا المعنى الكلي؛ وهو أن كل وعي مؤمن بوجود الحقيقة يلزمه ولابد شرط الإحالة إلى الغيب الماورائي لتعيين أنطولوجيتها، وتأسيس مبرر البحث عنها؛ سواء كان هذا الماوراء تعاليا ومفارقة، كما يذهب الفكر الإسلامي، أو كان محايثة ووحدة وجود كما يذهب إلى ذلك بعض توجهات الفكر الفلسفي والتأويل الصوفي…
إن شرط الإحالة إلى الماوراء بدا منذ أولى تجليات الوعيين الديني والفلسفي، حيث رفع الكائن الإنساني نظره إلى السماء لتفسير الأرض؛ لأنه أدرك أن الوجود بفعل تغيره وعرضيته غير مكتف بذاته، ولا يمكن أن يستمد معناه من كينونته المحكومة بالصيرورة والفناء. فكان لابد للوعي من أن يحيل إلى الماوراء. وهذه الإحالة المتعالية (الترنسندنتالية) هي في نظرنا جوهر وأساس الوعي الديني، كما أنها أساس إمكان قيام الوعي الفلسفي. غير أنه ببدء انهيار أقانيم المؤسسة الدينية الغربية مع المقاربات النقدية التي أنجزها فكر الحداثة والأنوار، انهارت إمكانية الإحالة، فانهار بذلك الإمكان الأنطولوجي للمعنى وليس فقط إمكانه الإبستمولوجي. ونقصد بالإمكان الأنطولوجي الاعتقاد بكينونة ماورائية نفسر بالإحالة عليها. وبانهيار هذا الإمكان آل الفكر الفلسفي،في سياق ما بعد الحداثة، إلى العدمية.
هذا بإيجاز جوهر نظريتنا ومحصول قراءتنا لتاريخ الفكر الفلسفي. لكن لا نقصد بأبحاث هذه السلسلة أن نصادر على هذه النظرية، ونطوع المادة الفلسفية لتوكيدها عسفا، بل سننفتح على الميراث الفلسفي الغربي بأداة التحليل المفاهيمي والإشكالي لبنيته ونظمه المعرفية، جاعلين من هذه النظرية فرضية للاختبار لا مقياسا جاهزا نستدخل فيه المادة الفلسفية المدروسة.
ثالثا
هذا على مستوى البعد الفرضي للرؤية النظرية، أما من حيثية الشكل الأسلوبي فقد حرصت على الإقلال من استعمال اللفظ الفلسفي برسمه الأجنبي، اللهم من بعض الحدود المتداولة في مختلف اللغات، كالأنطولوجيا، والإبستيمولوجيا، والميثودولوجيا، والترنسندنتالي، واللوغوس… ونحوها. وإيرادنا لهذه الحدود اللفظية بمنطوقها الأجنبي راجع من جهة إلى شهرتها، كما يرجع من جهة ثانية إلى أن مقابلها العربي المتداول لا نراه يحتوي ما صدقها الدلالي. مثلا فلفظ “الترنسندنتالي” يترجم بـ”المتعالي”، ومعلوم أن هذه الترجمة لا تستطيع حمل الدلالة المقصودة فلسفيا من لفظ “الترنسندنتالي”، الذي يفيد، مثلا، عند كانط “القبلي” بما هو شرط مقولي سابق وناظم للتفكير، بينما يوحي اللفظ العربي (المتعالي) إلى معنى أخلاقي كالكبرياء والتكبر، مما يؤدي إلى غبش المعنى الأصلي للفظ. وقس على هذا بعض الحدود الاصطلاحية الأخرى. لكن، عند استعمالنا لهذه الحدود اللفظية بمنطوقها الأجنبي، سنحرص على إيضاح معناها في سياق ورودها.
رابعا
ثم إن كتب هذه السلسلة تخاطب غير المتخصص في الفكر الفلسفي؛ لذا كان لابد من أن تكون أداة إجرائية توفر له من المعطيات ما يسمح بتكوين رؤية واضحة لتطور التفكير الفلسفي الغربي. لذا كان لازما أن نقف أحيانا كثيرة عند بعض الأبجديات التي قد يستثقل الوقوف عندها من له سابق اختصاص في المعرفة الفلسفية.
خامسا
ما الذي أيقظ السؤال الديني داخل الكائن الإنساني؛ فأثمر مختلف أنماط الفكر، التي منها نمط الفكر الفلسفي؟
ما الذي أثار جوعة المعرفة إلى الماوراء فحفز فعل التفكير نحو إشباعها؟
لم يستطع العقل البشري أن يخلص إلى جواب جازم عن هذا السؤال؛ إنما تعددت الأجوبة واختلفت، وذهبت في التأويل مذاهب قددا. وكل ما أمكن للفلسفة في حقلها الميثافيزيقي، وللأنثروبولوجيا الثقافية في تحليلها لأقدم تمظهرات بنى التفكير، أن تجزم في شأنه هو أن الكائن الإنساني لم يكتف بعيش وجوده، بل سعى أيضا إلى فهمه.
وبالنظر إلى مختلف الأنساق الثقافية والمجتمعية، يتأكد أنه “لم يسبق أن انتظم وجود بشري دون بلورة رؤية دينية أو رؤية فلسفية ميثافيزيقية ينهض عليها ذاك الوجود؛ الأمر الذي يبين أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش في الوجود دون أن يستفهم عن معناه ويفكر في مدلوله، ويبحث عن الكُنْهِ الذي يثوي خلف أعراضه.”
إن السؤال الديني المقصود في هذا السياق، هو ذاك السؤال المركزي الذي يتعلق بدلالة الوجود، وأصله ومصيره. وهو السؤال الذي نراه الحافز الاستفهامي لنشأة مختلف أنماط التفكير البشري.
وفي تحليلنا لتاريخ الفكر الفلسفي الغربي، سنلقى أمامنا هذا السؤال ماثلا مستفزا لطاقة العقل، ومثمرا لنتاجات بدأت ببلورة جوابه، ثم انتقلت إلى تحليل أداة التفكير فيه، لمساءلة حدودها وإمكاناتها؛ قبل أن ينقلب التفكير الفلسفي ما بعد الحداثي ليس فقط إلى محاولة التخلص من السؤال وإنكار إمكان الإجابة عنه، بل أيضا محاولة نفي حتى مبررات طرحه!
وتحليلنا لهذه الصيرورة التاريخية هو موضوع هذه السلسلة التي نبدأها بهذا الكتاب التمهيدي الذي يختص ببحث دلالة الفلسفة، وسؤال نشأتها.
وبحث الدلالة، يثير مفارقة عندما يختص بلفظ “الفلسفة”؛ لأن من بين المسائل الإشكالية التي تميز حقل المعرفة الفلسفية، مسألة مفهومها. ومعلوم أن التفكير الفلسفي من أكثر أنماط الفكر اعتناء ببحث الحدود والدلالات. بل يزعم في فرعه المنطقي أن لا تعريف غير التعريف الفلسفي؛ لأنه هو وحده الذي يجاوز الحدود الرسمية واللفظية… وينتج الفصول الماهوية التي لا تعلو عليها أي مرتبة دلالية.
وهنا المفارقة:
إذ كيف تكون الفلسفة أكثر أنماط الفكر اعتناء بالدلالة، وأقدرها، حسب زعمها، على إنتاج الفصل الماهوي، بينما ليس لها، هي ذاتها، معنى حدي متفق عليه بين المشتغلين بها؟!
جوابا عن هذا الاستفهام سنخصص الفصل الأول لبيان اختلاف مدلول الفلسفة، وأسباب استشكاله. بما يعنيه ذلك من تفصيل في مسائل التعريف والموضوع والمنهج، وما يتعلق بكل ذلك من حراك في البنية المفاهيمية.
وبعد أن تتبين لنا حقيقة الوضع الإشكالي لمفهوم الفلسفة، سننتقل، في الفصل الثاني، إلى بحث سؤال نشأتها في السياق اليوناني. وهناك سنقارن بين أطروحتين اثنتين، هما: أطروحة الفصل التي ترتكز عليها وتنافح عنها المركزية الأوروبية، بنموذجيها اللذين سنصطلح على تسميتهما بـ”الاستعلاء العرقي الكامن” و”الاستعلاء العرقي الصريح”. وأطروحة الوصل التي ندفع بها ضدا على التمركز الأوروبي، للتوكيد على أن نشأة الفلسفة في السياق اليوناني كانت نشأة مستأنفة لا نشأة مبتدئة.
وانصرافنا إلى توكيد فرضية الوصل لا يعني تضخيم التأثير الخارجي في نشأة الفلسفة اليونانية وإغفال الشرط الداخلي الذي اكتنف تبلورها فيه، بل سنستحضر السياق الثقافي والمجتمعي اليوناني زمن ظهور الفلسفة، باحثين في نوعية الحاجة، أو الضرورة التاريخية التي اضطرت “النخبة” الفكرية اليونانية إلى انتهاج نمط في التفكير مغاير للسائد، فانتهت إلى بلورة التفكير الفلسفي.
وتحليل ما نسميه بالضرورة التاريخية سيكون من حيثيتين اثنتين: أولاهما؛ تخص الحاجة إلى تجديد الوجود السياسي، والثانية؛ تخص الحاجة إلى تجديد معنى الوجود الكوني. وذلك لأننا لا نعتقد أن من الصدفة أن يتزامن طاليس الذي أعاد النظر في سياسة الكون بنفي التأويل الميثولوجي للوجود؛ فبلور اللوغوس الفلسفي؛ مع المصلح السياسي الأثيني صولون الذي أعاد النظر في سياسة المدينة؛ فبلور منظورا جديدا بدل به قواعد الوجود السياسي.
والمزاوجة بين استحضار طاليس وصولون سيسمح لنا بفهم نوعية الحاجة، التي استلزمت ظهور الفلسفة في السياق التاريخي اليوناني. ذلك الظهور الذي ساعد على حدوثه الفعلي الميراث النظري الذي استمده اليونانيون من حضارات الشرق التي تواصلوا معها.
***
ومن حيثية الشكل، قد يلاحظ القارئ أننا نستعمل أسماء الفلاسفة بترسيماتها المشهورة، حتى لو كان الترسيم خاطئا. حيث نورد، مثلا، اسم “فيثاغور” و”هيراقليط” بهذا الترسيم، بينما نرسم اسم “أنباذوقليس”… بإضافة حرف السين. ومعيارنا في حذف السين عن “فيثاغور” وإثباتها لـ”أنباذوقليس”، ليس الصواب في الكتابة، بل الاشتهار فقط؛ إذ من المعلوم أن الصواب هو حذف حرف السين من أواخر أسماء فلاسفة اليونان؛ لأنه ليس جزءًا من الاسم، بل مجرد علامة إعرابية. ولكننا حذفناه عن “فيثاغور” لاشتهار كتابته في العربية بإثباته حينا وحذفه حينا آخر، بينما لم نحذفه عن أنباذوقليس بسبب كونه لم يشتهر ترسيم اسمه بحذف السين (أنباذوقل). وقس على هذا باقي الأسماء الأخرى.
واعتماد الاسم المشتهر، ولو كان خاطئا، في ترسيمه حدث أيضا في حرف الفاء، فنقول “فيثاغور” مع أن الصواب هو “بيثاغور”، ونقول “أفلاطون”، مع أن الصواب هو “بلاطون”… وذلك لشيوع ترسيمه في المتن العربي بالفاء. والسبب على ما يذكر الأستاذ يوسف كرم نقلا عن المستشرق نلينو هو أن رسم حرف p (فاء) بدل (باء)، راجع إلى “الترجمات السريانية من اليونانية، وفي الخط السرياني يرمز بحرف واحد إلى حرفي باء وفاء، فتعذر على الناقلين من السريانية إلى العربية تمييز ذينك الحرفين.”
لكننا نرى أن قول المستشرق نلينو لا يفسر حالات أخرى عديدة، إذ يمكن أن نلاحظ أن العرب ميزوا في أسماء “بارميند” و”أبيقور”… فرسموها بالباء لا بالفاء. كما أنني وجدت بن النديم في كتاب الفهرست يكتب اسم “فيثاغور” بترسيم صحيح، من حيث استبدال الباء بالفاء؛ حيث يقول: “إن أول من تكلم في الفلسفة بوثاغورس، وهو بوثاغورس بن ميسارخس من أهل سامينا.”
وخلاصة القول بالنسبة للشكل، هو أننا لن نعتمد الصواب إلا إذا كان له سند من الشهرة، وسنعتمد الترسيم الخطأ في حالة اشتهاره، ولن نعتني بتصحيح رسمه؛ لأن الأمر قبل هذا وذاك يبقى مجرد شكل يتعلق برسم الكلم، لا بمضمون الفكر.