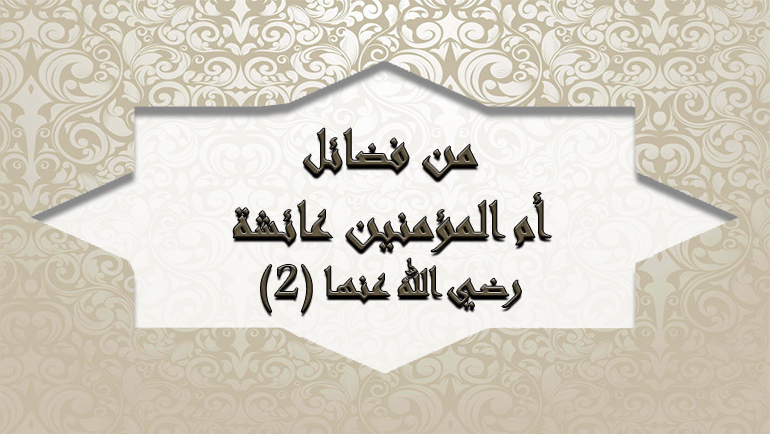ارتباط التراث الإسلامي بدين؛ جوهرُه وحيٌ وضع نقطة الختم للتجربة الإنسانية على الأرض، وأصبح شاهداً عليها إلى نهاية الساعة؛ هيمَنَ على ما سبق، ووضع أدق تنظيم لجزئيات الحياة البشرية في أدق تفاصيلها، مع إعدادها وتبصيرها بالرُّجعَى أي بيوم الدين. فكان التراث هو ما تَخَلَّق وتنَشَّأ من خطابات حول الوحي، وما احتفَّ به من علوم ومعارف في مساره الحضاريّ من فُهوم وشروح وتأويلات له؛ قرباً منه، أو بعداً عنه.
التحدي الأول:
ارتباط هذا التراث بالوحي ألزمه بقاعدة جوهريّة هي ارتباط القول بالعمل، فلا ينفكّ أحدهما عن الآخر؛ فكان الاحتكام إلى السلوك وما يترتب عنه من خُلُق؛ إذْ هو الأساس في بناء ذلك التّراث وتقويمه.
وتراث الإسلام، في كل ما كُتِب حوله، هو خلاصة تجربة أمة الإسلام في مسارها الحضاريّ مع الدّين؛ فهو تراث ديني لا يحتمل تنزيل مفاهيم ومناهج ليست لها صِلة بدين ولا لها منطلقات دينيّة.
التحدي الثاني:
ارتباط هذا التّراث ارتباطاً عضويّاً بلغة الوحي؛ إذ كانت لسانَه، والحاملةَ لكلام الله، عزّ وجلّ، إلى النّاس أجمعين، فأصبح فهم مقاصد الوحي لا يناط بغيرها في استكناه البيان القرآنيّ، ولا تنوب عنها لغة في مقاربته، وإدراك حقيقته، وكل تآمر على العربيّة هو تآمر سافر عن الوحي، وعمل يسعى به صاحبه بوعي أو بغيره إلى إطفاء نور الله في الأرض.
وقد بدأت بوادر المؤامرة على العربية منذ القرن الرابع، مع شيوع اللهجات في ربوع الإسلام، وعودة اللغة الفارسيّة إلى الفكر والأدب، واقتصار العربيّة على دور العلم، ومجالس الدّرس، ومجالات التّأليف.
وفي العصور الحديثة اتسعت دائرة المؤامرة على العربيّة في ديار أبناء يعرب، وتلونت بألوان الحداثة المختلفة، وما تزال الدّيار تبارك تلك المؤامرة، ويتبارى أبناؤها في تشجيعها.
التحدي الثالث:
مع القرن الهجريّ الثاني، بدأ التّأسيس للعلوم والمعارف شيئا فشيئا، وكلّها تسير في موكب الوحي؛ تيسيراً لفهمه، وترسيخاً لمعارفه، وإنشاءً لهوية ثقافيّة إسلاميّة، وفيه استيقظت بقايا الملل والنِّحل القديمة. وظهرت في نهايته حركة شعوبيّة تضمر عداءً سافراً لأصحاب الدّين الجديد الذي ذهب بمُلْكهم، وسفَّه أحلامهم، وأعلَى من شأن العرب وكل من آمن برسالة الإسلام، وجعل لغتَهم لغة العلم؛ فراح الشعوبيُّون يكيدون لاستعادة الحكم الفارسيّ وإشاعة التراث المجوسيّ؛ وبدأ الكيد للإسلام، والعمل على تفتيت كيانه، وإشاعة الفاحشة بين أهله، وبث السّموم في تراثه بالوضع في الأحاديث والأشعار والأخبار والمأثورات، ودسّ الإسرائليات في تفسير القرآن الكريم، وتسريب كل ما يمكن نَفْثُه من شياطين الإنس والجن في التراث الإسلاميّ.
التحدي الرابع:
لهذا التراث بعد إنسانيّ عام؛ إذ شاركتْ في إنجازه وتشكّله أممٌ وأجناسٌ من أصقاع مختلفة، ومن حضارات وثقافات متنوعة؛ فهو تراث تضافرت على تكوينه عشرات المؤثِّرات والعوامل الجغرافيّة والتاريخيّة والثقافيّة. فاصطبغ بطبائع أهلها وأمزجتهم وأهوائهم وبقايا ما كان فيهم من نِحَل ومِلَل وثقافات.
وبمضيِّ المراحل الأولى من حضارة الإسلام؛ تمَّ تأسيس هُويّة إسلامية أسهمت في مُكوِّناتها أممٌ وشعوب خلال القرون الأربعة الأولى، واتّضحت معالم التراث الإسلاميّ، وصارت بمثابة جيناتٍ وراثيةً تتوارثها الأجيال؛ بها يُعرَفون وبفضلها يُذكَرون، وباستلهام روحها يَتطوَّرون فيحاورون ما كان من حضارات وثقافات من مركز القوة. بل أصبحت هُويّةُ تلك الأجيال مشروطةً بوجوده، وحضورُها في التّاريخ رهيناً بحضوره.
وحين بلغت الحضارة الإسلاميّة أوجها؛ اتسعت العربيّة للتّعبير عن أدقّ الحقائق باقتدار شديد، فتبلورت علوم ومعارف قامت على أُسُسِها هُويَّةٌ إسلاميّة؛ وعرفت طريقها إلى المعارف السّابقة عن طريق التّرجمة؛ فأصبحت العربيّة تُدِير الحوار العالميَّ في ذلك الزمان من بغداد؛ واتضحت رؤية شموليّة للتّجربة البشريّة على الأرض، من خلال حضارة الإسلام.
التحدي الخامس:
منذ القرن الهجري الخامس، وحتى مشارف النّهضة العربيّة الحديثة؛ بدأت خريطة العالم الإسلاميّ تَتمدَّد من جانب وتنحسر من جانب آخر، وتشرذمت في تخومها دويلات بسلطاتها وجيوشها على امتداد ما أنجزته في حروبها، وتولَّى المماليك زمام الأمور في صُرَّة العالم العربيّ؛ الذي وقع بين كَمّاشتيْ المغول من الشرق والصليبيِّين من الغرب (حروب دامت نحو قرنيْن من الزمن)..
وتعرَّض جانب هام من التراث الإسلاميّ إلى الإحراق والدمار والإبادة؛ مما دعا إلى صيانته في العهود اللاحقة عبر موسوعات (في التفسير، والحديث، والفقه، والتّاريخ، والتّراجم، واللغة…)، وصارت العلوم والمعارف متوناً تشرح في منتديات العلم وتوضع عليها الحواشي، وبدأ الإبداع يتوارى قليلا ويرحل عن الديار؛ إلا من التماعات هنا وهناك، ويترك مكانه للشروح التي لا تنتهي إلا لتبدأ.
مرحلة ظهر فيها في بدايتها هاجس إحياء علوم الدين، وتوسطتها الحروب المغولية والصّليبية، ثم جاءت انتكاسة التّجربة الحضاريّة للإسلام في الأندلس، وانتهت المرحلة بالمرض المزمن الذي أصاب القوة التركيّة. وبدت في الآفاق مظاهر الحركات الاستعماريّة يسير في ركابها المبشِّرون والمستشرقون.
التحدي السادس:
حدث في المرحلة المذكورة، أن انغلقت الأمة على علوم خاصّة؛ لا تسعفها في مواكبة أوروبا في نهضتها وعنفوانها.
وأخطر ما حدث في تلك المرحلة؛ إغلاق باب الاجتهاد، فلم يعد الواقع هو مصدر النص؛ فتراجع التوهج الفكري في الأمة؛ وصار التراث مخزونا ماديا للمخطوطات يملأ المساجد والدُّور العامّة والخاصّة للكتب؛ تتعدّد النسخ وتتكرّر الشروح والحواشي عليها، والتعليقات على حواشيها، وبذلك عاش التّراثُ على الاجترار وتجميعِ ما مضى؛ فَرَانَ عليه الجمود والتأخُّر والتكلّس.
علوم احترقت، فعاش أناس يطلبون العلم، فيجدون أنفسهم يتدارسون ما احترق؛ أي ما صار رماداً، وتناسوْا أن ما قامت عليه الثقافة الإسلامية؛ أن ترتبط رسالة الخَتْم بما يجري في واقع الناس، أن تكون عناية البحث العلمي بما تدعو الحاجة إليه، وتلتزم بحقيقة ما ينفع الناس، وبما يمكث في الأرض، وبكل ما هو إبداع، وبما لم يُسبق إليه في دنيا البحث والنظر. فأي نفع لحاضر المسلمين في كثير من المحروقات؟ وما سرُّ مكوثها وتباكيها عند كثير من المحروقات ما عادت الحاجة تدعو إليها؟
ويلاحظ أن مناهج التعليم، خلال عهود عريضة مضت، انحصرت في متون لا تتجاوزها، تتكاثر شروحها، والحواشي على شروحها، وتناط المكانة العلميّة لحامليها باسحضارها وحفظها، والانشغال بغالبية قضايا منها لا تدعو الحاجة إليها، ولا تغير من واقع المسلمين شيئا.
وبسبب كل ذلك، أو من نتائجه؛ تسرّبت إلى التراث الإسلاميّ من الأوهام والخرافات والأساطير ما أفسد على الأمة مسارها الحضاريّ، ودورها الرياديّ؛ وأدخل على نفوس أهلها كثيراً من الوهن والضعف والتقاعس والعجز. وهذا نوع من التراث ما يزال يتشكّل منه جزء ليس باليسير من ثقافة واقعنا الحالي.
ويلاحظ أن أغلب ما نملكه اليوم من تراث مكتوب، ومن موسوعات؛ يعود إلى هذه المرحلة.
ومن مجمله كانت منطلقاتنا في العصر الحديث، وعاشت وتعيش جامعاتنا في جوانب من علومها الإنسانية، وما تزال تعمل على إحيائه وتحقيقه ودراسته، وما أدري ما آثار كل ذلك على واقعنا، وعلى ما أُحْدِثَ فيه من تحولات في حياتنا وأفكارنا، وفي اجتهاداتنا، وفي مواقعنا في عالمنا المعاصر.
التحدي السابع:
تمثل فيما جاءت به العصور الحديثة من ثورات سياسيّة وتصوّرات في الاقتصاد والاجتماع والدّين والثّقافة كما تمثَّلها الغرب وأنجزها، وعمل على نشرها في المعمور، وسار في ركاب ثورته الصناعية حركات استعمارية غربيّة اجتاحت العالمَيْن العربيّ والإسلاميّ، وهما مُلتصقان بالتراب، مُقعدانِ ساكنان، مُصابانِ في عمودهما الفِقَريّ، يزحفان ولا يستطيعان الجَرْيَ، وسيطرت على مصادر القوّة فيهما، فتضاعف عجزهما أثناء المواجهة، وسعت إلى إحلال نظم الغرب محلّ النظم الإسلاميّة، وتشكيل المجتمعات المستضعفة في صور نمطية لتصوراته، والتفنّن في تشويه تعاليم الدّين الذي قامت عليه حضارة الإسلام، وطَمْسِ ثقافة ما قامت عليه تلك الحضارة؛ فتمّ لها عزل الأمّة عن منابع قوتها، وترسيخ تبعيتها للغرب.
وقد ارتكبت هذه الحركات الاستعماريّة جرائم إنسانيّة لا تنسى: أبادت شعوبا، واستغلت خيراتها، ومزّقت هوياتها ضمن كيانات متناقضة، وأحيت نعرات عرقيّة، وأحيت لهجات محلّية، وعمّقت خلافات مذهبيّة ودينيّة، وزرعت الأخطبوط الصهيونيّ في جسم الأمة العربيّة. وظل هذا الفيروس يُسمِّم شرايين الأمة، ويستأسد بقوة الغرب في ديار العرب والمسلمين، ويضع خيرات هذه الديار في خزائن الأبناك الدوليّة، وفي جيوب سماسرة السّلاح في العالم الغربيّ.
التحدي الثامن:
وسار في ركاب الحركات الاستعماريّة الحقد الصليبيّ الدفين؛ ممثَّلا في الحركات التبشيريّة؛ قصد تشويه العقيدة الإسلاميّة وإحلال المسيحيّة محلّها، وممثلا في الحركات الاستشراقيّة التي عملت بكل وسائلها لدراسة حضارة الشرق ودياناته وتاريخه ولغاته… وكان أهمّ هدف لهذه الحركات هدمَ العقيدة الإسلامية في نفوس أهلها؛ عن طريق نفي الوحي عن القرآن، وتشويه سيرة الرّسول، صلى الله عليه وسلّم، والطعن في نبوته. أما التّراث الإسلاميّ فجعلوا منه حقول ألغام؛ تنفجر طعناً وتزويراً وتشكيكاً في أصوله وحقائقه، ونفي الأصالة عن ثقافته بجعلها تابعة ليونانيته قديما، ولحَفَدَتِه من الأوربّيين حديثاً، وتلك أعمالهم شاهدة على جهودهم الرائدة في خدمة الاستعمار الحديث بكل أجهزته وأساليبه في محاولاته لطمس آخر شعاع من نور في تجربة البشريّة على الأرض.
وستظل دائرة المعارف الإسلاميّة التي وضعها المستشرقون، شاهدة على عِلْمهم بالإسلام، وحضارة الإسلام، شاهدة على الكيد الخفيّ والمعلَن للإسلام، على الترهات التي وضعها دهاقنته لتشويه حقيقة الإسلام، ويتعلم منها التاريخ كيف تكون الموضوعيّة حين تبنى على المكر والتزوير والخداع، وتتعلّم منها الدنيا ماذا فعل الغرب بحقيقة الإسلام، وكيف شوَّه هذه الحقيقة فارتكب أكبر جريمة في تاريخ الإيمان في تاريخ البشرية كما وضعها هؤلاء لصدّ الناس عن الإسلام.
وإني أَعُدُّ هذا من أكبر الجرائم التي عرفتها الإنسانيّة في تاريخها الطويل.
وبعد موت دهاقنتهم، انتهى التّراث عند بعض المتأخّرين منهم إلى فلكلور؛ ثم أصبح تراثنا فلكلوراً وأدبا شعبيّاً؛ دوره الحضاري لا يتجاوز الفرجة. بل أصبحت هذه الفرجة تعرض في ديار العرب وفي ديار الغرب على السواء؛ يُتلهّى بها وتُستجلَبُ بها أموال المستثمرين والسياح. وحين ارتبط التراث في الأذهان بالفلكلور؛ انكشف ما بدأه المستشرقون من مؤامرة على اللغة العربية؛ فأصبحت اللهجة المصرية تطاول أهرامات مصر، وتسرّبت إلى العالم العربي عبر وسائل الترفيه والفن، وشاعت في اللهجات المحلية في العالم العربي ممزوجة برطانة لغات المستعمرين. وما تزال المؤامرة تحاك في الديار التي يُتلى فيها القرآن، ويشرح أحيانا باللهجات المحلّية.
التحدي التاسع:
تمثّل في حدوث صدام بين أوروبا بثورتها الصناعيّة، وحركاتها الاستعماريّة، وخلفياتها الفكريّة، وما تحمله من أحقاد من عهود حروبها الصليبيّة، وبين شعوب مستضعفة، توالت عليها المحن والصراعات السياسيّة والمذهبيّة؛ شعوب تنتمي لتراث أصبح جله في خزائن الغربيّين، أمة اخترقتها أفكار ولغات وأصبحت مبعَدة عن هويتها وعن حقيقة تراثها؛ لا تتمثَّل روح ذلك التّراث، بل لا تحسن صيانته، ولا الدفاع عنه، كما أنها لا تستطيع تنزيله على واقعها، وحين تحاول تشتدّ خلافات وهمية حول ما يُثار قضاياه في شكل خلافات لا تنتهي؛ تدل في مجملها على جهل مطبق وتخلّف مركّب.
من هنا بدأت الأزمة الحضاريّة التي ما تزال سارية إلى اليوم، في معترك حياة الشعوب الإسلاميّة، وما تزيدها الأيّام إلا استفحالا. أما أهل هذا التّراث؛ فهم على مستوى القرارات الدوليّة لا في العير ولا في النّفير؛ يؤثِّثون خريطة سكّان الأرض لاستهلاك ما تستهلكه آلات التصنيع في الغرب.
التحدي العاشر:
مع الرغبة في التحرّر من ربقة الاستعمار العسكريّ، والخروج من متاهات التخلّف، والدّخول في معترك العصور الحديثة؛ كان لابد أن يحدث الصدام بين الحضارتيْن: الإسلاميّة والغربيّة، وأن يبدأ البحث عن كيفية تحقيق البعث الحضاريّ لتراث الأمة الإسلاميّة، وكيف يستعيد هذا التراث حضوره وقوته ومكانته؟ وكيف ينخرط هذا التراث في مسيرة التقدّم في عالمنا المعاصر؟ وكيف تتمّ العودة إلى التّراث في ضوء تجربة العصر؟
فبعد أن طُرح سؤال التّراث مع انطلاقة النهضة العربيّة الحديثة؛ توارى نسبيّاً مع استفحال الحركات الاستعماريّة في العالم العربيّ، ثم عاد الاهتمام به في ستينيَّات القرن العشرين مع الرّغبة في التحرّر من مخلفات الاستعمار، والدخول في معترك الحداثة والتّجديد والدّعوة إلى التشبث بالهويّة العربيّة الإسلاميّة. وأصبح التراث محط أنظار الباحثين بكل أطيافهم الفكريّة والإيديولوجيّة. وحدثت طفرة في نشره وتحقيقه وصنوف العناية به في الجامعات والمحافل والمنتديات.
ومع هزيمة 1967؛ اشتدّت مساءلته، وتم إخضاعه لشتى القراءات والتأويلات، واحتدّت حوله أنواع من الخلافات، وكان طموح الجميع تحقيق راهنية اللحظة التاريخية بكلّ ما تشكل عنه من خلفيات. وظل طموح كثير من الباحثين، بعثَ التّراث وإحياءَه برؤية إبداعية خلاقة نابعة من حاضرنا، متّسقة مع واقعنا؛ إذ اتّضح أن مكمن القوة في الأمة ماثلٌ في تراثها؛ فهو منبع الحيوية الذي تستمدّ منه طاقتها الذاتية وقدراتها الفعلية، لمواكبة المرحلة الراهنة، وليس لها سواه إن أرادت أن تتوهّج شعلةُ الوعي في كيانها.
التحدي الحادي عشر:
مع دخول مرحلة الحداثة بمناهجها وطروحاتها الفكرية؛ عرف التّراث الإسلاميّ العربيّ أزمة في كيفية قراءته، وتنزيله على الواقع، وانصرفت الجهود تلو الجهود إلى الدفاع عنه والاحتفاء به في المعاهد ومراكز البحث والجامعات.
ويأتي هذا في لحظة تاريخية، “تَصَهْيَنَتْ” فيها سياسة الغرب، واتضح مكرها، وأساليب فرض ثقافتها على سكان المعمور، و”تَفَرْعَنَ” فيها القطب الواحد الذي يتعبّد في محراب مصلحته ليحافظ على “فرعونيته”، ويعمل على “قولبته” ليصبح على شاكلته.
وما زراعة الكيان الصهيونيّ في جسم الأمة العربية، والتمكين له في الأرض اغتصاباً، وجعله قوة نوويّة دون سواها؛ إلا بغاية استغلال خيرات شعوب المنطقة، ومتابعة تفتيتها، وإثارة الفتن بين أهلها، بافتعال خلافات لا تنتهي.
وغاية الغايات أن تهتز ثقة المسلمين بتراثهم، وبكل شيء في حياتهم، وأن يصبح تراثهم، على عِلاّت ما آل إليه أمرُه، مهجوراً بينهم؛ تتراجع قيمُه وتتهاوَى أمام “إفرازات” الحداثة الغربية المعادية للإسلام، وأمام حركة العولمة، وما تغرق به الفضائيات وشبكات الإنترنت العقولَ والأعصابَ؛ فتزداد الهوة بين تراثنا وما يجري في العالم من حولنا. وترى الشعوب العربية، خاصة، تزداد جموداً وتخلفاً، ولا تمَلّ من التغني بشعارات جوفاء ما عادت تحرك ساكنا. شعوب استكانت إلى الذل، ورضيت بالهوان، تنتظر الذي يأتي ولا يأتي، وتَتَلَهَّى بكل ما يُغريها، ويدغدغ غرائزها من إبداعات شياطين الإنس.
ومع نهاية القرن العشرين وبداية القرن الموالي؛ ازدادت حدة التصادم بين الاحتكام إلى مقومات الأمة، وما تفرضه الحداثة الغربيّة التي تريد أن يتشكّل العالم حسب رؤيتها أي حسب مصالحها، أو بتعبير أدق حسب رؤية الصهيونية العالمية التي تعتبر الإسلامي أخطر ما يقف حجر عثرة في مشروعها “لِصَهْيَنَةِ” العالم.
هي لحظة يعيش فيها الإنسان المسلم معركة غير متكافئة، لحظة اختلّت فيها الموازين، وأصبحت تتلاعب بها الأزمات بأنواعها وخاصة الاقتصاديّة منها.
لحظة أضحى فيها الصهاينة فراعنة العصر، وانطفأت شعلة الثّورات الأوروبيّة الداعية إلى الحرّية؛ ليصبح أهلها يتبارون في تذليل الصهاينة، ولا يجرؤ متحرِّر غربي، من دعاة الحرّية؛ أن ينبس ببنت شفة عن “السامية” في مفهوم الصهيونية. لا لأن التّراث الإسلاميّ فضح جذور الصهيونية على امتداد التاريخ؛ ولكن لأن الغرب أدرك منذ الحروب الصليبية في عصوره الوسطى أن الإسلام أسلوب حياة ونظام اجتماعيّ يقوم على العدل والشورى؛ وهذا ما أفسد على الغرب كل الشعارات التي رفعها في ثوراته.
التحدي الثاني عشر:
القراءات الحداثية للتراث؛ وهي قراءات توسلت بالنموذج الغربيّ في مناهجها وتوجّهاتها؛ إذ أنه فرض سلطته المعرفيّة على الذات العربيّة منذ زمن ليس باليسير. وفي ضوء تلك المناهج سعى بعض الباحثين العرب، إلى صياغة رؤية جديدة لذلك التّراث.
فكان لابد أن تصطدم الحداثة بمنطلقات ذلك التّراث ومضامينه وآلياته في التّحليل، وكيفيّات تنزيله على الواقع. وكان من الطبيعيّ أن يحدث توتُّر شديد بين ما أطلق عليه الأنا والآخر؛ فالأنا تعاني من أزمة في تحديد موقفها من التّراث، وكيفيّة التعامل معه، ولا ترى له تنزيلا يلائم حياتها المعاصرة. والأنا ممزَّقة بين من يبحث في التراث عما يفتقده في حاضره، ومن يرى التّراث ثقافة موقعها في التاريخ، ومن يُخفي تبعيته للآخر وهو يقرأ التّراث بموضوعيّة.
أما الآخر، فمَكَّنَتْه تطوراتُه في مجالات المعرفة باللغويات وأساليب الخطاب، من بلورة مناهج متطوّرة في التّحليل والتأويل؛ ادّعى في ضوئها عمق معرفته بأنواع الخطابات، وتنوّع السياقات، وتعدد الإيديولوجيات، وما يتوارى وراءها من خلفيات.
كل يتحدث عن إشكالات لقراءة التراث، كل يريد أن تنتج قراءة معرفة جديدة بالتراث، وكثير من أصحاب تلك القراءات يسعون إلى إخضاع الماضي لسيطرة الحاضر، وأن يقدّم ذلك التراث ما نفتقده في حاضرنا، ويساعد على وضع حلول لأزماتنا المتلاحقة.
التحدي الثالث عشر:
قراءات حداثية إيديولوجية، لا تختلف في منطلقاتها عن منطلقات المستشرقين، وهي بعيدة عن روح ذلك التراث؛ ترميه بالعقم وبالعجز عن مواكبة الحياة، وتتحدّث عن ضرورة القطيعة معه. وظلّت لفظة تراث في هذه القراءات تحيل على ما تركته العهود السابقة من آثار، وتربط سبل نهوض الأمة بالانقطاع عن ذلك التراث، واعتباره ماضيا كانت له ملابساته وأوضاعه التاريخية.
ويدعو أصحاب هذه القراءات إلى تحرر الوعي العربيّ من سلطان التراث.
طُرِحَ السؤال في الأول ببراءة المعرفة المنهجيّة: كيف نقرأ التراث؟ وانتقل السؤال المنهجيّ ثانيا إلى الدعوة إلى نقد التراث، وإلى كيفيّة نقده. ثم جاء السؤال الإيديولوجيّ: كيف نحدد علاقتنا بالتراث؟
خاتمة
كيف تصبح الأمّة في موقف المنتج للحضارة؟
إذا تغيّر الإنسانُ فيها، وتغيّرتْ عقليتُه، وبدأت حضارته تستعيد كينونتها، وتستعيد ثقتها بنفسها، وتستشعر عناصر القوة في حاضرها وماضيها.
إذا استطاعت أن تحدد عناصر الأصالة والإبداع في تراثها، وتعمل بحق على تنقيته مما علق به من رواسب وأخلاط وأوهام وخرافات وحرائق وانحرافات… وغيرت البرامج والمقررات والتوجهات والفلسفات والادعاءات والمسؤوليات؛ لعل شيئا ما يحدث في العقليّات…
إذا عادت العقيدة الإسلامية صافية من شوائب الهرطقات، تُدرك حقيقة الخلافات حين تكون أساسا في بناء المعتقدات، ودعامة في بناء المجتمعات، وإذا عادت اللغة وسيلة لفهم الوحي؛ يُقرأ ويكتب بها ما به يستقيم الحال والمآل، ولا يجترّ أهلها ما احترق، وإذا تحرر الفكر وأصبح عمليّاً واقعيّاً منتجاً وجهتُه ما ينفع الناس، وما تدعو الحاجة إليه في دنياه وأخراه، وما يعطي لوجوده معنىً.
إذا كان فهم مضامين ذلك التراث يستمدّ وجوده من طبيعة آلياته ومجاله المعرفيّ.
وأختم بكلمة جاءت في تمهيد الباب الأول من كتاب تجديد المنهج في تقويم التراث لطه عبد الرحمن، يقول فيها : “لا سبيل إلى الانقطاع عن عمل بالتّراث في واقعنا؛ لأن أسبابه مشتغلة على الدوام فينا؛ آخذة بأفكارنا وموجهة لأعمالنا؛ متحكمة في حاضرنا ومستشرفة لمستقبلنا؛ سواء أأقبلنا على التراث إقبال الواعي بآثاره التي لا تنمحي، أم تظاهرنا بالإدبار عنه؛ غافلين عن واقع استلابه على وجودنا ومداركنا”. (ص 19).
وأخيراً، علينا قبل كل شيء، أن نحدد علاقتنا بهذا التراث، ولعل تحديد طبيعة هذه العلاقة هو مكمن الغموض في كل أحاديثنا عن التراث. إذا استطعنا أن نحدد هذه العلاقة، ونعمل على وضع رؤية علمية لاستكناه حقيقتها، وتنفيذ استراتيجية لتفعيلها في واقعنا المعاصر؛ يُمكننا أن نُحدِّد موقع العبور إلى المستقبل.
تحديات واجهت التراث الإسلامي وتواجهه
د. عباس أرحيلة
أستاذ التعليم العالي في الأدب العربي/مراكش
ارتباط التراث الإسلامي بدين؛ جوهرُه وحيٌ وضع نقطة الختم للتجربة الإنسانية على الأرض، وأصبح شاهداً عليها إلى نهاية الساعة؛ هيمَنَ على ما سبق، ووضع أدق تنظيم لجزئيات الحياة البشرية في أدق تفاصيلها، مع إعدادها وتبصيرها بالرُّجعَى أي بيوم الدين. فكان التراث هو ما تَخَلَّق وتنَشَّأ من خطابات حول الوحي، وما احتفَّ به من علوم ومعارف في مساره الحضاريّ من فُهوم وشروح وتأويلات له؛ قرباً منه، أو بعداً عنه.
التحدي الأول:
ارتباط هذا التراث بالوحي ألزمه بقاعدة جوهريّة هي ارتباط القول بالعمل، فلا ينفكّ أحدهما عن الآخر؛ فكان الاحتكام إلى السلوك وما يترتب عنه من خُلُق؛ إذْ هو الأساس في بناء ذلك التّراث وتقويمه.
وتراث الإسلام، في كل ما كُتِب حوله، هو خلاصة تجربة أمة الإسلام في مسارها الحضاريّ مع الدّين؛ فهو تراث ديني لا يحتمل تنزيل مفاهيم ومناهج ليست لها صِلة بدين ولا لها منطلقات دينيّة.
التحدي الثاني:
ارتباط هذا التّراث ارتباطاً عضويّاً بلغة الوحي؛ إذ كانت لسانَه، والحاملةَ لكلام الله، عزّ وجلّ، إلى النّاس أجمعين، فأصبح فهم مقاصد الوحي لا يناط بغيرها في استكناه البيان القرآنيّ، ولا تنوب عنها لغة في مقاربته، وإدراك حقيقته، وكل تآمر على العربيّة هو تآمر سافر عن الوحي، وعمل يسعى به صاحبه بوعي أو بغيره إلى إطفاء نور الله في الأرض.
وقد بدأت بوادر المؤامرة على العربية منذ القرن الرابع، مع شيوع اللهجات في ربوع الإسلام، وعودة اللغة الفارسيّة إلى الفكر والأدب، واقتصار العربيّة على دور العلم، ومجالس الدّرس، ومجالات التّأليف.
وفي العصور الحديثة اتسعت دائرة المؤامرة على العربيّة في ديار أبناء يعرب، وتلونت بألوان الحداثة المختلفة، وما تزال الدّيار تبارك تلك المؤامرة، ويتبارى أبناؤها في تشجيعها.
التحدي الثالث:
مع القرن الهجريّ الثاني، بدأ التّأسيس للعلوم والمعارف شيئا فشيئا، وكلّها تسير في موكب الوحي؛ تيسيراً لفهمه، وترسيخاً لمعارفه، وإنشاءً لهوية ثقافيّة إسلاميّة، وفيه استيقظت بقايا الملل والنِّحل القديمة. وظهرت في نهايته حركة شعوبيّة تضمر عداءً سافراً لأصحاب الدّين الجديد الذي ذهب بمُلْكهم، وسفَّه أحلامهم، وأعلَى من شأن العرب وكل من آمن برسالة الإسلام، وجعل لغتَهم لغة العلم؛ فراح الشعوبيُّون يكيدون لاستعادة الحكم الفارسيّ وإشاعة التراث المجوسيّ؛ وبدأ الكيد للإسلام، والعمل على تفتيت كيانه، وإشاعة الفاحشة بين أهله، وبث السّموم في تراثه بالوضع في الأحاديث والأشعار والأخبار والمأثورات، ودسّ الإسرائليات في تفسير القرآن الكريم، وتسريب كل ما يمكن نَفْثُه من شياطين الإنس والجن في التراث الإسلاميّ.
التحدي الرابع:
لهذا التراث بعد إنسانيّ عام؛ إذ شاركتْ في إنجازه وتشكّله أممٌ وأجناسٌ من أصقاع مختلفة، ومن حضارات وثقافات متنوعة؛ فهو تراث تضافرت على تكوينه عشرات المؤثِّرات والعوامل الجغرافيّة والتاريخيّة والثقافيّة. فاصطبغ بطبائع أهلها وأمزجتهم وأهوائهم وبقايا ما كان فيهم من نِحَل ومِلَل وثقافات.
وبمضيِّ المراحل الأولى من حضارة الإسلام؛ تمَّ تأسيس هُويّة إسلامية أسهمت في مُكوِّناتها أممٌ وشعوب خلال القرون الأربعة الأولى، واتّضحت معالم التراث الإسلاميّ، وصارت بمثابة جيناتٍ وراثيةً تتوارثها الأجيال؛ بها يُعرَفون وبفضلها يُذكَرون، وباستلهام روحها يَتطوَّرون فيحاورون ما كان من حضارات وثقافات من مركز القوة. بل أصبحت هُويّةُ تلك الأجيال مشروطةً بوجوده، وحضورُها في التّاريخ رهيناً بحضوره.
وحين بلغت الحضارة الإسلاميّة أوجها؛ اتسعت العربيّة للتّعبير عن أدقّ الحقائق باقتدار شديد، فتبلورت علوم ومعارف قامت على أُسُسِها هُويَّةٌ إسلاميّة؛ وعرفت طريقها إلى المعارف السّابقة عن طريق التّرجمة؛ فأصبحت العربيّة تُدِير الحوار العالميَّ في ذلك الزمان من بغداد؛ واتضحت رؤية شموليّة للتّجربة البشريّة على الأرض، من خلال حضارة الإسلام.
التحدي الخامس:
منذ القرن الهجري الخامس، وحتى مشارف النّهضة العربيّة الحديثة؛ بدأت خريطة العالم الإسلاميّ تَتمدَّد من جانب وتنحسر من جانب آخر، وتشرذمت في تخومها دويلات بسلطاتها وجيوشها على امتداد ما أنجزته في حروبها، وتولَّى المماليك زمام الأمور في صُرَّة العالم العربيّ؛ الذي وقع بين كَمّاشتيْ المغول من الشرق والصليبيِّين من الغرب (حروب دامت نحو قرنيْن من الزمن)..
وتعرَّض جانب هام من التراث الإسلاميّ إلى الإحراق والدمار والإبادة؛ مما دعا إلى صيانته في العهود اللاحقة عبر موسوعات (في التفسير، والحديث، والفقه، والتّاريخ، والتّراجم، واللغة…)، وصارت العلوم والمعارف متوناً تشرح في منتديات العلم وتوضع عليها الحواشي، وبدأ الإبداع يتوارى قليلا ويرحل عن الديار؛ إلا من التماعات هنا وهناك، ويترك مكانه للشروح التي لا تنتهي إلا لتبدأ.
مرحلة ظهر فيها في بدايتها هاجس إحياء علوم الدين، وتوسطتها الحروب المغولية والصّليبية، ثم جاءت انتكاسة التّجربة الحضاريّة للإسلام في الأندلس، وانتهت المرحلة بالمرض المزمن الذي أصاب القوة التركيّة. وبدت في الآفاق مظاهر الحركات الاستعماريّة يسير في ركابها المبشِّرون والمستشرقون.
التحدي السادس:
حدث في المرحلة المذكورة، أن انغلقت الأمة على علوم خاصّة؛ لا تسعفها في مواكبة أوروبا في نهضتها وعنفوانها.
وأخطر ما حدث في تلك المرحلة؛ إغلاق باب الاجتهاد، فلم يعد الواقع هو مصدر النص؛ فتراجع التوهج الفكري في الأمة؛ وصار التراث مخزونا ماديا للمخطوطات يملأ المساجد والدُّور العامّة والخاصّة للكتب؛ تتعدّد النسخ وتتكرّر الشروح والحواشي عليها، والتعليقات على حواشيها، وبذلك عاش التّراثُ على الاجترار وتجميعِ ما مضى؛ فَرَانَ عليه الجمود والتأخُّر والتكلّس.
علوم احترقت، فعاش أناس يطلبون العلم، فيجدون أنفسهم يتدارسون ما احترق؛ أي ما صار رماداً، وتناسوْا أن ما قامت عليه الثقافة الإسلامية؛ أن ترتبط رسالة الخَتْم بما يجري في واقع الناس، أن تكون عناية البحث العلمي بما تدعو الحاجة إليه، وتلتزم بحقيقة ما ينفع الناس، وبما يمكث في الأرض، وبكل ما هو إبداع، وبما لم يُسبق إليه في دنيا البحث والنظر. فأي نفع لحاضر المسلمين في كثير من المحروقات؟ وما سرُّ مكوثها وتباكيها عند كثير من المحروقات ما عادت الحاجة تدعو إليها؟
ويلاحظ أن مناهج التعليم، خلال عهود عريضة مضت، انحصرت في متون لا تتجاوزها، تتكاثر شروحها، والحواشي على شروحها، وتناط المكانة العلميّة لحامليها باسحضارها وحفظها، والانشغال بغالبية قضايا منها لا تدعو الحاجة إليها، ولا تغير من واقع المسلمين شيئا.
وبسبب كل ذلك، أو من نتائجه؛ تسرّبت إلى التراث الإسلاميّ من الأوهام والخرافات والأساطير ما أفسد على الأمة مسارها الحضاريّ، ودورها الرياديّ؛ وأدخل على نفوس أهلها كثيراً من الوهن والضعف والتقاعس والعجز. وهذا نوع من التراث ما يزال يتشكّل منه جزء ليس باليسير من ثقافة واقعنا الحالي.
ويلاحظ أن أغلب ما نملكه اليوم من تراث مكتوب، ومن موسوعات؛ يعود إلى هذه المرحلة.
ومن مجمله كانت منطلقاتنا في العصر الحديث، وعاشت وتعيش جامعاتنا في جوانب من علومها الإنسانية، وما تزال تعمل على إحيائه وتحقيقه ودراسته، وما أدري ما آثار كل ذلك على واقعنا، وعلى ما أُحْدِثَ فيه من تحولات في حياتنا وأفكارنا، وفي اجتهاداتنا، وفي مواقعنا في عالمنا المعاصر.
التحدي السابع:
تمثل فيما جاءت به العصور الحديثة من ثورات سياسيّة وتصوّرات في الاقتصاد والاجتماع والدّين والثّقافة كما تمثَّلها الغرب وأنجزها، وعمل على نشرها في المعمور، وسار في ركاب ثورته الصناعية حركات استعمارية غربيّة اجتاحت العالمَيْن العربيّ والإسلاميّ، وهما مُلتصقان بالتراب، مُقعدانِ ساكنان، مُصابانِ في عمودهما الفِقَريّ، يزحفان ولا يستطيعان الجَرْيَ، وسيطرت على مصادر القوّة فيهما، فتضاعف عجزهما أثناء المواجهة، وسعت إلى إحلال نظم الغرب محلّ النظم الإسلاميّة، وتشكيل المجتمعات المستضعفة في صور نمطية لتصوراته، والتفنّن في تشويه تعاليم الدّين الذي قامت عليه حضارة الإسلام، وطَمْسِ ثقافة ما قامت عليه تلك الحضارة؛ فتمّ لها عزل الأمّة عن منابع قوتها، وترسيخ تبعيتها للغرب.
وقد ارتكبت هذه الحركات الاستعماريّة جرائم إنسانيّة لا تنسى: أبادت شعوبا، واستغلت خيراتها، ومزّقت هوياتها ضمن كيانات متناقضة، وأحيت نعرات عرقيّة، وأحيت لهجات محلّية، وعمّقت خلافات مذهبيّة ودينيّة، وزرعت الأخطبوط الصهيونيّ في جسم الأمة العربيّة. وظل هذا الفيروس يُسمِّم شرايين الأمة، ويستأسد بقوة الغرب في ديار العرب والمسلمين، ويضع خيرات هذه الديار في خزائن الأبناك الدوليّة، وفي جيوب سماسرة السّلاح في العالم الغربيّ.
التحدي الثامن:
وسار في ركاب الحركات الاستعماريّة الحقد الصليبيّ الدفين؛ ممثَّلا في الحركات التبشيريّة؛ قصد تشويه العقيدة الإسلاميّة وإحلال المسيحيّة محلّها، وممثلا في الحركات الاستشراقيّة التي عملت بكل وسائلها لدراسة حضارة الشرق ودياناته وتاريخه ولغاته… وكان أهمّ هدف لهذه الحركات هدمَ العقيدة الإسلامية في نفوس أهلها؛ عن طريق نفي الوحي عن القرآن، وتشويه سيرة الرّسول، صلى الله عليه وسلّم، والطعن في نبوته. أما التّراث الإسلاميّ فجعلوا منه حقول ألغام؛ تنفجر طعناً وتزويراً وتشكيكاً في أصوله وحقائقه، ونفي الأصالة عن ثقافته بجعلها تابعة ليونانيته قديما، ولحَفَدَتِه من الأوربّيين حديثاً، وتلك أعمالهم شاهدة على جهودهم الرائدة في خدمة الاستعمار الحديث بكل أجهزته وأساليبه في محاولاته لطمس آخر شعاع من نور في تجربة البشريّة على الأرض.
وستظل دائرة المعارف الإسلاميّة التي وضعها المستشرقون، شاهدة على عِلْمهم بالإسلام، وحضارة الإسلام، شاهدة على الكيد الخفيّ والمعلَن للإسلام، على الترهات التي وضعها دهاقنته لتشويه حقيقة الإسلام، ويتعلم منها التاريخ كيف تكون الموضوعيّة حين تبنى على المكر والتزوير والخداع، وتتعلّم منها الدنيا ماذا فعل الغرب بحقيقة الإسلام، وكيف شوَّه هذه الحقيقة فارتكب أكبر جريمة في تاريخ الإيمان في تاريخ البشرية كما وضعها هؤلاء لصدّ الناس عن الإسلام.
وإني أَعُدُّ هذا من أكبر الجرائم التي عرفتها الإنسانيّة في تاريخها الطويل.
وبعد موت دهاقنتهم، انتهى التّراث عند بعض المتأخّرين منهم إلى فلكلور؛ ثم أصبح تراثنا فلكلوراً وأدبا شعبيّاً؛ دوره الحضاري لا يتجاوز الفرجة. بل أصبحت هذه الفرجة تعرض في ديار العرب وفي ديار الغرب على السواء؛ يُتلهّى بها وتُستجلَبُ بها أموال المستثمرين والسياح. وحين ارتبط التراث في الأذهان بالفلكلور؛ انكشف ما بدأه المستشرقون من مؤامرة على اللغة العربية؛ فأصبحت اللهجة المصرية تطاول أهرامات مصر، وتسرّبت إلى العالم العربي عبر وسائل الترفيه والفن، وشاعت في اللهجات المحلية في العالم العربي ممزوجة برطانة لغات المستعمرين. وما تزال المؤامرة تحاك في الديار التي يُتلى فيها القرآن، ويشرح أحيانا باللهجات المحلّية.
التحدي التاسع:
تمثّل في حدوث صدام بين أوروبا بثورتها الصناعيّة، وحركاتها الاستعماريّة، وخلفياتها الفكريّة، وما تحمله من أحقاد من عهود حروبها الصليبيّة، وبين شعوب مستضعفة، توالت عليها المحن والصراعات السياسيّة والمذهبيّة؛ شعوب تنتمي لتراث أصبح جله في خزائن الغربيّين، أمة اخترقتها أفكار ولغات وأصبحت مبعَدة عن هويتها وعن حقيقة تراثها؛ لا تتمثَّل روح ذلك التّراث، بل لا تحسن صيانته، ولا الدفاع عنه، كما أنها لا تستطيع تنزيله على واقعها، وحين تحاول تشتدّ خلافات وهمية حول ما يُثار قضاياه في شكل خلافات لا تنتهي؛ تدل في مجملها على جهل مطبق وتخلّف مركّب.
من هنا بدأت الأزمة الحضاريّة التي ما تزال سارية إلى اليوم، في معترك حياة الشعوب الإسلاميّة، وما تزيدها الأيّام إلا استفحالا. أما أهل هذا التّراث؛ فهم على مستوى القرارات الدوليّة لا في العير ولا في النّفير؛ يؤثِّثون خريطة سكّان الأرض لاستهلاك ما تستهلكه آلات التصنيع في الغرب.
التحدي العاشر:
مع الرغبة في التحرّر من ربقة الاستعمار العسكريّ، والخروج من متاهات التخلّف، والدّخول في معترك العصور الحديثة؛ كان لابد أن يحدث الصدام بين الحضارتيْن: الإسلاميّة والغربيّة، وأن يبدأ البحث عن كيفية تحقيق البعث الحضاريّ لتراث الأمة الإسلاميّة، وكيف يستعيد هذا التراث حضوره وقوته ومكانته؟ وكيف ينخرط هذا التراث في مسيرة التقدّم في عالمنا المعاصر؟ وكيف تتمّ العودة إلى التّراث في ضوء تجربة العصر؟
فبعد أن طُرح سؤال التّراث مع انطلاقة النهضة العربيّة الحديثة؛ توارى نسبيّاً مع استفحال الحركات الاستعماريّة في العالم العربيّ، ثم عاد الاهتمام به في ستينيَّات القرن العشرين مع الرّغبة في التحرّر من مخلفات الاستعمار، والدخول في معترك الحداثة والتّجديد والدّعوة إلى التشبث بالهويّة العربيّة الإسلاميّة. وأصبح التراث محط أنظار الباحثين بكل أطيافهم الفكريّة والإيديولوجيّة. وحدثت طفرة في نشره وتحقيقه وصنوف العناية به في الجامعات والمحافل والمنتديات.
ومع هزيمة 1967؛ اشتدّت مساءلته، وتم إخضاعه لشتى القراءات والتأويلات، واحتدّت حوله أنواع من الخلافات، وكان طموح الجميع تحقيق راهنية اللحظة التاريخية بكلّ ما تشكل عنه من خلفيات. وظل طموح كثير من الباحثين، بعثَ التّراث وإحياءَه برؤية إبداعية خلاقة نابعة من حاضرنا، متّسقة مع واقعنا؛ إذ اتّضح أن مكمن القوة في الأمة ماثلٌ في تراثها؛ فهو منبع الحيوية الذي تستمدّ منه طاقتها الذاتية وقدراتها الفعلية، لمواكبة المرحلة الراهنة، وليس لها سواه إن أرادت أن تتوهّج شعلةُ الوعي في كيانها.
التحدي الحادي عشر:
مع دخول مرحلة الحداثة بمناهجها وطروحاتها الفكرية؛ عرف التّراث الإسلاميّ العربيّ أزمة في كيفية قراءته، وتنزيله على الواقع، وانصرفت الجهود تلو الجهود إلى الدفاع عنه والاحتفاء به في المعاهد ومراكز البحث والجامعات.
ويأتي هذا في لحظة تاريخية، “تَصَهْيَنَتْ” فيها سياسة الغرب، واتضح مكرها، وأساليب فرض ثقافتها على سكان المعمور، و”تَفَرْعَنَ” فيها القطب الواحد الذي يتعبّد في محراب مصلحته ليحافظ على “فرعونيته”، ويعمل على “قولبته” ليصبح على شاكلته.
وما زراعة الكيان الصهيونيّ في جسم الأمة العربية، والتمكين له في الأرض اغتصاباً، وجعله قوة نوويّة دون سواها؛ إلا بغاية استغلال خيرات شعوب المنطقة، ومتابعة تفتيتها، وإثارة الفتن بين أهلها، بافتعال خلافات لا تنتهي.
وغاية الغايات أن تهتز ثقة المسلمين بتراثهم، وبكل شيء في حياتهم، وأن يصبح تراثهم، على عِلاّت ما آل إليه أمرُه، مهجوراً بينهم؛ تتراجع قيمُه وتتهاوَى أمام “إفرازات” الحداثة الغربية المعادية للإسلام، وأمام حركة العولمة، وما تغرق به الفضائيات وشبكات الإنترنت العقولَ والأعصابَ؛ فتزداد الهوة بين تراثنا وما يجري في العالم من حولنا. وترى الشعوب العربية، خاصة، تزداد جموداً وتخلفاً، ولا تمَلّ من التغني بشعارات جوفاء ما عادت تحرك ساكنا. شعوب استكانت إلى الذل، ورضيت بالهوان، تنتظر الذي يأتي ولا يأتي، وتَتَلَهَّى بكل ما يُغريها، ويدغدغ غرائزها من إبداعات شياطين الإنس.
ومع نهاية القرن العشرين وبداية القرن الموالي؛ ازدادت حدة التصادم بين الاحتكام إلى مقومات الأمة، وما تفرضه الحداثة الغربيّة التي تريد أن يتشكّل العالم حسب رؤيتها أي حسب مصالحها، أو بتعبير أدق حسب رؤية الصهيونية العالمية التي تعتبر الإسلامي أخطر ما يقف حجر عثرة في مشروعها “لِصَهْيَنَةِ” العالم.
هي لحظة يعيش فيها الإنسان المسلم معركة غير متكافئة، لحظة اختلّت فيها الموازين، وأصبحت تتلاعب بها الأزمات بأنواعها وخاصة الاقتصاديّة منها.
لحظة أضحى فيها الصهاينة فراعنة العصر، وانطفأت شعلة الثّورات الأوروبيّة الداعية إلى الحرّية؛ ليصبح أهلها يتبارون في تذليل الصهاينة، ولا يجرؤ متحرِّر غربي، من دعاة الحرّية؛ أن ينبس ببنت شفة عن “السامية” في مفهوم الصهيونية. لا لأن التّراث الإسلاميّ فضح جذور الصهيونية على امتداد التاريخ؛ ولكن لأن الغرب أدرك منذ الحروب الصليبية في عصوره الوسطى أن الإسلام أسلوب حياة ونظام اجتماعيّ يقوم على العدل والشورى؛ وهذا ما أفسد على الغرب كل الشعارات التي رفعها في ثوراته.
التحدي الثاني عشر:
القراءات الحداثية للتراث؛ وهي قراءات توسلت بالنموذج الغربيّ في مناهجها وتوجّهاتها؛ إذ أنه فرض سلطته المعرفيّة على الذات العربيّة منذ زمن ليس باليسير. وفي ضوء تلك المناهج سعى بعض الباحثين العرب، إلى صياغة رؤية جديدة لذلك التّراث.
فكان لابد أن تصطدم الحداثة بمنطلقات ذلك التّراث ومضامينه وآلياته في التّحليل، وكيفيّات تنزيله على الواقع. وكان من الطبيعيّ أن يحدث توتُّر شديد بين ما أطلق عليه الأنا والآخر؛ فالأنا تعاني من أزمة في تحديد موقفها من التّراث، وكيفيّة التعامل معه، ولا ترى له تنزيلا يلائم حياتها المعاصرة. والأنا ممزَّقة بين من يبحث في التراث عما يفتقده في حاضره، ومن يرى التّراث ثقافة موقعها في التاريخ، ومن يُخفي تبعيته للآخر وهو يقرأ التّراث بموضوعيّة.
أما الآخر، فمَكَّنَتْه تطوراتُه في مجالات المعرفة باللغويات وأساليب الخطاب، من بلورة مناهج متطوّرة في التّحليل والتأويل؛ ادّعى في ضوئها عمق معرفته بأنواع الخطابات، وتنوّع السياقات، وتعدد الإيديولوجيات، وما يتوارى وراءها من خلفيات.
كل يتحدث عن إشكالات لقراءة التراث، كل يريد أن تنتج قراءة معرفة جديدة بالتراث، وكثير من أصحاب تلك القراءات يسعون إلى إخضاع الماضي لسيطرة الحاضر، وأن يقدّم ذلك التراث ما نفتقده في حاضرنا، ويساعد على وضع حلول لأزماتنا المتلاحقة.
التحدي الثالث عشر:
قراءات حداثية إيديولوجية، لا تختلف في منطلقاتها عن منطلقات المستشرقين، وهي بعيدة عن روح ذلك التراث؛ ترميه بالعقم وبالعجز عن مواكبة الحياة، وتتحدّث عن ضرورة القطيعة معه. وظلّت لفظة تراث في هذه القراءات تحيل على ما تركته العهود السابقة من آثار، وتربط سبل نهوض الأمة بالانقطاع عن ذلك التراث، واعتباره ماضيا كانت له ملابساته وأوضاعه التاريخية.
ويدعو أصحاب هذه القراءات إلى تحرر الوعي العربيّ من سلطان التراث.
طُرِحَ السؤال في الأول ببراءة المعرفة المنهجيّة: كيف نقرأ التراث؟ وانتقل السؤال المنهجيّ ثانيا إلى الدعوة إلى نقد التراث، وإلى كيفيّة نقده. ثم جاء السؤال الإيديولوجيّ: كيف نحدد علاقتنا بالتراث؟
خاتمة
كيف تصبح الأمّة في موقف المنتج للحضارة؟
إذا تغيّر الإنسانُ فيها، وتغيّرتْ عقليتُه، وبدأت حضارته تستعيد كينونتها، وتستعيد ثقتها بنفسها، وتستشعر عناصر القوة في حاضرها وماضيها.
إذا استطاعت أن تحدد عناصر الأصالة والإبداع في تراثها، وتعمل بحق على تنقيته مما علق به من رواسب وأخلاط وأوهام وخرافات وحرائق وانحرافات… وغيرت البرامج والمقررات والتوجهات والفلسفات والادعاءات والمسؤوليات؛ لعل شيئا ما يحدث في العقليّات…
إذا عادت العقيدة الإسلامية صافية من شوائب الهرطقات، تُدرك حقيقة الخلافات حين تكون أساسا في بناء المعتقدات، ودعامة في بناء المجتمعات، وإذا عادت اللغة وسيلة لفهم الوحي؛ يُقرأ ويكتب بها ما به يستقيم الحال والمآل، ولا يجترّ أهلها ما احترق، وإذا تحرر الفكر وأصبح عمليّاً واقعيّاً منتجاً وجهتُه ما ينفع الناس، وما تدعو الحاجة إليه في دنياه وأخراه، وما يعطي لوجوده معنىً.
إذا كان فهم مضامين ذلك التراث يستمدّ وجوده من طبيعة آلياته ومجاله المعرفيّ.
وأختم بكلمة جاءت في تمهيد الباب الأول من كتاب تجديد المنهج في تقويم التراث لطه عبد الرحمن، يقول فيها : “لا سبيل إلى الانقطاع عن عمل بالتّراث في واقعنا؛ لأن أسبابه مشتغلة على الدوام فينا؛ آخذة بأفكارنا وموجهة لأعمالنا؛ متحكمة في حاضرنا ومستشرفة لمستقبلنا؛ سواء أأقبلنا على التراث إقبال الواعي بآثاره التي لا تنمحي، أم تظاهرنا بالإدبار عنه؛ غافلين عن واقع استلابه على وجودنا ومداركنا”. (ص 19).
وأخيراً، علينا قبل كل شيء، أن نحدد علاقتنا بهذا التراث، ولعل تحديد طبيعة هذه العلاقة هو مكمن الغموض في كل أحاديثنا عن التراث. إذا استطعنا أن نحدد هذه العلاقة، ونعمل على وضع رؤية علمية لاستكناه حقيقتها، وتنفيذ استراتيجية لتفعيلها في واقعنا المعاصر؛ يُمكننا أن نُحدِّد موقع العبور إلى المستقبل.
تحديات واجهت التراث الإسلامي وتواجهه
د. عباس أرحيلة
أستاذ التعليم العالي في الأدب العربي/مراكش
ارتباط التراث الإسلامي بدين؛ جوهرُه وحيٌ وضع نقطة الختم للتجربة الإنسانية على الأرض، وأصبح شاهداً عليها إلى نهاية الساعة؛ هيمَنَ على ما سبق، ووضع أدق تنظيم لجزئيات الحياة البشرية في أدق تفاصيلها، مع إعدادها وتبصيرها بالرُّجعَى أي بيوم الدين. فكان التراث هو ما تَخَلَّق وتنَشَّأ من خطابات حول الوحي، وما احتفَّ به من علوم ومعارف في مساره الحضاريّ من فُهوم وشروح وتأويلات له؛ قرباً منه، أو بعداً عنه.
التحدي الأول:
ارتباط هذا التراث بالوحي ألزمه بقاعدة جوهريّة هي ارتباط القول بالعمل، فلا ينفكّ أحدهما عن الآخر؛ فكان الاحتكام إلى السلوك وما يترتب عنه من خُلُق؛ إذْ هو الأساس في بناء ذلك التّراث وتقويمه.
وتراث الإسلام، في كل ما كُتِب حوله، هو خلاصة تجربة أمة الإسلام في مسارها الحضاريّ مع الدّين؛ فهو تراث ديني لا يحتمل تنزيل مفاهيم ومناهج ليست لها صِلة بدين ولا لها منطلقات دينيّة.
التحدي الثاني:
ارتباط هذا التّراث ارتباطاً عضويّاً بلغة الوحي؛ إذ كانت لسانَه، والحاملةَ لكلام الله، عزّ وجلّ، إلى النّاس أجمعين، فأصبح فهم مقاصد الوحي لا يناط بغيرها في استكناه البيان القرآنيّ، ولا تنوب عنها لغة في مقاربته، وإدراك حقيقته، وكل تآمر على العربيّة هو تآمر سافر عن الوحي، وعمل يسعى به صاحبه بوعي أو بغيره إلى إطفاء نور الله في الأرض.
وقد بدأت بوادر المؤامرة على العربية منذ القرن الرابع، مع شيوع اللهجات في ربوع الإسلام، وعودة اللغة الفارسيّة إلى الفكر والأدب، واقتصار العربيّة على دور العلم، ومجالس الدّرس، ومجالات التّأليف.
وفي العصور الحديثة اتسعت دائرة المؤامرة على العربيّة في ديار أبناء يعرب، وتلونت بألوان الحداثة المختلفة، وما تزال الدّيار تبارك تلك المؤامرة، ويتبارى أبناؤها في تشجيعها.
التحدي الثالث:
مع القرن الهجريّ الثاني، بدأ التّأسيس للعلوم والمعارف شيئا فشيئا، وكلّها تسير في موكب الوحي؛ تيسيراً لفهمه، وترسيخاً لمعارفه، وإنشاءً لهوية ثقافيّة إسلاميّة، وفيه استيقظت بقايا الملل والنِّحل القديمة. وظهرت في نهايته حركة شعوبيّة تضمر عداءً سافراً لأصحاب الدّين الجديد الذي ذهب بمُلْكهم، وسفَّه أحلامهم، وأعلَى من شأن العرب وكل من آمن برسالة الإسلام، وجعل لغتَهم لغة العلم؛ فراح الشعوبيُّون يكيدون لاستعادة الحكم الفارسيّ وإشاعة التراث المجوسيّ؛ وبدأ الكيد للإسلام، والعمل على تفتيت كيانه، وإشاعة الفاحشة بين أهله، وبث السّموم في تراثه بالوضع في الأحاديث والأشعار والأخبار والمأثورات، ودسّ الإسرائليات في تفسير القرآن الكريم، وتسريب كل ما يمكن نَفْثُه من شياطين الإنس والجن في التراث الإسلاميّ.
التحدي الرابع:
لهذا التراث بعد إنسانيّ عام؛ إذ شاركتْ في إنجازه وتشكّله أممٌ وأجناسٌ من أصقاع مختلفة، ومن حضارات وثقافات متنوعة؛ فهو تراث تضافرت على تكوينه عشرات المؤثِّرات والعوامل الجغرافيّة والتاريخيّة والثقافيّة. فاصطبغ بطبائع أهلها وأمزجتهم وأهوائهم وبقايا ما كان فيهم من نِحَل ومِلَل وثقافات.
وبمضيِّ المراحل الأولى من حضارة الإسلام؛ تمَّ تأسيس هُويّة إسلامية أسهمت في مُكوِّناتها أممٌ وشعوب خلال القرون الأربعة الأولى، واتّضحت معالم التراث الإسلاميّ، وصارت بمثابة جيناتٍ وراثيةً تتوارثها الأجيال؛ بها يُعرَفون وبفضلها يُذكَرون، وباستلهام روحها يَتطوَّرون فيحاورون ما كان من حضارات وثقافات من مركز القوة. بل أصبحت هُويّةُ تلك الأجيال مشروطةً بوجوده، وحضورُها في التّاريخ رهيناً بحضوره.
وحين بلغت الحضارة الإسلاميّة أوجها؛ اتسعت العربيّة للتّعبير عن أدقّ الحقائق باقتدار شديد، فتبلورت علوم ومعارف قامت على أُسُسِها هُويَّةٌ إسلاميّة؛ وعرفت طريقها إلى المعارف السّابقة عن طريق التّرجمة؛ فأصبحت العربيّة تُدِير الحوار العالميَّ في ذلك الزمان من بغداد؛ واتضحت رؤية شموليّة للتّجربة البشريّة على الأرض، من خلال حضارة الإسلام.
التحدي الخامس:
منذ القرن الهجري الخامس، وحتى مشارف النّهضة العربيّة الحديثة؛ بدأت خريطة العالم الإسلاميّ تَتمدَّد من جانب وتنحسر من جانب آخر، وتشرذمت في تخومها دويلات بسلطاتها وجيوشها على امتداد ما أنجزته في حروبها، وتولَّى المماليك زمام الأمور في صُرَّة العالم العربيّ؛ الذي وقع بين كَمّاشتيْ المغول من الشرق والصليبيِّين من الغرب (حروب دامت نحو قرنيْن من الزمن)..
وتعرَّض جانب هام من التراث الإسلاميّ إلى الإحراق والدمار والإبادة؛ مما دعا إلى صيانته في العهود اللاحقة عبر موسوعات (في التفسير، والحديث، والفقه، والتّاريخ، والتّراجم، واللغة…)، وصارت العلوم والمعارف متوناً تشرح في منتديات العلم وتوضع عليها الحواشي، وبدأ الإبداع يتوارى قليلا ويرحل عن الديار؛ إلا من التماعات هنا وهناك، ويترك مكانه للشروح التي لا تنتهي إلا لتبدأ.
مرحلة ظهر فيها في بدايتها هاجس إحياء علوم الدين، وتوسطتها الحروب المغولية والصّليبية، ثم جاءت انتكاسة التّجربة الحضاريّة للإسلام في الأندلس، وانتهت المرحلة بالمرض المزمن الذي أصاب القوة التركيّة. وبدت في الآفاق مظاهر الحركات الاستعماريّة يسير في ركابها المبشِّرون والمستشرقون.
التحدي السادس:
حدث في المرحلة المذكورة، أن انغلقت الأمة على علوم خاصّة؛ لا تسعفها في مواكبة أوروبا في نهضتها وعنفوانها.
وأخطر ما حدث في تلك المرحلة؛ إغلاق باب الاجتهاد، فلم يعد الواقع هو مصدر النص؛ فتراجع التوهج الفكري في الأمة؛ وصار التراث مخزونا ماديا للمخطوطات يملأ المساجد والدُّور العامّة والخاصّة للكتب؛ تتعدّد النسخ وتتكرّر الشروح والحواشي عليها، والتعليقات على حواشيها، وبذلك عاش التّراثُ على الاجترار وتجميعِ ما مضى؛ فَرَانَ عليه الجمود والتأخُّر والتكلّس.
علوم احترقت، فعاش أناس يطلبون العلم، فيجدون أنفسهم يتدارسون ما احترق؛ أي ما صار رماداً، وتناسوْا أن ما قامت عليه الثقافة الإسلامية؛ أن ترتبط رسالة الخَتْم بما يجري في واقع الناس، أن تكون عناية البحث العلمي بما تدعو الحاجة إليه، وتلتزم بحقيقة ما ينفع الناس، وبما يمكث في الأرض، وبكل ما هو إبداع، وبما لم يُسبق إليه في دنيا البحث والنظر. فأي نفع لحاضر المسلمين في كثير من المحروقات؟ وما سرُّ مكوثها وتباكيها عند كثير من المحروقات ما عادت الحاجة تدعو إليها؟
ويلاحظ أن مناهج التعليم، خلال عهود عريضة مضت، انحصرت في متون لا تتجاوزها، تتكاثر شروحها، والحواشي على شروحها، وتناط المكانة العلميّة لحامليها باسحضارها وحفظها، والانشغال بغالبية قضايا منها لا تدعو الحاجة إليها، ولا تغير من واقع المسلمين شيئا.
وبسبب كل ذلك، أو من نتائجه؛ تسرّبت إلى التراث الإسلاميّ من الأوهام والخرافات والأساطير ما أفسد على الأمة مسارها الحضاريّ، ودورها الرياديّ؛ وأدخل على نفوس أهلها كثيراً من الوهن والضعف والتقاعس والعجز. وهذا نوع من التراث ما يزال يتشكّل منه جزء ليس باليسير من ثقافة واقعنا الحالي.
ويلاحظ أن أغلب ما نملكه اليوم من تراث مكتوب، ومن موسوعات؛ يعود إلى هذه المرحلة.
ومن مجمله كانت منطلقاتنا في العصر الحديث، وعاشت وتعيش جامعاتنا في جوانب من علومها الإنسانية، وما تزال تعمل على إحيائه وتحقيقه ودراسته، وما أدري ما آثار كل ذلك على واقعنا، وعلى ما أُحْدِثَ فيه من تحولات في حياتنا وأفكارنا، وفي اجتهاداتنا، وفي مواقعنا في عالمنا المعاصر.
التحدي السابع:
تمثل فيما جاءت به العصور الحديثة من ثورات سياسيّة وتصوّرات في الاقتصاد والاجتماع والدّين والثّقافة كما تمثَّلها الغرب وأنجزها، وعمل على نشرها في المعمور، وسار في ركاب ثورته الصناعية حركات استعمارية غربيّة اجتاحت العالمَيْن العربيّ والإسلاميّ، وهما مُلتصقان بالتراب، مُقعدانِ ساكنان، مُصابانِ في عمودهما الفِقَريّ، يزحفان ولا يستطيعان الجَرْيَ، وسيطرت على مصادر القوّة فيهما، فتضاعف عجزهما أثناء المواجهة، وسعت إلى إحلال نظم الغرب محلّ النظم الإسلاميّة، وتشكيل المجتمعات المستضعفة في صور نمطية لتصوراته، والتفنّن في تشويه تعاليم الدّين الذي قامت عليه حضارة الإسلام، وطَمْسِ ثقافة ما قامت عليه تلك الحضارة؛ فتمّ لها عزل الأمّة عن منابع قوتها، وترسيخ تبعيتها للغرب.
وقد ارتكبت هذه الحركات الاستعماريّة جرائم إنسانيّة لا تنسى: أبادت شعوبا، واستغلت خيراتها، ومزّقت هوياتها ضمن كيانات متناقضة، وأحيت نعرات عرقيّة، وأحيت لهجات محلّية، وعمّقت خلافات مذهبيّة ودينيّة، وزرعت الأخطبوط الصهيونيّ في جسم الأمة العربيّة. وظل هذا الفيروس يُسمِّم شرايين الأمة، ويستأسد بقوة الغرب في ديار العرب والمسلمين، ويضع خيرات هذه الديار في خزائن الأبناك الدوليّة، وفي جيوب سماسرة السّلاح في العالم الغربيّ.
التحدي الثامن:
وسار في ركاب الحركات الاستعماريّة الحقد الصليبيّ الدفين؛ ممثَّلا في الحركات التبشيريّة؛ قصد تشويه العقيدة الإسلاميّة وإحلال المسيحيّة محلّها، وممثلا في الحركات الاستشراقيّة التي عملت بكل وسائلها لدراسة حضارة الشرق ودياناته وتاريخه ولغاته… وكان أهمّ هدف لهذه الحركات هدمَ العقيدة الإسلامية في نفوس أهلها؛ عن طريق نفي الوحي عن القرآن، وتشويه سيرة الرّسول، صلى الله عليه وسلّم، والطعن في نبوته. أما التّراث الإسلاميّ فجعلوا منه حقول ألغام؛ تنفجر طعناً وتزويراً وتشكيكاً في أصوله وحقائقه، ونفي الأصالة عن ثقافته بجعلها تابعة ليونانيته قديما، ولحَفَدَتِه من الأوربّيين حديثاً، وتلك أعمالهم شاهدة على جهودهم الرائدة في خدمة الاستعمار الحديث بكل أجهزته وأساليبه في محاولاته لطمس آخر شعاع من نور في تجربة البشريّة على الأرض.
وستظل دائرة المعارف الإسلاميّة التي وضعها المستشرقون، شاهدة على عِلْمهم بالإسلام، وحضارة الإسلام، شاهدة على الكيد الخفيّ والمعلَن للإسلام، على الترهات التي وضعها دهاقنته لتشويه حقيقة الإسلام، ويتعلم منها التاريخ كيف تكون الموضوعيّة حين تبنى على المكر والتزوير والخداع، وتتعلّم منها الدنيا ماذا فعل الغرب بحقيقة الإسلام، وكيف شوَّه هذه الحقيقة فارتكب أكبر جريمة في تاريخ الإيمان في تاريخ البشرية كما وضعها هؤلاء لصدّ الناس عن الإسلام.
وإني أَعُدُّ هذا من أكبر الجرائم التي عرفتها الإنسانيّة في تاريخها الطويل.
وبعد موت دهاقنتهم، انتهى التّراث عند بعض المتأخّرين منهم إلى فلكلور؛ ثم أصبح تراثنا فلكلوراً وأدبا شعبيّاً؛ دوره الحضاري لا يتجاوز الفرجة. بل أصبحت هذه الفرجة تعرض في ديار العرب وفي ديار الغرب على السواء؛ يُتلهّى بها وتُستجلَبُ بها أموال المستثمرين والسياح. وحين ارتبط التراث في الأذهان بالفلكلور؛ انكشف ما بدأه المستشرقون من مؤامرة على اللغة العربية؛ فأصبحت اللهجة المصرية تطاول أهرامات مصر، وتسرّبت إلى العالم العربي عبر وسائل الترفيه والفن، وشاعت في اللهجات المحلية في العالم العربي ممزوجة برطانة لغات المستعمرين. وما تزال المؤامرة تحاك في الديار التي يُتلى فيها القرآن، ويشرح أحيانا باللهجات المحلّية.
التحدي التاسع:
تمثّل في حدوث صدام بين أوروبا بثورتها الصناعيّة، وحركاتها الاستعماريّة، وخلفياتها الفكريّة، وما تحمله من أحقاد من عهود حروبها الصليبيّة، وبين شعوب مستضعفة، توالت عليها المحن والصراعات السياسيّة والمذهبيّة؛ شعوب تنتمي لتراث أصبح جله في خزائن الغربيّين، أمة اخترقتها أفكار ولغات وأصبحت مبعَدة عن هويتها وعن حقيقة تراثها؛ لا تتمثَّل روح ذلك التّراث، بل لا تحسن صيانته، ولا الدفاع عنه، كما أنها لا تستطيع تنزيله على واقعها، وحين تحاول تشتدّ خلافات وهمية حول ما يُثار قضاياه في شكل خلافات لا تنتهي؛ تدل في مجملها على جهل مطبق وتخلّف مركّب.
من هنا بدأت الأزمة الحضاريّة التي ما تزال سارية إلى اليوم، في معترك حياة الشعوب الإسلاميّة، وما تزيدها الأيّام إلا استفحالا. أما أهل هذا التّراث؛ فهم على مستوى القرارات الدوليّة لا في العير ولا في النّفير؛ يؤثِّثون خريطة سكّان الأرض لاستهلاك ما تستهلكه آلات التصنيع في الغرب.
التحدي العاشر:
مع الرغبة في التحرّر من ربقة الاستعمار العسكريّ، والخروج من متاهات التخلّف، والدّخول في معترك العصور الحديثة؛ كان لابد أن يحدث الصدام بين الحضارتيْن: الإسلاميّة والغربيّة، وأن يبدأ البحث عن كيفية تحقيق البعث الحضاريّ لتراث الأمة الإسلاميّة، وكيف يستعيد هذا التراث حضوره وقوته ومكانته؟ وكيف ينخرط هذا التراث في مسيرة التقدّم في عالمنا المعاصر؟ وكيف تتمّ العودة إلى التّراث في ضوء تجربة العصر؟
فبعد أن طُرح سؤال التّراث مع انطلاقة النهضة العربيّة الحديثة؛ توارى نسبيّاً مع استفحال الحركات الاستعماريّة في العالم العربيّ، ثم عاد الاهتمام به في ستينيَّات القرن العشرين مع الرّغبة في التحرّر من مخلفات الاستعمار، والدخول في معترك الحداثة والتّجديد والدّعوة إلى التشبث بالهويّة العربيّة الإسلاميّة. وأصبح التراث محط أنظار الباحثين بكل أطيافهم الفكريّة والإيديولوجيّة. وحدثت طفرة في نشره وتحقيقه وصنوف العناية به في الجامعات والمحافل والمنتديات.
ومع هزيمة 1967؛ اشتدّت مساءلته، وتم إخضاعه لشتى القراءات والتأويلات، واحتدّت حوله أنواع من الخلافات، وكان طموح الجميع تحقيق راهنية اللحظة التاريخية بكلّ ما تشكل عنه من خلفيات. وظل طموح كثير من الباحثين، بعثَ التّراث وإحياءَه برؤية إبداعية خلاقة نابعة من حاضرنا، متّسقة مع واقعنا؛ إذ اتّضح أن مكمن القوة في الأمة ماثلٌ في تراثها؛ فهو منبع الحيوية الذي تستمدّ منه طاقتها الذاتية وقدراتها الفعلية، لمواكبة المرحلة الراهنة، وليس لها سواه إن أرادت أن تتوهّج شعلةُ الوعي في كيانها.
التحدي الحادي عشر:
مع دخول مرحلة الحداثة بمناهجها وطروحاتها الفكرية؛ عرف التّراث الإسلاميّ العربيّ أزمة في كيفية قراءته، وتنزيله على الواقع، وانصرفت الجهود تلو الجهود إلى الدفاع عنه والاحتفاء به في المعاهد ومراكز البحث والجامعات.
ويأتي هذا في لحظة تاريخية، “تَصَهْيَنَتْ” فيها سياسة الغرب، واتضح مكرها، وأساليب فرض ثقافتها على سكان المعمور، و”تَفَرْعَنَ” فيها القطب الواحد الذي يتعبّد في محراب مصلحته ليحافظ على “فرعونيته”، ويعمل على “قولبته” ليصبح على شاكلته.
وما زراعة الكيان الصهيونيّ في جسم الأمة العربية، والتمكين له في الأرض اغتصاباً، وجعله قوة نوويّة دون سواها؛ إلا بغاية استغلال خيرات شعوب المنطقة، ومتابعة تفتيتها، وإثارة الفتن بين أهلها، بافتعال خلافات لا تنتهي.
وغاية الغايات أن تهتز ثقة المسلمين بتراثهم، وبكل شيء في حياتهم، وأن يصبح تراثهم، على عِلاّت ما آل إليه أمرُه، مهجوراً بينهم؛ تتراجع قيمُه وتتهاوَى أمام “إفرازات” الحداثة الغربية المعادية للإسلام، وأمام حركة العولمة، وما تغرق به الفضائيات وشبكات الإنترنت العقولَ والأعصابَ؛ فتزداد الهوة بين تراثنا وما يجري في العالم من حولنا. وترى الشعوب العربية، خاصة، تزداد جموداً وتخلفاً، ولا تمَلّ من التغني بشعارات جوفاء ما عادت تحرك ساكنا. شعوب استكانت إلى الذل، ورضيت بالهوان، تنتظر الذي يأتي ولا يأتي، وتَتَلَهَّى بكل ما يُغريها، ويدغدغ غرائزها من إبداعات شياطين الإنس.
ومع نهاية القرن العشرين وبداية القرن الموالي؛ ازدادت حدة التصادم بين الاحتكام إلى مقومات الأمة، وما تفرضه الحداثة الغربيّة التي تريد أن يتشكّل العالم حسب رؤيتها أي حسب مصالحها، أو بتعبير أدق حسب رؤية الصهيونية العالمية التي تعتبر الإسلامي أخطر ما يقف حجر عثرة في مشروعها “لِصَهْيَنَةِ” العالم.
هي لحظة يعيش فيها الإنسان المسلم معركة غير متكافئة، لحظة اختلّت فيها الموازين، وأصبحت تتلاعب بها الأزمات بأنواعها وخاصة الاقتصاديّة منها.
لحظة أضحى فيها الصهاينة فراعنة العصر، وانطفأت شعلة الثّورات الأوروبيّة الداعية إلى الحرّية؛ ليصبح أهلها يتبارون في تذليل الصهاينة، ولا يجرؤ متحرِّر غربي، من دعاة الحرّية؛ أن ينبس ببنت شفة عن “السامية” في مفهوم الصهيونية. لا لأن التّراث الإسلاميّ فضح جذور الصهيونية على امتداد التاريخ؛ ولكن لأن الغرب أدرك منذ الحروب الصليبية في عصوره الوسطى أن الإسلام أسلوب حياة ونظام اجتماعيّ يقوم على العدل والشورى؛ وهذا ما أفسد على الغرب كل الشعارات التي رفعها في ثوراته.
التحدي الثاني عشر:
القراءات الحداثية للتراث؛ وهي قراءات توسلت بالنموذج الغربيّ في مناهجها وتوجّهاتها؛ إذ أنه فرض سلطته المعرفيّة على الذات العربيّة منذ زمن ليس باليسير. وفي ضوء تلك المناهج سعى بعض الباحثين العرب، إلى صياغة رؤية جديدة لذلك التّراث.
فكان لابد أن تصطدم الحداثة بمنطلقات ذلك التّراث ومضامينه وآلياته في التّحليل، وكيفيّات تنزيله على الواقع. وكان من الطبيعيّ أن يحدث توتُّر شديد بين ما أطلق عليه الأنا والآخر؛ فالأنا تعاني من أزمة في تحديد موقفها من التّراث، وكيفيّة التعامل معه، ولا ترى له تنزيلا يلائم حياتها المعاصرة. والأنا ممزَّقة بين من يبحث في التراث عما يفتقده في حاضره، ومن يرى التّراث ثقافة موقعها في التاريخ، ومن يُخفي تبعيته للآخر وهو يقرأ التّراث بموضوعيّة.
أما الآخر، فمَكَّنَتْه تطوراتُه في مجالات المعرفة باللغويات وأساليب الخطاب، من بلورة مناهج متطوّرة في التّحليل والتأويل؛ ادّعى في ضوئها عمق معرفته بأنواع الخطابات، وتنوّع السياقات، وتعدد الإيديولوجيات، وما يتوارى وراءها من خلفيات.
كل يتحدث عن إشكالات لقراءة التراث، كل يريد أن تنتج قراءة معرفة جديدة بالتراث، وكثير من أصحاب تلك القراءات يسعون إلى إخضاع الماضي لسيطرة الحاضر، وأن يقدّم ذلك التراث ما نفتقده في حاضرنا، ويساعد على وضع حلول لأزماتنا المتلاحقة.
التحدي الثالث عشر:
قراءات حداثية إيديولوجية، لا تختلف في منطلقاتها عن منطلقات المستشرقين، وهي بعيدة عن روح ذلك التراث؛ ترميه بالعقم وبالعجز عن مواكبة الحياة، وتتحدّث عن ضرورة القطيعة معه. وظلّت لفظة تراث في هذه القراءات تحيل على ما تركته العهود السابقة من آثار، وتربط سبل نهوض الأمة بالانقطاع عن ذلك التراث، واعتباره ماضيا كانت له ملابساته وأوضاعه التاريخية.
ويدعو أصحاب هذه القراءات إلى تحرر الوعي العربيّ من سلطان التراث.
طُرِحَ السؤال في الأول ببراءة المعرفة المنهجيّة: كيف نقرأ التراث؟ وانتقل السؤال المنهجيّ ثانيا إلى الدعوة إلى نقد التراث، وإلى كيفيّة نقده. ثم جاء السؤال الإيديولوجيّ: كيف نحدد علاقتنا بالتراث؟
خاتمة
كيف تصبح الأمّة في موقف المنتج للحضارة؟
إذا تغيّر الإنسانُ فيها، وتغيّرتْ عقليتُه، وبدأت حضارته تستعيد كينونتها، وتستعيد ثقتها بنفسها، وتستشعر عناصر القوة في حاضرها وماضيها.
إذا استطاعت أن تحدد عناصر الأصالة والإبداع في تراثها، وتعمل بحق على تنقيته مما علق به من رواسب وأخلاط وأوهام وخرافات وحرائق وانحرافات… وغيرت البرامج والمقررات والتوجهات والفلسفات والادعاءات والمسؤوليات؛ لعل شيئا ما يحدث في العقليّات…
إذا عادت العقيدة الإسلامية صافية من شوائب الهرطقات، تُدرك حقيقة الخلافات حين تكون أساسا في بناء المعتقدات، ودعامة في بناء المجتمعات، وإذا عادت اللغة وسيلة لفهم الوحي؛ يُقرأ ويكتب بها ما به يستقيم الحال والمآل، ولا يجترّ أهلها ما احترق، وإذا تحرر الفكر وأصبح عمليّاً واقعيّاً منتجاً وجهتُه ما ينفع الناس، وما تدعو الحاجة إليه في دنياه وأخراه، وما يعطي لوجوده معنىً.
إذا كان فهم مضامين ذلك التراث يستمدّ وجوده من طبيعة آلياته ومجاله المعرفيّ.
وأختم بكلمة جاءت في تمهيد الباب الأول من كتاب تجديد المنهج في تقويم التراث لطه عبد الرحمن، يقول فيها : “لا سبيل إلى الانقطاع عن عمل بالتّراث في واقعنا؛ لأن أسبابه مشتغلة على الدوام فينا؛ آخذة بأفكارنا وموجهة لأعمالنا؛ متحكمة في حاضرنا ومستشرفة لمستقبلنا؛ سواء أأقبلنا على التراث إقبال الواعي بآثاره التي لا تنمحي، أم تظاهرنا بالإدبار عنه؛ غافلين عن واقع استلابه على وجودنا ومداركنا”. (ص 19).
وأخيراً، علينا قبل كل شيء، أن نحدد علاقتنا بهذا التراث، ولعل تحديد طبيعة هذه العلاقة هو مكمن الغموض في كل أحاديثنا عن التراث. إذا استطعنا أن نحدد هذه العلاقة، ونعمل على وضع رؤية علمية لاستكناه حقيقتها، وتنفيذ استراتيجية لتفعيلها في واقعنا المعاصر؛ يُمكننا أن نُحدِّد موقع العبور إلى المستقبل.