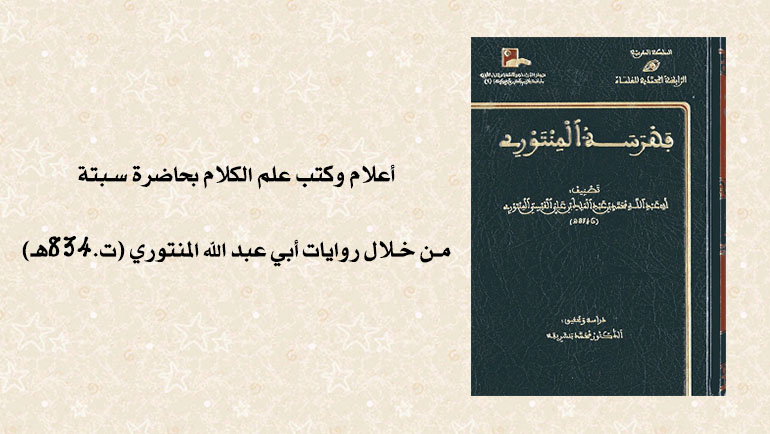نظرة الإسلام إلى المال
إن الإسلام أقام حدودا ووضع أصولا نظم بها شؤون الإنسان المالية والاقتصادية، وجعل تلك الحدود والأصول وفق قواعد الحق والصدق والعدل والأمانة.
فنظرة الإسلام إلى المال نظرة موضوعية، فهو وسيلة لا غاية وجد لتحقيق العدالة الاجتماعية التي ينشدها الإسلام.
فالأموال في الشريعة الإسلامية لم تكن إلا وسيلة من وسائل تبادل المنافع وقضاء الحاجات، لأنها في الحقيقة أموال مملوكة لله وما الإنسان إلا مستخلف فيها على وجه الأرض، سيما وأن الخالق تعالى يقول في كتابه العزيز: ﴿وءاتوهم من مال الله الذي أتاكم﴾ ﴿وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه﴾ فإذا استعمل هذا المستخلف تلك الأموال في غير ما يأمر به المالك الحقيقي لها، انقلبت إلى شهوة تورث صاحبها الهلاك، وتفتح على الناس أبواب الفساد.
يقول تعالى: ﴿زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا﴾ وليس معنى هذا أن الإسلام عدو للمال، لأن القرءان ذكره ستا وسبعين مرة، مفردا، وجمعا ومعرفا ونكرة ومضافا ومنعطفا على الإضافة، بل على العكس، فإن الإسلام يرى في المال العصب المحرك للحياة في انطلاقها ودورانها، ويرى فيه الخير كل الخير إذا أنفق في مقتضاه وهو يحرص كل الحرص على ألا يشل حركته ولا يعوقه عند القيام بوظيفته بوصفه عاملا هاما من عوامل الإنتاج، والشر كل الشر إذا رصد إنفاقه نحو الرذيلة والمحرمات.
يقول تعالى: ﴿قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق﴾ فالواجب يقتضي التحلي بزينة الحياة والتمتع بالطيبات لما في ذلك من تشجيع للإنتاج واستثمار للأموال وتداول للنقد.
فالمال في ذاته ليس شرا، وليس خيرا، هو أداة خاضعة لمشيئة الإنسان، إن شاء كان عليه نعمة وفضلا ورزقا ينال به الطيبات، وإن شاء حول نعمة هذا المال إلى نقمة، وذلك إذا ترك لسلطانه أن يطغى عليه.
بهذا التقدير ينظر الإسلام في سياسته إلى المال، فهو يقر بفعاليته في الحياة ومكانه في القلوب، لأن حب التملك في ذاته ضرورة من ضرورات الحياة، لا يعيش الكائن الحي إلا إذا دب فيه دبيب هذه الغريزة، وفي هذا الصدد نجد الرسول، صلى الله عليه وسلم، يقول: “لو كان لابن آدم واديان من مال لا بتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من يتوب”[1] ويقول عليه السلام: “قلب الشيخ شاب على حب اثنتين: “طول الحياة وحب المال”[2].
ما هو المال الذي ينشده الإسلام؟
إن المال الذي ينشده الإسلام، هو المال الذي يكسبه الإنسان بالطرق المشروعة، بكده واجتهاده وسعيه. يقول صلى الله عليه وسلم: “إن أفضل الكسب، كسب الرجل من يده” ويقول: “ما أكل أحد طعاما قط خيرا من عمل يده”[3] إذ لا يجوز لأحد أن يسأل الناس وهو قادر على الكسب، فالإسلام يسمح بكل طريق يسلكه الإنسان للتملك كالإرث، والهبة، والوصية، والعارية، والقرض…”إلا ما كان عن طريق الظلم والغش والخديعة، والمكر، والإكراه، والسطو، والسرقة، والسلب، والنهب، والقمار، والرشوة، والربا، فالإسلام يحرم مثل هذه الأعمال.
لقد أباح الإسلام كل وسيلة كريمة للكسب المشروع، فللمرء أن يقوم بأي عمل من الأعمال المباحة التي من شأنها أن تكسبه رزقا حلالا طيبا، فليس هناك عمل خاص بطبقة معينة، فالإسلام أقام المساواة المطلقة في مجالات العمل، فلم يخص أحدا أو جماعة بعمل دون عمل، فالناس كلهم سواء يرتفعون وينخفضون حسب استعدادهم ومواهبهم وثقافتهم وكدهم واجتهادهم في مجالات الكسب الحلال[4]. فعندما يحترم الإسلام طرق الكسب ويبيح المنافسة المشروعة، لا يقبل أن تتحول ثمار المال المكتسب إلى قوة باطشة مستبدة تتحكم في مصير الفرد والجماعة وتجعل من الإنسان عبدا للمادة يعبد معها العجل الذهبي، في الصباح يركع أمام قرنيه، وفي المساء وراء ذيله متمردا على كل القيم الدينية والإنسانية لذته في الحياة البحث عن المادة وتكديس الثروات، وإذ يصير الأمر على هذا الحد فإن الشريعة الإسلامية تتدخل لتضع حدا لطغيان المال على الإنسان ولتبسط حمايتها على المجتمع وتضع بين الناس موازين الحق والعدل والإنصاف.
ولعل أول ظاهرة لتسلط المال على حقوق الناس هي تلك التي تتجلى في تفشي المعاملات الربوية بين الناس، هذه الظاهرة التي تمثل أبشع صورة من صور الاستغلال التي لازالت مجتمعاتنا الإسلامية تعاني منها نتيجة تعاملها بأساليب الاقتصاد المعاصر وتخليها عن تعاليم الشريعة الإسلامية التي تنطوي على اقتصاد إسلامي متكامل البنيان.
فمن المؤسف أن يكون موقف الإسلام من المعاملات الاقتصادية الحديثة موقف الصرامة والحدة والوعد الجهنمي، ومع ذلك لا تتحاشى الأمة الإسلامية وهي تنص في دساتيرها التي وضعتها باختيارها ورضاها على أن دينها الرسمي هو الإسلام – عن التعامل بالأساليب الربوية، والله يقول في كتابه العزيز: ﴿يأيها الذين ءامنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مومنين، فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله﴾[5].
ولعل من الأخطار التي تنطوي عليها المعاملات الربوية تكديس الثروات في أيد قليلة من المجتمع فيصبح بذلك البعد شاسعا بين الطبقات، طبقة الفقراء المحرومين التعساء، وطبقة الأغنياء المترفين المستعبدين للفقراء. وهذا ما نهى عنه القرءان الكريم في عدة سور، ففي سورة الحشر يقول الله تعالى في وجوب إعطاء الفقراء نصيبا من الفيء: ﴿كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم﴾ ولعل فريضة الزكاة وغيرها مما سنعلمه فيما بعد، شرعت كشريان متجدد بين أفراد المجتمع الإسلامي، الذين يملكون والذين لا يملكون، شريان يحمل معه الرحمة والتعاون والإيثار والمنفعة العامة حتى يتحقق بذلك التكامل الاجتماعي المنشود لصالح أفراد الأمة الإسلامية.
التصور الإسلامي للهياكل المالية
لم يكن المجتمع الإسلامي بمكة قبل الهجرة مجتمعا آمنا مستقرا يستطيع أن ينظر في أموره السياسية والمالية ويستكمل مقومات وجوده، وإنما كان المسلمون في وجه ظلم كالح، واضطهاد قاهر لا يرحم، ولكن بانتشار الإسلام الذي عم معه الأمن والرخاء، ازدهرت التجارة والاقتصاد، فوضعت الدولة الإسلامية أول لبنة في صرح النظام المالي، حيث تأسس مباشرة بعد غزوة بدر “بيت مال المسلمين “الذي أصبح خزينة الأمة التي تجمع بها الموارد وتصرف من دخلها النفقات، ولم تكن تلك الموارد والنفقات تشكل ميزانية الدولة على النمط المتعارف عليه في المفهوم المالي الحديث، بل كانت مالية الدولة الإسلامية مرنة تستجيب لمتطلبات الأمة وما تقتضيه مصلحة الدين الإسلامي.
فإذا كانت السياسة المالية لكل دولة تقوم على تحقيق التوازن بين مواريدها ومصاريفها، فإن الدولة الإسلامية على الرغم من التطورات التي حدثت في بداية الإسلام حافظت على التوازن المالي فلم تلجأ في يوم من الأيام إلى مساومة بحق من حقوق الأمة في مقابل عطاء مالي، وهكذا كانت أموال متوفرة لبيت المال تأتي من موارد مختلفة كالخراج، والجزية والزكاة، والفيء، والغنيمة، والعشور…
ونظرا لكون هذه الأصناف المالية سبق لعدد من العلماء الأجلاء أن كتبوا فيها الشيء الكثير، فإنني سأكتفي في هذا البحث بإعطاء تعاريف مختصرة عن كل صنف من أصناف موارد بيت مال المسلمين، غير أني سأركز، بصفة خاصة، على الزكاة باعتبارها أحد أركان الإسلام الخمس ولما تنطوي عليه من فلسفة اجتماعية، ثم سأحاول مناقشة موضوع الضرائب في الإسلام على ضوء الآراء المختلفة التي تنفي وجود الضرائب المباشرة أو غير المباشرة في النظام المالي الإسلامي وبالتالي وجود مالية إسلامية منظمة في شكل ميزانية عمومية بالمفهوم الحديث للمالية.
مالية الدولة الإسلامية
إن موارد الدولة الإسلامية لا تشكل فقط، الخراج، والجزية والزكاة، والفيء، والغنيمة، والعشور، بل هناك أموال أخرى تجبيها الدولة من جهات أخرى مثل الأملاك العامة وميراث من لا وارث له، ومداخل الوقف، والتبرعات الخصوصية وغير ذلك، وإلى جانب هذه الموارد هناك نفقات التكافل الاجتماعي من زكاة وصدقات وغيرها، وأعطيات الموظفين والقضاة والجند، ونفقات التعليم والصحة وإصلاح الطرقات والترع والقناطر… وسنتعرض باختصار إلى أهم ما في هذا الموضوع من جوانب هامة.
أولا: موارد بيت المال
أ. الخراج: هو مقدار معين من المال أو الحاصلات، ويفرض على الأرض التي صولح عليها المشركون، ويؤخذ عن الأرض التي فتحها المسلمون عنوة، وعن الأرض التي أفاء الله بها على المسلمين فملكوها وصالحوا أهلها على أن يتركوهم بخراج معلوم يؤدونه إلى بيت المال، وكان للخراج ديوان خاص.
ب. الجزية: هي مبلغ معين من المال توضع على الرؤوس، وتسقط بالإسلام، وثبتت بنص القرءان لقوله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يومنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ [التوبة: 29] والفرق بينها وبين الخراج أن الخراج على الأرض (وليس على الرؤوس)، ولا يسقط بالإسلام، وثبت بالاجتهاد لا بنص القرءان.
وقد فرضت الجزية على الذميين في مقابل الزكاة على المسلمين حتى يتكافأ الفريقان، لأن الذميين والمسلمين رعية لدولة واحدة، ويتمتعون بحقوق واحدة، وينتفعون بمرافق الدولة العامة بنسبة واحدة. وليست الجزية من مستحدثات الإسلام، بل هي قديمة فرضها اليونان على سكان آسيا الصغرى حوالي القرن الخامس قبل الميلاد، كما وضع الرومان والفرس الجزية على الأمم التي خضعت لهم[6].
ج. الفئ: مأخوذ من فاء يفئ إذا رجع، وهو كل مال وصل من المشركين للمسلمين عفوا من غير قتال لا بإيجاف خيل[7] ولا ركاب، فهو كمال الهدنة والجزية والخراج.
وخمس الفئ يقسم على خمسة أسهم: سهم لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، أما أخماس الخمس، فسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم لابن السبيل، وسهم للمساكين وفي ذلك يقول تعالى: ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾.
د. الغنيمة: المراد بها مال الكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر، وهي قديمة بقدم الحرب لأنها نتيجة وثمرة لها.
فلم يعرف المسلمون الغنائم إلا بعد هجرتهم إلى المدينة، لأن المراحل التي اجتازتها الدعوة الإسلامية في أول أمرها كانت مقتصرة على الإرشاد، واكتساب العرب عن طريقها بالحكمة والموعظة.
وفي غزوة بدر نزل قوله تعالى: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، ولذي القربى، واليتامى، والمساكين وابن السبيل﴾ (الأنفال: 41) فكانت هذه الآية حكما في شأن الغنائم التي تقع في يد المسلمين من جيوش المشركين، فكان للمحاربين في الغنائم أربعة أخماس، أما الخمس الباقي فيقسم بدوره إلى خمسة أقسام: قسم لذوي القربى، وقسم لليتامى، وقسم للمساكين، وقسم لابن السبيل.
وفي كتاب الخراج لأبي يوسف، وكذلك، في الأحكام السلطانية للماوردي، والجامع لأحكام القرءان، شروح كثيرة للكيفية التي كانت تقسم بها الغنائم في مختلف العهود الإسلامية.
ﻫ. العشور: هي الضرائب التي كانت تفرض على أموال التجارة الصادرة من البلاد الإسلامية والواردة إليها، وهذا ما نسميه في الوقت الحاضر بالضرائب الجمركية.
فمن التنظيم المالي الذي اقتضته سياسة الدولة الإسلامية فرض ضرائب على تجارة أهل الذمة، وكذلك على أهل الحرب إذا مروا بتجارتهم في أرض المسلمين، ذلك أن التجارة هي مورد من موارد الرزق، تنمو، وتثمر في ظل الدولة وفي حمايتها، بما يدور من الأخذ والعطاء بين أفراد المجتمع، فكان من المنطق أن يعود للدولة شيء مما يجنيه التجار من ربح في تجارتهم، وقد شملت هذه الضريبة المسلمين والذميين والمحاربين جميعا، فهي على المسلمين زكاة، ومن ثم فإنها تخرج مخرج الزكاة ربع العشر إذا بلغت قيمتها مائتي درهم أو عشرين مثقالا، فإن كانت أقل من ذلك فلا شيء عليها.
أما الذمي فإن عليه في تجارته نصف العشر من قيمتها، من الحول إلى الحول وأما المحارب فإن عليه العشر كاملا[8].
و. الزكاة: هي الركن الثالث في الإسلام جاء الأمر بها مقرونا بالصلاة في نحو ثلاثين موضعا، وكلمة الزكاة في اللغة العربية لها مدلول مزدوج، الأول أنها تزكية وتطهير للروح، والثاني أنها تزكية وتنمية للمال، فهي أولا تزكي نفس مؤديها بما تتيح له من تدريب مستمر على حرمان النفس لمنفعة الغير، وشفاء لها من سيطرة الشح عليها، ثم هي بما تبثه من تراحم بين طبقات المجتمع وما تنزع من غل عند الطبقات المحرومة للطبقات الموسرة، تكفل تنمية التعاون الاجتماعي. كذلك يلاحظ أن الزكاة بما تقتطعه سنويا من رأس المال تساعد على توزيع الثروة في ثنايا المجتمع، وتحول دون تكدسها في أيد قليلة، وما يلازم هذا التكدس من مساوئ خطيرة.
والزكاة عرفت كضريبة في الأمم القديمة وفي الشريعة الموسوية. وفي العهود الأولى للإسلام كانت مجرد إحسان ولم يكن لهذا الإحسان نظام معين أو تشريع خاص[9] لكن نزلت آيات كثيرة تجعل الزكاة واجبة على الأغنياء يقول تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها﴾ ثم يقول: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم…﴾ ويقول: ﴿قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى﴾ (الأعلى: 14-15) وروي عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قام في الناس فقال: «يا أيها الناس أتاني آت من ربي في المنام فقال لي يا محمد لا صلاة لمن لا زكاة له ولا زكاة لمن لا صلاة له، مانع الزكاة في النار والمتعدي فيها كمانعها».
إن أكثر من خمسين آية موزعة بين سور القرءان تتحدث عن الزكاة وهي في مجموعها تؤلف دستورا لهذه الضريبة الإسلامية التي لأهميتها جعلها القرءان ركنا من أركان الإسلام الخمس، كما أن عشرات الأحاديث النبوية تكشف عن أهمية الزكاة ودورها في تحقيق التكافل الاجتماعي. كما أن العلماء الكبار خصوها بمؤلفات كثيرة تشرح فلسفتها وأهميتها ومن أين تجبى ونوع الأصناف المستحقين لها، فالزكاة ما هي في الواقع إلا علاج لمشكلة الغني والفقير، أوجدها الإسلام لتفتيت الثروة الكبيرة حتى لا تتكدس الأموال في أيد قليلة، فهي حق معلوم للسائل والمحروم، فريضة من الله في الأموال والأنعام والزروع، تصرف من أموال الأغنياء لا منحة يمنون بها على الفقراء وإنما هي حقهم الذي أوجبه الله في كتابه العزيز حيث قال تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم﴾.
وفي هذا الصدد يروي ابن حزم في كتابه المحلى عن سيدنا علي ابن أبي طالب: (إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم، فإن جاعوا أوعروا فبمنع، فمنع، وحق على الله أن يحاسبهم يوم القيامة ويعذبهم عليه… والسلطان يجبر الأغنياء على إعالة الفقراء فإن لم تقم الزكوات فإنهم يطعمونهم من القوت الذي لا بد منه ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك، وبمسكن يقيهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة”[10].
هذا وتجب الزكاة في الأموال النقدية وفي عروض التجارة بنسبة 5‚2 بالمائة وفي المواشي بنسبة كتلك النسبة تقريبا، وفي الزروع والثمار بنسبة العشور في الأراضي المروية من غير كلفة كالتي تروى بمياه الأمطار والينابيع، ونصف العشر في الأراضي التي تروى بآلة ونحوها.
وكانت مداخيل الزكاة تشكل نسبة عظمى من موارد بيت المال الشيء الذي جعل دولة الإسلام في عهود كثيرة في ازدهار ورخاء انعدم معه كل فقر وخصاصة.
هل تصلح الزكاة في هذا العصر؟
كثيرا من الحاقدين على الإسلام يرون بأن الزكاة لم تصبح صالحة للتطبيق في عصرنا هذا الذي فرضت فيه ضرائب على الأغنياء حلت محل الزكاة، وهذا تأويل خاطئ، سيما وأن الزكاة خصها الإسلام لأصناف معينة في المجتمع الإسلامي، وهم الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل، فهي في الواقع ضريبة على الأغنياء تدفع للفقراء، ولا نعني بالأغنياء ذوي الثروات الكبيرة، وإنما كل من عنده مال زائد عن الحاجة، فالزكاة عامل من أهم عوامل توزيع الثروة وانتقالها بين أيدي الشعب، وهي عامل كبير من عوامل نشر الألفة والمحبة بين الناس وهو ما يحرص عليه الإسلام، ولذلك فالزكاة ضريبة من نوع خاص[11].
أما الضرائب التي تؤدى، فإنها تدفع في مقابل الخدمات العامة التي يعود نفعها على دافعيها وغيرهم، لصيانة الأمن الداخلي والدفاع الخارجي، وإقامة العدالة وتمويل المرافق الصحية والتعليمية، وإنشاء الطرق، وهي ضرائب موجودة في كل الدول التي تدين بديانات مختلفة، أما الزكاة فهي ضريبة خاصة تبقى بعد هذا شريعة من شرائع الإسلام وحكما من أحكامه لرعاية جانب كل ضعيف في المجتمع تحقيقا للتكافل الاجتماعي الذي ينشده الإسلام.
ثانيا: نفقات الدولة الإسلامية
يمكن إجمال هذه النفقات في ثلاثة عناصر، وإن كانت مصاريف الدولة الإسلامية متنوعة:
- فإيراد الدولة من ضريبة الأرض والرؤوس وأموال التجارة، تجارة أهل الحرب والذمة، كان يوجه للنفقات في المصالح العامة كرواتب الخلفاء، والولاة، والقضاة، والجند، وبناء القناطر وإقامة الجسور، وسد الثغور، وحفر الترع، وإصلاح الأنهار، ونحو ذلك.
- أما إيراد الزكاة فكان ينفق في النواحي التي ذكرت في الآية الكريمة ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم﴾ (التوبة: 60).
- أما إيرادات خمس الغنائم فكان يوجه للإنفاق على الجهات التي ذكرت في قوله تعالى: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾ (الأنفال: 41).
من هنا نستطيع القول بأن مالية الدولة الإسلامية كانت عبارة عن ثلاثة أبواب، لكل واحد من هذه الأبواب دخل وإنفاق خاص، فلا يجوز الجمع بين بند وآخر. وفي هذا الصدد يذكر أبو سيف أنه “لا ينبغي أن يجمع مال الخراج إلى مال الصدقات والعشور”[12]. كما أنه لا يجوز أن يصرف إيراد أحد البنود في مصرف آخر[13].
وإلى جانب هذه النفقات التي هي مقيدة بنصوص قرءانية، كانت الدولة الإسلامية تتولى الإنفاق على متطلبات الصحة والتعليم، فاتسم إنفاقها بالعدالة الاجتماعية وتحقيق الرخاء للأفراد والجماعات.
وهكذا رصدت نفقات ضخمة للتعليم فجند الفقهاء وفتحت المساجد ودور العلم، كما هيئت إمكانات البحث العلمي، وكل ذلك مكن الأمة الإسلامية من أن تكون أمة العلوم والمخترعات وأمة حضارة ورقي وازدهار.
أما نفقات الصحة العامة، فقد كان نصيبها كبيرا أيضا، إذ تستلزم التعاليم الإسلامية نظافة الأجساد والأماكن، كما تستلزم الوقاية اللازمة من الأمراض ومكافحة الأوبئة وعلاج المرضى وكل ذلك يتطلب من بيت مال المسلمين مصاريف كثيرة لم تبخل بها الدولة الإسلامية على أفراد مجتمعها، مسلمين وغيرهم [14].
هذا وقد أوجد الإسلام قوانين لنفقات التكافل الاجتماعي يتجلى في الآتي:
أ. المدين: إذا لزمت المدين الديون بسبب التجارة أو غيرها ولم يستطع دفع ديونه، عن حسن نية، (وكان في حالة إفلاس) فإن ديونه تسدد نيابة عنه (من بيت المال).
ب. القاتل: إذا قتل خطأ، فإن دية القتل لا يتحملها وحده بل تتحملها عاقلته وهم عصبته من أقربائه…
ج. المنقطع: المنقطع في بلد غير بلده، ويسمى “ابن السبيل” فيعان حتى يصل إلى بلده ولو كان فيها غنيا.
وهناك قوانين للإنفاق لا تجب على الدولة، وإنما تجب على أفراد الدولة الإسلامية تتجلى في النفقة على الضيف فهي واجبة ثلاثة أيام وما بعدها يكون صدقة، وقانون المشاركة الذي يعني انه حين وقت المواسم الزراعية، فإن من حق المواطنين الذين لا يجدون ما يشترون به الثمار إبان قطفها لغلائها أن يأكلوا منها من غير ثمن[15]. وهناك قانون الماعون وهو كل ما ينتفع به من شؤون البيت أو الحقل ويستعيره الناس فيما بينهم كالقدر والدلو وأمثالها[16]. وهناك قانون الإعفاف: فالزواج واجب على القادر عليه فإن كان فقيرا لا يجد نفقات الزواج وجب على قريبه الموسر تزويجه كما يجب عليه نفقة طعامه ولباسه وسكناه. وهناك قانون الإسعاف: ويعني أنه إذا جاع إنسان أو عطش أو مرض بحيث أشرف على الهلاك، وجب على من يعلم بحاله أن يبادر إلى إنقاذه، فإن كان فضل من طعام أو شراب أو دواء أو مال يدفع به الهلاك عن ذلك الإنسان وجب أن يدفعه إليه، فإن امتنع كان لذلك المضطر أن يأخذه منه بالقوة ويقاتله عليه.
ومن أهم قوانين الإنفاق لتحقيق التكافل الاجتماعي يوجد قانون الطوارئ أو (القروض الإجبارية) بالمفهوم الحديث للمالية. إنه إذا أصبح العدو يهدد سلامة البلاد، ولم يكن في خزينة الدولة ما يكفي للإنفاق على الجيش وتجهيز المقاتلين وشراء السلاح، وجب أن تأخذ الدولة من أموال الناس بقدر ما يندفع به الخطر، وتأمن الأمة على أرواحها وأموالها واستقلالها لأن الجهاد، في تلك الحالة، واجب بالمال والنفس على كل مستطيع وحق الإنسان في استبقاء ماله بيده يصبح باطلا في الوقت التي تكون بلاد الإسلام مهددة والدولة في حاجة إلى المال وقد وقع في التاريخ الإسلامي تنفيذ قانون الطوارئ عدة مرات.
وعندما تحل الكوارث العامة كالفيضانات والزلازل والمجاعة وأمثالها فإن من واجب الدولة أن تسعف المنكوبين، لا بالخيام والدقيق فحسب، بل بتمكينهم من الحياة الكريمة التي يحياها سائر الناس، ولما كانت خزينة الدولة تعجز في الغالب عن القيام بهذا الواجب الاجتماعي نحو المنكوبين فإنها تستطيع أن تفرض ضرائب خاصة لهذه النكبات تستوفيها من الأغنياء كل حسب ثروته، فلما كان عام المجاعة في عهد عمر أرسل إلى ولاة الأمصار ليمدوه بالطعام والأموال فأرسل له كل وال ما استطاع إرساله وكان هذا الطعام يوزع على المحتاجين بالمساواة.
وقد لا يتسع هذا البحث استيعاب كل الموضوعات التي تتعلق بنفقات التكافل الاجتماعي، ولذلك نكتفي بالإشارة إلى أن هناك عدة قوانين، منها قانون الوقف، وقانون الوصية، وقانون الركاز، وقانون النذور، وقانون الكفارات، وقانون الأضاحي، وقانون الكفاية، وهي قوانين تفرض الإنفاق على الفرد المسلم إما لأخيه المحتاج أو لبيت المال الذي يقوم بدوره بإنفاقها في النواحي المخصصة لها بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية.
هل عرف الإسلام نظام الضرائب والميزانية؟
يعتقد بعض خبراء المالية العامة ولاسيما الأوربيون منهم أن الشريعة الإسلامية والفقه المتفرع عنها لا يتضمن مفهوما للنظام الضرائبي وبالتالي مفهوما للميزانية، ويوجد على رأس هؤلاء الأستاذ الفرنسي مارك لوز Marc loze الذي أصدر كتابا بعنوان مالية الدولة: جاء فيه: “يعترف المؤرخون أن موسوعات الحقوق الإسلامية لا تتضمن أي عرض للمسائل الضريبية، لأن المفهوم الضريبي، وفقا للمفهوم المغربي، إنما هو مفهوم غريب إطلاقا بالنسبة للإسلام… فهو لا يتضمن أي مفهوم للميزانية، كما أن المصادر الضريبية متعددة، وتسمح بشكل خاص لتمويل الحملات العسكرية…”[17] وقد رد الأستاذ خالد عيد في رسالته الجامعية[18] على ادعاءات هذا الكاتب، فحلل كل فقرة من فقرات رأي البروفسور مارك لوز حيث قال:
- إن الأستاذ لوز، لم يقدم لنا كمثل، أيا من هؤلاء المؤرخين.
- نحن يكفي أن نقدم (للبروفسور لوز) ما ورد في كتاب المؤرخ الألماني كارل بروكلمان: “تاريخ الشعوب الإسلامية” الذي تكلم فيه عن مالية الدولة، في عهد المقتدر الذي يعتبر عهد انحلال الخلافة، حيث يذكر بأن سنوية الميزانية وتقسيمها لأبواب الواردات والنفقات كان معروفا لدى الجهاز الإداري في الدولة الإسلامية في عهود انحلالها وضعفها وتقطع أوصالها فبالأحرى أن تكون هذه المفاهيم موجودة في عهد قوتها…ثم يشرح بروكلمان مصادر إيرادات الميزانية فيقول: “بينما كان العراق يقدم لخزانة الدولة من طريق الخراج، والرسوم المفروضة على الملاحة والأنهار والمكوس 1.547.734 دينارا، والولايات الشرقية تقدم 6.213.283 دينارا، مصر وسوريا تقدمان 4.746.492 دينارا، كان الخليفة يكتفي برقم إجمالي لا يتجاوز 4.746.492 من أذربجان وأرمينيا تضاف إلى هذا كله 1.768.015 دينارا من موارد الضياع والأوقاف…
أما قول مارك لوز: فإن المفهوم الضريبي وفقا للمفهوم الغربي، إنما هو مفهوم غريب إطلاقا بالنسبة للإسلام، فإن هناك ما يدحض هذا القول، فإذا ما أردنا أن نعرف الضريبة في المفهوم المالي الحديث فإننا نعرفها بأنها “فريضة من المال تستأديها الدولة أو السلطة المحلية من الأفراد القاطنين في ديارها على قدر يسار كل مكلف، لتمكينها من أداء المرافق العامة التي تضطلع به”[19].
فإذا أخذنا هذا التعريف وسرنا نطبقه على موارد الدولة الإسلامية نجد أن الزكاة ضريبة وكذلك الجزية والخراج وعشور التجارة، والقطائع، لأنها جميعها متكررة ومتجددة في أوقات معينة على المسلمين، ومن تمتع بحماية الإسلام، وقد فرض بعضها عن طريق القرءان والبعض عن طريق الإجماع، وقد تكفل التشريع الإسلامي بتحديد الأنصبة، مقادير الضرائب، والأشخاص المكلفين بدفعها، وكيفية ذلك، ووقت التحصيل، وأوجه النفقات، وأبواب الصرف الواجب على الدولة القيام بها، أما ما عدا ذلك من الموارد:
كخمس الغنائم، وتركة من لا وارث له، فهذه لا يشملها معنى الضرائب، لعدم دوام المورد، ولعدم نص تشريعي يقضي بهذا التجدد والتكرر في مواعد منتظمة[20].
فمن التحليل الذي قدمناه يمكن القول بأن القواعد التي التزمها علماء المالية في شأن الضريبة توجد في قواعد المالية الإسلامية، فالعدالة التي ذكرها علماء المالية الحديثة هي مطلب الشارع الحكيم حيث قرر المساواة في الأموال والأفراد، لا فرق بين شخص وآخر، وهكذا فلم يعف من الضريبة إقطاعي أو رئيس أو أمير أو نبيل كما كانت تفعل بعض الشرائع الوضعية مما أشعل لهيب بعض الثورات كالثورة الفرنسية التي كان من أسبابها عدم المساواة في فرض الضرائب فضريبة الزكاة، التي هي نوع خاص، إن كمل نصابها المحدد لها أخذ منه الواجب بنسبة ميسورة وإلا فالعفو، والجميع في ذلك سواء.
وكذلك ضريبة الجزية، لا يطالب بها إلا الموسرون القادرون على الأداء وكل على قدر يساره واحتماله. فقد روى أبو يوسف في كتابه الخراج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مر بباب قوم وعليه سائل يسأل، وكان شيخا أعمى ويبدو عليه أنه ذمي فضرب عمر بعضده وقال من أي أهل الكتاب أنت؟ فقال يهودي، قال ما ألجأك إلى ما أرى؟ قال أسأل الجزية والحاجة والسن، فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله وأعطاه شيئا مما عنده ثم استقدم خازن بيت المال وقال له انظر هذا وضرباءه، فوالله ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم وقال رضي الله عنه: “إنما الصدقات…”[21] وإذا كانت آراء المالية الحديثة تميل في معظمها إلى الأخذ بنظام تعدد الضرائب لما فيه من عدالة اجتماعية واقتصادية، فإننا نجد الإسلام قد بنى نظامه المالي على أساس تعدد الضرائب حتى تقوم كل واحدة منها بنصيب من العبء المشترك. ولم يقصر مؤنة الدولة المالية على ضريبة واحدة لما في ذلك من المساوئ والعثرات التي فيها عرقلة الحياة الاقتصادية، وإرهاق الأفراد، وارتفاع تكاليف الجباية.
والإسلام، أيضا، كان سباقا إلى الأخذ بنظام عدم ازدواج الضريبة، بمعنى ألا يلزم المكلف الواحد بدفع الضريبة أكثر من مرة عن نفس المال لنفس السبب وعن نفس المدة. وهكذا نجد الرسول، صلى الله عليه وسلم، يقول: “لا ثنى في الصدقة” ومن أوجهه أن لا تؤخذ الصدقة عن عام مرتين[22].
والإسلام طبق فكرة شخصية الضريبة، بمعنى أنه أعفى الحد الأدنى اللازم للمعيشة حيث قرر أن لا تفرض الزكاة إلا إذا بلغ المال نصابا، ونصابا فائضا عن الحاجات الأصلية ولم تقتصر هذه على الطعام والكسوة، وإنما امتدت أيضا إلى الدين، لأن المشغول بالدين مشغول بالحاجة الأصلية.
كذلك قال علماء المالية إن الوعاء الذي تغترف منه الدولة ضرائبها لابد أن يكون وعاءً واحدا هو المال الذي في حوزة الأفراد. أما الضرائب الشخصية التي توضع على الرؤوس فهي من مظاهر عصور البداوة الغابرة[23].
فإذا نظرنا إلى ضريبة الزكاة والخراج والعشور، ألفينا أن هذه الضرائب ليس لها إلا وعاء واحد هو المال الذي في حوزة الأفراد، أما ضريبة الجزية فحقيقة هي ضريبة شخصية، وضعت على رؤوس أهل الذمة ولكن باعتبار ما يملك الفرد من الثروة فكأنها في الواقع موضوعة على المكلفين باعتبار ما يملكونه من المال، بدليل أن الفقير المعدم من أهل الذمة أعفي من هذه الضريبة، فلو كانت على الرؤوس، بغض النظر على الثورة، لما سقطت عن الشخص العاجز.
هذا وإذا أردنا أن نقيم مقارنة بين بناء النظام الضريبي في الشريعة الإسلامية وفي التشاريع الوضعية، نجد بأن الضرائب في النظام المالي الإسلامي كانت كما في النظام المالي الوضعي على نوعين، ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة.
فكانت الضرائب المباشرة تتجلى في الخراج والزكاة بجميع فروعها وعشور التجارة، والجزية، وعلى رأس المال حيث تؤخذ من الدخل المنتظر نتاجه والضرائب الإسلامية تتمثل فيها الضريبة العينية وهي التي تصيب المال دون نظر إلى الشخص المكلف كالزكاة، وضريبة عينية وهي التي تربط بالعين كالخراج.
أما الضرائب غير المباشرة، فتتجلى في العشور وفي ما يفرضه النظام الإسلامي في المعادن والركاز، وقد أفتى الشافعي بأن للإمام أن يزيد في المأخوذ عن العشور وأن ينقص عنه إلى نصف العشر، وأن يرفع عنهم إذا رأى فيه مصلحة، وهذا أحدث ما وصلت إليه التنظيمات المالية الحديثة في نطاق الضرائب غير المباشرة ولاسيما ضرائب الجمارك[24].
هذا كل ما يتعلق بالنظام المالي الإسلامي ومقارنته بالأنظمة المالية الحديثة في باب الموارد، ولكن ألا يحق لنا أن نقيم بعض المقارنات بين الشريعة والمالية الحديثة في باب المصارف، فقد رأينا مما تقدم في هذا البحث عند الحديث عن النفقات، أن المصاريف العامة التي كانت تقوم بها الدولة الإسلامية في مرافقها العامة لا تخرج عن كونها رواتب ومعاشات للعمال والجند إلى جانب الإنفاق على المرافق العامة وموظفيها، فإن نظام الدولة الإسلامية جعل للموظفين رواتب وأعطيات ومعاشات، ولذلك فإن إيرادات الدولة الإسلامية كانت تصرف لسداد حاجات الكافة ومصالح الجميع، ولم تخصص حصيلتها لتغذية المنافع الفردية أو تؤثر طائفة على أخرى أو إقليما على آخر لأنه أكثر موردا أو أجزل إخراجا، فإيراد الخزينة كما ذكرنا وكذلك الخراج قد خصص لأعطيات الجند والولاة والقضاة وما يلزم الدولة، كالأسلحة ومعدات الجهاد ونحو ذلك، وإيراد الصدقات يتناول الإحسان العام للمعدمين، ومنح الهبات، ولبعض الأفراد الذين يقدمون للدولة خدمة نافعة سياسية أو دينية وكذلك خمس الغنائم[25].
إننا باختصار نقول بأن الإسلام وضع الأسس الحديثة للنظام المالي الإسلامي، هذه الأسس التي لا زالت تهتدي بها التشريعات الوضعية الحديثة[26].
إنه نظام رتب أصوله ونظم قواعده عمر بن الخطاب، فلو أنه استقر في العالم وانتظمت به الحياة لتبدلت الإنسانية ولانهارت المبادئ العميقة، وقامت المبادئ الإسلامية التي توجه العالم إلى الخير، وتوصل الناس إلى السعادة ومحو الشقاء المتمثل في الربا والقمار وأكل أموال الناس بالباطل[27].
خاتمة
ونختم هذا البحث بما قاله الدكتور بدوي عبد اللطيف عطية في كتابه “النظام المالي المقارن”: “إن الإنسان إذا أراد الموازنة بين النظام المالي الإسلامي، والأنظمة المالية في الدولة الحديثة، والشرائع المختلفة، لحكم في اطمئنان بأن النظام المالي الإسلامي لا نظير له في حضارة من الحضارات ولم يأت حتى اليوم ما هو خير منه في أي عصر من العصور”[28].
فالأمل معقود على الشباب المسلم العامل في الحقل المالي أن ينهل من معين شريعته ففيها كل خير وبركة، فالسياسة المالية التي وضعها الإسلام، سياسة حكيمة تنبني على عدالة اجتماعية تامة، والنظام المالي الإسلامي نظام متكامل رأينا جوانبه من خلال المقارنات البسيطة التي قمنا بها في هذا البحث، فما على أبناء الأمة الإسلامية إلا أن يرجعوا إلى الأصل الأصيل وينهجوا في معاملاتهم وتجاراتهم وسلوكهم نهجا مستمدا من أحكام الشريعة الإسلامية – شريعة المستقبل بحول الله.
ذ. عبد الرحيم بن سلامة

(العدد 8)
الهوامش
- صحيح مسلم، الجزء الثالث، ص99.
- المصدر نفسه.
- رواه البخاري في صحيحه.
- راجع البحث الذي نشرناه بمجلة (دعوة الحق) العدد الأول السنة الثانية عشرة دجنبر 1969 ص175 حول “المساواة في الإسلام” وكذلك يمكن الرجوع إلى كتاب أبي الأعلى المودودي “نظام الحياة في الإسلام” ص61، التي نقتطف منها هذه الفقرات: “إن الإسلام لا يقول بالمساواة في الرزق، وإنما بالمساواة في فرص العمل والجد والسعي في اكتساب المعاش والتماس الرزق.
- لقد نشرنا بحثا موسعا عن الربا والفائدة في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، يمكن الرجوع إليه بمجلة (دعوة الحق) العدد الثاني، السنة الحادية عشر، (رمضان 1387ﻫ/دجنبر 1967)، ص118.
- من أراد التوسع في هذا الموضوع عليه أن يرجع إلى كتاب “الإسلام وأهل الذمة” للدكتور علي حسني الخربوطلي، مطبوعات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة.
- أي سرعة السير والركاب (راجع كتاب النظم الإسلامية للدكتور حسن إبراهيم حسن، ص232).
- انظر: أبو يوسف، الخراج، ص123.
- دائرة المعارف الإسلامية، المجلد الرابع، ص1202.
- راجعابن حزم، المحلى، ص218.
- راجع البحث الذي نشرناه بمجلة المنهل السعودية حول موضوع: “النظام المالي في الدولة الإسلامية”، العدد 11 السنة 36، ص8.
- الخراج، م، س، ص80.
- راجع الأحكام السلطانية للماوردي ص122 وكتاب النظام المالي المقارن للدكتور بدوي عوض طبعة 1971 ص102.
- نفقات الدولة الإسلامية بحث للدكتور إبراهيم دسوقي أباظة نشر بمجلة التضامن الإسلامي، السلسلة الأولى العدد العاشر مايو 1973.
- راجع كتاب اشتراكية الإسلام للدكتور مصطفى السباعي ص 46.
- تفسير ابن كثير الجزء الرابع ص 555.
- راجع كتاب مالية الدولة لمارك لوز ص 252
Les finances de l’état par marc lozc lze) p.252..
- العدالة الضريبية في التشريع الضريبي المغربي ص 62 وهذا كتاب عبارة عن رسالة جامعية تقدم بها الأستاذ خالد عيد إلى كلية الحقوق بالرباط عام 1972 لنيل دبلوم الدراسات العليا.
- مالية الدولة للدكتور إبراهيم أباظة ومبادئ المالية العامة للدكتور عبد العال العكبان الجزء الأول ص 120.
- الإسلام المالي المقارن للدكتور بدوي عوض ص 124.
- راجع نص المحاضرة التي ألقاها الدكتور علي عبد الواحد وافي في الملتقى السادس للتعرف على الفكر الإسلامي بعنوان موقف الإسلام من الأديان الأخرى التي نشرت في الجزء الثاني من سلسلة محاضرات الملتقى ص 403.
- الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام فقرة 918 ص 375.
- مبادئ علم المالية العامة للدكتور فوزي الجزء الثاني ص91 ومالية الدولة للدكتور إبراهيم أباظة دسوقي ص 214.
- النظم الإسلامية للدكتور حسن إبراهيم حسن ص285.
- نظام الضرائب بين القانون والإسلام للدكتور محمد كمال الجرف ص 266.
- كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام فقرة 119 ص45.
- النقد الذاتي للأستاذ علال الفاسي، ص 198. وكذلك يمكن الرجوع إلى كتاب الربا والفائدة للقاضي علاء الدين حزوفة مطبوعات جامعة البصرة العراق.
- بدوي عطية، النظام المالي المقارن، بدوي عطية، ص143