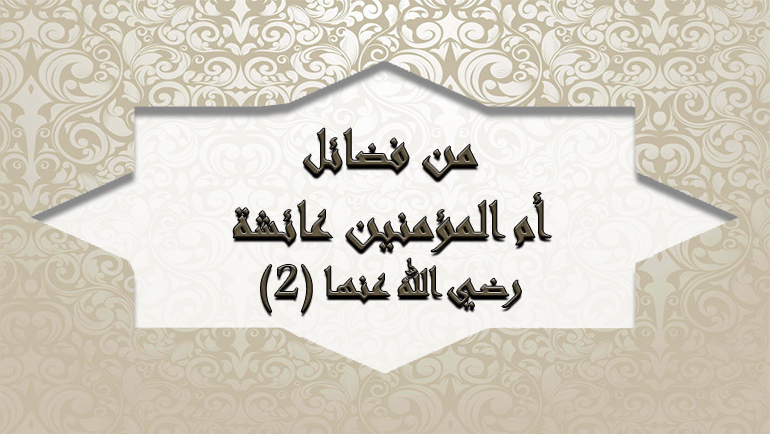أقبلتُ على تجربة مدخل “رؤية العالم” في مقاربة المنظومة القيمية في القرآن الكريم، لأول مرةٍ في ندوة الرابطة المحمدية للعلماء بالدار البيضاء قبل خمس سنوات. ورؤية العالم Weltanschauung وردت في التعبير عند “إيمانيويل كانط” (-1804)، لكنها صارت نظريةً لدى “فلهلم دلتاي” (-1911). وقد صارت تعني لدى معتنقيها التصورات الأساسية لدى الأفراد والجماعات للخير والشر، والحق والباطل، والصالح والطالح، والحسن والقبيح، أو ما يسميه المسلمون أحياناً المعروف والمنكر.
أما في المجال العملي وأحياناً الفردي، فيُعنى هذا المصطلح بمتطلبات التلاؤم بين التصورات الأساسية أو الكبرى واحتياجات الأفراد والجماعات الصغيرة والبيئات القريبة. وهو ما جرى الاصطلاح على تسميته بالأخلاق. وبالطبع هناك فروقٌ بين القيم والأخلاق المعنية حصراً بالجوانب السلوكية.
لكنْ إذا أردْنا هنا تجاوُز هذا المبحث التفصيلي، والبقاء في الجوامع الكبرى لرؤية العالم هذه لدى المسلمين؛ أي الجوامع الشاملة للقيم والأخلاق معاً، فإننا نجد ذلك في مئات الآيات القرآنية التي تربط بين الإيمان والعمل الصالح أو الأخلاقي: “الذين ءامنوا وعملوا الصالحات”. وبهذا المعنى فإنّ الإيمان بالله هو في جانبٍ رئيسيٍّ فيه رؤيةٌ قيميةٌ للعالم، ويترتب عليه العملُ الأخلاقي أو العمل الصالح.
وبالطبع أيضاً ما كنتُ منفرداً ولا مكتشفاً في هذا المجال. فقد سبق للباحث الياباني “توشيهيكو إيزوتسو” أن اعتبر صورة الله، عزّ وجل، في القرآن، وفي الديانات الإبراهيمية الأُخرى صورةً أخلاقية. وقد قصد إيزوتسو من ذلك أمرين: سواد فكرة الخلاص، وأنّ الإيمان بحد ذاته (بالله واليوم الآخر) يترتب عليه الحساب والثواب والعقاب، وهي جميعاً مسائلُ أخلاقيةٌ في اعتبار المتدينين.
والذي أراه أنّ توجُّه وتوجيه إيزوتسو صحيحٌ في الأساس، لكنه قد يوصل لنتائج حسابية. وهذا أمرٌ حاوله المسلمون الأوائل أو كثيرٌ منهم فأفضى إلى مشكلاتٍ ما استطاعوا تقدير عواقبها في البداية. وأنا أقصد بذلك ما صار يُعرف بمبحث مرتكب الكبيرة. فقد دار حوله خلافٌ شديدٌ بين أهل الفِرق الكلامية في القرنين الثاني والثالث للهجرة. وقد انتهى الأمر بمفكري الجماعة للقول إنّ العمل الصالح لا يترتب على الإيمان بصورةٍ ميكانيكية. وهكذا فإنّ القيمة ليست ذات معنًى حسابي حصراً، بل هي في صورتها البدئية أو الاعتبارية الكبرى ذات أبعاد احتسابية. وهذا الأمر أو هذا البُعْد الفارق هو الذي اكتشفه أو كشف عنه شيخُنا محمد عبد الله دراز قبل إيزوتسو في أُطروحته عن الأخلاق بل القيم في القرآن (1948).
إنّ أهمية مقاربة كلٍّ من دراز وإيزوتسو، أنها مقاربةٌ تأويلية؛ أي أنها تُواصلُ تقليداً عريقاً وتُجدِّد فيه استناداً للاستجابات الممكنة للكون المسطور على الكون المنظور. وقد كانت لها عندهما أسبابٌ معرفية وليست نقدية. أما عندي وعند الآخرين الذين اجترحوا هذا النهج التأويلي في السنوات الأخيرة؛ فهي إجابةٌ نقديةٌ على القطائع من كلِّ وجهٍ، والتي قالت وتقول باستحالة التواصل مع كلِّ الموروث أو التقليد، وسواء أكان نصوصاً أو وجوهَ فهمٍ أو مقولاتٍ أو جماعات ذات تجربة تاريخية، تبحث عن مشروعية وجودٍ في هذا العالم.
واستناداً إلى هذا التمهيد، سأقوم بعرض نظرةٍ تواصليةٍ وتأويليةٍ للمنظومة القيمية في القرآن. لألتفتَ بعد ذلك إلى مسارات التفكير بشأنها في الزمان التاريخي، وأخيراً إمكانيات التدبير في الزمن الراهن.
أولا
تحكُمُ نظرتنا للمنظومة القيمية في القرآن، إذن، ثلاثة أمور:
أولها؛ أنها تتبع منهج رؤية العالم الذي سبق التعرض له، وهو يعتمد في مجال النصوص على الأبعاد السيمانطيقية، والدلالية للمصطلحات المفتاحية.
وثانيها؛ أنّ المجال السياقيَّ لتأمُّل تكوُّن المنظومة وانتشارها هو حواريةُ النص مع الجماعة ونخبها العالمة في التاريخ.
وثالثُها؛ أنها تتجنب في هذه العجالة التحاور أو التناقش مع الآراء والاستطلاعات والاختيارات الأُخرى، بسبب اختلاف المنهج أو اختلاف النظرة، إلى العلائق بين الدين والحضارة والقيم الحاكمة أو السائدة.
واستناداً إلى هذه المحدِّدات المنهجية والدلالية والسياقية، كنتُ قد استظهرتُ في محاضرتي بالرابطة المحمدية أنّ المنظومة القيمية/الأخلاقية في القرآن تتركز مصطلحاتها المفتاحية في ستَّة مفاهيم: المساواة، والكرامة، والرحمة، والعدالة، والتعارُف، والخير العام.
أمّا مفهوم المساواة فيتركزُ في القرآن الكريم حول الخَلْق من نفسٍ واحدة. ويتضمن ذلك التساوي أمام الله سبحانه وتعالى، والتساوي والتماثُل في مادة الخلْق ﴿خلقكم من تراب﴾، والتماثل في المبادئ والمصائر، وتساوي الناس فيما بينهم في القيمة الإنسانية، والتماثُلُ أخيراً في التفضيل على الكائنات الأُخرى. وإذا كان الخَلْقُ الواحدُ من كلِّ وجهٍ واقعاً لا يمكن الخروج عليه فيما يتصل بالعلاقة بالله عز وجل؛ فإنه يتحول إلى قيمةٍ عندما يصل الموضوع إلى العلاقة بين بني البشر.
فالسواسيةُ أمام الله هي في وجهها الدنيوي القيمي والاجتماعي والسياسي سواسيةٌ ينبغي أن يُسعى إليها، وأن تسودَ في نظرة كلِّ إنسانٍ إلى الآخر. فالتألُّهُ في مواجهة الله، عز وجل، مرفوضٌ لأنّ العلاقة تقوم على التمايُز والافتراق. والتألُّهُ تُجاه الآخرين من الناس مرفوضٌ قيميّاً؛ لأنّ العلاقة تقوم على التماثُل والتساوي من كلّ وجه. وتأتي الفضيلةُ هنا من مواجهة نوازع التمايُز إبقاءً على سوية إنسانية الإنسان التماثُلية. وعلى بلوغ فضيلة الإقرار بالتماثل رؤيةً وعملاً تترتب الفضائل الفرعية المشتقّة مثل: الإنصاف وحُسْن التعامُل والتواضُع.
وهكذا فأُمُّ الكبائر أو المُنكرات المُقابلة لقيمة المساواة هي رذيلةُ الكِبْر، التي قد تصلُ إلى التطاوُل على الله، عز وجل، بالإنكار أو ادّعاء المُماثلة. فتكون لهذه الجهة ناجمةً عن الخروج على قيمة المُساواة بين بني البشر، حتى لو اعتبر المتكبّر نفسَه مؤمناً بالله عز وجل؛ إذ إنّ الرذيلة هذه تؤدّي حكماً إلى الكبيرة الأولى: التطاوُلُ على الله أو إنكارُه.
أمّا القيمة الثانيةُ في المنظومة القيمية القرآنية فهي الكرامة، وعمادُها الآيةُ القرآنية في سورة الإسراء: “ولقد كرّمنا بني ءادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضّلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا”؛ فالكرامةُ بحسب الآيات القرآنية في الأصل بالعقل، وترتبت عليها الكراماتُ والمسؤولياتُ الأُخرى من مثل: الاستخلاف وتسخير الموجودات والكائنات الأُخرى، والإقدار على ممارسة تدبير العالم وإعماره. أمّا الأمرُ الرابعُ في مربَّع الكرامات هذا فهو الحُرْمة، والتي ينبغي أن تسودَ بين بني البشر في حق الفرد الإنساني. فإذا كان العملُ الصالحُ أو المُصْلِحُ الذي يقومُ به الإنسانُ المستخلَفُ ضرورياً لعُمران العالَم وازدهاره؛ فإنّ الحُرمة، وهي حقوقٌ للبشر تُجاه بعضهم بعضاً، تُسهمُ في تمكين الإنسان من القيام بحقوق العقل والفرد والجماعة على حدٍ سواء.
ونحن نعلم أنّ الفقهاء المسلمين عندما بحثوا “مقاصد الشريعة”، وأقاموها على الضرورات أو المصالح الخمس إنما اشتقّوا ذلك من مفهوم الحُرمة، وتناولت تلك المصالح الضرورية: النفس أو الحياة، والعقل، والدين، والنسْل، والمِلْك. واختار الفقيه التونسي الطاهر بن عاشور تسمية هذه المصالح أو الحُرُمات بالحقوق، وجعل منها حقَّ الحرية؛ لكنّ ذلك، كما هو معروفٌ، كان في زمنٍ آخَر.
والقيمة الثالثةُ في المنظومة القرآنية للقيم هي الرحمة. والآيتان المركزيتان لهذه الدلالة: ” كتب على نفسه الرحمة” (الأنعام: 12)، “كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ” (الأنعام: 55)، “وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ” (الأعراف: 156). ولنتأمَّل الفعلين: كتب ووسِعَ؛ لأنهما يجعلان من الرحمة صفة لله، عز وجل، صِفةَ قدرةٍ وإقدار في مُعاملة عباده من بني البشر، ومن ذلك بحسب الآيات القرآنية: إرسال الرسل لهداية البشر. ثُمَّ إنها تتحول رأساً لتُصبح القيمة العليا والأخلاق العُليا في تعامُل الإنسان مع والديه وأولاده وأقرانه من بني البشر.
وإذا كانت مفاهيم الرحمة والنعمة والعناية صَفاتٍ له عز وجل في مُعاملة مخلوقاته؛ فإنها ترد في القرآن تارةً باعتبارها معطىً فطرياً لدى الإنسان، وطوراً باعتبارها قيمةً يكونُ على البشر في رؤيتهم وسلوكهم أن يسعَوا لبلوغها.
أما القيمة الرابعةُ في النظام القيمي والأخلاقي القرآني فهي العدل أو العدالة، وهي في الأصل صفةٌ لله عز وجل؛ بيد أنّ مواردَها القرآنية تعتبرها غالباً قيمةً وخُلقاً في التعامل بين الناس.
وهي قيمةٌ؛ لأنّ سياقات الورود في القرآن تعني النظرة الصحيحة أو المنصفة إلى المسائل والأشياء، كما تعني السلوك السليم في معارض ومواردَ أُخرى. وقد جمعت الآية رقم 13 في سورة الشورى بين الأمرين القيمي والخُلُقي: “فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آَمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ”.
وهكذا، فهناك ثلاثة اعتبارات تتعلقُ كلُّها بالعدالة بوصفها قيمةً وبوصفها خُلُقاً وفضيلةً عملية: الاستقامةُ في النظرة إلى الأُمور، والعدلُ في النظرة إلى عقائد أهل الكتاب باعتبارها قيمةً مشتركةً لا تخضع للتجاذُب والمُجادلة، وأخيراً العدلُ في الحكم بين الناس بالمعنى الإنساني وبالمعنى القضائي.
والقيمة الخامسة في النظام القيمي القرآني هي التعارُف بالمعروف، والآيةُ المركزيةُ هي المشهورةُ في سورة الحجرات: الآية 13 “يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ”. والتعارُفُ بحسب المفسِّرين ليس الإقبال على الحوار رغم الاختلاف أو بسببه وحسْب؛ بل هو تناظُرٌ ونديةٌ أيضاً، ولقاءٌ على قدم المساواة أيضاً، كما هو واضحٌ في عدة آياتٍ أو معارض.
فالتعارُف يعني قيمة الثقة أو أخلاق الثقة، وهو المعنى الكبير للدين ذاتِه؛ بيد أنّ هذا المعنى الذي يتكرر بهذه الصيغة وفي معارضَ مختلفة ستَّ مراتٍ في القرآن، لا يُحاط بأبعاده إلاّ إذا ربطناه كما ربطه القرآن الكريم بمفرد أو مفهوم العُرف والمعروف الذي يتكرر في القرآن مئات المرات مقروناً في الغالب بمقابِله أو مُضادِّه؛ أي المنكَر. فالمعروف مشتركٌ ومُتعارَفٌ عليه بين الناس، أو ينبغي أن يكون كذلك. والمنكَر، أو تلك الرذيلةُ المستنكَرة، ضروري الاجتناب والإنكار.
فالتعارف قيمةٌ وثقةٌ، والمعروفُ قيمةٌ وخُلُقٌ وسلوكٌ دينيٌ وإنساني.
والقيمة السادسةً والأخيرة مما استظهرتُه من المنظومة القرآنية، هي الخيرُ العام. والخير لدى المفسرين واللغويين يعني القصدَ الساميَ والرفيعَ، ويعني اختيار الأعلى والأفضل والأحسن والأشقّ على النفس والمصلحة بين قصدَين أو قولين أو فعلَين فاضِلَين. وهذا المفردُ هو الأكثر ذكْراً ووروداً في القرآن بعد قيمة الرحمة ومشتقاتها ومُرادفاتها، وبالنظر لمعارض الورود.
فالخير تارةً هو فعلٌ لله عز وجل، مثل: بيدك الخير. وهو تارةً إيثار للأحسن والأفضل على الحسن والجميل، من مثل: “إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُم” (الأنفال: 19)، ومن مثل: “خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ” (المجادلة: 12). وهو تارةً منافسةٌ حميدةٌ مع أهل الديانات الأُخرى: “فاستبقوا الخيرات” (البقرة: 147، والمائدة: 50)، “ويسارعون في الخيرات” (ءال عمران: 114)؛ أي اختيار الأفضل والأحسن في مساعٍ متوالية أو أعمالٍ مستمرة.
والموردُ الأخيرُ الذي استظهرتُه بالنسبة لقيمة الخير أو خياره، أنَّهُ في النيَّة والمقصد أمرٌ احتسابيٌّ يُقصَدُ به في التعبير الإسلامي وجه الله، وليس الجزاء التبادُلي أو المباشر؛ من مثل: “والله خير وأبقى” (طه: 72)، ومن مثل: “ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ” (الروم: 37)، ومن مثل: “وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُون” (الزخرف: 32)؛ ولنلاحظ ارتباط الخير بالرحمة، وارتباطه حيناً آخر بالعدل أو بالكرامة أو بالتقوى. وكونه في ذروة فعاليته احتساباً.
إنّ هذا التحاوُرَ والتجاوُرَ والترابطَ في منظومة القيم القرآنية هو المعْنيُّ برؤية العالم التي تصفُ نهج أيّ ثقافةٍ أو مجتمعٍ في فهم عالمها او تكوين التصورات عنه، بتحويله إلى نَسَقٍ مترابطٍ أو متشابكٍ من المفاهيم المتعالقة في شبكةٍ صخمةٍ معقَّدةٍ أو كُلٍّ منظَّمٍ من التصورات التي يتضمنها معجم ثقافة المجتمع، بحيث يعبّر بهذه الطريقة عن كون الإنسان وأُسلوبه في إضفاء المعنى على وجوده، وفهم ما حوله وتنظيمه والتفاعُل معه.
ثانيا
كنتُ في محاضرتي بالرابطة المحمدية لعلماء المغرب، قد تتبعْتُ السياقات التاريخية لتمُّثلات نُخَب الأمة لمنظومة القيم القرآنية عبر النتاجات الفكرية والثقافية لفئتين من فئات النُخْبة العالمية هما المتكلّمون والفقهاء، وأُريدُ أن أُضيفَ هنا فئةً ثالثةً هي الصوفية. وقد آثرْتُ هذه الفئات الثلاث بالدراسة ليس فقط لأنّ أنظمتها الفكرية وشبكات مفاهيمها ظهرت في وقتٍ مبكِّرٍ؛ (أي القرنين الثاني والثالث للهجرة)؛ بل ولأنَّ الفئات الثلاث تُصرِّحُ باستمداد مفاهيمها من القرآن الكريم. إنما يكونُ علينا قبل ذلك أن نقرأ ظاهرة تلقّي النصّ الديني بهذه الطريقة.
فنحن نعرفُ أنّ النبي، صلواتُ الله وسلامُهُ عليه، ما استخلف على القرآن ديناً ولا على الأمة سياسةً وإدارةً أحداً. ونعرف أنّ فئاتٍ ادعت فيما بعد الاستخلاف السياسي، أمّا الاستخلاف الديني فما قال به أحدٌ إلاّ في تأويلاتٍ بعيدة. وهذا يعني أنّ النصَّ القرآني مضى إلى الأمة المستجيبة مباشرةً ودونما واسطةٍ من طبقةٍ كهنوتية أو إدارةٍ سياسة.
ونحن نعرف القراءات النقدية الكثيرة التي قُرئتْ بها الروايةُ التاريخية لجمع القرآن أو تدوينه. وبحسبها فإنّ أبا بكرٍ وعمر وعثمان، رضوان الله عليهم، ترددوا طويلاً في تدوين النصّ أو جمعه كما قالوا بحجة أنه فعلٌ لم يفعله رسولُ الله، صلى الله عليه وسلم، في حياته، فكيف يفعلونه هم. وعندما فعله عثمان في النهاية التزم بقدْر الإمكان بسلطة الأمة وحقّها في ذلك؛ إذ كان المشرفون على الجمع يقرأون كل آيةٍ عَلناً وينتظرون ردودَ الفعل قبل الإثبات في المصحف الذي سمّوه المصحفَ الإمام.
ولهذا سهل الحصول على الإجماع باعتبار أنَّ الجميع مشاركون بهذا القدْر أو ذاك. ونعرفُ أنّ عبد الله بن مسعود استمر على معارضته لجمع النص أو تدوينه، ليس لأنهم لم يُشركوهُ فقط. بل ولأنه رأى أنه لا شان للإدارة السياسية للجماعة بجمع النص وتدوينه، ولا محلَّ لخشية حُذيفة بن اليمان من ضياع النص لأنّ الله سبحانه يقول: “إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ” (الحجر: 9)؛ أي في صدور المؤمنين وعقولهم وذاكرتهم وعباداتهم.
إنّ هذه التجربة الجماعية مع النصّ؛ أي من فهم النبي إلى أسماع الناس وأخلادهم، هي التي طبعت بطابعها تجربة القرآن التاريخية مع جماعة المؤمنين، بل والمسلمين. وسواء أكان ذلك بالحفظ والقراءة والتعبد به في الصلوات، أو في استيعاب الجماعة له والمفسرين الأوائل لأغراضٍ تعليمية، في أعمال أو إدراك منظومته العامة من خلال المتكلمين وعلماء الأصول، أو عيش الفقهاء معه وفيه لتفعيله في حياة الجماعة، أو منافسة الصوفية للفقهاء والمتكلمين بالتفسير الإشاري المعروف.
وهكذا ما استطاعت فئةٌ من فئات المتطوعين هؤلاء الاستئثار بالنص أو احتكاره فضلاً عن السلطة السياسية بالطبع. وحتى الفئات التي ظهرت أيام الرسول، صلى الله عليه وسلم، ومنها فئة “القراء” ما استطاعت تكوين سلطةٍ لنفسها أو لمهمتها فيما يتعلق بالنص.
إنّ أول ما ينبغي ملاحظته في علاقة أو صِلة القرآن بجماعة المؤمنين والمسلمين أنه حتى بعد التدوين أو الجمع؛ فإنّ النشر ظلَّ، بالدرجة الأولى، تعليمياً وشفوياً؛ ومن الأفواه والأسماع والأخلاد إلى الأفواه والأسماع والأخلاد. بل إنّ المفسِّرين الأوائل إنما كانت مهمتهم تعليمية، ولذلك كانت تفسيراً لكلمةٍ قرآنيةٍ بكلمةٍ قرآنيةٍ أُخرى مثل تفسير العُرف بالمعروف، والرحمة باللطف، والكرامة بالحرمة أو العزة، والأمانة بالقرآن أو الدين أو الإسلام.. الخ. وهي تفسيراتٌ كان مسوِّغها أنّ الأمة أو سوادها الأعظم تلقّت ذلك التفسير بالقبول أو الترحاب. ولنتأمل الفرق بين القرآن والسنة أو حديث الرسول، صلى الله عليه وسلم، وسيرته. فالسنةُ يُعتمدُ فيها على الرواة ثقةٍ وضبطاً، ويكثر فيها الأخذ والردُّ، ولا كذلك القرآن الذي يُعتمد فيه على الذاكرة الجماعية المتلوَّة في الجماعة وفي الصلوات وخارجَها وسائر المناسبات.
إنّ القرآن أو النصّ المقروء المتلوّ (وبذلك سمَّى نفسه) تبادل منذ البداية وبأشكالٍ مباشرةٍ مع الجماعة الاحتضان فعصَمَها واعتصمت به، وهو عهدٌ لا رجعةَ فيه ولا عودةَ عنه: “الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا” (المائدة: 3).
فلنعُدْ بعد هذا التقرير والتقدير الصارم إلى كيفيات إدراك المنظومة القيمية القرآنية وتفعيلها بمناهج مختلفة، ومن جانب فئات أهل العلم أو حملته في القرنين الثاني والثالث للهجرة. وكما سبق القول سنذكر منهم المتكلمين والفقهاء والصوفية، ومسارات التفكير في النص والعيش به ومعه لدى هذه الفئات ومن ورائها ومعها الجمهور.
نحن نعرف أنّ المعتزلة وهم أقدمُ الفِرَق الكلامية الخالصة التي نملكُ عن أُصولها معلوماتٍ مقبولة، كانوا يسمُّون أنفُسَهُمْ أهل العدل والتوحيد. والتوحيد المقصودُ به تنزيهُ الذات الإلهية حتى عن الصفات. أمّا العدلُ فيعنون به، وهم لاهوتيون وليسوا فقهاء ولا فلاسفة، الدفاعَ عن صورة الله سبحانه، وليس بالدرجة الأولى عن حرية الإنسان في خَلْق أفعاله؛ إنَّما ما دام العبدُ مسؤولاً عن أفعالِه فينبغي أن يكون هو الذي استقلّ بفعلها، بينما لا يكونُ من العدل أن تنالَهُ العقوبةُ أو المثوبة إذا كان الله هو خالقُ الفعل، أو يكون معنى القضاء والقَدَر هو المعنى المتعارَف عليه.
ولستُ هنا في معرض الدفاع عن المعتزلة أو إدانتهم؛ لكنّ اهتمامهم بصورة الله بالدرجة الأُولى، لا يعني أنّ أحداً منهم ما فكّر في الحرية الإنسانية، كما هو المفروض أن يكونَ قد حصل وإن بالتداعيات، وليس بالأصل.
وهكذا نجد أنّ أُصول المعتزلة التي تضبط انتماءَهم المدرسي خمسة هي: التوحيد، والعدل، والمنزلة بين المنزلتين، والوعد والوعيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهم يستشهدون لكلٍ أصلٍ منها بآياتٍ قرآنية، يذهبون إلى أنهم استنبطوها منها مباشرةً. وهكذا يظلُّ العدلُ إلى جانب الإيمان القيمة الرئيسة في النظام الفكري للمعتزلة الأوائل. وهم يستشهدون على ذلك بآياتٍ قرآنية كثيرة، لكنهم يلجؤون أيضاً إلى التأويل؛ لأنّ ظاهر النص لا يُساعِدُهُم في كثيرٍ من الأحيان.
إنَّمَا بتأمُّل الخمسة الأصول لديهم نجد أنّ ثلاثة منها تتعلقُ بالإيمان، والتوحيد هو القيمة الأولى، والعدل هو القيمةُ الثانيةُ؛ بينما القيمة الاجتماعيةُ والسياسية هي المعروفُ أو الأَمْرُ به. وهكذا فتفكير المعتزلة عقدي أو لاهوتي أو كلامي بقدْر ما هو أخلاقي. وتتصدر القيم الثلاث دون أن تغيب المفاهيم الأُخرى في المنظومة كلِّيّاً؛ فالمساواةُ حاضرةٌ في فهمهم للعدل، والرحمةُ حاضرةٌ في مفهوم اللُّطْف الذي أدخلوه لاحقاً على نظامهم الفكري، لتعليل إرسال الرسل وإنزال الكتب وإيتاء العقل والهداية. مع إصرارٍ شديدٍ على الحيادية الإلهية تُجاه بني البشر، بل وتُجاه سُنَن الكَون بعد الخَلْق والترتيب، وهذه الحياديةُ تقعُ في صميم فهمهم للعدل الإلهي.
ما هي مصادرُ عقيدة أو لاهوت العدل هذا؟ لاشكّ أنه قرآنيٌّ من الناحية السياقية والدلالية. إنَّمَا للمعتزلة سابقون في ذلك في اللاهوت المسيحي الذي كان معروفاً بالبصرة والشام. أمّا في الإسلام، فنحن نعرفُ أنّ المحكِّمة على اختلاف طوائفهم ناضلوا منذ منتصف القرن الأول الهجري من أجل نظامٍ سياسيٍّ عادل. وقد اختلف معهم المعتزلةُ في مفهوم الإيمان ومقتضياته، لكنهم أفادوا منهم كما أفادوا من القَدَرية في مسألة العدل أو قيمة العدل.
وفي النهاية، اكتمل في القرن الخامس الهجري لاهوتٌ عقديٌّ وأخلاقيٌّ للعدل قالت به المعتزلة، والإباضية، والشيعة الزيدية، والإثنا عشرية، ولخليطٍ من الأسباب الدينية المتعلقة بصورة الله عز وجل، والأسباب السياسية والاجتماعية التي ظلُّوا يعبرون عنها بوضوح في أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وفي الوقت الذي كان فيه المعتزلة يزدهرون في الربع الأول من القرن الثالث الهجري، وتمضي طليعتُهم في تحالُفها مع السلطة، وإقبال قسمٍ كبيرٍ منهم على النتاج الفلسفي المترجَم، ماضين باتجاه بحث مسألة الحُسْن والقبح في الأشياء والأفعال؛ أي باتجاه تحديد مرجعيةٍ للفعل الإنساني والسعْي الإنساني من خلال مسألة القيمة وليس الفعل وحسْب؛ كان المتأدبون منهم مثل: ثُمامة بن أشرس والجاحظ، يكتبون الرسائل الساخرة من فقهاء العامة، فيسمُّونهم بالنابتة، ويتهمونهم بالتجسيم للذات الإلهية.
أمّا فقهاء العامة هؤلاء، والذين سمَّوا أنفُسَهم بأهل السُّنة وأصحاب الحديث؛ فقد كانوا يعجبون ويسخرون من محمد بن عبد الملك الزيّات، وزير الواثق والمتوكِّل، الذي كان يُعذِّب خصومه في التنُّور، فإذا سُئل الرَّحمة بهم قال ساخراً ومستكبراً: لا رحمةَ، لأنّ الرحمةَ خَوَرٌ في الطبيعة! حتّى إذا وضعه سيّدهُ هو نفسه في التنور وصاح طالباً الرحمة، أقبل هؤلاء على السخرية منه بالطريقة نفسِها: كيف تطلُبُ الرحمةَ وهي خَورٌ في الطبيعة؟! وقد لا يكونُ شيءٌ من ذلك قد حَدَث، لكنْ لنُلاحظ هذا التقابُل بين مركزية قيمة العدل في نظام المعتزلة الكلامي، ومركزية قيمة الرحمة في النظام الذي كان أصحابُ الحديث يحاولون بلورتَه.
لقد كان النقاشُ أو الجدالُ ما يزال يدورُ ظاهراً حول التنزيه، أو حول صورة الله وعلاقة الإنسان به. وما كان أصحابُ الحديث من أنصار الكلام أو من عارفيه، إنما في هذا الجيل بالذات ظهر التوجُّهُ الذي يريد مواجهة المعتزلة والفلاسفة معاً وبالأساليب الكلامية، إنما من ضمن رؤيةٍ أُخرى تضعُ الصفات الإلهية وفي طليعتها قيمةُ الرحمة في قلب النظام القديم/الجديد.
ويذكر مؤرّخو الكلام بين طلائع أصحاب هذا الاتجاه كلٌّ من المحاسبي (-243ﻫ)، والقطّان وابن كُلاّب؛ وهم يستندون في ذلك إلى ظواهر النصّ القرآني القديم أو غير المخلوق، فالله، سبحانه وتعالى، عادلٌ ولا يظلمُ أحداً، وهو كتب على نفسه الرحمة، وأقام علاقة الإنسان به على العناية والفضل والمودة وليس على العدل، وإذا كان العدل وارداً في أعمال السلطان؛ فإنه في علاقات الناس بعضهم ببعض، وعلاقتهم بالله، يقع بالتأكيد بعد الإحسان والرحمة.
ومضت حوالي المائة عام قبل أن يجرؤ أبو الحسن الأشعري (-324ﻫ) على الانشقاق عن المعتزلة والإقبال على بناء النظام اللاهوتي والقيمي الآخر، لاهوت العناية والرحمة والفضل. وظلَّ الفعلُ الإنسانيُّ، الذي يسميه الأشعريُّ كسباً، مشكلةً كبرى لأصحاب النظام الجديد، الذين صاروا بالتدريج الاتجاه الكلامي الرئيس لدى أهل السُّنَّة. قال الأشعريُّ إنّ الخلق كلَّه لله، بما في ذلك أفعال الإنسان، والمرءُ إنما يكسب أعمالَهُ ولا يخلُقُها. والله يحاسبه ليس على الفعل بالذات، بل على اختيار الفعل أو الترك. والمسؤوليةُ تترتبُ على هذا الكسْب الناتج عن النية والاختيار. والاعتبارات الدافعة لهذا التأويل اعتبارُ الإيمان بالقَدَر جزءًا من العقيدة، واعتبارُ تفرد الله سبحانه بالخَلْق: “له الخلق والأمر” (الأعراف: 53).
وما أقنع هذا التعليل كثيرين من المتكلمين حتى جاء الباقلاني (-403ﻫ) فأَكمل النظام، بما في ذلك القول: إنّ أحكام القيمة (= الحُسْن والقُبح) هي أحكامٌ شرعية، وليست عقلية. فالقيم هي المُطلَقة، أمّا الأفعالُ فهي نسْبيةٌ من حيث الحكمُ عليها من الناحية العقلية بالتحسين أو التقبيح، فإذا ترتّب عليها ثوابٌ أو عقابٌ صارت شرعية.
وصحيحٌ أنّ كسْبَ الأشعري بقي موضعَ نزاع، لكنّ أشعريةَ العامة هذه سادت لدى السواد الأعظم منذ القرن السادس الهجري، وهي ظاهرةٌ بصيغتها الفائقة الوضوح في إحياء علوم الدين للغزالي.
وهكذا، فإنّ تجربة المتكلمين وصراعاتهم خلال ثلاثة قرونٍ على قراءة النصّ القرآني ترتّب عليها ظهورُ لاهوتين: لاهوتُ التنزيه والعدل، ولاهوتُ العناية والرحمة والفضل. والله خالقٌ في التصوُّرين، لكنه ذاتٌ مجردةٌ ومحايدةٌ لدى المعتزلة والفلاسفة، وهو ذاتٌ فاعلةٌ ومتدخّلةٌ بالخَلْق المستمر وبالعناية والرحمة لدى الأشاعرة.
أما التجربةُ الفقهيةُ فقد أظهرت انفصالاً نسبياً عن الكلام وأهله بعد أبي حنيفة (-150ً). فقد كانت لدى أبي حنيفة اهتماماتٌ كلاميةٌ وأُخرى سياسية. لكنه كان واضحاً في قسمة العِلم إلى قسمين: الفقه الأكبر أو علم الكلام أو أُصول الدين. والفقه الأصغر، فقه الفروع الذي يهتمُّ بعبادات الناس ومعاملاتهم من حيث الحِلُّ والحرمةُ والمُلاءمة.
فإذا كان المتكلم مهتماً بصحة عقائد الناس؛ فإنّ الفقيه مهتمٌّ بتصحيح عبادات الناس ومُعاملاتهم؛ أي أنه مهتمٌّ بتعليم الناس دينهم، وتسهيل عيشهم، ومصالحهم في الدنيا.
وهكذا، فإنّ عمل الفقيه هو عملٌ أخلاقيٌّ في مبتداه وغاياته، هو عملٌ أخلاقيٌّ في دوافعه، وهو عملٌ أخلاقيٌّ في استهدافه مصلحةَ الناس في معاشهم وبالتالي في معادهم.
بيد أنّ الفقهاء قبل القرن الخامس الهجري، ما اهتموا بالتنظير لاجتهادهم في المصالح، ولا اهتمّوا بكتابة قراءاتٍ شاملةٍ للنظام الفقهي. أمّا في القرن الخامس فنجد فقهاء من الشافعية والحنابلة، حاولوا القيام بشيء من ذلك؛ ومن هؤلاء أبو الحسن الماوردي (450ﻫ)، وأبو يعلي الحنبلي (458ﻫ)، وإمام الحرمين الجويني الشافعي (478ﻫ)، والغزالي الشافعي (505ﻫ)..
ويعيد بعض مؤرّخي الفقه مثل ابن الصلاح اهتمامات الماوردي النظرية والقيمية إلى أنه كانت لديه ميولٌ معتزلية: إنما الطريف أنه في كتابه “أدب الدنيا والدين” حاول أن يؤلّف بين لاهوتي العدل والرحمة. إذ تحدث عن الأصول القيمية التي رآها ضروريةً لصلاح حال الإنسان فاعتبرها سِتاً وهي: دينٌ متبعٌ، وسلطانٌ قاهرٌ، وعدلٌ شاملٌ، وأمن عامٌ، وخصبٌ دائمٌ، وأملٌ فسيح. فالدين المتّبعُ يمثّل عنده الركيزة التي تقومُ عليها الأعمدةُ الأُخرى وبخاصةٍ السلطانُ القاهر والعدلُ الشامل. إنما البارز أنه لا يُرتّب على هذين الركنين؛ (أي السلطة والعدل) المثالات أو القيم الأخرى في الأمن والخصْب والأمل، بل هو يعتبرها قيماً في علاقة الله بالإنسان، ويجمعُها في الرحمة والخير العامّ.
وبذلك فإنه في جَمعه بين لاهوتي العدل والرحمة، إنَّمَا يقتربُ كثيراً من عوالم القرآن وعوالم الحياة المدينية الشاسعة والمزدهرة في القرن الخامس الهجري. وهكذا فإنّ هذا المخرج الفقهي المنفتح والأخلاقي أَخرج علم الكلام من مأزقه الذي كان قد وضع قيمتين قرآنيتين هما العدلُ والرحمةُ في مواجهةٍ إحداهما مع الأُخرى؛ وذلك بإعادة التأليف بينهما ضمن نظامٍ قيميٍ عام، يتضمن طرحَ مسألة الإنسان على مصراعيها، بدون تعمُّلاتٍ كلامية أو فلسفية. فأَمكن بعد المارودي مباشرةً ظهورُ مبحث “مقاصد الشريعة” على أيدي فقهاء كبار مثل إمام الحرمين (478ﻫ)، والغزالي (505ﻫ)، وعز الدين ابن عبد السلام (665ﻫ)، وبلوغه الذروة في “الموافقات في أصول الشريعة” للشاطبي (790ﻫ).
ومقاصد الشريعة هي صَونُ “المصالح الضرورية للإنسان”، والتي تتركز في خمس: النفس والدين والعقل والنسْل والمِلْك. وهي ضرورياتٌ، يقول ابن عبد السلام والشاطبي: إنهما استقرآها من القرآن الكريم. وهي في أحد وجهيها قيمٌ، وفي الوجه الآخر أخلاقُ ثقةٍ إنسانيةٍ بإله العناية والرحمة والسكينة والمودة والخير العام.
والتصوف تجربةٌ ثالثةٌ في نطاق الثقافة الإسلامية مختلفةٌ عن تجربتي المتكلمين والفقهاء. فإذا كان المتكلم يلتمسُ سلامة العقيدة، والفقيه يلتمسُ سلامة العيش وصلاحه؛ فإنّ المتصوف يلتمس سلامة النفس وصلاحها. ويربطُ المؤرخون للتصوف بين مرحلتي الزُهد والمعرفة فيه. لكنّ الواقع أنّ الزُهد يلتمس قواعد للسلوك تتقصد بالتقلُّل تجنُّب التبعية لشهوات الدنيا، وهو مشتركٌ بين سائر فئات النُخَب العالمة من كل المدارس.
وفي حين تختصُّ المعرفة أو اليقين بالحالة أو التجربة الذاتية التي يرتبطُ خلالها العارفُ بالله برباطي أو علاقتي الرضا والحُبّ. وليس بالوسع التأريخ بدقة لأحوال هذه الفئة؛ لأنها تجربةٌ داخليةٌ لا يلجأ العارفُ أو المجرِّب خلالها للتعبير عن أحواله من طريق الكتابة. إنما في منتصف القرن الثالث الهجري ظهرت مجموعاتٌ من الرسائل والمسائل المكتوبة تحت اسم الرعاية أو الصدق أو المعرفة أو الإخلاص أو السكينة أو الرضا أو الثقة بالله أو الميثاق أو قوت القلوب أو دواء النفوس. وهذه المفرداتُ موجودةٌ كلُّها في القرآن الكريم، ولا شكّ أنّ هذه العناوين مستمدةٌ من المفردات القرآنية.
وبعد القرن السادس الهجري ظهرت الطرق الصوفية، وهي مجموعاتٌ ضخمةٌ تنتسبُ إلى شيخ، وتعتمد التضامُن الداخلي والعيش المشترك، وأخلاق المُسالمة والتراحُم. وقد انضوت الطرق الصوفية ضمن أهل السنة، واعتنقت لاهوت العناية والرحمة والفضل، لكنْ بقيت لها رغم ذلك خصوصياتها التنظيمية والمعيشية، وهي تختلف عن تنظيمات المذاهب الفقهية الإسلامية دون أن يعني ذلك تناقُضاً أو تناكُراً، وبخاصةٍ بعد تحالفها مع الأشعرية.
لقد تكوَن هذا العرض للمفهوم القيمي في القرآن وتجلياته التاريخية، من فَرَضيةٍ لنظام القيم والأخلاق في القرآن استظلّت بمنهج” رؤية العالم”. ثم جرى استعراضٌ لتمثُّلات هذا النظام في مسارات التفكير في التجربة الإسلامية الوسيطة، ولدى ثلاث فئات من النُخَب العالمة: المتكلمون والفقهاء والصوفية. وما تجلّت المنظومة القرآنية بشكلٍ كاملٍ في الأنظمة الفكرية والقيمية لهذه الفئات على النحو الوشائجي والتعالُقي الذي استقرأناه في القرآن، لكنّ معنييها الكبيرين؛ (أي العدل والرحمة) ظهرا مع مشتقاتهما ونظائرهما في سائر النُظُم أو المنظومات مع تقديمٍ لهذه القيمة أو تلك. وقد اتضح لنا أنّ مُصالحةً كبرى جرت بين أجزاء المنظومة القرآنية التي تضاربت لدى المتكلمين متجاوزةً خلافات الأطراف؛ وذلك لدى علماء مقاصد الشريعة والمصالح الضرورية للإنسان.
إنها تجربةٌ تاريخيةٌ وثقافيةٌ وحضاريةٌ زاخرة، عرضنا منها ما اتّصل مباشرةً بمسارات التفكير بالمنظومة القيمية في القرآن. وقد كانت التجربة بهذا الشكل ممكنةً بسبب صدورها عن كتابٍ مقدَّس لا ترعاه طبقةٌ كهنوتية ولا مجتمعات طبقية. وذلك بسبب الفلسفة الكبيرة المتنزلة من هذه القيم لتصنعَ تلك الحضارة الكبيرة من خلال أمرين أو مقولتين: مقولة غرزية العقل، ومقولة عصمة الجماعة.
نعرف مفهومَ الجماعة أي التي تتوحَّدُ بالدين عند أبي حنيفة (-150ﻫ) في قوله بالسواد الأعظم. وعند الإمام مالك بن أَنَس (-179ﻫ) في قوله بحجية عمل أهل المدينة. فالسلطة للجماعة والسواد الأعظم في الدين والدنيا. وقد بلْوَرَ لها الشافعي (-204ﻫ) في رسالته: الإجماع باعتباره مصدراً تشريعياً إلى جانب الكتاب والسنة. وهذا منزِعٌ خطير القيمة لأنه يقول بتنزُّل الكتاب والسنة في التاريخ من خلاله؛ أي من خلال تقاليد الجماعة وإجماعاتها.
ولذا فقد كان منطقياً أن تظهر لدى المتكلمين والفقهاء في الوقت ذاتِه مقولةُ غَرَزية العقل. فالناسُ متساوون في عقولهم ما دام العقل غريزةً أو قوةً من قوى الإنسان مثل سائر القوى التي تتفق في طبيعتها الفطرية وإن اختلفت وظائفُها. وقد كان من حسن الحظّ بقاء مؤلَّفات الحارث بن أسد المحاسبي(-243ﻫ) المعدود بين تلامذة الشافعي. ومن بين تلك المؤلَّفات رسالةٌ له اسمُها: مائيةُ العقل وحقيقةُ معناه واختلافُ الناس فيه. وهي الرسالةُ التي قال فيها إنّ العقل غريزة، بخلاف ما ذهب إليه معاصروه من الفلاسفة مثل الكندي (-252ﻫ) الذين ذهبوا إلى أنّ العقل جوهرٌ فرد والبشر مختلفون فيه، ولذلك يتفاوتون في القيمة والقدرات والإمكانيات، وتتفاوتُ بالتالي سلطاتُهُم أو قُدُراتُهم على إدارة شؤونهم الفردية والجماعية تبعاً لتفاوت وجود ذاك الجوهر لديهم قوةً وضعفاً. وبذلك تقوم مجتمعات النخبة أو الصفوة في المدن الفاضلة!
ثالثا
إنّ هذا العالم القيميَّ كلَّه، عالم التحالف بين الأشعرية المتأخرة والصوفية، جرى تجاوُزُهُ باعتبار أنه استنفد أغراضَهُ وصار عبئاً بعد أواسط القرن التاسع عشر الميلادي. في تلك الفترة جرى التركيز على شروط التمدُّن والتقدم على النمط الأوروبي، كما جرى اعتبارُ ذلك قيمةً أخلاقيةً ووجوديةً عليا، لمواجهة السيل الاستعماري الذي لا يمكن دفعُهُ إلاّ بالاستيعاب واستعارة الأسلحة المفهومية والعملية، كما ذهب لذلك خير الدين التونسي (-1888م).
ومن ضمن تبيئة قيم التقدم والتمدن هذه، جرى إحياءُ مقولة “مقاصد الشريعة”، وتجديد مبحث الإنسان من خلالها، فصارت الضروريات الخمس حقوقاً للإنسان وهي: حق الدين، وحق العقل، وحق النفس، وحق النسل، وحق الملك. وقد أمكن للفقهاء بالفعل التدليل على أنّ هذه المصالح أو الضروريات سبق أن قررها الفقهاء والأصوليون وأبرزهم الشاطبي المالكي في أواخر القرن الثامن الهجري. بيد أنّ إعادة الصياغة هذه، والتي شارك فيها الإصلاحيون والسلفيون، جرت من خارج التقليد، ومن أجل تجاوُزِه وكسْره باعتباره السببَ الرئيس للتخلف والانحطاط والانسداد الحضاري والديني.
لقد توالى ظهور الأدبيات التي تدعمُ هذه المقولةَ التمدنية التقدمية الإنسانية منذ أواسط القرن التاسع عشر. كان المستشرق الفرنسي “كاترمير” قد نشر مقدمة ابن خلدون المعنية بعلم العمران بباريس، ونشر التونسيون في مطبعة الدولة كتاب محمد بيرم الخامس: “السياسة الشرعية” (1883)، والموافقات للشاطبي (1884)، وأقوم المسالك لخير الدين التونسي (1876). وهذه الكتب جميعاً تُعنى بالمدنية والعمران وأحوالهما.
وفي زيارات محمد عبده لتونس نقل هذه الأدبيات وهذا الوعي، ثم طبقه في تفسيره للقرآن الذي عُرف فيما بعد بتفسير المنار. ونشر محمد حسين المُرصفي بمصر أيضاً كتابه: الكلم الثمان، وهو يتضمن ثمانية مفرداتٍ جديدة تتعلقُ كلُّها بتبيئة المفاهيم الأوروبية للتقدم في البيئات الإسلامية.
لقد صار الهمُّ: كيف يمكن تحقيقُ التقدم على النمط الأوربي؟ وقد جرى التوسُّل لذلك بمفاهيم أوروبية، وأدوات اجتهادية شكلاً مستمدة من الأزمنة الوسيطة حفاظاً على الأصالة ولعدم إثارة الهواجس نتيجة الاستعانة بالغريب والوافد. ومع ذلك، فإنه ما أمكن تبيئةُ فكرة المصالح العامة، أو المنافع العمومية للإنسان والأمة على نحوٍ قوي. ربما لاستنادها إلى فكرة المستبد العادل الذي لا يحتاجُ لتحقيق التقدم غير خَرْط الشعب في سياقٍ واحد إرادوي وكارزماتي. ثُمَّ إنّ التقدم المبتغى ما اقترن بقيمة الحرية، ولا بقيمة المشاركة الشعبية الفاعلة في التنمية والتقدم، وإنما ارتبط بالتحرر من الاستعمار الخارجي. ولذلك سرعان ما ماتت بالتدريج فكرةُ أو قيمةُ المصالح الضرورية، ملحقةً أضراراً كبيرةً بقيمة الحرية التي ما أمكن ربطُها كما سبق القول بقيمة أو مقولة التقدم.
وعندما عادت “مقاصد الشريعة” للظهور في أبحاثٍ كثيرةٍ منذ السبعينات من القرن الماضي، فقد كان ذلك من ضمن تيارات الصحوة والأصالة والخصوصية، وفي استقلال عن العالم الوسيط أولاً، وعن مستجدات الداخل العربي والإسلامي ثانياً.
إنّ ما حدث منذ السبعينات من القرن الماضي، وفي مجالاتٍ عربيةٍ رئيسيةٍ للثقافة والتمدن مثل: مصر وسورية والعراق وتونس وليبيا والسودان والجزائر، كان أفدح وأخطر؛ فقد سادت أنظمةٌ شموليةٌ واجهها تمردٌ إسلامي، فقامت ثنائيةٌ في المجال السلطوي والسياسي على مدى أربعة عقودٍ، شرذمت عالم القيمة ومزَّقتهُ بين الاستقرار والاستبداد، وبين الإسلام والجاهلية، وبين العروبة والإسلام، وبين الدين والدولة، وبين الجمهور والنخبة.
وانصرف كبارُ المثقفين العرب، الذين توفي عددٌ منهم بالمصادفة عام 2010، إلى استحداث ثُنائية مزيدة في وعي شبان الجامعات بين الحداثة والموروث. لقد أراد المثقفون الكبار من مثل: محمد أركون، ومحمد عابد الجابري، وحسن حنفي، ونصر حامد أبوزيد، وحسين مروة، وطيب تيزيني، وصادق جلال العظم، وهشام شرابي، وأدونيس، تحرير الوعي العربي من الموروث الديني والثقافي العربي والإسلامي.
فهذا الموروث في قناعاتهم ما يزالُ يحيا حياةً مفوَّتة منذ سيطرت الأشعريةُ في القرن الخامس الهجري، وهو قد تسبب في انسدادٍ ثقافي وحضاري وأخلاقي، هو الذي يحول حتى اليوم دون تبيئة مفاهيم وقيم الحرية والتقدم وحقوق الإنسان والديمقراطية. فقوَّوا بذلك بوعيٍ أو بدون وعيٍ من قبضة الاستبداد المدّعي للعلمانية والحداثة، وزادوا من فصامية الوعي والتصرف لدى الإسلاميين معتدليهم ومتطرفيهم. وحدث ذلك كلُّه بينما يجري الصراع الدونكيشوتي الانتحاري على طواحين الهواء بين الاستبدادية السلطوية والانتحارية الإسلامية، وتلاعب العلاقات الدولية بهما، وسط غياب الشارع والجمهور.
ولنتأمَّل المشهد الآن بعد حركات التغيير التي خمدت موجتها الأولى؛ فالشبان الذين نزلوا إلى الشارع بعد غياب أكثر من أربعين عاماً يحملون ثلاثة شعاراتٍ رئيسية: الكرامة والحرية والعدالة، التي ينبغي تحقيقها بالتحرك السلمي؛ بل إنها لا تتحقق بدونه. وهي شعاراتٌ ما سبق أن طُرحت من قبل بهذه الصيغة، وهذا الانتظام، وهذه الحرارة. فهي تربطُ الكرامة والعدالة بالحرية، وتربطهما معاً بالنزوع السلمي الذي هو شأْنُ الجمهور الذي كان أبوحنيفة يسمّيه السواد الأعظم. ولأنه السوادُ الأعظم؛ فلا تنفصمُ في وعيه وتصرفه المحلياتُ عن الإسلام، ولا الإسلامُ عن العالم.
ولذلك، فإنّ هذه الحركات التغييرية تشكّل بالوعي والتصرف خروجاً من المرحلة الماضية بعُجَرها وبُجَرِها. يزول أُسامة بن لادن ويزولُ خصومُهُ، وينفتحُ الأُفُق على مُصالحةٍ مع النفس ومع الآخر، كما ينفتح على محاولةٍ من جانب الجمهور لتولِّي إدارة شؤونه بنفسه، ومن خلال الآليات التي يضعُها ممثِّلوه المنتَخَبون. وبذلك ينتهي أيضاً زمن الطليعة الثورية، التي تكسبُ شرعيتها من قدرتها على إقصاء الناس عن تولّي تدبير مصالحهم بحجة العامية والجهل والتخلُّف والرجعية والتطرف. ويزول القهر الديني، والقهر السلطوي، ونُطِلُّ على مرحلةٍ جديدةٍ، يكونُ على شباننا وكهولنا خلالها العملَ على إزالة آثار الثُنائيات وبناء الجديد الواعد والمتقدم، ومع العالم وفيه، وليس ضدَّه أو في مواجهته.
لقد قلتُ: إنّ المرحلة المنقضية شهدت إقصاءً لديننا من الثقافة والوعي، ومن القدرة على التجديد والتغيير والتطوير. وردَّ الأُصوليون المتشددون على ذلك بالمزيد من الإقصاء للآخر باسم الإسلام، وصُنْع شرنقة من حول أنفُسهم أو القول بانتحارية الفسطاطين.
لقد كانت تلك مسالكُ التفكير والتقدير. وهذا ما انتهت إليه على أنقاض التقليد، وعقل الجماعة، الذي كان المحاسبي يسميه في كتابه: الرعاية لحقوق الله: العقل عن الله. فما هو التدبير اليومَ والآن؟
إنّ المرحلة الجديدة ينبغي أن تشهد نهوضاً وتجديداً في الفكر الإسلامي، وفي تجديد طرح القيم القرآنية التي تشرذمت منظوماتُها، وغادرت رحمة القرآن وعدالته وكرامته وسكينته وخيره العامّ. نحن كما قال ابن خلدون: عشية خَلْقٍ جديدٍ ونشأةٍ مستأنفة. وكما كان للزمن المنقضي أصوليوه وراديكاليوه، فينبغي أن يكونَ للزمن المستأنَف سلميُّوه ونهضويُّوه ومثقفوه وديمقراطيوه. الهمُّ موجود ومشبوبٌ، إنما ينبغي أن تكون لهذا الهم وجوه وعيه، ووجوه تدبيره. لدينا مشروع مجلة التأويل للعمل على القرآن. ولدينا الإمكانيات العلمية والأخلاقية الشابة للنهوض الفكري والديني، ولدينا المؤسسات التي ينبغي إعادةُ بنائها لتتمكن من القيام بالمهمات التي فوتتها طوال القرن المنقضي.
هناك ثلاث مهماتٍ، إذن، تدخل كلُّها في التفكير والتدبير معاً: النهوض الفكري المُخرج من الثُنائيات، والصائن للدين. والعمل على تجديد المؤسسات الدينية لكي تتولى المهمات التي عطلتها الاستبداديات، أو استلبتها الأُصوليات. وإقامة أنظمة الحكم الصالح، لإدارة الشأن العام، فيتجه إليها الناس بعيداً عن أوهام تديين السياسة، وتسييس الدين، أو إمكان سَوس الناس بالقهر والإبادات.
لقد بدأ هذا المبحث عن المفهوم القيمي في القرآن، بالقول: إنّ فكرة الأُلوهية في القرآن والإسلام هي فكرةٌ قيميةٌ وأخلاقية؛ ولذلك فقد كانت المنظومة القيمية والأخلاقية هي أبرزُ ما دعا الكتاب المسطور العالمَ المنظورَ إليه. فلتعُدْ لاجتماعنا الإسلامي والإنساني سويتُه، لتعودَ له أخلاقيتُه، فيتواصل كما يحاول أن يفعل الآن، مع قيم وأخلاقيات ومنظومات الإيمان والإسلام، وقيم الحرية والتسامح والتنمية الإنسانية في عالم العصر وعصر العالم.