
يراد بالفكر المقاصدي، ذلك الفكر المتشبع بمعرفة معاني مقاصد الشريعة وأسسها ومضامينها، من حيث الاطلاع والفهم والاستيعاب. وهو الذي آمن واستيقن مقصدية الشريعة في كلياتها وجزئياتها، وأن لكل حكم حكمته ولكل تكليف مقصده أو مقاصده. وهو الذي يفهم نصوص الشريعة ويفقه أحكامها في ضوء ما تقرر من مقاصدها العامة والخاصة. وهو الذي يصبح مسلحا بالمقاصد ومؤسسا على استحضارها واعتبارها في كل ما يقدمه أو يقرره أو يفسره، في كل المجالات العلمية والعملية[1]؛ ومن ذلك الاجتهادي الفقهي، الذي يكون مبنيا عند المجتهد على فكر ونظر مقاصدي؛ فيصير اجتهادا مقاصديا.
ولما كان الاجتهاد المقاصدي هو “العمل بمقاصد الشريعة، والالتفات إليها، والاعتداد بها في عملية الاجتهاد الفقهي[2]“؛ فإنه هو الذي يعطي للنصوص والأحكام الشرعية عطاء متجددا يساير واقع الحياة ومصالح الناس المتجددة؛ تحقيقا لاستمرارية أحكام الشريعة الإسلامية وهيمنتها على جميع مجالات الحياة، بما يحقق مصالح العباد في الدارين.
وقد اعتمد الإمام مالك في اجتهاده الفقهي على قواعد الأصول، مع استحضار مقاصد الشريعة في كل اجتهاده مؤسسا على فكر مقاصدي.
وسنتناول فكر مالك المقاصدي من خلال منهجه في الاجتهاد، المكون من تسعة ضوابط أو مسالك اجتهادية.
أولا: تفسير النصوص بمقاصدها
المراد بهذا المسلك الاجتهادي أن تفسر النصوص وتستنبط منها الأحكام، مع استحضار الحكم والمصالح التي يعمل الشرع على تحقيقها ورعايتها؛ وهو ما يكون له أثره في فهم النص وتوجيهه والاستنباط منه، فقد يصرف النص عن ظاهره، وقد يقيد أو يخصص، وقد يعمم وظاهره الخصوصية… فيتم تفسير النص بما يحقق المصلحة[3]…
وفي هذا الإطار سنسوق نماذج من هذا المنهج الاجتهادي الذي سار عليه مالك، فيما يخص الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ثم آثار الصحابة.
أ. التفسير المصلحي للآيات القرآنية
قال مالك: الأمر عندنا في قسم الصدقات، أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي؛ فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد، أوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي، وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام، فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيثما كان ذلك، وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم، ثم قال: وليس للعامل على الصدقات فريضة مسماة إلا على قدر ما يرى الإمام[4].
فهذا تفسير مصلحي لنص الآية الواردة في الأصناف الثمانية الذين تصرف لهم الزكاة، وهي قوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾ [التوبة: 60].
وقد ذكر ابن رشد أن أبا حنيفة وافق مالكا في هذا الحكم، بينما خالفه الشافعي فقال بقسم الزكاة على الأصناف الثمانية كما سمى الله تعالى[5].
وبين ابن عبد البر أن العلماء اختلفوا من لدن التابعين في كيفية قسم الصدقات، وهل هي مقسومة على من سماه الله في الآية؟ وهل الآية إعلام منه تعالى لمن تحل له الصدقة؟ وأن مالكا والثوري وأبا حنيفة كانوا يقولون إنه يجوز أن توضع الصدقة في صنف واحد من الأصناف المذكورين في الآية. يضعها الإمام فيمن شاء من تلك الأصناف على حسب اجتهاد[6]، أي بما فيه مصلحة الأمة، ويحقق مقاصد الزكاة.
ويؤيد هذا قول مالك في المدونة، أنه إن لم يجد الوالي إلا صنفا واحدا ممن ذكر الله في كتابه أجزاه أن يجعلها فيهم. وأنه إذا كان يجد الأصناف كلها التي ذكر الله في كتابه، وكان منها صنف هم أحوج، أوثر أهل الحاجة حيث كانوا حتى تسد حاجتهم، وإنما يتبع في ذلك في كل عام الحاجة حيث كانت، وليس في ذلك قسم مسمى[7].
ب. التفسير المصلحي للأحاديث النبوية
في موضوع القضاء باليمين مع الشاهد الذي اختلف فيه العلماء؛ فأجاز بعضهم قضاء القاضي بذلك، ومنع القضاء بذلك البعض الآخر. نجد أن من العلماء القائلين بجواز القضاء باليمين مع الشاهد؛ الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد[8]، ومن الأدلة المعتمدة عندهم ما ورد في السنة النبوية، ومن ذلك ما روى عن ابن عباس أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قضى بيمين وشاهد[9].
والذي يهمنا بيانه هنا هو إجازة مالك للقضاء باليمين مع شهادة امرأتين، بينما منع ذلك الشافعي.
ورد في الموطأ في سياق كلام مالك عن شهادة النساء وفيما تجوز: “(…) وقد يكون ذلك في الأموال العظام من الذهب والورق والرباع والحوائط والرقيق، وما سوى ذلك من الأموال، ولو شهدت امرأتان على درهم واحد، أو أقل من ذلك أو أكثر، لم تقطع شهادتهما شيئا ولم تجز، إلا أن يكون معهما شاهد أو يمين[10]“.
وقد أشار الزرقاني إلى نهج مالك في تفسير الأحاديث الواردة في القضاء باليمين مع الشاهد؛ بما يوافق مقصد الشارع من إقامة الشهادة، بينما وقف الشافعي عند لفظ الحديث؛ فقال: “فيقضي مالك باليمين مع شهادة المرأتين، خلافا للشافعي؛ قال: لأن شهادة النساء لا تجوز دون الرجال، وإنما حلف في اليمين مع الشاهد للحديث[11]“.
فمذهب مالك في قبول القضاء باليمين مع شهادة امرأتين؛ مبني على تفسير الأحاديث الواردة في القضاء بيمين وشاهد واحد تفسيرا مصلحيا.
ج. التفسير المصلحي لأثار الصحابة
روى مالك بسنده عن عمر بن الخطاب قال: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها، فلها صداقها كاملا، وذلك لزوجها غرم على وليها.
ثم قال مالك معلقا على قول عمر: وإنما يكون ذلك غرما على وليها لزوجها، إذا كان وليها الذي أنكحها هو أبوها أو أخوها، أو من يرى أنه يعلم ذلك منها، فأما إذا كان وليها الذي أنكحها، ابن عم أو مولى أو من العشيرة، ممن يرى أنه لا يعلم ذلك منها، فليس عليه غرم، وترد تلك المرأة ما أخذته من صداقها، ويترك لها قدر ما تستحل به[12].
فقد فسر الإمام مالك قول عمر فيمن تزوج امرأة بها جنون أو غيره من العيوب التي ذكرها، أن صداقها لزوجها غرم على وليها؛ تفسيرا مصلحيا مستنبطا فيه مناط الحكم الوارد في قول عمر، بما يبين محل تطبيق ذلك الحكم.
وقد بين الباجي أنه يحتمل أن يكون قول مالك خلافا لقول عمر، وأن يكون مالك تلقى قد أورد قول عمر على ما رواه وذكر رأيه على ما رآه، ويحتمل أن يكون مالك تلقى قول عمر على أنه موافق لرأيه ولكنه خاص في الولي الذي يظن به أنه يعلم، وبين مالك ذلك بتفصيله الذي فصله؛ فإذا كان ذلك كذلك وكان ما وجد من العيب بالمرأة موجودا بها حين العقد وظهر عليه الزوج بعد المسيس، فلا يخلو أن يكون الولي في عقد نكاحها ممن ظاهره المعرفة بحالها والاطلاع على ما بها، أو يكون ممن ظاهره أنه لا يعلم حالها ولا يقف على ما بها[13]، وعلى هذا الأساس المراعي لحال الولي ومدى اطلاعه في العادة على أحوال المرأة؛ بنى مالك رأيه فيما قاله، ولا يخفى ما في ذلك من نظر إلى تحقيق العدل في الحكم.
ومن المؤكد أن مالكا كان يستحضر في ذلك روح الشريعة، وعللها المنصوصة والمستنبطة، وقواعدها المعلومة بالاستقراء، ثم إذا توصل إلى المصلحة والحكمة المقصودة في النص؛ فسره في ضوئها، ومن ثم حدد نطاق تطبيق ذلك النص، وما يراد به، بناء على تلك المصلحة.
وبهذا تبين أن التفسير المصلحي للنصوص عند مالك؛ تستحضر فيه قواعد الشريعة وكلياتها العامة بموازاة تلك النصوص باعتبارها أدلة جزئية خاصة، وهذا مسلك آخر من مسالك الاجتهاد المقاصدي عند مالك، يرتبط ارتباطا وثيقا بالمسلك الأول، وهو يعني بالجمع، في عملية الاجتهاد، بين القواعد الكلية العامة والأدلة الجزئية الخاصة.
ثانيا: الجمع بين القواعد الكلية والأدلة الجزئية
حيث يتم النظر في الدليل الجزئي مع استحضار الكليات والمقاصد العامة، فتكون مراعاة هذه وتلك في آن واحد، وبالتالي يكون الحكم مبنيا عليهما معا.
وإن الناظر في الأصول التي بنى عليها مالك فقهه، يدرك مدى انسجامها وخدمتها لهذا المسلك الاجتهادي، وخاصة منها أصوله الاجتهادية؛ مثل المصالح المرسلة وسد الذرائع والاستحسان وغيرها، بالإضافة إلى العرف الذي يعتبر من الأدلة العملية. فهذه الأصول وكيفية اعتمادها والتوسع في إعمالها، جعلت مذهب مالك ينظر إلى النوازل بمنظار الاستيعاب والشمولية، بما يحقق روح الأحكام الشرعية ويراعي مقاصدها السامية.
ومن أمثلة هذا المسلك في فقه مالك؛ تقييد التصرف في استعمال الحق، الذي يمكن التعبير عنه أيضا بمنع التعسف في استعمال الحق؛ ومنه منع التعسف في استعمال الحقوق للإضرار بالزوجة.
وفي هذا الإطار نجد مالكا قال في من طلق زوجته ثلاثا في مرض موته بتوريثها منه، وإن طلقها قبل الدخول بها فلها نصف الصداق ولها الميراث أيضا ولا عدة عليها[14].
وننبه هنا على أن “السبب في توريث المطلق ثلاثا في حالة المرض، هو أن الطلاق في هذه الحالة مظنة إرادة إخراجها من الميراث، فمعاملة للمطلق بنقيض قصده الذي أجري مجرى الظاهر وإن لم يتوفر، ونظرا لأن هذا التصرف خرج عن الغاية الطبيعية، حيث لو لم يتم طلاق المرأة لورثت زوجها، وهو بالتالي يعتبر متعسفا في حق طلاقه؛ ولذلك ثبت للزوجة المطلقة غير المدخول بها نصف الصداق والميراث، فإن وقع الدخول بها فلها الصداق كاملا والميراث[15]“.
فمع أن للزوج أن يطلق زوجته بما يترتب على ذلك من آثار، إلا أن مالك منع ترتب بعض آثار تصرف الزوج في ذلك الحق، ناظرا إلى ما يبعد الضرر عن المرأة، تطبيقا للأصل العام الدال على منع التعسف في استعمال الحق.
ولما كان من أبرز أغراض الجمع بين القواعد الكلية والأدلة الجزئية عند مالك، تحقيق المصلحة الشرعية وتطبيقها في الأحكام الفقهية المستنبطة؛ فإنه كان يروم دائما مراعاة مقاصد الشريعة في جلب المصالح للعباد ودرء المفاسد عنهم بإطلاق؛ وهو ما سنراه فيما يلي:
ثالثا: رعاية جلب المصالح ودرء المفاسد مطلقا
إن أول ما يثير الانتباه بالنسبة لعلاقة هذا المسلك بأصول مالك، هو اهتمامه بجلب المصالح ودرء المفاسد بإطلاق في فقهه عامة، ولذلك كان “تجنب الفساد واعتبار مصالح الأمة من الأسس البارزة في كتاب الموطإ[16]“.
وقد نص الشيخ أبو زهرة على أن ما يلاحظ على أصول مالك؛ اتجاهها نحو تحقيق المصلحة من أقرب طريق، وأن مالكا أكثر من طرقها، فجعل القياس طريقا لتحقيقها، وجعل من طرقها الاستحسان بترجيح الاستدلال المرسل إن أبعد القياس الوصول إليها، وجعل المصلحة المرسلة القريبة أساسا في الاستدلال لتتحقق من أيسر سبيل، وجعل سد الذرائع وفتحها من طرقها واعتبره أيضا من أصول الاستدلال، واعتبر العرف وهو من أبواب رفع الحرج ودفع المشقة وتحقيق المصلحة وسد الحاجة، وجعل العقود تحقق رغبات الناس البريئة من الآثام وحاجاتهم، وتسير على مقتضى مشهورهم.
فمالك رأى قصد الشارع الأساسي إلى تحقيق مصالح الناس جليا في شريعته؛ فجعل فقهه يسير حول قطبها، ويدور على محورها، يحميها بسد الذرائع وفتحها، ويكثر من الطرق الموصلة إليها، لتتحقق من أقرب طريق وأيسر سبيل… وبذلك التقى فقهه في غاية واحدة، وهي مصالح الناس في الدنيا والآخرة[17].
ومن الفتاوى المروية عن مالك مما يدخل في هذا الإطار؛ قوله في الزعفران المغشوش، وغيره من السلع التي يغش فيها بعض الناس، إذا وجد ذلك بيد الذي غشه؛ أنه يتصدق به على المساكين قل أو كثر.
جاء في العتبية؛ “وسئل مالك عن الرجل يشتري الزعفران فيجده مغشوشا؛ أترى أن يرده؟ قال: نعم، أرى أن يرده، وليس عن هذا سألني صاحب السوق، إنما سألني أنه أراد أن يحرق المغشوش بالنار لما فيه من الغش، فنهيته عن ذلك. وسئل مالك عما يغش من اللبن؛ أترى أن يراق؟ قال: لا، ولكن أرى أن يتصدق به على المساكين من غير ثمن، إذا كان هو الذي غشه. قيل له فالزعفران أو المسك أتراه مثله؟ قال: ما أشبهه بذلك، إن كان هو الذي غشه فأراه مثل اللبن[18]“.
وقال الشاطبي في سياق كلامه عن أنواع العقوبة عند مالك؛ أن تكون جناية الجاني في نفس ذلك المال أو في عوضه، فالعقوبة فيه عنده ثابتة، فإنه قال في الزعفران المغشوش إذا وجد بيد الذي غشه؛ إنه يتصدق به على المساكين قل أو كثر. وذهب ابن القاسم إلى أنه يتصدق بما قل منه دون ما كثر. وذلك محكي عن عمر بن الخطاب، وأنه أراق اللبن المغشوش بالماء، ووجد ذلك التأديب للغاش. وهذا التأديب لا نص يشهد له، لكنه من باب الحكم على الخاصة لأجل العامة[19].
وهذا يدل على أن مالكا لا يقول بمصلحة غريبة قط، وأنه في العقوبة في المال، إذا كانت جناية الجاني في نفس المال أو في عوضه، يعمل بمصلحة تدخل تحت جنس راعاه الشارع في نصوصه، وسار عليه في أحكامه؛ فهو من المصالح التي شهد الشرع لجنسها بنصوص غير معينة؛ والتي تعد جزئيا من أصل شرعي كلي، أو فردا من أفراد العام الاستقرائي، وهو أنه إذا تعارضت مصلحة عامة ومصلحة خاصة؛ قدمت المصلحة العامة على الخاصة. ومصلحة الزجر عن الغش وارتكاب الجرائم بواسطة بعض الأموال؛ مصلحة عامة دون شك، في حين أن مصلحة الغاش مصلحة خاصة، وقد تعارضت المصلحتان فقدمت المصلحة العامة على المصلحة الخاصة[20].
ولعل من نافلة القول هنا التأكيد على أن عمل مالك بالاستحسان، وما يجري مجراه من مستثنيات القواعد، تعتبر أحد أشكال مراعاة المصالح في الأحكام؛ فكما هو معلوم أن تطبيق القواعد العامة على كل الحالات، من غير مراعاة لمستثنياتها؛ يؤدي إلى الحرج ويوقع المكلفين في المشقة، وبالتالي يفوت بعض المصالح التي جاءت الشريعة بحفظها، ومن هذا القبيل أيضا مراعاة حالات الضرورة؛ التي سنتناولها فيما يلي.
رابعا: استثناء حالات الضرورة من القواعد العامة
الضرورة هي: “خوف الهلاك أو الضرر الشديد على أحد الضروريات للنفس أو الغير يقينا أو ظنا، إن لم يفعل ما يدفع به الهلاك أو الضرر الشديد[21]“.
ومن المقرر أن مراعاة حالات الضرورة وثيق الصلة برعاية المقاصد الشرعية، وأن مراعاة الضرورة تندرج ضمن الأصول الاجتهادية التي عمل بها الإمام مالك.
ومن أمثلة مراعاة الضرورة في فقهه؛ الترخيص في الصلاة بالتيمم مراعاة لحفظ النفس أو المال؛ فإنه لما “سئل مالك عن الرجل يكون في السفر فتحضره الصلاة والماء منه على ميل ونصف ميل، فيريد أن يذهب إليه، وهو يتخوف عناء ذلك، أو يتخوف منه أن ينفرد إما من سلابة وإما من السباع؛ قال: لا أرى عليه أن يذهب إليه وهو يتخوف.
قال محمد بن رشد: وسواء تخوف على نفسه أو على ماله دون نفسه؛ ليس على شيء من ذلك (…). وفي النوادر؛ إن كانت عليه في ذلك مشقة فليتيمم[22]“.
وفي نفس المعنى “سئل مالك عن الرجل يكون معه الماء القليل لوضوئه فيمر به رجل فيستسقيه؛ أترى أن يسقيه ويتيمم؟ قال: ذلك يختلف، أما رجل يخاف أن يموت فأرى ذلك له، وإن لم يبلغ منه الأمر الخوف فلا أرى ذلك له، وقد يكون عطش خفيف، ولكن إن أصابه من ذلك أمر يخافه فأرى ذلك له.
قال محمد بن رشد: خوفه على الرجل الذي يستسقيه كخوفه على نفسه سواء، وقد قال (…) إنه إذا كان له من الماء قدر وضوئه فخاف العطش؛ أنه يجوز له أن يتيمم ويبقى ماءه، وهو كما قال؛ لأن الخوف على النفس يسقط حق الله[23]“.
وبهذا تبين أن مالكا يراعي حالات الضرورة، لما فيها من مشقة بالغة وحرج شديد على المكلفين؛ ومن ثم فقد كانت فتاويه في هذا المجال منبنية على أصل رفع الحرج، لأن الضرورة تتطلب الترخيص بإباحة المحظور الذي تتعلق به…
وإذا كانت مراعاة الضرورة تعتبر من قبيل الاستثناء لبعض الحالات رفعا للحرج عن المكلفين؛ اعتبارا لمبدإ جلب المصالح ودفع المفاسد، بما يحقق مقاصد الشرع الحقيقية من وضع الأحكام، فإنه يصب في هذا المرمى عديد من الأصول والقواعد، التي يعتبر العمل بها من قبيل استثناء بعض الحالات من القواعد العامة، مراعاة لما يؤول إليه تصرف المكلف من مخالفة لمقصود الشارع من تشريعه للأحكام؛ فيكون بناء الحكم وتقريره في تلك الحالات مؤسسا على النظر في المآلات؛ وهو الذي سنفرده بالكلام فيما يلي.
خامسا: تقدير المآلات واعتبارها
حاصل هذا المسلك أنا لا نقف عند ظاهر الأمر فنحكم بمشروعية الفعل في جميع الحالات وتحت كل الظروف، حتى في الحالات التي لا يحقق فيها الفعل المصلحة التي شرع لتحقيقها، أو كان تحقيق الفعل لهذه المصلحة يترتب عليه فوات مصلحة أهم أو حصول ضرر أكبر، وبالمثل فإننا لا نقف عند ظاهر النهي، فنحكم بعدم مشروعية الفعل في جميع الحالات وتحت كل الظروف، حتى إذا أدى ذلك إلى حصول مفسدة أشد من المفسدة التي قصد بالمنع من الفعل درؤها، بل الواجب تحصيل أرجح المصلحتين ودفع أشد الضررين[24].
وإذا أردنا أن نكشف عن مدى إعمال الإمام مالك لهذا المسلك الاجتهادي في فتاويه واجتهاداته؛ نجد أن هذا المسلك يتجلى في مجموعة من القواعد والأصول الاجتهادية التي عمل بها مالك وبنى عليها فقهه؛ كسد الذرائع والاستحسان ومراعاة الخلاف والمنع من التحيل… ويكفينا في التدليل على اندراج هذه الأصول والقواعد في هذا المسلك؛ أن الشاطبي عندما تكلم عن النظر في مآلات الأفعال ذكر أنه ينبني عليه عدة قواعد، ومنها الأصول والقواعد المشار إليها[25]. وبناء على ذلك فإن التطبيقات الفقهية للفكر المقاصدي المبني على تلك القواعد، تصلح للتمثيل بها على مراعاة مالك للمآلات في اجتهاداته وفتاويه.
أ. مراعاة المآلات من خلال قاعدة الذرائع
جاء في العتبية أن مالك سئل “عن صلاة النوافل في البيوت أحب إليك أم في المسجد؟ قال: أما في النهار فلم يزل من عمل الناس الصلاة في المسجد يجرون ويصلون، وأما الليل ففي البيوت، وقد كان الرسول عليه السلام يصلي الليل في بيته، (…).
قال محمد بن رشد: استحب مالك صلاة النافلة بالنهار في المسجد على صلاتها في البيت؛ لأن صلاة الرجل في بيته وبين أهله وولده وهم يتصرفون ويتحدثون؛ ذريعة إلى اشتغال باله بأمرهم في صلاته، ولهذه العلة كان السلف يهجرون ويصلون في المسجد، فإذا أمن الرجل من هذه العلة فصلاته في بيته أفضل، (…) وقد سئل مالك (…) عن الصلاة في مسجد النبي، عليه السلام، في النوافل أفيه أحب إليك أم في البيوت؟ قال: أما الغرباء فإن فيه أحب إلي، يعني بذلك الذين لا يريدون إقامة؛ فدل هذا من قوله أن الصلاة بالنهار في البيوت لغير الغرباء أحب إليه من الصلاة في المسجد؛ ومعنى ذلك إذا أمنون من اشتغال بالهم في بيوتهم بغير صلاتهم، وأما إذا لم يأمنوا ذلك فالصلاة في المسجد أفضل لهم[26]“.
ب. مراعاة المآلات من خلال المنع من التحيل
من ذلك أن مالكا سئل: “عن رجل ممن يبيع السلعة من الرجل بثمن إلى أجل، فإذا قبضها منه ابتاعها منه رجل حاضر كان قاعدا معهما فباعها منه؛ ثم إن الذي باعها الأول اشتراها منه بعد، وذلك في موضع واحد. قال: لا خير في هذا، ورآه كأنه محلل فيما بينهما، وقال: إنما يريدون إجازة المكروه (…) قال ابن القاسم: ورأيتها عند مالك من المكروه البين.
قال محمد بن رشد: هذا صحيح على طرد القياس في الحكم بالمنع من الذرائع لأن المتبايعين إذا اتهما على أن يظهرا أن أحدهما باع سلعة من صاحبه بخمسة عشر إلى أجل، ثم اشتراها منه بعشرة نقدا ليتوصلا بها إلى استباحة دفع عشرة في خمسة عشر إلى أجل، وجب أن يتهما على ذلك وإن اشتراها الذي باعها من غير الذي باعها منه إذا كان في مجلس واحد لاحتمال أن يكون إنما أدخلا هذا الرجل فيما بينهما لتبعد التهمة عن أنفسهما، ولا تبعد عنهما به؛ لأن التحيل به ممكن بأن يقولا لرجل مثلهما في قلة الدعة: تعال تشتري من هذا الرجل هذه السلعة التي تبيعها منه بخمسة عشر إلى أجل بعشرة نقدا، وأنا أبتاعها منك بذلك، أو تربح دينارا فتدفع إليه العشرة التي تأخذ مني ولا تزد من عندك شيئا فيكون إذا كان الأمر على هذا، قد رجعت إلى البائع الأول سلعته، ودفع إلى الذي باعها منه عشرة دنانير يأخذ بها منه خمسة عشر إلى أجل، ويكون إذا كان قد ابتعاها من الثاني بربح دينار على الشرط المذكور؛ قد أعطاه ذلك الدينار ثمنا لمعونته إياه على الربا[27]“.
وكما هو واضح؛ فهذا المثال ينطبق مضمونه وما يؤول إليه التصرف المذكور فيه على بيع العينة؛ الذي يعتبر المنع منه من باب سد الذرائع أيضا.
ج. مراعاة المآلات من خلال الاستحسان
من ذلك أن مالك سئل عمن دفع زكاة الفطر، أيدفع إليه منها؟ فأنكر ذلك وقال: كيف تدفع إلى من يدفع؟ لا أرى ذلك. ثم رجع عنها بعد ذلك، فقال: نعم إني لأستحب ذلك إذا كان محتاجا.
وقد بين ابن رشد؛ أن زكاة الفطر إنما هي زكاة الرقاب وليست بزكاة الأموال، فهي تجب على من لا مال له إذا كان عنده فضل عن قوت يومه، وفيه ما يؤديها منه، إلا أن يضر ذلك به ويؤدي إلى جوعه وجوع عياله، ومن ليس له إلا هذا المقدار فهو من الفقراء الذين تحل لهم الزكاة، فلهذا وقع الاختلاف في هذه المسألة. فوجه قول مالك الأول هذا ممن تجب عليه زكاة الفطر، فلا يأخذها قياسا على سائر الزكوات، ووجه القول الثاني أنه مسكين، فجاز أن يأخذ صدقة الفطر، قياسا على سائر المساكين، وإن كان هو ممن دفعها، إذا جاز دفعها إليه فهو أولى من غيره، كما تبين من فضله إذ دفع الزكاة مع مسكنته وحاجته، قال الله عز وجل: ﴿ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة﴾ [الحشر: 9]، فهذا وجه استحسان قول مالك لذلك[28].
فتبين من هذا المثال أن مالكا لو استمر على القياس: لما أجاز للمحتاج الأخذ من زكاة الفطر بعد دفعه لها، ومعلوم أن في ذلك إضرار به مع حال فقره وحاجته، فإعمال القياس والدليل العام كان مآله سيؤدي إلى فوات مصلحة من المصالح التي من أجلها شرعت زكاة الفطر، وحصول ضرر لبعض الناس الذين كان ينبغي أن ينتفعوا من تلك الزكاة، مع ما تميزوا به من سخاء وبذل رغم حاجتهم.
د. اعتبار المآلات من خلال مراعاة الخلاف
في جواب لابن القاسم بما عليه شيخه مالك في إحدى المسائل؛ يظهر اعتبار المآل المرتبط بمراعاة الخلاف، وذلك أنه سئل عن رجل يبيع الزرع وقد أفرك[29] أو الفول وقد امتلأ حبه -وهو أخضر- والحمص والعدس، أو ما أشبه ذلك، فيتركه مشتريه حتى ييبس ويحصد، أيجوز بيعه؟ فقال: إن علم به قبل أن ييبس فسخ البيع، وإن لم يعلم به إلا بعد أن ييبس مضى البيع ولم يفسخ، وليس هو مثل من يشتري الثمرة قبل أن تزهى؛ لأن النهي جاء في بيع الثمار قبل أن تزهى من رسول الله، صلى الله عليه وسلم، واختلف العلماء في وقت بيع الزرع فقال بعضهم: إذا أفرك، وقال بعضهم حتى ييبس فأنا أجيز البيع إذا فات باليبس لما جاء فيه من الاختلاف، وأرده إذا علم به قبل أن ييبس.
وقد نص ابن رشد على أنه لا يجوز عند مالك وجميع أصحابه بيع شيء من ذلك حتى ييبس ويستغني عن الماء… إلا أنه إن بيع عندهم بعد أن أفرك وقبل أن ييبس لا يحكمون له بحكم البيع الفاسد؛ مراعاة لقول من يجيز ذلك من أهل العلم[30].
فمن خلال هذا النموذج تجلى أن القول فيه مبني على النظر إلى ما يؤول إليه ترتب الحكم بالنقض والإبطال، من إفضائه إلى مفسدة توازي مفسدة النهي أو تزيد[31]. وذلك أنه وقع فيه التصرف مخالفا لمذهب الإمام مالك ودليله، فكان ذلك يقتضي عدم ترتب آثاره عليه، إلا أنه لما كان في الحكم يمنع ترتب تلك الآثار ضرر أكبر، قال مالك بترتب الآثار بما يدفع الضرر نظرا إلى الوقاع، مراعاة لخلاف بعض العلماء في المسألة.
ﻫ. مراعاة المآلات من خلال تحقيق المناط الخاص
تحقيق المناط الخاص، كما ذكر الشاطبي، نظر في كل مكلف بالنسبة إلى ما وقع عليه من الدلائل التكليفية، بحيث يتعرف منه مداخل الشيطان ومداخل الهوى.. مع النظر فيما يصلح بكل مكلف في نفسه؛ بحسب وقت دون وقت وحال دون حال وشخص دون شخص… فصاحب هذا التحقيق الخاص يحمل على كل نفس من أحكام النصوص ما يليق بها[32]…
ومن تطبيقات هذه القاعدة؛ ما أورده ابن رشد في تفسير مالك لقوله تعالى: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الاَرض فسادا اَن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الاَرض﴾ [المائدة: 33]، وذلك أن الآية عند مالك على التخيير لا على الترتيب، والإمام مخير عنده في المحارب إذا أخاف السبل ولم يأخذ مالا ولم يقتل؛ بين أن يقتله وأن يصلبه أو يقطعه بخلاف أو يجلده أو ينفيه، وليس معنى تخييره في ذلك أن يعمل فيه بالهوى، وإنما معناه أن يتخير من العقوبات التي جعلها الله جزاءه ما يرى أنه أقرب إلى حكم الله وأولى بالصواب؛ فكم من محارب لم يقتل وهو أضر على المسلمين ممن قتل في تدبيره وتأليبه على قطع طرق المسلمين، فإن كان المحارب ممن له الرأي والتدبير فوجه الاجتهاد فيه قتله وصلبه، لأن القطع لا يدفع ضرره عن المسلمين، وإن كان ممن لا رأي له ولا تدبير، وإنما يخوف ويقطع السبيل بذاته وقوة جسمه قطعه من خلاف ولم يقتله؛ لأن ذلك يقطع ضرره عن المسلمين، وإن لم يكن على هذه الصفة وأخذ بحضرة خروجه؛ أخذ فيه بأيسر ذلك وهو الضرب والسجن[33].
و. اعتبار المآلات من خلال مراعاة المقاصد عامة
المقصود هنا؛ النظر في مآلات الأفعال والتصرفات؛ بما يراعي تحقق مقاصد الشريعة من ورائها بصفة عامة، ومن ذلك أن مالكا سئل “عن حيتان في برك يقل ماؤها فيطرح فيها السكران فيسكرها ذلك فتؤخذ، أفترى أن تؤكل؟ قال: ما يعجبني ذلك، ثم قال: أفيخاف على الذين يأكلونها؟ فقيل له: لا؛ قد جرب ذلك وإنه لا يضر ذلك، قال: ما يعجبني ذلك، وكرهه، وقال: هذا من عمل العجم.
قال محمد بن أحمد: إنما كره أكلها من ناحية الخوف على من يأكلها؛ وكأنه لم ير التجربة تصح في ذلك؛ قد يضر بعض الناس ولا يضر آخرين، لا من ناحية أن ذلك مما يؤثر في ذكاة الحيتان؛ لأنها لا تحتاج إلى ذكاة[34]“.
فالإمام مالك نظر في فتواه إلى مصلحة المستهلكين لذلك السمك الذي يتم صيده بتلك الوسيلة، اعتبارا لما قد يؤول إليه حال ذلك السمك فيصير به ما يضر ببعض الناس الذين يأكلونه؛ فمنع من استخدام تلك الطريقة في اصطياده حفاظا على صحة الناس الذين يستهلكونه.
وبعد؛ فإنه كما رأينا في مجموع ما سبق؛ فإن إمامنا كان حريصا على مراعاة مقاصد الشارع؛ من خلال عمله بمجموعة من الأصول والقواعد الاجتهادية. إلا أن مقاصد الشارع لا يمكن أن تتحقق مراعاتها إلا من خلال مقاصد المكلف وعلى هذا سنتكلم فيما يلي؛ عن اعتبار مقاصد المكلف في الحكم على تصرفاته، من جهة كونه أحد ضوابط ومسالك الاجتهاد المقاصدي عند مالك.
سادسا: الحكم على تصرفات المكلف بالنظر إلى مقاصده
لعله يكفينا في التدليل على تأصيل مالك لاعتبار مقاصد المكلف في الحكم على تصرفاته؛ بعض الأصول والقواعد التي عمل بها في اجتهاداته وبنى عليها كثيرا من الفروع الفقهية، ونقصد بذلك على وجه الخصوص؛ أصل سد الذرائع وقاعدة منع التحيل. علما بأن مراعاة تلك المقاصد هي أوسع وأعم من سد الذرائع ومنع الحيل؛ لأنها تعني النظر بصفة عامة لمقاصد المكلفين وبناء الأحكام عليها.
فلم يكن مالك يكتفي بالنظر إلى ظاهر التصرف ليحكم بصحته أو بطلانه، بل كان ينظر إلى غرض المكلف وباعثه وقصده من وراء إنشاء عقد معين والقيام يتصرف من التصرفات.
ومما يندرج في هذا الإطار عند مالك؛ أنه إذا دلت قرائن الحال على عدم قصد الحالف اليمين كالمكره، فإن مالكا لا يلزمه اليمين، إذا كان إكراهه بشيء يلحقه في بدنه من قتل أو ضرب أو سجن أو تعذيب[35]…
وكذلك الشأن إذا كان المقصود من اليمين الزجر عند الغضب فلا شيء فيها، كما نص على ذلك الونشريسي، وذكر عن مالك ما يشير إلى هذا المعنى عند تمحيص ما يقصده الناس من ذلك، فنقل عن ابن حبيب أن أعرابيا سأل مالكا عن ناقة له نفرت فانصرفت، فقال لها: تقدمي فأنت بدنة؛ يعني هديا إلى بيت الله. فقال له مالك: أردت أجرها بذلك؟ فقال: نعم. قال: لا شيء عليك. قال: أرشدت يا ابن أنس. ونقل الونشريسي عن ابن رشد في كلامه على هذه المسألة أنه لم يوجب عليه إخراجها، إذا لم تكن له نية في ذلك، إنما قصد زجرها لا القرب إلى الله تعالى في إخراجها. وهو الأظهر لقول النبي، صلى الله عليه وسلم: “إنما الأعمال بالنيات[36]“.
وإذا كان للمقاصد قطبان رئيسيان هما مقاصد الشارع ومقاصد المكلف، بحيث لا يمكن تحقيق الأولى إلا من خلال الثانية التي يجب أن تكون موافقة للأولى؛ فإنه لا يكفي المجتهد المعرفة بذلك فقط، بل لابد له من إحاطة ومعرفة واسعة بواقع الناس وأحوالهم وظروف الزمان والمكان الذي يفتي فيه لكي تكون الأحكام التي يقررها محققة للمقصود الشرعي من تشريعها، وهو ما حرص عليه مالك في اجتهاداته من خلال تحكيمه لأعراف الناس ومراعاته لاختلاف الأحوال، كما سيتبين من المسلك الاجتهادي التالي.
سابعا: مراعاة الأعراف وظروف الزمان والمكان والأحوال
أ. مراعاة الأعراف
من المسائل المختلف فيها بين الفقهاء، وقد اعتبر فيها مالك العرف؛ المسألة المتعلقة بتوزيع الربح في المضاربة، إذا اختلف صاحب المال والعامل في مقدار الربح المتفق عليه لكل منهما؛ حيث حكم مالك فيها العرف، فيكون القول العامل مع يمينه إن جرى عرف بمثل ما يدعيه.
وفي ذلك “قال مالك” في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، فربح فيه ربحا، فقال العامل؛ قارضتك على أن لي الثلثين؛ وقال صاحب المال؛ قارضتك على أن لك الثلث. قال مالك: القول قول العامل، وعليه في ذلك اليمين، إذا كان ما قال يشبه قراض مثله، وكان ذلك نحوا مما يتقارض عليه الناس، وإن جاء بأمر يستنكر ليس على مثله يتقارض الناس، لم يصدق، ورد إلى قراض مثله[37]“.
بينما رأى أبو حنيفة وأصحابه والثوري خلاف هذا الرأي؛ فقالوا: إذا ربح فقال رب المال: شرطت لك النصف، وقال العامل: شرطت لك الثلثين فالقول قول رب المال. كما خالفه الشافعي فقال: يتحالفان ويكون للعامل أجر مثله على رب المال[38].
والواقع أن ما ذهب إليه مالك بتحكيمه للعرف في هذه المسألة؛ أقرب إلى تحقيق مقاصد الشرع الداعي إلى اعتبار الأعراف الجارية بين الناس في معاملاتهم؛ ومن ثم نجد الباجي يقرر أنه إن ادعى العامل ما يشبه قراض مثله وادعى صاحب المال مالا يشبه، أو ادعيا جميعا ما يشبه، فإن القول قول العامل مع يمينه؛ لأن المال في يده فكان أولى بما يدعيه من ربحه، فإن ادعى صاحب المال ما يشبهه، دون العامل، فالقول قول صاحب المال؛ لأن الظاهر شهد له، وإن ادعى كل واحد منهما مالا يشبه؛ رد إلى قراض المثل بعد أيمانهما[39].
ب. مراعاة ظروف الواقع واختلاف الفتوى بتغيير الأحوال
جاء في العتبية؛ قال أشهب: سألت مالكا عن قول عمر بن الخطاب في الذي وجد البعير ضالا؛ أرسله حيث وجدته؛ فقال لي مالك: نعم يرسله حيث وجد، قلت له يشهد عليه أم لا؟ فقال: ما شأنه يشهد عليه؟ كأنه لا يرى ذلك عليه، ومعلوم أنه ثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال في ضالة الإبل جوابا عن السائل عنها، “مالك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها[40]“.
فالاختيار في ضالة الإبل ألا تؤخذ، فإن أخذت عرفت، فإن لم تعرف ردت حيث وجدت، جاء ذلك عن عمر بن الخطاب، وأخذ به مالك في أحد قوليه، وهو قوله هاهنا وفي المدونة، وقيل إنها تؤخذ وتعرف فإن لم تعرف بيعت ووقف ثمنها لصاحبها، فإن لم يأت وأيس منه تصدق به عنه، جاء ذلك عن عثمان بن عفان، وروي ذلك عن مالك أيضا: قال: من وجد بعيرا ضالا فليأت به الإمام يبيعه ويجعل ثمنه في بيت المال، يريد بعد أن يعرف[41]..
وواضح أن ما يفسر تغير الفتوى بشأن ضوال الإبل؛ هو مراعاة المصلحة المعتبرة في ذلك تبعا لتغير الظروف المحتفة بضوال الإبل؛ من حيث اختلاف الزمان وتغير أحوال الناس.
وقد ذكر ابن رشد أنه إنما اختلف الحكم في ذلك من عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان لاختلاف الأزمان بفساد الناس، ثم جاء مالك فرأى أن يكون الحكم فيها ببيعها وجعل ثمنها في بيت المال إن كان الإمام عدلا، وإن كان غير عدل يخشى عليها إن أخذت ردت حيث وجدت[42].
ولعل من أهم مكملات فقه الواقع وما يتصل به، خاصة في العمل القضائي والفصل في النزاعات وإثبات الدعاوى، ما يتعلق بقرائن الأحوال التي تعتبر من وسائل الإثبات عند مالك، وعلى هذا سنتكلم عن العمل بها عنده فيما يلي.
ثامنا: العمل بالقرائن
القرائن أمارات ظاهرة تقارن شيئا خفيا وتدل عليه، وأن مالكا كثيرا ما كان يرجع إليها ويعتمدها في الأحكام حتى عدت من قواعده التي بنى عليها مذهبه.
ومن أمثلة العمل بها عنده؛ ما ذهب إليه موافقا من حكم من الصحابة[43] بوجوب الحد على من وجد فيه رائحة الخمر أو قاءها، اعتمادا على القرينة الظاهرة[44].
جاء في العتبية أن مالك سئل عن الرائحة توجد بالرجل، قال: إن شهد عليه ذوا عدل أنه شرب مسكرا حد، وإن لم يستيقن وكان من أهل السفه نكل، وإن كان رضي في حاله لم أر عليه نكالا ولا حدا[45].
وقال مالك بلغني أن عمر بن الخطاب رأى رجلا قاء خمرا، فقال لأبي هريرة: أتشهد أنه شرب خمرا؟ قال: أشهد أنه قاءها، فقال: ما هذا التعمق؟.
قال ابن رشد: يجوز للشاهد أن يشهد بما علم من جهة النظر والاستدلال، كما يجوز له أن يشهد بما علمه ضرورة بالعين، وإنما توقف أبو هريرة عن الشهادة أنه شربها لاحتمال أن يكون لم يشربها باختياره، وإنما أكره عليها فصبت في حلقه، ولم ير عمر الشهادة تبطل بهذا الاحتمال؛ لأن أمره يحمل على أنه شربها باختياره، إذ لم يدع أنه أكره على شربها، وإنما أنكر أن يكون شربها، ولهذا قال له: ما هذا التعمق[46]؟.
وبعد؛ فإذا كان الإمام مالك شديد الحرص على تعرف المقاصد والإحاطة بها، ثم العمل على تحقيقها من خلال التشريعات والأحكام التي يقررها، فإن هذا النهج لا يطرد عنده في كل أحكام الشريعة؛ حيث يقتصر في ذلك على ما هو من قبيل المعاملات والعادات وما شاكلها، بينما يقف في مجال العبادات في الأغلب عند المنصوص عليه فيها، كما سيتضح من خلال ما يلي.
تاسعا: تغيب عدم الالتفات إلى المقاصد في العبادات
قرر الشاطبي أن مالكا التزم في العبادات عدم الالتفات إلى المعاني وإن ظهرت لبادي الرأي، وقوفا مع ما فهم من مقصود الشارع فيها من التسليم على ما هي عليه[47] فتبين بهذا أن الأصل عند مالك عدم التعليل في العبادات، إلا استثناء، ومن ثم فالاجتهاد في العبادات بناء على إعطاء تعليلات لها، لا يقوم على أساس سليم. على أنه يصح للمكلف القصد إلى الفوائد المشروعة للعبادات وثمراتها المرجوة، إلا أن الواقف مع مجرد الأتباع في العبادات أولى بالصواب، وأجرى على طريقة السلف الصالح، وهو رأي مالك رحمه الله[48].
ومن أمثلة ذلك في اجتهادات مالك أنه لما سئل “عن الرجل يؤدي زكاة ماله قبل حلولها، قبل أن يحول على ماله الحول، أترى عليه إعادة الزكاة؟ قال: نعم أرى ذلك عليه، أرأيت الذي يصلي الظهر قبل زوال الشمس، أو الصبح قبل إطلاع الفجر، أليس يعيد؟ فهذا مثله[49]“.
وقد بين ابن رشد أن ظاهرة هذه الرواية الواردة في العتبية؛ أن الزكاة لا تجزيه إذا أخرجها قبل محلها، وإن كان ذلك قريبا، وعلى هذا حمل ابن نافع قول مالك، فقال: معناه أنها لا تجزيه إلا بعد محلها، فإن أداها قبل محلها لم تجزه، وقد قيل إنها تجزيه إن كان قريبا؛ وإن اختلف في حد القرب… والأظهر حسب رأي ابن رشد أنها تجزيه إذا أخرجها قبل المحل بيسير؛ لأن الحول توسعة فليس كالصلاة التي وقتها محدود لا يجوز أن تعجل قبله، ولا تؤخر بعده؛ ولو كانت الزكاة كالصلاة في هذا، لوجب أن يعرف الساعة التي أفاد فيها المال ليخرج الزكاة عندها، وفي هذا تضييق[50].
والواقع أن هذا الرأي الذي ذهب إليه ابن رشد؛ فجعل الزكاة تجزيه إذا أخرجها قبل المحل يسير هو ورأي الإمام مالك نفسه حسب رواية المدونة، التي جاءت مفصلة ومفسرة لما نقلناه عن مالك في العتبية؛ وذلك أنه ورد في المدونة؛ “قلت؛ (أي سحنون)،: أرأيت الرجل يعجل زكاة ماله في الماشية أو في الإبل أو في الزرع أو في المال السنة أو السنتين أيجوز ذلك؟ فقال (أي ابن القاسم): لا. قلت: وهو قول مالك؟ قال نعم. قال وقال مالك؛ إلا أن يكون قرب الحول أو قبله بشيء يسير فلا أرى بذلك بأسا، وأحب إلي أن لا يفعل حتى يحول عليه الحول[51]“.
وهذا الرأي المجيز لإخراج الزكاة قبل الحول بيسير، يوافق القاعدة الفقهية التي اشتهرت عند المالكية؛ وهي ما قارب الشيء يعطى حكمه[52]“.
وقد ذكر ابن رشد أقوالا في المذهب المالكي تحدد القرب الذي يجزئ في إخراج الزكاة، حيث نقل في ذلك أربعة أقوال: أحدها أنه اليوم واليومان؛ وهو قول ابن المواز، والثاني أنه العشر الأيام ونحوها؛ وهو قول ابن حبيب، والثالث أنه الشهر ونحوه؛ وهو رواية عن ابن القاسم، والرابع أنه الشهران ونحوهما[53].
ومثل هذه الأقوال نقلها الدكتور أحمد الريسوني عن ابن العربي، ثم نقل عنه قوله في التعليق على تلك الأقوال؛ بأن الذي يصح في النظر ترك التقديم أصلا أو التقديم مطلقا[54]. ثم بين أن ابن العربي ضاق بتلك التحديدات التي لاهي وقفت مع التعبد ومع قول الإمام، ولا هي فتحت باب التسهيل والمصلحة… وذكر أن المهم عنده من إيرادها هو أنها كلها لم تتقيد بقول الإمام مالك[55].
والذي نريد التنبيه عليه هنا؛ هو أن تلك الأقوال هي في الواقع مستوحاة من قول مالك نفسه ورأيه الذي نقلناه عنه قريبا. كما جاء بنصه في المدونة؛ حيث: قال: ” إلا أن يكون قرب الحول أو قبله بشيء يسير فلا أرى بذلك بأسا”؛ فالإمام مالك نفسه لم يقف في هذه المسألة مع مطلق التعبد، بل أجاز التقديم عن حلول الحول باليسير، وإنما اختلف علماء المذهب فيما بعد في تحديد المقصود بذلك الشيء اليسير الذي أجازه الإمام مالك.
كما تظهر هذه التوسعة عند مالك في زكاة الفطر؛ حيث روي عن نافع أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة[56]، ثم قال مالك: وذلك واسع إن شاء الله، أن تؤدى قبل الغدو من يوم الفطر وبعده[57].
وبعد؛ فهذه المسالك والضوابط الاجتهادية التي عالجناها، إن دلت على شيء فإنما تدل على مدى انضباط المنهج الاجتهادي للإمام مالك بقواعد مقاصدية واضحة، وكما رأينا فإن المقاصد الشرعية حاضرة دائما في ذهن إمامنا الجليل؛ وفي ذلك ما يبرهن على مراعاتها باستمرار في المنهج التشريعي الذي اعتمده وبنى عليه فقهه، مع مراعاته الوقوف في العبادات عندما يفهم من قصد المشرع فيها من التسليم بها على ما هي عليه؛ وقوفا مع ما شرعه المشرع من تفاصيل أحكام شعائرها.
ومن ثم فإنه قد يكفي المجتهدين في أحكام الشرع الاهتداء بذلك النهج؛ لكي يستنبطوا الأحكام وفق ما ترتبط به من علل وحكم ومقاصد، في مجال المعاملات وما يجري مجراها على وجه الخصوص، وينزلوها على واقع الحياة التنزيل الصحيح… مع عدم إغفال الإفادة من المقاصد العامة للعبادات، وعلل الرخص الواردة فيها.
الهوامش
[1]. أحمد الريسوني، الفكر المقاصدي قواعده وفوائده، الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، سلسلة كتاب الجيب، رقم 9، دجنبر 1999، ص34-35.
[2]. نور الدين بن مختار الخادمي، الاجتهاد المقاصدي: حجيته، ضوابطه، مجالاته، سلسلة كتاب الأمة رقم 65، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية/قطر، ط1، (جمادى الأولى 1413ﻫ غشت/شتنبر 1998م)، ج 1، ص 39.
[3]. أحمد الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الرباط: دار الأمان، ط1، (جمادي الأولى 1411ﻫ/يناير 1991م)، ص 258.
[4]. الإمام مالك بن أنس، الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي، تعليق: نحند فؤاد عبد الباقي، القاهرة: دار الحديث، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها، د. ت، ج1، ص 226.
[5]. ابن رشد (الحفيد)، بداية المجتهد نهاية المقتصد، بيروت: دار الكتب العلمية/لبنان، ط10، (1408ﻫ/1988م)، ج1، ص275.
[6]. ابن عبد البر، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك بالإيجاز والاختصار، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، دمشق/بيروت: دار الوعي، حلب، القاهرة، توزيع مؤسسة الرسالة، ط1، (1414-1413ﻫ/1993م)، ج9، ص204.
[7]. الإمام مالك ابن أنس، المدونة الكبرى، رواها سحنون عن عبد الرحمن بن القاسم عن إمام دار الهجرة، بيروت: دار صادر، د. ت، ج 2، ص 295.
[8]. محمد عبد القادر أبو فارس، مقال: القضاء بشاهد ويمين، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، تصدر عن جامعة الكويت، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، السنة 3، العدد 6، (ربيع الأول 1406ﻫ/دجنبر 1986م)، ص223.
[9]. أخرجه مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه، ج 2، ص 277، وابن ماجة في سننه، ج 2، ص793، رقم 2370.
[10]. الموطأ، كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين مع الشاهد، ج 2، ص 557.
[11]. محمد الزرقاني، شرح الزرقاني على الموطأ، بيروت: دار الكتب العلمية/لبنان، ط1، (1411ﻫ/1990م)، ج 3، ص 496.
[12]. الموطأ، كتاب النكاح، باب ما جاء في الصداق والحياء، ج 2، ص 416.
[13]. أبو الوليد سليمان الباجي، المنتقى شرح موطأ الإمام مالك، بيروت: دار الكتاب العربي، د. ت، ج 3، ص 280.
[14]. الموطأ، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض، ج 2، ص 448. والمدونة، ج 6، ص 34.
[15]. محمد رياض، التعسف في استعمال الحق على ضوء المذهب المالكي والقانون المغربي، مراكش: المطبعة والوراقة الوطني، ط1، (1412ﻫ/1992م)، ص 122.
[16]. مدخل إلى أصول الفقه المالكي، محمد المختار ولد أباه، ص 132.
[17]. محمد أبو زهرة، مالك حياته وعصره آراؤه وفقهه، دار الفكر العربي، د. ت، ص 342.
[18]. ابن رشد (الجد)، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في المسائل المستخرجة، تحقيق: محمد حجي وأساتذة آخرين، بيروت: دار الغرب الإسلامي/لبنان، (1046ﻫ/1986م)، ج 9، ص 318- 319.
[19]. أبو إسحاق الشاطبي، الاعتصام، بيروت: دار المعرفة/لبنان، (1402ﻫ/1982م)، ج 2، ص 124.
[20]. حسين حامد حسان، نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي، القاهرة: مكتبة المتنبي، 1981، ص 94.
[21]. جميل محمد بن مبارك، نظرية الضرورة الشرعية حدودها وضوابطها، المنصورة: دار الوفاء، ط1، (1408ﻫ/1988م)، ص 28.
[22]. البيان والتحصيل، م، س، ج 1، ص 73.
[23]. المرجع نفسه، ج 1، ص 89، وانظر ص 118.
[24]. كتاب التكملة، س1، ص 69- 68.
[25]. نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي، م، س، ص 194- 195.
[26]. البيان والتحصيل، م، س، ج 1، ص 261- 262، وانظر ج 18، ص 61- 62.
[27]. المرجع نفسه، ج 7، ص 89- 99.
[28]. المرجع نفسه، ج 2، ص 482- 483.
[29]. أفرك السنبل: صار فريكا؛ وذلك حين يصلح أن يفرك؛ (أي يدلك ويحك حتى ينقلع قشره) فيؤكل؛ انظر لسان العرب مادة “فرك”.
[30]. البيان والتحصيل، م، س، ج 7، ص 465.
[31]. أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، شرح الشيخ عبد الله بن دراز، ضبط وترقيم: محمد عبد الله دراز، بيروت: دار المعرفة/لبنان، ط2، (1396ﻫ/1975م)، ج 4، ص 205.
[32]. المرجع نفسه، ج 4 ص 98.
[33]. البيان والتحصيل، م، س، ج 16، ص 418. وانظر الإمام مالك مفسرا، حميد لحمر، ص 177.
[34]. المرجع نفسه، ج 3، ص 277- 278.
[35]. المرجع نفسه، ج 6، ص 119.
[36]. أبو العباس أحمد الزنشريسي، المعيار المعرب والجامع المعرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب، خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجي، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية/المغرب، (1401ﻫ/1981م)، ج 2، ص 100، والحديث رواه الستة وغيرهم.
[37]. الموطأ، ج 2، ص 539.
[38]. الاستذكار ج 21، ص 188- 189.
[39]. المنتقى، ج 5، ص 180.
[40]. أخرجه مالك في الموطإ، كتاب الأفضية، باب القضاء في اللقطة، ج 2، ص 579- 580. كما أخرجه البخاري، كتاب اللقطة، باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها، ومسلم كتاب اللقطة، حديث 1.
[41]. البيان والتحصيل، م، س، ج 15، ص 359.
[42]. المرجع نفسه، ج 15، ص 360.
[43]. وهم عمر وعثمان وابن مسعود.
[44]. عمر الجيدي، محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي، منشورات عكاظ، الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، د. ت، ص 144.
[45]. البيان والتحصيل، م، س، ج 16، ص 285.
[46]. المرجع نفسه، ج 16، ص 296. وانظر ج 17، ص 182؛ حيث أضاف موضحا ما تضمنه قول مالك: إن عمر بن الخطاب قال لرجل: أتشهد أنه شرب خمرا؟ قال: أشهد أنه قاءها، قال عمر: هذا التعمق؛ يعني في الشهادة.
[47]. الاعتصام، م، س، ج 2، ص 132.
[48]. الموافقات، م، س، ج 2، ص 304.
[49]. البيان والتحصيل، م، س، ج 2، ص 366.
[50]. المرجع نفسه، ج 2، ص 366- 367.
[51]. المدونة الكبرى، م، س، ج 2، ص 284.
[52]. انظر أبو عبد الله المقري، القواعد (أو قواعد الفقه)، تحقيق: محمد الدردابي، أطروحة دكتوراه بدار الحديث الحسنية، بالرباط، القاعدة 87، (1400ﻫ/1980م)، على أنه نبه فيها على اختلاف المالكية في إعطاء ما قرب من الشيء حكمه أو بقائه على أصله، وانظر إيضاح المسالك ص 170، حيث صاغ الونشريسي هذه القاعدة في شكل سؤال كعادته؛ فقال: “ما قرب من الشيء هل له حكمه أم لا”؟
[53]. البيان والتحصيل، م، س، ج 2، ص 366-367.
[54]. نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، م، س، ص 338، (نقلا عن عارضة الأحوذي، ج 3، ص 192.)
[55]. المرجع نفسه، ص 338.
[56]. الموطأ، كتاب الزكاة، باب إرسال زكاة الفطر، ج 1، ص 237. والمدونة، ج 2، ص285.
[57]. الموطأ، ج 1، ص 237.







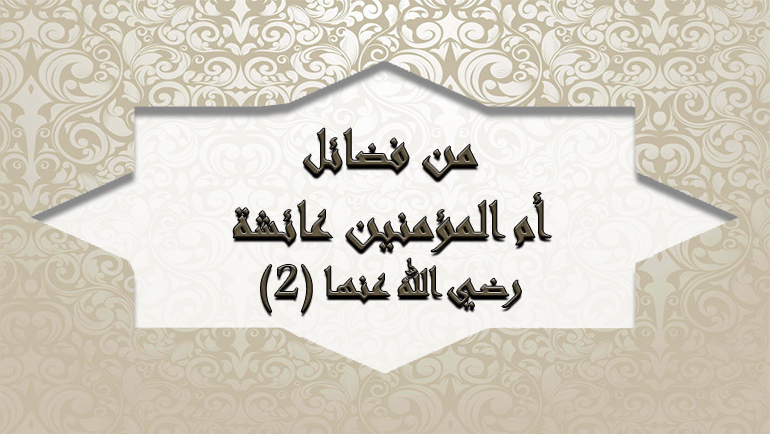
شكر الله مجهودكم وزادكم من فضله