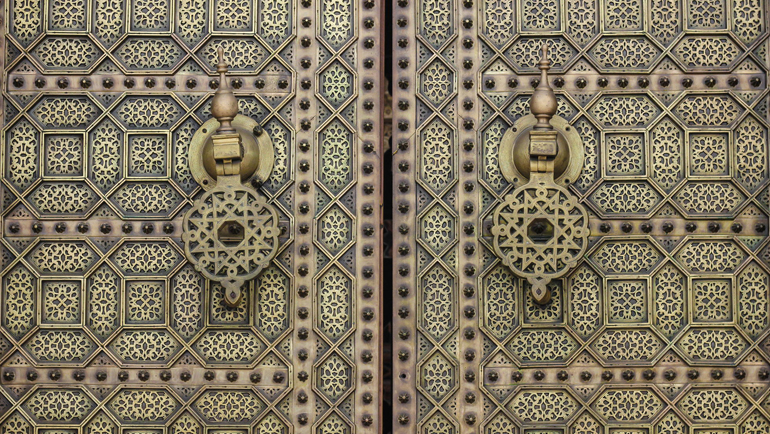
الشريعة عدل كلها ورحمة كلها، لهذا المقصد أتت وعلى بنيانه انبنت، فسواء أكانت مصادرها نصا أو معقول نص، وسواء تعددت الأدوات والمناهج لاستنباط الأحكام منها، فالوسائل والمقاصد هنا لا تتخلف عن تحقيق هذه القيمة، التي عدت بالاستقراء التام مبدءًا معنوياً عاما قام عليه الوجود ووظائف الموجود، واختزنته مقاصد القرآن وحقائق العمران، وأناط به الحق سبحانه التكليف، فجعل مبناه على التخفيف، وربط مصالح العباد بإقامة القسط والاحتراز من التطفيف.
وكان مما أفصح عنه الشرع أن بالعدل قامت السماوات والأرض، قال تعالى: ﴿والسماء رفعها ووضع الميزان﴾ (الرحمن: 5)، وعليه المدار في تحقيق مقام الاستجابة، قال سبحانه: ﴿إن الله يامر بالعدل والاِحسان﴾ (النحل: 90)، ﴿إن الله يامركم أن تودوا الاَمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل﴾ (النساء: 57)، ﴿فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا﴾ (النساء: 134)، ﴿اعدلوا هو أقرب للتقوى﴾ (المائدة: 9).
وبه التشوف والتعرف إلى جلال الله سبحانه؛ إذ من أسمائه الحكم العدل. ومن ثم نشد التشريع إقامة ميزان القسط في العبادات، فلا إفراط ولا تفريط، ولا رهبانية أو غلواء، وسدد به قوام المعاملات فلا ضرر ولا ضرار، وتحقق بفضله في السلوك التآلف والتسامح؛ فالمومن يألف ويؤلف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف.
فكان العدل، إذن، أصل العمران وبه قامت الأرض ودامت الدولات، وكان أهم ما ينشأ عنه صفتين إن هما تحققتا سعدت الأمة ودام بقاؤها وهما: الحرية والأخوة.
فإن الحرية إن لم يكن معها عدل ذبلت حتى تسّاقط إلى الحضيض؛ إذ حقيقتها أن يأخذ المرء بكل حقوقه، وأن يفي بجميع حقوق غيره، وأن يصدع بآرائه، وهذا كله لا يكون بغير العدل[1]، والحرية لمن درى قبل تطبيق الشريعة؛ إذ لا يتأتى تطبيقها دونها، وهذا مناف لمنطق العدل، الذي جعل إقامة العقيدة في النفوس مؤسسا على الاختيار، بأن تكون عبدا لله اختيارا كما كنت عبدا له اضطرارا، واستتبع ذلك ما يتعلق بالعبادات والعادات.
ابتغيت من خلال هذه المباحثة المتواضعة الكشف عن بعض الحقائق التي لا تخلو الشريعة في جميع أصولها وفصولها من ترسيخ تلك القيمة السنية، والمفهوم الخصب، الذي تجد صداه في الأمر والنهي، ومقدماتهما وفي مدارك التشريع جملة.
وأحب أن أعرض في لمعة خاطفة إلى علاقة هذا المفهوم بالمصادر الأصلية والتبعية في المذهب المالكي، فإذا أمكن ذلك فسوف يلين جانب مسائل الأحكام وطرق الاستدلال ومدارك الخلاف والخصائص والمقاصد لاحتمال هذا المعنى الذي زخرت به أصول هذا المذهب ومظانه.
وهنا سوف نجد امتدادا لهذا المفهوم في المصادر الأصلية والتبعية، وإن كان الفصل بينها لا يتجه؛ إذ كلا الضربين مفتقر إلى الآخر، ويكاد يتفصّى عن هذا التحقيق دركُ ما تزخرُ به المصادر، نصية أو اجتهادية، من معان سَنية ابتغى فيها المشرع أن يكون القصد في التكليف موافقا لقصد الله في التشريع.
ولن أتجاوز جماع المصادر، والتي ينبني عليها غيرها، حتى يتهيأ النهل من كلياتها إجمالا ويُستتبع بعدُ تفصيلا، وأجعلها بحول الله على قسمين وهي:
المبحث الأول: المصادر الأصلية
المطلب الأول: القرآن الكريم
استبطن مفهوم العدل في القرآن مقاصد الدين جملة، فكان أشرف المأمورات؛ إذ كسته حلة القدسية وجلال المصدرية، فقال سبحانه: ﴿إن الله يامر بالعدل﴾ وهذه الآية اختزنت (ما يتصل بالتكليف فرضا ونفلا، وما يتصل بالأخلاق والآداب عموما وخصوصا) حتى صرح ابن مسعود، رضي الله عنه، أنها “أجمع آية في القرآن للخير والشر[2].”
والعدل الذي أمر به القرآن يشمل كل أنواع العدل وصوره، فهو عدل مع النفس، وعدل مع الله تعالى، وعدل مع الغير، وهو عدل في الأقوال وفي الشهادة وفي الحكم، وعدل في حياة الأسرة، وعدل مع المسلم وغيره؛ إذ من خصائصه أنه لا يتجزأ، ولا يتقلب، وعدل في المعاملات والمبادلات، والجنايات والسياسات، والأحوال الشخصية، وجماع أمره النظر إليه من أبعاد ثلاثة:
1. العدل القانوني والقضائي.
2. العدل الاجتماعي.
3. العدل الدولي[3].
فلا يمكن على هذا الأساس إلا التسليم بقطعية هذا المقصد الذي ارتبط بمجالات التشريع، ومن ثم فلا يمتنع إدخال قيم أخرى وإدماجها في مراتب المقاصد بعد الدين والنفس والعقل والنسل والمال والعرض، مثل “حفظ الذكر، وحفظ العدل، وحفظ الحرية، وحفظ التكافل.. لأن الحاصل بطريق الاستقراء يتقلب بتقلب الأطوار الإنسانية، بحيث قد يفضي تقلب هذه الأطوار إلى ظهور قيم ضرورية جديدة يجوز أن نجد لها أدلة في النصوص الشرعية لم نكن نلتفت إليها قبل حصول هذا التقلب[4].”
إن النظر إلى تقرير معنى العدل في أشرف المصادر على الإطلاق يتجاوز المعنى التجريدي ليسبح في مدارك أرشد النص إلى اعتبارها موجهات أساسية لتحقيق هذا المقصد، به يُتكيف مع إلزامات الوحي، وبمعيته يجاوره في طريقه نحو الوقوع، ومن ثم فإذا كان تبين العدل بطريق النص، بما يمثل مراد الشارع من حِكمه وغايته، فإن الاجتهاد وثيق الصلة به؛ لأنه الجهد العقلي المبذول بأقصى طاقاته، لتفهم مراد الشارع من النص، وتحديد هدفه، فهو، إذن، وسيلة تبين العدل، وتحديد معالمه، وبدونه يفقد العدل ما به يُعرف نظرا، وما به يتحقق عملا وتطبيقا في الواقع الوجودي.
لذا ندرك بجلاء ما يربط الرأي بالعدل في شرع الله، ومن ثم يتبدى لك عمق النظر الأصولي عند الإمام الشافعي حين اعتبر الاجتهاد فرضا من فرائض الدين. ولأن الاجتهاد يصحب الاستدلال، ومداره ابتداء على النص وحيثما الاجتهاد فثم الاستدلال، أمكن أن يكون وسيلة إلى تقرير الحق والعدل، فالاجتهاد بالرأي والعدل متلازمان، فلا اجتهاد بالعقل المجرد، ولا عدل بدون اجتهاد بالرأي في الشرع[5].
المطلب الثاني: السنة النبوية
تعد السنة تفسيرا بيانيا وتطبيقا عمليا لما ورد في كتاب الله تعالى، وقد ترسخ مفهوم العدل على مستوى بلاغها، ورسالتها التي عُدّت ثاني مصدر للتشريع في مصادره الأصلية، وانعكس هذا المنهج على مسالكها العامة، حيث احتفى العلماء منذ تدوينها بالإلمام بقيم العدل في مجالي الرواية والدراية، ولا يمكن الإحاطة بذلك لكن أهم ما ينبغي المثول عنده لائح في:
1. ضوابط الرواية
إن الأساس الأول لقبول الحديث هو أن يكون راويه قد أداه كما سمعه، وهو أمر واضح لا جدال فيه، مما يوجب علينا أن نخبُر أحوال الرواة، وقد اشترط المحدثون شروطا دقيقة شديدة في الراوي لكي تقبل روايته، وخلاصة هذه الشروط أمران[6]:
أ. الشرط الأول: العدالة؛ يعني أن يكون راويه عدلا، وهذا يوازي ما نسميه اليوم: “الأمانة العلمية”، لكنها أشد من مفهومنا في هذا العصر؛ لأنها تشتمل على العقل والبلوغ والتقوى، وترك ما يخل بالمروءة؛ أي العرف الاجتماعي السليم، وترك الكبائر، وعدم الإصرار على الكبائر.
ب. الشرط الثاني: الضبط؛ وهو يوازي ما نعبر عنه بـ”الكفاءة العلمية”، لكن شرط المحدثين أقوى؛ لأن الضبط عندهم يعني حفظ الحديث من حين سمعه الراوي إلى أن يؤديه ويرويه، إما عن ظهر قلب، أو مكتوبا عنده على أصل محفوظ عن أن تصل إليه الأيدي إلا بشروط دقيقة.
وهذا كله لعمري ينبثق عن أساس أن هذا العلم دين فلينظر المرء ممن يأخذ دينه؟ وأن الإسناد من الدين، فلهذا استجمعت هذه الضوابط مقصدا عاما عليه يقوم بنيان البلاغ في السنة النبوية وهو العدل.
2. الرواية عن المبتدعة
قال ابن الصلاح، في مقدمة علوم الحديث: “فإن كتبهم؛ أي المحدثين طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة، وفي الصحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد والأصول.”
يقول شيخنا الدكتور إبراهيم بن الصديق: وهذا غاية ما يكون من التسامح والمرونة ووزن الأمور بميزان الشرع والعقل، ولذلك نتيجة الاستقراء والتتبع حسب الجهد والطاقة أن أهل السنة مع غيرهم يفترقون في أمر هام وأساسي هو أنهم؛ (أي أهل السنة) امتازوا بالتسامح وسعة الصدر وعدم العصبية والتشنج سواء في مناظراتهم مع تلك الفرق أو في كتاباتهم عنهم أو، وذلك هو الأهم، في التغاضي عن بدعهم حين يكون الحكم والسلطان والخلافة والدولة لأهل السنة. كما هو ثابت تاريخيا وواقعيا، إلا في النادر جدا. بل بلغ تسامح أهل السنة بالنسبة إلى المبتدعة أن قبلوا رواياتهم لحديث رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وصدقوهم فيها. وقعدوا أصلا عظيما في هذا الباب حين قالوا إن المبتدع الذي لا يكفر ببدعته إذا كان صادقا ضابطا لحديثه ولم يكن داعية إلى بدعته تقبل روايته للحديث ويعمل بها في الحلال والحرام وبقية الأحكام الشرعية[7].
وهذا تحقيق وظيفي لمبدأ العدل في عمل أهل السنة، دونهم ملل ونحل وقفت موقفا حاسما وسارت مذهبا حازما في رد كل ما لا يتوافق مع رأيها وينتهج سبيلها، ومن ثم لا يؤبه بما يعترض به المتشددون على الإمام البخاري وغيره بروايته عن بعض المبتدعة، فقد تبين مستند منهج أهل السنة في الرواية والدراية، وبه التحقق من جمع الرواية ثم التتبع والاستقصاء ما أمكن، وهم من عرفت ألحاظهم وأبشارهم كلام رسول الله، عليه الصلاة والسلام، وتشربت أفئدتهم هديه فلا يحتاج الأمر بعده إلى شك أو ريب.
وهذا الأمر يستثنى منه ما لو صار حديثهم علما على ريبة أو شائبة هوى، قال أحمد بن أبي الحواري: “سمعت بعض أصحابنا يقول: كان مالك إذا قيل له: هذا الحديث يحتج به أهل البدع تركه[8].”
ونصوص السنة عامة مرنة، سواء قررت حكما في القرآن أو بينته وخصوصا ما أنشأت فيه حكما سكت عنه القرآن، لترتبط بالظروف والملابسات، وهذا مما لا يقف عقبة في سبيل التطور التشريعي، ومن ثم ينبغي التفريق بين السنة التشريعية وغيرها، ومصاحبة بعد النظر في تصرفات النبي، صلى الله عليه وسلم، من حيث الإمامة أو التبليغ أو الفتوى.. لينبني عليها فقه متجدد وأحكام مصلحية تتعدى الجمود مع المنقولات وما هو من قبيل ضربة لازب.
ولا نبارح هذا المقام دون توكيد ما نص عليه المصدران، مما يتوافق مع المنشود في هذه المباحثة ثم ما يتفصّى عنه من الإلمام بقواطع النظام الشرعي العام، التي عليها تبنى القواعد وربط المعاقد، ويتحق فيها مبدأ العدل السائد، ومنها:
ـ “ألا تزر وازرة وزر أخرى”؛
ـ سد الذرائع؛
ـ مبدأ الرضائية في العقود؛
ـ نفي الحرج في الدين؛
ـ لا ضرر ولا ضرار؛
ـ درء الحدود بالشبهات..[9].
ـ المساواة: فكل ما شهدت الفطرة فيه بالتساوي بين المسلمين فالتشريع يفرض فيه التساوي بينهم كذلك، وقد أجمع علماء الأمة على أن كل خطاب في القرآن بصيغة التذكير يشمل النساء، ولا تحتاج العبارة من هذا النوع في المصدرين إلى تغيير لشمولها الجنسين.
المطلب الثالث: الإجماع
وهو اتفاق أهل الحل والعقد من هذه الأمة في أمر من الأمور، وإن قطعوا بقولهم في كل أمة فهو حجة لاستناده إلى حجة قاطعة؛ لأن العادة لا تختلف في الأمم.
قال القرافي: “والعمدة الكبرى أن كل نص من هذه النصوص (المؤيدة لحجية الإجماع)، مضموم للاستقراء التام من نصوص القرآن والسنة وأحوال الصحابة، وذلك يفيد القطع من المطلع عليه، وأن هذه الأمة معصومة من الخطأ، وأن الحق لا يفوتها فيما بينته شرعا، فالحق واجب الاتباع فقولهم واجب الاتباع…[10].”
والمعتبر في كل فن أهل الاجتهاد فيه، وإن لم يكونوا من أهل الاجتهاد في غيره. والذي لا شك فيه أن الإجماع مصدر تشريعي شديد الخصب؛ لأن الأمة تستطيع به أن تواجه كل ما يقع فيها من أحداث، وأن تساير به الزمن، وتكفل لمختلف البيئات مصالحها المختلفة، على أنه يعتبر وسيلة إلى تضييق دائرة الخلاف بين المسلمين؛ لأن ذوي الرأي فيهم إذا تشاوروا في الواقعة وتدارسوها، أمكن أن يصلوا فيها إلى حكم يكفل المصلحة، ولا يسمح بالخلاف..
وذاك عين العدل، ليتقرر بعده أن مبدأ هذا الأصل ومنشأ فكرته هو مبدأ الشورى الذي قرره المولى عز وجل: ﴿فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الاَمر﴾ (ءال عمران: 159)، ثم جعله من عمد الدين كإقامة الصلاة… إذا عرفنا هذا أدركنا إلى أي مدى يفسح الشارع الإسلامي المجال أمام رعاية المصلحة والعدل؛ لأنه يأمر بالشورى منشأ الإجماع، ويصف المومنين المستجيبين لربهم بها، ولعله لا معنى لإجماع يتجاهل مقتضيات البيئة، ومطالب الجماعة، وحاجات الناس ومصالحهم[11].
فالإجماع الذي ثبت أن مستنده لم يكن مصلحة زمنية عابرة، كالنص القطعي سواء بسواء، فهو عين الحق والصواب دون شك أو ارتياب.
المطلب الرابع: القياس
إن جميع العلل والأسباب التي شرعت لأجلها الأحكام منبنية على دفع الضرر والحرج وجلب النفع والخير، ولا تعقل في الشريعة علة حكم لا تلج في عموم المصلحة، وما القياس إلا إلحاق المستجدّ بما سبق، لأجل اشتباههما في علة الحكم.
والقياس في اللغة التسوية، وفي الشرع مساواة الفرع للأصل في ذلك الحكم فسمي قياسا، والتعليل كما يكون بالوصف يتأتى بالحكمة؛ لأنها أصله، وأصل الشيء لا يقصر عنه، ولأنها نفس المصلحة والمفسدة وحاجات الخلق، وهذا هو سبب ورود الشرائع، فالاعتماد عليها أولى من الاعتماد على الفرع.
وما دامت أحكام الشرع معللة بمصالح العباد، من درء المفاسد وجلب المصالح، فأهل الاجتهاد يُملى عليهم في كل زمان ترصد التصرفات وتوجيه الأحكام، وهذا ما لا تحده الحدود ودونه استيعاب الجزئيات في الشريعة لعدم كفاية الدليل النقلي، ومن ثم اقتضى العدل التشريعي إعمال النظر في الأحكام السابقة والمؤالفة لجامع بينهما، وهذا ما يُعزز عند المجتهد آليات إحكام النظر العقلي، والذي مافتئت الإنسانية تتطلع مذ أن فتر الوحي وامتد الاستمداد من باكورة العقل المُوجّه بنوره، إلى استشراف الأمل في الاجتهاد حركة عقلية في أحكام الدين المشروعة لمصالح الأمة، وما زال أثر ذلك ساريا حتى إذا تقرينا الواقع والوقائع على البعد التاريخي ابتداء من عصر النبوة إلى وقتنا المعاصر، ألفينا أن الأعصار والأمصار التي أينعت فيها الحركة الاجتهادية كلها وسمت بميسم الازدهار والابتكار، في حين كان عصر الركود والجمود: كل وقت نفق فيه سوق العلم وركدت فيه حركة العقل ولم يستجب فيه الفقه التاريخي لتموضعات عصره وعجز عن تحقيق التوازن النفسي والواقعي والنظمي المعاصر للحياة، فخابت الأهداف التي يتوخاها الفقه غالبا لرسم حركة المجتمع، وساد الاجترار والتقليد المستميت الناقل من اليسر إلى العسر ومن جمع القلة إلى جمع الكثرة مما انعكس سلبا على الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بله المدارك العلمية والثقافية.
والقياس لا يُشترط فيه اتفاق المجتهدين، بل هو عمل فردي لكل مجتهد، والحوادث تتجدد كل يوم، وتختلف باختلاف البلدان، وليس لها من دليل غير القياس الذي يلحقها بما هو منصوص عليه أو مجمع عليه[12].
المبحث الثاني: المصادر المقاصدية
المطلب الأول: المصلحة
لما تقرر أن المصلحة هي مقصود الشرع، لم يكن بمنأى عن الحق أنها سواء كانت خاصة أو عامة فهي مساوية لمبدأ العدل؛ إذ ما كان مقصود الشرع إلا ذاك، ومن أنكر فقد طاله العجز والارتباك. ولما كانت المصلحة أعز مدارك أصول الاجتهاد والاستدلال التي ليست إلا من أنواعها وهي مندرجة تحتها، والتي يأتي بعضها تباعا بان من تجليات العدل في معاني وصور الاستدلال ما لا يخفى بيانه.
وإذا تمثل العدل في المصلحة المعتبرة شرعا في ميدان التشريع إبان الاستنباط والتطبيق، فمظهرها في التعامل يبدو فيما يأتي:
1. مبدأ المساواة أمام أحكام الشريعة، فالناس سواسية.
2. مبدأ المساواة في الالتزامات المتقابلة، وإقامة التوازن بينها في العقود التبادلية، مع زيادة معقولة في الربح، ومن هنا حارب الإسلام الغبن الفاحش، والربا والاحتكار والاستغلال بكافة صوره وأساليبه، وحدد الشروط المقترنة بالعقد…
3. مبدأ الجزاء على قدر الجهد الذاتي.
4. مبدأ المماثلة في الجزاء بين العقوبة والجريمة أو في التضمين في المتلفات.
5. مبدأ شخصية العقوبة “ولا تزر وازرة وزر أخرى”.
6. مبدأ الكف عن إيقاع الضرر بدون وجه حق أيّا كان منشؤه.
7. مبدأ دفع الضرر الأشد بالأخف[13].
وكان مدار الأحكام الشرعية على اعتبار المصالح، فحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، واندرجت تحت هذا المفهوم قواعد سَنيّة في الفقه الإسلامي، ومن ذلك ما أوردته المجلة العدلية في مادتها السادسة والعشرين: “يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام”.
وقد ظهرت هذه المادة في التفكير القانوني الإنجليزي بلفظ مماثل وصيغتهاpopuli est auprema lex ومعناها أن القانون يقدم المصلحة العامة[14].
ويندرج تحت رعاية المصالح من القواعد الفقهية قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، ومن تطبيقاتها في الفقه والقانون، شرع مبدأ الدفاع عن النفس المعروف في الفقه الإسلامي بدفع الصائل وغيره مما يتسع المجال لذكره.
ويتسع مجال النظر إلى المصالح في الأحكام، في قسم العبادات والمعاملات، ليتقرر شمولية انبناء الأحكام عليها، سواء تعلق الأمر بتنظيم العلاقة بين العبد وربه، في مجال التعبدات التي تستوقف ألباب العقلاء لدرك الحكمة والمصلحة فيها، والتي ينبغي المقارعة لقرع معانيها وأسرارها، ومن ثم فالعجز عن تبيينها ما هو إلا ضرب من القصور المعرفي وعجز عن بيان الحكمة والسر الذي تحتوشه معانيها وقد يتنخل عند الغوص في دلالتها.
وإذا تحقق ذلك في مجال التعبد فغير حري هجره في العادات، بل الأصل في هذا القسم الالتفات إلى المعاني والبواعث، التي شرعت من أجلها الأحكام، باتفاق الفقهاء؛ إذ إن التكليفات في هذه الأمور إنما كانت لتكوين مجتمع إسلامي فاضل، أساسه العدل والفضيلة..[15].
فلا ينهض حجة تمسك بعض الفقهاء على اختلاف المذاهب بالغلو في الأقيسة البعيدة لمنع معاملات تسهم إلى حد ما في الرفع من قيم المجتمع وضخ اقتصاده، بدافع التعبد بالتحريم والالتفات إلى الشبه، فليس ذاك بالمنهج الرصين، بل هو سبيل التضييق المؤالف للتكلف والتعسير، والمخالف للعدل والتيسير، “وليس سبيل التحري في الدين والورع محصورا في تضييق الدين، بل سبيل التحري هو أن يصيب روح التشريع المبني على حفظ ناموس الأمة وشرفها واغتباطها بشرعها، وكونه موافقا مصلحتها، ولا يكون حجر عثرة في سبيل رقيها، ولم يجعل الله شريعة من الشرائع منافية لناموس الاجتماع ولا قيدا ثقيلا في أرجل من يريد النهوض من الأمم، بل جميع الشرائع جاءت محافظة على رقي المجتمع الإنساني، ولاسيما هذه الشريعة العامة الأبدية[16].”
إن عين ما يبتغيه التشريع يساير المصالح، ولحظُ ذاك بين في التدرج وتجدد الحوادث وتبدل الأحكام بتبدل المصالح، ورعي الأقيسة والأسيقة والظروف والأحوال في كل حكم أو فتوى أو قضاء.
المطلب الثاني: الاستحسان
إن أخذ بهذا الأصل بعض من المذاهب الفقهية، فيكاد جزما يأخذ به جمهور الفقهاء ليبقى الخلاف في الاصطلاح ولا مشاحة فيه كما هو معلوم[17]، وذلك بأن لحاظ نوع مدركه واستكشافه مليّا يوحي أنه يندرج تحت أصل الاستثناء الذي يعد من كليات الشريعة، فلم تبعد مفهوميته عند كل من عرفه عن العدول؛ أي العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى يقتضي هذا العدول.
ويفسر ابن رشد مبدأ الاستحسان بأنه التفات إلى المصلحة والعدل[18]. ويظهر أن الاستحسان كيفما كانت صوره وأقسامه يكون في جزئية ولو نسبيا في مقابل قاعدة كلية، فيلجأ إليه الفقيه في هذه الجزئية لكيلا يؤدي في الأخذ بالقاعدة التي هي القياس إلى النأي عن الشرع والبعد عن روحه ومعناه، ونفَسه الذي ليس هو إلا العدل.
· فمن التطبيقات التي تُجلّي أثر مبدأ العدل في تطبيقات هذا الأصل:
مسألة: حوطة الدماء
ولا يكاد يخلو باب الاستحسان وضروبه من مثال: قتل الجماعة بالواحد؛ إذ لما شرع القصاص لحقن الدماء، فلو لم يجب عند الاشتراك لكان كل من أراد أن يقتل شخصا استعان بآخر على قتله، واتخذ ذلك ذريعة إلى سفك الدماء؛ لأنه صار آمنا من القصاص[19].
وتحقيق قيم العدل يقتضي الردع والزجر فلو سقط القصاص بالاشتراك لأدى إلى اتساع القتل به، ومن ثم إسقاط حكمة الردع.
فالأصل في الاقتصاص طلب المساواة في القصاص، لقوله تعالى: ﴿يأيها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والاُنثى بالاُنثى﴾ (البقرة: 177)، ولكن عدل عنه فحكم بقتل الجماعة حفاظا على النفس البشرية التي عُدّ حفظها من مقاصد الدين الضرورية.
قال ابن العربي من المالكية:
وقد كانت العرب تقول: القتل أنفى للقتل؛ لأنها لم تكن تأخذ حقها بعدل، وإنما كانت تستوفيه بربا، وأعظم ما يكون الربا في الدماء، فشرع الله تعالى استيفاء الحق في القتل بالمساواة، فقال تعالى: ﴿كتب عليكم القصاص﴾؛ يعني المساواة في القتل.
قال: فإن قيل: فلم تراعوا المساواة حين قلتم: تقتل الجماعة بالواحد، وهلاّ طردتم أصلكم كما فعل أحمد بن حنبل حين منع من ذلك؟
قلنا: إذا اعترض اللفظ على القاعدة، وخالف معنى من آخر الكلام أوله سقط، فكيف إذا خالفه كله؟ وبيانه: أن الله تعالى قال: ﴿ولكم في القصاص حياة﴾ (البقرة: 178)؛ المعنى: أن القاتل إذا علم أنه يقتل، كفّ عن ذلك وحقنت الدماء في أُهُبها. فلو لم تقتل الجماعة بالواحد، لاستعان الأعداء على الأعداء، وقتلوا من أحبوا حتى يبلغوا أملهم فيه، ويسقط القود عنهم بالاشتراك في قتله، وقد وفّى مالك هذا النظر، وأعطاه قسطه من الكمال.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا قود على الممسك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “اقتلوا القاتل واصبروا الصابر”؛ ولأنه لم يَقتل فكيف يُقتل؟
قلنا: أما الحديث فلا يُساوي سماعه، وأما المعنى فهو ضد ما قالوا. الممسك هو القاتل حقيقة، أو كلاهما قاتل، والدليل عليه: إجماعنا على أنه لو أمسكه على سبُع فأكله، لزمه القود.
فإن قيل: إن فعل السبُع جُبار.
قلنا: وفعله هو معتبر، آلا ترى أنهما يشتركان في الدية وهو البدل الجابر؟ كذلك يجب أن يشتركا في القصاص وهو العوض الزاجر[20].
فإباحة قتل الجماعة بالواحد استثناء من قاعدة عامة مفادها المساواة في القصاص، وهكذا كان هذا التشريع الاستثنائي لمعالجة الواقع والوقائع بظروفها، ومخايل حالها، ودرء المفاسد في أُهُبها على أساس المصلحة توثيقا لأصل العدل.
وكان من ضوابط المعاملات الصادرة عن لقاح معاني العدل القيمية، تجاوز اليسير من العيوب واللمم من الذنوب استحسانا حتى لا يؤاخذ بها العموم فتفقد الثقة بين الناس ومن ثم قرروا أنْ:
ـ من كان عيبه خفيفا والأمر كله حسن، فلا يُذكر اليسير الذي لا عصمة منه لأحد من أهل الصلاح..
ـ ومن الرجال رجال لا تُذكر عيوبهم..
ـ والخطأ النادر لا يسلم منه إلا من عصمه الله.
من كان من أهل الفضل والعدالة والصدق، وله مكانة وقدر، وأكثر أحواله الاستقامة والطاعة، والمروءة والديانة، لا يقدح في عدالته ومروءته الهفوة القليلة، والزلة الصغيرة، فإن من كان كثير الصواب خفيف العيب، لا يُذكر له اليسير الذي لا عصمة منه لأحد من أهل الصلاح، وكذلك من كان له في العلم قدم وقدر، كثير صوابه، قليل زلـله وخطؤه، يغتفر له زلـله القليل من أجل صوابه الكثير، ولا يترك ويهدر قدره، ويحط من منزلته في قلوب المسلمين من أجل خطئه، بل يوقر ويتبع صوابه، ويتجنب خطؤه، ولا يشنع عليه وينفر منه إلا المبتدعة أعداء العلم وأهله؛ إذ لو ترك كل مخطئ لترك أهل العلم جميعا، فالخطأ لا يسلم منه أحد سوى المعصوم.
ومن تطبيقات ما تقدم أن العدل إذا اجتنب الكبائر، واجتنب الصغائر الدالة على الخسّة، كسرقة كسرة، وتطفيف حبة، ولم يدمن على غير ذات الخسّة من الصغائر، كالنظر المحرم، بل صدر ذلك منه نادرا كالنظرة، والغفلة بارتكاب صغيرة في أوقات متباعدة، فلا يقدح مثل ذلك في العدالة؛ لأن النادر لا يسلم منه إلا من عصمه الله تعالى، ومن كان عيبه خفيفا، فلا يُذكر له اليسير الذي لا عصمة منه لأحد من أهل الصلاح[21].
المطلب الثالث: الذرائع
ويبقى وجه الجمع بين الذرائع والمقاصد باعتبارها خادمة لها، وغير مستغنية عن استحضارها فيُحتاج إلى المقاصد كلية في وصد أبواب الفساد، فإن كان مبتنى القاعدة على قصد الشارع النظر في مآلات الأفعال واعتبار مقاصد المكلفين فذاك عين اعتبار المقاصد، وليس هنالك من مقصد جاءت به الشريعة أبلغ من رفع الحرج ودرء المفاسد وإزالة الضرر، والمضارة في الحقوق وهو ما يعني التعسف في استعمال الحق؛ “إذ مبدأ سد الذرائع قائم على دفع ضرر متوقع، بتحريم التسبب فيه، والمنع من ممارسته قبل وقوعه، وهذا هو الدور الوقائي الذي تقوم به نظرية التعسف؛ إذ تمنع صاحب الحق من ممارسته حقه على نحو تعسفي، توقيا من وقوع الضرر، أو الانحراف عن غاية الحق..[22].”
فقاعدة سد الذرائع تنهض بنظرية التعسف، ودورها الوقائي منع الظلم وتقرير العدل؛ فيترجح هنا حماية هذا المبدأ لمفهومي الحق والعدل، وندرك هنا أن أصل الذرائع في حد ذاته توثيق لمقصد العدل، الذي عد من المقاصد الكلية للشريعة، وذهب جمع من المفسرين إلى أنه المقصود من قوله تعالى: ﴿ووضع الميزان﴾ فشرع الله العدل وأمر به حتى يوفّى كل ذي حق حقه، وحتى انتظم أمر العالم واستقام. فبالعدل صلاح الناس[23].
فإذا كان من العدل توزيع الثروات واستحقاق المصالح فإنه قد يصار بفعل الشره والاحتيال الذاتي إلى هضم الحقوق والتملّص من الواجبات فتنقلب المصالح الذاتية المشروعة غير مشروعة خصوصا إن أفضت إلى مآل ممنوع، تحت تأثير ظرف من الظروف كالإضرار بالمصلحة العامة، وحينئذ يوقف العمل بالحكم في هذا الظرف، خشية انهيار الصالح العام، باعتبار أن هذا الحكم الشرعي هو منشأ الحق الذاتي المعارض، مراعاة للمصلحة العامة الحقيقية للأمة التي تمثل “العدل” في أقوى صوره، وبزوال الظرف تعود المشروعية إلى المصلحة الذاتية، ويؤذن للمكلف باستعمال حقه.
إن في التسعير، مثلا، مصلحة العموم بعد فساد الناس لذلك يجوز سدا للفساد وتحقيقا للمصلحة، وتضمين الصناع في الحقيقة كان الأصل فيه الأمانة، لكن بعد شيوع التلف والهلاك في الأمانات بسبب فساد المجتمع جاء التضمين سدا للذريعة، فمنعها ومنع الحيل وسد أبواب الفساد كله خادم لمقصد العدل في الشريعة.
ويبقى من عدالة الشريعة الكاملة أنها لم تجز عقدا أو تصرفا إلا إذا كان ناشئا عن اختيار ورضا، هذا أصل تشريعي ثابت بنصوص القرآن والسنة، ولهذا جعل علماء الأصول فساد العقود والتصرفات الناشئة عن الإكراه قاعدة كلية من قواعد التشريع[24].
· ومن تطبيقات هذا الأصل الكاشفة لأثر مبدأ العدل في تكوينه وصياغته:
تحقيق المساواة: “رفع الإشكال عن مسألة الاقتصاص من الذكر للأنثى في الشريعة”
يقول شيخي عبد الحي بن الصديق رحمه الله: قد ورد علي سؤال من أحد طلبة قسم الباكالوريا بالمعهد الإسلامي بطنجة عن حكم الاقتصاص من الذكر للأنثى، فحررت هذه الرسالة الموجزة وسميتها: “مفتاح الذريعة إلى حكم الاقتصاص من الذكر للأنثى في الشريعة”.
في قتل الذكر بالأنثى قصاصا ثلاثة أقوال:
ـ الأول؛ أنه يجب قتله بها.. وهذا القول مذهب الجماهير من العلماء، بل حكى ابن المنذر الإجماع عليه.
ـ الثاني؛ أنه لا يقتل بها وإنما تجب الدية، وحكي عن علي والحسن البصري وعطاء.
ـ الثالث؛ أن ورثتها يخيرون بين الدية والقتل على شرط أن يسلموا لورثة القاتل، إن اختاروا قتله، نصف ديته، وهذا القول روي عن طائفة من المتقدمين.
فهذه أقوال ثلاثة في المسألة، لكن هذا الخلاف لا قيمة له ولا عبرة به؛ إذ ليس كل خلاف يعتبر إلا خلاف يستند إلى حجة واضحة، ولهذا كان أحق هذه الأقوال بالاعتبار هو القول الأول لا لكونه مذهب الجمهور، بل لكون الأدلة تؤيده، والنصوص تعضده، وإليكها على سبيل الاختصار والإجمال:
أ. الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾، فإنه عام يشمل القود من الرجل للمرأة. وخصوص آخر الآية لا ينافي عموم أولها، بل كل يجري على حكمه، يؤيد هذا ويزيده وضوحا أن قوله تعالى: ﴿الحر بالحر..﴾ من أفراد العام المذكور في أولها وقد تقرر في أصول الفقه أن ذكر بعض أفراد العام لا يخصصه.
فإن قيل: أي فائدة لذكر بعض الأفراد مع دخوله تحت لفظ العام المذكور قبله.
قلنا: فائدة ذكره زيادة الاهتمام والعناية به، كما في قوله تعالى: ” حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى”، فخص الوسطى بالذكر مع دخولها في لفظ الصلوات للنكتة التي أشرنا إليها..
ب. الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾ (المائدة: 48)، فإنه عام أيضا تدخل تحته هذه المسألة. وكون هذه الآية حكاية عن شريعة بني إسرائيل لا يقدح في الاحتجاج بها؛ لأن الخلاف في شريعة من قبلنا: هل تلزمنا؟ مقيد بما إذا لم ترد شريعتنا بإقرارها وإلا كانت لازمة لنا بدون خلاف كما هو مدون في أصول الفقه.
ج. الدليل الثالث: حديث البخاري ومسلم عن أنس: أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين على حلي لها فأخذ فاعترف، فأمر به النبي، صلى الله عليه وسلم، فرض رأسه بحجرين. احتج بهذا الحديث جماعة من الأئمة للقصاص من الرجل للمرأة. واستشكل الشوكاني الاحتجاج به.
د. الدليل الرابع: حديث عمرو بن حزم أن النبي، صلى الله عليه وسلم، كتب إلى أهل اليمن أن الذكر يقتل بالأنثى. رواه أحمد ومالك والشافعي وصححه جماعة من الحفاظ.
ﻫ. الدليل الخامس: حديث علي أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: “المسلمون تتكافأ دماؤهم” رواه أحمد وأبو داود. والتكافؤ هو التساوي، وذلك يدل على أنه لا فرق في القصاص بين رجل وامرأة، ولا بين شريف وحقير، بل الكل سواء فيه لاسيما وقد علق الحكمة في الحديث على المشتق فيفيد بطريق الإيماء أن علة التكافؤ هي الإسلام، وأن الذكورية لا تعتبر في التكافؤ والتساوي.. يؤيد هذا.
و. الدليل السادس: وهو أن حفظ النفوس من الكليات الخمس التي جاءت جميع الشرائع السماوية به ومن أجله شرع القصاص كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: ﴿ولكم في القصاص حياة﴾، حتى أن العرب في الجاهلية كانوا يقولون: القتل أنفى للقتل؛ لأن القاتل إذا علم أنه إذا قتل قُتل كف وانزجر عن هذه الجريمة الشنيعة، فكان في القصاص حياة له ولغيره. ولا يخفى على عاقل أن ترك الاقتصاص من الرجل للمرأة يفضي إلى نقيض هذه الحكمة الجليلة التي شرع لأجلها القصاص في شريعتنا وفي شريعة من قبلنا؛ لأن الرجل إذا علم أنه لا يقتل بها أقدم على اقتراف هذه الجريمة، لأدنى سبب كدفع العار عن نفسه وأهله إذا ارتكبت، أو ظن أنها ارتكبت ما فيه عار لها ولأهلها لاسيما في الوسط الذي يتصف أهله بالجهل وغلظ القلوب وشدة الغيرة والأنفة اللاحقة بما كان عليه أهل الجاهلية. وقد رأينا نحن بمصر من هذا ما يثير العجب حيث تقتل المرأة بصعيد مصر لأدنى سبب وبدون موجب شرعي بل بمجرد التهمة ليدفع القاتل العار عن نفسه فيما يزعم. ولا يخفى على من له أدنى مسكة من العلم أن من قواعد الشريعة أن الوسائل تعطى حكم المقاصد المترتبة عليها، ولا شك أن ترك القصاص من الرجل للمرأة وسيلة تؤدي إلى فتح باب قتلها لأدنى سبب، وقتلها مفسدة عظمى لا تقرها شريعتنا التي بنيت على جلب المصالح ودرء المفاسد، فيكون ترك قتله بها، الذي هو وسيلة إلى هذه المفسدة، باطلا لا توافق عليه قواعد الشريعة المعلومة بطريق القطع.
فهذه أدلة يكفي الواحد منها للاحتجاج على وجوب القود من الرجل للمرأة، فكيف وهي كلها متظاهرة متضافرة على إفادة الوجوب والمساواة بينهما في القصاص. اﻫ[25].
وهكذا فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع من أجله أتى عليها بالهدم، وناقض مقصود الشرع، واستحق المعاملة بنقيض المقصود الفاسد، وسقوط المشروعية هنا ليس معناه إلا سقوط العدل، ولذا تماهت هذه الأصول الاجتهادية في تحقيق المعنى الاجتماعي والإنساني في التشريع الإسلامي.
بقي من أصول المالكية التبعية أكثر مما ذكر، وذاك منهج ابتغيت منه التعميم وفق الله تعالى لذلك لاحقا.
الهوامش
1.محمد الطاهر بن عاشور، تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة، ص6.
2. الرازي، التفسير الكبير، 20/100.
3. انظر: يوسف القرضاوي، الأقسام وصور معاني العدل المستقرأة من كتاب الله تعالى في: مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، ص75 وما بعدها.
4. طه عبد الرحمن، مشروع تجديد علمي لمبحث مقاصد الشريعة، عن مجلة المسلم المعاصر، عدد 26، ص50.
5. بتصرف عن: محمد فتحي الدريني، المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي، ص44-45.
6. انظرها في كتب علوم الحديث كالمقدمة ابن الصلاح، ص104، وانظر: كتاب شيخنا نور الدين عتر، فكر المسلم وتحديات الألف الثالثة بتصرف، ص181-182.
7. إبراهيم بن الصديق، مجالات الاتفاق والاختلاف في الأصول والفروع، بحث تقدم به في الدورة الرابعة لجامعة الصحوة الإسلامية (الإسلام والمسلمون بأوروبا) طبعة وزارة الأوقاف، (1417ﻫ/1997م).
14. محمد أحمد سراج، الفقه الإسلامي بين النظرية والتطبيق، ص221.
15. مصطفى ديب البغا، أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي، ص38.
16. محمد مصطفى شلبي، تعليل الأحكام، ص304. وفي نفس الصدد يقرر ابن عاشور أنك إذا نظرت إلى أصول الظاهرية تجدهم يوشكون أن ينفوا عن الشريعة نوط أحكامها بالحكمة؛ لأنهم نفوا القياس والاعتبار بالمعاني، ووقفوا عند الظواهر فلم يجتازوها.. على أن أهل الظاهر يقعون بذلك في ورطة التوقف عن إثبات الأحكام فيما لم يُرو فيه عن الشارع حكم من حوادث الزمان، وهو موقف خطير يُخشى على المتردد فيه أن يكون نافيا عن شريعة الإسلام صلاحها لجميع العصور والأقطار. ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص242.
17. قال الغزالي بعد إيراده تعريف الكرخي الذي أوردته، “وهذا مما لا ينكر، وإنما يرجع الاستنكار إلى اللفظ، وتخصيص هذا النوع بتسميته استحسانا من بين سائر الأدلة”. المستصفى: 1/283. والغزالي من الشافعية وليس هنالك من بالغ في إبطال الاستحسان غيرهم حتى ألف الإمام الشافعي كتابا في الباب شنع فيه على الاستحسانيين، ومراده كما حققه الحاذقون ما كان عن طريق التشهي وهذا ما يضبطه الغزالي هنا.
19. الخطيب الشربيني الشافعي، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: 4/30.
22. الدريني، نظرية التعسف في استعمال الحق، ص196. وانظر: يوسف حامد العالم، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، ص191. ومما قرره الدكتور الدريني أن هذه النظرية بقواعدها المحكمة لم يعرفها المشرع الوضعي إلا في القرن العشرين، وعلى نحو ضيق ومبهم.. م، س، ص301.
23. ابن عجيبة، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، 6/6.
24. الشيخ عبد الحي بن الصديق، نقد مقال في مسائل من علم الحديث والفقه وأصوله وتفضيل بعض المذاهب، ص182.
25. عبد الحي بن الصديق، مفتاح الذريعة إلى حكم الاقتصاص من الذكر للأنثى في الشريعة، مخطوط خاص، ص1-3.







