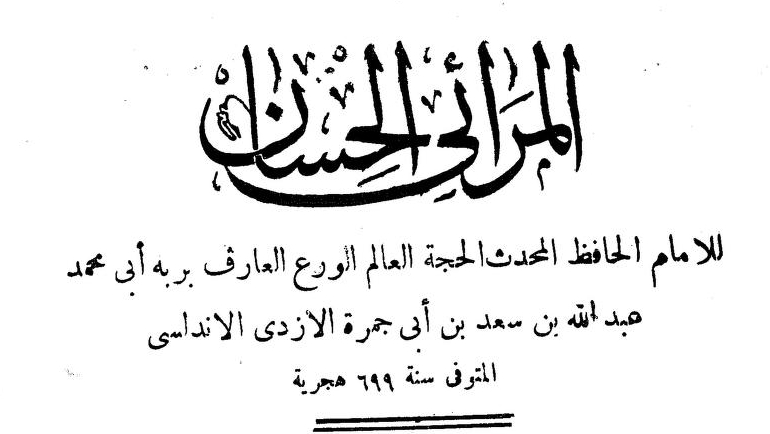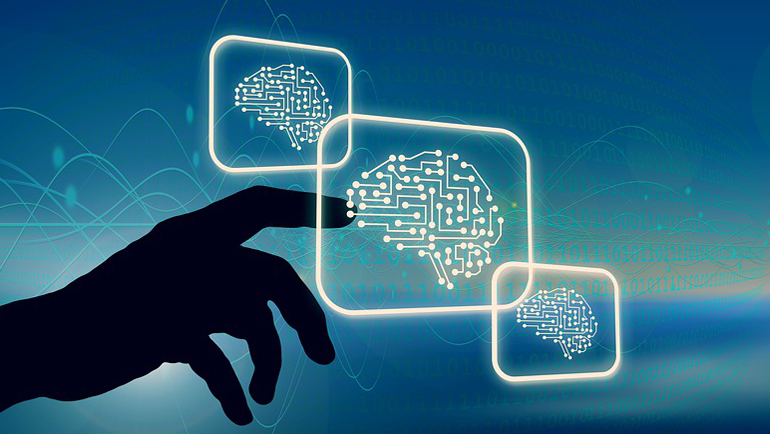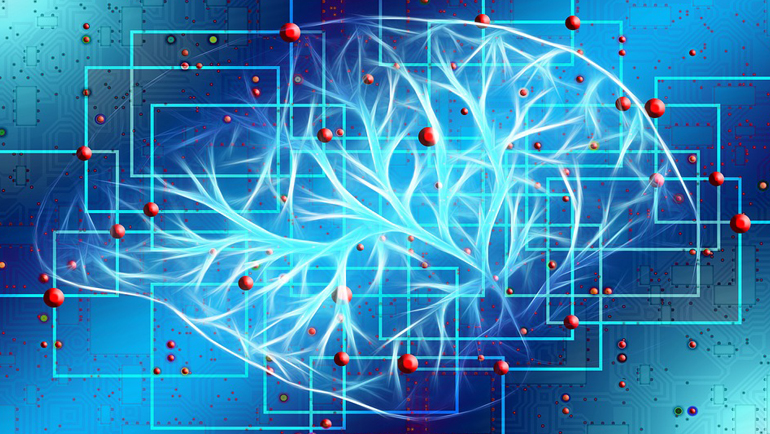المتأمل في خطاب المفسرين يدرك أنهم لم يقتصروا على تحديد وسائل فهم الخطاب، وإنما عملوا على إبراز الوسائل التي تساعد على ترجيح معنى دون آخر، وتقوية دلالة على حساب غيرها من الدلالات المحتملة؛ إذ لا يكتفى بالدلالات اللغوية المجردة، بل لا بد من مراعاة مجموع القرائن، وفي ذلك يقول الآمدي: “دلالات الألفاظ ليست لذواتها، بل هي تابعة لقصد المتكلم وإرادته”[1] في تصريف الخطاب لغة وأسلوبا وبناء.
ومن العلامات المساعدة على فهم قصد المتكلم بالخطاب النظر في سياق الكلام، قريبه وبعيده، لغويه ومقامه. وقد وجدنا المفسرين يعرضون لتلك القواعد، ويطبقونها.
وسنفرد هذه الدراسة للحديث عن دور السياق في ترجيح دلالة معينة من بين الدلالات التي يمنحها المفسرون للآية القرآنية الواحدة.
وفي الفقرات القادمة تحديد لمفهوم قاعدة الترجيح بالسياق ونماذج تطبيقية تجلي المراد وتقدم الدليل الداعم لمحكمية القاعدة ودورها في إحداث مراجعة منهجية في خطاب المفسرين.
1. السيـاق: المفهوم والأهميـة
يستعمل مصطلح “السياق” في سياقات متعددة، بعضها لغوي وآخر اجتماعي واقتصادي وسياسي، غير أن المعاجم تقدم له تعريفا يكاد ينطبق، من حيث المقوم الجوهري، على تلك السياقات جميعا، فالسياق، في مجال تحليل الخطاب، هو سلسلة الأفكار التي تجسد نصا ما، وبالتحديد، فإن السياق هو مجموع النص الذي يحيط بالجملة التي يراد فهمها، وعليه يتوقف الفهم السليم لها[2]، أو هو المحيط اللساني الذي أُنْتِجت فيه العبارة[3]، ولا يشترط في تلك العناصر الحافة بالعبارة أن تكون قريبة، بل يمكنها أن تكون بعيدة في متن الخطاب[4].
ومن ثم، فإن معنى العبارة يتغير طبقا للمساق الذي ترد فيه، وما دام الأمر كذلك، فالواجب يقتضي تأويل كل كلمة أو جملة، ليس في استقلاليتها وتفردها، وإنما من خلال مراعاة سياقها. إلى درجة يصح القول إذا كان التركيب يوجد داخل النص، فإن الدلالة توجد داخل السياق. وهذا لايقتصر على تحديد دلالة العبارة فقط، بل يمتد ليشمل تحديد الصور والاستعارات والمجازات، والبحث في آليات ضبطها وتأويلها[5].
ونظرا للأهمية التي تولى للسياق في فهم دلالة الكلام، فقد غدا قاعدة أساسية في عملية التأويل[6]، مادام فهم الخطاب يستدعي شرطا أساسيا وهو فهم السياق.
والعلاقة بين العبارة، مجال الشرح، والمحيط اللغوي الحاف بها علاقة تأثير ممتدة بين قطبين: قطب العبارة وقطب النص، إلا أنها تسير في الاتجاه الثاني نحو الاتجاه الأول، وقد عملت بعض التعريفات على إضافة مقوم التأثير إلى مفهوم السياق، من ذلك قولهم: “السياق هو مجموع الوحدات اللسانية التي تحيط بعنصر معين داخل سلسلة الخطاب، وتؤثر فيه”[7].
وعادة ما يضع المحللون هذا السياق النصي في مقابل سياق آخر مرجعي أومقامي، أو سياق الحالة الذي يضم مجموع الظروف والوقائع خارج لسانية كالظروف النفسية والاجتماعية والثقافية. والتي بداخلها يجري حدث التواصل، كما يجري حدث التلقي. ومن ثم، يمكن التمييز بين السياق اللساني والسياق الحالي[8].
وقد أبرز المفسرون والعلماء أهمية السياق في فهم دلالة النص، وترجيح التأويلات، يقول ابن قيم الجوزية: “السياق يرشد إلى تبيين المجمل وتعيين المحتمل والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وتنوع الدلالة، وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم”[9].
وفي سياق حديثه عن ضروب التفسير وأنواعه، أشار العز بن عبد السلام إلى النوع الذي يكون للسياق دور بارز في توجيهه، فقال: “وقد يتردد أي معنى الآية بين محامل كثيرة يتساوى بعضها مع بعض، ويترجح بعضها على بعض، وأولى الأقوال ما دل عليه الكتاب في موضع آخر أو السنة، أو إجماع الأمة، أو سياق الكلام، وإذا احتمل الكلام معنيين، وكان حمله على أحدهما أوضح وأشد موافقة للسياق كان الحمل عليه أولى”[10].
إن السياق هاد إلى اختيار المعنى المراد من الكلمة بحسب موضعها الملائم لموضوع النص[11].
والأساس الحاكم لهذا التصور هو أن الكل مهيمن على الجزء وموجه له، بل مؤثر فيه، إلى درجة أن معنى الجزء ينعدم في ظل غياب معنى الكل، وذلك ما عناه الشاطبي بقوله: “فلا محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أوله، وأوله على آخره، وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع في فهم المتكلف، فإن فـرق النظـر في أجزائه، فلا يتـوصل به إلى مراده، فلا يصح الاقتصار في النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض”[12]. وهوالقائل في مناسبة أخرى: “كلام العرب على الإطلاق لابد فيه من اعتبار السياق”[13]، وهو قانون لايختص بكلام العرب، بل هو جار على جميع اللغات.
لقد أصبح مبدأ مراعاة السياق شرطا أساسا في فهم الخطاب، غير أن ما نود التذكير به، هنا، هو أن السياق لا يقوم بالوظيفة التفسيرية فقط، وإنما يتعداها إلى وظيفة أخرى تختص بترجيح معنى معين على ما سواه، وتقوية دلالة مخصوصة على حساب دلالات مرجوحة، ورفع الاحتمالات بتأكيد احتمال واحد قوي لقوة مرتكزه السياقي.
وقد انتهى البحث في الدراسات القرآنية في العصور المتأخرة إلى اعتبار وظيفة السياق الترجيحية إحدى قواعد الترجيح المعتبرة، يقول محمد بن محمد سالم المجلسي: “أما وجوه الترجيح، فهي اثنا عشر… سادسا: أن يشهد لصحة القول سياق الكلام ويدل عليه ما قبله وما بعده”[14].
ولخص الشيخ رشيد رضا قاعدة الترجيح بالسياق في قوله: “إن أفضل قرينة تقوم على حقيقة معنى اللفظ: موافقته لما سبق له من القول، واتفاقه مع جملة المعنى وائتلافه مع القصد الذي جاء به الكتاب جملة”[15].
وإحكاما لهذه القاعدة، قاعدة الترجيح بالسياق، وتمكينا لها في بيئة تدبر القرآن الكريم والتعامل معه، وتحسيسا لطلبة علوم التفسير بضرورة اعتماد هذه القاعدة في بحوثهم المتصلة بتاريخ التفسير ومناهج المفسرين والعلاقة بين التفسير وأسباب النـزول وأقوال الصحابي، فإننا نقدم نماذج تطبيقية نرجو لها أن تكون خير ممثل لما نخاله عملا مفيدا لحقل التفسير، ومسلكا طيبا لتنقية التفاسير مما علق بها من أقوال مرجوحة لا تتناسب مع السياق الحاف بالآيات، وذلك كله من أجل مراجعة لتراث التفسير مراجعة منهجية تبني عطاء الدلالة القرآنية على صحيح فهم الصحابة والتابعين، وعلى قواعد مراعاة السياق، إيمانا بأنه يستحيل أن يكون هناك تعارض أو تناقض بين مراعاة السياق واستصحاب أقوال المفسرين.
2. مفهوم الترجيح: من الاصطلاح الأصولي إلى الاصطلاح التفسيري
تتحدد دلالة الترجيح اللغوية في الميل، فرجح الميزان بمعنى مال، وأرجح الميزان: أي أثقله حتى مال[16].
أما في الاصطلاح، فقد استعمل الترجيح بمعنى “تقوية أحد الدليلين المتعارضين على الآخر للعمل به”[17]، أوهو إبداء زيادة قوة الدليل على الدليل المعارض”[18]. ولعل أكثر تعريفات الترجيح اختصارا قول الشيرازي: “بيان قوة أحد الدليلين على الآخر”[19].
ولا يتصور ترجيح إلا بوجود تعارض بين الدليلين أو القولين، والتعارض هو “تقابل الحجتين المتساويتين على وجه توجب كل واحدة منهما ضد ما توجبه الأخرى”[20].
وضابط التعارض نسبي؛ إذ قد لا يكون التعارض بين دلالتي النصين، وإنما في فهم المتعامل معهما، وفي ضوء درجة إحكام مقولات العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ…
ولا فائدة ترجى من انتهاج الترجيح إن لم يكن بغرض إعمال الدليل القوي الراجح وإهمال الدليل الضعيف المرجوح، وإلا فقد الترجيح معناه ووظيفته، يقول الآمدي: “أما الترجيح، فعبارة عن اقتران أحد الدليلين الصالحين للدلالة على المطلوب، مع تعارضهما، بما يوجب العمل به وإهمال الآخر”[21].
ونشير إلى أن التحديد السالف للترجيح يتداول عند الأصوليين والفقهاء، وذلك لأن هاته الحقول العلمية تتعامل مع نصوص القرآن وأحاديث الرسول عليه السلام، ومن المعلوم أن تلك النصوص كثيرة، ومنها ما هو قطعي في ثبوته ودلالته أو في أحدهما، ومنها ما هو ظني في ثبوته ودلالته أو في أحدهما، ويحصل أن يقع، في فهم العالم، تعارض بين نصين أو أكثر، فإذا أمكن الجمع بين دلالاتها بوسائل الجمع التي حصرها الأصوليون جاز ذلك، وإلا تعين ترجيح نص واحد على ما سواه بسلوك طرائق الترجيح التي بينوها في مصنفاتهم.
والملاحظ أن الترجيح، سواء في إطلاق هذه الدراسة أم في خطاب المفسرين، لا يتعلق بنصين اثنين، أو أكثر، من نصوص القرآن أو السنة، وإنما يتصل بأقوال المفسرين في تفسيرهم للآية الواحدة. فالتعارض يتصور بين تلك الأقوال، والدعوة إلى ترجيح بعضها على بعض إنما ينحصر في تلك الأقوال. وفي كلمة واحدة، فإذا كان الأصوليون يتحدثون عن التعارض والترجيح بين نصوص القرآن والسنة، فإن الدراسة تتحدث عن التعارض والترجيح في فهم المفسرين لتلك النصوص، ولعل الفرق صار واضحا وجليا.
وإذا كان الأصوليون يذكرون أربعة أسباب جوهرية لوقوع الترجيح بين النصوص[22]، فإن الترجيح، في مجال دراستنا، يكون له سبب جوهري هو سياق الآية والقرائن الحافة بنظمها، وقد يتدعم هذا السبب ويتقوى بنصوص قرآنية وحديثية خارج السياق النصي، وقد يضاف إليه السياق المقاصدي للخطاب والشريعة في مجالات العقيدة والتربية والعمران.
وهذا يجعل مفهوم السياق يتسع ليصير ذا أربع شعب:
أ. شعبة السياق النصي القريب، وهو المقصود الأول بالسياق في هذه الدراسة.
ب. شعبة السياق المقامي، وهو الداخل في مفهوم أسباب النـزول باعتبارها الوعاء الزمني والحالي الذي تنـزلت فيه الآية موضوع التفسير نقدا وتوجيها أو إقرارا وتمكينا، أو إصلاحا وتعديلا.
ج. شعبة السياق الكلي للخطاب، ويتمثل في استحضار الوحدة النظمية والدلالية للخطاب القرآني.
د. شعبة السياق المقاصدي للخطاب القرآني، وهو الدائرة الكبرى التي تستوعب الدائرتين السالفتين، وتتعداهما إلى مقاصد القرآن في العقيدة والشريعة والتربية والعمران، إذ أن ترجيح دلالة معينة وإعمالها ملزم بأن يساوق الدلالات المقاصدية للخطاب، أما إذا عارضها أوناقضها، فهو دليل مرجوحيته وإهماله.
وقد فات د. محمد عابد الجابري الانتباه إلى رباعية شعب السياق، فلم يشر إلى الشعبة الثالثة والرابعة، وذلك في قوله: “والسياق في القرآن يتحدد بأمرين اثنين: أولهما الآيات التي تشكل كلا واحدا تندرج تحته الآية المراد تفسيرها، على سلم ترتيب النـزول. ومناسبة نـزول تلك الآية أو الآيات، وتبين المخاطب فيه”[23]، مع أن السياق لا يتقوم، بالمعنى العلمي والمنهجي، إلا بإدراج السياق الكلي للخطاب القرآني، والسياق المقاصدي له، باعتبارهما ميزانين راجحين في تقويم الكثير من “الخلط” و”الاضطراب” في حقل تفسير العديد من الآيات.
ولنستبق التحليل في ضرب مثال للمراد بالسياق المقاصدي للخطاب القرآني، وليكن المثال متصلا بالإشكال الفقهي والحضاري المعاصر حول الموقف من الآخر، فقد أريد لمذهب القول بشرعية قتال الآخر بسبب كفره أن ينتشر في وسائل الإعلام انتشارا يشوش على الموقف السليم، وفصل العديد من الأقوال والأحكام والتحليلات عن سياقها التاريخي لتؤكد تلك المقولة، مع أن تحرير الإشكال، في بعده الفقهي، يضع الدارس إزاء موقفين:
ـ الموقف الأول: لا شرعية لمقولة قتال الكفار بسبب كفرهم، وإنما جاز قتالهم بسبب حرابتهم للمسلمين واعتدائهم عليهم، وهو الموقف الغالب في التراث الفقهي، ومفاده أن الكفار، حين يحاربون المسلمين، يصار إلى قتالهم استجابة للأمر الواجب في القرآن الكريم.
ـ الموقف الثاني: شرعية قتال الكفار بسبب كفرهم، وهو موقف لم يقل به، في غالب الاستقراء، إلا مذهب فقهي واحد، ظنا منه أن علة القتال والجهاد هي كفر الآخر، وغاب عنه أن العلة هي الحرابة.
ويجد المسلم المعاصر نفسه حائرا بين هذين الموقفين والتفسيرين، وخاصة عندما يريد أن يفسر قوله تعالى: “وقاتلوا المشركين..”.
وفي هذه الحال، ورغبة في درك الفهم السليم، يتعين قراءة مختلف الآيات الآمرة بالقتال على ضوء مقاصد القرآن في العمران الإنساني، وسيتضح، حينئذ، أن من مقاصد القرآن الكبرى رعاية الحرية الفكرية والاعتقادية للإنسان، وانتفاء الشرعية عن أي جهة في إجبار الأفراد والجماعات على الخضوع إلى فكر معين أو عقيدة محددة، وهذا المقصد متأصل بقوة في النصوص الشرعية من مثل قوله تعالى:﴿لا إكراه في الدين﴾، التي أريد لها، خضوعا لمنطق شرعية قتال الكفار بسبب كفرهم، أن تصير منسوخة بآية السيف: “وقاتلوا..” مع أنها، كما يقول البحث التحقيقي في الناسخ والمنسوخ، آية محكمة ناسخة.
وعندما يخرق هذا المنطق مقصد الحرية الاعتقادية للأفراد والجماعات والأمم، فإن خرقه لمقاصد القرآن الأخرى يصير أمرا مستساغا، مثل من يحشر الآخر في خانة واحدة، ويوجه سلاح قتاله إلى مختلف الفئات والجماعات في مجتمعات “الكفار”، مع أن مقاصد القرآن الكبرى تقر بأن لا يؤخذ أحد بجريرة غيره، وألا يعاقب الأبرياء بصنيع المجرمين، وإلا صارت الحياة فوضى، واستحال قيام قواعد أخلاقية وقانونية. وحرصا من القرآن على تثبيت أركان هذا المقصد، تواردت الآيات على تقرير هذه القاعدة الحضارية، من مثل قوله تعالى: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ وقوله: ﴿كل امرئ بما كسب رهين﴾.
وقد كان التوقف ينتابني عندما أحضر مجالس الجُمع والجماعات، ويقف الإمام والخطيب داعيا، ويقول: “اللهم دمر اليهود والنصارى أجمعين، واجعلهم وذريتهم وأموالهم غنيمة للمسلمين”؛ إذ كان الصراع بين وعيي لمقاصد القرآن وبين هذا الدعاء حادا وقويا؛ إذ كيف يجوز حشر جميع اليهود وجميع النصارى في خانة واحدة واستهدافهم بالدعاء عليهم وعلى ذرياتهم وحضارتهم؟ ألا يمكن أن يعاد النظر في مثل ذلك الدعاء على ضوء مقاصد القرآن ممثلة في العدل والإنصاف وعدم جواز أخذ أحد بجريرة غيره.
إن السياق المقاصدي للخطاب القرآني روح وقواعد ومبادئ، وهي محتاجة إلى أن تتحول إلى مقررات دراسية تدمج ضمن مواد العلوم الإسلامية بالثانويات والمعاهد والجامعات كي تصير ملكة لدى طلبة العلم والدعاة والوعاظ والباحثين. وإن في عدم إدراكها وتمثلها خطرا على فهم النص وتنـزيله، وقد يكون إهمال الباحث والعالم والداعي والواعظ لنص من النصوص أو غفلته عنه مستساغا، وقد لا يؤثر على منهجه في العلم والبحث والاستدلال والدعوة، وإن كان الاستقصاء مطلبا لازما. ولكن إذا تم إهمال مقاصد القرآن، ولم توضع في الاعتبار الأول، فإن النتائج تكون سلبية منهجا وفهما وتطبيقا.
استراتيجية حاكمة
من المؤكد أن الخطاب القرآني يهدي إلى مقاصد، من مثل مقصد العدل والحرية الاعتقادية والمساواة الإنسانية، ونفي الإكراه في الدين، وإعمار الأرض… وعلى المفسر أن ينطلق من هذه المقاصد، وإذا بدا له أن قولا ما يتعارض مع هذه المقاصد، فليعلم بأن المقصد هو الحاكم، وليس أقوال فلان أو فلان، إذ لا يجوز أن يطالب القرآن الناس بقيمة من القيم المذكورة، ثم يأمرهم، في أي سياق، بتجاوزها أو خرقها، فإذا كان القرآن يقصد إلى نفي الإكراه في الدين، مثلا، فلن تجد في آياته الأخرى أمرا بقصر الناس على الدين وإرغامهم على القبول به بالقوة أو التهديد.
3. نماذج تطبيقية لمحكمية قاعدة الترجيح بالسياق
النموذج الأول: الحصور: العُنَة الضعف الجنسي أم العفة الخُلقية؟
وصف القرآن الكريم يحيى بن زكرياء عليهما السلام بأوصاف جليلة، وذلك في قوله تعالى إخبارا عن زكـرياء: ﴿فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيئا من الصالحين﴾ (ءال عمران: 39).
واختلف المفسرون في دلالة “الحصور”، فقد انتهى الطبري إلى أنها تدل على “الذي لا يأتي النساء” أو “لا يقرب النساء”، أو “الذي ليس له ماء”[24] مستندا في ذلك إلى ما ورد عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم، ولم يشر إلى المعنى الثاني الذي ذهب إليه آخرون.
ونجد عند القرطبي عرضا لدلالتين مختلفتين، وقد رجح الإمام إحداهما لاعتبارات تتصل بسياق الكلام.
فقد ذكر أولا المعنى السابق، ثم ثنى بالدلالة التي استمدها من علماء آخرين، ومفادها أن الحصور هو الذي يكف عن النساء ولا يقربهن مع القدرة. ونسب هذا التفسير إلى ابن مسعود وابن عباس وابن جبير وقتادة وعطاء والحسن والسدي وابن زيد، ولنا أن نعجب كيف أن كتب التفسير تحتوي في دلالة الآية الواحدة قولين مختلفين لعالم واحد، ورجح القرطبي الدلالة الثانية، وعلل ترجيحه بقوله: “وهذا أصح الأقوال لوجهين: أحدهما أنه مدح وثناء عليه، والثناء إنما يكون عن الفعل المكتسب دون الجبلة في الغالب، والثاني أن فعول في اللغة من صيغ الفاعلين، كما قال: من الطويل
ضَرُوبٌ بِنَصْلِ السيفِ سَوْقَ سِمَانِهَا *** إِذَا عَدَمُـوا زَاداً فَإِنَّـكَ عَاقِـرُ
فالمعنى أنه يحصر نفسه عن الشهوات، ولعل هذا كان شرعه”[25].
وإذا كان التعليل الثاني معتبرا؛ لأنه يستند إلى دلالة الصيغ في اللغة العربية، فإن التعليل الأول هو المقصود؛ لأنه يستحضر سياق الكلام، فقد مدح القرآن يحيى بأنه مصدق بعيسى، على بعض الأقوال، وسيد حاز الشرف والكرم في العلم والعبادة، ثم هو نبي من الصالحين، وهي صفات حميدة، فكيف تقتحمها صفة هي إلى الذم أقرب منها إلى المدح، إن الراجح أن تكون دلالة “الحصور” متصلة بما من شأنه أن يضاعف من طهارة يحيى ويقربه من رضا الله.
يقول الطاهر بن عاشور: “وذكر هذه الصفة في أثناء صفات المدح إما أن يكون مدحا له، لما تستلزمه هذه الصفة من البعد عن الشهوات المحرمة، بأصل الخلقة، ولعل ذلك لمراعاة براءته مما يلصقه أهل البهتان ببعض أهل الزهد من التهم، وقد كان اليهود في عصره في أشد البهتان والاختلاق”[26].
وكان الأولى بالإمام الطبري أن يلتفت إلى هذه الدلالة الراجحة، ويدعمها بما عرف عنه من ذوق في إدراك معنى الآية والترجيح بين الأقاويل المختلفة، وليته كان سباقا إلى ما ذهب إليه الراغب الأصبهاني في قوله: “فالحصور الذي لا يأتي النساء إما من العنة، وإما من العفة والاجتهاد في إزالة الشهوة، والثاني أظهر في الآية، لأن بذلك تستحق المحمدة”[27].
وتشير الدراسة، هنا على سبيل التذكير، إلى أن نظرة النصوص “التوراتية” و”المسيحية” إلى الأنبياء نظرة يشوبها الكثير من الاضطراب، فهي تصف الأنبياء، في بعض السياقات، بما لا يتناسب مع كريم شخصهم وعصمتهم، والأمر محتاج إلى جمع تلك النصوص ونقدها، خاصة إذا علم أن بعض تلك النصوص مما يتصل بالمرويات قد تسرب إلى الثقافة الإسلامية، وهي تتضمن أوصافا قدحية لا تجوز في حق الأنبياء.
النموذج الثاني: أسفل سافلين: الهرم أم سوء العاقبة؟
في سورة التين، ورد قوله تعالى: ﴿لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين ءامنوا وعملوا الصالحات، فلهم أجر غير ممنون﴾ (التين: 4-6).
وباستقراء كتب التفسيـر، يلحظ الدارس أن المفسرين قدمـوا لقوله تعالـى: ﴿أسفل سافلين﴾ الدلالتين الآتيتين: الهرم والشيخوخة، وأرذل العمر ابن عباس وعكرمة، وقتادة، وأبو العالية، ومجاهد…. النار قتادة، وابن زيد..[28].
والجدير بالذكر أن الطبري رجح القول الأول، وانطلق في استدلاله من قوله تعالى: ﴿فما يكذبك بعد بالدين﴾، وقال: “وإنما قلنا هذا القول أولى بالصواب في ذلك لأن الله تعالى ذكره أخبر عن خلقه ابن آدم، وتصريفه في الأحوال، احتجاجا بذلك على منكري قدرته على البعث بعد الموت، ألا ترى أنه يقول: ﴿فما يكذبك بعد بالدين﴾، يعني هذه الحجج، ومحال أن يحتج على قوم كانوا منكرين معنى من المعاني بما كانوا له منكرين، وإنما الحجة على كل قوم بما لا يقدرون على دفعه، مما يعاينونه ويحسونه أو يقرون به، وإن لم يكونوا له محسين. وإذ كان ذلك كذلك، وكان القوم للنار التي كان الله يتوعدهم بها في الآخرة منكرين، وكانوا لأهل الهرم والخرف من بعد الشباب والجلد شاهدين، عُلِمَ أنه إنما احتج عليهم بما كانوا له معاينين، من تصريفه خلقه، ونقله إياهم من حال التقويم والحسن والشباب والجلد إلى الهرم والضعف وفناء العمر وحدوث الخرف”[29].
ولكن هذا الاستدلال قد يقوم لهم حجة، لأن فيهم الدهريين الذين يعتقدون أن الفناء مآل الإنسان، فلعل القول بالرد إلى أرذل العمر يكون متساوقا مع مذهبهم، ولذلك، فقد رجح البعض الدلالة الثانية، أي النار أو سوء العاقبة دنيا وآخرة، خُلُقاً واتصافا، وحكموا في ذلك دلالة السياق، إذ استثنى القرآن بعد ذلك الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا معنى لهذا الاستثناء إذا كان الرد يتعلق بالهرم وأرذل العمر، إذ المؤمنون العاملون بالصالحات مشتركون مع الكفار في خضوعهم لقانون الشيخوخة وسريانه عليهم، إلا إذا اعتبرنا الاستثناء، هنا، منقطعا على تأويل بعضهم، وقد ذكر الطبري ذلك، وجعله محتملا، “لأنه يحسن أن يقال ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين ءامنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون بعد أن يرد أسفل سافلين”[30]، بمعنى: “لكن الذين ءامنوا..”.
ونظرا لتردد دلالة الآية بين هذين المحملين، انتهى القرطبي إلى تجويزهما معا، خاتما كلامه بقول: “والاستثناء، على قول من قال: “أسفل سافلين: النار، متصل ومن قال إنه الهرم، فهو منقطع”[31]، وبه قال كثير من المفسرين مثل أبي حيان في البحر المحيط[32]، وابن جزي في التسهيل[33].
إن هذا النموذج يبين كيف أن السياق النصي القريب للآية لا يرجح دلالة على أخرى، بل إنه يقويهما معا، وقد اهتدى بعض المفسرين إلى تجاوز هذا السياق القريب، والالتفات إلى سياق أبعد، ونظروا في سورة “التين” على ضوء علاقتها بسورة الشرح الواردة قبلها. ونجد نواة هذه الالتفاتة عند أبي حيان، فقد قال في بداية تفسيره لسورة “التين”: “هذه السورة مكية في قول الجمهور، وقال ابن عباس وقتادة مدنية، ولما ذكر الله فيما قبلها مَنْ كمل الله خَلقا وخُلقا، وفضله على سائر العالم، ذكر هنا حالة من يعاديه وأنه يرده أسفل سافلين في الدنيا والآخرة”[34]، وهي إشارة تقيم علاقة تقابلية بين المتحدث عنه في سورة “الشرح” وهو الرسول الكريم، والمتحدث عنه في سورة التين، وهو الإنسان، إما جنسه أو كافره.
وقد عمق السيوطي هذه الالتفاتة مسترشدا بكلام بعض الشيوخ، يقول: “نقل الشيخ أبو العباس تاج الدين ابن عطاء الله السكندري في “لطائف المنن” عن الشيخ أبي العباس المرسي، قال: قرأت مرة “والتين والزيتون”، إلى أن انتهيت إلى قوله: ﴿لقد خلقنا الاِنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين﴾، ففكرت في معنى هذه الآية، فألهمني الله أن معناها لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم روحا وعقلا، ثم رددناه أسفل سافلين نفسا وهوى”[35]. وهذا يعني أن تفسير الآية متجه نحو الأحسنية في الخُلُق والعقل والأسفلية في الخُلُق والسلوك، ولا تعلق لها بالهيئة والهرم، ومن ثم، فقد بحث السيوطي في وجه مناسبة إيراد سورة “التين” عقب سورة “الشرح”، فظهر له أن سورة “الشرح” “أخبر فيها عن شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يستدعي كمال عقله وروحه، فكلاهما في القلب الذي محله الصدر، وعن خلاصه من الوزر الذي ينشأ من النفس والهوى، وهو معصوم منهما، وعن رفع الذكر، حيث نـزه مقامه عن كل موهم، فلما كانت هذه السورة في هذا العَلَم الفرد من الإنسان، أعقبها بسورة مشتملة على بقية الأناسي، وذكر ما خامرهم في متابعة النفس والهوى”[36].
سورة الشرح ــــ كمال شخص الرسول
سورة التين ــــ أسفلية الإنسان غير المؤمن
والعلاقة بين النموذجين علاقة مقابلة نموذجية تقتضي صرف دلالة الأسفلية إلى المستوى الأخلاقي والقيمي دون المستوى البيولوجي.
وقد أحسن العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي صنعا، إذ أعرض عن الإشارة إلى دلالة “أسفل سافلين” على الشيخوخة، واقتصر على الدلالة المساوقة لسياق الآية، مع ربطها بأسفلية أخلاق من استحق النار. يقول: “ومع شدة النعم العظيمة التي ينبغي له القيام بشكرها، فأكثر الخلق منحرفون عن شكر المنعم، مشتغلون باللهو واللعب، قد رضوا لأنفسهم بأسافل الأمر وسفاسف الأخلاق، فردهم الله في أسفل سافلين، أي أسفل النار، موضع العصاة المتمردين على ربهم، إلا من من الله عليه بالإيمان والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة العالية”[37].
النموذج الثالث: دلالة المستقدمين والمستأخرين بين صفوف الصلاة ومداولة الحياة والممات
يقول تعالى: ﴿ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين﴾ (الحجر: 24).
أورد الطبري لهذه الآية ثلاثة تفاسير:
أ. “المستقدمين”: الذين مضوا وانقضوا، و”المستأخرين”: الباقون الذين يعيشون في المستقبل.
ب. المستقدمون في صفوف الصلاة والمتأخرون فيها بسبب المرأة الحسناء.
ج. المستقدمون في الخير والمتأخرون عنه.
وبمقتضى التفسير الأول، فإن المستقدمين هم الخلق الذين مضوا في الأزمنة الخالية، أما المستأخرون فهم الذين يحيون لاحقا ويموتون مستقبلا.
أما في التوجيه الثاني لدلالة الآية، فإن رواية تشرحه على الشكل الآتي:
عن أبي الجوزاء عن ابن عباس، رضي الله عنه، قال: “كانت تصلي خلف رسول الله، صلى الله عليه وسلم، امرأة حسناء من أحسن الناس، فكان بعض الناس يتقدم في الصف الأول لئلا يراها، ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر، فإذا ركع نظر من تحت إبطيه في الصف، فأنـزل الله في شأنها: “ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين”[38].
أما التفسير الثالث فهو واضح المعنى
غير أن الإشكال الذي يعن هنا هو: كيف يمكن الجمع بين دلالتين مختلفتين في معرض تفسير الآية المذكورة، وكيف تستمر تلك الدلالات المتباينة حاضرة في كتب التفسير، بل كيف تغلب الدلالة المتعلقة بالمرأة الحسناء وصفوف الصلاة، وتستقر في كتب علوم القرآن التي يتخذها الطلبة مرجعا في تكوينهم العلمي؟
لقد كان على المفسرين أن ينتبهوا إلى أن السياق الذي وردت فيه الآية مجال الدرس لا تعلق له بقصة المرأة الحسناء وصفوف الصلاة، وإنما ينسجم مع الدلالة الأولى، وهذا ما لا حظه الإمام الطبري ولخصه في قوله: “وأولى الأقوال عندي في ذلك بالصحة قول من قال: معنى ذلك: ولقد علمنا المستأخرين الذين استأخر موتهم ممن هو حي ومن هو حادث منكم ممن لم يحدث بعد لدلالة ما قبله من الكلام، وهو قوله تعالى: “وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون” وما بعده، وهو قوله: ﴿وإن ربك هو يحشرهم﴾ على أن ذلك كذلك، إذ كان بين هذين الخبرين، ولم يجر قبل ذلك من الكلام ما يدل على خلافه”[39].
ومن المؤسف أن الإمام السيوطي أغفل الدلالة المعتبرة المساوقة لسياق الآية، وغلب دلالتها على قصة المرأة الحسناء، وجعل ذلك سببا في استثناء الآية الرابعة والعشرين وجعلها آية مدنية وسط سورة مكية.
وقد تعقبه الشيخ عبد الله بن الصديق محكما قاعدتين اثنتين: نقد سند الحديث. والترجيح بالسياق.
فأما القاعدة الأولى، فقد هدته إلى إعلان ضعف إسناد الحديث، يقول: “وهذا الأثر، وإن صححه ابن حبان، له علة، فقد رواه عبد الرزاق في تفسيره عن أبي الجوزاء[40]، ولم يذكر ابن عباس، وقال الترمذي: روى عن أبي الجوزاء مرسلاً وهو أشبه. فهذه علة تقتضي ضعفه من جهة الإسناد.
وأما تطبيقه لقاعدة الترجيح بالسياق، فقد تجلت في قوله: “وأما من جهة المعنى، فإن السياق يرده، يقول تعالى: ﴿وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، ولقد علمنا المستقدمين منكم﴾ ولادة وموتا، ﴿ولقد علمنا المستاخرين﴾ كذلك، فلا يختلط علينا متقدم بمتأخر، ﴿وإن ربك هو يحشرهم﴾ جميعا مع كثرة عددهم وتباعد أزمانهم. فلا محل لصفوف الصلاة في الآية، ولا معنى لاستثنائها”[41].
لقد ظهر كيف أن من مظاهر ضعف الأساس المنهجي في التفسير أن بعض المفسرين يربطون بين دلالة الآية والحديث ربطا بعيدا، ولو كان ذلك على حساب سياق الآية ونظام المعنى الحاف والمرتبط بها ارتباطا تركيبيا ودلاليا.
ولعل الإمام الطبري لم يكن، بعد الذي تبين من سند الحديث ومخالفة توجيه الآية بعيدا عن سياقها، ليعمد إلى الجمع بين تلك الأقوال التفسيرية المتباينة، أو يلتجئ إلى مقولة العموم ليحشر تلك الدلالات في سلك واحد. فهو القائل: “وجائز أن تكون نـزلت في شأن المتقدمين في الصف لشأن النساء والمستأخرين فيه لذلك، ثم يكون الله عز وجل عمّ بالمعنى المراد منه جميع الخلق، فقال جل ثناؤه لهم: قد علمنا ما مضى من الخلق وأحصيناهم، وما كانوا يعملون، ومن هو حي منكم، ومن هو حادث بعدكم أيها الناس…”[42].
لم يكن الطبري مضطرا إلى هذا الجمع بعد أن رجح، هو نفسه، الدلالة المعتبرة التي لا تعلق لها بمسألة الصفوف والمرأة الحسناء.
حقيقة أن الجمع أولى من الترجيح، صونا لكلام الصحابة والمفسرين من الضعف والخطأ، ولكن من شروط الجمع أن يكون وفق أسس قوية البناء، وليس بمجرد القول بالجواز.
النموذج الرابع: الذي أوتي الآيات: هل هو نبي أم رجل من بني إسرائيل؟
تساءل المفسرون عن هذا الذي أشار إليه القرآن في قوله تعالى: ﴿واتل عليهم نبأ الذي ءاتيناه ءاياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين﴾ (الاَعراف: 175)، واختلفوا في ذلك اختلافا بينا، إذ ذهب بعضهم إلى أنه نبي من أنبياء الله، وقد ذكر بعضهم اسمه، وهو “بلعم”، وفي مقدمة هؤلاء الإمام الطبري، فقد أورد روايات عديدة تضم أقوالا تفسيرية يقول بعضها: إنه “بلعم”، وبعضها يقول إنه أمية بن أبي الصلت.
والغريب أن الطبري اعتبر دلالة الآية على أمية بن أبي الصلت غير جائزة؛ لأن الأمة لا تختلف في أن أمية لم يكن أوتي شيئا من ذلك؛ أي من الكتاب والنبوة[43]. وغفل عن الالتفات إلى حقيقة جوهرية، تمثل مقصدا من مقاصد القرآن، وهي أنه لا يجوز القول إنه نبي؛ لأن ذلك مدخل للطعن في حكمة الله وعلمه، إذ كيف يتسرب إلى وهم المرء أن إنسانا يصطفيه الله للنبوة وبالنبوة ثم يعرض عنها ويسلك منهجا مخالفا لها، إن هذا الفهم مدخل إلى تسرب عقائد فاسدة تمس الإيمان بحكمة الله وعلمه.
وأين ذلك من السياق العام لحكمة الله تعالى وعلمه، ذلك السياق الذي يلخصه قوله تعالى: ﴿وإذا جآءتهم ءاية قالوا لن نومن حتى نوتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالاته﴾ (الاَنعام: 125).
ولهذا يتعين نقد مختلف تلك الروايات التي أوردها الطبري سندا ومتنا، خاصة وأن إحداها تضم، في سندها، رواة مجروحين من مثل عبد العزيز بن أبان الذي قال فيه ابن حجر: “عبد العزيز بن أبان بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن العاص الأموي السعدي أبو خالد الكوفي، نـزيل بغداد متروك وكذبه ابن معين وغيره”[44].
وإذا كان بعض المفسرين قد اكتفوا بإيراد مجموع الأقوال التفسيرية دون نقد أو تمحيص أو ترجيح، كما هو صنيع القرطبي[45]، فإن آخرين التفتوا إلى غرابة ذلك التفسير وردوه، يقول الماوردي في تفسيره: “وهذا غير صحيح؛ لأن الله تعالى لا يصطفي لنبوته إلا من يعلم أنه لا يخرج عن طاعته إلى معصيته”[46].
وصاغ الفخر الرازي نقده لمن يذهب بأن المذكور في الآية هو نبي الله “بلعم” في صيغة سؤال: هل يصح أن يقال إن المذكور في هذه الآية كان نبيا ثم صار كافرا؟ فأجاب: “هذا بعيد لأنه تعالى قال: ﴿الله أعلم حيث يجعل رسالاته﴾ (الاَنعام: 125)، وذلك يدل على أنه تعالى لا يشرف عبدا من عبيده بالرسالة إلا إذا علم امتيازه عن سائر العبيد بمزيد الشرف والدرجات العالية والمناقب العظيمة، فمن كان هذا حاله، فكيف يليق به الكفر؟”[47].
وهذا يكشف عن حجم تأثير المرويات الإسرائيلية في توجيه تفسير الدلالة القرآنية، ففي النصوص التوارتية الأصلية حديث عن “بلعم” هذا باعتباره “نبيا”، فكيف تسرب هذا إلى حقل التفسير القرآني؟ وكيف جاز تجاوز الدلالة القرآنية التي لا تصرح بأنه نبي، وتقديم الدلالة التوراتية التي تقول إنه نبي؟ مع تناقضها مع المقصد القرآني المتمثل في أن الله حكيم ولا يصدر عنه إلا فعل حكيم؟!
وعندما انتهى الأمر إلى ابن كثير، عَير الأقوال التفسيرية السابقة بمعيار مقاصد القرآن، ثم حكم عليها بالخطأ والغرابة، يقول: “وأغرب، بل أبعد، بل أخطأ من قال كان قد أوتي النبوة فانسلخ منها، حكاه ابن جرير عن بعضهم ولا يصح”[48]، وانتصر للقول التفسيري الذي ذهب إليه ابن مسعود وغيره من أن الأمر يتصل برجل من بني إسرائيل حصل على علم، غير أنه انسلخ عن الإيمان، وهذا ظاهر في علماء كل عصر، فمنهم من يبلغ درجات عالية في سلم العلم والمعرفة ثم يركنُ إلى الكفر والإلحاد منسلخا من نداء الفطرة وحقائق الآيات.
ومادامت الدراسة تتحدث عن دور السياق في ترجيح الدلالة القرآنية المعتبرة، فإن ما تشير إليه هنا، هو أن أغلب المفسرين غفلوا عن الالتفات إلى السياق الذي وردت فيه الآية المذكورة، فقد ورد قبله قوله تعالى: ﴿وإذ اخذ ربك من بني ءادم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك ءاباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الاَيات ولعلهم يرجعون﴾ (الاَعراف: 172-173)، ثم عقب ذلك، ذكرت الآية: ﴿واتل عليهم نبأ الذي…﴾، وبعدها، ورد قوله تعالى: ﴿فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث اَو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون﴾ (الاَعراف: 176).
فقد عرضت الآيات الأولى للعهد الذي بين الله وذرية آدم، وأشارت الآية الأخيرة إلى حالة القوم الكافرين، فكأن الآية، موضوع التوجيه والترجيح، لم ترد في هذا السياق إلا لتقدم مثلا أو نموذجا لمن خرج عن العهد الذي عاهد الله عليه ليصير من القوم الكافرين، فهي تقدم نموذج الإنسان الذي يودع الله في قلبه عناصر تدعوه إلى الهدى، فطرة وعلما، ولكنه يعرض عن الهدى بعدما تبين له النور. ولا تعلق لها بنبي من أنبياء الله.
وقد لاحظ الإمام البقاعي هذا التناسب، وشرحه بقوله: “ولما ذكر لهم ما أخذ عليهم في كتابهم من الميثاق الخاص الذي انسلخوا منه، وأتبعه الميثاق العام الذي قطع به الأعذار، اتبعها بيان ما يعرفونه من حال من انسلخ عن الآيات، فأسقطه الله من ديوان السعداء، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يتلو ذلك عليهم، لأنه، مع الوفاء بتبكيتهم، من أدلة نبوته الموجبة عليهم اتباعه، فذكره ما وقع له في نبذ العهد والانسلاخ من الميثاق بعد أن كان قد أعطى الآيات وأفرغ عليه من الروح، فقال: “واتل”؛ أي اقرأ شيئا بعد شيء “عليهم”، أي اليهود وسائر الكفار بل الخلق كلهم..”[49].
وانطلاقا من استحضار هذا السياق الحاف بالآية، يمكن، تجاوزا، إدخال “أمية بن أبي الصلت” في مشمولات لفظ “الذي”، كما ذهب إلى ذلك عبد الله بن عمرو وغيره، باعتبار أنه اسم لا يلغي تخصيص “الذي” بالرجل من بني إسرائيل، إنما تقدم أعيانا من ذلك الإعراض ونماذج بين يدي الخلق كلهم كما نبه عليه الإمام البقاعي.
إن النماذج التطبيقية السابقة سيقت لإبراز كيف أن السياق لا يعين على التفسير فقط، وإنما يمارس وظيفة ترجيحية بين الدلالات التي تمنح للآية الواحدة، ومن ثم، فإنه يمثل إحدى قواعد الترجيح التي على المفسر أن يعملها وهو يعرض لأقوال المفسرين، أو يسعى، إن كملت له آلة الفهم، إلى إدراك دلالة الخطاب.
4. إشكالات منهجية مصاحبة للقول بالوظيفة الترجيحية للسياق
إن ما أقدمنا على عرضه من نماذج إنما كان لهدف واحد وهو أن إعمال السياق يسهم في القيام بمهمة الترجيح بين الأقوال، وبالتالي، فهو يساعد على إنجاز مراجعة شاملة لأقوال المفسرين ومذاهبهم في التأويل، وهذا ما سعت الدراسة إلى التذكير به.
غير أن هذا المقرر يصطدم ببعض المنازع والمقررات والقواعد التي تسربت إلى حقل التفسير، واتخذت طابع المسلمات، منها القول إن جميع المعاني التي أوردها المفسرون للآية الواحدة هي مما تقبله لغة القرآن ويطيقه بيانه الذي اختار تكثير المعاني في اللفظ الموجز، ومنها تصور أن دلالة السياق قد تكون مرجوحة أو ضعيفة بحجة من الحجج، ومنها الذهاب إلى أن قول الصحابي حجة. وسنقتصر على نقد المنـزعين الأولين، تاركين الحديث عن قول الصحابي إلى مناسبة أخرى بحول الله.
والكلام على هذه الإشكالات يقتضي تفصيلا في القول لا تطيقه هذه الدراسة الموجزة، ولكن يكتفى بالإشارة إلى الإشكال تحريرا وتمثيلا.
أ. نقد منـزع القول بقبول الآية القرآنية لمختلف الدلالات
فقد اعتبر الشيخ الطاهر بن عاشور قبول المعاني المتعددة للآية الواحدة أصلا ومنهجا، وانتقد غفلة المفسرين عنه، يقول: “وقد كان المفسرون غافلين عن تأصيل هذا الأصل، فلذلك كان الذي يرجح معنى من المعاني التي يحتملها لفظ آية من القرآن يجعل غير ذلك المعنى ملغى، ونحن لا نتابعهم إلى ذلك، بل نرى المعاني المتعددة التي يحتملها اللفظ بدون خروج عن مهيع الكلام العربي البليغ معاني في تفسير الآية”[50].
غير أن هذا الكلام يتوجه إليه الاستدراك الآتي:
– إن لجوء المفسرين إلى الترجيح يدل على أن بعض المعاني غير مقصود بلفظ القرآن، إما لعدم احتماله له، أو لتخلف بعض شروط الدلالة لغة وسياقا.
– إن تعدد المعاني التفسيرية لا يقتصر على اللفظ المفرد، بل إنه يشمل المخاطبات والضمائر وعودها، والمتحدث عنهم، والتراكيب، وغيرها من الأنماط والظواهر، ومن ثم وجب حمل عموم كلام الطاهر بن عاشور على خاص واحد ألا وهو التعدد الدلالي للفظ المفرد، وقد صرح فضيلته بذلك، أما أن ينسحب على مختلف أشكال الاختلاف بين أقوال المفسرين، أو أن يستغرقها جميعا استغراق لفظ العام لمشمولاته، فهو بعيد والله أعلم، لأن ما أتينا على عرضه من نماذج، وهي غيض من فيض، يدل على أنهم لم يختلفوا في دلالة اللفظة المفردة فقط، وإنما امتد خلافهم إلى أبعد من ذلك، وإذا استحال الجمع بين الأقوال المختلفة، والجمع أولى من التفرقة، وجب الهروع إلى الترجيح، والله أعلم بالصواب.
إن مذهب الإمام الطاهر بن عاشور مقبول في حدود التعدد الدلالي للفظ الذي يحتمل ذلك، وقد كان المفسرون واعين بهذا المسلك، وجاءت تفسيراتهم مستوعبة لمختلف ما يطيقه اللفظ. وإذا كانت الأمثلة كثيرة، فإن الدراسة تقتصر على إيراد نموذج واحد يقاس عليه.
فقد وقف المفسرون عند قوله تعالى: ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة﴾ (الاَنفال: 61)، وذهب بعضهم إلى أن المراد بها الرمي، وذهب آخرون إلى أنها الخيل، ولعل هذه المعاني هي آحاد تخصص عموم القوة، وكأنها نماذج من القوة المطلوبة، باعتبار أن الرمي قوة والخيل قوة. وبإحكام هذا التعدد الدلالي المستجيب لشروطه اللغوية والمقامية، فلا معنى لأن يرد تفسير “مجاهد” للقوة بالخيل كما يذهب إليه الزركشي[51]، ما دام الخيل من مشمولات القوة وعناصرها.
لكن هذا الاستيعاب الدلالي لمختلف التفاسير الواردة في موضوع “قوة” لا يتاح مع جميع أشكال الاختلاف التفسيري بين العلماء، قديما وحديثا، مما يستدعي الهروع إلى قاعدة الترجيح بين تلك الأقاويل، واعتماد السياق أداة حاكمة في تطبيق تلك القاعدة. فكيف يمكن الجمع، مثلا، بين دلالتي “الحصور” التي وصف الله بها “يحيى بن زكريا”: الضعف الجنسي، والقدرة على ضبط الشهوة، إنهما دلالتان مختلفتان، ولا يمكن، بأي وجه من وجوه التأول، أن يعتبرا من قبيل أن يكون كل مفسر “ذكر معنى ظهر من الآية، وإنما اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل، أو لكونه أليق بحال السائل، وقد يكون بعضهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره، والآخر بمقصوده وثمرته، والكل يؤول إلى معنى واحد، والمراد الجميع… وكثيرا ما يذكر المفسرون شيئا في الآية على جهة التمثيل لما دخل في الآية، فيظن بعض الناس أنه قصر الآية على ذلك..”[52]، أو من قبيل “أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى… ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس.. أو أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل، وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه..”[53]؛ لأن القول بذلك، ثم الجمع بين دلالتين مختلفتين، لن يكون سوى محاولة موقعة في الاضطراب والتناقض، باعتبار أنه ليس كل الاختلاف التفسيري راجعا إلى علاقة التضمن والعام والخاص واللازم والثمرة، وإنما يتعدى الاختلاف مختلف تلك العلاقات المنطقية إلى اختلاف تضاد وتناقض، مما يوجب إخضاع مقولة “قبول اللفظ القرآني لمختلف الدلالات المذكورة” لأقصى درجات التقييد والتخصيص.
ب. هل تخضع دلالة السياق للإهمال بحجة؟
يذهب الإمام الطبري إلى أن دلالة السياق تعد مرجوحة حين تتقدم عليها دلالة أخرى بحجة من الحجج، يقول: “غير جائز صرف الكلام عما هو في سياقه إلى غيره إلا بحجة يجب التسليم لها”[54]. وجعل الحجة مرتبطة بالعناصر الآتية:
ـ أن تكون دلالة ظاهر القرآن تدل على خلاف ما يوحي به السياق.
ـ أن يكون هناك خبر صحيح يفسر الآية بخلاف ما يفهمه سياقها.
ـ أن يكون هناك إجماع من أهل التأويل على تفسير الآية تفسيرا يخرجها عن سباقها ولحاقها[55].
ولعل الدارس يستشكل هذا التقييد من قبل الإمام الطبري، إذ كيف يمكن لإجماع علمي تفسيري أن ينقض دلالة السياق؟ وهل يتصور جواز ذلك أصلا؟ وهل وجد فعلا خبر صحيح مناقض لدلالة السياق؟ وأليس ظاهر الآية جزء من سياقها المعتبر؟ يعين على الفهم ولا يقتصر عليه.
إن الأمر يستدعي استقراءا دقيقا لمعرفة هل وجدت، فعلا، دلالة سياقية لآية ما، ووجد إلى جانبها إجماع من قبل المفسرين بمرجوحيتها أوضعفها؟ وقل الأمر نفسه بخصوص قيد الخبر الصحيح وظاهر القرآن.
إن التعرض لهذه الإشكالات الثلاث، منـزع القول بقبول اللفظ القرآني لمختلف التفاسير المحتملة، ومنـزع القول بحجية قول الصحابي في التفسير، ومنـزع القول بتقييد دلالة السياق بحجة معتبرة، إنما كان لمقصدية إثارة الإشكال ليسهم أهل التفسير والاجتهاد في بسط القول في ما يعود بالنفع على علوم التفسير وطلبة تلك العلوم على حد سواء.
الهوامش
1. الآمدي: “الإحكـام في أصـول الأحكام”، دار الكتب العلمية، بيروت ط:2، 1983، 1/104.
2. André Lalande: “Vocabulaire technique et critique de la philosophie”, PUF, 13°ed, 1980, p. 181.
3. R.Galison et D.Coste: “Dictionnaire de didactique des langues”, p. 123.
4. Ibid.
5. Roger Fowler: “A dictionary of moderne critical term”. Rout ledge-London, 1991,p:41.
6. André Lalande: ” Vocabulaire…”, p. 181.
7. Encyclopédie AXIS. (C.D).
8. Dictionnaire de didactique des langues, p. 123.
9. ابن قيم الجوزية “بدائع الفوائد”، دار الكتاب العربي، بيروت، 4/9-10.
10. الشيخ العز بن عبد السلام: “الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز”، دار الحديث، القاهرة، ص: 220.
11. محمد حبنكة الميداني: “قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل”، دار القلم، دمشق، ط:2، 1989، ص: 319.
12. الشاطبي: “الموافقات في أصول الشريعة”، تصحيح: محمد عبد الله دراز، دار المعرفة، بيروت، 3/413-414.
13. الموافقات: 3/ 153
14. محمد بن محمد سالم المجلسي: “الريان في تفسير القرآن”، مخطوط: ص: 15-16، نقلا عن “الدراسات القرآنية بالمغرب في القرن الرابع الهجري”، إبراهيم الوافي، مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء، ط: 1، 1999، ص: 120.
15. الشيخ رشيد رضا: “تفسير المنار”، 1/22.
16. ابن منظور: “لسان العرب”، دار الفكر، مادة “رجح”، ج:2، ص: 445.
17. القاضي البيضاوي: “منهاج الوصول في علم الأصول”، مطبوع مع “نهاية السول شرح منهاج الأصول” للأسنوي، مطبعة التوفيق الأدبية، مصر، ج: 3، ص: 138
18. الصاحب محيي الدين يوسف بن عبد الرحمن الجوزي: “كتاب الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل والمناظرة”، تحقيق: محمود بن محمد السيد الدغيم، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط:1، 1995، ص: 449.
19. أبو إسحاق الشيرازي: “شرح اللمع”، تحقيق د. عبد المجيد التركي، دار الغرب، الإسلامي، ط:1، 1983، ج:2، ص: 950.
20. “أصول السرخسي”، تحقيق الأفغاني أبو الوفاء، بيروت، دار المعرفة، ج:2، ص: 12.
21. سيف الدين الآمدي:” الإحكام في أصول الأحكام “، ج:4، ص: 320.
22. الآمدي: “الإحكام في أصول الأحكام”، ج:4، ص: 324.
23. د. محمد عابد الجابري:” مدخل إلى القرآن الكريم”، دار النشر المغربية، البيضاء، ط: 1، 2006، ص: 80.
24. الطبري: “جامع البيان…”، 3/255-256.
25. القرطبي: “الجامع لأحكام القرآن”، 4/78، والبيت لأبي طالب بن عبد المطلب يمدح رجلا بالكرم.
26. الطاهر بن عاشور: “تفسير التحرير والتنوير”، دار سحنون للنشر، تونس، 3/241.
27. الراغب الأصبهاني: “مفردات ألفاظ القرآن الكريم”، تحقيق صفوان عدنان داوودي، دار القلم، ط:1، 1992، ص: 238-239.
28. “جامع البيان”: 12/637-638.
29. المرجع نفسه، 12/639.
30. المرجع نفسه.
31. “الجامع لأحكام القرآن”: 20/115.
32. أبو حيان الأندلسي: “البحر المحيط”، تحقيق زكريا عبدالمجيد النوني وأحمد النجول الجمل، دار الكتب العلمية بيروت، ط:1، 1993، 8/486.
33. ابن جزي الكلبي: “التسهيل لعلوم التنـزيل”، دار الفكر، م: 2، 4/207.
34. “البحر المحيط”، 8/489.
35. السيوطي: “تناسق الدرر في تناسب السور”، تحقيق عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: 1، 1986، ص: 140.
36. المرجع نفسه.
37. عبد الرحمن بن ناصر السعدي: “تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان..، تحقيق: محمد زهري النجار، مؤسسة الرسالة، ج: 2، ص: 1042.
38. رواه الحاكم في المستدرك، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط:1، 1990، ج: 2، ص: 384، تفسير سورة الحجر، حديث رقم: 3346، وابن ماجة في سننه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت، ج:1، ص: 332، باب الخشوع في الصلاة، حديث رقم: 1046، ومسند الإمام أحمد، مؤسسة قرطبة، مصر، ج:1، ص: 305، حديث رقم: 2784، وسنن البيهقي الكبرى، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الباز، مكة، باب الرجل يقف في آخر صفوف الرجال،ج: 3، ص: 98، حديث رقم:4950.
39. جامع البيان، ج: 7، ص: 510.
40. أوس بن عبد الله الربعي البصري، حدث عن عائشة وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص، قتل سنة 83 في الجماجم، قال عنه الإمام البخاري في إسناده نظر. انظر “الكامل في الضعفاء، ج: 1، ص: 411، المغني في الضعفاء للذهبي، ج: 2، ص: 779، وميزان الاعتدال للذهبي، ج:1، ص: 445، وقال:”في إسناده نظر، ويختلفون فيه” والتاريخ الصغير، ج: 1، ص: 180، ولم يذكر ابن عباس، و الترمذي، سنن الترمذي ج:5/ ص: 296/ باب ومن سورة الحجر، حديث رقم: 3122، ولم يذكر ابن عباس. (الشيخ عبد الله بن الصديق: “الإحسان في تعقب الإتقان” دار الأنصار، مصر، ص: 10).
41. المرجع نفسه، ص: 10.
42. جامع البيان، ج7، ص: 510.
43. جامع البيان، ج: 6، ص: 122.
44. تقريب التهذيب، ج: 1، ص: 602.
45. الغريب أن الإمام القرطبي تعهد في مقدمة جامعه بأن يخلص تفسيره من الإسرائيليات،وذلك في قوله:”… وأضرب عن كثير من قصص المفسرين وأخبار المؤرخين، إلا ما لابد منه ولا غنى عنه للتبيين”، لكنه يورد، هنا، بعضا منها دون نقد أو تضعيف.
46. تفسير الماوردي، ج: 2، ص: 279.
47. الفخر الرازي: “مفاتيح الغيب”، ج:15، ص:54.
48. ابن كثير: “تفسير القرآن العظيم”، ج: 3، ص: 508.
49. الإمام البقاعي: “نظم الدرر في تناسب الآيات والسور”، تحقيق: عبد الرزاق الغالب المهدي، دارالكتب العلمية، بيروت، ط:1، 1995، ج: 3، ص: 150.
50. الطاهر بن عاشور: “تفسير التحرير والتنوير”، 1/100.
51. الزركشي: “البرهان في علوم القرآن”، ج: 2، ص: 157.
52. المرجع نفسه، ج: 2، ص: 160.
53. “شرح مقدمة التفسير لابن تيمية”: الشيخ محمد بن صالح العثيمين، دار الوطن، الرياض،ط:1، 1995.ص:29-40.
54. “جامع البيان”، ج: 5، ص: 555.
55. نفسه، ج:7، ص: 268.