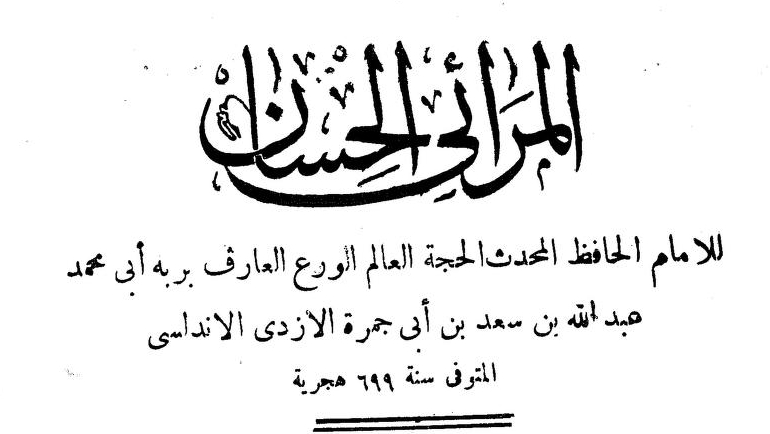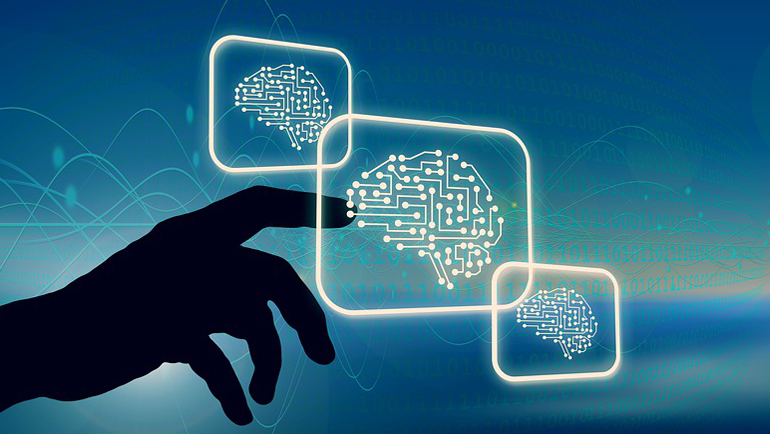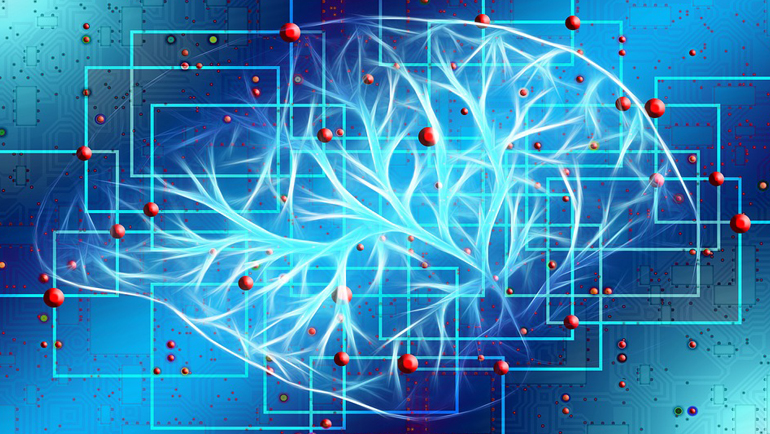أولا: أزمة العقل المسلم
معضلتنا الحضارية تكمن في أن العقل الإسلامي المعاصر، عمدًا وإهمالاً، قد صيغ على نحو غير إسلامي، ومرآته تعكس ذلك بوضوح يدركه القاصي والداني في بنيتنا السياسية، ونظمنا الاجتماعية، وأنساقنا الفكرية والتعليمية؛ فالعقل المأزوم، والواقع المعتل سمتان رئيسيتان في المشهد الإسلامي الراهن..
فالأزمة، إذن، قائمة، والاعتراف بها ضرورة منهجية للتصحيح، وهي في المقام الأول أزمة عقل تخلى عن موقعه كسلاً، وأزمة مجتمع تراجعت حركته جهلاً، وتحت وطأة التراكم المعرفي المعكوس، لم يعد التخلي والتراجع مجرد غفوة تقطعها الصحوة، ولا مجرد فجوة يتجاوزها التجسير، وإنما تحولت إلى جفوة تغذيها قوى نخبوية متعددة الاتجاهات، ومتقاطعة الاجتهادات، إلا أنها تجتمع على التحذير من الإسلام باعتباره منهج حياة فتسعى جاهدة إلى تقطيع أوصاله العقدية، وتنحية أحكامه التشريعية، والثورة على منظومته القيمية.
وللنخبة الشاردة مداخل كثيرة في تفكيك “العقل المسلم”؛ فمنهم من يطعن في القرآن كله وينزله من مقام الوحي الإلهي، إلى سفوح الوعي البشري، ومنهم من يستخدم منهج التفرقة بين اللغة والفكر، لينقض على الدلالة القطعية للنص. والتي يراها مجرد شكلانية تقوم على التواتر، وتعترض من أعلى ثبوت النص وثباته، إعلاءً لمعيار صلاحية الفكرة التي تقبل الدحض من خلال تكذيب الواقع لها في التجربة المعاشة..
وهكذا تصبح الأحكام كلها نسبية، ويصبح الدين كله ذيلاً للواقع، فمعيار الصلاحية قانون التغير، ومعيار القطعية قانون الثبات، قانون الصلاحية يعني التجديد، وقانون القطعية يعني الجمود، ومن خلال هذه الجدلية التي لا يوجد لها قانون ضابط يحاكم الإسلام، ومصادره وأحكامه، من زاوية رؤية تتزامن فيها الأحكام، وتغيب في بؤسها المادي كل منظومات الشريعة عقائدية وأخلاقية وتشريعية، وهو ما يلخصه “طه محمود طه” بقوله: “والحق الذي لا مرية فيه أن قوانين القرآن في نصها وروحها إنما هي وسيلة… بيد أن الوسيلة في روح القرآن أقرب إفضاء إلى الغاية عن الوسيلة في نصه… ولذلك لا يرى القرآن بأسًا من الخروج على النص، بل إن الخروج على النص عمل يستهدفه التطور الذي يرعاه ويهديه القرآن… وما ينبغي التنبيه إليه هو أن الشريعة الإسلامية ليست خالدة، وإنما هي خاضعة لسنة التطور والتجديد، وهي لم تكن خالدة لأنها ناقصة، ولا يأتيها النقص من ذاتها، وإنما يأتيها في ملابساتها، ذلك لأنها جاءت لخدمة مجموعة بعينها، مجموعة بدائية، بسيطة، متخلفة فطورتها ورقتها، ثم أصبحت الآن تعيش في مجموعة أكثر تعقيدًا، وأكثر تقدمًا، وأصبح علينا أن نتخذ من التشريع ما يتلاءم مع حاجة هذه المجموعة المتمدينة، المعقدة، المتقدمة”.
وبهذه الكلمات يتم القفز على النصوص وتنبذ التشريعات؛ يدعو “طه محمود طه” في جرأة نفتقدها عند نظرائه أن لا نختبئ وراء منظور فلسفي، ولكن وبأسلوب صحفي يعلن موقفه وقد سُئل في مهرجان أقامه نادي الجمهوريين الذي يرأسه: ما رأيك في الزكاة ذات المقادير التي بيَّنها الرسول في سنته؟ فقال: ليست أصلاً في الإسلام، وإنما كان تشريعًا لفترة محددة وهي لا تناسب زماننا.
وسُئل: هل تصلي؟ فقال لا أصلي صلاة التقليد.
وسُئل: هل تذهب إلى الحج؟ فقال: أحج حول قلبي.
وسُئل: هل تصوم رمضان؟ فقال: آكل نهار رمضان ولكنني لا أشبع.
ثانيا: الوحي
الوحي له معانٍ متعددة ورد بها القرآن الكريم، فهناك وحي إلى الملائكة، ووحي إلى الجمادات، ووحي إلى الحيوانات الدنيا، وكلها أنواع من الوحي لها طبيعة مختلفة عن الوحي إلى البشر، وهو على ثلاثة أنواع:
النوع الأول؛ يتمثل في إلقاء فكرة في الروع والذي أُطلق عليه اصطلاحًا “الوحي الخفي” وهذا نوع يشترك فيه الأنبياء وغيرهم.
النوع الثاني؛ تكليم الله للبشر من وراء حجاب، وهو يشمل الرؤيا والكشف والإلهام، وهذه تجربة معاشة لدى البشر جميعًا.
النوع الثالث؛ الوحي الخاص بالنبوة: وهو رسالة إلهية يحملها جبريل إلى النبي المصفى، ويسمى هذا الوحي بالوحي المتلو، وهذا هو أسمى صور الوحي، وهي طريق تبليغ الرسالة إلى كل نبي رسول بلاغًا للناس وبيانًا للكتاب. وهذا الوحي في الإسلام مرتبط بأمرين:
الأول: الإيمان بكل كتب الله المنزلة.
الثاني: الإيمان بختم الرسالة واكتمال الدين.
من هنا اتجه الفكر العلماني إلى رفض مصطلح الوحي في منظور المعرفة العقائدية الدينية، فاعتبره مجرد تنوير للعقل، واستخدم التأويل ليصل إلى القول بأن الله يتكلم إنما هو على سبيل المجاز؛ لأن الموحى له هو الذي يتكلم تحت تأثير إلهي معين..
ويحاول “عبد الكريم سروج” في كتابه “بسط التجربة النبوية” حذف الوحي بمفهومه الاصطلاحي عن المعجم الكلامي بقوله: “وليس النبي تابعًا لجبريل، بل جبريل تابع له، فهو الذي ينزل الملك، ومتى أراد أن يرحل عنه تحقق ذلك. وبإمكاننا الإشارة إلى هذه الحقيقة، وهي الاعتقاد بأن كلام النبي هو عين كلام الباري، ويُعد أفضل طريقة لحل المشكلات الكلامية في موضوع الكلام الإلهي”.
وفي نفس السياق يؤكد “أن الوحي تابع لشخصية النبي وليس النبي تابعًا للوحي”، وبعيدًا عن تصور وحدة الوجود بالمفهوم العرفاني التي تنطوي عليها كلمات “سروش” فهي تأسيس لعلمانية تذيب مفهوم الوحي في شخصية النبي، وتقطع الصلة بين المخلوق والخالق بتأليه النبي ذاته. وينتهي الأمر بـ“سروش” إلى قطع الصلة بين القرآن واللوح المحفوظ ليقول: “إن القرآن لم يكن موجودًا قبل ذلك إطلاقًا؛ (أي قبل نزوله بالتدريج)، بل إن حوادث الزمان ورشد النبي قد منحا القرآن وجوده التاريخي؛
أي أن القرآن قد وُجد بالتدريج، والدين الذي يتكون بالتدريج، كما يقول “سروش”، فإن استمراره وحركته بعد ذلك سيكونان متدرجين. والقرآن، مادة وحجمًا، مرتبط بتاريخ النبوة لأنه من إنتاجها “فلو أن النبي استمر في حياته، وكان له من العمر أكثر مما وقع، فمن الطبيعي أن تزداد ممارساته ومواجهاته للحوادث، وهذا يعني أن القرآن كان بإمكانه أن يكون أكثر في حجمه من هذا القرآن الموجود”.
ويقول أيضًا: “وبإمكان القرآن أن يزداد حجمًا فيما لو فرضنا أن النبي قد امتد به العمر أكثر مما كان، وهذا يعني أن حجم الهداية النبوية، وبيان التعاليم السماوية سيكون أكثر مما هو موجود فعلاً”؛ وهذا يعني أن القرآن لا يعرف مرحلة نزول تنتهي برحيل الرسول، صلى الله عليه وسلم، بل هو تنزيل سيال مرتبط في تكوينه وأحكامه بحركة التاريخ.
وهذه السفسطة مهما حاول “سروش” إسباغ المنطق عليها يمكن إيجازها في تعبير أستاذه “نصر أبو زيد” بأن القرآن منتج تاريخي، وقد حاول “سروش” الرد على قطعية اكتمال الدين، وهي محاولة ساذجة، يقول: “وفي مسألة اكتمال الدين فإن الله تعالى قرر أن يمنح الدين صفة الكمال، ولكن البعض يعتقدون خطأ بأن معنى “كمال الدين” هو شمولية هذا الدين…
وكل هذه التفسيرات والأقوال مجانبة للصواب؛ فهناك فرق بين “الجامع” و”الكامل”، الجامع يعني الشامل لكل شيء والكامل يعني أن هذا الدين لا ينقصه شيء من الأدوات والمفاهيم والتعاليم بالنسبة لما يريد أن يحققه على أرض “الواقع البشري”..
نعم إذا كنا ننظر إلى الدين بعين الطمع، ونتوقع منه أن يكون جامعًا وشموليًا ونريد أن نستخرج منه كل ما يحتاج إليه الإنسان في حركة الواقع والحياة، ولكنا نرغب في أن يمثل الدين الحد الأعلى من توقعات الإنسان، فسوف نصطدم سريعًا بأن الدين بهذا المعنى ناقص ولا يحقق جميع طموحات الإنسان في حياته الاجتماعية، إذن الدين كامل لا جامع، وهذا الكمال يمثل الحد الأدنى في عالم الثبوت لا الحد الأعلى في عالم الإثبات”. والسؤال الذي يفرض نفسه: ما الذي بقي من الدين بعد إلغاء الوحي، وما الذي بقي من القرآن بعد ربطه بعمر النبوة أي بالتاريخ، وليس بوظيفة النبوة وهي التلقي والبلاغ؟
وإذا كان القرآن سيتكون عبر التاريخ فمن الذي يحمله إلى الناس؟ وأين مكان عقيدة ختم النبوة من هذه الهرطقة التي لا يكبح جماحها عقل رشيد، لابد من نبي جديد؛ “فالنبي، صلى الله عليه وسلم، كما يقول سروش، قد بُعث لقوم معينين وفي تاريخ معين، ولا يستوعب جميع الأزمنة والأمة” وهذا يعني أن الخطاب التجريدي في الحكم التكليفي لا وجود له، وأن الله ليس متكلمًا ولا كلام له، وأن الكتب السماوية هي وقائع لا متناهية، هي مجرد وقائع أعيان تختلف كل الاختلاف من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان..
وكل إنسان يُعد نبيّا مادام الله لم يخلق الإنسان، وإنما الإنسان هو الذي خلق الله كما يزعم “حسن حنفي”، وكل شخص يمكن أن يكون رسولاً فلا اصطفاء ولا اختيار، وكما يقول “سروش” نفسه: “إن كل إنسان يمكنه أن يكون رسولاً لنفسه وينبغي الإذعان لهذه الحقيقة، ولكن المجتمع الديني الإسلامي سيتصدى لمثل هؤلاء فيما لو أعلنوا نبوتهم من موقع القساوة والشدة والخصومة”.
وهذا يعني شخصانية الدين والعودة به إلى مفهوم مسيحي قد يتناسب مع دين ضاع كتابه، وكتبت أناجيله تحت تأثير تصور للوحي يبتعد به كثيرًا عن الوحي الذي حمل القرآن إلى الرسول وبلغه الرسول، صلى الله عليه وسلم، إلى دنيا الناس.
والحاصل أنّ ما يقدمه “سروش” يُعد معرفة دينية مغلوطة لأنها تنفي الوحي، وتنكر ختم النبوة، وتجعل القرآن مجرد وعاء فارغ يملأه الإنسان بما يراه من خلال حركة التاريخ، وليس المقصود استبعاد الوحي ذاته؛ وإنما المقصود التأكيد على بشرية الدين وكتابه، وتاريخية الأحكام ونسبيتها، والعقل العلماني لا يقدم أفكاره إلا في ضوء إلغاء حاكمية النص ليصبح العقل هو المرجع الأول والأخير.
وأختم ما أنقله عن “سروش” بسطور دالة من مقالة للأستاذة التونسية “آمال قرامي” نشرته مجلة الشروق المصرية في 10 مايو 2016 عن “جدل المساواة في الإرث” تقول: “إن مبادرة المساواة في الإرث تفضح المتناقضات في تركيبة الشخصية التونسية والإسلامية عمومًا، وتكشف النقاب عن مقاصد المدافعين عن الأيديولوجيا الذكورية من الرجال والنساء، وتبين مأزق العلماء، الكل يحتمي بحجج واهية من قبيل؛ “لا يجوز مخالفة النص القرآني”.
وهكذا تبدأ “آمال قرامي” مقالتها وتنهيها بإدانة من يحتكم إلى النص القرآني، إن الوحي لا وجود له في منظومتها الفكرية كما هو الحال عند العلمانيين جميعًا، فهي تدعو الجميع إلى تغيير منطق الاحتجاج، لينسحب الدين عن الحياة وتبقى العقلانية المتوحشة هي الحكم الأول والحكم الأخير، إن قواعد أي لعبة تحتاج إلى حكم، والحكم يحتاج إلى منظومة حاكمة، وتجريد الدين من أحكامه لا يعني إلا أن الحكم الوحيد هو العقل وتلك قسمة ضيزى في المفهوم الإسلامي.
إن القضية في تقديري ليست في تغيير منطق الاحتجاج، لأن الاحتجاج موقف قبْلي لا يرتضيه العلم، وإنما في تأكيد قواعد الحجاج بعيدًا عن اللجاج، حيث يظل الوحي وحيًا والعقل عقلاً، ويظل السؤال قائمًا: هل يكفي العقل وحده ليتجاوز الإنسان مشكلاته ويمكنه فهم الكون المحيط؟ فإذا كانت الإجابة بـ”لا” وهي في الحقيقة كذلك، فإن الدين في مقامه المتعالي هو الوجهة الأولى التي تلهم العقل وتوجه الحياة، وكما قال “كينج”: “إن الثقة في العقل الإنساني وحده هي ظاهريا تعبير عن موقف عقلاني، أما في حقيقة أمرها فهي لا عقلانية”.
إن أية محاولة لعزل الدين عن الحياة تعني في الأخير أنسنة الآلهة، وعلمنة التشريع، وهو ما يريده دعاة العلمانية، ولكن السؤال الحاد الذي يواجه كل العلمانيين بسيفه القاطع: هل هذه عقلانية أصيلة أم أنها عقلانية مزيفة؟ ولماذا نضع الدين في موقف التعارض مع العقل؟ وكلاهما له مجاله الحيوي رغم التماس بينهما؛ الدين ميدانه الغيبيات وأحكام التكليف التي قانونها الاختيار، والعقل ميدانه الكون وسننه والتي تقوم على الإجبار. فكل ما هو اختيار فإن للدين فيه كلمة أعلى، وكل ما هو إجبار فللعقل فيه كلمة عليا. ثم يلتقيان في مناط التكليف ومحله، حيث يصبح الحكم التكليفي والحكم الوضعي يجمعهما النص والعقل معًا في وحدة عضوية لا تقبل التجزئة.
يقول “الجنيد”: “إن الله لا يسألك لماذا مرضت، ولكنه يسألك لماذا ضجرت” المرض ابتلاء لازم، والضجر اختيار مأزوم، و“حسن حنفي” في كتابه “من العقيدة إلى الثورة” يجعل مشكلة العقل أكثر تعقيدًا في مواجهة الوحي عندما يقول: “إن النبوات التي تتحدث عن إمكانية اتصال النبي بالله، وتبليغه رسالة منه، هي في الحقيقة مبحث في الإنسان كحلقة اتصال بين الفكر والواقع… فهي ليست غيبية بل حسيّة، والمعارف النبوية الدنيوية حسيّة، وصفات الله السبع هي في حقيقة الأمر صفات إنسانية خالصة، فالإنسان هو العالم، والقادر، والحي، والسميع، والبصير، والمريد، والمتكلم.. وهذه الصفات في الإنسان ومنه على الحقيقة، وفي الله وإليه على المجاز.
وذات الله المطلق هو ذاتنا نحو المطلق؛ فالإنسان يخلق جزءًا من ذاته ويؤلهه أي يخلق المؤله على صورته ومثاله، ثم يعبده، فالذات الإلهية هي الذات الإنسانية في أكمل صورها، وتصور الله على أنه موجود كامل هو في الحقيقة تعبير عن رغبة، وليس حكمًا على وجود في الخارج، وأي دليل يكشف عن إثبات وجود الله إنما يكشف عن وعي مزيف.
والعقل ليس بحاجة إلى عون، وليس هناك ما يند عن العقل، ويمكن معرفة الأخلاق بالفطرة، فالوحي لا يعطي الإنسان شيئًا لا تستطيع الإنسانية أن تكتشفه بنفسها في داخلها، وأن مهمتنا أن ننتقل بحضارتنا من الطور الإلهي القديم إلى طور إنساني جديد، وتحويل قطبها من علم الله إلى علم الإنسان.
إن تقدم البشرية مرهون بتطور من الدين إلى الفلسفة، ومن الإيمان إلى العقل، ومن مركزية الله إلى مركزية الإنسان حتى تصل الإنسانية إلى طور الكمال، وينشأ المجتمع العقلي المستنير”.
وبعيدًا عن هذه العبارات التي تناقض منطق الدين والعقل، وبعيدًا عن قانون الحالات الثلاث عند “بيكون” الكامن وراء هذا التصور، فإن “حسن حنفي” يدخل فكره في جدلية متناقضة مع الواقع الذي هو المصدر المعرفي الأصيل عنده، إن الواقع المشاهد يكشف عن عدم استطاعة العقل فإذا كانت عدم الاستطاعة مصدرها عدم القدرة فنحن أمام ما يشبه الدور أي أمام قادر لا يستطيع، وإذا أخذنا بقول المعتزلة في الصرّفة فمن الذي صرَّف العقل وسلبه القدرة..
فعدم الاستطاعة تعني أنّ الإنسان بعقله ليس بقادر لأن القادر من لديه قدرة مطلقة وشاملة ومستمرة، وإذا كانت الصرّفة فقد حضرت قدرة الله وغابت قوة الإنسان، واللطف كما قال الشيخ “المفيد” مستمر في الصرّف إلى آخر الزمان. ومثل ذلك يقال في العالم، والحي، والسميع البصير إلى آخره، وهكذا تصبح عبارات “حسن حنفي” حروفًا متقطعة ومتقاطعة، وتحتاج إلى النظم بمفهوم “عبد القاهر الجرجاني” حتى تكون نسقًا معرفيًا يستحق المناقشة أو يخضع لمعايير الرفض والقبول.
ثالثا: خصائص النص القرآني
إن النص القرآني له خصائصه الكامنة فيه، وهي خصائص لازمة لفهم النص وإهمالها خروج صريح على النص، وهي خصائص أوجزها فيما يلي:
1. القرآن الكريم نص إلهي
وهذه الخصيصة الأولى للقرآن الكريم إذا غابت عن الناظر فيه، قارئًا أو مستنبطًا، مفسرًا أو مؤولاً، فَقَدْ فَقَدَ القاعدة المنهجية الأولى للتعامل مع القرآن الكريم، لأن قضايا الإعجاز والغيب والنبوة، لا تُفهم ولا تُستوعب إلا باعتباره نصًا إلهيًا، نزل بلسان عربي مبين، وهذا يقتضي ما يلي:
أ. هناك مسلمات في الاقتراب من النص القرآني، فلا تُفهم أحكامه، ولا تُستوعب تشريعاته، عند أولئك الذين يرونه نصًا بشريًا، إنكاريًا أو ارتدادًا، فكل تفسير لهذا الكتاب بالرأي أو بالمأثور، لابد من انطلاقه من بديهية أولى هي إلهية النص، ولا تعني إلهية النص القرآني جموده أو تجميده، وإنما تعني أن العقل مرتبط بالنص، مهمته أن يفهم أحكامه، لا أن يتجاوزها، أو يأتي بابتداع لا سند له من كليات النص، ومقاصد الشرع.
ب. إن عربية النص القرآني تقتضي عند فهمه ودراسته، الانقياد لقوانينه اللغوية، مع التأكيد على أنه نص إلهي وليس نصًا بشريًا، أو كما يدعو “الراغب الأصفهاني” في مقدمة تفسيره، إلى ضرورة انقياد المفسّر للنص، فلا يجافي منطق اللغة، ولا ينأى عن دلالاتهما، وإلا خرج إلى التأويل المستكره الذي يلوي فيه المفسّر أو المؤول عنق النص، حتى يوافق هواه، ويدعم مذهبه واتجاهاته، وكثير من الكاتبين اليوم في تفسير القرآن من غير أهل الاختصاص، يخرجون عن النص بتأويل مستكره كما يقول الراغب الأصفهاني.
2. عمومية النص القرآني
وهي عمومية خطاب يستوعب الزمان والمكان، فلا يتوجه فحسب إلى بيئته التي نزل فيها، أو زمن بلاغ الرسالة، أو بلاد معتنقيه وأتباعه، فالقرآن خطاب للحياة الإنسانية كلها، وهذا أحد معاني ختم الرسالة الإسلامية، والقول بعمومية النص القرآني يلزم بما يلي:
أ. أن هذا النص لا يتحدد عمله، ولا يتقيد أثره بالحياة المعاصرة لنزوله، فكل قول بتاريخية النص، أو نسبية أحكامه يُعد خروجًا عن حقيقة النص القرآني، ويتضمن مغالطة أو سوء نيّة ممن يحاول فهم نصوص القرآن الكريم بهذا المنهج المعكوس.
ب. صلاحية النص القرآني لكل زمان ومكان، وهذه الصلاحية اقتضت أن يكون تركيبه من نوع خاص، يلائم هذه الصلاحية ويسندها، ويدور معها أينما كانت، وحيث وُجدت، من هنا لم يكن القرآن زمنيًا بيئيًا إلا من حيث الظواهر اللغوية، والخصائص التركيبية، باعتباره نزل بلغة عربية لها أسلوبها الخاص، وطريقة بنائها، فهو، عدا أبنيته اللغوية، نص لا يحده إنسان أو زمان أو مكان.
3. قطعية النص القرآني
فالقرآن كله قطعي الثبوت، وإن كانت بعض آياته قطعية الدلالة، والبعض الآخر دلالته ظنية، وقطعية الثبوت تلزم بما يلي:
أ. أن النص القرآني بعد وفاة الرسول، صلى الله عليه وسلم، لا سبيل إلى الإضافة إليه، أو الإنقاص منه، فقد بلغ النص بانقطاع الوحي مرحلة الكمال، كمال الدين واكتمال الكتاب على حد سواء.
ب. أن الدلالة القطعية والظنية في النص القرآني ليست مجرد تحديد لمجال عمل العقل في مواجهة النص، بل هي بالدرجة الأولى تحديد للثابت والمتغير في حياة الناس، فالثابت جاءت نصوصه تفصيلية وأغلبها قطعية، والمتغير تضمنته النصوص ذات الدلالة المرنة أو المفتوحة، والتي تقوم على المبادئ العامة والقواعد الكلية.