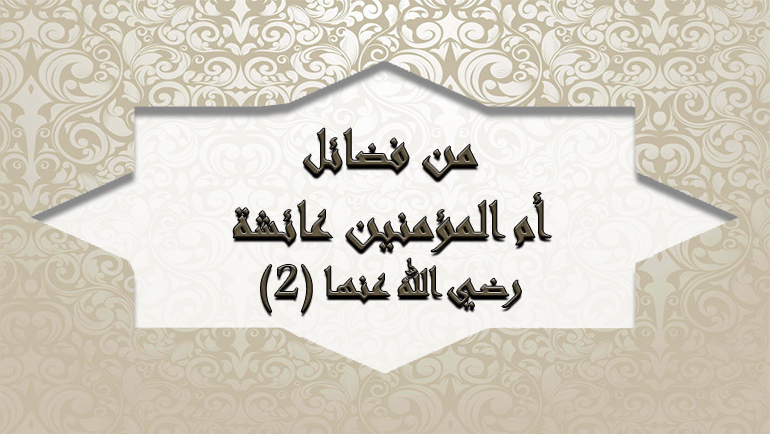تواردت عبارة حذاق الأصوليين على أنّ من شروط الاجتهاد فهم مقاصد الشريعة على كمالها، وأن يبلغ الفقيه من خلال التمرس بالنظر في النصوص الشرعية والتتبع لمقاصدها درجة تؤهله إلى معرفة أنسب الأحكام وأوفقها لروح الشريعة؛ كما قال السبكي: “أن يكون له من الممارسة والتتبع لمقاصد الشريعة ما يكسبه قوة يفهم منها مراد الشرع من ذلك، وما يناسب أن يكون حكما له في ذلك المحل وإن لم يصرح به[1].”
فالمجتهد لا يستغني، على كل حال، في مسائل الاجتهاد ومسالكه وطرائقه عن ملاحظة المقاصد ومراعاتها والاستمداد منها. وهذا الأمر أضحى اليوم من بدائه العلم وضرورياته خصوصا بعد تراكم البحوث والأنظار والتحقيقات وتأكيدها على التنويه بأهمية فقه المقاصد والحاجة إليه.
ولقد أحسن الأستاذ الدكتور أحمد الريسوني تقرير هذا المعنى إجمالا بقوله: “يلزم الفقيهَ والمجتهدَ والمستنبِطَ، أن يكون مستحضرا على الدوام أنَّ كل شيء من الشريعة له مقصوده ومرتبط بمقصوده وتابع له. فسواء تعلق الأمر بلفظ من ألفاظ الشريعة، أو نص من نصوصها، أو قاعدة من قواعدها، أو حكم من أحكامها، مستخرجٍ منها، أو مُخَـرَّجٍ على أصولها الجزئية أو الكلية، ففي كل ذلك مقاصد مطلوبة للشارع، لا يستقيم شيء من الشريعة إلا بها[2].”
وفصله الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور وبين أن تصرف المجتهدين بفقههم في الشريعة يقع على خمسة أنحاء:
النحو الأول؛ فهم أقوالها، واستفادة مدلولات تلك الأقوال، بحسب الاستعمال اللغوي، وبحسب النقل الشرعي بالقواعد اللفظية التي بها عمل الاستدلال الفقهي. وقد تكفل بمعظمه علم أصول الفقه.
النحو الثاني؛ البحث عما يعارض الأدلة التي لاحت للمجتهد، والتي استكمل إعمال نظره في استفادة مدلولاتها، ليستيقن أن تلك الأدلة سالمة مما يبطل ويقضي عليها بالإلغاء والتنقيح. فإذا استيقن أن الدليل سالم عن المعارض أعمله، وإذا ألفى له معارضاً نظر في كيفية العمل بالدليلين معاً، أو رجحان أحدهما على الآخر.
النحو الثالث؛ قياس ما لم يرد حكمه في أقوال الشارع على حكم ما ورد حكمه فيه بعد أن يعرف علل التشريعات الثابتة بطريق من طرق مسالك العلة المبينة في أصول الفقه.
النحو الرابع؛ إعطاء حكم لفعل أو حادث حدث للناس لا يعرف حكمه فيما لاح للمجتهدين من أدلة الشريعة، ولا له نظير يقاس عليه.
النحو الخامس؛ تلقي بعض أحكام الشريعة الثابتة عنده تلقي من لم يعرف علل أحكامها ولا حكمة الشريعة في تشريعها. فهو يتهم نفسه بالقصور عن إدراك حكمة الشارع منها، ويستضعف علمه في جنب سعة الشريعة، فيسمي هذا النوع بالتعبدي. فالفقيه بحاجة إلى معرفة مقاصد الشريعة في هذه الأنحاء كلها[3].
المبحث الأول: فوائد إعمال المقاصد في الاجتهاد الفقهي
لا شك أن ملاحظة مقاصد الشريعة والاعتداد بها في الفقه له فوائد جمة منها:
1. تفادي التصادم بين الفروع المستنبطة، والأصول الكلية والأهداف العامة للشريعة؛ وهو ما وقع لكثير من الأنظار والفتاوى الفقهية التي أَهمَلت أو أغفلت المعنى المقصدي في القديم والحديث، فأغلاط الفقهاء وزلاتهم “أكثر ما تكون عند الغفلة عن اعتبار مقاصد الشارع في ذلك المعنى الذي اجتهد فيه…[4].
2. منح الاستنباط قوة ورجحانا أكبر بانضمام الأدلة الكلية إلى الأدلة الجزئية.
3. تحقيق مصالح الخلق في المعاش والمعاد، ورفع الحرج عنهم في شؤونهم الخاصة والعامة.
4. تقريب شقة الخلاف بين المجتهدين، ومحاولة تحقيق ما يشبه الإجماع في جملة من القضايا الفقهية بناء على اتفاق العلماء على المعنى المقصدي الكلي الذي يُرام تحقيقه.
المبحث الثاني: مجالات إعمال المقاصد في الاجتهاد الفقهي
إن إعمال المقاصد يحتاج إلى ضوابط معينة، تنفي عنه انتحال المبطلين، وتسيّب المتعالمين. ولقد دعا بعض الكتاب إلى الاعتماد على المقاصد الشرعية طريقاً للفهم والاستنباط، دون الأحكام الجزئية، واعتبر تجديد المقاصد بجعل ضروريات العصر وحاجياته وتحسينياته جزءاً منها؛ فتضاف الحقوق الأساسية للمواطن والمجتمع المعاصر إلى الضروريات؛ كالحق في التعليم والتعبير والعمل والعلاج ونحوها، وأن يكون العمل بالنص مقتصراً على مكانه وزمانه المتقدمين.
وهذه الدعوة تجعل المقاصد مرسلة سائبة لا خطم لها ولا أزمة؛ وأن تكون متلونة بحسب إدراك الإنسان وفكره ومزاجه وعصره.
والواقع، أن المقاصد إذا لم تقيد بضوابط الشرع، ولم تستهد بنصوصه، فإنها تصير ذريعة للانسلاخ من الدين، وخرق سياجه، وهتك حرمته.
ويمكن القول بأن مجالات إعمال المقاصد في الاجتهاد تتجلى في أربعة:
المجال الأول: في تفسير النصوص والاستنباط منها
لم يكن الكلام في أي لغة مستقلا بنفسه كافيا في الدلالة على مراد المتكلم دلالة لا تحتمل شكا في مقصده من لفظه، وبذلك لم يستغن المتكلم ولا المخاطب عن أن تحف بالكلام ملامح من سياق الكلام، ومقام الخطاب، ومبينات من القرائن، لتتضافر تلك الأشياء على دفع الاحتمال وتحقيق القدر الضروري من البيان والإفهام “ومن هنا يقصر بعض العلماء ويتوحل في خضخاض من الأغلاط حين يقتصر في استنباط أحكام الشريعة على اعتصار الألفاظ، ويوجه رأيه إلى اللفظ مقتنعا به، فلا يزال يقلبه ويحلله ويأمل أن يستخرج لبه، ويهمل ما قدمناه من الاستعانة بما يحف بالكلام من حافات القرائن والاصطلاحات والسياق[5].”
فالنصوص الشرعية الواردة في المسألة قيد البحث هي المورد الأول الذي يجب أن يرِدَه المجتهد، والنظر في مدلولاتها اللغوية هو سبيل الاستنباط منها، ولكن النظر في الألفاظ لا يكفي للوقوف على دلالاتها الشرعية، بل لابد من تحديد دلالاتها الاصطلاحية والسياقية، وذلك يتوقف على الاسترشاد بالمقاصد؛ لأن دلالة الألفاظ على معانيها “تابعة لمقصد المتكلم وإرادته[6]“، ولذلك قال الغزالي: “فاعلم أن كل من طلب المعاني من الألفاظ ضاع وهلك، وكان كمن استدبر المغرب وهو يطلبه، ومن قرر المعاني أولا في عقله ثم أتبع المعانيَ الألفاظَ فقد اهتدى[7]“. وقال القرافي: “بعض المعاني والألفاظ إنما هي وسائل، والأحكام الشرعية مقاصد بالنسبة إلى الألفاظ، والمقاصد أفضل من الوسائل[8].”
ومعرفة مقصود الشارع من كلامه لا تتأتى إلا لمن كان خبيرا بمقاصده العامة والخاصة، عارفا بما يوافقها ويعارضها، “وهذا المساق يختص بمعرفته العارفون بمقاصد الشارع كما قال الشاطبي[9].”
المجال الثاني: في إجراء القياس على الأحكام المنصوصة[10]
فالقياس أساس التعليل وسباره، وهو لا يكون صحيحا واقعا في محله إلا إذا كان محققا لمقصود الشارع وحكمته، ومن ثم، فإن الوقوف على العلل المناسبة التي علق بها الشارع أحكامه وإجراء الأقيسة الصحيحة بناء عليها رهين بملاحظة المقاصد فيها ومراعاتها، قال ابن تيمية: “فإن الْعِلْمَ بِصَحِيحِ الْقِيَاسِ وَفَاسِدِهِ مِنْ أَجَلِّ الْعُلُومِ. وَإِنَّمَا يَعْرِفُ ذَلِكَ مَنْ كَانَ خَبيرًا بِأَسْرَار الشَّرْعِ وَمَقَاصِدِهِ، وَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ شَرِيعَةُ الْإِسْلَامِ مِنْ الْمَحَاسِنِ الَّتِي تَفُوقُ التَّعْدَادَ، وَمَا تَضَمَّنَتْهُ مِنْ مَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ، وَمَا فِيهَا مِنْ الْحِكْمَةِ الْبَالِغَةِ وَالنِّعْمَةِ السَّابِغَةِ وَالْعَدْلِ التَّامِّ[11].”
فمراعاة شروط القياس الصورية التي يذكرها الأصوليون محفوف بعوارض وقوادح تجعل نتيجته غير مسلمة إذا تعارضت مع مقاصد الشارع، وبهذا الضابط ينجو الفقيه من الوقوع في الأقيسة الصورية المجافية للمقاصد العامة، والتي وقع فيها طائفة من الفقهاء لعدم ملاحظتها واعتبارها، كما بين ذلك ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين عند حديثه عن تناقضات القائسين.
فما كل قياس قد وضع في مرتبته، أو استعمل في محله، أو استوفى جميع شروطه. وعرض الأقيسة على مقاصد الشريعة هو الذي يكشف عُوارها، أو يؤكد صحتها.
ولاعتبار أئمة الاجتهاد وكبار الفقهاء لمقاصد الشريعة في القياس، كانوا يعدلون عن مقتضى الأقيسة الجزئية حين تعارض المقاصد العامة، فكان الإمامان أبو حنيفة ومالك بن أنس، رحمهما الله، يريان القول بالاستحسان لتفادي غلو القياس، ولذلك عده الإمام مالك “تسعة أعشار العلم”، والاستحسان في العلم يكون أغلب من القياس كما قال أصبغ بن الفرج[12].
وهذا إنما هو سير منهم على منهج جمهور الصحابة، وفي طليعتهم عمر بن الخطاب؛ فقد ورَّث عمر الإخوة الأشقاء مع الإخوة للأم في “المُشَرَّكة”، وهي: زوج، وأم أو جدة، وأخوة لأم، وإخوة أشقاء، والقياس: أن الإخوة الأشقاء لا يرثون؛ لأنهم عصبة حجبوا بالفرض المستغرق. ولذلك لم يورثهم عبد الله بن عباس، لكن ما قضى به عمر، رضي الله عنه، هو مذهب زيد وعامة فقهاء الأمصار.
وقضى عمر بقتل الجماعة بالواحد في القصاص، وتبعه في ذلك الصحابة، وعامة فقهاء الأمصار، مع أن القياس أن تقتل النفس بالنفس، لا النفس بالأنفس.
ومعنى ذلك أن القياس يعمل به، ما دام في نطاق مقاصد الشارع، فإذا اشتط القياس وحاد عنها في مسائل، وجب العدول عنه إلى ما يحقق المصلحة الشرعية الكلية بالمفهوم الاصطلاحي؛ وهو أن تشهد لها النصوص العامة للشريعة، أو القواعد الشرعية القطعية.
ومن الأمثلة الفقهية لذلك:
1. بيع العينة، والمقصود بها هنا: أن يشتري الرجل من الرجل السلعة بثمن مؤجل، ثم يشتريها منه بثمن معجل أقل منه. فالقياس أن هذا البيع صحيح؛ لأن الذي اشترى السلعة بثمن مؤجل قد أصبح مالكا للمبيع، والمالك للمبيع يبيعه ممن شاء. ولذلك لم يتردد الشافعي في إجازته، بل أنكر على من لم يأخذ به، حيث قال لمن لم يأخذ به: “.. فكيف لم تذهب إلى قول زيد ومعه القياس..[13]“.” ولكن طائفة من الفقهاء منهم مالك لم يطردوا القياس في هذا الفرع واستحسنوا. ووجه الاستحسان أن هذه الصورة ذريعة إلى الربا المحرم بالقرآن والسنة والإجماع.
2. بيع السلاح لمن يريد أن يقتل به، وبيع العنب لمن يريد أن يعصره خمرا.. فذلك كله مكروه عند الشافعي، وليس بحرام؛ لأن صاحبه “باعه حلالا..[14].” وهذا إسراف في التمسك بالقياس، واتباع رسومه وأشكاله، دون الالتفات إلى المعاني والحِكَم المقصودة. فالشريعة لا يتصور قبولها مساعدة من يريد أن يقتل، ومساعدة من يريد أن يصنع شيئا مقطوعا بحرمته، كالخمر. والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الاِثم والعدوان﴾ (المائدة: 3)، والله أعلم.
المجال الثالث: في الاجتهاد المصلحي
ونعني به الاجتهاد القائم على المصلحة المرسلة، ومجاله المسائل التي لم يرد في حكمها نص خاص بها، وليس لها نظير تقاس عليه، سواء كانت قضايا مستجدة، أو قضايا قديمة تطورت تطورا هائلا جعلها مختلفة بصورة كبيرة عما كانت عليه في زمن الوحي، كما نجده في كثير من المعاملات المالية والأنظمة الاجتماعية. ولا ريب أن هذا الضرب من أشد الأنحاء احتياجا إلى مقاصد الشريعة، فمن خلالها نتعرف على أنواع المقاصد ومراتب المصالح وميزان الترجيح بينها، وشروط إعمال المصالح المرسلة وغير ذلك.
والمصلحة المرعية ليست هي ما تتوهم بعض العقول أنه مصلحة، وإنما هي المصلحة الشرعية التي اعتبرت الشريعة جنسها، والتي تتضمن حفظ الضروريات الخمس المقصودة للشارع: ابتداءً بالدين وانتهاءً بالمال[15]، والتي تشمل المصالح الدنيوية والأخروية، وتراعي المصالح المادية والمعنوية، وتوازن بين المصالح الخاصة والعامة، والآنية والمتوقعة.
فإذا كانت المصلحة محققة أو راجحة فإن الشرع يقتضي أنها مطلوبة. وبحسب مرتبة المصلحة يكون حكم ما يؤدي إليها، وفي ذلك قال القرافي: “المصلحة إن كانت في أدنى الرتب، كان المرَتَّبَ عليها الندبُ، وإن كانت في أعلى الرتب، كان المرتب عليها الوجوب. ثم إن المصلحة تترقى ويرتقي الندب بارتقائها، حتى يكون أعلى مراتب الندب يلي أدنى مراتب الوجوب. وكذلك نقول في المفسدة التقسيم بجملته. وترتقي الكراهة بارتقاء المفسدة، حتى يكون أعلى مراتب المكروه يلي أدنى مراتب التحريم[16].”
ومعنى هذا أن الاجتهاد المصلحي مبناه على تقدير المصالح والمفاسد، وذلك يستلزم معرفة واسعة بمقاصد الشريعة. بل في بعض الحالات لا يتوقف إلا على معرفة المقاصد، كما نبه عليه الشاطبي بقوله: “وإن تعلق؛ (أي الاجتهاد) بالمعاني من المصالح والمفاسد مجردة عن اقتضاء النصوص لها، أو مسلَّمة من صاحب الاجتهاد في النصوص، فلا يلزم في ذلك العلم بالعربية، وإنما يلزم العلم بمقاصد الشرع من الشريعة جملة وتفصيلا خاصة…[17].”
المجال الرابع: في تنزيل الأحكام على المحال
ونعني به الأحكام الاجتهادية التي يستلزمها تطبيق الحكم وتنزيله على محله، وذلك لأن صورة تطبيق الحكم الشرعي قد تضعنا أمام عناصر جديدة تحتف به لم تكن حاضرة في أصله، إما لتخلف بعض الأوصاف، أو زيادة أخرى، أو طروء موانع معينة.
ومن آكد ما يعول عليه هنا لتحصيل هذا النمط الدقيق من الفقه: تحقيق المناط، واعتبار المآل، وتصفح العلل ورتب المصالح، ومراعاة مقاصد الشرع عامة، ومقاصده الخاصة في ذلك الحكم، لتطبيق الحكم بصورة يتحقق بها المقصود من تشريعه دون أن يقترن بمفسدة أو ضرر.
ومن أمثلة ذلك هجر العصاة والمبتدعين المجاهرين، فقد تقررت مشروعيته بأدلة متعددة، ولكن تطبيق الهجر على حالات معينة يحتاج إلى استحضار مقاصد الشريعة من هذا الحكم. ولهذا قال ابن تيمية في فتوى من فتاواه: “وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين، في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله. فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة، بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفته كان مشروعا. وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك، بل يزيد الشر، والهاجر ضعيف، بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر؛ بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر. والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف؛ ولهذا كان النبي، صلى الله عليه و سلم، يتألف قوما ويهجر آخرين… وإذا عرف مقصود الشريعة سُلك في حصوله أوصل الطرق إليه[18].”
ومما يدخل في إعمال المقاصد في الاجتهاد التطبيقي، تحديدُ الوسائل التي فوض الشرع تحديدها إلى النظر الاجتهادي، لاتخاذ أنسبها لمقصود الحكم، والنظرُ في الوسائل التي جاءت في النصوص الشرعية لمعرفة ما إن كانت مطلوبة بعينها أم أنها وسائل ظرفية، ويمكن الانتقال إلى غيرها من الوسائل المستجدة، مما قد يكون أَشد إيصالا إلى المقصود وأبلغ في تحقيقه[19].
ويدخل فيه سد الذرائع والنظر في المآلات، وذلك لأننا حين التطبيق الفعلي للحكم، نجد أنه قد يحقق مقصده وقد يؤول إلى غير ما قصد به، والشريعة تتوخى المصلحة في الحال والمآل، والمجتهد، كما قال الشاطبي، “لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام، إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل، مشروعا كان لمصلحة فيه تُستجلَب أو لمفسدة تُدرأ، ولكن له مآل على خلاف ما قُصد فيه. وقد يكون غيَر مشروع، لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآل على خلاف ذلك. فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية، فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها، فيكون هذا مانعا من إطلاق القول بالمشروعية. وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم مشروعيته، ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد، فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية[20].”
هذه هي أوجه إعمال المقاصد في الاجتهاد، وبهذا يعلم شمول المقاصد لجميع مراحل الاجتهاد الفقهي بدءًا باستنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية وانتهاء بتنزيلها على محالها ومواردها.
المبحث الثالث: ضوابط إعمال المقاصد في الاجتهاد
قلنا إن إعمال المقاصد في الاجتهاد بجميع أنواعه وصوره يحتاج إلى قوانين وضوابط ضرورية تنفي عنه انتحال المبطلين؛ وتسيب المتعالمين؛ لأن المقاصد إذا لم تقيد بضوابط الشرع، ولم تَستَهدِ بنصوصه، فإنها تصير ذريعة للانسلاخ من سلطان النصوص وهتك حرمة الدين واختلال نظامه.
ولذلك تردد كثير من أهل العلم في القول باستقلال المقاصد بإنشاء الأحكام، واعتبروه من باب التشريع بمحض الرأي والتشهي، وأنه لابد أن يستند إلى دليل أصولي إجمالي يضبطه، وهذا مغزى الخلاف القديم في “هل المصالح المرسلة تعد أصلا مستقلا بنفسها، أم هي مردودة إلى الأصول الاجتهادية الأخرى المتفق عليها؟” فذهب ابن الحاجب والآمدي وصاحب مسلم الثبوت وشارحه ومعظم الحنفية إلى إنكار كونها أصلا مستقلا برأسه. ولكن من المناسب المفيد أن تقوم المقاصد بوظيفة ترجيحية؛ بأن تكون أقوى مسالك الترجيح لقول اجتهادي مرجوح استنادا إلى المعاني المصلحية الكلية، وهذا ما درج عليه فقهاء المالكية في فقه العمليات حين يراعون القول الضعيف ويختارونه من بين الأقوال إذا اقتضت الضرورة أو الحاجة ذلك.
وقد ادعى بعض الباحثين أن المقاصد وسيلة لإحداث ثورة فقهية لاستبدال فقه جديد بفقه قديم عفا عليه الزمن؛ وهذه دعوى كبيرة وعريضة، فالأماني شيء وتشييد بناء العلم على أسس ثابتة وقواعد راسخة شيء آخر.
والمأمول ألا تصير فتنة المقاصد كفتنة التأويل التي وصفها ابن رشد في كتابه “الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة” عندما مثل لمن أول شيئا فزعم أن ما أوله هو مراد الشارع حيث قال: “وذلك أن كل فرقة منهم تأولت في الشريعة تأويلا غير التأويل الذي تأولته الفرقة الأخرى، فزعمت أنه الذي قصده صاحب الشرع حتى تمزق الشرع كل ممزق، وبعُد جدا عن موضعه الأول[21].”
من أجل ذلك؛ حرص كثير من العلماء على ضبط استعمال المقاصد في الاجتهاد بجملة من الضوابط الدقيقة. ولعل المتعامل مع المقاصد يدرك أن هذا الفن عندما يتعلق بإنتاج الأحكام الشرعية ليس ترفا ذهنيا، إنما هو استنباط منضبط ومنهج مخصوص لاستفادة الأحكام واستثمارها من أدلتها. وهذا ما نراه جليا في تراثنا الفقهي وخصوصا في فقه النوازل من خلال الكثير من الأمثلة المعبرة عن هذا النهج، نذكر منها ما أورده الونشريسي في معياره عن القاضي أبي عمر بن منظور المالقي المالكي (توفي 735ﻫ) الذي أجاب في مسألة مدى جواز ما يفرضه السلطان من توظيفات مالية على الرعية إذا احتاج بيت المال لذلك. فقال: “إن الأصل أن لا يطالب المسلمون بمغارم غير واجبة بالشرع، وإنما يطالبون بالزكاة وما أوجبه القرآن والسنة، كالفيء و الركاز، وإرث من يرثه بيت المال. وهذا ما أمكن به حمل الوطن وما يحتاج له من جند ومصالح المسلمين وسد ثُلَمِ الإسلام.
فإذا عجز بيت المال عن أرزاق الجند وما يحتاج إليه من آلة حرب وعدة، فيوزع على الناس ما يحتاج إليه من ذلك، وعند ذلك يقال: يُخرج هذا الحكم، ويستنبط من قوله تعالى: ﴿قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً…﴾ (الكهف: 90).
لكن لا يجوز هذا إلا بشروط:
الأول؛ أن تتعين الحاجة، فلو كان في بيت المال ما يقوم به، لم يجز أن يُفرض عليهم شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم: “لَيْسَ عَلَى المُسْلِمين جِزْيَةٌ” وقال صلى الله عليه وسلم: “لا يَدْخُل الجَنَّة صَاحِبُ مكْس” وهذا يرجع إلى إغرام المال ظلما.
الثاني؛ أن يتصرف فيه بالعدل، ولا يجوز أن يستأثر به دون المسلمين، ولا أن ينفقه في سرف، ولا أن يعطي من لا يستحق، ولا يعطي أحداً أكثر مما يستحق.
الثالث؛ أن يصرف مَصرفه بحسب المصلحة والحاجة لا بحسب الغرض.
الرابع؛ أن يكون الغُرمُ على من كان قادراً من غير ضرر ولا إجحاف، ومن لا شيء له، أو له شيء قليل فلا يغرم شيئاً.
الخامس؛ أن يتفقد هذا في كل وقت، فربما جاء وقت لا يفتقر فيه لزيادة على ما في بيت المال فلا يوزع وكما يتعين المال في التوزيع، فكذلك إذا تعينت الضرورة للمعونة بالأبدان، ولم يكف المال، فإن الناس يُجْبَرون على التعاون على الأمر الداعي للمعونة، بشرط القدرة وتعين المصلحة والافتقار إلى ذلك[22].
وفي السياق نفسه كتب القاضي الفقيه أبو العباس أحمد الشماع الهنتاتي (833ﻫ) في مسألة ما يعاقب به الجاني ارتكب جرحا أو قطعا أو هروبا بامرأة، أو أخذ مالا بسرقة أو خيانة، أو بحرابة أو نحو ذلك من التعدي والغصب، وهي مسألة مشهورة بإفريقية بالعقوبة بالمال في هذه الجنايات، فقال في كتابه: “مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد القول بإباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام”:
“قال؛ (يعني الفقيه البرزلي التونسي): هذه المسألة ينبغي أن تجري على حكم المصالح المرسلة، وهو الوصف المناسب الذي لم يشهد له الشرع بإهدار ولا باعتبار.
أقول: هذا الكلام فاسد، وقول عن سبيل الحق حائد، وذلك من وجوه:
الأول؛ أن الكلام مفروض على ما حكاه أول كلامه فيما يعاقب به الجاني إذا ارتكب جرحا، أو قطعا، أو قتلا، أو هروبا بامرأة، أو أخذ مالا بسرقة، أو خيانة، أو بحرابة أو نحو ذلك من التعدي والغصب، هذا نصه وعين لفظه. وإذا كان هذا فرض المسائل المسؤول عنها، فأحكامها من الكتاب والسنة وإجماع الأمة قطعا على وجه من التنصيص، لا يحتمل التأويل، وليس إلى تبديله والزيادة عليه أو النقص منه من سبيل، ومن قواعده التي أشار إلى أن غيره لم يتضلع فيها، وهو وحده من تضلع فيها، أنه لا يحل الاجتهاد ولا يصح، بل لا يعقد إلا فيما لم يعلم حكمه من كتاب ولا سنة نصا، ولا من الإجماع. ثم إن المصالح المرسلة، من أغمض طرق الاجتهاد، ثم هي على القول بدلالتها، من أضعف الأدلة، ولذلك اتفقت الشافعية والحنفية وأكثر الفقهاء على امتناع التمسك بها[23]. والاجتهاد في العقوبة الرادعة لهذه الجنايات، فضلا عن بنائها على المصالح المرسلة، مع القطع بأحكامها من الكتاب والسنة، خارج عن المعقول، مخالف لإجماع أهل الفروع والأصول، سيما في مسائل الحدود، لدخول التعبد في مقدارها، والتشديد الوارد في الشريعة في حق من لم يلزم أحكامها في إيرادها وإصدارها.
والدليل على ما قلناه من كتاب الله، قوله تعالى: ﴿وما كان لمومن ولا مومنة اِذا قضى الله ورسوله أمرا اَن تكون لهم الخيرة من اَمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا﴾ (الأحزاب: 36). وقد دل على حرمة الاجتهاد فيه نص الله وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم.
وأما الذي يريد أن يجتهد ليشرع أخذ المال في الجنايات، فيفضي به الاجتهاد إلى ما علم تحريمه بالضرورة من الشرائع؛ وهو أكل المال بالباطل.
فإن قال: ما قلت بتعطيل الحد الواجب، كما فعله بنو إسرائيل؛ لأن الحدود إذا وجبت لم يكن غيرها، ولا يحل إغرام المال فيها، بل يجب على من ولاه الله إقامتها. وإنما أقول بذلك فيما لم يجب فيه الحد، لعدم ثبوت ما يجب به. أو قال: إنما نقول بالمال زيادة على الحد المشروع.
فالجواب: إنه إن أراد ذلك، وجب عليه أن يبين الموضع الذي يريد أن يشرع بالمصلحة فيه الردع، ولا يطلق في موضع التقييد، ولا يعمم في محل التخصيص.
فإن قيل: اعتمد في التقييد على المتعارف المعتاد.
قلت: هو يعلم وغيره أن المعتاد بذلك غير منضبط، بل الأمر عندنا من يباشر ذلك في ازدياد، لا يقال: اعتمد على ما عرف في الشريعة من أن تعطيل الحدود غير جائز. قلنا: واقعات الوجود الخارجي لا تتغير بتعارف من الشريعة، وهو قد أجرى على المصلحة المرسلة العقوبة بالمال المشتهرة بقوله في مفتتح كلامه: مال يعاقب به الجاني، وهي مسألة مشهورة بالعقوبة بالمال. وفي آخره قال: ينبغي أن يجري على المصالح المرسلة. فهذا ممن أنصف واتقى، إلا تصريح بالاجتهاد في الأمر الخارجي المعتاد.
قال: إباحته من المصلحة. ثم هذا ليس بالذي ينجيه، فإن الجهة التي تعلق الذم بها، الاجتهاد في موضع النص، وهذا قدر مشترك، سواء جعل أخذ المال من الجناة زائدا على الحد أو بدل، مع أن الزيادة فيها تعد لحدود الله، ﴿ومن يتعدّ حدود الله فأولئك هم الظالمون﴾ (البقرة: 227).
فإن قال: أنا لا أقول بإغرام المال إذا ثبت موجب الحد بوجه، وإنما أقول به إذا لم يثبت، وأرجع عما اقتضى ظاهر الكلام؛ لأن الرجوع إلى الحق خير من التمادي على الباطل.
قلنا: وهذا أيضا لا ينجيك، حتى ترجع عن المقالة بأسرها، فإن حرمة أكل المال بالباطل معلومة بالأدلة القاطعة من الشريعة، بل بالضرورة الدينية، لم تختلف فيها ملة من الملل، ولا قال بخلاف ذلك أحد من أهل النحل.. وما لم يثبت من هذه الجنايات على صاحبه، أخذ المال فيه أيضا أكل للمال بالباطل؛ لأن الباطل ما ليس بحق، وكل ما لم يثبت فليس بحق؛ لأن الحق عبارة عن الثابت باتفاق علماء اللسان والشريعة. فنقول: إن أخذ المال فيما لم يثبت من الجنايات أخذ له بما ليس بحق، وكل أكل للمال بما ليس بحق فهو أكل للمال بالباطل، وكل أكل للمال بالباطل فهو محرم قطعا وضرورة، وكل من أحل ما هو محرم قطعا وضرورة فقد كفر. فمن أحل أخذ مال الجاني الذي لم تثبت جنايته فقد كفر. ولذلك حكم الله على بني إسرائيل بالكفر والفسق والظلم، حيث اجتهدوا فيما يعاقبون به الجاني غير ما شرع الله لهم. وقد تبين لك ما سبق أن اجتهادهم أقرب من اجتهاد من أراد أن يشرع الزجر بالمال. وهذه جزئية ما اشتمل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: “لتتبعن سنن من قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه”. فصلى الله على هذا النبي الشريف، الذي لا تنقطع على مدى الدهر معجزاته، ولا تنقضي آياته[24].”
فهذه نماذج من الفتاوى والتحقيقات المعبرة عن إعمال المقاصد في الاجتهاد، حيث يسيجها الفقيه المفتي بسياج من الضوابط المحكمة المانعة لأي استغلال سيء بذريعة ما هو قائم في الواقع من أوضاع أو ما تقتضيه السياسات. لذلك أضحى ضرورة علمية إبراز جملة من القواعد والضوابط في استعمال المقاصد في التفقه. ولقد أجاد العلامة الفقيه المجدد الشيخ عبد الله بن بيه تتبعها وتحريرها والتمثيل لها في عدد من بحوثه ومؤلفاته، لعل أجمعها وأوعاها ما ذكره في كتابه النافع الماتع “مشاهد من المقاصد” حيث أوصلها إلى ثمانية ضوابط؛ يمكن عرضها وتلخيصها كالتالي:
الضابط الأول؛ التحقق من المقصد الأصلي الذي من أجله شرع الحكم؛ لأنه بدون التحقق من المقصد الأصلي لا يمكن أن يعلل به؛ إذ يمكن أن ينصرف إلى التعبد مباشرة؛ لأن الأصل في المصلحة تعبدي كما يقول الشاطبي بمعنى أن الشارع هو الذي حددها، وهي مسألة مختلف فيها. قال إمام الحرمين: “ما لا يعقل معناه على التثبت لا يُحكم المعنى فيه[25].”
الضابط الثاني؛ أن يكون ذلك المقصد وصفا وجوديا منضبطا؛ لأنه إذا لم يكن كذلك فلا يمكن التعليل به؛ فالغرر مثلاً يورث البغضاء، والبغضاء صفة نفسية، فهو من باب الحكمة التي قد نلجأ إليها للتعليل بها على خلاف، وذلك عند تعذر الانضباط في الوصف، قال في المراقي[26]:
ومن شروط الوصف الانضباط *** وإلا فحكـمـة بــــها يناط
الضابط الثالث؛ أن نحدد مرتبة المقصد في سلم المقاصد؛ هل هو في مرتبة الضروري أو مرتبة الحاجي أو التحسيني؛ لأن التعامل معها ليس على وتيرة واحدة ووزان واحد، وهل هو مقصد أصلي أو تبعي. والمقصود الأصلي هو المقصود بالأمر أو بالنهي ابتداء، والتبعي في الغالب قد يكون وسيلة، وقد يكون حماية للأصلي وسياجا له، كمنع البيع وقت النداء سدا لذريعة التشاغل عن الجمعة.
و قد يكون تابعا باعتبار علية المقصد الأول واهتمام الشارع به، كالتناسل بالنسبة للنكاح، مع ما يلحق به من المودة، والسكن، والإحصان، والاستعفاف، والتمتع بمال الزوجة، والاعتزاز بحسبها، والتعاون على المصالح الدنيوية والأخروية؛ فهذه مقاصد تابعة.
الضابط الرابع؛ النظر في النصوص الجزئية المؤسسة للحكم؛ لأنه من خلالها يمكن ضبط التصرف في ضوء تأكيد الشارع على الحكم أو عدمه للتعرف على المقصد ومكانته وضبط التعامل معه إلغاءً أو إثباتًا لما يعارضه من الضرورات أو الحاجات.
الضابط الخامس؛ النظر هل المقصد المعلل به منصوص أو مستنبط، ففي الحالة الأولى يرتفع الحكم بزواله، وفي الثانية لا يرتفع لكنه يمكن أن يخصص كالثمنية بالنسبة للنقدين.
الضابط السادس؛ النظر في المآل الذي يفضي إليه إعمال المقصد.
الضابط السابع؛ اعتبار الجزئي بالكلي، والكلي بالجزئي. قال الشاطبي: “فالإعراض عن الجزئي من حيث هو جزئي إعراض عن الكلي نفسه في الحقيقة وذلك تناقض، ولأن الإعراض عن الجزئي جملة يؤدي إلى الشك في الكلي من جهة أن الإعراض عنه إنما يكون عند مخالفته للكلي أو توهم المخالفة له وإذا خالف الكلي الجزئي مع أنا إنما نأخذه من الجزئي دل على أن ذلك الكلي لم يتحقق العلم به لإمكان أن يتضمن ذلك الجزئي جزءا من الكلي لم يأخذه المعتبر جزءًا منه وإذا أمكن هذا لم يكن بد من الرجوع إلى الجزئي في معرفة الكلي ودل ذلك على أن الكلي لا يعتبر بإطلاقه دون اعتبار الجزئي وهذا كله يؤكد لك أن المطلوب المحافظة على قصد الشارع لأن الكلي إنما ترجع حقيقته إلى ذلك والجزئي كذلك أيضا فلابد من اعتبارهما معا في كل مسألة[27].”
الضابط الثامن؛ ألا يكون المقصد معارضا بمقصد أولى منه بالاعتبار، تبعا لما أوردناه في الضابط الثالث[28].
الضابط التاسع؛ ألا يكون المقصد خلاف النص أو الإجماع أو القياس الكلي السالم من المعارض.
الضابط العاشر؛ أن يكون المتصدي لإعمال المقاصد من أهل الارتياض على أصول الاجتهاد ومعاني الشريعة.
وختاما، فإن إعمال المقاصد في الاجتهاد من أهم القضايا التي يجب أن تشغل بال الباحثين في الفقه الإسلامي، وذلك راجع بالأساس إلى أثر تلك المقاصد في مفردات العملية الاجتهادية برمتها، إلى درجة أنها أصبحت ميزانا يعرف به صحيح الاجتهاد من ضعيفه، وراجحه من مرجوحه.
وإعمال المقاصد طريقه بأن يجعل مبدأ أو إطارا كليا حاكما على قواعد منهج الاجتهاد ومعاييره ونتائجه، وبأن تجعل مرحلة من مراحل صياغة الفتوى والحكم، بحيث تعرض الأدلة الجزئية على مقاصد الشريعة العامة والخاصة، ولا تقبل إلا إذا انسجمت معها، وتكون هي عمدة المجتهد في المسائل المستجدة التي لا نص فيها ولا نظير لها تقاس عليه.
الهوامش
[1]. فتاوى السبكي، 1/71.
[2]. أحمد الريسوني، المقاصد الشرعية ودورها في استنباط الأحكام، بحث مقدم إلى الدورة الثامنة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، المنعقدة بماليزيا في (رجب 1328ﻫ/يوليو 2007م)، ص4.
[3]. محمد الطاهر ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص15.
[4]. الشاطبي، الموافقات، 4/101.
[5]. محمد الطاهر ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص80.
[6]. الآمدي، الإحكام، 2/340.
[7]. الغزالي، المستصفى، 1/38.
[8]. القرافي، الفروق، 4/298.
[9]. الموافقات، م، س، 3/276.
[10]. المقاصد الشرعية ودورها في استنباط الأحكام، م، س، ص20.
[11]. مجموع الفتاوى: 4/363.
[12]. ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، 6/757.
[13]. ينظر الأم 3/38 (باب في بيع العروض).
[14]. المصدر نفسه، 3/75 (باب النهي عن بيع الكراع والسلاح في الفتنة).
[15]. المستصفى، م، س، 1/438.
[16]. الفروق، م، س، 3/94.
[17]. الموافقات، م، س، 4/162.
[18]. مجموع الفتاوى، م، س، 6/351.
[19]. المقاصد الشرعية ودورها في استنباط الأحكام، م، س، ص15، وانظر أمثلة أخرى: يوسف القرضاوي، “في فقه مقاصد الشريعة”، ص174 إلى 189.
[20]. الموافقات، م، س، 4/194.
[21]. الكشف عن مناهج الأدلة، ص150.
[22]. الونشريسي، المعيار، 11/127 وما بعدها.
[23]. انظر: المستصفى، م، س، 1/284 وما بعدها، وشفاء الغليل، ص142 و266، والإحكام، م، س، 4/216،. ابن قدامة، روضة الناظر، ص87. الشاطبي، الاعتصام، 2/111-112، وشرح تنقيح الفصول، ص516. الزنجاني، تخريج الفروع على الأصول، ص170-173.
[24]. انظر أحمد الشماع، مطالع التمام ونصائح الأنام، تحقيق عبد الخالق أحمدون، ص84 وما بعدها.
[25]. نهاية المطلب، 4/291.
[26]. مراقي السعود، ص327.
[27]. الموافقات، م، س، (3/9).
[28]. الشيخ عبد الله بن بيه، مشاهد من المقاصد، الرياض: دار التجديد، ط2، 2012، ص181-182.