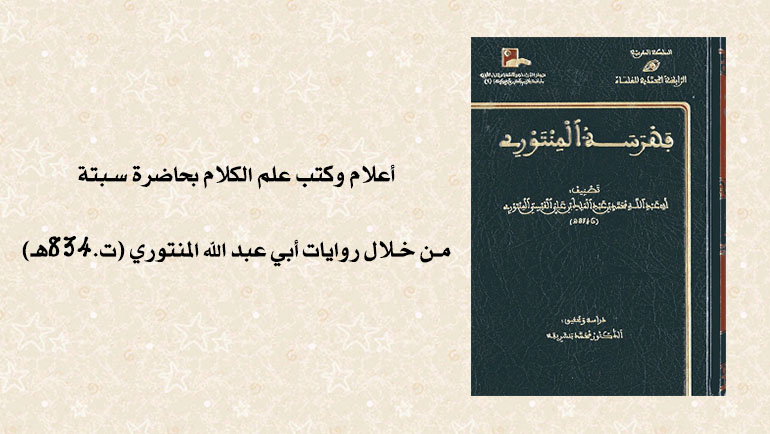ذ. العربي الغساسي
(العدد 20)
تقديم
إن الاهتمامات الصحية، أصبحت في الوقت الحاضر من الموضوعات الأساسية، سواء على المستوى الطبي، أو على المستوى العام، فقد عقد في شأنها عدة مؤتمرات وندوات في أنحاء المعمور، وصدر عنها توصيات وإعلانات كان أبرزها “إعلان المآتا” في شتنبر 1978 والذي جاء فيه على الخصوص: “إن الرعاية الصحية هي المدخل إلى بلوغ هدف الصحة للجميع، وتتضمن التثقيف الصحي بشأن المشاكل الصحية السائدة، وطرق تحديدها والوقاية منها، والسيطرة عليها، وتوفير الغذاء السليم، ورعاية الأم والطفل بما في ذلك تنظيم الأسرة، والعلاج الملائم للأمراض والإصابات الشائعة، وتوفير الأدوية اللازمة” كما تم نشرها في مختلف المجالات من دوريات وموسوعات طبية وإعلام سمعي وبصري. فكان لكل ذلك دوره الفعال في القضايا الصحية العامة للأفراد والأسر والمجتمع، في المدن والقرى، وكان الهدف من ذلك: إبراز أهمية الصحة، من حيث أنها تشمل حالة الإنسان البدنية والعقلية والروحية والاجتماعية كوحدة متماسكة لا تتجزأ.
وقد سبق الإسلام كل هذا، حين رسم للإنسان أساس السلامة في قلبه وبدنه وروحه، وقرر أن الغذاء الصالح الطاهر خير، وأمر بطلبه والمحافظة عليه، والدعاء ببقائه وتكثيره. كما قرر أن المرض شر، وأمر باجتنابه والعمل على علاجه. فمن سنن الله، عز وجل، أن البقاء في الكون للأصحاء، فهم الذين يعمرونه، ويكشفون عن خيراته وكنوزه، وإن الإسلام يرى في الإنسان خليفة الله في الأرض، وكل ما يضر أو يسيء إلى معنى الخلافة، أو يضعف من قوته محرم شرعا، ليظل محتفظا بمكانته وقوته كخليفة الله في الأرض.
وعناية الإسلام بالحفاظ على سلامة وصحة المسلم، هي عناية بقوة المسلمين، فهو يتطلب أجساما تجري في عروقها دماء العافية، ويمتلئ أصحابها فتوة ونشاطا، وللجسم أثر لا في سلامة التفكير فحسب، بل في تفاعل الإنسان مع الحياة.
وإن الاهتمامات الصحية غير طارئة على تراثنا العربي والإسلامي، وعلى فكرنا الفقهي والطبي، وإن اختلفت التسميات، فقد زخر الدين الإسلامي بفيض من القواعد والمبادئ في ميدان الصحة، وخير مثال على ذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تناولت التوجيهات الوقائية والعلاجية، كما أن الفقهاء والعلماء أفاضوا في بيان الأحكام، وربطوا التشريعات بمقاصدها، ومن أجلها رعاية النفوس والأبدان، فألفوا في ذلك كتبا مستقلة، ضمنوها فصولا في وقاية القلوب والأبدان وعلاجها، ودور الأدوية في ذلك، كما كتب أطباء معاصرون في الصحة الجسدية والعقلية في الإسلام وكشفوا عن الإعجاز العلمي في التعاليم القرآنية والنبوية[1].
وستتم ملامسة هاته الجوانب من خلال موضوع “الحجر الصحي في الإسلام” وما يندرج فيه من وقاية وعدوى وعلاج للأمراض والأوبئة، وذلك بالاعتماد على ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية، مع اتباع مخطط يشتمل على المحاور التالية:
– الطب الوقائي الإسلامي.
– الإسلام والحجر الصحي.
– التنظيمات والإجراءات الصحية عند حدوث الأوبئة.
أولا: الطب الوقائي الإسلامي
تعتبر الوقاية من أهم الفروع الطبية في العصر الحاضر، وقد أطلق عليها “الطب الوقائي” لما لم يعد العمل الطبي يعتمد على العلاج فقط، وأصبح يعتمد على الوقاية من الدرجة الأولى، فحينما نريد أن نقضي على الأمراض والعلل دون المعاناة منها، يتطلب ذلك، تفادي الوقوع فيها، عملا بالقول الشائع في علم الطب “إن المرض يسبق العلاج، وإن الوقاية تسبق المرض”، وقديما قال الأطباء العرب: “الفرق كبير بين أن يترك الإنسان ليصاب بالمرض، ثم نسعى لمعالجته، وبين أن نقيه من المرض أصلا.
والوقاية تعد جزءا من التشريعات الطبية في الإسلام، إذ أنها تقوم على قواعد أساسية من التحصن من شأنها أن تكسب الجسم مناعة ذاتية، تقيه من عوامل العدوى والأمراض الوافدة وميكروباتها وفيروساتها المختلفة.
وإن دراسة في هذا المجال لكتاب الله تعالى وسنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لتؤكد لنا: أن الوقاية من الأمراض والعلل نهج من المناهج الإسلامية، وأنها تنصب على البناء الوقائي للفرد والمجتمع تداركا للأمراض، واتقاء لشرها قبل وقوعها، فقد وفر الإسلام أسباب الوقاية بما شرع من قواعد ثم بما رسم من حياة رتيبة يلزم المسلم السير عليها. ونحن حين نريد تصنيف “الطب الوقائي الإسلامي” في مجموعات، نجدها مصنفة في ثلاث سنتحدث عنها بإيجاز مع تقديم نماذج من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وهي:
1.الوقاية الصحية بواسطة النظافة.
2. الوقاية من الأطعمة والأشربة المحرمة.
3. الوقاية من الآفات الجنسية.
1. الوقاية الصحية بواسطة النظافة
إن الدين الإسلامي هو أكثر الأديان عناية بالنظافة، وتعاليمه فيها هي من الوضوح والدقة، بحيث إن تقدم العلم لم يزد عليها شيئا، وإن كان قد أوضح تغييرات في بعض الإجراءات، والدين الإسلامي هو أول من نادى بما يسمى في العصر الحديث ب”التعقيم” أي إزالة الميكروبات والأوساخ من الأجسام، أو الأشياء التي يمكن أن تكون مكانا تحيا فيه الميكروبات، أو تساعد على تكاثرها، وسماها الإسلام ب “النظافة” وحدد المواد التي يمكن أن ينتقل بها الميكروب أو يتكاثر فيها، وسماها بـ”النجاسة”، كما حدد ظروف ووسائل تطهير الأشياء والأجسام لإزالة الميكروب منها.
هذا في الوقت الذي لم تكن الإنسانية فيه وخاصة في أوربا، تفهم قيمة النظافة وفائدتها، بل كانت القذارة التي تنتج عن التقشف والزهد في الحياة والرهبنة وغيرها تعد من الورع والإيمان، وفي هذا يقول الفيلسوف البريطاني “برنادشو” كانت القذارة تشكل جزءا لا يتجزأ من الورع المسيحي، ولم تكن كلمة “التعقيم” (الطهارة والتطهير) قد ظهرت في الوجود، أو استعملت في معناها اليوم”.
هذا وقد اشتمل منهج النظافة الذي وضعه الرسول، صلى الله عليه وسلم، على تعاليم كثيرة ندرج بعضها في الحديث عن نظافة الأبدان، والطعام والشراب، والمساكن والطرقات.
أ. نظافة الأبدان
أبدى الإسلام اهتماما بالغا بجسم الإنسان، فأمر بتعهده بالنظافة، وذلك بالغسل والوضوء، وإفراغ ما في الباطن من النجاسة. وشرع الختان وأحكاما دقيقة في الحيض والنفاس، فمن الآيات الكريمة التي تأمر بنظافة الجسم قوله تعالى: ﴿يأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا..﴾ [النساء: 43]. ففي هذه الآية النص على نهي الجنب أن يقرب الصلاة، إلا إذا اغتسل وتطهر من الجنابة.
وهذه ميزة من النظافة يمتاز بها المسلمون عن غيرهم الذين لا يغتسلون من الجنابة، وقد أثبت الطب أن في الغسل صحة للأبدان، وتنشيطا للأجسام، ثم يأتي الوضوء للصلوات الخمس لإزالة ما علق بالأعضاء من الأوساخ.
إن في الوضوء فوائد لإزالة البكتريا العالقة بالأعضاء حيث يؤدي تراكمها في الفم إلى جفافه وقلة اللعاب. لذلك كان النبي، صلى الله عليه وسلم، إذا توضأ كما جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود “يدلك أصابع رجليه بخنصره”، فكان في الوضوء الحكمة التي تهدي الإنسان إلى منفعته وحمايته، فلا يكاد يعلق بجسم الإنسان درن أو إفرازات بدنية، حتى يأتي الوضوء فيزيل هذه الأقدار والأدران، فيبيت المسلم نظيفا طاهرا.
ب. نظافة الطعام والشراب
إن التعاليم الإسلامية التي جاءت قبل أربعة عشر قرنا بالنسبة لنظافة الطعام والشراب، شملت الكثير من الحقائق العلمية والطبية الرائعة التي لم تعرف إلا في القرون المتأخرة من ذلك قوله، صلى الله عليه وسلم، “إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في القدح، ولكن ليبين الماء من فيه”، وعن ابن عباس، رضي الله عنهما، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، نهى عن الشرب من السقاء” ومن ذلك أيضا وصية الرسول، صلى الله عليه وسلم، بتغطية أواني الطعام والشراب، وعدم تركها معرضة للأتربة والميكروبات، حفظا لها من التلوث أو الفساد، وصيانة لها من الحشرات الضارة، فيقول، صلى الله عليه وسلم، “أوكؤوا قربكم وخمروا –غطوا- آنيتكم واذكروا اسم الله”[2]، فإن الجراثيم تنتقل إلى المأكولات والمشروبات بواسطة الحشرات الصغيرة التي تأتي من الأدران التي تعيش فيها وتتكاثر وهكذا تقع الجرثومة على أعضائها، فتنقلها مباشرة إلى المأكولات والمشروبات.
أما الماء فيعتبر من أكثر الأوساط القابلة لنمو الجراثيم وتكاثرها، لأنه أساسي كذلك بالنسبة لهذه الكائنات، وخاصة إذا ترك لمدة طويلة، معرضا للهواء، فالأمراض التي تنتقل إلى الإنسان بواسطة المياه، تتم عن طريق الشراب أو عن طريق استهلاك المياه الملوثة التي تم استخدامها لأغراض منزلية، أو زراعية أو صناعية بكيفية غير سليمة.
ومن الثابت أن تلوث مياه الشرب يكون بوصول مياه ملوثة إليها، أو بإلقاء قاذورات أو غسيل ثياب مريض ما، فإذا تسربت جرثومة على الماء المستعمل بطريقة من الطرق فإنها قد تؤدي إلى نقل العدوى إلى إنسان آخر، أو أناس آخرين، فيتحول الماء من سبب للحياة إلى سبب للدمار[3]، لذلك شدد النبي، صلى الله عليه وسلم، على عدم تلويث المياه وفي مصادرها[4] بالقاذورات، فعن ابن ماجة أن النبي، صلى الله عليه وسلم، نهى أن يبتال في الماء الجاري” وقال، صلى الله عليه وسلم: “لا يبلولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه”[5]، وكذلك شدد، صلى الله عليه وسلم، على تطهير ما تلوث بالكلاب، وذلك قبل قرن من اكتشاف أنها السبب في الغالب في إصابة الإنسان وحيواناته بداء الكيسة”[6] قال، صلى الله عليه وسلم: “طهروا إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه بأن يغسله سبع مرات إحداهن بالتراب”.
وبذلك تعلم المسلمون أن من وسائل الوقاية من الأمراض والعلل –الأمر- بتغطية أواني الطعام والشراب، والنهي عن كشفها ما دام فيها طعام وشراب، فكل ذلك وقاية للسليم من انتقال الكثير من الأمراض عن طريق اللعاب والشفتين، ومن الثابت علميا اليوم بأن الكثير من الأمراض المعدية والطفيليات والبلهارسيا[7] وغيرها، يمكن أن تنتقل إلى الماء، ومن تم إلى الأشخاص السليمين.
واستنادا إلى هذه الأحاديث، اشترط الفقهاء بالنسبة للماء والحليب وأنواع الشراب عدم تغير لونها وطعمها ورائحتها. وإذا تخمر الشراب أصبح في نظر الشرع نجسا لا يجوز شربه، والهدف من ذلك هو المحافظة على الصحة، والوقاية من الأمراض والعلل، لذلك جاءت الإرشادات النبوية تصب في هذا المضمار.
ج. نظافة المساكن والطرقات
وتمتد نظافة الجسم والطعام والشراب إلى نظافة المساكن والطرقات، وذلك لأن النظام الصحي في المنزل وما يحيط به، يعتبر من القضايا الجوهرية لوقاية الفرد الجسمانية، وقد نالت نظافة المساكن اهتماما خاصا من لدن الرسول، صلى الله عليه وسلم، ففي مسند البزار عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: “نظفوا أفناءكم وساحاتكم، ولا تشبهوا باليهود يجمعون الأكباد؛ (أي الزبالة) في دورهم”[8] ومعروف ما للقمامة وتراكمها في البيوت من أضرار على الصحة لكونها بؤرة لتكاثر الحشرات والميكروبات التي تعد من أغلب أسباب الأمراض.
أما الطرقات فهي حق لكل الناس، فلا يتسبب أي إنسان في الضرر أو العبث بهذا الحق، ففي حديث للنبي، صلى الله عليه وسلم، قال فيه: “اعطوا الطريق حقها”، وهو جزء من حديث رواه أحمد والبخاري ومسلم أوله… إياكم والجلوس في الطرقات”، كذلك نهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن تلويث الطريق لأنه يجلب اللعنة لصاحبه، خاصة إذا كان هذا التلوث بالغائط أو قضاء الحاجة في طريق الناس أو ظلهم، فعن أبي هريرة، رضي الله عنه، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم قال: “اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في المواد وقارعة الطريق والظل”[9]، وقد أثبت العلم الحديث أن التبرز أو إلقاء القاذورات في الطريق العام يصيب الإنسان بكثير من الأمراض مثل الكوليرا، وهو مرض وبائي ينقله الذباب من أماكن التبرز، وكذلك أمراض الحمى تخرج مع براز المريض وتنتقل إلى الأمعاء عن طريق الذباب.
2. الوقاية من الأطعمة والأشربة المحرمة
لقد أحل الله لنا الطيبات وحرم علينا الضار الخبيث الذي يوهن القوة ويضعف الصحة ويذهب العقل، قال تعالى: ﴿…ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث﴾ [الأعراف: 157]، والخبيث ما تضرر به الجسم والعقل، فلأسباب وقائية وصحية حرم الميتة والدم ولحم الخنزير والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما أهل به لغير الله.
أ. حرم الميتة
لأنها ما ماتت إلا بسبب قد يكون مرضا لازم هذا الحيوان فترة طويلة، حتى انتشرت الجراثيم وطفيليات المرض في كل أجزائه، فإذا تناول المسلم شيئا من هذه الميتة أصيب هو الآخر ببعض الأمراض، أما المنخنقة والموقودة والمتردية وما إليها فهي ملحقة بالميتة، حيث يدخل في الميتة ما مات منها ميتة طبيعية، أو بواسطة حادثة من الحوادث أو لم يذكر اسم الله عليه.
ب. حرم الدم
لأن أي سموم يمكن أن تصل إلى الجسم، تمتص من الأمعاء، وتذهب للدم الذي ينقلها إلى الكبد للتخلص منها، وتفرزها الكلي، إذن نجد الدم دائما محملا بالجراثيم، وقد يتخمر داخل الجهاز الهضمي ويصيب الجسم بأضرار بالغة الخطورة.
ج. حرم الخنزير
لأنه يعتبر من أكثر الحيوانات نقلا للجراثيم، وهو يسبب كثرة الأمراض القاتلة والمعدية، ومنها الدودة الوحيدة، والاختناق والحمى، والموت المفاجئ. والخنزير من الحيوانات التي تأكل كل شيء حتى البراز والقمامة والميتة، ومن طبائعه أن الذكر منه لا يغار على أنثاه بعكس الحيوانات الأخرى. وقد وجد أن هذا الطبع يوجد، أيضا، فيمن يأكلون لحم الخنزير أي أن آكل لحم الخنزير لا يغار على أنثاه، لكل هذه الأسباب وغيرها حرمه الله تعالى، وقد جاء تحريمه في أربع آيات منها قوله تعالى: ﴿إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به﴾ [النخل: 115].
كما نهى الله تعالى عن الأشربة المحرمة وهي الخمر وما اشتق منها، وما ينطبق عليها من حشيش وأفيون وكوكايين، وهي تتفق مع الخمر من ناحية أضرارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية، إنها ليست من أعظم الأخطار السامة فحسب، بل بعواقبها الوخيمة أيضا بما تسببه من علة الشقاء والبؤس والذل ومدخلا لعالم الخبائث والانحرافات المختلفة، وقد أثبت العلم الحديث أضرار الخمر الصحية على الكبد والكليتين بالإضافة إلى مضارها على النسل والتناسل، وإلى ما لها من تأثير على الناحية العقلية والبدنية والخلقية والمادية، وإن كل المحاولات التي قامت لمكافحة هذا الوباء باءت بالفشل، إلا التجربة الإسلامية التي نجحت نجاحا باهرا، إذ اعتبر الإسلام أن القضية قضية إنسان أولا، قضية بناء مقومات الخير فيه واجتناب عوامل الشر فيه، يقول الله تعالى: ﴿يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون﴾ [المائدة: 90]، ويقول الرسول، صلى الله عليه وسلم: “إياكم و الخمرة فإن خطيئتها تفرع الخطايا كما أن شجرتها تفرع الشجر”[10]، ففي كل ذلك تأكيد على تحريم الخمر وأنها رجس والرجس لا يطلق في القرآن إلا على ما اشتد قبحه.
3. الوقاية من الآفات الجنسية
لقد نهى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة عن إتيان بعض الأفعال وأنواع السلوك التي ينتج عنها ضرر بصحة الفرد وما يترتب عليها من سوء عاقبة وخبث الأثر، ولذا جاء تحريم بعض السلوك في منهج الإسلام من باب الوقاية من العلل والأدواء التي منها: النهي عن الزنا والفاحشة، وغشيان النساء زمن الحيض وغير ذلك.
وإن بروز كثير من الآفات المرضية في عصرنا من خلال الممارسات المشينة كالزنا، والشذوذ الجنسي، يؤكد وجود خلل في القوانين الوضعية، ذلك لأن جل المجتمعات البشرية اليوم مجتمعات موبوءة عليلة، لأنها فقدت الوقاية، فانتشرت فيها الأمراض والعلل بلا حدود، فالعافية في هذه المجتمعات استثنائية، وأهل العافية قلة، وهذا عكس ما عليه المجتمع الإسلامي، حيث العافية هي الأصل والمرض هو الشاذ.
إن وباء الإيدز يقض اليوم مضاجع العالم، لكونه يتسبب في فقدان المناعة المكتسبة ويجعل الإنسان المصاب عرضة لكل الآفات وللموت السريع المحقق، ويكفي أن نشير هنا إلى أن السبب الرئيسي لهذا المرض هو الزنى المحرم وما يسمى بالشذوذ الجنسي الذي يهدد المجتمعات بأوخم العواقب النفسية والجنسية.
لقد عالجه الإسلام بسد كل المنافذ التي تؤدي إلى الوقوع فيه، وفي الأمراض الفتاكة ووفر أسباب الوقاية بما شرع من قواعد، وذلك في عدة آيات قرآنية وأحاديث نبوية منها قوله تعالى: ﴿ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾ [الأنعام: 151]، وقوله تعالى: ﴿ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا﴾ [الإسراء: 32][11]، وقوله تعالى: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ [البقرة: 222][12]، ويقول النبي، صلى الله عليه وسلم، وإياكم والزنى فإن فيه أربع خصال: يذهب البهاء من الوجه، ويقطع الرزق، ويسخط الرحمان، والخلود في النار[13].
كل هذا مما سقناه على سبيل المثال قرآنا وسنة من التدابير والوصايا الوقائية، يبين لنا السبل التي تسمو بالإنسان جسميا ونفسيا نحو الصحة والسلامة. وما ذلك إلا لكون المنهج الإسلامي عمد إلى قطع الطريق على الأمراض والعلل قبل حدوثها، ووقاية الأفراد والمجتمع منها قبل وقوعها، كما عمل على تجنب كل الأسباب والعوامل المؤدية إلى المرض في المأكل والمشرب وغيرهما مما يورث العلل والأسقام، كل ذلك في إطار علمي أثبت الطب الوقائي الحديث فعاليته، وعظم نتائجه في الوقاية من الأمراض والعلل، وهذا ما جعل هذا المنهج منفردا على سائر المناهج ذات المعنى المرضي والوبائي.
ثانيا: الإسلام والحجر الصحي
كان خطر التقاط العدوى بسبب تنقل الناس الحاملين للوباء أمرا معروفا منذ أمد طويل، وإنه على الرغم من عدم معرفة الأطباء العرب والمسلمين لعلم الجراثيم فإن كتاباتهم عن أسباب الأمراض وانتقال العدوى تدل على باع طويل لهم في الملاحظة والتجربة والفهم الصحيح.
والعدوى انتقال المرض من جسم مريض إلى جسم سليم، وهذا الانتقال يكون بواسطة جراثيم تسمى ميكروبات، وهي كائنات حية صغيرة لا ترى بالعين المجردة، ولكل مرض معد ميكروب خاص به، ومتى انتقل إلى الجسم السليم وكان قابلا له، تكاثر فيه، وظهرت أعراض نفس ذلك المرض على ذلك الجسم، بعد مضي مدة محدودة، وبذلك تظهر الحكمة من قوله، صلى الله عليه وسلم: “…وفر من المجذوم فرارك من الأسد”[14]، فهذه إشارة صريحة في إثبات العدوى على أبلغ وجه، فقد شبه النبي، صلى الله عليه وسلم، فتك مرض المجذوم بصاحبه بفتك الأسد بفريسته، وهذا النظام أو الأمر الصحي هو ما يسمى اليوم في الطب الوقائي للحديث “الحجر الصحي”.
فالحجر الصحي ليس من مبتكرات الطب الحديث فقد سبقه الإسلام بعدة قرون في تقريره لهذا النظام، حيث لم يفت الإسلام أن يدعو إليه عند حدوث الوباء، حتى لا تنتشر الأمراض المعدية بين الناس على نطاق واسع، فله نظرة عميقة في حصر هذا المرض في أضيق حدوده وحجزه في مهده الأول حتى لا ينتشر وتكثر الإصابة، ويعتبر ذلك أعظم نظام في الطب الوقائي وأحسن وسيلة يلجأ إليها للوقاية من الأمراض الوبائية المعدية، فقد جاءت الأحاديث النبوية مؤكدة هذا الداء، ومرشدة إلى حماية الفرد والمجتمع منه، وواضعة أسس “الحجر الصحي” لأول مرة في تاريخ البشرية، متخذة لذلك عدة وسائل سنتحدث عن اثنتين منها، وهما: العزل، والمنع الصحي.
1. العزل
ويتم ذلك حين تحصل الإصابة بمرض معد، لشخص أو لعدة أشخاص داخل البلد، فمن إرشادات النبي، صلى الله عليه وسلم، عند إصابة أحد بمرض معد هو عزله عن الأصحاء وعدم اختلاطه بهم لكي لا تنتشر العدوى في غيره، ويبتلى الآخرون بمرضه، فقد أوصى المريض بداء سار، ألا يختلط بالأصحاء إذا علم أن في اختلاطه بهم احتمالا للعدوى وفي ذلك يقول الرسول، صلى الله عليه وسلم، في رواية عن أبي هريرة، رضي الله عنه: “لا توردوا الممرض على المصح”[15]، أي لا يدخل المريض على الأصحاء، فلا يجوز للمريض بمرض متنقل يخالطهم لما في ذلك من خطر في انتقال العدوى، فبما أن لكل شيء سببا يؤدي إلى حدوثه، فإن حدوث مرض ما، يشعر بأن عاملا غير مقبول، أغار على الجسم، فأدى إلى حالة غيرت جسم الإنسان وقوانين سير وظائف أعضائه، فهناك عوامل مرضية غير موجودة تؤدي إلى مرض الإنسان وقوانين سير وظائف أعضائه، فهناك عوامل مرضية غير موجودة تؤدي إلى مرض غير معد، مثل الارتجاج أو فقدان الوعي وهناك عوامل أخرى تحدثها عوامل متنقلة تدخل الجسم فتسبب له المرض، وإن الجسم ينقل ذلك إلى جسم سليم بطريقة ما، وهذه هي التي تسمى العدوى، وهي التي أمر النبي، صلى الله عليه وسلم، بالعمل على عدم انتشارها، وحث المريض بدائها على عدم الاختلاط بالأصحاء حتى لا يبتلوا بمرضه.
ولا يكتفي، صلى الله عليه وسلم، بمنع المريض من الاختلاط بالأصحاء، وإنما يأمر الأصحاء، أيضا، بعدم الاختلاط بالمريض المصاب بمرض معد، حتى يصبح غير ناقل للمرض، فيقول، صلى الله عليه وسلم: “وكلم المجذوم وبينك وبينه قدر رمح أو رمحين، إن تحديد المسافة بين الصحيح والمريض إلى أكثر من الرمح خشية العدوى هي المسافة نفسها التي تشترطها اليوم الدوائر الصحية بين أسرة المرضى في المستشفيات. فيأمر، صلى الله عليه وسلم، بعدم مقابلة المجذوم وملامسته، حتى لا يصاب الشخص السليم بهذا المرض الخطير عن طريق العدوى، والحكمة في منع الاقتراب منه هو ما تؤكده الدراسات الطبية الحديثة وهو عين ما جاء به الرسول، صلى الله عليه وسلم، إن انتقال مرض العدوى يتم بواسطة الانتقال مباشرة في حالة الاقتراب والمصافحة باليد، كما جاء في هذا الحديث، أو بوسيلة غير مباشرة كما في حديث منع البصاق الآتي. والتي تكون في حالة ملامسة مواد ملوثة بالبصاق والدم والماء المتعفن، فمن الروائع التي جاء بها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، منعه البصاق على الأرض، فعن أنس عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: “البصاق على الأرض في المسجد خطيئة، وكفارتها ردمها”[16] والحكمة العلمية وراء ردم البصاق أن الميكروبات لا تعيش طويلا في التراب الجاف، وأن الرياح لا تنقله إلى الأصحاء إذا دفن في التراب، ذلك أن انتقال عوامل المرض من جسم مريض إلى جسم سليم، يحدث بطرق متعددة تسير في ثلاث مراحل:
- خروج عامل المرض من الجسم المريض.
- تنقله إلى المجال الخارجي.
- دخوله إلى الجسم الجديد.
وبانتقال العوامل المرضية إلى المحيط الخارجي تصبح معرضة للفناء إذا هي لم تجد وسطا ملائما لبقائها وتكاثرها، حتى تنتقل إلى جسم جديد. ووقوع العوامل كالبصاق والعطاس والسعال على شيء لا يساعد على نقلها أو تغطيتها بشيء يمنعها من الانتقال كردم البصاق في التراب الجاف معناه فناؤها وانقراضها، لكن وقوعها في الهواء أو أنواع الأكل، فإنها سرعان ما تجد نفسها منقولة إلى جسم آخر ومعيل جديد وإحداث عدوى أخرى.
إنها خاصية للأمراض الأخرى المعدية يقدمها لنا الرسول، صلى الله عليه وسلم، نصيحة لم يلتفت إليها إلا قبل عقود بجهود مضنية من الباحثين، وبعد أن اتسعت معارف الإنسان بهذه الأمراض، وتم اكتشاف المجهر الإلكتروني حيث بدأ الإنسان يتعرف على الميكروبات والفيروسات وتطورها وطرق الوقاية منها.
ومع أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، كان يحرص على تطبيب نفس المرض، إلا أنه كان يضع مصلحة المجتمع المسلم في المقام الأول، بحيث إذا تعارضت مع مشاعر فرد فإن مصلحة المجتمع هي الرابحة، فمما يروى في ذلك عن عروة بن مسيك، قال: “قلت يا رسول الله” إن عندنا أرضا يقال لها أبين هي أرضنا ربتنا، وأرض ميراتنا، هي شديدة الوباء فقال، صلى الله عليه وسلم: “دعها فإن من القرف التلف”[17]، والقرف هنا مقارفة المريض أي ملامسته، والاحتكاك به، والتلف هو الهلاك، أي العدوى، وفي صحيح مسلم من حديث عمرو بن الشريد الثقفي عن أبيه قال: “جاء إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، وفد من بني ثقيف لكي يبايعوه وبينهم رجل مصاب بالجذام، فرفض رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أن يدخل المجذوم في مجلسه، أو يبايعه باليد، وأرسل إليه من يقول له: “ابلغوه أننا قد بايعناه فليرجع”، وذلك من مسيرة ميلين كما جاء في بعض الروايات.
وبالرغم من أن هناك أحاديث تنهى عن الاعتقاد في العدوى مثل حديث “لا عدوى ولا صفر ولا هامة”[18]، وقول الأعرابي لرسول الله، صلى الله عليه وسلم: “فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيجيء البعير الأجرب يدخل فيها فيجربها كلها”، قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: “فمن أعدى الأول؟”[19] فإن العلماء جمعوا بين هذه الأحاديث بأن النهي عن العدوى جاء لعدم الاعتقاد في أنها تعدي بغير أمر الله كما كان ذلك في الجاهلية، وأمرهم بالابتعاد عن المريض، ليبين لهم أن هذه الأسباب أجرى الله العادة على حصول المرض بسببها، أي بسبب الدنو من المريض ومخالطته، وقد جاء في شرح حديث “لا عدوى ولا طيرة ولا صفرة” في فتح الباري “أن المراد بنفي العدوى أن شيئا لا يعدي بطبعه، نفيا لما كانت الجاهلية تعتقد بأن الأمراض تعدي بطبعها من غير إضافة الله تعالى، فأبطل النبي اعتقادهم ذلك ليبين أن الله هو الذي يمرض ويشفي، ونهاهم عن الدنو من المجذوم ليبين لهم أن هذا من الأسباب التي جرى الله العادة بأنها تفضي إلى مسبباتها، ففي فهمه، صلى الله عليه وسلم، لإثبات الأسباب إشارة إلى أنها لا تنتقل، بل الله هو الذي إن شاء سلبها قواها فلا تؤثر شيئا، وإن شاء أبقاها فأثرت.
2.الحجر
أصل الحجر، المنع، ومنه يقال حجر القاضي على فلان إذا منعه التصرف، إما لسفه أو لصغر أو نحو ذلك، ومنه يقال للعقل “حجر” لأنه يمنع صاحبه عن تعاطي مالا يليق به من الأقوال والأفعال، وبالنسبة للمكان فالحجر: المكان المحجور أي الممنوع من الناس بسبب اختصاص به.
والحجر الصحي: هو المنع من دخول أرض الوباء أو الخروج منها، منعا لانتشار العدوى بالأمراض المعدية السريعة الانتقال مثل الطاعون والكوليرا أو الجذام وغيرها، وهو الذي وضع الإسلام أسسه فحذر من الخروج من بلد وقع فيه الوباء ومن الدخول إليه، فحتى لا تنتشر عدوى الأمراض الوبائية الخطيرة من بلد إلى آخر نهى الرسول، صلى الله عليه وسلم، أهل مكان وقع فيه مرض وبائي من الخروج، ومنع من هم خارجه من الدخول إليه فقال، صلى الله عليه وسلم: الطاعون أرسل على من كان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض أنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه”[20].
وذلك حتى لا يصاب الشخص السليم القادم إلى الأرض المصابة بمرض العدوى، فينقلون إليه المرض، وهذا الحديث يدل على تعليم المسلمين اتباع وسيلة قوية من وسائل الوقاية من الأمراض المعدية الوبائية سريعة الانتشار كالطاعون والكوليرا والجذام كما أنها طريقة من طرق حصر المرض المعدي في مكمنه.
إن ما أمر به الرسول، صلى الله عليه وسلم، في شأن مرض الطاعون من عدم الدخول أو الخروج عن أرض وقع فيها يتفق تماما مع ما هو معمول به الآن في الطب الحديث فيما يعرف ب”الكردون الصحي” حول المنطقة التي يظهر فيها المرض، فيمنع دخول أو خروج أي شخص إلا الأطباء، هؤلاء الذين يتخذون كل الإجراءات الوقائية من تعقيم وغيره، وبذلك يتم حصر المرض وعدم انتشاره إلى أماكن أخرى فيسهل مراقبة المرضى وعلاجهم.
وبذلك يكون النبي، صلى الله عليه وسلم، أول من فرض نظام الحجر الصحي “ونظمه عن طريق عزل المرضى الموبوءين ومنع المصابين ومن معهم من التنقل خارج المكان الموجود، ومنع الوافدين من دخول موطن الوباء، فمن كان داخل حزام الخطر لزمه وبقي به، وعدم الاختلاط بغيره حتى ينجلي المرض وينقطع دابر الإصابة به، ومن كان خارجه امتنع من الدخول إليه، وهناك أحاديث أخرى صحيحة، ترغب في الصبر على المكوث في أرض يقع بها الطاعون، وتحذر من الفرار منها، يقول الرسول، صلى الله عليه وسلم: “ليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان مثل أجر الشهيد”[21]. ويقول: “الفار من الطاعون كالفار من الزحف، ومن صبر فيه كان له أجر شهيد”[22]، وأخرج الإمام أحمد عن سيدتنا عائشة، رضي الله عنها، أنها قالت: “يا رسول الله فما الطاعون؟ قال: “غدة كغدة الإبل، المقيم فيها كالشهيد والفار منها كالفار من الزحف”.
ومنع المسلم من الدخول إلى أرض موبوءة حفاظا من الإصابة أمر منطقي إلا أن منع الأشخاص الأصحاء في منطقة الوباء من الخروج والفرار من المرض أمر صعب الفهم، من دون معرفة دقيقة بالطب حيث إن العقل والمنطق يشيران إلى ضرورة الفرار للخلاص من العدوى. ولكن الطب الحديث يؤكد أن الشخص السليم والموجود في منطقة الوباء يكون حاملا للميكروب دون أن تظهر عليه علامات المرض أو يكون الميكروب لديه لازال في دور الحضانة. وبذلك يمكن أن يكون سببا لنقل المرض إلى غيره من الأصحاء، فمن المعروف أن المرض حين يبدأ أو ينتهي نهاية حسنة، يلاحظ في سيره العادي ثلاث مراحل أساسية هي: الحضانة، المرض، النقاهة، فدور الحضانة، هو المدة الفاصلة بين دخول العامل المرضي إلى الجسم، إذ تكون العوامل المرضية في دور التكاثر، أما مرحلة ظهور الأعراض أي المرض نفسه فهي حين تنقلب العناصر المرضية على كل المقومات الداخلية للجسم، وتكون مرحلة صعبة للمريض والمحيطين به، إذ فيها يمثل المريض أكثر حالة لنشر العدوى. فهي تخرج من جسمه من عدة طرق. وهذا الذي حذر منه الرسول، صلى الله عليه وسلم، إذ من المحتمل أن يكون المتنقلون من أهل البلد المصابة بالوباء في دور الحضانة حاملين للمكروبات، دون أن تظهر عليهم علامات المرض. ويأتي الدور الثالث وهو دور النقاهة الذي يعد استكمالا، لملكات الشخص الصحية، ولذا جاء منع الرسول، صلى الله عليه وسلم، أهل البلد المصاب بالوباء، من أن ينتقلوا منها، تشريعا رائعا، ومعجزة ظهرت حقيقتها اليوم بعد مضي أربعة عشر قرنا من الزمان.
ولما جاء المنع شديدا، والوعيد مرعبا في قوله، صلى الله عليه وسلم: “والفار من الطاعون كالفار من الزحف” جاء الوعد مرغبا، وحاثا على الإقامة والصبر في قوله، صلى الله عليه وسلم: “المقيم فيه كالشهيد والصابر فيه كالصابر في الزحف والمطعون شهيد”.
هذه بعض التعاليم والتوجيهات التي جاء بها الإسلام في مجال الصحة والعلاج والتي اختلفت فيها عن ما جاء في الديانات والتعاليم الأخرى، والتي سبق فيها الكثير من الآراء والنظريات الطبية الحديثة، فما هي التنظيمات الصحية المطبقة؟ وكيف تتم الرقابة الصحية في الأسواق والمرافق والطرقات؟ وما هي التدابير المتخذة عند حدوث الأوبئة؟ هذا ما سنتناوله بإيجاز فيما يأتي:
ثالثا: التنظيمات الصحية والتدابير المتخذة عند حدوث الأوبئة
لقد انبثقت القواعد المنظمة للسلوك الإسلامي إزاء الإصابات بالأوبئة عن الأحاديث النبوية الشريفة، وعلى ما كان ينظر فيه أولو الأمر من الأمراء والفقهاء ومجالس الصحة.
وكانت الإجراءات منذ العهود الإسلامية الأولى تتخذ حال انتشار الأوبئة، فكان ذلك دافعا قويا للحفاظ على أن يكون الفرد في صحة وعافية، والمدينة سليمة من التلوث والأقذار، وتلك علامات الصحة والصيانة والحصانة: إنسان صحيح، ومسكن نظيف، وشراب نظيف، في مدن مرتبة ونظيفة، فقد أنشئ لذلك نظام الحسبة حيث تكفل هذا النظام بالإشراف على المؤسسات والمرافق التي تقدم خدمات صحية، وقد اقتضى هذا النظام تعيين عريف (موظف مسؤول) لكل صنعة، يكون ذلك العريف ثقة يتحلى بالأمانة والدقة والخبرة في صنعته، بصيرا في معرفة الغش والتدليس، ووسيطا بينهم وبين المحتسب، يطالعهم بأخبارهم، ويحثهم على العمل[23] الجيد، ويعترض عليهم في إساءتهم للعمل، ويعنينا في باب التنظيمات الصحية جانبان: الرقابة الصحية، والتدابير المتخذة عند حدوث الأوبئة.
الجانب الأول: الرقابة الصحية
لقد سعت الدولة الإسلامية إلى حماية المرء من الأوساخ والقاذورات من خلال التنظيف من قبل العاملين بها ويمكن إيجاز ذلك فيما يلي:
أ. الأسواق والطرقات
ألزمت الدولة أهل الأسواق بالحفاظ على نظافتها وكنسها من الأوساخ والطين الذي قد يجتمع بها، وحرصا على نظافة الطرق حذرت من خروج المياه الوسخة[24]. ومن وجوه اهتمام الدولة بالمدينة منع رمي الأزبال بالطرق، فضلا عن عدم ترك مياه المطر والأوحال فيها من غير مسح، يقول الخبراء في الميدان الصحي: “إن نظام التخلص من القاذورات في مجتمع ما، هو مؤشر مباشر على مستوى مدينة ذلك المجتمع، ومقياس تقدمه وانحطاطه”، وقد جاء في كتاب “الطب والأطباء بالمغرب”[25]: إن في عام 1760م كانت توجد في كافة مدن المغرب لجنة صحية تتركب من أعيان يهتمون بكل ما يتصل بالصحة العمومية وطهارة المدينة وتمويل الأسواق وجلب المياه، وكان المخزن يقوم بتطهير بعض الأزقة والشوارع خلال الليل.
هذا حين كان بعض الإسبان يقترحون كنس الطرق بمدريد من الأزبال التي تغمرها وتدنس المدينة، فتحتج الهيآت الطبية بقوة مؤكدة أن أجدادها كانوا رجالا حكماء يعرفون ما يفعلون وأنهم عاشوا في الأزبال فلماذا لا نعيش نحن فيها على أن نقل الأزبال تجربة يستحيل تكهن عواقبها[26].
ب. مجال الأطعمة
ومما كان يدخل في تنظيمات الرقابة الصحية، اشتراط الدولة النظافة على أصحاب المطاعم، ومعدي الطعام، حرصا على سلامة الفرد الصحية، فمن ذلك أوجبت على الخباز مثلا ألا يعجن بقدميه ولا بركبتيه ولا بمرفقيه خشية وقوع شيء من عرق بدنه بالعجين، فلا يجوز أن يعجن إلا وعليه لباس خاص، وأن يكون ملثما، وعلى جبينه عصابة، وأن يزيل شعر ذراعيه، إذ ربما يسقط شيء منه في العجين[27] منعتهم من استقاء الماء من مواضع الأزبال وألزموا أصحاب محال الأكل بتنظيف آلاتهم يوميا، كما ألزموا بتغطية أواني الطبخ حفظا لها من الذباب وهوام الأرض[28]، عن نظافة الدكاكين، إذ غالبا ما يتفقد المحتسب دكاكينهم غفلة لملاحظة المخالفات الصحية. ومن الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الدولة، أيضا، في ميدان الرقابة الصحية، حرصا على صحة المواطنين منع السقائين من سقاية المجذوم والأبراص ومرضى العاهات والأمراض الجلدية.
ج. الحيوانات والحشرات كسبب من أسباب الأمراض
وذلك لأن الجراثيم تنتقل إلى المأكولات والمشروبات بواسطة الطفيليات وهوام الأرض، لأنها تأتي من الأدران التي تعيش فيها وتتكاثر، فتقع الجرثومة على أعضائها، فتنقلها إلى المأكولات والمشروبات ثم إلى الأشخاص الأصحاء، لذلك فإن المسؤولين على الأسواق والدكاكين، أمروا البائعين والسقائين بتغطية الأقداح والأواني وغيرها حفظا لها من هوام الأرض من طفيليات وديدان وحشرات.
ولكون مرض داء الكلب من الأمراض المعدية التي تنتقل للإنسان عن طريق الكلاب، فإن ذلك جعل المسؤولين ينتهون إلى حظر الكلاب السائبة على البيئة والإنسان، فمما يروى أن الإمام ابن سحنون قاضي القيروان المتوفى سنة 1240ﮪ أمر الشرطة بقتل الكلاب التي تتجول بطرقات المدينة.
وقد جاء ذكر مرض داء الكلب لدى أغلب الأطباء العرب، ووصفوه قبل “باستور” الذي أعلن أنه أول من اكتشفه ووصف اللقاح للتحصين منه.
ومما يؤثر عن الطيب ابن التلميذ أنه ذكر ضرر الذباب على الجرح قبل اكتشاف المتأخرين له حيث قال:
لا تحقرن عدوا لأن جانبه ولو يكون قليل البطش والجلد
فالذبابة في الجرح المديد تنال ما قصرت عنه يد الأسد[29]
وما ذاك إلا لأن الذباب من مضاره أن الجراثيم التي يأتي بها من الأوساخ، تنتقل بواسطته إلى أعضاء الإنسان بواسطة لعابه.
وقد أسهب الأطباء العرب والمسلمون في ذكر تأثير الحيوانات الضارة وكذا الهوام والحشرات وكيفية التخلص منها، فعمل المسؤولون وأولو الأمر على تطبيقها وإصدار الأوامر بتنفيذها، وكل ذلك لتأمين صحة خالصة وخالية من الأمراض.
الجانب الثاني: التدابير المتخذة عند حدوث الأوبئة
كانت المجاعات والأوبئة فاعلا في كثير من التحولات السياسية والديمغرافية التي عرفتها كثير من الدول حتى الأمس القريب، وما ذاك لأن هاتين الظاهرتين كانتا من الكثرة والقوة لدرجة هيمنتهما على ما عداهما من جوانب الحياة.
وكان الطاعون والكوليرا من بين الأوبئة التي عم انتشارها في كثير من الأقطار، وكانت منطقة الشرق الإسلامي من بين المناطق الرئيسية المصدرة لهما في حوض البحر الأبيض المتوسط. وفي آخر القرن الثامن الهجري تبدلت، كما يقول الناصري، أحوال المغرب به وأحوال المشرق، ونسخ الكثير من عوائد الناس ومألوفاتهم وأزيائهم وذلك، حسب ابن خلدون، نظرا لما “نزل بالعمران شرقا وغربا في منتصف المائة الثامنة من الطاعون الجارف الذي طوى كثيرا من محاسن العمران ومحاها، وانتقص عمران الأرض بانتقاص البشر، فخلت الديار والمنازل، وضعفت الدول والقبائل[30]، وفي عام 1799م، نقل الحجاج الطاعون من الحجاز إلى المغرب، ثم بدأت أخطاره تتفاقم عن طريقهم بعد أن صاروا يستعملون الطريق البحري، فقد تفشى هذا الوباء في الجزائر 1232ﮪ، ثم جاء دور المغرب في عام 1818م، حيث اجتاحه مباشرة بعد عودة الحجاج عبر الطريق البحري، وقد تحدثت المصادر عن هذا الطاعون وحملت الحجاج مسؤولية تفشيه. جاء في كتاب “الروضة السليمانية”[31]: “وفي سنة 1233ﮪ بلغنا أن ولدي أمير المؤمنين مولاي علي ومولاي عمر قدما من الحج ووجه لهما والدهما مركبا من مراكب الإنجليز للإسكندرية حملهما وأصحابهما الحجاج والتجار منها، ولما نزلوا بطنجة كان ذلك سبب دخول الوباء للمغرب”.
أما الكوليرا فما يهمنا من أمر المغرب أنها ظهرت لأول مرة عام 1834م ثم جرفته عام 1859م آتية من إسبانيا وفي أبريل 1865م تفشت في الحجاز، ومع تهاون السلطة الصحية في مصر أفضى ذلك إلى فتح أبواب البحر الأبيض المتوسط أمام الكوليرا، ليكتسح العالم هذا الوباء، ونتيجة لما عاش عليه العالم من محنة قاسية، ولما أصبحت الدول الأوروبية تنظر إلى الحاج كحامل للوباء اقتضى الأمر باستخدام الحجاج المغاربة محاجر أوروبية، وبعدها تم إحداث حجر صحي بالمغرب كما سيأتي بيانه.
وإلى جانب الطاعون والكوليرا كانت تصيب المغرب كثير من الأوبئة الأخرى مثل الجذام والصرع والسعال والأمراض التناسلية. ففي عام 987ﮪ أصاب الناس في بعض فصولها سعال كبير قل من سلم منه، وكان الرجل لا يزال يسعل إلى أن تفيض نفسه، فسمى العامة تلك السنة سنة كحيكحة”[32]، وقد أشار الحسن الوزاني إلى الأمراض التي كانت منتشرة في عصره (القرن العاشر الهجري) بالمغرب، فذكر الصرع أو داء النقطة، وذكر أن عشر السكان مصابون بالداء الإسباني أو الداء الفرنسي الذي نقله المهاجرون اليهود من الأندلس إلى المغرب بعد سنة 1492م وهو المعروف بمرض الدنيا أو مرض النساء (النوادر) كما يوجد الجذام الوراثي في أحضان المداشر”[33].
التدابير المتخذة في الداخل
كانت توجد في كافة مدن المغرب لجنة صحية تتركب من أعيان، يهتمون بكل ما يتصل بالصحة العمومية، كما كان المخزن يقوم بتطهير الأزقة والشوارع خلال الليل، ويقيم الحارات للمجذومين والبيمارستانات للمصابين بالأمراض العقلية والمعتوهين والمحاجر الصحية أيام خطر انتشار الأوبئة.
أ. حارات المجذومين
كانت تقام في أرياض كثيرة من المدن المغربية حارات للمجذومين نذكر منها حارة باب الخوخة بفاس التي نقلت إلى الكهوف بعيدا عن المدينة عندما جددت الأسوار[34]، ويشير كثير من الأوروبيين في رحلاتهم إلى حارات مراكش وأشهر حارة قرب باب دكالة وهي عبارة عن دور من الطوب أو أخصاص محاطة بجدران ولم تكن الحارة تحتوي على أكثر من مائتين إلى ثلاثمائة شخص، فقد زار الدكتور “ليريدو” مؤلف “المغرب والمغاربة” هذه القرية عام 1875م، فلاحظ فيها وجود مسجد وأهلها يتاجرون وفيهم من سكن القرية ثلاثين سنة ومنهم من يرجع أصلها لسوس أو حاحا، أو الصحراء، ولم يكن يسمح لغير المجذومين بالدخول إلى المدينة، وكان على المجذومين لبس زي خاص، ويجعلون تارازا على الرأس وهي عبارة عن قبعة من التبن ذات جوانب عريضة، بل كانوا مرغمين في بعض النواحي على إيذان الناس بوجودهم بواسطة جرس[35]، كما لاحظ “أدمون دولي” في كتابه “مراكش” أن حارة المجذومين كانت عبارة عن عشر خيام يحدق بها جدار من الطوب ولا تحتوي على أكثر من أربعين شخصا، فكلما لوحظ شخص مصاب بالجذام أو بمرض من هذا النوع في إحدى القبائل يلزم بالانتقال إلى الحارة، فإذا امتنع أجبره القائد[36].
وقد لاحظ أبو علي اليوسي “أن مدينة بوادي العبيد المعروفة بالصومعة في تادلا كثيرة الأمراض بالأوبئة والوخم”[37]، ولوحظ أيضا وجود للمجذومين على بعد ساعة من الجديدة.
وبذلك يكون المغرب اهتم بهذا المرض وعمل على ضبط حالاته وأماكن تواجده ووفر حارات خاصة له، كان المرضى يتمتعون فيها بحقوقهم ويحظون بالعناية اللازمة، عملا بالإشارات الحاسمة التي سبق الإسلام إليها، ومن بينها تلك التي أوردها ابن القيم في الطب النبوي من حديث للنبي، صلى الله عليه وسلم: “لا تديموا النظر إلى المجذومين”، وتلك التي قال فيها، صلى الله عليه وسلم، في الحديث الذي رواه البخاري والذي سبق ذكره: “وفر من المجذوم فرارك من الأسد”، ويحدث في العصر الحاضر أن تخصص منظمة الصحة العالمية يوم 27 يناير من كل سنة يوما عالميا لمكافحة داء الجذام.
ب. تشييد البمارستانات
أقيمت حارات للمجذومين، تم تشييد كثير من البمارستانات[38] في المدن المغربية للمختلين العقليين والمعتوهين، فقد ذكر “لكسيوني”[39] في مقال أفرده “للمارستانات في المغرب”، أعاد فيه التذكير بالماضي المجيد للموحدين (القرن الثاني عشر)، الذين مكنوا المرضى من الانتفاع من حسنات الحضارة الأندلسية، فقد استقدموا مشاهير الأطباء من بلاد الأندلس أمثال ابن زهر وابن رشد وابن طفيل، وجاء المرينيون فواصلوا في بداية حكمهم في القرن الرابع عشر العمل الذي سنته الدولة الموحدية، كما ذكر بأن المارستانات كانت في مبتدئها تستقبل جميع المرضى من دون تمييز بين الإصابات، وكثيرا ما كان يقدم تدريس طبي أو جراحي، ثم أصبحت تستعمل فيما بعد، أكثر ما تستعمل مصحات عقلية للمختلين العقليين والمعتوهين[40].
ج. إقامة المحاجر الصحية
عند ظهور الأوبئة الأخرى كالطاعون والكوليرا، فإن المغرب كان يتخذ الإجراءات داخليا وخارجيا للقضاء عليها بالمحاجر الصحية، والحصار الضيق الذي كان يضرب أيام الخطر، ففي عام 1089ﮪ عندما ظهر الطاعون بمكناس وبالقصر وقف الحراس من العبيد على مشرع سبو وغيره لا يتركون من يرد على فاس ومكناسة، وقد ظهرت بفاس، فأمر السلطان بتحريق ما بسوق الخميس[41]. وكان محظورا حتى في الأوقات العادية نقل الأفراد الذين يموتون خارج المدن إلى داخلها. ونصح المنصور السعدي ولده في رسالة وجهها إليه باستعمال الدواء إبان الطاعون الذي طرأ في عهده في وصفات تدل على براعة المنصور في الطب. ومن جملة ما أوصاه به عدم فتح الرسائل إلا بعد غمسها في الخل القوي ثم تنشيفها. وهذا يدل كما يقول “رينو” على أن المغرب كان يعرف، إذ ذاك، أن عزل المرضى أصبح وسيلة لدرء المرض[42].
التدابير المتخذة في الخارج
هذا بالنسبة للداخل أما في الخارج فإن ما تعرض له المغرب من غزو للطاعون في عام 1818م، فإن المجلس الطبي الدولي المتكون من الهيأة القنصلية المقيمة في طنجة، اتخذ إجراءات ضد السفن العائدة بالحجاج، وذلك بمنعهم من دخول المغرب إلا بعد قضاء حجر صحي في إحدى المحطات الصحية بأوربا، وذلك لعدم توفر المغرب[43] على معزل صحي، فتم طرد كل سفينة واردة من الأقطار المنكوبة مثل إيطاليا ومرسيليا وتونس والجزائر، إلا أن هاته التدابير على الرغم من أنها عملت على تحقيق انقطاع وباء الطاعون بالمغرب فإن الظروف الصعبة التي كان الحجاج المغاربة يلاقونها في تلك المحاجر من قسوة المعاملة وكثرة المصاريف التي كانوا يدفعونها جعلت المسؤولين في المغرب يستعجلون استحداث محاجر صحية بالمغرب.
وقد كانت المحاولات الأولى بدأت سنة 1799م لما وقع الاختيار على البرجين الكبيرين في مرسى طنجة، ليكونا مركزين للمراقبة وعزل الركاب الموبوءين، فباءت هاته المحاولات بالفشل إلى أن كانت سنة 1865 التي تفشت فيها الكوليرا في الحجاز بشكل فظيع وتحولت إلى كارثة عالمية، فدشنت هذه المحنة مرحلة حاسمة في تاريخ المغرب الصحي جعلته يعجل بإحداث “حجر صحي” بجزيرة الصويرة، وذلك لأن تطبيق طرد السفن الموبوءة في تلك السنة كان سيعرض المئات من الحجاج المغاربة للهلاك فوق ظهر السفن المقلة لهم، لأن أي ميناء أوروبي لم يكن على استعداد ليستقبل الأفواج المنكوبة الكثيرة العدد. فتدخلت السلطة المحلية لإقناع المجلس الصحي بالعدول عن قراره القاضي بطرد سفينة كان على متنها العديد من المصابين بالكوليرا فتم التوصل إلى اتفاق يقضي بتوجيه السفينة إلى جزيرة الصويرة لقضاء حجرها الصحي فيها.
وبعد انقضاء مدة الحجر وإجراء الفحص العام، الذي لم تسجل بموجبه أية علامة للكوليرا بين الحجاج، كشف هذا الحجر عن الدور الذي يمكن أن تقوم به جزيرة الصويرة في تدعيم الدفاع الصحي البحري في المغرب. وكان ذلك في سنة 1866 التي وافق فيها سيدي محمد بن عبد الرحمان على جعل مدينة الصويرة محجرا صحيا للموبوءين.
إن الأمراض والعلل والأوبئة هي سنة من سنن الله في الكون، تصيب الإنسان كما تصيب غيره من المخلوقات. وما كانت سنة الله هذه لعنة ولا عقوبة، وإنما هي ابتلاء تكفير ووسيلة للأجر، إذا حقق المريض الالتزام الصحيح بالعلاج والصبر من أجل إعانته على تحقيق ذلك.
وقد حدد الإسلام الموقف من الأمراض المعدية وغيرها، وبين نظام الحجر الصحي ليسهل على المسلمين في عصورهم المختلفة أن يتلقوا الوصايا الصحية للوقاية من الأمراض بقبول حسن.
وإن التعاليم التي جاءت في أحاديث الرسول، صلى الله عليه وسلم، حول الحجر الصحي لا تختلف عن أحدث التعاليم العلمية في وقتنا الحاضر، ولقد تنبهت الدول إلى هذا القانون الوقائي، فأنشأت المعازل، وألزمت القادمين على المدينة بالإقامة فيها. وإن المتتبع لقواعد دوائر الصحة في أي بلد في حال انتشار وباء معد كالكوليرا والطاعون والجذري وغيرها، يجد أنه يضرب حول ذلك البلد نطاق عازل، ويمنع الناس من الدخول إليه مهما كانت الأسباب عدا رجال الصحة، وفي ذات الوقت يمنع خروج أي شخص أو غذاء، حتى يتم التأكد من سلامتهم، ولما أثبت التلقيح فعاليته استعيض بشهادته عن الحجر.
المصادر
- كتاب نهاية الرتبة في طلب الحسبة، لابن بسام.
- عيون الأنباء في طبقات الأطباء، لابن أبي أصبيعة.
- جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام بمدينة فاس، لابن القاضي.
- محاضرات اليوسي، الطب والأطباء لعبد العزيز بنعبد الله.
- حضارة العرب، لغوستاف لوبون.
- الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، لأحمد الناصري.
- معالم الفكر العربي في العصر الوسيط، لكمال اليازجي.
الهوامش
- فاقت السنة النبوية ثلاثمائة حديث في العلاجات، كان منها ما اشتمل على مفاهيم طبية خالصة انتقى منها بعض المستشرقين وعلماء الطب الحديث ما ينيف عن الثلاثين، كانت مفاهيمها أساسية للعلاجات الطبية، سيتم التطرق إلى بعضها، والاستشهاد بها في ثنايا هذا المقال.
- رواه البخاري.
- فبهذه القاذورات تنتشر الأمراض وتتولد الجراثيم.
- مصادر المياه كالترع والأنهار والآبار.
- رواه مسلم.
- داء الكيسة: يصيب بذلك الإنسان عن طريق الصدفة، وانتقال عدواه تكون بواسطة الأيدي الوسخة، فالإنسان يلمس شعر الكلب أو يلمس الكلب شعر الإنسان.
- داء البهارسيا: هو من الطفيليات التي تتطفل على الإنسان، وقد تم اكتشافه في بداية القرن الماضي، إلا أن الأطباء العرب أدركوا في العصور الوسطى أنه كان هنا؛ “تبول الدم” لدى أصحاب القافلات الوافدين من إفريقيا السوداء، بقصد المبادلات التجارية، وانتشاره بين الناس يحدث باستعمال المياه الملوثة، وكذلك بالبول، حيث أن بول المصابين يحتوي على الميكروبات التي تقفز للإنسان في الأعضاء الجلدية.
- رواه الترمذي.
- رواه الترمذي.
- رواه ابن ماجة.
- والحكمة من هذا المنع، الوقاية من الأمراض الجنسية البالغة الضرر التي اكتشفها العالم الحديث مثل مرض السيلان والزهري والسل، فضلا عن مشكلة اللقطاء.
- وهذا المنع من أجل رفع الضرر بالصحة لكل من الزوجين وخاصة الزوجة لأن غشيان النساء زمن الحيض يزيد أعضاء التناسل اختناقا والتهابا مما يزيد ضعفا وقت الحيض.
- رواه الطبري.
- رواه البخاري.
- جواهر البخاري، شرح القسطلاني.
- يقول الإمام النووي في كتابه “رياض الصالحين” في باب النهي عن البصاق في المسجد في بيانه لهذا الحديث: “والمراد بدفنها إذا كان المسجد ترابا أو رملا ونحوه، فيواريها تحت ترابه، وأما إذا كان المسجد مبلطا أو مجصصا فدلكها عليه أو بمداسة أو بغيره فليس ذلك بدفن، بل زيادة في الخطيئة وتكثير للأقذار في المسجد”.
- رواه أبو داود.
- رواه الترمذي.
- أخرجه البخاري.
- أخرجه البخاري ومسلم.
- رواه البخاري.
- رواه الإمام أحمد.
- كتاب نهاية الرتبة في طلب الحسبة، لابن بسام، صفحة 18.
- كتاب نهاية الرتبة لابن بسام، صفحة 19.
- لعبد العزيز، بنعبد الله.
- كتاب حضارة العرب، لغوستاف لوبون، ص638.
- كتاب نهاية الرتبة، لابن بسام، ص21.
- كتاب معالم القرية في أحكام الحسبة، لابن الأخوة، ص173.
- كتاب عيون الأنباء في طبقات الأطباء، لابن أبي أصبيعة، الجزء الثاني، ص283.
- كتاب الاستقصا، الجزء الثالث، ص144.
- لأبي القاسم الزياتي.
- كتاب الاستقصا، للناصري، الجزء الثالث، ص96.
- المغرب في السنوات الأولى للقرن السادس عشر، لما سينيون.
- كتاب جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام بمدينة فاس، لأحمد بن القاضي، ص17.
- الطب والأطباء، لعبد العزيز بنعبد الله، ص77.
- المصدر نفسه، ص78.
- محاضرات اليوسي، ص126.
- كلمة مارستان اشتقت من كلمة “بيمارستان” المتألفة من كلمتين فارسيتين: “بيما” التي تعني المريض وذا العاهة، وكلمة “رستان” التي تعني مكان المؤسسة المعنية للمرضى، ويعود إنشاء أول مارستان على الأرجح إلى القرن التاسع في بغداد، وكان يرأسه الرازي، ثم أنشئت بعد ذلك مؤسسات شبيهة في القاهرة وقرطبة وفاس.
- كان رئيس إدارة الحبوس في المغرب خلال فترة الحماية.
- الطب والأطباء، م، س، ص78.
- نشر المثاني في ذكر ملوك المغرب في القرن الحادي عشر والثاني، ص77.
- كتاب الطب القديم بالمغرب.
- كتاب الطب والأطباء بالمغرب، م، س، ص81.