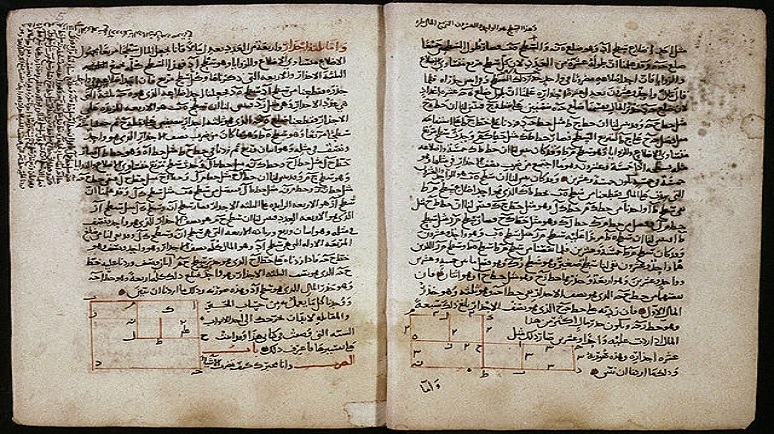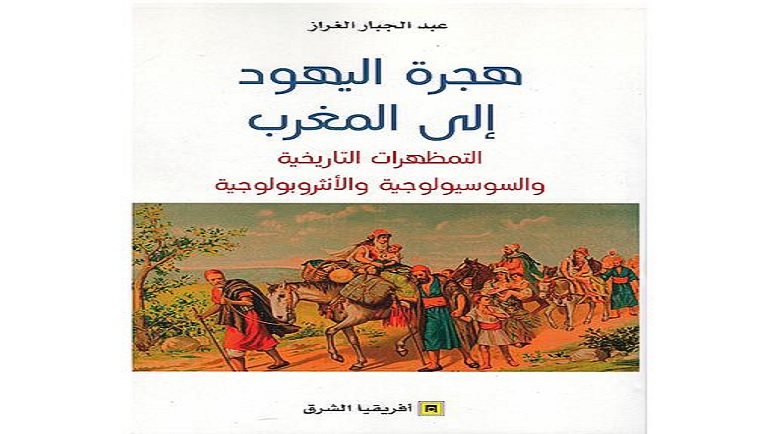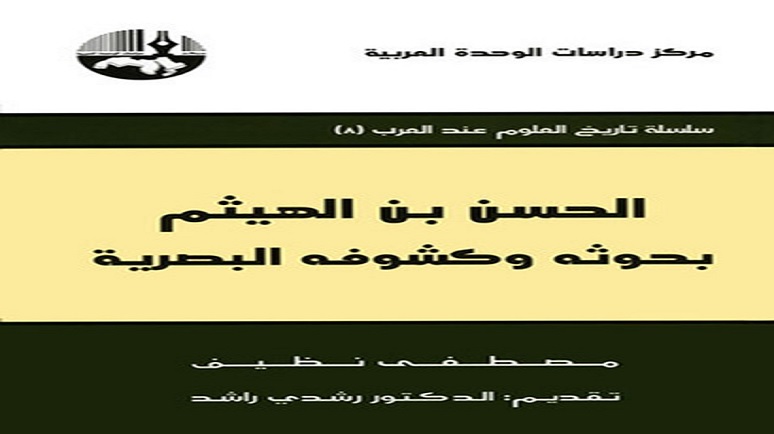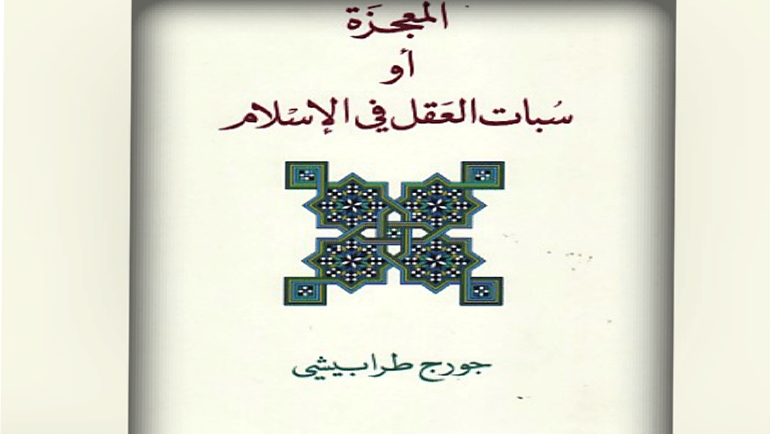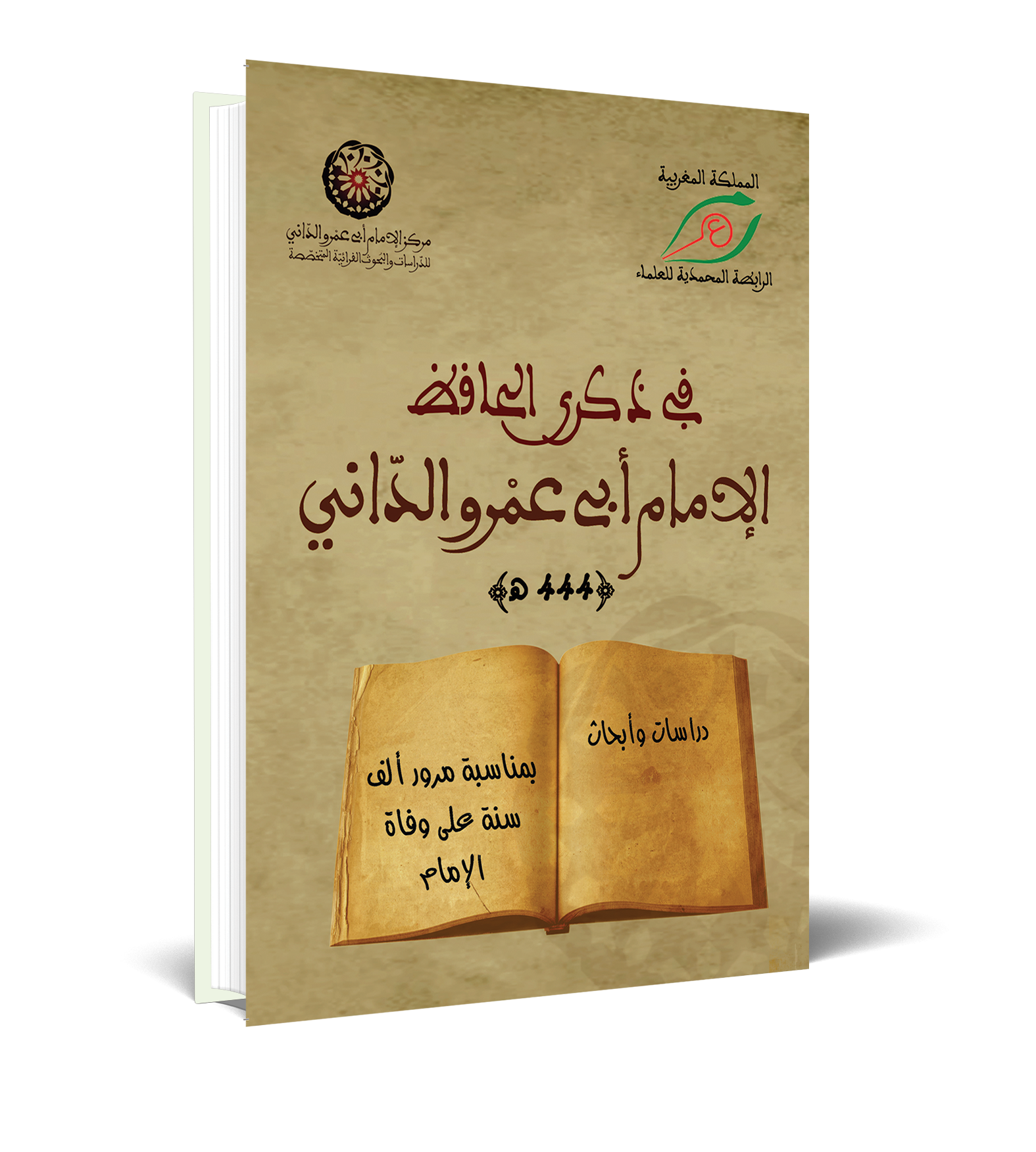قراءة في كتاب الوسيلة الأدبية إلى العلوم العربية للشيخ حسين المرصفي – الحلقة الثانية-

تحدثنا في الحلقة السابقة عن الجزء الأول من كتاب الوسيلة الأدبية إلى العلوم العربية، والذي كان بمنزلةِ مدخل للفنون الأدبية أو تمهيدٍ نظري، اهتم فيه المؤلف بالقواعد وتعريفات العلوم، واهتم بالحديث عن بعض المسائل النظرية التي تتصل بالأدب، ونامل في هذه الحلقة بيان موضوعات الجزء الثاني من الكتاب ومضامينه.
الجزء الثاني:
أبواب الكتاب ومضمونه:
انتقل المؤلف في المجلد الثاني إلى بيان «المقصد الثالث في فنون البلاغة» فقد أخذ على عاتقه مهمة الكشف عن نشأة البلاغة وتطورها فقال:«وأول من تنبه لاستخراج هذه الفنون، واتخاذها معياراً لصناعة الكلام حسب ما تقتضيه، الشاعران الشهيران: مسلم بن الوليد، وأبو تمام حبيب بن أوس الطائي، ولكن لم يدوناها، وإنما كانا يتحدثان بها ويسميانها «البديع».(1)
وفي هذا المقصد أخذ المؤلف يتابع تطور هذا العلم حتى وصل إلى عبد القاهر، وقد تنبه في تلك المقدمة التاريخية إلى جهود المتكلمين وفلاسفة الإسلام في تغيير الحساسية الجمالية، وتطوير البيان العربي والبلاغة العربية فقال:«ولما اتسعت دائرة القول في العلوم الفلسفية بين المسلمين حتى أفضى بها التكلم في تخليص العقائد الإسلامية، وإزاحة الشبه عنها إلى كشف حقيقة النبوة وبيان جهة إعجاز القرآن، رأى الناس نفع هذه الفنون في معرفة إعجاز القرآن الذي هو برهان الدين الحق فصار من العلوم الدينية، واشتغل بها طائفة من الناس وأكثروا فيها من التآلف وأولهم الشيخ عبد القاهر»(2)
وتحدث في هذا المقصد أولا عن «فن البيان» باعتباره فنًّا يبحث عن الألفاظ من حيث كونها مستعملة في معانيها التي وضعت لها أو فيما يناسبها اعتماداً على المناسبات، وفي هذا الفن تناول الكلام عن المجاز والاستعارة والكناية.(3)
كما تحدث عن«علم المعاني» باعتباره علمًا يبين الأغراض المترتبة على إيراد التركيب في صوره المختلفة، فموضوعه المركبات من حيث تختلف صورها لاختلاف الدواعي،ثم أشار إلى أن مدار البحث في هذا الفن هو إبانة صور التراكيب ودواعيها رسما للطريق الذي تسلك منه إلى اعتبار اللطائف الكلامية التي بها يسمى كل من الكلام والمتكلم به بليغا، وقبل أن يشرع المؤلف في تفصيل هذا الفن عرف الفصاحة والبلاغة وما يتعلق بذلك وما يوجب قسمة هذا الفن إلى أقسامه التي ينقسم إليها، وقد حاول المؤلف في هذا الصدد الوقوف على الجملة وأجزائها: الجملة الشرطية، الذكر، الحذف، التقديم، التعريف، التنكير، التقييد، القصر، الجمل الإنشائية، كما تحدث عن مواضع فصل الجمل وحصرها في خمسة مواضع:
الموضع الأول: «الجمل المتباينة بالخبرية والإنشائية معنى؛ نحو أكرم زيد أو زيد رجل عالم»، فالجملتان بينهما تنافر لصعوبة الجمع بينهما وخلوهما عن الفائدة بخلاف أكْرِمْهُ فهو فاضل ونحو: أكرمني زيد أكرمه الله.(4)
الموضع الثاني: الجمل التي فقدت المناسبة بينها، نحو: زيد فاضل، والكلب نجس العين في رأيٍ.(5)
الموضع الثالث:جملة سبقتها جملتان أولاهما صالحة للعطف عليها، والثانية في العطف عليها فساد فلدفع الوهم ينزل الوصل.(6)
الموضع الرابع: الجمل المتحدة مقصودًا بأن تكون الثانية مؤكدة للأولى أو بياناً لها أو بدلا منها، فالمؤكدة كقوله تعالى:« لَا رَ يْبَ فِيهِ »[البقرة-2[، وقوله تعالى: « هُدىً لِلْمُتَّقِينَ » فهما مؤكدتان لقوله تعالى:« ذَلِكَ الْكِتَابُ »، والبيان كقوله تعالى:« يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ» [البقرة-49[، والبدل كقوله تعالى:«أَمَدَّكُمْ بِما تَعْلَمُونَ، أَمَدَّكُمْ بِأَنْعامٍ وَبَنِينَ » [الشعراء [132-133 ، وهو بمنزلة بدل البعض في المفردات.(7)
الموضع الخامس: جملة يجاب بها عن سؤال ينشأ من جملة سابقة ويسمى هذا الفصل استئنافا واشتهر بالاستئناف البياني، ومنه قوله: قال لي كيف أنت قلت عليل، كأنه قيل: ما سبب ذلك؟ فأجيب: سببه سهر دائم.(8)
وهذه هي مواضع فصل الجمل التي تحدث عنها المرصفي في كتابه، وتحدث عن الإيجاز والإطناب والمساواة.
للشيخ المرصفي طريقة فريدة في عرضه لهذه الموضوعات ، لكونه جرى على الطريقة التحليلية في تناوله لهذه العلوم، فهو يشرح النص الذي يورده في موارد الاستشهاد، ثم يذكر طرفا عن قائله ثم يستطرد إلى شيء آخر، ثم يعود إلى موضوعه، ولكنه على كل حال لا يخرج عن المقصد الذي يتكلم فيه من فصل أو وصل أو ذكر أو حذف أو إيجاز أو إطناب أو مساواة.
ينتقل المؤلف بعد ذلك إلى الحديث عن «فن البديع» وقد جمع بخصوص هذا الفن ما يقارب خمسين فنا بسط فيها القول؛ بتفسير حقيقته وأسراره ودقائقه في صفحات كثيرة من الكتاب، وتتبعها المرصفي بدقة واقتدار لترسيخ فهمها واستيعابها، منها: حسن الابتداء ويقال له براعة المطلع، الجناس والتجنيس والمجانسة والتجانس، وذكر أنواعه: التام، والجناس المطلق، والجناس المذيل، والجناس المطرف، والجناس المضارع، والجناس اللاحق، والجناس اللفظي، والجناس المحرف، والجناس المصحَّف، والجناس المركَّب، والجناس الملفَّق، وجناس القلب، والجناس المعنوي، كما ذكر الاستطراد، والمقابلة، والاستخدام، والافتنان، والاستدراك، والإبهام، والمطابقة، وغيرها من أصناف البديع الكثيرة.
ثم تحدث بعد ذلك عن «فن العروض والقافية» باعتباره فن معرفة الموازين التي كانت شعراء العرب تزن بها أشعارها، وتلك الموازين بشهادة الاستقراء ستة عشر، سماها ناقلوها بحوراً لكل واحد اسم يخصه(9):
الأول: «الطويل» وأجزاؤه ثمانية: فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن***فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن.
الثاني:«المديد» وأجزاؤه ستة: فاعلاتن فاعلن فاعلاتن*** فاعلاتن فاعلن فاعلاتن.
الثالث:«البسيط» وأجزاؤه ثمانية: مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن*** مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن.
الرابع:«الكامل» وأجزاؤه ستة: متفاعلن متفاعلن متفاعلن*** متفاعلن متفاعلن متفاعلن.
الخامس:«الوافر» وأجزاؤه ستة: مفاعلتن مفاعلتن فعولن*** مفاعلتن مفاعلتن فعولن.
السادس:«الرجز» وأجزاؤه ستة: مستفعلن مستفعلن مستفعلن***مستفعلن مستفعلن مستفعلن.
السابع:«الهزج» وأجزاؤه: مفاعيلن مفاعيلن*** مفاعيلن مفاعيلن.
الثامن:«الرمل» وأجزاؤه: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن*** فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن.
التاسع:«السريع» وأجزاؤه: مستفعلن مستفعلن فاعلن***مستفعلن مستفعلن فاعلن.
العاشر:«المنسرح» وأجزاؤه: مستفعلن مفعولاتُ مستفعلن ***مستفعلن مفعولات مستفعلن.
الحادي عشر:«الخفيف» وأجزاؤه:فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن *** فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن.
الثاني عشر:«المضارع» وأجزاؤه: مفاعيلُ فاع لاتن *** مفاعيل فاع لاتن.
الثالث عشر:«المقتضب» وأجزاؤه:فاعلاتُ مفتعلن *** فاعلات مفتعلن.
الرابع عشر:«المجتث» وأجزاؤه: مستفع لن فاعلاتن ***مستفع لن فاعلاتن.
الخامس عشر:«المتقارب» وأجزاؤه: فعولن فعولن فعولن فعولن *** فعولن فعولن فعولن فعولن.
السادس عشر:«المتدارك» وأجزاؤه: فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن ***فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن.(10)
وقد تناول المؤلف أدق مباحث «علم العروض والقافية»؛ فقد انْصَبَّ حديثه في هذا الفن حول تفصيل القول في الأوزان وموسيقى الشعر العربي وبحوره، والقافية والتجديد، وبيان ذلك استدعى منه الوقوف على أشعار كبار الفحول وقصائدهم، وشرحها وبيان مرادها، لكونها تعوِّد القارئ سرعة ملاحظة زنة الأشعار؛ قال:« وهذه قصائد أثبتها في هذا الموضع تعود فيها ذهنك سرعة ملاحظة زنة الأشعار، فإن من اللازم للمتأدب أنه إذا ورد عليه الشعر لم يلبث أن يعرف وزنه ويلاحظه حال القراءة؛ ليساعده على إجاة الإنشاد، ويعصمه من فوات الخلل عليه».(11)
ينتقل حديث المؤلف بعد ذلك إلى بيان «المقصد الرابع في الكتابة» حيث عرفها بقوله:«الكتابة ويقال علم الخط القياسي في مقابلة خطين لا يقاس عليهما؛ وهما: خط المصحف العثماني الذي تحرم مخالفته أو تكره على خلاف المذاهب في ذلك، وخط العروضيين عند بيان أوزان الشعر وهي فن معرفة الكتابة على الصورة المصطلح عليها » (12) وبيان ذلك استدعى من المؤلف أن يوضحه في أربعة أبواب اتباعا لمن اختص بفضيلة ضبط هذا الفن:
الباب الأول: في الهمزة والألف ونون التوكيد والتنوين ونون إذا وهاء التأنيث.
الباب الثاني: في زيادة حروف.
الباب الثالث: في حذف بعض حروف.
الباب الرابع:في وصل بعض الكلم ببعض على خلاف الأصل الذي هو الفصل ليناسب الخط اللفظ.
وبعدما فرغ المؤلف من ذلك انتقل إلى الحديث عما سماه «كتابة الإنشاء، أو صناعة الترسل» وذكر طريقتين لمن يريد أن يتعلم الإنشاء كما وردت عند ابن الأثير؛ إحداهما: أن يحفظ القرآن ويفهم معناه وجملة من الأحاديث والآثار والأشعار مع تحصيل ما يلزم تحصيله من الفنون السابقة، ثم يجتهد في الإنشاء على نحو أساليب الكلام الذي حفظه، والطريقة الثانية: أن يزيد على ما تقدم الاطلاعَ على منشآت مَن تَقَدمه وحفظ الكثير منها واستعمال الفكر في انتقاد تراتيبها واختيار ما اختير في ابتداآتها وانتهاآتها ثم يأتي بما قدر عليه من اتباع أو اختراع، (13) وقسم هذا الباب إلى أنواع، سمى كل نوع منها جهة.
الجهة الأولى: و في هذه الجهة تناول ما يجب تحصيله على من يريد أن يكون كاتبا حسب ما كانت تقتضيه الأزمنة السالفة، وذلك بالتوسع في حفظ منتقيات اللغة فاصلا بين مشتركها ومختصها ومتباينها ومترادفها ومتكافئها ومطلقها ومقيدها، وملاحظة مجازاتها وكناياتها، وأن يجيد معرفة النحو حتى يأمن بملاحظته حين يقرأ وحين يكتب من اللحن، وأن يعرف التصريف حتى يأمن من الخطأ في مثل أبنية المصادر، وأن يحصل علوم البلاغة ليستعمل كل حال من أحوال التراكيب في موضعها، ويعرف متى تحسن الاستعارة والكناية والمجاز، وكيف يستعمل المحسنات البديعية، مستشهدا بما قاله الشيخ شهاب الدين محمود الحلبي في كتابه «حسن التوسل في صناعة الترسل» حيث يقول: «وهذه العلوم الثلاثة وإن لم يضطر إليها ذو الذهن الثاقب والطبع السليم والقريحة المطاوعة والفكرة المنقحة والبديهة المجيبة والروية المتصرفة، لكن العالم بها يتمكن من أزمة المعاني وصناعة الكلام يقول عن علم ويتصرف عن معرفة وينتقد بحجة ويتخير بدليل ويستحسن ببرهان ويصوغ الكلام بترتيب »(14)، فقد أبان المؤلف عموم الحاجة إلى معرفة هذه العلوم، ولم يقف عند استغناء الأذكياء عنها.
كما تحدث في هذه الجهة عن صناعة الشعر، وأفاض في نقل قصائد الشعراء ومناقشتها، ونقل كثيرا من الأمثال العربية وتناولها بالدرس والتحليل والمناقشة،فمن الأمثال العربية التي ذكرها:«إن من البيان لسحرًا»قاله النبي صلى الله عليه وسلم حين وفد عليه عمرو بن الأهتم والزبرقان بن بدر وقيس بن عاصم، فسأل عليه الصلاة والسلام عمرو بن الأهتم عن الزبرقان فقال عمرو: مطاع في أَدْنَيْه، شديد العارضة -أي البيان واللسن -، مانع لما وراء ظهره، فقال الزبرقان: يا رسول الله إنه ليعلم مني أكثر من هذا، ولكنه حسدني، فقال عمرو: أما والله إنه لزمر المروءة-أي قليل -، ضيق العطن، أحمق الوالد، لئيم الخال، فرأى الغضب في وجه النبي – صلى الله عليه وسلم – لمكان التناقض في كلامه فقال: والله يا رسول الله، ما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الأخرى؛ ولكني رجل رضيت فقلت أحسن ما علمت، وسخطت فقلت أقبح ما وجدت فقال عليه الصلاة والسلام:«إن من البيان لسحرًا» يعني أن بعض البيان يعمل عمل السحر، ومعنى السحر إظهار الباطل في صورة الحق، والبيان اجتماع الفصاحة والبلاغة وذكاء القلب مع اللسن؛ وإنما شبه بالسحر لحدة عمله في سامعه وسرعة قبول القلب له يضرب في استحسان المنطق وإيراد الحجة البالغة(15)، إلى غير ذلك من الأمثال العربية الكثيرة التي أوردها في كتابه وكشف عنها كشفا دقيقا.
كما سعى المؤلف في هذه الجهة إلى بيان طريقة أبي هلال العسكري في معالجة مسائل البلاغة من خلال كتابه الموسوم بــ«الصناعتين» حيث كان المرصفي ملخصا لما ورد في الكتاب ، فقد بيَّن المؤلف ما نقله أبو هلال العسكري من جهة الكلام الدال على حسن الإيجاز واختيار أهل البلاغة له، كما بيَّن أن الشعر وسائر الكلام بحسب براعة العبارات واشتمالها على الفوائد ينقسم أربعة أقسام: قسم حسن لفظه وكثرت فوائده، وقسم حسن لفظه وقلت فوائده، وقسم كثرت فوائده ولم يحسن لفظه، وقسم فقد الأمرين، وخلص إلى أن الأول لسلامته من إيذاء المستمع أفضل وأجمل وصاحبه أحق بالتقديم والإجلال ممثلا لذلك بقوله:«والمثل في ذلك أن الصوت الجميل المضطرب بموافقة النفوس يملأها التذاذا وإن كان خاليا من صناعة الغناء بقدر ما ينفرها ويوحشها الصوت القبيح مع استيفاء الصنعة فيه، ومن غلب عليه رعاية الصناعة والالتذاذ بملاحظتها وإدراك دقائقها يفضل القسم الثاني(16)»، كما بيَّن أيضا أن جودة الكلام تعتمد صحة المعنى وشرفه وتخير الألفاظ في أنفسها ومن جهة تجاورها وموافقتها للمقام وإجادة التركيب على ما شرح في علم المعاني، بحيث تكون الألفاظ سلسة خالية من التنافر وشدة الغرابة يألف بعضها بعضا.
وفي فصل آخر يعود المرصفي من جديد ليثير مسألة في صناعة الشعر ووجه تعلمه والذي قام فيه المؤلف ببيان حقيقة الشعر باعتبار ما فيه من الإعراب والبلاغة والوزن والقوالب الخاصة، وليس باعتباره الكلام الموزون المقفى، ذلك أن المرصفي تناول ما ورد عند نقاد العرب القدماء مثل قدامة بن جعفر عندما عرَّف الشعر في كتابه «نقد الشعر» بقوله: «إنه الكلام الموزون المقفى» وجاراه في هذا التعريف جميع من خلفه، على حين نرى الشيخ حسين المرصفي اتجه اتجاها آخر بقوله:«وقول العروضيين في حد الشعر إنه الكلام الموزون المقفى ليس بحد لهذا الشعر الذي نحن بصدده ولا رسم له وصناعتهم، إنما تنظر في الشعر باعتبار ما فيه من الإعراب والبلاغة والوزن والقوالب الخاصة، فلا جرم أن حدهم ذلك لا يصلح له عندنا فلا بد من تعريف يعطينا حقيقة من هذه الحيثية فنقول: إن الشعر هو الكلام البليغ المبني على الاستعارة والأوصاف المفصل بأجزاء متفقة في الوزن والروي مستقل كل جزء منها في غرضه ومقصده عما قبله وبعده، الجاري على أساليب العرب المخصوصة به، فقولنا الكلام البليغ جنس وقولنا المبني على الاستعارة والأوصاف فصل عما يخلو من هذه فإنه في الغالب ليس بشعر وقولنا: المفصل بأجزاء متفقة الوزن والروي فصل له عن الكلام المنثور الذي ليس بشعر عند الكل وقولنا: مستقل كل جزء منها في غرضه ومقصده عما قبله وبعده بيان للحقيقة لأن الشعر لا تكون أبياته إلا كذلك ولم يفصل به شيء وقوله الجاري على الأساليب المخصوصة به فصل له عما لم يجْر منه على أساليب العرب المعروفة، فإنه حينئذ لا يكون شعرا إنما هو كلام منظوم لأن الشعر له أساليب تخصه لا تكون للمنثور، وكذا أساليب المنثور لا تكون للشعر».(17)
وقد حاول المرصفي الوقوف على حقيقة الشعر ووصف مزاياه وصفاته وصفا حسنا ليدرك خاصية أساسية تميز الأدب عامة والشعر خاصة من غيره من الكتابات وهي التصوير البياني بدلا من التقرير الجاف، فرجَعَ بحقيقة الشعر إلى أصله، وتتبع كلامه واستقرَى بيانه ونظر فيه حتى انكشف له معناه وخصائصه وروابطه ووشائج كلماته.
ينتقل المؤلف بعد ذلك إلى الحديث عن كيفية عمل الشعر والمنهج الذي رسمه لمعاصريه وتلاميذه لتجويد إنتاجهم الشعري والنثري والسمو به إلى مرتبة الأدب العربي القديم، فهو يوصي شداة الشعر مثلا بأن يحفظوا أكثر ما يستطيعون من الشعر الجزل القديم، فيقول – وأصل الكلام لابن خلدون في مقدمته -:«اعلم أن لعمل الشعر وإحكام صناعته شروطا أولها الحفظ من جنسه، أي من جنس شعر العرب، حتى تنشأ في النفس ملكة ينسج على منوالها، ويتخير المحفوظ من الحر النقي الكثير الأساليب، وهذا المحفوظ المختار أقل ما يكفي فيه شعر شاعر من الفحول الإسلاميين مثل ابن أبي ربيعة وكُثَيِّر وذي الرُّمة وجرير وأبي نواس وحبيب والبحتري والرضي وأبي فراس وأكثر شعر كتاب الأغاني؛ لأنه جمع شعر أهل الطبقة الإسلامية كله، والمختار من شعر الجاهلية. ومن كان خاليا من المحفوظ فنظمه قاصر رديء، ولا يعطيه الرونق والحلاوة إلا كثرة المحفوظ، فمن قل حفظه أو عدم لم يكن له شعر، وإنما هو نظم ساقط، واجتناب الشعر أولى بمن لم يكن له محفوظ، ثم بعد الامتلاء من الحفظ، وشحذ القريحة للنسج على المنوال يقبل على النظم بالإكثار منه تستحكم ملكته وترسخ وربما يقال: إن من شرطه نسيان ذلك المحفوظ، لتمحى رسومه الحرفية الظاهرة، إذ هي صادة عن استعمالها بعينها، فإذا نسيها – وقد تكيفت النفس بها – انتقش الأسلوب فيها كأنه منوال يأخذ بالنسج عليه بأمثالها من كلمات أخرى ضرورة، ثم لابد له من الخلوة واستجادة المكان المنظور فيه من المياه والأزهار وكذا المسموع لاستنارة القريحة باستجماعها وتنشيطها بملاذ السرور … »(18)
وقد وضح المؤلف أن الطريقة الوحيدة لتحصيل ملكة الشعر منذ أقدم العصور حتى اليوم هو كثرة مطالعة الجيد منه وحفظه كلما استطاع الباحث إلى ذلك سبيلا حتى تنشأ في النفس ملكة ينسج على منوالها.
كما عمل المؤلف على بيان ملكة البلاغة في اللسان باعتبارها تحصل بممارسة كلام العرب وتكرره على السمع والتفطن لخواص تراكيبه، كما أنها تهدي البليغ إلى وجوه النظم وحسن التركيب الموافق لتراكيب العرب في لغتهم ونظم كلامهم، ولو رام صاحب هذه الملكة حيدا عن هذه السبيل المعينة والتراكيب المخصوصة لما قدر عليه ولا وافقه عليه لسانه؛ لأنه لا يعتاده ولا تهديه إليه ملكته الراسخة عنده وإذا عرض عليه الكلام حائدا عن أسلوب العرب وبلاغتهم في نظم كلامهم أعرض عنه ومجه وعلم أنه ليس من كلام العرب الذين مارس كلامهم وربما يعجز عن الاحتجاج لذلك كما تصنع أهل القوانين النحوية والبيانية، فإن ذلك استدلال بما حصل من القوانين المفادة بالاستقراء، وهذا أمر وجداني حاصل بممارسة كلام العرب حتى يصير كواحد منهم، (19) وقدم مثالا لذلك بقوله:«لو فرضنا صبيا من صبيانهم نشأ وربي في جيلهم فإنه يتعلم لغتهم ويحكم شأن الإعراب والبلاغة فيها حتى يستولي على غايتها وليس من العلم القانوني في شيء، وإنما هو بحصول هذه الملكة في لسانه ونطقه، وكذلك تحصل هذه الملكة لمن بعد ذلك الجيل بحفظ كلامهم وأشعارهم وخطبهم والمداومة على ذلك بحيث يحصل الملكة ويصير كواحد ممن نشأ في جيلهم وربي بين أجيالهم … ».(20)
فتقرر بجميع ما سلف أنه لا طريق لتعلم صناعة الإنشاء إلا بحفظ كلام الغير وفهمه وتمييز مقاصده مستشهدا بما قاله ابن خلدون، ونصُّه:«فإن عرض لك ما تسمعه من أن سيبويه والفارسي والزمخشري وأمثالهم من فرسان الكلام كانوا أعجاما مع حصول هذه الملكة لهم، فاعلم أن أولئك القوم الذين تسمع عنهم إنما كانوا عجما في نسبهم فقط، وأما المَرْبَى والنشأة فكانت بين أهل هذه الملكة من العرب ومن تعلمها منهم فاستولوا بذلك من الكلام على غاية لا شيءَ وراءها، وكأنهم في أول نشأتهم من العرب الذين نشأوا في أجيالهم حتى أدركوا كنه اللغة وصاروا من أهلها، فهم وإن كانوا عجما في النسب فليسوا بأعجام في اللغة والكلام لأنهم أدركوا الملة في عنفوانها واللغة في شبابها ولم تذهب آثار الملكة ولا من أهل الأمصار ثم عكفوا على الممارسة والمدارسة لكلام العرب حتى استولوا على غايته»(21)
وأكد المؤلف نقطةً مهمة في هذا الصدد تمثلت في من يريد أن يتصدى لإنشاء الكلام نثرا كان أو نظما لابد أن يكون فيه استعداد طبيعي لأمور اختيارية وذلك بأن يكون ذا حافظة قوية وفهم ثاقب وذاكرة مطيعة، وبعد حصول هذه الملكة لا بد من الدربة الطويلة على النظم والإكثار منه حتى تستحكم الملكة كما يقول الشيخ حسين المرصفي: فإذا كان الإنسان ذا حافظة قوية واستعملها في حفظ ما اتفق أسلافه ومعلموه على استجادته مهتديا بفهمه إلى معاني محفوظاته ومقاصدها وتمييز كل فريق منها بما له من المحاسن، وما لغيره من المساوئ حسب ما سلف إرشادك له، ثم استخدم ذاكرته في إحضار ما أراد من ذلك متى شاء فهو حينئذ متهيئ لتحصيل تلك الصناعة وبالغ منها بتوفيق الله غاية منيته ومنتهى مقصوده، فمن لم يجد من نفسه ذلك الاستعداد فعليه أن لا يورط نفسه ويستعملها فيما يكدها من غير عاقبة حميدة، بل عليه أن ينظر فيما يسهل عليه ويمكنه الانتفاع به كما قيل:(22)
إِذَا لَمْ تَسْتَطِع شَيْئا فَدَعْهُ=وَجَاوِزْهُ إِلَى مَا تَسْتَطِيع
وقد حاول المؤلف الوقوف على الطريقة التي كوَّن بها صديقه محمود سامي البارودي باعث الشعر العربي المعاصر حيث قال عنه:« هذا الأمير الجليل ذو الشرف الأصيل، والطبع البالغ نقاؤه، والذهن المتناهى ذكاؤه محمود سامي باشا البارودي، لم يقرأ كتابا في فن من فنون العربية غير أنه لما بلغ سن التعقيل وجد من طبعه ميلا إلى قراءة الشعر وعمله، فكان يستمع إلى بعض من له دراية وهو يقرأ بعض الدواوين، أو يقرأ بحضرته حتى تصور في برهة يسيرة هيئات التراكيب العربية ومواقع المرفوعات منها والمنصوبات والمخفوضات حسبما تقتضيه المعاني والتعلقات المختلفة، فصار يقرأ ولا يكاد يلحن، وسمعته مرة يسكن ياء المنقوص والفعل المعتل بها المنصوبين، فقلت له في ذلك، فقال هو كذا في قول فلان وأنشد شعرا لبعض العرب فقلت تلك ضرورة، وقال علماء العربية إنها غير شاذة، ثم استقل بقراءة دواوين مشاهير الشعراء من العرب وغيرهم حتى حفظ الكثير منها دون كلفة، واستثبث جميع معانيها ناقدا شريفها من خسيسها واقفا على صوابها وخطئها مدركا ما كان ينبغي وفق مقام الكلام وما لا ينبغي… ».(23)
بيَّن المرصفي في هذا النص المنهج السليم الذي سلكه محمود سامي البارودي والمتمثل في قراءة النصوص الجيدة وحفظ خيارها والعكوف عليها وإدامة النظر فيها لإتقان صناعة الأدب باعتبارها الوسيلة التي لا يمكن أن تغني عنها أية دراسة لغوية أو نقدية، وخير دليل على ذلك مجموعة الأشعار التي خلفها لنا البارودي في مختاراته التي تذكر بمختارات أبي تمام في ديوان الحماسة.
وقد أورد المرصفي مثالا لما ينبغي تحصيله للحفظ وترديد النظر فيه من قصائد لمشاهير الشعراء، وبحسب نشأة الشعر وما عرض له من التغير جعل الشعراء في ثلاث طبقات:
– الطبقة الأولى: للعرب الجاهليين والإسلاميين من المهلهل إلى بشار بن برد.
– الطبقة الثانية: للمحدثين الذين كانوا يحرصون على موافقة العرب ويجتهدون في سلوك طرائقهم من أبي نواس إلى من قبل عبد الرحيم المعروف بالقاضي الفاضل.
– الطبقة الثالثة: الشعراء الذين غلب عليهم استعمال النكات والإفراط في مراعاة البديع وهم من القاضي الفاضل إلى هذا الوقت.(24)
وتتبع المرصفي فروق كل طبقة من هذه الطبقات ومميزاتها، حيث كان له ذوق رفيع في اختيار النصوص الشعرية وعرضها وتحليلها مع بيان ذلك في نماذج من شعر الشعراء كالمهلهل وأبي فراس الحمداني … مما جعل الوسيلة الأدبية مجموعة من المختارات الأدبية العالية شعرا ونثرا.
ينتقل المؤلف بعد ذلك إلى الجهة الثانية «في أمور كلية» تحدث فيها عن أصول يعتمدها الكاتب في المكاتبات بحيث يتعين على مريد الصناعة التمكن من معرفتها واعتبارها ليأتي بها على وجهها، مستعينا بما ورد عند «أبي العباس أحمد القلقشندي» في كتابه «صبح الأعشى»، بيَّن فيها حسن الافتتاح المطلوب في سائر أنواع الكلام من نثر ونظم، وبراعة الاستهلال المطلوبة في كل فن من فنون الكلام، والمقدمة التي يلزم أن يأتي بها في صدر الكتب المشتملة على المقاصد الجليلة تأسيسا لما يأتي به في المكاتبة، ومواقع الألفاظ الدائرة في الكتب، والأدعية التي جرت عادة السلف وتبعهم الخلف باستعمالها في المكاتبات إلى غير ذلك من الحديث النظري العام.
أما الجهة الثالثة فخصها المؤلف بأمثلة تعين بتفهمها وتأمل سياقاتها من فواتحها إلى خواتمها على تربية الذهن، ومن فضائل ما ذكره المؤلف في هذه الجهة حشده مجموعة كبيرة من النصوص النثرية وتناولها بالتفصيل والتحليل والمناقشة.
والكتاب على أية حال شديد الشبه بكتب الأمالي العربية القديمة، كــ«الأمالي»لأبي علي القالي و«الكامل» للمبرد وغيرهما، وإن اختلف عن الأمالي القديمة في أنه لم يقتصر على الأدب وروايته، بل شمل جميع علوم اللغة العربية من نحو وصرف وعروض وفصاحة وبيان وبديع ومعان، ثم الأدب بفرعيه: الشعر والنثر، متحدثا عن كل فن على حدة، ولكن على طريقة الاستطراد والتداعي المعروفة في كتب الأمالي القديمة، واستشهاد الشيخ حسين المرصفي ومحفوظاته الضخمة تنم عن ذوق سليم في الاختيار، كما ينم حديثه عن علوم اللغة عن فقه وتعمق وحافظة جبارة، فضلا عن حديثه عن رائدي البعث الأدبي في عصره محمود سامي البارودي الشاعر وعبد الله فكري الناثر وإيراده عدداً من قصائد البارودي الشعرية ومقطوعات عبد الله فكري النثرية، والموازنة بينهما وبين شعر القدماء ونثرهم.
واستنادا إلى هذه المبادئ التي أثبتها الشيخ حسين في «وسيلته» يمكن القول بأنه قد وجه الأدب الوجهة الصحيحة في بعث الأدب العربي عامة والشعر العربي خاصة، باعتبار أن الشعر هو الذي يكون الجانب الأكبر من تراث الأدب العربي القديم.
ــــــــــــــــ
الهوامش:
(1) الوسيلة الأدبية 1/421.
(2) نفسه 1/422.
(3) نفسه 1/422.
(4) نفسه1 /489.
(5) نفسه1 /490.
(6) نفسه1 /492.
(7) نفسه 1/493.
(8) نفسه 1/494.
(9)نفسه 1/693.
(10) نفسه1/693-694.
(11)نفسه 1/708.
(12)نفسه 2/3.
(13) نفسه2/14-15.
(14)نفسه 2/16.
(15)نفسه 2/19.
(16)نفسه 2/392
(17) نفسه: 2/399-400.
(18) الوسيلة الأدبية: 2/401-400. مقدمة ابن خلدون 2/400-401
(19) نفسه: 2/403-404.
(20) نفسه: 2/403
(21) نفسه: 2/405. مقدمة ابن خلدون 2/389-388
(22) نفسه: 2/406.
(23) نفسه: 2/408.
(24) نفسه: 2/447-446.