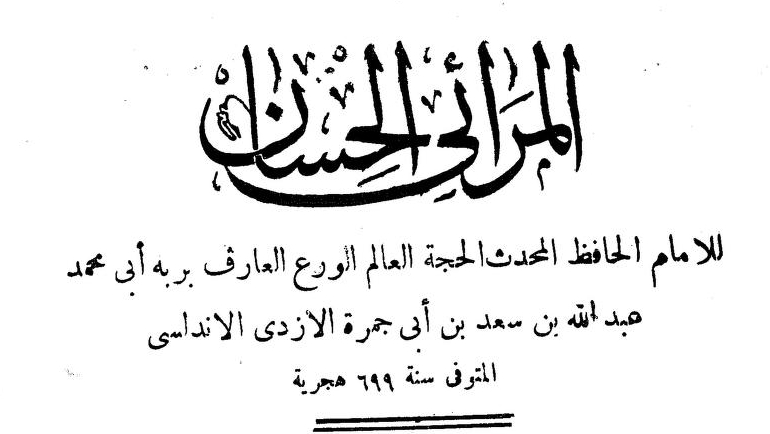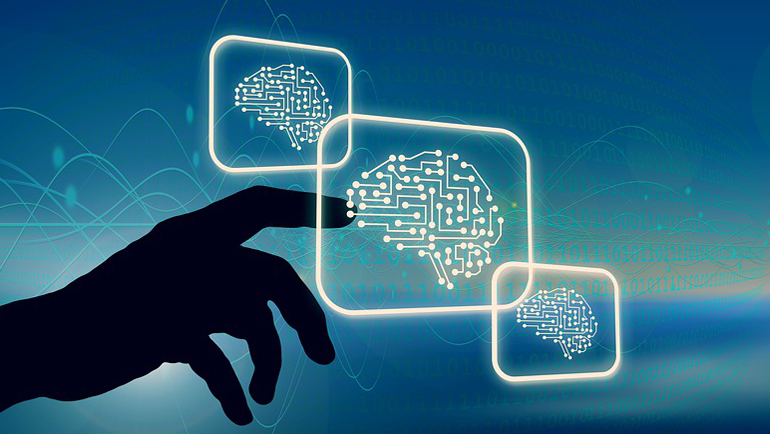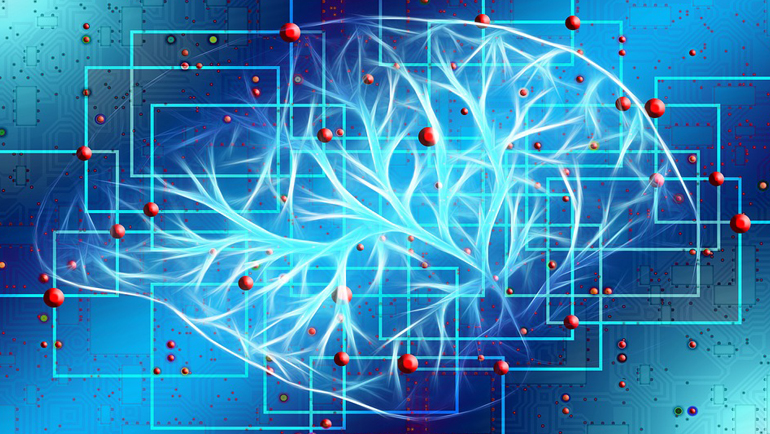ألا يجوز القول: إن الليبرالية، سواء كفلسفة اقتصادية أو نسق مجتمعي، تقف مهزوزة أمام سؤال الأخلاق؛ لأنه ليس لها في مرجعيتها النظرية، ولا في تطبيقها المجتمعي ما يمكن أن يسند القيمة الأخلاقية بما هي التزام يتعالى على النفعية الفردانية؟
وبما أن الرؤية الليبرالية للاجتماع تتأسس على منظور كمي والنفعية الفردانية؛ ألا تكون بذلك عاجزة عن تبرير ذاتها كفلسفة تتقصد بناء الحياة المجتمعية، لاحتياج هذه الحياة ولابد إلى الأساس الأخلاقي المتعالي على المصلحة الفردانية، أساس شارط لها لا مشروط بها؟
لكن في مقابل ذلك، ألا يكون التوكيد على قيمة الحرية توكيدا على أهم خصيصة في الكائن الإنساني؟ أليست الحرية قيمة القيم؟ ألا يمكن من خلال منظور الحرية تأسيس منظومة أخلاقية؟
لمقاربة هذه الاستفهامات أبدأ أولا بالتحديد الليبرالي للكينونة الإنسانية، ثم أنتقل بعدها إلى بيان مفهوم الأخلاق الليبرالية.
أولا: في تعريف الليبرالية للإنسان بوصفه “كائناً اقتصادياً”
من خلال تأمّلنا في الرؤية الفلسفية الليبرالية، ونمطها الثقافي والمجتمعي، نرى أنها قامت بقلب دلالي لمعنى ماهية الإنسان من الماهية العاقلة إلى الماهية المالكة، بالمدلول الاقتصادي المادي للتملك؛ إذ تعد مقولة “الإنسان كائن- اقتصادي Homo Economicus مرتكزاً نظرياً أساسياً للنمط الثقافي الليبرالي.
فهي ليست مجرّد محدد نظري لمفهوم الإنسان من حيث بعده الاقتصادي المادي، ولا هي مجرد مبدأ لتأسيس النظرية الاقتصادية الليبرالية، بل إن تلك المقولة هي نقطة الانطلاق لبناء رؤية فلسفية عامة، تتعلق بنوع النظرة إلى ماهية الكينونة الإنسانية ككل؛ وهي تعبير عن قلب دلالي جذري للمقولة القديمة المحددة للإنسان بوصفه “كائناً عاقلاً” تتحدد ماهيته في التفكير Homo Sapiens. كما أنها في أبعادها الغائية تنتهي إلى توكيد نمط الرؤية المادية للإنسان، رؤية أصبحت في النسق الليبرالي ومنظومته المجتمعية تعبيراً عن أسلوب في العيش وأسلوب في التفكير على حد سواء، بل يجوز أن نقول: إنها ما تجسدت كنمط عيش إلا لأنها نمط تفكير ابتداء.
كما أن هذه الرؤية تتحكم في المنظور الثقافي الغربي، رغم تعدد واختلاف توجهاته الفلسفية، حيث استحالت إلى أنموذج نظري شارط لعملية الإدراك؛ ولذلك فهي تتمظهر في مختلف نتاجات الوعي الأوروبي، فَنّاً كان هذا النتاج أو فلسفة أو معماراً بنائياً، هذا فضلاً عن التمظهر في القيم الناظمة للسلوك الاقتصادي.
ونرى أن لهذا الأسلوب الاقتصادي المادي في تحديد الإنسان جذوراً في الخلفية الثقافية الغربية، وليس مرتبطاً فقط بظهور نمط المجتمع الصناعي وما رافقه وأطر له من رؤى ليبرالية. والدليل على ذلك أنه رغم التناقض الظاهري بين المشروع الليبرالي الرأسمالي والمشروع الاشتراكي الماركسي، فإن أساسهما مشترك ومتماثل، وهو هذا النمط المحدد للنظرة إلى الكائن الإنساني بوصفه “حيواناً اقتصادياً!” وهذا ما يجعلنا نعده أحد مكونات الشبكة الإدراكية المحددة لرؤية الوعي الغربي إلى ذاته وإلى الوجود من حوله؛ لأننا نراها شبكة ماثلة في مختلف نظمه وأنساقه الثقافية على اختلافها.
وما القراءة النقدية التي أنجزتها مدرسة فرنكفورت لـ”العقل الأداتي”، الباحثة عن جذوره في الخلفية الأسطورية والفلسفية الهلينية إلا توكيداً لما سبق، وإشارة إلى أمر أعمق مما وقفت عنده هذه المدرسة السوسيولوجية ذاتها. فنمط العقل الأداتي هو مظهر للرؤية إلى الكائن الإنساني بوصفه كائناً مادياً. وبناء على هذه الرؤية ينطلق العقل الغربي إلى قراءة مادية للذات والوجود، قراءة لا تنظر إلى الغايات بل تحول كل كينونة، حتى كينونة الإنسان ذاتها، إلى أشياء/أدوات استعمالية.
وهذه النظرة للإنسان الخاضعة للرؤية الاقتصادية المادية، ليست محدودة، من حيث تأثيرها، بحدود الجغرافية الغربية، بل يراد لها أن تُعولم وتسود على مختلف الأنساق الثقافية والمجتمعية. ومن ثم فتحليل هذه الرؤية النمطية ونقدها لا يندرج في باب النظر إلى ما يسود وعي الآخر وواقعه، بل هو تحليل ونقد لمنظور أنثروبولوجي مادي آخذ في السيادة والتجذر في وعينا وواقعنا نحن أيضاً.
وإرادة تشميل هذا النموذج تفصح عنها مختلف الكتابات الليبرالية المعاصرة؛ يقول فوكوياما في كتابه الشهير”نهاية التاريخ”: “إذا كان الإنسان هو بالأساس حيواناً اقتصادياً محكوماً برغبته وعقله، فإن الصيرورة الجدلية للتطور التاريخي يجب أن تكون في المتوسط متماثلة بالنسبة لمختلف المجتمعات والثقافات[1].”
هكذا يصادر فوكوياما على المطلوب، ويجعل من تحديد الإنسان كحيوان اقتصادي منطلقاً. ثم يقفز ليجعل النمط التطوري الغربي نمطاً كونياً لجميع المجتمعات رغم اختلافاتها الثقافية. ثم يستدرك بأنه رغم وجود مسارات متنوعة لتطور المجتمعات، فإن ذلك مجرّد تنويع في المسار لا في الغاية؛ إذ الغاية عنده هي الخلوص إلى نهاية التاريخ؛ أي الانتظام وفق النمط الليبرالي الرأسمالي.
ويختتم بالقول بأنه رغم وجود أشكال حداثية خارج النمط الغربي، فإن الحداثة الليبرالية الرأسمالية هي المظهر الوحيد الممكن للنجاح! حيث يقول: “ورغم وجود تنويع كبير في المسارات التي يمكن للمجتمعات أن تسلكها لبلوغ نهاية التاريخ، فإنه لا وجود إلا لعدد قليل للحداثة خارج الصيغة الديمقراطية الليبرالية للرأسمالية، فهذه الصيغة هي التي تكشف عن مظاهر النجاح الممكن[2].”
إن نمط تفكير الحضارة الغربية نمط ذو نزوع كمي متمحور حول الأشياء، ولذا فأسلوب مقاربته للوجود هو انتهاج للتحليل الكمي الأداتي المفارق لفلسفة الغايات المجاوزة لسياجات الحس المادي. وفي هذا السياق يمكن أن نستحضر تلك المقارنة الذكية التي أنجزها مالك بن نبي في كتابه “مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي” بين قصتي “روبنسون كروزو” و”حي بن يقظان”. واستحضاره لهذين النموذجين الروائيين كان مدخلاً لبحث نمطي الرؤيتين الغربية والشرقية.
فقصة “روبنسون كروزو” للروائي الانجليزي دانيال ديفو (1660-1731) تدور كلها حول عالم الحس، ولا تلتفت إطلاقاً إلى الماوراء. حيث أن كروزو لم يشغل نفسه، في عزلته، إلا بصناعة طاولة خشب، والأكل والنوم… أي انحصرت أشواقه وهواجسه في الاهتمام بعالم المادة فقط. بينما قصة “حي بن يقظان” يشغلها هاجس البحث عن الحقيقة. فانطلاقاً من تأمّل فكرة الموت يبدأ السؤال الوجودي عند بطل القصة “حي”، فينشغل بمعنى الروح، ويخلص بعد سلسلة من التأملات إلى وجود الله الخالق.
في سياق المقارنة بين هاتين القصتين يستنتج مالك بن نبي التمايز بين العقلين الغربي والشرقي، عقل يغوص في المادة ويغرق فيها، فينسى ذاته وينسى سؤال الكينونة؛ وعقل يتشوف إلى الماوراء وينزع نحو تأمله.
لكن ثمة أمراً لم يقف عنده الأستاذ مالك بن نبي، أمر يحسن أن نبرزه هنا تعميقاً لدلالة هذا التمايز. وهو أن ديفو، هذا الرجل الذي جاء إلى فن السرد من دكان لتجارة الأقمشة والخردوات، لا نراه كتب قصته باستقلال عن حي بن يقظان، بل كما أكد غوتييه، سبق لديفو أن قرأ قصة ابن طفيل، حيث ترجمت إلى الإنجليزية سنة 1708؛ أي قبل كتابة ديفو لقصته بإحدى عشرة سنة. لكن عندما أذكر هذا فليس من أجل اتهام ديفو بالسرقة الأدبية، بل قصدي أهم من ذلك، كما لا أريد أن أسلك مسلك غوتييه للتوكيد على اطلاع صاحب قصة كروزو على “حي بن يقظان”، وذلك بإبراز ما بينهما من تشابه في الكثير من الأحداث، بل الذي يلفت انتباهي هو المختلف بينهما أكثر من المتشابه؛ حيث إن ما يهمني هنا هو ما حذفه ديفو لا ما استبقاه أو سرقه أو استعاره بفعل التناص من ابن طفيل! لأنني أرى أن ما حذفه هو بالضبط ما ينقص نمط التفكير الغربي، وما أضافه للقصة هو بالضبط ما يميز هذا النمط!
ماذا أخذ ديفو وماذا ترك؟!
لقد استبقى ديفو أحداثاً كثيرة، لكنها كلها تتميز بكونها أحداثاً كمية شيئية، فإذا استثنينا تعلم اللغة، حيث كما علم أسال حي بن يقظان، نجد عند ديفو تعليم كروزو لفرايدي، فإن ما تبقى كله يتمحور حول الكينونة المادية، مثل تدجين بعض الحيوانات، وبناء البيت، وصنع الملابس والسلاح واكتشاف النار. أما الذي حذفه ديفو فهو كل تلك الصيرورة التأملية الفلسفية الثرية التي تميز حي بن يقظان؛ أي أن ما حذفه هو سؤال الحقيقة والنزوع إلى الماوراء!
وبناء على التحليل السابق لمحددات الرؤية إلى الكائن الإنساني في المنظور الثقافي الغربي، ووقوفنا عند المقارنة التي قام بها المفكر الجزائري مالك بن نبي بين قصة “حي بن يقظان” لابن طفيل، وقصة “روبنسون كروزو” لديفو؛ صح لنا أن ننتهي في سياق المقارنة إلى تقرير اختلاف جوهري في الرؤية إلى الكائن الإنساني ووظيفته في الوجود، حيث تنزع الرؤية الشرقية نحو نظرة كلية كيفية، وتنزع الرؤية الغربية نحو نظرة تحليلية كمية. وتتجسد هذه النظرة بوضوح في الاختزال المادي لكينونة الإنسان، حيث تؤول به إلى مجرد حيوان اقتصادي!
وهذا ما يشير إليه مالك بن نبي بقوله في سياق تحليله لقصة ديفو: “إذ يعتزل الإنسان وحيداً، ينتابه شعور بالفراغ الكوني. لكن طريقته في ملء هذا الفراغ، هي التي تحدد طراز ثقافته وحضارته؛ أي سائر الخصائص الداخلية والخارجية لوظيفته التاريخية. وهناك أساساً طريقتان لملء الفراغ، إما أن ينظر المرء حول قدميه؛ أي نحو الأرض، وإما أن يرفع بصره نحو السماء[3]“، منتهياً إلى أن: “الفكر الغربي يجنح على ما يبدو أساساً إلى الدوران حول مفهوم الوزن والكم[4].”
واستحضارنا لنموذج كروزو وتأويلنا له على النحو السابق لا يستند فقط على قراءة بن نبي، بل يستند أيضاً على قراءة السوسيولوجي الألماني ماكس فيبر في كتابه الشهير “الأخلاق البروتستانتية”، حيث وجدناه هو أيضاً يُؤَوِّلُ شخصية روبنسون كروزو رائياً فيه تجسيداً لنموذج “الإنسان الاقتصادي[5]“، ومحدّداً لنمط الحضارة الرأسمالية.
ونحن عندما نستحضر هذا المعنى نريد أن نذهب أبعد من ذلك، وهو أن هذا النموذج ليس ملمحاً من ملامح النمط المجتمعي الصناعي فقط، بل هو محدد من محددات نمط التفكير الغربي ككل.
فالرؤية الكمية إلى العالم لا تبدو فقط في هذا النتاج السردي الروائي، ولا في النمط الثقافي والحضاري الغربي الراهن، بل حتى في الخلفية الثقافية الهيلينية. وقد وقفت مدرسة فرنكفورت ملياً عند أسطورة أوديسيوس في ملحمة “الأوديسة[6]“، كاشفة عن مركزية هذه الرؤية المادية التي سيصطلح عليها هوركايمر وأدورنو بـ”الأداتية”.
كما أن هذا النمط في تمثل الذات والوجود نجده يتمظهر في علم الفيزياء مع جاليليو في رؤيته التحليلية الرياضية للكون، وفلسفياً مع ديكارت في تمييزه بين الفكر والامتداد، وتأسيسه للعقل بوصفه قوة للسيطرة على الطبيعة واستغلالها. كما سيتمظهر مجتمعياً في النمط الليبرالي، كنمط يتقصد تأسيس واقع يعامل الذات الإنسانية بوصفها جسدا.
وبالرجوع إلى الخطاب الفلسفي الليبرالي نلاحظ أن المنظرين للفكرة الليبرالية سيحرصون على اختزال الدوافع والأشواق والغايات الإنسانية، حتى تلك التي تخرج عن نطاق العلاقة الاقتصادية، إلى رغبات وأشواق جسدية لتؤول إلى محض رغبة اقتصادية!
لكن الفيلسوف الليبرالي يستشعر اختلال هذه الأولوية المطلقة التي يعطيها للمنظور الاقتصادي في فهم الإنسان وتحديد حاجاته؛ لأنه يحس أن ثمة دوافع وأشواقاً وقيماً إنسانية تنفلت من إطار رؤيته المادية القاصرة، دوافع وأشواق تعلو القيمة المادية وتجاوز نطاقها الكسيح المحكوم بمعايير الحساب النفعي، ولذا تجده يحاول أن يغض الطرف عنها، أو يتحايل لتجاوزها بمنطق التبرير والتسويغ حيناً، أو بمنطق الاختزال بل والتحريف حينا آخر.
لنتأمل ما كتبه أحد منظري الفكر الليبرالي المعاصر (موريس فلامان) في دفاعه عن الرؤية الليبرالية لكينونة الإنسان؛ إذ لما أبان عن مادية هذه الرؤية، واستشعر انزلاقه في الرؤية الاختزالية، حاول الدفاع عن الموقف الليبرالي فكان شكل ومضمون دفاعه، القائم على التزييف، أقبح من زلته الأولى في تحديده لهيمنة الدوافع الاقتصادية عند الكائن الإنساني؛ إذ أمام هذا التحديد لهذه الدوافع وجد نفسه ملزماً بالحديث عن دوافع أخرى غير اقتصادية تتحكم في الإنسان.
لكنه بدل أن يذكر هذه الدوافع والأشواق بموضوعية انتقى بعض الدوافع الخسيسة ليقيم حكماً تفضيلياً بأنها لا تعلو قيمياً على الدوافع الاقتصادية، ويجعل منها دليلاً على أن لا شيء يرقى فوق الدافع الاقتصادي! يقول في كتابه “تاريخ الليبرالية”: “إن الإنسان يستجيب غالباً لدوافع هي رغم أنها ليست دوافع اقتصادية فإنها ليست أبداً أرقى منها، مثل: الغرور، والرغبة في السيطرة، وعدم التسامح، و التعصب، والطائفية، ومحاباة الأقارب[7].”
ويا له من تذاكٍ مفضوح في الانتقاء!
وهنا ثمة سؤال مشروع هو: أليس للإنسان دوافع ومقاصد أخرى غير هذه، وتعلوها قيمياً، ما دام فلامان يعاير بمنطق التفاضل القيمي؟
إن حرصه على الدفاع عن هيمنة الرؤية الاقتصادية في تحديد الكائن الإنساني، واختزال دوافعه في مجموعة من النوازع النفسية النابعة من الأنانية الخسيسة، وكأنه ليس للإنسان غيرها من الدوافع والأشواق! يكشف أنه في مسلكه هذا يؤكّد ضمنياً إفلاس الرؤية الليبرالية في فهم واستيعاب كينونة الإنسان، باندفاعها القصدي إلى اختزال الذاتية الإنسانية في كينونة مادية لا عقل لها ولا قلب، سوى عقل الغريزة وقلب الشهوة.
ونحن نرى أن ليس هناك عيب في ذكر هذه الدوافع، ولا الصواب في نفي وجودها، لكن العيب يكمن في الرؤية الاختزالية، والصواب يتحدد في رؤية مستوعبة للكائن الإنساني، تقاربه في تعدد دوافعه وتنوع أشواقه؛ لأن رؤية هذا التنوع هو المدخل المنهجي الضروري لتأسيس نظرية مجتمعية تستجيب لكينونة الإنسان في كليتها وتوازنها. أما نفي التنوع فهو نفي لإمكان الاستجابة إلى كيان الإنسان، وهذا ما نلاحظه في النسق المجتمعي الليبرالي الذي استجاب فقط لما اهتم به من أبعاد في الكائن الإنساني، أي استجاب له كجسد. فاستوى الإنسان في نسقها التربوي المادي كآلة حاسبة لا إحساس لها ولا شعور!
ليس الإنسان مجرّد كائن يعيش وجوده، بل هو، فوق ذلك، كائن ينزع نحو فهم الوجود، بل حتى على مستوى وجوده الفردي يحرص على أن يجعل له معنى وقيمة. إنه بعد محايث لكينونة الإنسان ولا يمكن تجاهله. وهذا ما أدركه بعض الليبراليين واستشعروا الحاجة إلى اعتباره عند تحليلهم للوضعية الإنسانية.
وأعتقد أن استثمار النيوليبرالي المعاصر روبير نوزيك للفلسفة الكانطية، ووقوفه في كتابه “الفوضى، الدولة واليوتوبيا” Anarchy, State and Utopia، عند وظيفة المعنى في حياة الكائن الإنساني هو في تقديري ذو دلالة كبيرة؛ إذ هو دليل على اضطرار المقاربة النيوليبرالية إلى توسيع رؤيتها إلى خارج السياج المادي، وإن كان ذلك لم يثمر عندها أي تبديل لنمط رؤيتها لماهية الإنسان، بسبب عدم انتباهها إلى منطلقها الخاطئ المحكوم بالرؤية المادية.
ثانيا: في الأخلاق الليبرالية!
ليس ثمة تحليل نقدي وُجِّهَ إلى الفلسفة الاجتماعية الليبرالية، إلا وانتبه إلى هامشية القيمة الأخلاقية في رؤيتها إلى ما ينبغي أن ينظم علاقة الأفراد، ونوع القيم التي يجب أن تضبط ترابطهم داخل المجتمع. لذا حق لنا أن نصحب عنوان هذه السطور بعلامة تعجب؛ ذلك لأن الجمع بين الأخلاق والليبرالية أمر إشكالي يبدو حاملا لمفارقة؛ حيث أن الخلق مجموع من القيم والقواعد الواجب امتثالها من قبل الفرد في سلوكه وعلاقاته مع الآخر، بينما الحرية انطلاق من القيود، لذا بين التخلق والتحرر فاصل ومائز دلالي وفعلي لا سبيل إلى إنكارهما.
لكن ما سبق قوله من وجود مفارقة بين الحرية والأخلاق لا يمكن نقده ببيان الصلة بينهما فقط، بل يمكن أن نذهب بتوكيد هذه العلاقة إلى حد القول بأنهما مترابطين برابط شرطي يؤكد تلازمهما؛ حيث أن الكائن الإنساني ما كان كائناً أخلاقياً إلا لكونه حراً. فالأخلاق فضلاً عن طابعها الإلزامي هي أيضاً التزام نابع عن قدرة على الامتثال للقيمة الخلقية أو خرقها. ولا يمكن أن نحكم على سلوك ما بكونه امتثالاً للقيمة أو خرقاً لها إلا إذا كان صادراً عن ذات مختارة لا ملزمة. ولهذا السبب لا يندرج السلوك الحيواني ضمن السلوكيات الأخلاقية؛ لأنه صادر عن فعل غريزي منتظم وفق منطق الضرورة لا الحرية.
ومن هذا اللحاظ فالحرية شرط الأخلاق.
وهذا تقدير صحيح، لكننا هنا لا نتحدث عن الشرط الأنطولجي المقوم للفعل القابل للمعايرة الأخلاقية، بل عن مبدأ المذهب، فالليبرالية بوصفها مذهباً يطلق الفردانية من أي ضابط قيمي غير ضابط المنفعة المحددة كمياً، تطرح مفارقة تسوغ لناقديها أن يروها متضادة مع أساس القيم الأخلاقية.
لذا ألا يجوز القول: إن الليبرالية، سواء كفلسفة اقتصادية أو نسق مجتمعي، تقف مهزوزة أمام سؤال الأخلاق؛ لأنه ليس لها في مرجعيتها النظرية، ولا في تطبيقها المجتمعي ما يمكن أن يسند القيمة الأخلاقية بما هي التزام يتعالى على النفعية الفردانية؟
وبما أن الرؤية الليبرالية للاجتماع تتأسس على منظور فرداني يتقصد الربح المادي والمنفعة الشخصية؛ ألا تكون، بذلك، عاجزة عن تبرير ذاتها كفلسفة تتقصد بناء الحياة المجتمعية، لاحتياج هذه الحياة، ولابد، إلى الأساس الأخلاقي المتعالي على المصلحة الفردانية، أساس شارط لها لا مشروط بها؟
لكن في مقابل ذلك، ألا يكون التوكيد على قيمة الحرية توكيدا على أهم خصيصة في الكائن الانساني؟ أليست الحرية قيمة القيم؟ ألا يمكن من خلال منظور الحرية تأسيس منظومة أخلاقية؟
الواقع أن المفارقة التي تبدو عليها القيمة الأخلاقية داخل النسق الفلسفي الليبرالي لا يعيها ناقدو الليبرالية فقط، بل يستشعرها حتى دعاتها. ولنأخذ كدليل على ذلك المؤرخ الليبرالي موريس فلامان في كتابه “تاريخ الليبرالية”، حيث نجده يستحضر النقد الأخلاقي الموجه لمذهبه، وبعد أن يعترف بأن هذا النقد من أكثر الانتقادات تداولاً حول الفلسفة الليبرالية، يحاول الدفاع عن أخلاقياتها، من خلال ما أسماه بوجود “أخلاق عملية”!
فما هي محدّدات الأخلاق العملية الليبرالية؟
يرى فلامان أنها ثلاثة هي:
“1. التأكيد على فعل الادخار، الأمر الذي يستلزم نوعاً من التقشف.
2. احترام العقود سواء المكتوبة أو غيرها ( كاحترام الكلمة)، وهو ما كان يعكس منذ القديم الاحتراس من خيانتها..
3. المسؤولية: بحيث إن الإخفاق البسيط يجب أن يؤدي صاحبه الثمن عليه[8].”
هذا هو دفاع فلامان عن أن الليبرالية لها أخلاق. لكن هنا يمكن تسجيل ملاحظتين اثنتين: الأولى شكلية، والثانية مضمونية:
أما من حيث شكل دفاعه، فأرى أن ما كتبه فلامان قد يراه ناقد النسق الفلسفي والاجتماعي الليبرالي أنه توكيد على هامشية الأخلاق في المنظومة الفلسفية الليبرالية. ويمكن أن يعزز نقده شكليا بالإشارة إلى أن الصفحات التي خصصها فلامون لبحث المسألة الأخلاقية لم تجاوز في كتابه صفحة ونصف! ويكفي هذا دليلاً عكسياً على ما حاول الكاتب إثباته؛ إذ أن دفاعه عن وجود أخلاقية ليبرالية جاء على قدر من الاحتشام والانكماش والاختزال، فكان بذلك دالاً على غياب ما أراد التوكيد على حضوره!
أما الملاحظة الثانية، فإن هذه المبادئ الأخلاقية ذاتها، التي أعلنها كبرهان على وجود أخلاق ليبرالية، ودليلاً للدفاع عنها ضد الانتقادات الموجهة لها، يمكن النظر إليها بوصفها تفتقر إلى المبدئية الأخلاقية، فهي من ناحية السمت اللغوي مصاغة في لغة تجارية لا تفرق بين التعاقد الإنساني حول مُثُلِ الحياة وقيمها، وبين التعاقد التجاري القائم على مفاهيم الثمن والبيع والشراء ومقدار الادخار.
لنتأمل مبدأ المسؤولية الذي هو محدد أساس من محددات الفعل الأخلاقي، ولننظر كيف ابتذله فلامان بتأسيسه على مفهوم الثمن حيث يقول مفسرا إياه: “إن الإخفاق البسيط يجب أن يؤدي صاحبه الثمن عليه[9].” وكذلك الشأن بالنسبة للمبدأين الآخرين (التأكيد على فعل الادخار، و احترام العقود)؛ إنها مفاهيم تفضح بصريح بنيتها اللسنية الابتذال الاقتصادي للقيم الأخلاقية من قبل الفلاسفة الليبراليين.
إن نوعية دفاع فلامان عن الأخلاقية الليبرالية، ودفاع غيره من الليبراليين، يكشف أن أفضل ما يؤكّد هامشية القيمة الأخلاقية داخل المنظومة الليبرالية هو استحضار دفاع الليبراليين عن أخلاقيات مذهبهم؟!
وإذا كان فلامون قد أكد على مجموعة من القيم للدلالة على أخلاقية الليبرالية، فإن بعض المدافعين عن النسق الليبرالي يحرص على القول بأن الليبرالية محايدة في ما يخص الأخلاق (مبدأ الحياد الأخلاقي)، وهذا أيضاً دفاع معكوس يثبت ما يحسب أنه ينفيه. فالحياد الأخلاقي الذي تزعمه الليبرالية لنفسها هو عند ناقديها إثبات لعجزها عن تأسيس المسألة الأخلاقية على نحو يبلور نظرية قابلة لأن تتسمى حقاً بالأخلاقية؛ لأن الليبرالية، في تقديرهم، ما اختارت الحياد إلا لعجزها عن إيجاد نقطة ارتكاز لموضعة موقفها وبنائه.
كما يمكن من منظور نقدي القول بأن ما يؤكد هامشية سؤال القيم داخل هذه النزعة المذهبية هو النظر في مرجعيتها الفلسفية، وبحث أصولها النظرية التي سعت إلى التأسيس والتنظير للمحدد الأخلاقي؛ حيث سنجد أن ما انتهت إليه يثبت عدم استحقاق نتاجها؛ لأن يسمى فلسفة أخلاقية أصلاً. والدليل على ذلك هو النظر في أهم مرجع نظري للأخلاق الليبرالية، ذاك الذي يتمثل في الإسهام الفلسفي لجيريمي بنتام، الذي يعد في هذا السياق اسماً مرجعيا من جهتين:
ـ من جهة ريادته؛ حيث كان أول من وسع من المنظور الليبرالي ونقله من مستوى التفكير في العلاقة السياسة، إلى بحث العلاقة الأخلاقية.
ـ ومن جهة ثانية؛ لأنه كان أول من أسّس نسقاً نظرياً أخلاقياً مترابطاً، لم ينحصر في تحديد المبادئ، بل وصل إلى حد التأسيس لمعايير قياسها.
لقد انتهى بنتام، بنزعة موغلة في تجريد القيم الأخلاقية من كل أساس مرجعي متعال، إلى أن المبدأ الأخلاقي الوحيد هو مبدأ المنفعة بمدلوله الخاص الفردي، ولم يستطع التخفيف من فردانية نزعته بتوكيده على دور الدولة في ضمان النفع لأكبر عدد من الأفراد. فهو في منطقه يخلص إلى أنه يجب على الفرد أن يتحقق من المنفعة التي تعود عليه هو ذاته من الفعل قبل أن يقوم به.
ووفق هذا المنظور المادي سيذهب بنتام، مستنداً على هيلفيتيوس وبريستلي، إلى التأسيس “لعلم حساب اللذة والآلام”، قاصداً أن يكون معياراً لقياس السلوك الأخلاقي والعملي قياساً كمياً. وبما أن المبدئية الأخلاقية هي المنفعة، فقد كان لازماً على هذا العلم أن يؤسس لطريقة تمكن من قياس اللذة، تلك التي يصنفها بنتام إلى نوعين “متجانسة” و”غير متجانسة”، فالأولى يمكن قياسها كمياً من خلال سبعة محدّدات هي:
1. المدة؛ وهو محدّد لقياس المدة الزمنية للذة، فاللذة المستمرة، أو الممتدة زمنياً أفضل من اللذة العابرة.
2. الشدة؛ أي قياس مدى قوة اللذة أو ضعفها.
3. التيقن من الإنجاز؛ حيث إن اللذة المؤكد حصولها أفضل من تلك التي نشك في إنجازها.
4. القرب؛ أي أن اللذة العاجلة أفضل من اللذة الآجلة.
5. الخصب؛ أي النظر في مدى أن تثمر اللذة لذات أخرى.
6. الصفاء؛ أي أن تكون اللذة خالصة غير مصحوبة بالألم.
7. الامتداد؛ أي قياس مدى تعدي اللذة من الفرد إلى شمولها لأفراد آخرين.
ولا يعني مبدأ الامتداد هذا أن بنتام ينقذ أخلاقيته من الفردانية، بل إنه هو نفسه يحرص في شرحه لمبدئه على القول بأن الفرد عندما يتقصد تحقيق منفعته، فإنه “عفويا” يطلب لغيره اللذة، ولا يطلبها له قصدياً، فمنفعة التاجر مرتبطة بمنفعة المشتري من جهة غير قصدية. لكن هذا لا يمنع من القول صراحة: إن مفهوم الغيرية حاضر في الوعي الأخلاقي البنتامي، وإن لم نجد له ضمن نسقه ما يدعمه فعلياً.
ويحرص بنتام على التوكيد على أن مقياس الكم قابل لقياس ما يسميه باللذات المتجانسة، غير أنه عندما يبحث اللذات غير المتجانسة، كلذة القراءة مثلاً وغيرها، فإنه يعترف بصعوبة حسابها كمياً. لذا نجده يبحث عن مقياس آخر يقاربها به. لكن لا ينبغي أن يذهب الظن بالقارئ إلى أن المقياس الذي سيقترحه بنتام لقياس اللذات غير المتجانسة سيكون مقياساً معيارياً قيمياً وغير كمي، بل هو أكثر إيغالاً في التكميم مما يظنه بنتام نفسه.
فالمفارقة المثيرة للانتباه هي أن المقياس البديل الذي وضعه لا يخرج بتاتاً عن الرؤية الكمية النفعية، التي تحكم منظوره الليبرالي ككل؛ ذلك لأنه رأى أن هذه اللذات غير المتجانسة يمكن قياسها بـ”المال”! أي يجب على الفرد أن يقيس تلك اللذة بمقدار ما يصرفه من مال لتحصيلها، فإذا كان المبلغ المالي الذي تحتاجه مكلفاً يجب أن يعرض عنها إلى لذة أقل منها كلفة.
هذه هي خلاصة الفلسفة الأخلاقية البنتامية التي تشكل إحدى الأسس المرجعية للمنظور الليبرالي، وتأمّل هذه الفلسفة يكفي لتوكيد هامشية الأخلاق في نسقها التصوري والاجتماعي. وبسبب مزلق الفردية التي انساقت فيها حاول جون استيورت مل التخفيف منها لتوكيد البعد الأخلاقي، ودلالة محاولة مل توكيد لعمق المفارقة الذي أشرت إليه من قبل؛ أي أن وضعية سؤال القيم الأخلاقية داخل إطار ثقافي يقوم على مرتكز الفردانية.
في المنظور والواقع الليبرالي اليوم، لم تعد الأخلاق قيماً عليا والتزاماً، بل مجرد قيم تجارية تقاس كمياً بمبدأ المنفعة في مردودها الفردي. وحتى قيمة الحرية ترتبط بآلية السوق ومنطقه.
وختاماً نقول: تأسيساً على ما سبق ندرك أن وضع علاقة تلازمية بين الليبرالية والحرية، والحرص على المرادفة بينهما من قبل التيار الليبرالي هو وضع خاطئ يقوم على تحريف وتزييف ليس لمثالية المفهوم فقط، بل أيضاً للسياق التاريخي لليبرالية ذاتها. وقد أكدنا في كتابنا “نقد الليبرالية[10]“، أن المعنى الأنواري لحرية الكائن الإنساني قد تم تحريفه من قبل الليبرالية الرأسمالية ليستحيل إلى تحرير الكائن المالك تحديداً، وإطلاق فعله دونما حاجز قيمي أو مصلحي عام. ومن ثم جاز لنا أن نقول: إن الفلسفة الليبرالية ابتذلت مفهوم الحرية واختزلتها إلى مجرّد دال على حرية القوة الاقتصادية ليس غير.
الهوامش
[1].F.Fukuyama, la fin de l histoire et le dernier homme, Paris, Flamarion,1992, p163.
[2]. ibid.
[3]. مالك بن نبي، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، دمشق: دار الفكر، 1988، ص17.
[4]. المرجع نفسه، ص24.
[5]. Max Weber, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Pion,, Paris 1964. p. 51.
[6]. عبد الوهاب المسيري، الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان، دمشق: دار الفكر، ط1، (1423ﻫ/2003م)، ص88.
[7]. Maurice Flamant, Histoire du Libéralismee, P.U.F,Paris1988, p59.
[8]. Maurice Flamant,op cit, p18.
[9]. ibid.
[10]. الطيب بوعزة، نقد الليبرالية، مطبوعات مجلة البيان، الرياض (1430ﻫ/2009م).