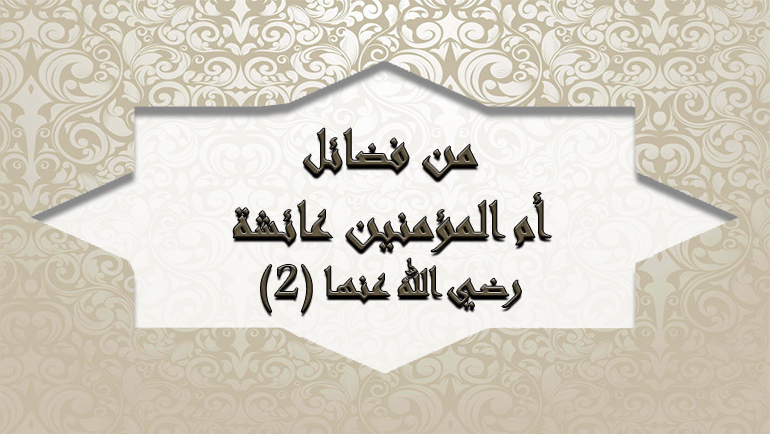من الأمور المقررة في الشريعة الإسلامية أن أحكامها مبنية على مبدإ اليسر ورفع الحرج عن العباد، على أن هذا المبدأ قد شابه بعض الغموض والالتباس في أوساط كثير من المسلمين في عصرنا الحاضر، الذي عرف عدة تطورات في مجالات متنوعة نتيجة التقدم العلمي والتقني وما أفرزه ذلك من وقائع ومسائل مستجدة، مع ما يتصل بذلك من آثار الاحتكاك بالعالم الغربي وتأثيراته المختلفة.
وقد كان من نتائج ذلك بروز ثلاث اتجاهات في التعامل مع أحكام الشرع والنظر في المسائل المطروحة والنوازل الواقعة؛ اتجاهان متقابلان يمثلان طرفي النقيض: أحدهما موغل في التشديد والتضييق بما يفضي إلى الحرج في كثير من الأحيان، والاتجاه الآخر متساهل، بل ومتهاون إلى حد ينتج عنه الانفلات من تكاليف الشرع، ممتطيا في ذلك مبدأ اليسر ورفع الحرج في الدين. وإلى جانب هذين الاتجاهين نجد اتجاها معتدلا وسطا بينهما يقتبس نهجه من الخصائص العامة للإسلام، التي دلت عليها نصوص الكتاب الكريم والسنة النبوية وفهم السلف الصالح لهذه الأمة.
ومن ثمة فإن الملاحظات والتنبيهات التي سنسوقها، والقواعد والضوابط التي سنثبتها، تستهدف دعم وتعزيز النهج المتبع عند أصحاب هذا الاتجاه المعتدل، والمساهمة في تقويم الاعوجاج الحاصل عند أصحاب الاتجاهين الآخرين؛ عن طريق تصحيح بعض المفاهيم المرتبطة باليسر ورفع الحرج، بما يؤدي إلى إزالة كثير من الالتباس في الموضوع. وذلك من خلال توضيح مفهوم الحرج والمشقة في علاقته بمقاصد الشارع، وبيان رجوع رفع الحرج إلى خاصية الوسطية والاعتدال في هذا الدين، وكون الأخذ بهذا المبدأ وسيلة لامتثال الأوامر والنواهي الشرعية، مع الوقوف على ضوابط الضرورة الشرعية في علاقتها برفع الحرج، وما يتخلل هذه القضايا من إشارات وتنبيهات لمجموعة من القواعد الضابطة لهذا المبدإ الشرعي، والتي ينبغي استحضارها والعمل بها محافظة على النهج السليم السائر في إطار الالتزام بوسطية الإسلام واعتداله.
1. مفهوم الحرج والمشقة وعلاقته بمقاصد الشارع
يطلق الحرج بعدة إطلاقات لا تخرج في عمومها عن معنى الضيق، ويراد به في الاصطلاح الشرعي ما أدى إلى مشقة زائدة عن المعتاد في النفس أو المال أو حال من الأحوال، سواء كان ذلك حالا أو مآلا[1]. ولذلك كان من مقاصد الشريعة رفع الحرج عن العباد بما يزيل تلك المشقة الزائدة غير المعتادة، ويكفل للإنسان اليسر فيما يقدم عليه من تصرفات وما يؤديه من تكاليف.
والفرق بين المشقة التي لا تعد مشقة عادة والتي تعد مشقة؛ يرجع إلى “أنه إن كان العمل يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع عنه، أو عن بعضه، وإلى وقوع خلل في صاحبه؛ في نفسه أو ماله أو حال من أحواله، فالمشقة هنا خارجة عن المعتاد. وإن لم يكن فيها شيء من ذلك في الغالب فلا يعد في العادة مشقة، وإن سميت كلفة[2].”
ولما كان من المقاصد الشرعية رفع الحرج عن المكلفين؛ علم أن ما قد يقع من مشقة خارجة عن المعتاد بالنسبة لبعض أحوال المكلفين في أداء العبادات وامتثال التكاليف الشرعية غير مقصود للشارع، كما تدل على ذلك النصوص الشرعية الكثيرة الدالة على رفع الحرج في الدين؛ كقول الله تعالى: “ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج” [المائدة: 7]، وقوله سبحانه: “وما جعل عليكم في الدين من حرج” [الحج: 76]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: “وضع الله الحرج[3]“، وكذا النصوص الدالة على التيسير والتخفيف؛ كقوله عز وجل: “يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر” [البقرة: 184]، وقوله تعالى: “يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الاِنسان ضعيفا” [النساء: 28]، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: “إن الدين يسر[4]“، كما يدل على ذلك أيضا وجود الرخص المنصوص عليها في موارد المشقة، بالإضافة لتضافر الأدلة على أن غاية الشريعة تحقيق مصالح العباد.
وأما المشقة المعتادة فهي مقصودة للشارع قصدا تبعيا: بمعنى أن الشارع قاصد لما في التكاليف من المشاق المعتادة، لكن ليس من حيث أنها مشقات وإنما من جهة كونها تؤدي لتحقيق مصالح العباد، كما نص على هذا المعنى الله تعالى في آخر آية الوضوء بقوله: “ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون” [المائدة: 6]. وقد فصل الإمام الشاطبي الكلام في هذه المسألة بما يؤكد المعنى الذي ذكرنا، ومما قال في ذلك: “هذه العوارض الطارئة وأشباهها مما يقع للمكلفين من أنواع المشاق هي مما يقصدها الشارع في أصل التشريع: أعني أن المقصود في التشريع، إنما هو جار على توسط مجرى العادات، وكونه شاقا على بعض الناس، أو في بعض الأحوال مما هو على غير المعتاد لا يخرجه عن أن يكون مقصودا له[5].”
وإذا كانت المشقة المعتادة والخفيفة واضحة في كونها لا تعتبر سببا للتخفيف، فإن المشقة الفادحة والشديدة واضحة في كونها تستدعي التخفيف، بل إنها في هذه الحالة وحيث تصل إلى حد يخاف معه الهلاك فإنه يحرم حينذاك القيام بالفعل الشاق، بل إن من الفقهاء من يذهب إلى أنه لا يجزئ المكلف ذلك العمل إن قام به؛ وهو ما حكاه الشاطبي عن مالك والشافعي؛ لأن المكلف عاص بفعله في هذه الحال ومعلوم أن المعصية لا يتقرب بها. وإن كان الشاطبي قد خالفهما الرأي فرجح الإجزاء[6]. بينما لم يقطع أبو حامد الغزالي بالإجزاء أو عدمه حيث ذكر أن فعل المكلف في هذه الحال يحتمل الإجزاء وعدمه[7].
على أن هناك إشكالا عمليا يطرح بالنسبة للمشقة الواقعة بين المرتبتين؛ أي بين المشقة الخفيفة والمشقة الشديدة، من حيث الضابط الذي تنضبط به، والواقع أن هذه المرتبة من المشاق يصعب إلحاقها بإحدى المرتبتين كما يصعب إطلاق معيار خارجي تنضبط به، ومن ثمة اختلفت أنظار الفقهاء في تحديد ضابطها، ولعل أقرب الآراء إلى الصواب في هذه القضية ما ذهب إليه الإمام الشاطبي حيث جعل المشقة إضافية لا أصلية: بمعنى أن كل مكلف فقيه نفسه في تحقق المشقة أو عدم تحققها، ما لم يحد فيها حد شرعي فيوقف عنده؛ لأن أسباب الرخص إضافية: أي أن المشقة الواحدة تعتبر في شخص دون آخر بحسب اختلاف الأحوال والأزمان وغير ذلك، فلا تدخل أسبابها تحت قانون أصلي لا يختلف باختلاف الناس[8].
ويؤيد هذا التوجه ما نقل عن أعلام أئمة السلف؛ من ذلك قول مالك في المرض المبيح للفطر “أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ ذلك منه؛ فإن له أن يفطر، وكذلك المريض إذا اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه (…) صلى وهو جالس ودين الله يسر[9].” فليس في كلام مالك تحديد ضابط للمشقة التي تبيح الإفطار للمريض، والتي تبيح له الانتقال من القيام إلى الجلوس في الصلاة، وإنما فيه نوع من التحديد توكل معرفة وجوده إلى المكلف المعني بالأمر.
ومن هذا القبيل أيضا ما ذكر الإمام الشافعي في قوله: “الحال التي يترك بها الكبير الصوم أن يكون يجهده الجهد غير المحتمل، وكذلك المريض والحامل[10]“، ومثل هذا ما جاء عن الإمام أحمد بن حنبل حيث سئل: “متى يفطر المريض؟ قال: إذا لم يستطع[11]“؛ ففي كلا هذين القولين لم يتم أيضا تحديد ضابط المشقة في نفسه، وإنما وكل أمره إلى المكلف الذي يحس من نفسه عدم القدرة على الصيام؛ ومن ثمة يرخص له الفطر.
ولما ثبت لدينا أن المكلف هو المسؤول عن تحديد درجة المشقة التي وجدها في عمل معين؛ فإن العمل الذي تجاوزت مشقته معتاد الإنسان يسقط عنه أو يؤخر إلى أن تزول المشقة، عملا بالقاعدة الفقهية: “المشقة تجلب التيسير[12].” على أنه لا يجوز للمكلف أن يتجاوز حد التخفيف الذي وضعه الشارع في عمل معين من أجل ما عرض فيه من مشقة، كأن يتعمد إخراج الصلاة عن وقتها في حال السفر متعللا بالمشقة، ومعلوم أنه إنما رخص له الشارع في هذه الحال القصر والجمع بين الصلاتين.
وهذا المنحى الذي أثبتناه في تحديد ضابط المشقة التي تبيح التخفيف، وأشرنا إلى أنه يتأيد بكون المشقة تختلف باختلاف المكلفين وأحوالهم؛ لأن مشقة عمل ما قد تكون غير معتادة لبعض الناس وتكون معتادة في حق البعض الآخر، يتأيد كذلك بكون المشقة تختلف أيضا باختلاف رتب العبادات؛ ذلك أنها ليست على مقياس واحد في كل الأعمال؛ فقد تكون معتادة في بعض الأعمال لكنها في أعمال أخرى تكون غير معتادة؛ فمثلا مشقة المخاطرة بالنفس مشقة غير معتادة في الصلاة والصيام بينما تعتبر مشقة معتادة في الجهاد. وبالنظر في هذه المسألة يتبين أن مناط اختلاف المشقات باختلاف رتب الأعمال؛ يعود إلى الموازنة بين الضرر الذي يحصل عن مشقة عمل ما وبين مصلحة العمل الذي نتجت عنه تلك المشقة.
ومما يدل على اختلاف المشاق باختلاف رتب العبادات أن الشارع قسم الأعمال المطلوبة إلى فرائض ومندوبات ونوافل، ولم يتساهل في أداء الفرائض نظرا لأهميتها، فلم يلتفت إلى ما في المحافظة عليها من مشقة بالتخفيف ونحوه من الرخص ما لم تكن تلك المشقة كبيرة وخارجة عن المعتاد، ولم يجعل المندوبات في مرتبة الفرائض تخفيفا عن الناس ومراعاة لضعفهم، واكتفى بترغيبهم في النوافل لما في فرضها من مشقة.
وتظهر فائدة التقسيم المذكور للأعمال المطلوبة شرعا في تحديد المعيار الذي يهتدى به لإدراك ما يكون من المشاق مؤثرا في التخفيف؛ وهو ما نجده عند عز الدين بن عبد السلام حيث نص على النظر في مدى اهتمام المشرع بالعمل، فكلما اشتد اهتمام الشرع بعبادة من العبادات أو عمل من الأعمال شرط لأجل تخفيف تلك العبادة أو ذلك العمل وجود مشقة شديدة وعامة، في حين إذا لم يهتم به كثيرا جاز تخفيفه بالمشاق الخفيفة، على أنه قد تخفف مشاق العمل مع شرفه وعلو مرتبته لتكرر مشاقه كي لا يفضي إلى مشاق عامة كثيرة الوقوع[13].
وبالتأمل في اهتمام الشارع الحكيم بالمطلوبات الشرعية نجده يتفاوت بالنظر إلى بعض الاعتبارات التي يمكن إجمالها في:
ـ التمييز بين العبادات وغيرها؛ فالغالب أن تقدير المشقة في العبادات يختلف عن تقديرها في غيرها من العادات والمعاملات، وذلك راجع لاهتمام الشرع أكثر بمجال العبادات، ومن ثمة فلا يليق تفويتها أو الترخص فيها بمسمى المشقة مع إمكان احتمالها. وبالمقابل فإن المعاملات تراعى فيها حاجات الناس، ولذلك رخص الشرع في مجموعة من العقود التي يقتضي القياس منعها مراعاة لما يلحق الناس من عسر ومشقة لو لم يتم تشريعها.
ـ التمييز بين المأمورات والمنهيات؛ فاعتناء الشرع باجتناب المنهيات أشد من اعتنائه بإتيان المأمورات؛ فالمنهيات تجتنب بإطلاق أما المأمورات فيأتي منها المرء بقدر استطاعته، ولذلك يتم التخفيف في أداء الواجبات لمشقة لا يتم الترخيص في مثلها بالنسبة للمنهيات خاصة إذا كانت من الكبائر، وذلك راجع للقاعدة المقررة: “درء المفاسد أولى من جلب المصالح[14].”
ـ التمييز بين المقاصد والوسائل؛ حيث يتم النظر إلى المشقة من حيث كون الفعل مقصودا في نفسه أو وسيلة إلى غيره؛ ولذلك نص العلماء على أنه “يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد[15]“، فمن الوسائل الوضوء من أجل الصلاة والسفر لأداء الحج، ومن المقاصد نفس أفعال الصلاة ومناسك الحج.
2. رجوع رفع الحرج إلى الوسطية والاعتدال
إن اليسر ورفع الحرج في الشريعة يرجع في جوهره إلى خاصية الاعتدال والتوسط التي يمتاز بها هذا الدين وتعتبر من ألزم الصفات التي ينبغي على المسلمين مراعاتها؛ مصداقا لقول الله تعالى: “وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا” [البقرة: 142]، فالتوسط والاعتدال هو مصدر الكمالات والمثل العليا التي جاء بها الإسلام؛ ولذلك فإن اليسر والسماحة في هذا الدين ورفع الحرج عن الناس فيه، إنما يرجع في الحقيقة إلى الالتزام بسلوك سبيل الوسطية والاعتدال دون إفراط ولا تفريط.
وتأسيسا على ذلك وبناء أيضا على كون الشارع لا يقصد المشقة من حيث كونها مشقة، فإنه لا يجوز للمكلف أن يقصد فعل المشقة لمجرد كونها مشقة ليعظم بذلك أجره؛ لأنه بذلك يكون مخالفا لقصد الشارع، ومن ثمة لا يتحقق له حصول الأجر والثواب. وإنما يجوز له أن يقصد العمل الذي يتضمن مشقة من حيث هو عمل فيه مصلحة ويكثر أجره لا من حيث هو شاق، وهو ما عبر عنه ابن عبد السلام بقوله: “إذا اتحد الفعلان في الشرف والشرائط والسنن والأركان وكان أحدهما شاقا، فقد استويا في أجرهما لتساويهما في جميع الوظائف، وانفرد أحدهما بتحمل المشقة لأجل الله سبحانه وتعالى، فأثيب على تحمل المشقة لا على عين المشاق؛ إذ لا يصح التقرب بالمشاق؛ لأن القرب كلها تعظيم للرب سبحانه وتعالى، وليس عين المشاق تعظيما ولا توقيرا[16].”
وبهذا ندرك أنه لا يجوز للمكلف أن يعرض نفسه لمشقة في عبادة لا علاقة لها بتلك المشقة؛ كمن يلزم نفسه في الصيام بالبقاء تحت أشعة الشمس طول النهار؛ لأن ذلك مجرد تعذيب للنفس وتنطع ليس فيه تقرب إلى الله، بل يعتبر في هذه الحال معصية. ولذلك لما سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- بخصوص رجل رآه قائما في الشمس: ما بال هذا؟ فقالوا: نذر أن لا يتكلم ولا يستظل من الشمس ولا يجلس ويصوم، قال عليه الصلاة والسلام: “مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صومه[17].”
وعلى هذا النهج سار أئمة السلف في فتاويهم؛ ومن ذلك ما نجده عند الإمام مالك إذا نذر المكلف التقرب إلى الله تعالى بفعل فيه مشقة زائدة غير لازمة، فإنه يفتيه بفعل ما أراد من الطاعة مجردة عن تلك المشقة؛ فعلى سبيل المثال من قال: علي المشي إلى بيت الله حافيا راجلا، فإن مالكا يفتيه بأن ينتعل[18].
وبناء على ذلك نؤكد على أن التنطع والغلو والتشديد إنما هو إدخال للحرج في الدين بما يحمله من مضار، لعل أقربها حصول العسر في أداء التكاليف، وقد تصل أحيانا إلى إدخال الفساد على من سلك طريق التشديد والغلو، حتى يفضي به ذلك إلى كراهية التكليف الشرعي، أو إهمال بعض الواجبات والتقصير الكبير في أدائها والانشغال عنها، بسبب غلوه ومبالغته في الاهتمام بغيرها من الأعمال التي قد تدخل في الواجبات أيضا أو في مجرد المندوبات.
كما أننا نقرر بالمقابل أن التساهل والتفريط والتقصير في القيام بالتكاليف الشرعية وأداء الواجبات التي على المكلف؛ يفضي إلى تعطيل مصالح العباد العاجلة والآجلة، وبالتالي عدم تحقق مقاصد الشرع من تشريع أحكامه. ومعلوم أن مبدأ اليسر ورفع الحرج لا يعني التهاون والتقصير في أداء التكاليف أو التنصل منها؛ لأن ذلك ينقلب نفسه حرجا على الناس لما قلنا من إفضائه لتعطيل مصالحهم.
ويجدر التنبيه هنا على أنه لا يعتبر مفرطا ومقصرا في القيام بالتكاليف من قارب الوجه المطلوب؛ لأن من مظاهر اليسر في الشريعة الإسلامية أن ما يطلب فعله أو تركه على نحو أو قدر معين فيأتي به المكلف بما يقارب الوجه المطلوب، فإن ذلك يعتبر كافيا ومجزئا، مع مراعاة ما تدل عليه القاعدة الفقهية أن “الميسور لا يسقط بالمعسور[19]“، وهذا يعني أنه كلما كان إتمام المطلوب في التكليف والإتيان به على أصله أو قريب منه متيسرا للمكلف كان عليه الإتيان بذلك؛ بما لا يؤدي إلى التوسع في اليسير المغتفر من غير حاجة، وبما يراعي الحفاظ على تحقيق المقاصد المشروعة.
وإذا كان ما قررناه هنا بالنسبة لنبذ الاتجاهين وضرورة التمسك بنهج الوسط والاعتدال؛ هو المبدأ والأصل العام الذي يتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية ويحقق مقاصدها في ضوء المفهوم الصحيح لليسر ورفع الحرج، فإن هناك بعض الحالات الاستثنائية التي تتطلب الميل إلى جانب التشديد أو الميل إلى جانب التخفيف كلما دعت الحاجة إلى ذلك، حيث يكون التشديد هو المناسب حين يغلب في الواقع التهاون والانحلال، وبالمقابل يلجأ إلى التخفيف حين يلاحظ الجنوح إلى التضييق والتشديد.
وقد قرر الشاطبي قديما هذه القاعدة الهامة في الدين بقوله: “إذا نظرت في كلية شرعية فتأملها تجدها حاملة على التوسط، فإن رأيت ميلا إلى جهة طرف من الأطراف فذلك في مقابلة واقع أو متوقع في الطرف الآخر؛ فطرف التشديد، وعامة ما يكون في التخويف والترهيب والزجر، يؤتى به في مقابلة من غلب عليه الانحلال في الدين، وطرف التخفيف، وعامة ما يكون في الترجية والترغيب والترخيص، يؤتى به في مقابلة من غلب عليه الحرج في التشديد، فإذا لم يكن هذا ولا ذاك رأيت التوسط لائحا ومسلك الاعتدال واضحا؛ وهو الأصل الذي يرجع إليه والمعقل الذي يلجأ إليه[20].”
3. رفع الحرج وسيلة لتحقيق الامتثال لأحكام الشرع
إن اليسر ورفع الحرج مع كونه عاما وشاملا لكل أحكام الشرع وتعاليمه إلا أنه ليس غاية مقصودة في ذاته، وإنما هو وسيلة مساعدة على تحقيق الغاية المتمثلة في الانصياع لشرع الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، كما يفيد ذلك معنى الإسلام: أي الاستسلام لله وشرعه بطاعته تحقيقا للعبودية له تعالى وحده، بما يكفل تحقيق مقاصد شرعه في جلب المصالح للعباد ودرء المفاسد عنهم.
ولذلك نبهت كثير من الآيات القرآنية على هذا المعنى بذكر الصلاح في معرض مدح أهله والحث عليه وذكر الفساد في سياق ذم أهله والتحذير منه؛ والأمر بالحفاظ على صلاح العالم الذي يعيش فيه الإنسان والتحذير من السعي في إفساده[21]. مما يدل على أن المقصد العام من التشريع هو حفظ نظام الأمة والعالم واستدامة صلاحه بصلاح الإنسان المستخلف فيه؛ بحيث يشمل ذلك الصلاح عقل الإنسان وعمله وما بين يديه من موجودات العالم الذي يعيش فيه[22]، ومن ذلك كما لا يخفى صلاح جوانب العقيدة والعبادات والمعاملات وجميع شؤون الحياة؛ بما يحقق الإعمار البناء في الأرض.
ومن ثمة فإن اليسر ورفع الحرج إذا انقلب غاية في نفسه فإنه سيؤدي تدريجيا إلى الابتعاد عن الشرع والانسلاخ من أحكامه بعدم الاهتمام بأداء الواجبات بالكيفية المطلوبة شرعا، سواء تعلق الأمر بمجال العبادات أو بمجال المعاملات. كما أن ذلك سيفضي إلى التهاون في الالتزام بحدود الحلال والحرام في مجالات الأطعمة والأشربة والألبسة والمعاملات المالية وغيرها بدعوى اليسر ورفع الحرج في الدين، ولا يخفى أن هذا تحريف للمفهوم الحقيقي لليسر ورفع الحرج، وخطأ كبير في الفهم وضلال عن سبيل الحق.
وبناء على ذلك، فإن سماحة الشريعة الإسلامية وما تضمنته من رخص تخفيفا وتيسيرا على العباد ينبغي أن لا نجعلها تطغى على المقصد العام من التشريع المتمثل، كما رأينا، في إصلاح الإنسان والعالم الذي يعيش فيه في كافة المجالات. فلا يجوز أن تنقلب الوسائل إلى مقاصد؛ فالرخص إنما تعتبر وسائل فلا يجوز أن نجعلها غايات في ذاتها فتتغلب على الغايات الحقيقية، وتصير بالتالي عائقا أمام تحقق تلك المقاصد التي حددها الشارع الحكيم.
ولما كان مبدأ اليسر ورفع الحرج ليس غاية مقصودة في ذاته، وإنما هو وسيلة مساعدة على تحقيق مقصد الامتثال لأوامر الله واجتناب نواهيه، فإن هذا المبدأ لا يعني تتبع الرخص؛ لأنه ينبغي أن يكون عند المكلف وازع ذاتي يدفعه إلى الالتزام بأحكام الشرع؛ فلا يجيز لنفسه الأخذ ببعض الرخص التي لا يسوغ له شرعا الإقدام عليها.
ومما يؤكد هذا المعنى استحضار مدلول الرخصة في الاصطلاح؛ ومن أحسن تعاريفها أنها “ما شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلي يقتضي المنع مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه[23].” فالرخصة، إذن، حكم شرعي وجد لرفع الحرج عن المكلف، وهو حكم مستثنى من حكم عام أصلي، ومن ثمة يزول ذلك الحكم العارض ويعود الحكم الأصلي بزوال العذر الذي ألجأ إلى الرخصة.
وإذا كان المطلوب الاقتصار في الأخذ بالرخصة على موضعها كما أشرنا؛ فإن هذا لا يعني الاقتصار على الرخص المنصوص عليها، بل يجوز القياس عليها، كما نبه على ذلك محمد الحجوي بقوله: “قال العلماء: الرخصة لا تتعدى محلها، وليس معناه أن الرخصة لا يقاس عليها، بل يقاس عليها إذا توفرت شروط القياس وزالت موانعه، خلافا لمن يزعم عدم القياس عليها أصلا فهو مخالف للأصول[24]“؛ ولذلك نجد العلماء قاسوا عدم القدرة على استعمال الماء لعجز أو مرض على عدم وجوده الذي ورد النص عليه في القرآن بقوله تعالى: “فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا” [النساء: 43] [المائدة: 7].
ويترتب على جواز القياس على محال الرخص أنه يجوز أيضا القياس على محال الضرورات، وإنما وقع الخلاف بين العلماء في القياس على محال الضرورات بسبب الخلاف في وجود كل معاني الأشياء المنصوص عليها في الضرورات: أي مدى توفر العلل أو عدم توفرها.
ورغم الاتفاق على مبدإ الأخذ بالرخص في محالها رفعا للحرج عن المكلف، فإن العلماء اختلفوا في الترجيح بين الأخذ بالعزيمة والأخذ بالرخصة؛ فالذين رجحوا الأخذ بالعزيمة نظروا إلى أن علة الترخيص هي نفس المشقة، فإذا انتفت المشقة عاد الأمر إلى الأصل وهو العزيمة. أما الذين رجحوا الرخصة فإنهم أنزلوا مظنة العلة منزلة نفس العلة؛ فمثلا الإفطار في السفر شرع لعلة مشقة الصيام فيه، فمن ربط الإفطار بمظنة المشقة؛ (أي السفر) رأى رخصة الإفطار مطلقا سواء وجدت المشقة في ذلك السفر أم لم توجد، ومن ربط الإفطار بالعلة الأصلية وهي المشقة ذهب إلى أنه إذا انتفت المشقة فالصيام أولى عملا بالعزيمة[25].
والواقع أن المفاضلة بين الأخذ بالعزيمة والأخذ بالرخصة مجال واسع للاجتهاد، فأحيانا تكون العزيمة أولى وأحيانا تكون الرخصة أولى حسب اختلاف الأحوال، كما يمكن أن يرى المجتهد التسوية بينهما.
على أن الذي ينبغي استحضاره في هذا المقام أن الأخذ بكل من العزيمة والرخصة في محلهما أمر مطلوب طاعة لله تعالى؛ ولذلك فمن ترك الرخصة وأخذ بالعزيمة ردا للرخصة التي وضعها الشارع فتركه حينذاك للرخصة مخالف للشرع، وأما من أخذ بالرخصة وقصد بالترخص قبول تفضل الله تعالى عليه وتطبيق السنة فأخذه بالرخصة حينئذ موافق للشرع.
وفي هذا المعنى قال الشافعي: “أكره ترك القصر وأنهى عنه إذا كان رغبة عن السنة فيه، وأكره ترك المسح على الخفين رغبة عن السنة فيه، ومن ترك المسح على الخفين غير رغبة عن السنة لم أكره له ذلك[26].”
ويزيد هذا المعنى وضوحا ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: “إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه[27]“؛ فهذا الحديث يدل على أنه “ينبغي استعمال الرخصة في مواضعها عند الحاجة لها سيما العالم يقتدى به، وإذا كان من أصر على مندوب ولم يعمل بالرخصة فقد أصاب منه الشيطان، فكيف بمن أصر على بدعة، فينبغي الأخذ بالرخصة الشرعية، فإن الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع[28].”
وإذا كان المطلوب من المكلف، كما رأينا، الاقتصار في الأخذ بالرخص على مواضعها لكي لا يتم إخراجها عن الغاية من تشريعها حفاظا على تحقق مقاصد الشرع من التشريع؛ فإنه حفاظا على تلك المقاصد أيضا ينبغي للمكلف انطلاقا من وازعه الذاتي أن لا يلتجئ إلى التدليس والتلبيس على المفتي عند استفتائه؛ فلا يحكي له النازلة ناقصة أو على غير حقيقتها ابتغاء الحصول على فتوى تتضمن تخفيفا ورخصة؛ لأنه يعلم أن المفتي إنما يجيبه على نحو ما يسمع من سؤاله وما يحكيه له من وقائع.
كما أن المكلف عندما يكون لديه وازع من نفسه فإنه يتورع عن تتبع رخص المذاهب؛ لأن من يسعى في تتبع تلك الرخص في عباداته ومعاملاته ويتحرى إتيان الأخف والأسهل، ولا ينظر في الدليل الذي يستند إليه ويعلم قوته ورجحانه فإنما هو في الحقيقة متبع لأهواء نفسه، ومعلوم أن الشريعة جاءت بإخراج الناس عن اتباع أهوائهم؛ ولذلك فالأليق بالمسلم، خاصة إذا لم يكن من أهل الاجتهاد في الشريعة، أن يلتزم في مواضع الخلاف بالمذهب المتبع، ولا يجعل مطلقا من اختلاف الأئمة ذريعة لتصيد الرخص التي يجدها عند بعضهم في كل مسألة مختلف فيها.
وإذا كان تتبع الرخص أمرا مذموما وغير جائز بجميع صوره وأشكاله التي أشرنا إلى أبرزها، فإن ذلك راجع إلى ما في تتبعها من مفاسد؛ منها ما ذكره الشاطبي في إطار بيانه لجملة من مفاسد اتباع رخص المذاهب؛ وذلك كالانسلاخ من الدين بترك اتباع الدليل إلى اتباع الخلاف، وكالاستهانة بالدين؛ إذ يصير بهذا الاعتبار سيالا لا ينضبط فلا يحجر النفوس عن هواها ولا يقفها عند حد، وكانخرام قانون السياسة الشرعية التي يندرج فيها كل ما شرع لسياسة الناس وزجر المعتدين وإقامة الحق؛ حيث يتم ترك الانضباط فيها إلى أمر معروف، وكإفضائه إلى القول بتلفيق المذاهب على وجه يخرق إجماعهم؛ بحيث يجمع في نفس المسألة الأخذ برخصتين أو أكثر من مذهبين مختلفين أو أكثر، وغير ذلك من المفاسد التي يكثر تعدادها[29].
4. ضوابط الضرورة ورفع الحرج
تعتبر حالة الضرورة في الإطلاق الشرعي أشد من حالة الحاجة والحرج؛ لأن الضرورة تعني “خوف الهلاك أو الضرر الشديد على أحد الضروريات للنفس أو الغير يقينا أو ظنا إن لم يفعل ما يدفع به الهلاك أو الضرر الشديد[30].” ولذلك فالمكلف الذي وقع في الضرورة يكون له من الرخص والأحكام الاستثنائية أكثر ممن كان واقعا في الحرج، على أنه كثيرا ما يطلق الفقهاء لفظ الضرورة على ما يشمل الحاجة التي يصدق على صاحبها الوقوع في الحرج، وهو ما درج عليه أيضا العديد من عامة الناس في كلامهم عن هذا الموضوع في العصر الراهن. وكثيرا ما يطلق على الحاجة الناتجة عن حالة الحرج ضرورة مجازا باعتبار المآل إذا استمرت، ولذلك فإن الحاجة تنزل منزلة الضرورة. ومن ثمة يكون من المفيد هنا بيان أهم ضوابط الضرورة الشرعية استكمالا لما يتطلبه توضيح المعايير الضابطة للأخذ بمبدإ رفع الحرج.
والملاحظ أنه كثيرا ما يتم اللجوء من طرف بعض الناس في هذا العصر إلى استحلال محرمات بدعوى الضرورة واستنادا إلى مبدإ التيسير ورفع الحرج في غير محله. ولعل من أهم العوامل والأسباب التي أدت إلى ظهور وتفشي هذا الاتجاه في التعامل مع أحكام الشرع؛ ما عرفه العصر الراهن من مسائل مستجدة خاصة في مجال المعاملات المالية بصفة عامة والمصرفية منها على وجه الخصوص، وكذا بعض المسائل الجديدة المرتبطة بالتقدم العلمي عامة والطبي منه خاصة، وهي مسائل تتميز في كثير من الحالات بنسبة من التعقيد تتفاوت قوة وضعفا. ويضاف إلى هذا العامل سوء فهم مبدإ التيسير ورفع الحرج في الشريعة من طرف العديد من الناس الذين يسلكون في حياتهم هذا المسلك الخاطئ. كما أن من العوامل التي تدعم الأخذ بالضرورة في غير محلها انسياق بعض العلماء والمفتين مع هذا التوجه رغبة منهم في تحبيب الشرع وأحكامه إلى نفوس الناس. بالإضافة إلى سوء فهم أصحاب هذا الاتجاه من عامة الناس لبعض القواعد المشهورة؛ كالقاعدة الفقهية التي تقرر أن “الضرورات تبيح المحظورات[31]“، وقاعدة تغير الأحكام بتغير الأزمان والأحوال، التي صاغها الفقهاء بعبارة أدق بقولهم: “الأحكام المترتبة على العوائد تتبع العوائد وتتغير عند تغيرها[32]“، مما يؤدي أحيانا من طرف البعض إلى إخضاع أحكام الشريعة لظروف العصر والخروج عن نصوص الشريعة ومقاصدها وقواعدها الثابتة.
وإذا كان من المسلم به أنه لا يجوز أن تستحل بعض المحرمات بدعوى الضرورة وأخذا بمبدإ التيسير ورفع الحرج في غير محله؛ فإنه ينبغي -دفعا للالتباس الحاصل في الموضوع وتصحيحا للفهم الخاطئ- الوقوف على أبرز ضوابط الضرورة المعتبرة التي ينبغي مراعاتها عند النظر في الضرورة والإفتاء والعمل بناء عليها، والتي يخفف التكليف بمقتضاها وينتقل من الحكم الأصلي إلى الحكم الطارئ استنادا عليها؛ ويمكن إيجازها فيما يلي:
أن تكون الضرورة مندرجة ضمن المقاصد التي جاء الشرع لتحقيقها؛ فإذا كان التيسير والأخذ بالأخف يخل بأحد مقاصد الشرع أو يتعارض مع ما دلت عليه نصوصه فلا ينبغي اعتباره والالتفات إليه؛ لأن في الأخذ به حينئذ مخالفة للشريعة وإفتاء وعملا بناء على الضرورة في غير محلها، ولذلك لابد من شهادة الشرع للضرورة بالاعتبار لكي يتم الترخيص بناء عليها. فالمصلحة المترتبة عن الأخذ بالضرورة إما أن تكون من المصالح التي ألغاها الشارع فلا تعتبر، وإما أن تكون من المصالح التي اعتبر الشارع عينها أو جنسها فهذه تعتبر باتفاق العلماء. ولذلك نص الغزالي على أن “كل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فهم من الكتاب والسنة والإجماع، وكانت من المصالح الغريبة التي لا تلائم تصرفات الشرع فهي باطلة مطرحة، ومن صار إليها فقد شرع[33].”
كما أنه لابد أن تكون الضرورة متحققة لا متوهمة؛ ويتبين ذلك بأن تكون متيقنة أو مظنونة ظنا قويا، وبأن لا يتمكن المرء من الخلاص منها بأي وجه مشروع دون الأخذ بالرخصة؛ فإن كثيرا من الناس يتوهمون أحيانا أنهم في حال ضرورة والواقع أنهم ليسوا في ضرورة. وقد نبه الشاطبي قديما على هذه الآفة وحذر من الوقوع فيها حيث ذكر أن أسباب الرخص أكثر ما تكون متوهمة لا محققة، فربما عدها المرء شديدة وهي خفيفة في نفسها، فأدى ذلك إلى عدم صحة التعبد وصار عمله ضائعا وغير مبني على أصل، وكثيرا ما يشاهد الإنسان ذلك؛ فقد يتوهم الأمور صعبة وليست كذلك إلا بمحض التوهم، ولو تتبع الإنسان الوهم لرمى به في مهاو بعيدة ولأبطل عليه أعمالا كثيرة وهذا مطرد في العادات والعبادات وسائر التصرفات[34].
أن لا يؤدي رفع الضرورة إلى وقوع ضرورة أكبر منها أو مثلها؛ ومدلول هذا الضابط يرجع إلى الترجيح بين مصلحتين ومفسدتين متعارضتين في ضرورتين مجتمعتين، بجلب أعظم المصلحتين والتخلي عن أصغرهما وبدرء أكبر المفسدتين وارتكاب أخفهما؛ وهو المعنى الذي أشار إليه ابن عبد السلام في إطار كلامه عن تفاوت المصالح والمفاسد مبينا “أن تقديم أرجح المصالح فأرجحها محمود حسن، وأن درء أفسد المفاسد فأفسدها محمود حسن، وأن تقديم المصالح الراجحة على المرجوحة محمود حسن، وأن درء المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة محمود حسن[35].” ومن أهم المعايير المساعدة على تطبيق هذا الضابط؛ النظر في النصوص الشرعية لإدراك مراتب المصالح ومراتب المفاسد، وتحديد انتمائها إلى أحد الكليات الخمس، مع معرفة آثارها المستقبلية وما تؤول إليه، بما يمكن من الترجيح بين ما تعارض منها.
كما أنه لابد أن تقدر الضرورة بقدرها؛ لأن الحكم الذي يعتمد عليها إنما هو حكم طارئ تم الترخيص به في تلك الحالة خاصة، وأما الحكم الذي كان قبل حدوث الضرورة فهو الحكم الأصلي الثابت، والمشرع لم يجز اللجوء إلى الحكم الطارئ وترك الحكم الأصلي إلا رحمة بعباده لكي لا يكلفهم ما يعنتهم وهم في حال ضرورة؛ ومن ثمة فبمجرد زوال الضرورة يزول الحكم الطارئ ويعود الحكم الأصلي. بل إنه في حال الضرورة ينبغي عدم تجاوز الحد فيما تم الترخيص به أيضا؛ لكي لا يقع المضطر في البغي والعدوان وتعدي الحدود بخروجه عن ضوابط الضرورة؛ لأن من شروط الأخذ بحكمها عدم البغي والعدوان كما نبه على ذلك الله تعالى بقوله: “فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه” [البقرة: 172].
ومن لوازم تقدير الضرورة بقدرها وعدم البغي والعدوان في الأخذ بالحكم المرخص به بناء عليها أن يعمل المرء ما في وسعه ويسعى جاهدا في إزالة ضرورته ولا يركن إليها لما ينتج عن ذلك من استثقال للحكم الأصلي أو نسيانه، حتى أنه قد يتوهم صاحب هذه الحالة أن حكم الضرورة هو الأصل، ومن ثمة نجد أن الشارع جعل في جملة من التخفيفات ما يذكر بالحكم الأصلي؛ كما هو الشأن في تشريعه للتيمم مثلا ليذكر بالأصل الذي هو الوضوء.
وقد نبه على هذا المعنى ولي الله أحمد الدهلوي حيث قرر أنه إذا منع من المأمور به مانع ضروري وجب أن يشرع له بدل يقوم مقامه؛ لأن المكلف حينئذ بين أمرين: إما أن يكلف به مع ما فيه من المشقة والحرج وذلك خلاف موضوع الشرع، وإما أن ينبذ وراء الظهر بالكلية فتألف النفس بتركه وتسترسل مع إهماله… ثم بين أنه ينبغي أن يلتزم في البدل شيء يذكر الأصل ويشعر بأنه نائبه وبدله، وسره تحقيق الغرض المطلوب من شرع الرخص؛ وهو أن تبقى الألفة بالعمل الأول وأن تكون النفس كالمنتظرة[36].
خاتمة
وختاما نشير إلى أن مسلك التيسير ورفع الحرج الذي انتهجه الشرع في أحكام الشريعة يعتبر مظهرا جليا لكون هذه الشريعة موافقة للفطرة التي جبلت عليها نفوس الناس، ومعلوم أن من الفطرة النفور من المشقة غير المعتادة وما فيها من إعنات، فكان الشارع مراعيا لرفع الحرج عن المكلفين بما يوافق فطرتهم، كما تجلى ذلك في مظهرين أساسيين:
أحدهما؛ أن أحكام الشريعة المعينة بنيت في جملتها على التيسير مصداقا لقول الله تعالى: “وما جعل عليكم في الدين من حرج” [الحج: 76]. والثاني؛ أن هذه الشريعة تنتهج نهج تغيير الأحكام من الصعوبة والمشقة إلى السهولة والتيسير فيما يعرض للفرد أو الجماعة من عسر وضيق من باب الرخصة؛ ولذلك كان من القواعد الشرعية المقررة قاعدة “المشقة تجلب التيسير[37].”
وإذا كان من المقرر أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، فإن اليسر والسماحة فيها من الأمور الهامة والأساسية التي جعلتها عامة ودائمة، لما منحها ذلك من سهولة في امتثالها بين الأمة أفرادا وجماعات؛ لموافقتها لنفوس الناس وتحقيقها لمصالحهم في يسر واعتدال. فكان على المسلمين امتثال تشريعات هذا الدين الحنيف في إطار الفهم والإدراك الصحيح لمفهوم اليسر ورفع الحرج فيه، كما مر بيانه ضمن القواعد والضوابط والملاحظات والتنبيهات السابقة؛ تحقيقا لتطبيقهم السليم لسماحة ويسر الدين الإسلامي في الواقع، بما يعزز ويدعم تمسكهم أكثر به، ويساعد في نفس الوقت على انتشاره بين سائر الناس وإقبالهم عليه.
الهوامش
1. انظر: صالح بن عبد الله بن حميد، رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ضوابطه وتطبيقاته، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة ط 1، 1403ﻫ، ص47، وقد ذكر في تعريفه أن المشقة الزائدة تكون “في البدن أو النفس أو المال”، حيث جعل النفس مختصة بالآلام النفسية، والواقع أن المشقة التي تكون في النفس تشمل الآلام البدنية أيضا لشمول لفظ “النفس” للبدن كذلك، ولذلك لم أذكر البدن في التعريف؛ لأنه داخل في النفس.
2. أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات في أصول الشربعة، بيروت: دار المعرفة، لبنان، ج2 ص123.
3. أخرجه ابن ماجه؛ كتاب الطب، باب: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء.
4. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإيمان، باب: الدين يسر: حديث 39.
5. انظر: الموافقات، ج1، ص322.
6. انظر: الموافقات، ج2، ص142.
7. انظر: أبو حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، بيروت: دار صادر، ج1 ص91.
8. انظر: الموافقات، ج1، ص314-318.
9. الإمام مالك، الموطأ، كتاب الصيام، باب: ما يفعل المريض في صيامه، القاهرة: دار الحديث، ج1 ص250.
10. الإمام الشافعي، الأم، دار الشعب، ج2، ص81.
11. ابن قدامة، المغني، مكتبة القاهرة، ج2، ص155.
12. انظر هذه القاعدة: علي أحمد الندوي، القواعد الفقهية، دمشق: دار القلم، ط1، 1986م، ص265، وانظر: د. محمد الروكي، نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء، منشورات كلية الآداب بالرباط، ط1، 1994م، ص92 و326.
13. عز الدين بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، دار الجيل ط2، 1980م، ج2 ص11.
14. انظر هذه القاعدة: السيوطي، الأشباه والنظائر في قواعد فقه الشافعية، مصر: دار إحياء الكتب العربية، ص97، والقواعد الفقهية ص170.
15. انظر هذه القاعدة في: الأشباه والنظائر، ص175، ومن القواعد الدالة على التمييز بين المقاصد والوسائل؛ قاعدة: “الوسائل أبدا أخفض من المقاصد إجماعا” ويعبر عنها أيضا بـ: “مراعاة المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل أبدا”، انظر هذه القاعدة بصيغتيها في: القواعد الفقهية، ص116 و163.
16. قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ج1، ص36.
17. أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب العلم، باب: النهي عن اتباع متشابه القرآن، وأبو داود في سننه: كتاب السنة، باب: في لزوم اتباع السنة.
18. انظر: الإمام مالك، المدونة الكبرى، (رواها سحنون عن ابن القاسم عن مالك)، بيروت: دار صادر، ج3 ص83.
19. انظر هذه القاعدة في: الأشباه والنظائر، ص159، والقواعد الفقهية، ص283، ونظرية التقعيد الفقهي، ص100.
20. الموافقات، ج 2 ص167-168.
21. من ذلك قول الله عز وجل حكاية عن رسوله شعيب وتنويها به: “إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب” [هود: 88]، ومن ذلك أيضا قوله تعالى: “وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين” [الاعراف: 142]، وقوله سبحانه: “ولا تفسدوا في الاَرض بعد إصلاحها” [الاعراف: 55 و84]، وقوله تعالى في بيان حال بعض المفسدين: “وإذا تولى سعى في الاَرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد” [البقرة: 203].
22. انظر: محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، الشركة التونسية للتوزيع ط3، 1988، ص63.
23. الموافقات، ج1 ص301.
24. محمد بن الحسن الحجوي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، مكتبة العلمية، المدينة المنورة ط1، 1396ﻫ، ج2 ص409-410.
25. انظر: المغني، ج3 ص151 والموافقات، ج1 ص345.
26. الأم، ج1 ص159.
27. أخرجه بألفاظ متقاربة؛ أحمد في مسنده عن ابن عمر، والبيهقي في السنن عنه أيضا، والطبراني في الكبير عن ابن مسعود.
28. محمد عبد الرؤوف المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير، مطبعة مصطفى محمد القاهرة ط2، ج2 ص293.
29. الموافقات، ج 4 ص147-148.
30. جميل محمد بن مبارك، نظرية الضرورة الشرعية حدودها وضوابطها، المنصورة دار الوفاء، ط1، 1988م، ص28.
31. انظر هذه القاعدة في: القواعد الفقهية، ص270، ونظرية التقعيد الفقهي، ص92.
32. انظر هذه القاعدة: شهاب الدين القرافي، الفروق، بيروت: دار المعرفة، ج3 ص29.
33. المستصفى، ج1 ص310-311.
34. الموافقات، ج1 ص131.
35. قواعد الأحكام، ج1 ص5.
36. ولي الله الدهلوي، حجة الله البالغة، بيروت: دار الكتب العلمية، لبنان ط1، 1995م، ج1 ص193-194.
37. انظر هذه القاعدة في: القواعد الفقهية، ص265، ونظرية التقعيد الفقهي، ص92 و326.