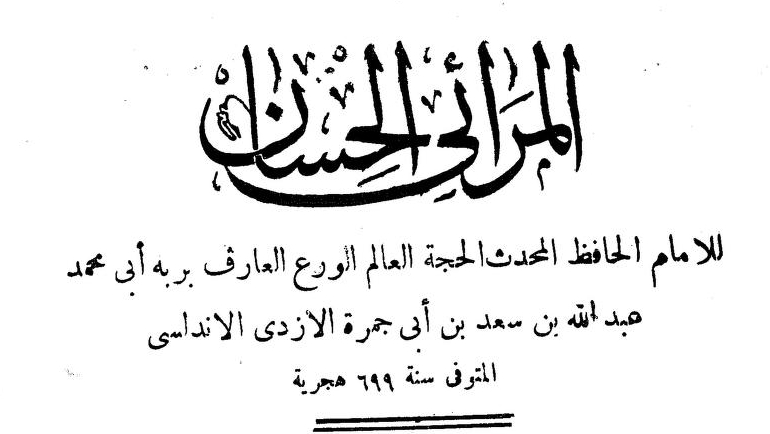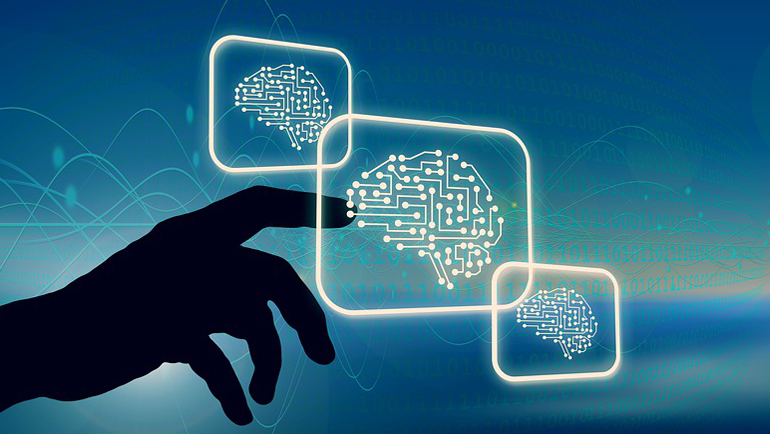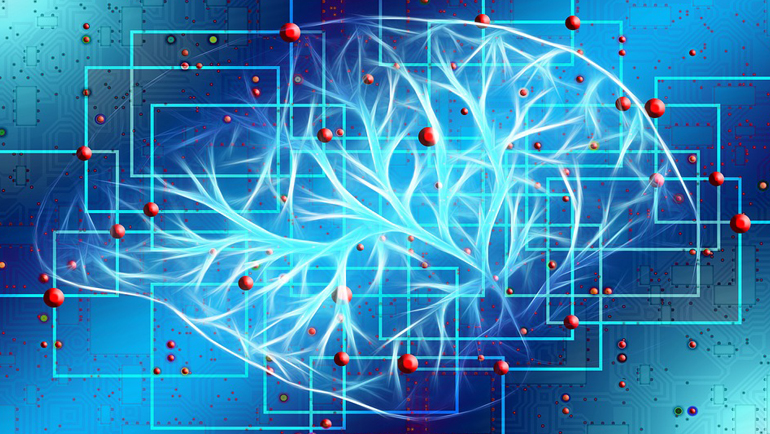ترتد أكثر الألفاظ الدارجة إلى أصول عربية بحتة، لكن اعتراها مع كثرة التداول أنماط من النحت والتغيير، والحذف والإسقاط، اقتضاها مبدأ التخفيف، الذي هو آلية تخدم الغرض التواصلي للغة، فالأكثر استعمالا هو الذي يكون عرضة لضروب من التخفيف في البنية والصوت والدلالة والتركيب.
وإذا كانت الدارجة تنتسب إلى العربية، انتساب الفرع لأصله، فإن منزلتها منها منزلة الخادم من المخدوم، والتابع من المتبوع، ذلك أن العربية في نسقها الفصيح، تفرض على الناطق بها الالتزام بمكونها القاعدي والتركيبي، وفي الالتزام كلفة، وما أسرع ما يطلب الناس التخفف ويركنون لما كان سهلا يسيرا، وينزعون منزع الترخص، وتلك عادة مستحكمة فيهم.
فلهذا تنزع الدوارج إلى ضروب من التخفيف والترخص في البينة اللغوية الفصيحة، محافظة بذلك على الحد الأدنى من الالتزام اللغوي.
ثم إنه مهما علت رتبة الخادم والتابع، فإنها مبنية على هذه الصفة فيه، صفة الخدمة والاتباع، ومن ثم فإن شأنه من شأن متبوعه، وأمره من أمر مخدومه، على أن واقع الناس مفض إلى تغليب الفرع على الأصل، ومحاباة الخادم على حساب المخدوم، وهذا فيه عكس المرتبة، وعدم حفظ المنازل التي وضعها الله للأشياء.
وهذا الوضع؛ مفض بعد ذلك إلى أن يدخل الضيم على العربية، وذلك لأن التداول شرط في اكتساب اللغة وحياتها، فإذا تدوولت اللهجات والدوارج، كان تداولها على حساب أصولها، وأخذت من حيز العربية التواصلي، حظا وافرا، تصير معه العربية حبيسة تداول محدود، تعد مفرداته عدا.
ولا يزال أمر الدارجة محتملا، ما بقي ولاؤها لأصلها، لأن هذا الولاء فيه اعتراف في الجملة بالأصول التي لها ينقاد الفرع، وينبني عليها، والمشكلة كامنة في انفراط عقد النسب، وعقوق الفرع لأصله، وتحرره من الولاء والتبعية.
وأمر الدارجة مبني على الحاجة التواصلية؛ ولا يزال الناس يزيدون فيها من الألفاظ وضروب العبارات، متى ما أحوجهم الأمر إلى ذلك، ولا تخضع هذه الزيادة إلى ضابط، والواضع فيها أمير نفسه، ولنا أن نعتبر بالمفردات الجديدة التي لحقت بالدارجة، في ميدان الإنترنيت، وضروب الكتابات التي انتهجت في برامج المحادثة، من كتابة العامي بالحروف العربية، أو اللاتينية، وجعل بعض الأرقام دالا على أحرف معينة، مثل 7 على الحاء و9 على القاف، وما شئت بعد ذلك.
فهذا باب من الدارجة، يشبه عند الاعتبار أن يكون مع الأيام دارجة أخرى ضمن الدارجة الأولى.
ولكل زمان ألفاظه التي يتداولها أهله، وعباراته التي يستعملها أصحابه، ولئن كانت العربية الفصيحة، محافظة على ألفاظها ومعجمها بسبب القرآن الكريم، وبسبب ما لها من الحصانة الذاتية، فإن الدارجة تفتقد هذا الشرط وتفتقر إليه، فترى كل جيل من الناس، تجري على ألسنتهم عبارات وألفاظ لا يستعملها الجيل قبلهم، فالآباء مع الأبناء، يجتمعون في الدارجة على الألفاظ العامة الدالة على أصل التواصل لا فضله، ثم ينفرد كل منهم بما عنده من ألفاظه الدارجة، وما يستعمله الآباء من ذلك، لا يستعمله أبناؤهم، فمن ثم كان الولد أعرف بما يقوله صاحبه منه بما يقوله أبوه، وبه آنس، ولئن اتفق أن يجتمع الجد مع حفيده، أو الشاب الحدث مع الشيخ الهرم، لكان ما بينهما من التفاوت في الخطاب على وزان ما بينهما من التفاوت في الأعمار.
والارتحال الدائم في ألفاظ الدارجة، هو ارتحال منوط بالغرض التواصلي، وهو ارتحال لا قرار له، تسير فيه الدارجة، سيرا لا تعريج فيه، بحيث تكون في كل جيل منفتحة على ضروب من الألفاظ والعبارات، التي تلبي من حاجة ذلك الجيل في التواصل، ما يحقق عنده هذا الغرض، وبذلك تدخل في متنها التداولي، من الألفاظ بقدر ما يخرج منها ويُمَات، فتحل الألفاظ الجديدة، محل عبارات أخرى كانت في زمانها هي مادة حديث الناس.
وهذا الارتحال يغذي الدراجة بمدد لا ينقطع، لأن الناس أحوج إلى التواصل، وأحرص على أن يفهم بعضهم بعضا، وهم لا يدعون في ذلك بابا إلا سلكوه، هذا مع سهولة الوضع فيها، وكثرة الوُضَّاع، ووجود الجمهور، وتوفر الدواعي.
وتسمية العامية بالدارجة، فيه ملمح لطيف، لأن الدارجة، مأخوذة من مادة “درج” وهذه المادة تدل في أصلها على مضي الشيء والمضي في الشيء. فيقال: درج الشيء إذا مشى مشيا فيه تؤدة ومهل. ودرج القوم إذا انقرضوا، ويقال للقوم إذا ماتوا ولم يخلفوا عقبا: قد درجوا. وقبيلة دارجة، إذا انقرضت ولم يبق لها عقب.
وحظ الدارجة من هذه المعاني بين، والتسمية بالدارجة تلخص سمتين بارزتين في اللغة العامية:
السمة الأولى: السهولة:
السمة الثانية: الانقراض:
أما سمة السهولة، فلأن الدارجة تتخذ من السهولة مقصدا تنتحيه في اختيار الألفاظ والأصوات والدلالة والتركيب، ولو كان على حساب البنية والوضع والتأليف والنظم.
فمن أعجزه حرف الضاد اكتفى بالدال، ومن شق عليه الذال في “هذا” ونحوه، مال إلى الدال، وإبدال الفاء ثاء والصاد سينا والحروف المتقاربة في المخرج والصفة، هو قاعدة معمول بها باطراد في الدارجة، ومن أعجزه معاناة التركيب ومقتضيات النظم، كان له في مطلق الترتيب غنية ومفزع، ولا يزال المتحدث بها ينتحي الأسهل فالأسهل، يُسَهِّلُ عليه ذلك ما فيها من حرية التصرف، وقابلية التصريف، ولو وضع لنفسه لفظا ونشره في الناس، لما كان عند أكثر الناس ملوما، بل كان عندهم محمود الفعال.
وأما سمة الانقراض، فقد مضى في بيان ارتحال الألفاظ الكامنة في الدارجة، ما فيه غنية، ولو أحصينا المفردات التي نتكلم بها نحن، ولا يتكلم بها آباؤنا لكان لنا حصيلة لا بأس بها، وكذلك الشأن مع أبنائنا وجيلهم، وإذا كان الناس بزمانهم، أشبه منهم بآبائهم، فأحر بهذا الشبه أن يكون في ألفاظهم وكلامهم، كما هو في عاداتهم وأسلوبهم.
وهاتان السمتان، سمة السهولة، وسمة الانقراض. تحيلان على أمرين مهمين:
الأول: أن الدارجة، لا تستقل بنفسها، ولا تقوى أن يكون لها سند من ذاتها، فهي في حركة دائبة، وتجدد مستمر، كأمواج البحر، يمدها البحر بما يكون لها به من اللجاج والتجدد، فإذا انقطع مدده عنها، لم يكن لها من ذلك ما تقوى به على أن تستمر.
الثاني: أنها غير مستقرة، وعدم الاستقرار يهدد حياة الألفاظ واللغة، لأن اللفظ إذا تكلم به، ولم يترك له مجال للنمو، وفرصة للتداول، ضمر وضعف، وإذا ضعف اللفظ، لم يقو على أن يحمل مفهوما، ولا أن يصير مصطلحا. ويصبيه من الضمور ما يقعد به عن شرف اللفظ وجزالته.
وليس ثمة عائدة أعود على اللفظ من استقراره وثباته، فاللفظ إذا استقر وشاخ في الاستعمال، فإنه يكتسب طاقة تداولية عجيبة، تجعله أحيانا ينوب مناب جملة بل مناب خطاب أحيانا، وكلما كانت اللغة ذات ألفاظ عتيقة مستقرة، كان ذلك من سعادتها وحظها، لأن هذه الألفاظ المستقرة هي التي سنعتمد عليها في بناء المفاهيم ووضع المصطلحات، وهي التي نشحنها بالقيم الدلالية الغنية، وإذا كان الإنسان يطول عمره فيكتسب من الحكمة والرزانة ما يكتسب، فكذلك اللفظ؛ مع طول عمره يكون له من ذلك الاكتساب حظ ظاهر.
وإذا كانت الدارجة، إنما اقتضاها الغرض التواصلي العام، فإن هذا الاقتضاء، هو شرط مصحح لاستعمال الدارجة، وينبني على هذا أننا إذا انتقلنا إلى سياق تواصل خاص، فإن هذا السياق ملزِم باستعمال النسق الفصيح، الذي يكون مناسبا لذلك المقام التواصلي، بسبب قدرة ألفاظه العتيقة، بما فيها من معان دقيقة، ومصطلحات مركزة، على مواكبة المقام التواصلي الخاص.
وإذا لم يُحترم هذا الشرط، وتُحُدِّثَ بالدارجة في المستويات التواصلية المتخصصة، أثَّرت الدارجة في ذلك المستوى التواصلي، وجعلته ينزل إلى حضيضه، فصار تواصلا عاما، فكانت بذلك مفسدة للمقام، مخلة بالنظام.
ومن أخص الأمثلة التي يظهر فيها ذلك التأثير بجلاء، المواضيع المعرفية، التي يكون التواصل فيها قائما على توظيف مفردات ذلك العلم، واستثمار مصطلحاته، التي هي نسق متكامل من التصورات الذهنية، عليها يعتمد المتخاطبون في تصور ذلك العلم، وفهمه على وجهه، فإذا دخلت الدارجة في هذا المستوى، دخولا كليا، بحيث كانت هي لسان العلم، والمعبر عنه، والمفصح عن إشكالياته، والمعتمد عليها في دفع عجلة التقدم العلمي، كان ذلك فسادا صريحا، وخللا بينا، لقصور الدارجة عن تمثيل مفاهيم ذلك العلم تمثيلا صحيحا، ونبو ألفاظها عن ذلك.
والذي يدعو إلى تعميم الدارجة، على جميع المستويات التواصلية، فهو لا يراعي شرط الاقتضاء السالف الذكر، وفي دعوته إفساد لا حدود له لفكر الناشئة، وتجن واضح على حقها في الإبداع والرقي، وحقها في معالي الأمور.
ومأتاه إما من جهله بخطر ما يقول، أو عدم تقديره لحجم الأضرار الناتجة عن ذلك، أو عدم مبالاته بمصير الأمة وحق أبنائها في المكاسب الرفيعة.
وغاية ما يقال عن هذه الدعوة، أنها مبنية على عوج، وأن سيرها فيه عرج، وفي مثلها يقال: “من تعلق بالدارج درج”.
ولا يزال أمر الدارجة بخير ما كانت صلتها بالعربية قوية، لأن الفرض أن الدارجة كلما اقتربت في مفرداتها وأساليبها من النسق الفصيح، كانت أعود على الناشئة وأنفع للمتحدث بها، وذلك لما يعهده منها من الألفاظ العربية، فإذا انتقل إلى العربية الفصحى، كان لسانه بالبيان العربي أفصح، وبه أنطق، وكان سمعه له آنس، وخاطره به أعلق.
ومن يدعو إلى الدارجة على حساب العربية، فهو يدعو إلى فصل الفرع عن أصله، وقطع الغصن عن شجرته، كما يدعو إلى دعم الفرع على حساب إضعاف الأصل، وإقامة قطيعة غير متعقلة ولا مسوغة، بين ما حقه أن يكون متصلا، وإذا كان مدد الابن من أبيه، وسند الغصن من شجرته، فلا يرجى له نمو، ولا يعول على نشأته وهو بعيد عن مورده، ولا منفصل عن سنده.
وإذا كانت الدارجة تسعف المتواصلين بالحد الأدنى من المعنى الذي يضمن سلاسة التواصل واستمراريته، فإنها لا تسعف المتواصلين بذلك عندما يرتقي الخطاب والموضوع، ومن ثم قيل قديما: لكل مقام مقال.
على أن الدعوة إلى الدراجة هي دعوة إلى تبني مستوى التواصل الأدنى والبقاء فيه، والاتكال على ما لا يغني المرء عند عزائم الأمور، ولا ينفع على الأيام والدهور، كأنها دعوة إلى أن نلتزم بالخطاب التواصلي اليومي، الذي لا يبني أمة، ولا يقيم وطنا.
وإنما الشأن فيه كقول الشاعر:
دع المكارم لا ترحل لبغيتها == واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي.
ومعنى الشعر: دع المكارم والمعالي فلست من أهلها، لأنك أهل فقط لأن تكون مهتما بطعامك وكسوتك.
ولو أخذت طائفة من الناس، وألزمتهم الحديث بالدارجة، وأبقيتهم على ذلك زمنا يشب فيه صغارهم، ويكبر فيه نشؤهم، لكانت الحصيلة الفكرية لهذا النشء، حصيلة هزيلة، مقتصرة على الأمور اليومية المعتادة، ولا يرتقون بما معهم من الألفاظ، إلى أن ينظروا في ضروب المعرفة والأمور المجردة، لما يحتاجه ذلك من اللفظ العتيق، والمفهوم المحدد، والمصطلح المركز.
ويكون من شب على الدارجة، غير مبدع في فكره ولا في لغته ولا في أمته. إذ كان الإبداع في هذه الأمور، نتيجة مترتبة على مدى قابلية الألفاظ لأن تحمل هذا الإبداع وتعبر عنه.
فإن قيل: الدارجة مقوم أساسي من مقومات الهوية المغربية، يجب أ ن نهتم بتقعيدها بدلا من تهميشها وإقصائها.
فالجواب أن كون الدارجة مقوما أساسا من مقومات الهوية المغربية، فهذا أمر متعالم عند الناس، وما حديث الناس من طنجة إلى الكويرة إلا بهذه الدارجة، التي درجوا عليها منذ زمن، ولذلك تنسب إليه قصرا عليه فيقال: الدارجة المغربية، تمييزا لها عن باقي الدوارج، وقصرا على الجهة المتواصلة بها.
وأما تقعيد الدارجة، فلا يجب أن يقع في مقابلة التهميش والإقصاء، لأنها مقابلة غير صحيحة، فليس عدم التقعيد مفض إلى التهميش، فقد يجتمع التهميش مع التقعيد كما هو الحال في العربية.
فليس صحيحا إذا أن نزعم أن الدارجة إذا لم تقعد همشت. لأنه كلام مرسل إرسالا، وليس من بابة التحقيق.
والتقعيد كلمة جامعة، تختزل في معناها مراحل طويلة، من البحث والتنقيب، ومن التنظير والترتيب، ومن الموازنة والتبويب، ومن الجمع والتنسيق، والتحقيق والتوثيق، ما يجعله من أهم المراحل التي تمر بها اللغة، لأن اللغة بالتقعيد تعبر من مرحلة التواصل الشفوي البحت، إلى مرحلة التوثيق والضبط، ومن مرحلة الاختيار إلى مرحلة المعيار.
والتقعيد اللغوي، يراد به جمع النظائر اللغوية، والظواهر المتشابهة في لغة ما، ووضعها تحت قاعدة عامة، تكون واصفة لهذه الظاهرة محددة لها، كما تكون ممثلة لها في الذهن، وعليها المعول في بناء الأنساق اللغوية، والتمثلات الذهنية للنموذج اللغوي.
وإذا كانت القاعدة ينبغي أن تكون مطردة، فإن مادة هذه القواعد، ينبغي أن يتحقق فيها شرط الاطراد، ولا يتحقق هذا الشرط إلا باستقرار اللفظ وثبات استعماله، وإلا كيف يتأتى ضبط اللفظ المرتحل، واللفظ الذي لا تتوفر له مدة ليعيش فترة كافية، يستقر فيها ويثبت كما هو الحال في الدارجة.
والتقعيد بهذا المعنى؛ هو الذي يمنح اللغة قوتها وشخصيتها ونفاذها في عالم الناس، وسطوتها على الفكر، وقدرتها على حمل المعرفة، والإبداع فيها، وبه تناط الهمم، وتشرف اللغات، وتتفاخر فيه الأمم.
وهذا المستوى من التقعيد، يكون على درجة عالية من التنظيم، بحيث يشتمل اشتمالا دقيقا على كل مكونات اللغة، بما هي عليه من صرف وصوت ودلالة وتركيب ومعجم.
وكلما كان لألفاظ اللغة تاريخ دلالي، واستقرار تداولي، وثبات بنيوي، انعكس على القواعد التي تصفها، وأثمر ذلك نسقا لغويا منتظما كأحسن ما يكون الانتظام.
فإذا طالبنا بتقعيد الدارجة، كانت هذه المطالبة غير متعقلة، لأنه جمع فيها بين أمرين لا يجتمعان، التقعيد (بما هو تأطير نظري منظم لمادة قابلة للتنظم والترتيب) والدارجة (بما أنها لهجة غير مستقرة في ألفاظها وبنيتها وأصواتها وتراكيبها)، وعليه تكون عبارة “تقعيد الدارجة” عبارة لاحنة دلاليا كما يقول أنصار التيار التوليدي.
وبعض الناس ينوح على الدارجة نوحا شديدا، ويتباكى على وضعيتها بكاء مرا، ويتمنى لو تكتحل عينه يوما بتقعيدها وترسيمها وجعلها شعارا لأهل المغرب، ويسعى إلى ذلك ما وسعه الجهد، ولا يدع سبيلا إلا وسلكه، ولا فرصة إلا اهتبلها، كأن له في الدرجة نسبا خاصا به من دون الناس، وكأنها كانت لسان قوم انقرضوا وبقي هو من دونهم، فهو المنافح والمدافع عنها، وكأن موصيا أوصاه بحفظها والاستماتة من أجلها، فهو على وصيته، هو في تهالكه على حبها، يظن بنا السوء أن لم نكن مثله محبين، وفي هواه سالكين، وإن تعجب فاعجب لمحب يكون على يديه هلاك محبوبه.
ومن عادة المحب أن يرفع شأن محبوبه، ويغلو فيه، ويجعله في موضع دون الموضع الذي يراه فيه أهل العلم والعقل والمروءة، ولا زال أمره في ازدياد إلى أن يدعي لمحبوبه ما ليس له، وأن ينسب إليه ما هو منه عاطل، فعند ذلك يهجره الناس، ويرون فيه نزق المحب، وصبابة العاشق، وينسبون أفكاره للوثة الحب، وفعل الصبابة، ويجعلونه مثلا يُروى، ويدخل في باب كليلة ودمنة، وباب الأخبار الطوال، ويصير مادة للتنادر، وباب للعبرة، وموضوعا للاستطراف.
والمحب إذا لم يكن عنده من التبصر ما يمنعه من الغلو في محبوبه، والاقتصاد في محبته، كان حتفه في حبه، وهلاكه في عشقه، وأساء من حيث أراد أن يحسن، وجاءته المحنة من الموضع الذي أمن، وهو إن لم يتدارك أمره في الابتداء، ويتنبه له ولما يستفحل، صعب علاجه، وكان الحديث معه إلى غير نهاية، ومن الحب ما قتل.
والقول بإتاحة الفرصة للدارجة، قول مبهم مجمل، ولو ذهبنا نتيح الفرصة للدارجة لكلفنا ذلك من الوقت الكثير والجهد المضني والخبرات الرائدة، والتخصصات العميقة، واليد العاملة والمال الوفير والحظ المواتي، وكثرة الموافق، وتوفر المادة، ومن المدد والعون، والتوفيق والتيسير، ما لا يكون مجتمعا في موضع، ولا متفقا مثله في أزمنة متطاولة، فكيف في الزمن اليسير؟؟؟؟
وهذه العبارة، (إتاحة الفرصة للدارجة) لو كتبت بحروف من ذهب، على صحيفة من ذهب، وزيد عليها وزنها ووزن قائلها ذهبا، لما قام هذا الذهب كله بما تكلفه هذه العبارة، ولاحتجنا في تمويلها إلى الخزائن والمال المدخر، وإلى أن نقترض من الناس، وإلى أن نعرض سمعتنا للخطر، ثم كانت فائدتها بعد ذلك، كمن رأى سرابا، فظنه ماء، فاقترض من الناس مالا، ليبني لهم سدا في الصحراء، فلما وصل وجد السراب، فضاع بذلك مشروعه، وضاع قومه الذي وثقوا به، وضاع مال الناس الذين أقرضوه، ووقع في مشكلة لا حل لها، ونعوذ بالله من سوء التدبير، لهذا قيل: ما يكلفك ذهبا، لا تجعله مذهبا.
ثم إن الدارجة اليوم، يدرس بها في المدرسة، وتكتب بها الإعلانات، وتترجم بها الأفلام، ويتحدث بها الخاصة والعامة، ولها من الحظ التداولي ما لا يوجد مثله ولا قريب منه للعربية ولا للأمازيغية، وهذا التدريج (أي اعتماد الدارجة) يسير بالتدريج (أي شيئا فشيئا).
وإذا كانت الدارجة مرتبطة بالغرض التواصلي العام، فإن تعميمها على جميع المقامات التواصلية، وعلى جميع المخاطبين، مخل بالتواصل ومفسد له، وذلك على مستويين:
المستوى الداخلي: بحيث سيقتصر المغاربة على المستوى التواصلي العام، وسيدورون في مجال تداولي محصور ومتكرر، وهو ما سيؤثر سلبا في فكرهم وعقلهم، إذ كانت اللغة مرآة للفكر ووعاء له. فكلما علت اللغة ودقت علا معها الفكر ودق.
المستوى الخارجي: بحيث ستقطع الدارجة علاقة المغاربة بغيرهم، لأن الدارجة المغربية لا يفهمها إلا المغربي، أما السوري والمصري والسعودي واللبناني وباقي المواطنين العرب، فلا يفهمون منها إلا رطانة وحروفا متداخلة، لا يثبتون معها على معنى، ولا ينتهون منها إلى غرض محصَّل.
وبذلك يكون المغاربة قطعوا صلتهم بغيرهم، وانطووا على أنفسهم، وهذا مضر غاية الإضرار، ولن يفهم المغربي حينها إلا المغربي أو الفرنسي، والحمد لله رب العالمين.
والحديث عن الدارجة، هو حديث مفتعل، وموضوع غريب مجتلب، وهو من الأحاديث المُدْرَجة، (على حد تعبير المُحَدِّثِينَ) لأنه موضوع مقحم إقحاما في النقاش اللغوي، ولا يتبناه عالم لغوي معروف، ولا لساني متخصص في هذا العلم، ولا جرت العادة بأن يكون مثله موضوعا بين الأمم الراشدة، ولا له في ذاته من مقومات العلمية ما يؤهله لأن يكون منظورا إليه من قبل أهل العلم، وليس أضر على الأمة من النقاشات الهامشية، التي يصرف فيها زمن وجهود ما كان أحراها أن تصرف في النقاشات الجوهرية.
والدارجة في أصلها لا تحتمل كل هذا الذي يدعو إليه من يريدها أن تتبوأ الصدارة، وإنما مثله ومثلها كمثل من يربي هرا، وهو في عينه أسد، فلا يزال يعامله معاملة الأسد، وينزله هذه المنزلة، ويحدث الناس عن إمكانات هذا الأسد، ويحكي لهم عن قوته وقدرته، والناس بين مدار له، ومتعجب منه، ومستغرب لما يصدر منه، يتمثلون فيه قول الشاعر:
كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد.