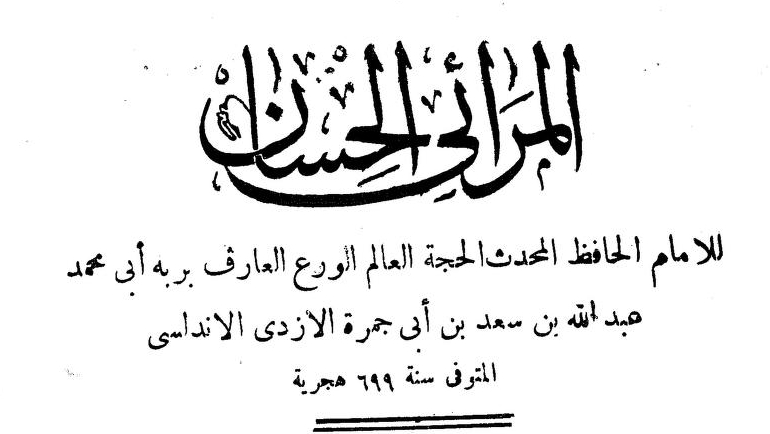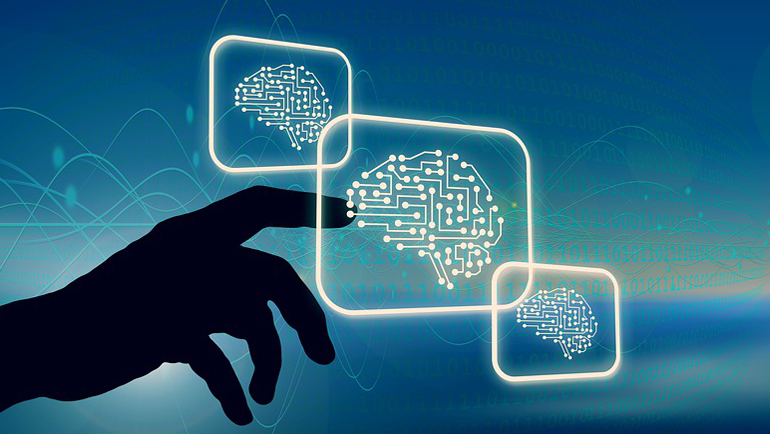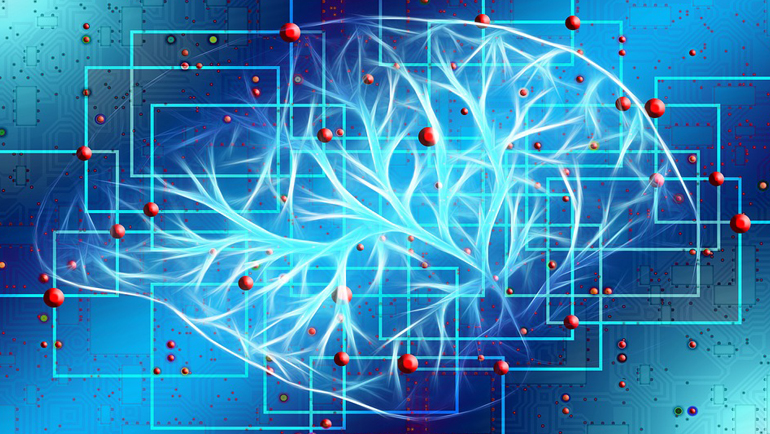تندرج هذه الندوة المباركة “الوحي والعالم.. جدلية مرجِع الوِجهة ومرجِع الحركة في عالم متغير” والتي تنعقد تحت الرعاية السامية لمولانا أمير المؤمنين أيده الله وحفظه، ضمن سلسلة من الندوات المتواشجات التي تتغيّى رفع صرح مشروع الرابطة المحمدية للعلماء الفكري والعلمي، فمنذ المبتدأ شرع العلماء في هذه المؤسسة المباركة في استبانة معالم السياق، ومعرفة لبناته التي ترصّ مسالكه وقضاياه ومساراته، حتى يُحقّق المناط، ويُخرّج، ويُنقّح، لكي يكون التوقيع عن الله تعالى على بصيرة.
بعدها جاءت الندوة الثانية، والتي بفضل الله انعقدت كأخواتها تحت الرعاية السامية لمولانا أمير المؤمنين، حفظه الله، لاستبانة معالم مناهج الاستمداد من الوحي، والنظر في هذه المناهج الموجودة، للوقوف على ما يسبّب حالة الخُلف التي نحياها ونعيشها، بين قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآَنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ (الإسراء: 9)، وبين واقع المسلمين الذي لا تتجسد فيه التي هي أقوم، إذ “التي هي أقوم” بانضمام هذا الاسم الموصول إلى صيغة التفضيل، تفيد الاستيعاب والاستغراق في جميع مناحي ومعالم الحياة..
وحلّ هذا الإشكال، لا يمكن أن يكون إلا بمقارعة مناهج العلوم، ولذلكم كانت الندوة الثالثة، التي بحثت في مناهج العلوم، وهل الأزمة أزمة تنزيل، أم أزمة منهج؟ وهل المضامين التي تتم بلورتها بالفعل، تجيب عن القضايا الحارقة، التي تقضّ سياقنا، والتي تفرض ذاتها بملحاحية على العالم، وعلى المسلمين والمسلمات، أم أن هذه المضامين لا تستجيب لهذه الأسئلة الحارقة؟ وهل المناهج، كما استقرت في إطار ما يسمى علوم التيسير، كافية للاستمداد وللاستنباط؛ أي استنباط العلوم، واستمداد القوة الاقتراحية من هذا الوحي الخاتم؟
ثم بحثنا بعد ذلك، قضية القيم في السياق المعاصر، وبحثنا قضية المقاصد، وهل التوقف عند المقاصد يُمَكّن بالفعل من تقديم بعض الإجابات عن القضايا الحارقة، ثم بعد ذلك نظرنا في مسائل التأويل، ثم نظرنا في قضية الرؤية الكلية، كل ذا في حلقات يتواشج بعضها مع بعض، في إطار المشروع الفكري والعلمي لمؤسسة الرابطة المحمدية للعلماء.
الآن أَزِف الأوان للعكوف على إشكالية الوجهة، في إطار التركيب الذي يعرفه عالمنا، وفي إطار هذا التشاكس من خلال نعق الناعقين، واقتراح المقترحين، وهداية الهداة، كلٌّ في هذه الحلبة التواصلية الرقمية، في المواقع الاجتماعية وغيرها، كلّ هذا يجعل الواحد منا حيرانا، أين الوجهة، وكيف تُستبان؟ وكيف يمكن أن تكون هذه العلامات، التي هي آيات، أي علامات الوحي؟ قال عز وجل: ﴿إِنَّ آَيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آَلُ مُوسَى﴾ (البقرة: 246)، وكيف يمكن أن تكون مناهج القراءة لها مُمَكّنة من الاستهداء بها واستبانة القبلة، كل من موقعه، قال سبحانه وتعالى: ﴿وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ (البقرة: 147).
لا شك أن مسألة الوجهة، في هذا السياق المركب، تكتسي أهمية بالغة، بحكم أن وظيفة القرآن المجيد الأساس، وكما سلف، هي الهداية للتي هي أقوم، فإذا كان الكون هو مرجع الحركة، والحوار معه يُمكّن من الفاعلية، ويُمكّن من الحركة، فإن الحوار مع الوحي هو الذي يُمكّن من إضافة الوجهة نحو القبلة، والتي هي وجه الله، قال عز وجل: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ (الكهف: 28)، هذه القبلة/المنتهى، ﴿وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى﴾ (النجم: 41)، ومناهج القراءة وجب أن تكون مُمَكّنة من استخراج هذه الهداية، نحو القبلة، كلٌّ من وجهته، بكفاياته/بكفاياتها، بقدراته/بقدراتها.
كما أن واقع المسلمين اليوم، يندرج ضمن واقع عالمي، وهذا الواقع العالمي، أقل ما يقال بشأنه، أنه واقع بالغ التركيب، وهذا التركيب من أجل تفكيكه يحتاج إلى جملة من الأنزيمات الإدراكية والمعرفية؛ بمعنى أننا نحتاج إلى تحويل إنسان قادر على القراءة، وقادر على التفكيك، في هذا الواقع المركب، ونقش جملة من الكفايات، وجملة من القدرات، هذا الإنسان، لكي يكون في الآن ذاته، قادرا على إدارة الواقع العيني المشخص، الذي يَحْتَوِشُهّ، من توافره على كيان بيولوجي سليم، فيه الكالسيوم وفيه المغنزيوم، وفيه كل هذه المقوّمات التي لا سبيل لاكتسابها إلا بالتغذية الآمنة والسليمة، بمعنى أنه يحتاج إلى أمن غذائي، وإلى أمن اجتماعي ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾ (قريش: 3-5).
كما أن هذا الإنسان يحتاج أن يُعَلّم كيف يلاحظ، كيف يقتبس ويقتنص، كيف يرتب هذه المعلومات في المرتبة الثانية بعد هذا الواقع العيني المشخّص، دون أن تكون هناك انكسارات معرفية. فالإنسان حين يلاحظ دون أن يكون ذا دراية بهذه الانكسارات التي يمكن أن تقع، يمكن أن يختزل في وجوده الذهني أشياء غير سليمة.
هذا التعامل الأول؛ إذا لم يكن الإنسان ذا ذهن سليم، وقادرا على الملاحظة لهذا الوجود العيني المشخّص، وقادرا على النقد لهذه المفردات، مما يليه بطريقة سليمة، سوف يكون ما عنده في ذهنه، حول هذا الوجود العيني المشخص، مضطربا ومرتبكا، وأنّا تكون له الفاعلية في هذا الوجود العيني المشخص، إذا كان ينظر للأمور بطريقة فيها هذه الانكسارات؟
بعد ذلك تأتي المرحلة الثالثة، التي هي الوجود اللفظي الشفهي، لأن الإنسان تواصلي بطبعه، عنده القدرة على القيام بعملية النقل من الوجود العيني المشخص، من خلال الذهن السليم، ومن خلال الملاحظة السليمة، إلى الوجود الذهني، ثم إلى الوجود الشفهي..
إن الإنسان حين يصبح مجاله التداولى عبارة عن ركامات، وعن فوضى، وعن مصارعات، لا تمت بصلة إلى حقيقة الوجود العيني المشخص، فإنه بالتبع لا يستطيع وضع الآليات التفكيكية، ولا التفكيرية، ولا التحليلية، على المفاصل الحقيقية، الموجودة في عالمه الذي يحتوشه، ومن تم سوف يكون مستهلكا منعدم الفاعلية.
ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الوجود البناني؛ أي التداول الكتابي، والذي أصبح الآن أيضا منتقلا إلى البعد الافتراضي، في كل هذه المواقع الاجتماعية، الذي أعطانا فاعلية.
إذا لم يكن الإنسان الذي سوف يتعامل مع الكتاب المنظور، كتاب التكوين، سليما، قادرا من خلال مناهج التنشئة على تحقيق الخلافة ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ (البقرة: 29)؛ أي يَخْلُف بعضهم بعضا، يتكامل عبر الزمن، لأنه؛ أي الإنسان، إنما هو في حركة مثلما الوحي كذلك في حركة؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ”[1]، وقال عز وجل: ﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾ (المائدة: 50)، بمعنى أننا في هذا السياق بالذات، نتعامل مع الإنسان الذي ينبغي أن يكون سويا، مصداقا لقوله تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (النحل: 76)، وقوله عز وجل: ﴿أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (الملك: 23).
إذا لم يكن الإنسان ذا بنية سليمة بيولوجيا، قادر على أن يتعامل بسلامة وبقوة ﴿ùخُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ﴾ (مريم: 12)، مع هذه الظواهر، فسوف يكون هناك اضطراب، وانكسارات معرفية، ويصبح المجال التداولي فوضويا، ويصبح في مقام القطيع المُوَجّه، ﴿وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾، فالعدل هنا يشير إلى الصواب، أي النقل دون أي انكسارات معرفية، الأمر الذي يقتضي مراجعة مناهج التربية والتكوين، ومناهج البحث العلمي، لكي تصبّ في هذا المصب.
إذا انتقلنا إلى الكتاب المسطور؛ كتاب التدوين، سوف نجد أن الغاية من الإنزال كما ينطق الكتاب الكريم عن نفسه، ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 24)، هذا القيام بالقسط، ما هو، كيف هو، أنّى هو، كيف يمكن تمثله والقيام به؟ وهنا تبرز كلمة الميزان باعتبارها كلمة مفتاحا، قال عز وجل: ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 5-7).
إن الموازين في القرآن المجيد، متكاملة فيما بينها، وهي عبارة عن طبقات، بعضها يندرج تحت بعض، إلى أن تأتي الطبقة الكبرى التي هي الرؤية الكلية والكونية الكوسمولوجية، التي تحتوش هذه الطبقات جميعها.
فالطبقة العليا التي هي رؤية العالم؛ تكتنز الملامح/المعالم الكبرى، لهذه الأكوان، ولهذه العوالم في ذهن الإنسان، والقرآن المجيد يعطي إمكانية هذا الاستيعاب الكلي الإجمالي للأكوان، وللخلق، وللوجود، وللحياة، وللأحياء، وللخالقية، وللمخلوقية، بطريقة بديعة يستطيعها كل الناس بمختلف طبقاتهم، لكن على سبيل الإجمال.
أما على سبيل التفصيل، فأن يستوعب الإنسان الفرد هذه الرؤية الكلية، أو أن يُجَلّيها ويرصّ قطعها جميعا، فهذا من قبيل الاستحالة، وهنا تبرز جدلية الفرد والمجموعة؛ إذ الفرد يمكن أن يُسْهِم من قِبَلِه، لأن الغريب والعجيب في كياننا، هو أن الكفايات متوزعة، حول هذه المائدة المباركة لا أحد/لا واحدة، يشبه الآخر، من حيث المسار، ومن حيث القدرات، كل له قدرة لا يمتلكها سواه، يتميز بها من دون العالمين، والسر هو كيف يمكن أن نكون البنيان المرصوص، كما قال الله عز وجل: ﴿كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ﴾ (الصف: 4)، أو كما قال، صلى الله عليه وسلم، استمدادا من هذه المشكاة “كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا”[2].
هذه الرؤية، إذا أردنا أن ندخل إلى تفاصيلها، كما هي كامنة في القرآن المجيد، وكما هي كامنة في الكتاب المنظور، سوف نجد أننا أمام بحار زاخرة من المصطلحات، ومن المفاهيم، وكل مفهوم يتواشج في علائق مع كل المفاهيم الموجودة في المنظومة القرآنية، بحيث إذا أخذنا “الهدى”، على سبيل المثال، سوف نجده يتواشج مع الضلال، مع الإبصار، مع العمى، مع القبلة، مع الوجهة، مع الوحي، مع العالَم، مع كل هذه المكونات، مع العلاقة، مع التأثير، مع حبّ شيوع الفاحشة، مع التضافر والتواطؤ على الحق، وعلى الخير، والتعاون على البر والتقوى، سوف نجد نسيجا في غاية التواشج، وفي غاية البهاء، وفي غاية الجمال، أي أنّ هذه القطعة سوف تكون بمثابة الرابط الترتيلي (من الرُّتَيْلاء؛ أي العنكبوت) الذي يمتدّ إلى القرآن المجيد كله، كما هو الحال في الدماغ، كل النورونات والخلايا تمتد لكي تتواشج مع كل الخلايا الأخرى.
فهذا المصطلح في القرآن الكريم، سوف نجده يتصادى مع الجميع، وسوف نجد أن هناك مناطق تركيز، تسمى المركبات المفاهيمية، أو الأنساق المعرفية، أو الأطر المرجعية، مثل الأحياء في مدينة تصورية كبيرة جدا، ولنأخذ مثلا قضية “الأُمّة”، التي أصلها من أَمَّ ـ يَؤُمّ، ومنها: الإمامة، قال عز وجل: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآَيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ (السجدة: 24) سوف نجد مرة أخرى، الآيات والعلامات، تتيمّم شطر القبلة، وتحدّد الوجهة. ولهذه القبلة آيات تهدي إليها، كما أن القبلة المركزية “الكعبة” كلّ له وجهة نحوها، قال تعالى: ﴿وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا﴾ (البقرة: 147)، وهي قبلة واحدة، ويظهر هذا في الإحوولاق حول الكعبة في صفّ الصلاة في الصّحن، حيث ترى أن الوِجهات متعدّدة، ولكنّ القِبلة واحدة.
لا شك أن كلّ شعب، وكل أمة، من الناحية الحضارية، اكتسب من التجارب، ما اكتسبه في محيطه، والآن هذه العولمة، وهذه التكنولوجيات، تمكّن من الدخول إلى كن التوحيد، الذي يُمكّن من جمع كل هذه الخبرات، وكل هذه المعطيات، وهذه الألغوريتمات الجديدة، تُمَكّن من مثل هذه الصياغات، فالكلّ له كفاية يتميّز بها.
إن الكشف عن هذا النسيج، الذي يشبه قطع البازل؛ أي الصورة المقطعة، والتي تكَوّن في مجموعها الرؤية الكلية في القرآن المجيد، يحتاج إلى بحث واستخراج، وإذا ما علمنا أن عدد العلماء الرسميين في العالَم الإسلامي وحده، يتجاوز خمسة ملايين عالِم رسمي، فإنه يبح لدينا الإمكان متحققا، وإذا قمنا بكتابة أدلة تكوينية لبناء قدرات هؤلاء، ووجهناهم إلى هذه القضية “الرؤية الكلية”، سوف نجد حلولا لعديد من القضايا، وسوف نُنْجَز حلولا خلال شهور قليلة، لكن شريطة أن تكون عندنا الألغوريتمات التي تمكن من بناء التصور لنوعية المقاربة والمنهجية البحثية، وهذه الآن مسألة يُحْسِنها المهندسون المبتدئون في التواصل والتكنولوجيات الحديثة. هذا عن الطبقة الأولى التي هي الرؤية الكلية.
بعد هذه الطبقة، سوف نجد الكليات، أي الأمور الحاكمة في الوحي، ويمكن أن نُجْمِلَها في ثلاث مسارات متكاملة، عندنا التوحيد، والتزكية، والعمران، وتحت كل واحدة من هذه الكليات، نجد جملة من الكليات الأصغر..
بعد هذه الطبقة، عندنا القِيَم، وهذه القيم سوف نجد أنها قيم مؤطرة من طبقات، منها ما هي قيم مؤطرة، وعندنا قيم عملية، وعندنا قيم وظيفية، وعندنا قيم تفصيلية، أجزاء يمكن أن تندرج تحت مسمى “علم الأخلاق”، الذي هو الطبقة الخامسة.
ثم عندنا البُعْد التشريعي الذي يمتح من الرؤية الكلية، ويمتح من الكليات، ويمتح من القيم المختلفة بأصنافها، ويمتح من المقاصد؛ مقاصد التشريع المعروفة لدينا. ثم عندنا التشريعات التفصيلية التي هي الأحكام، دون نسيان بُعْد الحكم الوضعي. ثم عندنا البُعْد المتصل بالباطن؛ فبالتمييز بين مختلف الأصوات والمكونات، التي تَمُور في كيان الإنسان ينطرح السؤال: ما هو مفهوم الشخصية؟ وما هي تعريفات البوذيين، والمسيحيين واليهود، وحتى الديانات الأمازونية لمفهوم الشخصية، ومفهوم الإنسان، ومن هو الإنسان من باطن/من داخل، كيف يتم تصوره؟
الحاصل أن هذه التصورات التي تخترق كل هذه المنظومات يثبت تكاملات وتقاطعات، ولكن الحلبة التي تُفْحَص بها فعالية هذه التصورات، تنصب أول ما تنصب على مدى الفاعلية، ونجاعة الفعل، والتوقيع على أرض الواقع.
ثم يأتي البُعْد المتعلق بالسلوك؛ فالناس عبر هذا الكويكب، الذي هو ذرة رمل كونية، معلقة بأشعة الشمس، أصبحوا قادرين على التواصل، من خلال مختلف اللغات؛ أي أن عدم التفاهم قد تقلّصت دوائره، وأصبحنا قادرين على الوصول والتواصل. ودلالة هذا المعطى، هي أنه يعطي الإمكان لأن نرسل بالليل السكانيرات IRM والتي لا نستطيع قراءاتها إلا في ساعات، إلى إنسان في الصين، أو أمريكا، الذي بدأ عنده الصباح، ونذهب لنستريح، وحين نستيقظ، نجد في الفاكس أو عبر بريدي الالكتروني نتائج قراءة السكانير موجودة. خصوصا إذا كان هناك ميثاق شرف، وثقة متبادلة، وطرائق فحص، بمعنى أن القدرة والفاعلية يمكن أن تُضاعف أضعافا كبيرة. أيضا الآن هناك زحلقة مناطق الثِّقل من المحيط الأطلسي نحو المحيط الهادي، وذهاب التأثير من الدولة إلى المدن الكبرى، وبروز قضية البيئة والوعي بالمخاطر المُهَدّدة، حيث إن مشاكل الجميع أصبحت مشاكل الجميع، والآن الكويكب بدأ يُتَمَثّل باعتباره كويكبا، وبدأ الإنسان يقف على مدى الحمق الذي يثيره هذا التمترس خلف الهويات، دون التمييز بين الثابت الكبير من عناصرها ومقوماتها، وبين الفردي التبعي، إلى غير ذلك من التغيرات التي أحصيناها إلى حوالي ثلاثين تغيرا.
إنه حينما نتحدث عن السياق، وعن طبيعة المصفوفة الراهنة، وجب أن نستحضر ضرورة التعامل مع الكتابين المنظور والمسطور، وحين نصل إلى هذه النقطة، نرجع مرة أخرى إلى كيفية تعاطي علمائنا في العصور السابقة مع هذه الإشكالات، إشكالية الوجهة، وعلم الوجهة، سوف نجد أن البحث كان مبكرا؛ فالرسول، صلى الله عليه وسلم، في توقيعه كان يضيف الوجهة إلى كل فعل أو قول، وحين يتحدث، عليه الصلاة والسلام، عن “النية” وهو ما اقتنصه البخاري، رحمه الله، وفقهه يظهر من تراجمه، يعني “إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ”[3]، ثم افتتح به جامعه الصحيح، فإنه عرف أن للعمل روحا، ثم شفع ذلك بعنوان آخر: “باب العلم قبل القول والعمل”[4]؛ أي أن هناك هذا البُعْد الذي هو الوجهة، والذي ينبغي أنْ يُضاف إلى التوقيع العملي المادي.
بعد مرحلة التجميع الأولية للنصوص، التي هي نصوص قرآنية، ثم نصوص السنة النبوية المطهرة التي تعد ضرورية، بعد هذه المرحلة؛ مرحلة الجمع، وجدنا الاستقرار قد اندهقت معه بوادر الاجتهاد؛ والاجتهاد كان منصبا على هذه القضية؛ اقتفاء الوجهة، والوعي بأن العمل ينبغي أن يكون خالصا. فالفضيل بن عياض، رحمه الله، خلص مبكرا إلى أن “أخلص العمل أصوبه”، قال أخلصه ما كان خالصا لوجه الله ﴿يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ (الكهف: 28)، وأصوبه ما كان وفق سنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أي التوقيع الأول.
إن قضية الوجهة كانت حاضرة، لكن ليس بوضوح كبير، حيث نجد المحاسبي، رحمه الله، يؤكد على ضرورة العقل لفهم القرآن، وضرورة استحضار جملة من الآليات لإجراء الحوار مع الكتاب المسطور، مع كتاب التدوين، ثم بعد ذلك قضية المحاسبة، أي أن الفرد يطمئن لسلامة الوجهة من خلال المحاسبة. ولم ينتقل المحاسبي، رحمه الله ورضي عنه، إلى المحاسبة المجموعية، مثل التي برزت مع العز بن عبد السلام، وقبله مع كل الفقهاء، ابتداء من وقت مبكر جدا مع الإمام مالك بن أنس الأصبحي، حين كان يتحدث عن المآل، واعتبار المآل، وبدأ الحديث عن الاستحسان، وتقديم القياسات الخفية على القياسات الجلية، للعلة التي تنقدح في ذهن المجتهد.
إنها ترسانة تبين أن مسألة التقويم والمحاسبة فيها الحاضر، ولكن كذلك فيها المآل، تتحدث عن فتح الذرائع، وعن سد الذرائع؛ بمعنى أنّ قضية الوجهة حاضرة في الممارسة الاجتماعية، التي كانت تتجلى من خلال فقه المجتمع، وليس فقه الأفراد وحده، أي أن البُعد المتصل بالمعاملات والمتصل بأبعاد الحكامة والسياسة كان ظاهرا..
إن العلماء، في فقه المجتمع، كانوا يعون قضية “الوِجْهَة” بشكل واضح، ثم جاء جيل مع الإمام الغزالي رحمه الله، الذي وعى، ولاسيما في كتاب “الإحياء”، أنّ هذه العلوم، وهذه المعارف، قد سارت فيها الاجتهادات في كل المسارات، وأن الأصولي قد انفرد باجتهاداته في علم الأصول، وأن الفقيه في علم الأحكام والتفريعات وأحكام الفروع قد سار في مسارات متعددة، وأن المتكلم والذي يتحدث عن الأصول الكبرى للدين، سار في مسارات، والمتصوف في مسارات، وأن هذه البنية الإدراكية لم تبق بالشمول الكلي، الذي يُمَكّن من الحراك نحو القبلة، التي هي وجه الله، عز وجل، من خلال ﴿وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا﴾ (البقرة: 147)؛ أي تعدد الوجهات، من خلال قراءة الآيات.
وبالمناسبة فالآيات والعلامات في الكون تسمى علامات/آيات، ﴿آَيَةَ مُلْكِهِ﴾ (البقرة: 246)، أي علامة ملكه: ﴿وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ (النحل: 16)، وفي كتاب التدوين، تسمى أيضا آيات: ﴿تِلْكَ آَيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾ (يونس: 1)، فعلا آيات، والاسم واحد، لكي يظهر أن التوجه إلى القبلة، هو توجه نحو الذي تكلم أزلاً بالكتاب المسطور، والذي خلق من عدمٍ الكتاب المنظور.
فإذن، هذا الوعي من قبل الإمام الغزالي رحمه الله، أن هذه العلوم قد حصل فيها انفجار داخلي وتشتّتت، لابد من محاولة الجمع، وأن الإحياء لا يمكن أن يكون إلا إذا كان هذا النوع من الاستيعابية، ومن اللّمّ لهذا الشتات بمقاربة تأثيلية، لكي يصبح العلم بهذا المفهوم الذي يُمَكّن من التوقيع الفعّال والناجع والمهتدي، في التعامل مع الكتابين المسطور والمنظور، لذلك كان هذا الجهد فعلا مضنيا.
ثم بعد ذلك، وجدنا الاجتهاد، لاستبانة الأقطاب التي تشدّ جانبا من جوانب الجهود، وسُمّيت مقاصد، وسميت أصول، لكي لا تبقى الأمور في هذا الشتات، تم الاهتداء إلى قضية “مصالح الأنام” من قبل العز بن عبد السلام، ثم تَمّ الاهتداء إلى قضية “الضروريات الخمس”، والتي يتفرع فيها العِرض إلى الكرامة وإلى النسل، تم الاهتداء إلى أنّ ثمة “محاور” في القرآن المجيد، تم الاهتداء إلى هذه السواري والأعمدة التي تحدّ من هذا الشتات من خلال الحديث عن “الكليات” ثم فقه “الموازنات”، وفقه “الترجيحات”.
إن هذا التوحدّ الذي في الكتاب المنظور، وعى به “ألبرت أنشتاين” من خلال اجتهاداته العلمية الساعية إلى بناء نظرية كلية تتجاوز المعطيات المختبرية الجزئية وما ينتج عنها من شتات. وكل ذلك في إطار “الإتيكس”؛ أي الأخلاق التي تضمن المصالح الكبرى دون أن تفرط في المصالح الصغرى. وهو ما جرى تتويجه بظهور علم الابستيمولوجيا.
وفي الخبرة التراثية نجد ابن تيمية، رحمه الله، يشتبك مع العلوم المختلفة، سواء في كتابه “درء تعرض العقل والنقل” أو في كتابه “موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول”، أو الاشتباكات التي كانت لتلميذه ابن القيم، في محاولة الجمع، مرة أخرى، لهذا الشتات، من خلال التوسل بالمنطق.
الذي استبصر به هؤلاء هو عِظَم المَهَمَّة، وأن هذه القضية لا يمكن أن يقوم بها الفرد، وأنه لابد فيها من التكامل المنهاجي بين مختلف الأفراد. وفي هذا السياق نجد جملة تتكرر حين نقرأ تراجم الفحول الكبار من العلماء: “كان يُسَوّد في ليلة ما يُبَيّضه تلامذته في جمعة، أي في أسبوع”، حيث بدأ نوع من التعاون المفضي إلى ظهور المدرسة. رغم أن المدرسة بالمفهوم الكلي لم تكن بارزة بالشكل المطلوب، ولم تبرز إلى الآن، رغم جهود حلقة النمسا، ومدرسة فرانكفورت، ونادي روما.. ذلك أن كل هذه المدارس إنما حاولت أن تنشئ تيارات فكرية كبرى بغرض النظر الكلي والشمولي ولَمّ هذه الشتاتات.
طبعا هذا يقودنا إلى ضبط قضية الحوار مع الكتابين وآليات هذا الحوار؛ والآليات الأولى نجدها تبرز في الكلمات الأولى من قصة خَلْق الإنسان، حيث نجد في سورة البقرة، مثلا: ﴿وَعَلَّمَ آَدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ (البقرة: 30)، أي أنه تمّ غرس قدرة تفكيك المجملات، من خلال الوَسْم في هذا الإنسان، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: “حتى القَصْعَة والقُصَيْعَة”[5]؛ أي أن هذا الإنسان قادر على التسمية، وحين نُعْمِل هذه الطاقة الآن، سوف نجد مئات الملايين من الأسماء، والتّسمية هي الوَسْم، أي أن الإنسان يَرْتُب ويُثبّت لكي تستطيع التقدم، في قدرة على الرجوع، ويستطيع أن يرجع قبل أن يصل، بدون خوف من أنه لن يستطيع أن يؤوب مرة أخرى إلى هذا المنطق. الوَسْم والتّسمية هي التي تُثَبّت الإنسان وتعطيه هذه المراجع، وهذه الثوابت، التي تُمَكّنه من الحراك، في تعليم وفي تثبيت لأماكن الانطلاق، ممّا يُمَكّن من الوَصْل، ومن النّسْج، ومن الوَشْج مرّة أخرى.
إن خصيصة “الأسماء” هي التي أعطت علوم التسخير: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ (الجاثية: 12)، وهكذا نجد أن علوم التسخير قد تطورت، واستمرت؛ أي أن حوار الإنسان في هذه المختبرات، من خلال إعمال قدرة الأسماء، حوار مستمر.
في مجال آخر، نجد علوم التيسير: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآَنَ لِلذِّكْرِ﴾ (القمر: 17)، وهذه المسألة وجدناها عند الإمام الشافعي، رحمه الله، الذي وعى أهمية اللغة، ووعى أهمية المعطى، ووعى أهمية الفرد، ولاسيما في كلامه الرائع في “الرسالة” عن فروض الكفايات، حين تناول قضية فروض الأعيان وفروض الكفايات، واستدل بقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ (الأنفال: 25).
وقد قام الإمام الشاطبي بنوع من الامتداد في هذه القضية، حين قال: “القيام بهذا الفرض قيام بمصلحة عامة، فهم مطلوبون بسدها على الجملة، فبعضهم هو قادر عليها مباشرة وذلك من كان أهلاً لها، والباقون وإن لم يقدروا عليها قادرون على إقامة القادرين. فالقادر مطلوب بإقامة الفرض، وغير القادر مطلوب بتقديم ذلك القادر، إذ لا يتوصل إلى قيام القادر إلا بالإقامة، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب”([6]).
ومثلما حصل في علوم التيسير نوع من الركود، فإن علوم التسخير حصلت فيها أزمة، حين انفصلت في القرون التي يسميها الغرب “الوسطى”، انفصلت عن أصلها الذي هو الكون، ولم يكن البُعْد الإمبريقي حاضرا، أي التجريب الذي يضمن الوصل مع المصدر، أي إجراء الحوار، وتمكين شجرة هذه العلوم من مدّ جذورها في أرضيتها، لكي تأخذ عناصر الاحتياج، فتنمو وتصبح وارفة الظلال، وتصبح مثمرة، هذا البُعْد الإمبيريقي هو الذي انتبه له علماء المسلمين، من خلال قضية القياس، وقضية التقويم، وقضية الفحص.
ولنأخذ، على سبيل المثال، قضية الدولة الإسلامية، وذلك حتى نرتبط بواقعنا الراهن؛ حين تقوم داعش بإقامة دولة الخلافة، فإننا إذا ما قرأنا الأمر بدون قياس، فإن القضية تبدو بالغة الخطورة؛ لأن الوجهة غير واضحة، لكن حين نضع قضية الآيات، والعلامات، والمقصد، والقبلة، لتغدو الوجهة هي رضوان الله، وهي تحقيق مصالح الأنام، بحيث يمكن أن نجمل ذلك في ستة أمور كبرى، هي: الحفاظ على الحياة، لأن الأبدان تقوم بها الأديان، ثم الحفاظ على الدين، والحفاظ على الكرامة، ثم الحفاظ على النسل، ثم الحفاظ على العقل، ثم الحفاظ على المال، أو على المِلْكِيّة.
ماذا يعني اضطلاع الدولة بالحفاظ على الحياة، ما هي عناصر دفتر تحملات الدولة في ظل هذه المقاييس؟ التي تمكن من قياس الوجهة، وسلامتها، في اتصالها بالقبلة، من خلال مدخل المقاصد، أو الضروريات، بحيث إذا فككنا قضية “الحفاظ على الحياة”، مثلا، سوف نجد الحفاظ على الصحة من خلال تكوين الأطباء، والممرضين والممرضات، وبناء المستشفيات، وتشجيع الصناعة الصيدلية،وإشاعة الأمن في المدن، وتحقيق الأمن الغذائي، إلى غير ذلك من الأمور، ويصبح كل عنصر من هذه العناصر، ضمن خانة الحفاظ على الحياة، يخضع لجملة من المعايير والمؤشرات التي تُمَكّن من قياسه، كما تُقاس الأمور الاقتصادية، وأمور حقوق الإنسان..
أقول كل هذا، لكي أخلص إلى قضية، وهي أن كلامنا عن الوجهة بنوع من الاستباحة دونما ارتباط بإرثنا، وبالكسب العلمي الدقيق، ليس في الحاضر فحسب، وإنما في الماضي، لكي نضبط الأمور بكل هذا الكدح والمكابدة التي كابدها علماؤنا، من أجل القيام بالقسط، سوف يبقى كلاما عاما، لكن نجد أن عندنا مفاتيح، من شأنها أن تسعفنا في تفكيك هذه الأمور إلى مؤشرات قابلة للقياس، وتمكننا من تنقيط هذه الدولة التي تسهر على الحفاظ على الحياة، وسوف يصبح هناك تنافس، ولا يمكن لأي كان أن يقول ما شاء، وإنما سوف يكون مضطرا إلى أن تكون المؤشرات القابلة للقياس شاهدة بالقدرة على الحفاظ على الحياة، وإلا سيبقى الكلام هلاميا. وهكذا سوف تتوافر هذه القابلية لقياس مدى صلاحية الوجهة، لكي تُتَبَنّى أو لا تُتَبنّى، أنْ يُعْلَم هل هي سليمة أو غير سليمة، وهو مفهوم المحاسبة الذي تكلم عنه المحاسبي، إذ أصبح اسمه معبرا عن همه رحمه الله ورضي عنه.
ونفس الأمر ينطبق على مقصد الحفاظ على الدين، والحفاظ على العقل، ما معنى الحفاظ على العقل، أين هي المدارس، أين هي المناهج، أين البرامج، أين شبكة التمثلات والانكسارات المعرفية، والنقل من الوجود العيني المشخّص، إلى الوجود الذهني، إلى الوجود الشفهي، إلى الوجود البَنَاني، إلى الوجود الافتراضي، يعني من أجل أنْ نفعل ونقوم بالذي ينبغي أن نقوم به، فنصبح موقّعين.
بمعنى أننا سوف نخرج من الإجمالات، بفعل هذه التفكيكات لـ”الأسماء”، ونصبح قادرين على أن نتحاور مع الكتاب، كتاب التدوين، عبر الكلمات، وعبر علوم التيسير، في استمداد لهذه الوجهات، ولمعالمها ومؤشراتها، بشكل أقرب إلى الوضوح.
بطبيعة الحال، حين يكون هذا البذل، بهذا الشكل الذي ذكرناه، فإنّا سوف نصبح مدعوّين لرفع حالة الخُلْف التي نعيشها، حالة خلف خطيرة، يعني نحن الآن في حرج، باعتبارنا مسلمين، مؤسساتنا تعيش جملة من الانسدادات، ومن الانحباسات. ولنتصور شخصا من بيلاروسيا يقول: قرآنك يقول: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآَنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ (الإسراء: 9)، وحال المسلمين اليوم ليست التي هي أقوم، أين هو هذا الكلام عن الوجهة؟ هل نحاول أن تضمد الجراحات من خلال عقد هذه الندوات، واستثمار هذا الذي تستثمره في هذه الندوات بحق، وبميزان وبعدل، من أجل أن تصل إلى جليّة الأمر، أم أننا تضمد الجراحات، ونحاول أن نتغنّى على الأطلال؟ ونقول نحن ﴿خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ (آل عمران: 110)؟[7].
إذا لم نحلّ هذا الإشكال فإن كلامنا يصبح لا مصداقية له. فإذا لم ترفع حالة الضّعف، حتى عند أبنائنا الذين هم في ذهول عن حقيقة هذا الذي كنا نتحدث عنه، وكل هذا الألَق والبهاء والجمال الموجود في كل الطبقات والموازين التي تحدثنا عنها، فَإن زَعْمُنا أننا نمتلك بوصلة الوجهة، وأنّ القرآن فيه علوم الوجهة، سوف يبقى محل شك. فهل إلى خروج من سبيل؟ نعم ورب العزة؛ هناك بفضل الله تعالى المخرج.
المَخْرَج يتمثل في سبعة مفاصل متواشجة ومتكاملة، ولكن وراءها كدحا كبيرا، ومكابدة وعناء مستمرّين، ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَد﴾ (البلد: 4)، ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾ (الانشقاق: 6)، ولا يمكن أن يكون الخروج من حالة الخُلْف، من خلال:
دع المكارم لا ترحل لبُغيتها *** واقعد فإنّك أنت الطّاعم الكاسي[8]
المفصل الأول: وهو تجديد مناهج الاستمداد، على النحو الوظيفي الذي فيه قراءة الآيات، مناهج الاستمداد من كتاب الحركة، ومرجع الحركة، ومناهج الاستمداد من مرجع الوجهة، من خلال بناء شبكة التمثلات بالطريقة السليمة، لأن مناهجنا التربوية أمست للأسف الشديد عبارة عن مُراوَحَة في المكان، كساقية جُحا تسقي من البحر وتصبّ في البحر.
إذا لم نَعِ بأنّ هذه الأمور التي ذكرناها من الجسم السليم، ومن النقل لمفردات الوجود العيني، إلى الوجود الذهني، إلى الوجود اللفظي، إلى الوجود البَنَاني، إلى الوجود الافتراضي، والتخزين بشكل سليم، وبناء قدرة الاستدعاء لما يُخَزّن بطريقة وظيفية، في وعي بأن كلّ الكفاءات الموجودة في المجتمع متكاملة، فأنت تتخصّص في هذا المجال، والآخر يتخصّص في هذا المجال، وتُرَبّى عندنا قدرة الاستمداد، واستدعاء ما يتم تخزينه بالطريقة التي يمكن بها التخزين، من خلال التمارين التي تنقش وتنحث قدرة الاستدعاء الوظيفي لتوظيف المعلومة في مكانها المناسب. وهذا هو الفرق بين التعليم الوظيفي والتعليم غير الوظيفي، وهذا حقل أول/مفصل أول كبير، يتصل بقضية مناهج التعامل مع النص.
المفصل الكبير الثاني: وقد بدأت هذا مُقَدِّما له على بناء الرؤية، وإعادة ترميم الكلّيات، والقيم الحاكمة، والقيم العملية الوظيفية، والقيم التفصيلية، ثم الحديث عن الكليات، والحديث عن المقاصد، والحديث عن التشريعات، والحديث عن البُعد الروحي، والحديث عن المجالات السلوكية.. قدّمت هذه المسألة، لأن الإنسان هو الذي سيفعل كلّ ذلك.
البُعد الثاني، هو قضية الرؤية التي تَنْظِم هذا الحَراك، وتكون بمثابة المشروع المجتمعي، الذي يُعيد الوَصْل، في وعي بالوِجهة مع قضية الأُمّة، وأنّ الإمامة في هذه الأمّة تتغيّى السير نحو القبلة، وتشبيك الوجهات، لكي يكون السير أمكن، والوصول أضمن، نحو القبلة، والتي نتدرّب، على الأقل، خمس مرّات في اليوم على استحضارها، أي القبلة والوجهات، ﴿وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا﴾ (البقرة: 147). هذا تدريب، وحين نذهب إلى العمرة أو الحج نطوف، أي أنّ على الإنسان أنْ يطوف من خلال الحَراك التعارفي، لكي يحققّ هذا التكامل، وهذا التواشج.
أقول، الجانب الثاني، أو المفصل الكبير الثاني، يتصل بطريقة الحكامة والتشبيك، من خلال نَسْج مشروعات مجتمعية تعيد الوصل بين الأمة، والسير إلى الله، عز وجل، في استحضار لقضية الأعمدة، أي المشاريع التفصيلية والتجزيئية، هذه كلها رياض أنف، تحتاج إلى انخراط أمثالكم وأمثالكن، تحتاج إلى إعادة هيكلة قضية التعليم، والشّعب، والتخصّصات، مرّة أخرى، لكي يكون هذا الحراك بهذا الشكل، الذي يضمن هذا الوصل بين الأمّة والإمامة، والحراك المشترك، واستخراج الكفايات والتخصصات، بعد أن تكون شبكة التمثلات وقضية الاستدعاءات؛ الجانب الثاني أو المفصل الثاني هو هذا المشروع المشترك.
القضية الثالثة: هي قضية الحكامة، كيف يمكن أن نمسك بهذه الخيوط كلها، وأنْ يكون حَراكُنا حراكاً واعياً، في وعي بأن نُخَبنا اليوم هي نُخًب لا ترقى، من خلال مدارك إبصارها الراهن إلى هذه المستويات، وأنّ المفكرين والمفكرات الكبار، الذين من واجبهم أن يضمنوا لنا هذا المفصل الثاني بوضوح، قد استقالوا، لم يبق هناك حديث عن هذه الأمور، وأصبحت تُرى كما لو كانت مثالات، وكما لو كانت أمورا بعيدة المرام، وتنظيرات لا حاجة إليها. التنمية الاقتصادية، الأمن العسكري، السِّلم السياسي، التنسيق، الكتل السياسية، إلى غير ذلك، مما أصبحنا فيه منشغلات ومنشغلين، عن هذه الدوائر من الحكامة، والتي تحتاج، فعلا، إلى أعمال مفكرينا ومفكراتنا لإعادة إظهار هذا الأُفق.
وهذا المفصل يسميه القرآن المجيد “الإبصار”، قال عز وجل: ﴿وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ﴾ (الصافات: 179)، لأن الرائد إذا لم يكن مبصرا أنّا له أن يقود؛ لأن الرائد لا يكذب أهله، لا بدّ أن يكون الإبصار ﴿وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ﴾ (الصافات: 175)، ﴿وَلَقَدْ رَآَهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ﴾ (التكوير: 23)، الذي يستحيل كالزّجاجة المكبّرة، التي تُظْهِر الصورة أقرب وأوضح. والأفق المبين يكون كذلك؛ أي مبينا حينما يستحيل كالزجاجة المكبّرة، وهذا الأفق المبين، هو الأفق الذي يتيحه القرآن المجيد، حينما يجعل الإنسان قادرا على هذا الإبصار، وعلى رؤية هذه الأمداء، ﴿وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى﴾ (النجم: 41).
قوة اقتراحية فظيعة، تُمَكّن من ثلاثة أضرب من التوحيد، توحيد الخالق عز وجل، وتوحيد الجنس، وتوحيد العدو، قال سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾ (فاطر: 6). توحيد العدو في غاية الخطورة، وتجعل الإنسان مستبصرا بأنّ ثمّة من يروم التفرقة، وأنّ ثمّة من يروم التجزئة، وأنّ هذه التجزئة لا يمكن أنْ تقوم على عرق أو على جنس، لأنّ المشروع الكلّي هو مشروع واحد في نهاية المطاف، ولاسيما في ظلّ عالم مُعولَم، يمر تيار التأثير والتأثر بين جنباته بهذا اليسر الذي أصبحنا نراه.
إذن، الإبصار، وأنْ يعودَ المفكرون، وتعودَ النّخب، إلى القيام بهذه الوظائف، لكي تصبح النّخب المكلفة بالتنزيلات قادرة على الاستهداء؛ لأننا وقفنا عند درجة السياسة، ونسينا أفق الرؤية، وأفق الفكر، وأفق الإبصار، الذي يوحي بالسياسة، ويوحي للمناهج، ويُوَجّه الإبصار، ويوجه كل الأنشطة في الدوائر الستة التي ذكرناها.
المفصل الرابع الهام: هو مفصل المجامع التي تكون بينها أنساق تُمَكّنها من التكامل، في كل الدوائر السالفة، وهذه الأنساق تنمو، ولكن تنمو في إطار الوعي بالكلّية، ولا تنمو في اتجاهات متعددة، وهذا هو بُعد التأليف الذي يبرز في القرآن المجيد، وآلية التأليف، قال عز وجل: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (الأنفال: 62-64)، أي أنّ السياسات، والتي لامسها العلامة سيدي عبد الحي الكتاني رحمه الله، الذي كتب “التراتيب الإدارية”، لامس هذه القضية، ولامس مسألة المجامع هذه، والتي ينبغي أنْ تنمو في التوقيعات التي تلت المرحلة النبوية، في تآلف، واستحضار لـ﴿وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ﴾؛ أي أنّ العمل وجب أنْ يبرز فيه بُعْد التأليف بهذا الشكل.
المفصل الخامس: هو الذي كنّا نتحدّث عنه، قضية “القياس“، أي أننا لا يمكن أنْ نترك من الآن فصاعدا، القضايا في هلامات، وفي كليات، وفي عموميات، دون أنْ يكون هنا القياس، من خلال المؤشرات، التي تُمَكّن من الفحص، وتمكن من هذا القياس، انطلاقاً من الحاضر، واستحضاراً للمآلات، فتحاً للذرائع، وسدّاً الذرائع، ورَعْياً للمصالح، وكلّ ما كان في خدمة العباد، سيْراً إلى رب العباد.
المفصل السادس، في غاية الأهمية؛ وهي قضية النسج بين القدرات، مثلا عندنا إشكالات، نسميها إشكالات الألفية، مثلا إذا أردت أن تعرف التطور الذي وقع في العلوم الإسلامية، وأخذت مرحلة الوحي، والحَمَلة والكَتَبة، ثم بعد ذلك أخذت مرحلة المتلقّين عن سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، الصحابة، والمعروف منهم من الحَمَلة الكبار حوالي ألف ونيّف، وكلّ له مسانيده التي هي معروفة عند أهل الاختصاص، ثم بعد ذلك اجتهادات الصحابة، وهي معروفة معلومة، ولاسيما بعد سيرهم نحو الكوفة، وسيرهم نحو دمشق، وسيرهم نحو البصرة، وغيرها من المناطق التي ساروا نحوها، ثم بعد هذه المرحلة، مرحلة التابعين، وأتباع التابعين، ثم العلماء المجدّدين، ثم بدأت الفنون تظهر، وفي كل قرن على الأقل مائة من الفحول؛
بمعنى أننا سوف نجد الإنسان أمام حوالي خمسة آلاف ونيّف شخصية فارقة محورية، إذا أردت أن تفهم ما الذي حدث في بِنْيَتِك العلمية، فلابدّ أن تنظر النظر المليّ والوفيّ، إلى كل شخصية وعطاءاتها، بنظرة متفحّصة، وكلّ شخصية تحتاج إذا أردنا أنْ ندرسها بطريقة تكاملية، على الأقل، إلى أربعة أشخاص يتكاملون على مستويات: البُعْد الاجتماعي، والبُعْد الفكري والعلمي في الواقع، والشيوخ وتأثيراتهم، وكذلك التوقيعات، في تجاوب مع التحدّيات، أربعة أشخاص على الأقل؛ بمعنى أنّه عندنا أربع سنوات، على الأقل، ما يعادل عشرين ألف سنة، إذا أردنا أن نرصد قضية واحدة، هي قضية التغيرات التي وقعت خلال هذه المدة، فإذا أراد إنسان فرد أن ينهض بهذا لوحده، فإنه يروم الخيال، لكنْ إذا فهم بأنّ تقوى الله في الأرحام ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ (النساء: 1)، يفيد أن يستعمل الذكاء المجموعي، الذي يتيحه هذا البعد الرَّحِمِي، لكي يتحرك ويستبين هذه الأمور، بحيث لا يصعب عليه أن يستبين عشرين ألف باحث في المنطقة. وذلك عبر بناء الدلائل التكوينية التي تبني القدرات، لكي يكون التأهيل من خلال المواقع الاجتماعية، دون استقدامهم من أماكنهم، لكن في مواكبة لحملة تواصلية إعلامية، تجعلهم يستيقظون ويبدأوا النّفير. في العالم الإسلامي كلّه..
لماذا تصلح هذه التكنولوجيات الحديثة، إذا لم نوظفها بهذه الكيفية؟ بمعنى أننا نسبح في عصر الإمكان، والألغريتمات الممكنة من هذا، والشركات العابرة للقارات، تعمل بهذا المنهج، فنحن، ولله الحمد، لا نتكلم في الخيال، وأنّ زمن ﴿آَتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا﴾ (الكهف: 92)، قد ظَهَر وأَزِف، حتى نرفع حالة الخُلْف.
بمعنى أننا اليوم، في إطار هذا التقوى لله في الأرحام، نتمكّن من بحث هذه القضايا الآن، بيسر بالغ، ونستبين، لكن إذا كتب كل واحد من هؤلاء العشرين ألف، مائة صفحة، وضربنا هذه المائة صفحة في عشرين ألف صفحة، مليارين من الصفحات تقريبا، مائتا مليون صفحة، من سيقرأ مائتا مليون صفحة، بمعنى أننا نحتاج إلى بُعد الأولغريتمات لبناء المداخل والشبكات، التي تُمَكّن من قراءة الرحيق والعصارة، وتصبح عندنا شبكة قابلة للقراءة، وهذا ممكن؛ إذ تصبح عندنا شبكة تُبَيّن للإنسان من خلال مداخلها التي تُعتصَر فيها، بفعل هذا الذكاء الذي أصبح ممكنا الآن، كل هذه النتائج، وتعرف ما الذي حصل في العلوم الإسلامية خلال هذه 1437 سنة، نضيف عليها 13 سنة، بمعنى أنه عندنا 1450 سنة، وعندنا إمكان بفضل الله تعالى أن نستفيد من هذا الذكاء الجماعي، لكن حين نصعد عبر هذه المفاصل الستة السابقة، ونصل إلى البعد المتعلق بالرؤية، سوف تجد المسألة في غاية الإمكان.
المفصل السابع الذي يُمَكّن من هذه الأمور، أنّ الحاجة ملحّة، وأنّ المبادرة لابدّ أنْ تكون، وهذه المبادرة لابدّ فيها من محاولة برمجة في غاية الدّقة، تُبَرمَج عبرها كل هذه الحركات، انطلاقا من الوعي بكل الأمور سالفة الذّكر، والبرمجة أيضا أمر في غاية الإمكان، وتُمَكّن من التقويم، وتمكّن من القياس.
فالتعاطي مع هذه الأمور بأجمعها، لن يُستَغرَق وقتا طويلا، إذا تمّ الوعي بها، والاستبصار بها، أي أنّنا نتحدث في ظلّ هذا الإمكان، الذي فيه التوزيع لقطع “البازل”، للمهام على القادرات والقادرين، من خلال هذا التواطؤ والروح التي تنبثق وتندهق وتنبجس حين يكون الإبصار، ﴿وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ﴾ (الصافات: 175)، حين يكون الإبصار لا يبقى هناك التردّد، ولن تبقى هذه القافلة متيمّمة شطر اليمين، واليسار، والجنوب، والشمال، والغرب؛ تصبح هناك إمامة، وتصبح هناك أمّة، لأن هناك توجها، وهناك قبلة واضحة المعالم.
لا شك أنّ هذا العمل، يحتاج إلى جُهد، وإلى اجتهاد، خصوصا وأن ميزة الإنسان، أنه حين يبصر يصبح قادرا على الفعل، على حد قول الإمام الشافعي:
إنّــــي رأيت وقوفَ الماء يُفسِده *** إن ســاحَ طاب وإن لم يَجْرِ لم يطب
والأُسْد لولا فراقُ الغاب ما افترست *** والسّهم لــولا فراقُ القوس لم يُصِب
والتِّبْر كالتُّرْب مُلْقًـى في أماكنه *** والعــودُ في أرضه نوعٌ من الحطب[9]
وتحسبُ أنّك جُرْمٌ صغيــرٌ *** وفيك انطـوى العـالمُ الأكــبرُ[10]
لكنّ هذا لن يكون إلا إذا بدأ العمل، ثم بدأت تظهر الأعمدة، والمؤسسات، التي تُبَيّن إمكانية الاهتداء إلى التي هي أقوم، من خلال تحريك هذا الوعي الكامن في كتاب الختم الذي يهدي فعلا للتي هي أقوم، وحين يتم التعاطي مع كل ما مر ببرهانية، تبدأ، في وقت وجيز، بفضل الله تعالى الثمرات بالظهور، لأن البعد البرهاني هو البعد الأكثر إقناعا للإنسان، وهنا لا بد من الرؤية بكل مقوماتها؛ وقد نُقِش ونُحِت اسم أتباع الأنبياء الخُلّص بالأمر بالقسط، الذي هو وظيفة الأنبياء، وأتباع الأنبياء الأولى، قال عز وجل: ﴿وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 24)، وقال سبحانه وتعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ﴾ (آل عمران: 21)، وهذا الأمر بالقسط هو الذي تدخل تحته كلّ الأمور المتعلقة بالمفاصل التي ذكرناها آنفا.
علم الوجهة، إذن، هو كل هذه الأبعاد أيها الأحبة، وعلم الوجهة في عالم متغير، لا يمكن أن نتصوّره من دون الكدح المسؤول، من خلال بناء القدرات لرفع حالة الخُلْف.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
الهوامش
[1] . صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب خاتم النبيّين صلى الله عليه وسلم، رقم: 3535.
[2] . صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، رقم: 2585.
[3] . صحيح البخاري، بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، رقم: 1.
[4] . صحيح البخاري، كتاب العلم.
[5] . انظر: تفسير الطبري، 1/483-484.
[6]. أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق: عبد الله دراز-محمد عبد الله دراز، دار الكتب العلمية، ط1، (1425ﻫ/2004م)، (1/284-285).
[7] . قد يقول لبيلاروسي مثلا وغيره: أنا يا أخي المسلم، لا أرى أنك فعلا خير أمّة أخرجت للناس، ولا أرى أنك فعلا هُديت للتي هي أقوم، من خلال تعاملك مع المرجع الذي تزعُم أنه مرجع الوجهة، الحرب في اليمن، الحرب في سوريا، الحرب في العراق، الحرب في ليبيا، الحرب في كل رقعة من رُقَع عالم الإنسان المسلم، والحرائق شبّت في كل مكان، يعني لا أرى أنك قد اهتديت فعلا للتي هي أقوم؟
[8] . انظر: ابن قتيبة، الشعر والشعراء، 1/315.
[9] . انظر: جواهر الأدب، 2/490.
[10] . انظر: مجمع الحكم والأمثال، 9/265.