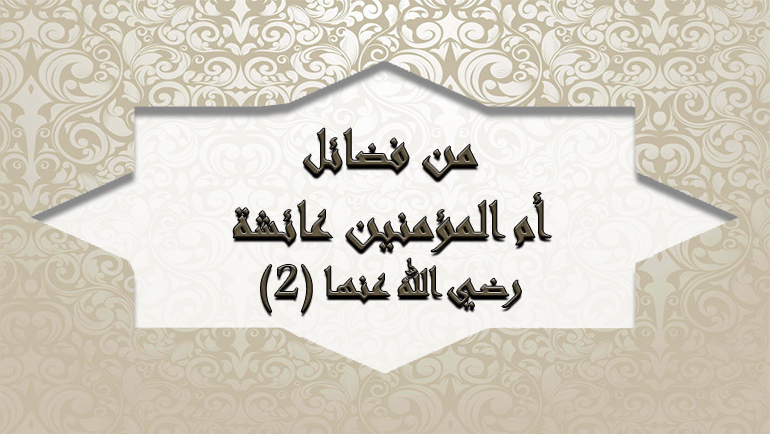الإشكال العلمي الذي نقصد إثارته، هو مباحثة في أهدى السبل إلى التحقق بمعاني الخطاب الشرعي، والاهتداء بهديه، على مستويي تفسير الوجود وتدبير الموجود.
ذلك أن مشكلة الأمة اليوم، وهي تسعى لاسترداد موقعها الحضاري بين الأمم، والنهوض بواجبها الشرعي، واجب الشهادة على الناس، تدرك تعدد الجبهات، وكثرة الواجبات، ويدفعها اجتهادها إلى تقدير أولا الأولويات، وآكد المطلوبات مراعاة للحال، ونظرا منها للمآل. وقد انتهى بها الفكر إلى أن مشكلتها من بعد تقسيم وصبر، هي مشكلة العلم، ومداره على العلم الشرعي الحامل لمسالك الهدى في الفعل والترك، المقيم لنظر اجتهادي مميز بين أولويات الفرد وأولويات الأمة.
وإن مناط تحقيق تلك الأولويات، الإحسان في فقه الدين فهما وتنزيلا، وإدراك أحكام الله نصا واستدلالا[1]، إذ به تصل الأمة أفرادا وجماعات، دولا ومؤسسات، إلى منزلة الرشد في القول والعمل، وبه تستوجب في الناس موضع الإمامة، فتدفع عن الدين تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين.
وإن الناظر في تاريخ العلوم الإسلامية، تحديدا لطبيعتها المعرفية، وبيانا لوظيفتها المنهجية، يدرك أن علم الأصول هو موئلها حين تشتد بها الأزمات، وتحاصرها المستجدات. ذلك أن مدار العلم -علم الأصول- على بناء العقل المسلم بناء مقاصديا، يعلمه صنعة التوازن بين مراد الشرع وأحوال الناس وأوضاعهم، حملا لهم على الوسط، وإجراءا لأحكامه تحت نظر العدل[2].
وإن هذه الورقات باتخاذها عنوان: “المعنى بين اللفظ والقصد في الوظائف المنهجية للسياق”، تحاول أن ترصد ذلك التوازن بتحديد إشكال المعنى، وبيان المسالك المفضية إليه. فهل يكفي فيه الوقوف على موجب اللفظ؟ أم نتعداه إلى اعتماد القصد ويلزم قبل ذلك وتمهيدا له تحديد المراد باللفظ وبالقصد، وتحديد الطرق المفضية إليه الهادية إلى إدراكه. وستخلص هذه الورقات إلى أن القصد متلقى من اللفظ، وأن الدال عليه من بعد (الوضع) هو سياق الخطاب. ومن ثم ستسعى إلى تحديد مدلول السياق، وحصر أنواعه، ورسم وظائف كل نوع، وإبراز مستنده المعرفي، بما يمهل لبناء (نظرية للسياق) ضمن النظرية العامة لتحليل الخطاب الشرعي.
ولتحقيق تلك الغاية، لن تقف هذه الورقات عند نقل النصوص، وإنما تشير إليها إشارات، مراعاة للوقت، وتقديرا للمستمع من حيث إدراكه للواقع في الدرس الأصولي.
إن السياق، وإن كان غالبا ما يوصف بأنه مصطلح متمرد، يأبى التحديد، فإنه يعتبر مصطلحا جامعا لمعاني متحدة الأصول، متشعبة الفروع. ومن ثم يمكن القول، إنه “مجموع الوقائع، اللغوية، وغير اللغوية، المتصلة بالخطاب، والمنفصلة عنه” وإن تصنيف ذلك بحسب طبيعته في ذاته، أو بحسب زمن وروده، مرتبط بالوظيفة المنهجية التي يؤديها، وبالمحل الذي يحتاج فيه إليه. وهو في كل ذلك له تعلق بطبيعة العمل الاجتهادي، ونوعه. وحاصل الأمر أن الاجتهاد الواقع في الشريعة على نوعين: اجتهاد فهم واجتهاد تنزيل. ويلحق بهما أنواع من النظر بجامع الفهم أو التنزيل. وإن كلا من الاجتهادين به خصاصة تلجئه إلى السياق، ويستمدان من قصد الشارع. وعليه يكون السياق بمختلف عناصره، وزمان وروده مكونا من مكونات منهجي الفهم والتنزيل، وخادم لقصد الشرع، وذلك بمراعاة حال المكلف في مرحلة الفهم ومراعاة حاله في مرحلة العمل.
1. السياق وقصد الإفهام
إن اعتبار السياق في المنهجية التشريعية، في مرحلة الفهم عن الشارع مراده، أمر يجد شرعيته في قصد الشارع الإفهام، لأن من شرط تحقق مقصد الامتثال، كون ما وقع التكليف به (معلوما للمأمور، معلوم التمييز عن غيره، حتى يتصور قصده إليه)[3]، وإلا كان التكليف تكليفا بما لا يطاق، إذ (كل خطاب متضمن للأمر بالفهم)[4] ولذلك قبض علماء الأصول أنه لا يوجد في خطاب التكليف ما يخرج عن الفهم. وحصروا طريق الفهم في قاعدتي (الوضع) و(الاستعمال). وما الاستعمال إلا مسلك قائم على اعتبار السياق، وإليه الإشارة بالقرائن في قول الغزالي (وطريق فهم المراد من الخطاب تقدم المعرفة بوضع اللغة التي بها المخاطب، ثم إن كان نصا لا يحتمل، كفى فيه معرفة اللغة، وإن تطرق إليه الاحتمال فلا يعرف المراد منه إلا بانضمام قرينة إلى اللفظ. والقرينة إما لفظ مكشوف.. وإما إحالة على دليل العقل.. وإما قرائن أحوال من إشارات، ورموز، وحركات، وسوابق ولواحق، لا تدخل تحت الحصر والتخمين، يختص بدركها المشاهد لها، فينقلها المشاهد من الصحابة إلى التابعين بألفاظ صريحة، أو مع قرائن من ذلك الجنس، أو من جنس آخر توجب علما ضروريا بفهم المراد، أو توجب ظنا)[5].
ومن ثم كان الأصل المنهجي عند الأصوليين إعمال الدلالة الأصلية للفظ فلا يبتغى المعنى في سواها اكتفاءا بالمعنى المتلقى من اللفظ وهو المدلول عليه بالنص، وهو ما عناه الإمام الشافعي بعبارته الشهيرة “ما استغني فيه بالتنزيل عن التفسير”. ولا يلجأ إلى السياق إلا عند عدم قدرة الوضع على الوفاء بالمعنى! وخشي الفقيه من أن يفوته المعنى المراد، ولذلك قرر الرازي (أن الخلل الحاصل في فهم مراد المتكلم)، إنما يحصل بناء على خمس احتمالات في اللفظ، وهي احتمال الاشتراك، والنقل، والمجاز، والإضمار، والتخصيص)[6]. ثم استفرد مبينا وجه الحصر والتقسيم قائلا: (والدليل على الحصر، أنه إذا انتفى احتمال الاشتراك والنقل، كان اللفظ موضوعا لمعنى واحد، وإذا انتفى احتمال المجاز والإضمار، كان المراد باللفظ ما وضع له، وإذا انتفى احتماله التخصيص كان المراد باللفظ جميع ما وضع له، وعند ذلك لا يبقى خلل البتة في الفهم)[7].
وإن مما يساعد على تبين هذه الوظيفة المنهجية للسياق ما نبه إليه إمام الشافعي بقوله: (فإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من معانيها، وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها، وأن فطرته أن يخاطب بالشيء عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر، ويستغنى بأول هذا منه عن آخره، وعاما ظاهرا يراد به العام، ويدخله الخاص، فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه، وعاما ظاهرا يراد به الخاص، وظاهرا يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره..) وإن في تفصيل هذه الوجوه في الرسالة، ما يقوي اعتبار السياق في الفهم، ويفيد في تبين الحدود المنهجية لإعمال السياق وضابطه أنه لا يحتاج إليه إلا عند استعمال اللفظ (المفرد والمركب) على خلاف ما وضع له.
ويتسع عمل الأصوليين في باب التأويل ليعتمد السياق بأوسع مظاهره، حيث يتعاملون مع اللفظ في مختلف أوضاعه، وأحوال وروده، وما سيق له، وهو اعتبار حال المخاطب قصد الإفهام، وذلك باعتماد قاعدتي الوضع والاستعمال، حيث يكون السياق جزء من نظرية تحليل الخطاب، جامعها إعمال الوضع، وعند عدم كفايته ننتقل إلى الاستعمال وضابطه السياق مستقلا عن الخطاب أو بما هو جزء منه، مقارنا له، أو سابقا عليه، أو لاحقا به.
وإن من مظانه اعتبار أسباب النزول، واختلاف أحوال اللفظ في أساليب الورود، وأنواع الخطاب ودلالات الأمر والنهي، وصيغ الخبر والإنشاء، ودلالات صيغ المدح والذم، والإلتفات، وأنواع التركيب حين يراد بها غير الأصلي فيها عند التقديم أو التأخير وعند الذكر أو الحذف.
وتمتد شواهد الإعمال -بقصد الإفهام- لتشمل وجوه الدلالة من غير المنطوق كما في قول الغزالي عن دلالة المفهوم الموافق (فهم غير المنطوق من المنطوق بدلالة سياق الكلام، ومقصود المتكلم)[8].
ومما يجري فيه ضابط السياق في الفهم ما يوصف عادة عند الأصوليين بمبدأ الجمع بين النصوص الشرعية، منعا للتعارض، وإبرازا لوحدة القصد وتحقيقا لمبدأ الانسجام بين النصوص. وإن الظاهر من عمل الأصوليين أن كل ما ظاهره التعارض والاختلاف، إنما يلحظ فيه اختلاف السياق مقاما وأحوالا، فيتقدر الفهم بقدره. ولذلك منعوا المجتهد من الحكم قبل النظر في المخصص، والمبين، والناسخ. وبناء على ذلك منعوا من تأخير البيان عن وقت الحاجة، سواء كان بيانا للعام بما يخصصه، أو بيان المنسوخ بناسخه، أو بيان المجمل بمفصله أو بمفسره، حتى يصير الأمر باللفظ إلى مرتبة النص أو المحكم.
وإن هذه الوحدة كما تكون بين الأدلة الجزئية، فهي تجري بين الأدلة الكلية والجزئية، وجامعها الجمع بين الأدلة، إعمالا للسياق المستمد مشروعيته من قصد الشارع الإسهام بالخطاب.
2. السياق وقصد الشارع التكليف بمقتضى الشريعة
إذا كان النوع الأول من السياق، يكاد يكون متفقا عليه بين الدارسين، فإن هذه الوظيفة يلزم فيها نوع مباحثة، تفضي إلى الإقناع بأهميتها. ولذلك فإن المراد بالسياق في هذا المقام هو مراعاة الوضع العام للتشريع، في مراحل تنزيل الأحكام على واقع المكلف رعيا لحاله، مما يفضي إلى تغير الأحكام بما يحقق مقصود الشرع من وضع الشريعة ابتداء، جلبا للمصالح ودفعا للمفاسد وهو المراد بالاجتهاد التنزيلي، وجامع هذا النوع من النظر الاجتهادي ما اصطلح الإمام الشاطبي (بالنظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة. وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام، إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل)[9] واعتبر من شواهده جميع ما مر في تحقيق المناط الخاص، ولذلك اعتبر أن (صاحب هذا التحقيق الخاص هو الذي رزق نورا يعرف به النفوس ومراميها، وتفاوت إدراكها، وقوة تحملها.. فهو يحمل على كل نفس من أحكام النصوص ما يليق بها، بناء على أن ذلك هو المقصود في تلقي الأحكام)[10].
وإن ذلك النظر الاجتهادي مستمد من قضية خطاب العزيمة وخطاب الرخصة، إذ الانتقال من العزيمة إلى الرخصة مراعاة لحال الاضطرار واعتبار للطوارئ الملجئة والموانع العارضة، وإن إطارها النظري، الأصل المقطوع به، منع تكليف ما لا يطاق.
وإن من شواهده، تغير الأحكام بتغير الأحوال، والزمان، والمكان، مراعاة لحال المكلف واعتبارا لقدراته، وهي العملية العلمية المسندة إلى الوظيفة المنهجية لخطاب الوضع.
وإن أوضع مستند لهذا المسلك المنهجي، الواقع في التشريع العام، المدلول عليه بالتشريع المكي، والتشريع المدني، حيث جرى كل ذلك بمراعاة حال المكلفين. ومن نماذجه المنهجية قضية الأصول المكية والمدنية، والتدرج في البيان، والتدرج في التحليل والتحريم لبعض المظاهر الاجتماعية. ومن ثم يمكن اعتبار السياق العام للتشريع، سياقا ضابطا لعلمية تنزيل الأحكام على محلها. وهو ما لاحظه الإمام الشاطبي عند قوله (الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط الأعدل، الآخذ من الطرفين بقسط لا ميل فيه الداخل تحت كسب العبد من غير مشقة عليه ولا انحلال، بل هو تكليف جار على موازنة تقتضي في جميع ذلك غاية الاعتدال)[11].
وقد ساق لبناء هذا المنهج نموذج فعل الطبيب الرفيق يحمل المريض على ما فيه صلاحه، بحسب حاله وعادته وقوته ومرضه وضعفه[12].
وجعل مستنده في هذا النظر صنيع الشرع فقال (أو لا ترى أن الله تعالى خاطب الناس في ابتداء التكليف خطاب التعريف بما أنعم عليه من الطيبات والمصالح التي بث في هذا الوجود لأجلهم، ولحصول منافعهم)[13].
ومن ذلك يمكن الخلوص إلى أن السياق يؤدي خدمتين في المنهج التشريعي جامعه مراعاة حال المكلف الأولى في مرحلة الفهم، والثانية في مرحلة التنزيل، ولكل من المسلكين المنهجيين مبادئ يستند إليها، وقواعد يعتمدها بما يمهد لبناء نظرية السياق في المنهج التشريعي.
الهوامش
1. الرسالة، للشافعي، ص20.
2. الموافقات، 2/164.
3. المستصفى، ص69.
4. المرجع نفسه، ص67.
5. المرجع نفسه، ص185.
6.المعالم في علم الأصول، 44.
7. المرجع نفسه.
8.المستصفى، م، س، ص 254.
9. الموافقات، م، س، 4/194.
10. المرجع نفسه، 4/198.
11. المرجع نفسه، 2/164.
12. المرجع نفسه، 4/163.
13. المرجع نفسه، 4/163-166.