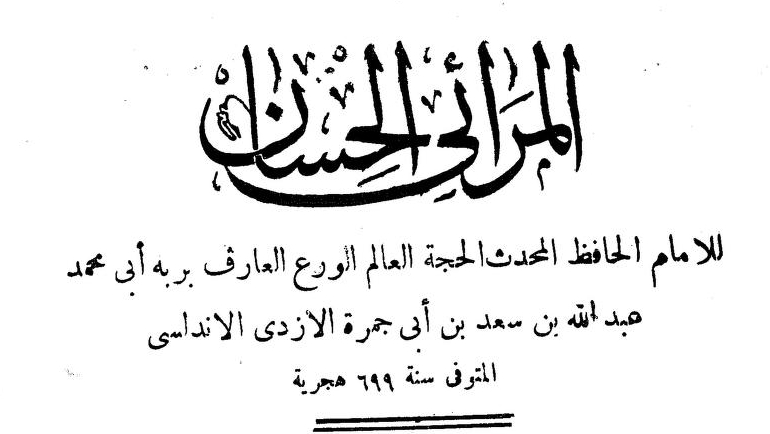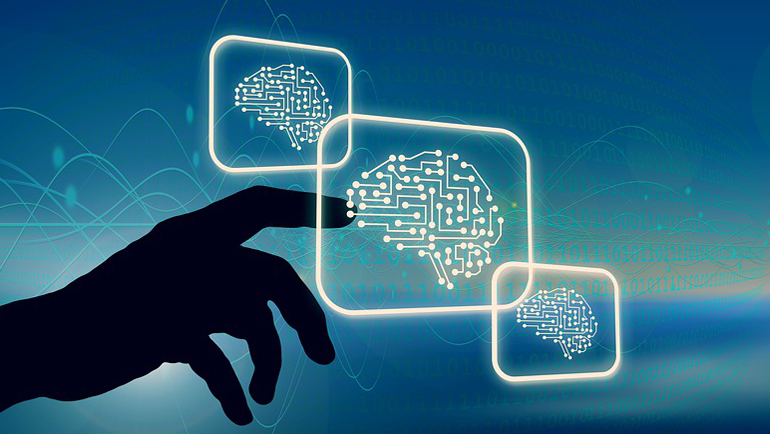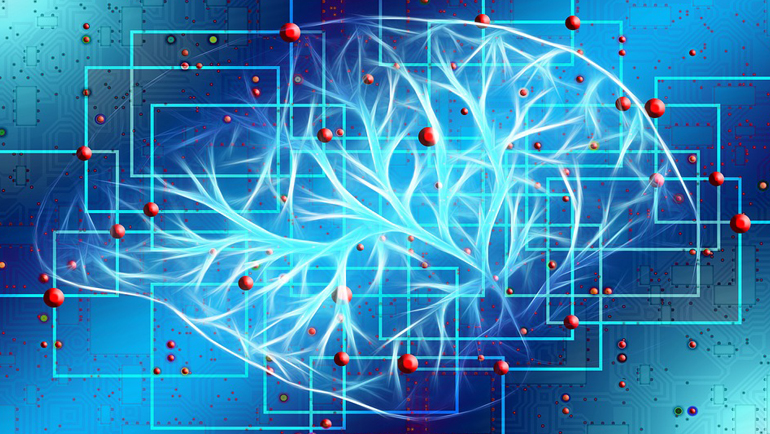صياغة المفهوم قرآنيّاً
وردت المادة اللفظيَّة “س، ي، ا، ق” في القرآن المجيد في آيات عديدة في سورة القيامة (9، 30) وفي سورة الأنفال (24)، وفي سورة الفرقان (7)، وفي سورة ص (33)، وفي سورة ق (21)، وفي سورة الفتح (29) وفي سورة النجم (42) وفي سورة القلم (42).
وفي غالب هذه الآيات الكريمة وردت الكلمة أو مادّتها للدلالة على مدلولات حسِّيَّة. مثل سوق الإبل، ومساق الناس يوم القيامة؛ أي منتهاهم إلى الله تعالى والتفاف الساق بالساق.
لكنّها وردت للإشارة إلى اشتداد الأمور في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ (القلم: 42) ففي هذه الآية الكريمة إشارة إلى اشتداد الأمور في القيامة. ويؤدي العرب نحو هذا المعنى في قولهم: “كشفت الحرب عن ساقها”؛ أي اشتدت وحمي الوطيس، ولابد أن تبلغ غايتها بانتصار فريق وهزيمة فريق.
و”الأسواق” هي الأماكن التي تجلب إليها الأمتعة فكأنّها تبدأ رحلة طويلة من موضع الإنتاج إلى موقع البيع، والانتهاء إلى أيدي المستهلكين، و”التفاف الساق بالساق” دليل على نهاية الحياة. فحين يستعار اللّفظ للاستعمال في المعاني، فذلك لما فيه من معنى “الكشف وبلوغ الغاية” فكأنّ “السياق” والحالة هذه يكشف عن المعاني، ويفصح عن مدلولات الألفاظ، ويبلغ من معانيها النهاية والغاية فلا تستطيع أن تخفي من معانيها أو مدلولاتها شيئاً. وفيه، أيضاً، إشارة إلى أنَّ الألفاظ كائنات حيَّة لها مبتدأ ولها منتهى، ولها طرق تسلكها من مبتدئها إلى نهايتها، فهي مسوقة إلى تلك النهاية، وجارية إليها؛ لتبلغ نهاية مدلولاتها ومعانيها.
والقرآن المجيد كتاب كونيٌّ، معادل للكون وحركته، مستوعب للكون وحركته، آياته معدودة (6238) آية كريمة، يستوعب ذلك، كلّه، ويهيمن ويصدّق على كل ما عداه لابد أن تتنوع دلالاته، وتعطي الناس من المعاني ما يجعل الناس في كل عصر ومصر في غنى تام عن سواه، فتتكشَّف معانيه عبر العصور عما تحتاجه تلك العصور؛ ولذلك لم يفهم البعض قول من قال: “إن القرآن حمّال أوجه”؛ فهذه الأوجه لا تعدو أن تكون معاني القرآن المجيد التي يتكشَّف مكنونه عنها عبر العصور لتستوعب مستجدَّات تلك العصور، وما يأتي فيها، فحين تفهم في هذا الإطار فإنّها تعبّر عن جانب من جوانب عظمة القرآن وإعجازه. وحين يحملها البعض، خطأ، على تعدّد المعاني الذي يؤدي إلى الاشتباه أو الغموض، أو الإجمال فإنّها تتحول إلى ما يشبه الذم للقرآن المجيد، وهو أمر لا يتوقع صدوره عمن نسب هذا القول إليه، بل يستحيل1.
إنّ الله تعالى كما أنّه قد يسَّر القرآن للذكر قد دعا إلى تدبُّره وتلاوته “حق التلاوة” وتعقّل ما جاء فيه والتفكير فيه وذلك يستلزم إضافة إلى تلاوته حق التلاوة، ومعرفة معاني ألفاظه ومفرداته، والتناسب بين كلماته في الآيات وآياته في سوره، وسوره في وحدته البنائيَّة. يجب، أيضاً، تدبّر “سياقاته” ونـزوله مفرّقاً منجماً كان لتثبيت فؤاد رسول الله،، عليه السلام،، فيه وبه وكذلك أفئدة المؤمنين: ﴿وَقُرْءاناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنـزلْنَاهُ تَنـزيلا﴾ (الإسراء: 106)، ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نـزلَ عَلَيْهِ الْقُرْءانُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾ (الفرقان: 32).
فهذا التنجيم والنـزول على مكث لابد أن يستدعي سائر أنواع “السياق” الذي نـزل فيه كل نجم من نجوم القرآن المجيد.
وهنا تتضح أهميَّة “أسباب النـزول” و”المناسبة” و”تأريخ النـزول”، ومعرفة موقع كل نجم بالنسبة لما قبله ولما بعده. ليتمكن المجتهد والمفسّر، وأهل الاستنباط، والمدركون لأسرار بلاغة القرآن ودلائل إعجازه من الوقوف من النصّ على ما لا يمكن الوقوف عليه بدون ملاحظة سائر أنواع السياق.
وإذا كان المناطقة ومن إليهم قد اعتبروا دلالات الألفاظ على المعاني أنواعاً ثلاثة، هي “دلالة المطابقة” و”دلالة التضمّن” و”دلالة الالتزام”، وقالوا بـ”دلالة المنطوق” و”دلالة المفهوم” فإن “دلالات السياق” أظهر وأبرز من تلك الدلالات، كلّّها، وهي أقواها في خدمة النص، وإبراز معانيه.
إنّ الكلام يجري إعداده في نفس المتكلّم، فالمتكلّم يعدّ ويرتّب المعاني في نفسه في المرحلة الأولى، ثم يبدأ في اختيار الكلمات المناسبة للتعبير عن تلك المعاني، ويظل يرتب فيها كلمة كلمة حتى يطمئن إلى أنّها هي العبارات التي ستفصح وتبين عما يريد التعبير عنه؛ قال الأخطل:
إنّ الكلام لفي الفؤاد وإنّما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً2.
وقال عمر رضي الله عنه: “كنت قد زوَّرت في نفسي كلاماً فسبقني إليه أبو بكر…”3.
ولذلك فقد هفا الإمام الرازي، وهفوات الكبار على أقدارهم، حين اعتبر “الدليل اللَّفظيّ” أيّاً كان مندرجاً تحت “الظن” لا يرقى إلى القطع إلا إذا تجاوز عوائق عشرة هي القطع بصحّة نقل اللغة والنحو والتصريف، وعدم الاشتراك، وعدم المجاز، وعدم الإضمار، وعدم التخصيص، وعدم التقديم والتأخير، وعدم الناسخ، وعدم المعارض4.
ولو تأمل الإمام الرازيّ “السياق” والتفت إليه بالقدر الكافي، وهو الأصوليّ القدير، والمفسِّر الكبير، المدرك لبلاغة القرآن ونظمه والسياق منه وأسرارها: لما أطلق هذا القول، ولما ساقه بتلك الطريقة. فـ”السياق” إذا أدرك على حقيقته فإنّ فيه القدرة على معالجة هذه الاحتمالات العشرة، واستيعابها وتجاوزها وحماية الخطاب القرآنيّ من أيّ أثر من آثارها.
السياق في اللغة
لم يزد جل اللغويِّين على ما وردت الإشارة إليه في معنى مادة “السياق” اللُّغويَّة في القرآن المجيد؛ فقد اعتمدوا الألفاظ القرآنيَّة التي وردت المادة اللغويَّة فيها، وساقوا لها المعاني ذاتها. لاحظنا هذا في القاموس وشرحه، وفي لسان العرب نحوه مع إسهاب في ذكر الشواهد والأسماء. وفي أساس البلاغة نجد قريباً من مرادنا بـ”السياق” قولهم: “فلان يسوق الحديث أحسن سياق”، و”إليك يساق الحديث”، لكنّه لم يبعد كثيراً عن الاستعمالات المذكورة. وكذلك كتاب “العين” و”المصباح” و”المختار” وما إليها. ففي كلّها نجد الأغلب استعمالها في أمور حسِّيّة مثل “سياق المرأة” أي مهرها. أو بعض الأمور الدالَّة على السوق إلى غاية أو نهاية كقوله:
ولمادنا منّى “السياق” تقدّمت إليّ ودوني من تقدمـﻫـا شـغـــل
أتت وحياض الموت بيني وبينﻫا وجادت بوصل حين لا ينفع الوصـل
فـ”السياق” هنا الاحتضار؛ ولأنّ الإنسان يساق به إلى الدار الآخرة حسن أن يطلق عليه “السياق”.
مفهوم السياق في تراثنا الإسلامي
أدرك علماؤنا على اختلاف المعارف التي اشتهروا بها ما للسياق من أهميَّة بالغة في جميع العلوم والمعارف ذات العلاقة بالخطاب القرآنيّ من تفسير وحديث وأصول وفقه وعلم كلام وعلوم ومسائل، وذلك لأنَّهم وجدوا فيه وسيلة منهجيَّة تساعد في بيان المراد بخطاب الشارع، ويمكن أن نجد قدراً مشتركاً بينهم، جميعاً، في بيان المراد بالسياق على سبيل الإجمال؛ وهو “ما ساق الشارع الخطاب من أجله”؛ وهذا الذي يتسوق أو حض وتحريض، أو منشئ لحكم، أو بيان لسنة كونيَّة، أو دعوة لموعظة أو اعتبار أو مثل أو بيان لسنة اجتماعيَّة أو إنسانيَّة…
وهناك قرائن ومؤشرات قد يحتف الخطاب بها تسبقه أو تلحقه إذا كانت من داخل الخطاب، وقد تكون أموراً خارجيَّة مثل الزمان والمكان وعناصر الواقع المختلفة ومناسبات أو أسباب النـزول بالنسبة للقرآن المجيد، أو أسباب الورود بالنسبية للسنن النبويَّة؛ ولذلك عرف بينهم مصطلح “القرينة السياقيَّة” للإشارة إلى بعض القرائن التي قد تحف بالنص بحيث تساعد على بيان مجمل أو تقييد مطلق، أو كشف مبهم أو ترجيح معنى على آخر.
والسياق في بعض الأحيان يكون ظاهراً بارزاً لا يحتاج إلى كثير من النظر والتدبر ليظهر، وأحياناً يحتاج إلى شيء من ذلك. وأحياناً يكون السياق لفظيّاً، وأحياناً يكون مقاميّاً، وأخرى يكون سياق نظم، أو سياق لفظ مفرد، وسياق “نطقيَّة سياقيَّة”.. وبعضهم جعل السياق في صدر الآية والعلاقات بينها وبين بيئتها القرآنيَّة. وهناك من فرّق بين “السياق والسباق” فاعتبر السياق ما سيقت الآية من أجله، و”السباق” ما سبق الآية. وعلى هذا فإنّ “السياق” إمَّا أن يراد به نصوص سابقة ولاحقة لما يراد بيانه، أو سيق الخطاب لأجله، أو تأويله بحيث يتَّضح ما سيق الكلام لأجله، بملاحظة بيئة النص التي قد تكون السورة كلها.
ويراد بـ”السياق” مقاصد الشريعة، أو عللها وحكمها، أو قصد الشارع الذي يدل النصّ عليه بنوع من أنواع الدلالة، ويستفاد منه بتأويله، أو بيانه.
وأحياناً يراد به سبب نـزول الآية أو مناسبتها أو سبب ورود الحديث أو مناسبته، ومكونات الواقع الذي نـزل الخطاب فيه، وأحوال المخاطَبين.
من هنا فإنّ من الممكن القول بأن الأئمة المتقدمين في علومنا النقليَّة المقاصدي والوسائلي قد عرفوا نوعين هاميّن شاملين من أنواع السياق المقاليّ اللّفظيّ والمقاميّ أو الحاليّ. واستفاد بكل أنواع منهما في دراساتهم لخطاب الشارع، وتحديد دلالاته وفقه المراد منه، وتحديد مستوياته في الدلالة، ومستوياته في إنتاج الأحكام.
السياق في علومنا النقليَّة
قد كان من موضوعات الاهتمام المشترك بين المعنيّين بعلومنا النقليَّة. وقد نال من الاهتمام ما جعله من المفاهيم الكبرى المشتركة بين علوم الوسائل وعلوم المقاصد؛ كيف لا وهو مما يتوقف فهم العديد من آيات الكتاب الكريم عليه. وكذلك فهم مراد رسول الله، عليه السلام، في كل ما جاء به. فـ”الخطاب” رسالة من مرسل إلى مستقبل؛ وهذه الرسالة قد تكون رسالة لإخبار المستقبل عن شيء، أو لدعوته للقيام بشيء مّا، أو الاستفهام منه أو رجائه أو حضّه وتحريضه أو أمره ونهيه. والخطاب ذاته يأتي بصياغات عديدة، وأساليب متنوعة عديدة ولا يمكن للمرسل أن يوصّل ما يريد أو يفصح ويبين عما يقصد بألفاظ النصّ المخاطب به وحدها. وللمستقبل عقليّته ونفسيّته وظروفه وثقافته وبيئته، وكلّها مؤثّرات تساعد أحياناً على فهم مراد المخاطب، وقد تعيق عمليَّة فهم مراده. وكل منهما المرسل والمستقبل يحتاج لملاحظة ذلك الذي نسمّيه بـ”السياق”، بل النصُّ الإنسانيّ عندما يتكوّن إنَّما يتكوّن في سياق حتى يصبح السياق ليس مجرد مؤثّر خارجيّ، بل هو جزء من مكونات النصّ. ولذلك اعتبر بعض الباحثين السياق متمّماً للنصِّ، والنصّ متمماً للسياق5. فالنصوص مكوّنات للسياقات التي تظهر فيها، والسياقات يجري تكوينها وتحويلها وتعديلها بشكل دائم بواسطة النصوص التي يستخدمها المتحدثون والكتّاب في مواقف معيَّنة6.
ويحدّد “السياق” معنى الجملة أو الوحدة الكلاميَّة في مستويات ثلاثة:
المستوى الأول: يقوم السياق فيه بتحديد نوع الجملة.
المستوى الثاني: يحدّد السياق فيه القضيَّة التي عبّرت عنها الجملة.
المستوى الثالث: يستدعي السياق فيه أيَّة مقاصد ضمنيَّة أو مضمرة للمتكلّم قد ينبّه كلامه إليها. أو القوة غير المنطوقة “اللاكلاميَّة” إليها. وذلك ما يطلق الأصوليون على بعض أنواعه “مفهوم المخالفة” أو “الفحوىٰ”.
وعندما نهمل السياق، أو لا نلتفت إليه بالقدر الكافي نجد أنفسنا نتردّد بين تفسيرات وتأويلات عديدة للقول قد تتدخل عوامل أخرى ذاتيَّة في اختياراتنا من بينها، منها المسلّمات السابقة، ومنها الأيديولوجي، ومنها الثقافة السائدة. وقد نسئ فهم القول، ونفسّره بشكل خاطئ لا يعبر عن مقصود المتكلّم. وعندما نفكر في المستوى الثاني الذي يحدّد السياق فيه القضيَّة التي أراد المتكلّم التعبير عنها فإنّ هذا المستوى يستدعي -ضمناً- لزمان النطق ومكانه، وأية ملابسات أخرى يمكن أن تلاحظ. مما يطلق عليه المعاصرون “سياق الظرف”.
والباحثون في اختلافات الفقهاء واستدلالاتهم لمذاهبهم بالنصوص يستطيع أن يكتشف الآثار الهامَّة لطرائق تعاملهم مع السياق، ومدى تأثيره في فهمهم للنصوص التي يستدلون بها.
تطوّر مفهوم “السياق” في إطار عمليّات التطوّر الدلاليّ
لقد تطوّر مفهوم “السياق” تطوّراً دلاليّاً ليصبح نظريَّة كاملة عرفت في عصرنا هذا بـ”النظريَّة السياقيَّة”.
وقد جاءت “النظريَّة السياقيَّة” بصياغتها الأخيرة بعد أن كانت مبعثرةً في أعمال اللغويّين والنقاد القدامى والمحدثين من علمائنا، ولكننا نستطيع أن نلملم شتاتها من ربط “نظريَّة المعنى” في التراث بعلم الأسلوب الحديث، كذلك نجد لها أصداءً واسعةً نسبيّاً في “المناهج البنيويَّة والتناصيَّة والتحليليَّة الاجتماعيَّة المعاصرة”. وخلاصة القول في ذلك أنّ:
1. الكلمة المعجميَّة ذات معنى محايد لا يجاوز الصورة التي يشير إليها مجموع أصوات الحروف، وهذا المعنى المحايد هو معنى شكليٌّ.
2. السياق هو الناظم الذي يعطي للكلمة في ارتباطها بما قبلها وما بعدها معناها المقصود أي معناها السياقيّ.
3. السياق ليس سياقاً واحداً بل هو شبكة علاقات بين عدة سياقاتٍ جزئيَّة تنتج السياق الكليّ:
أ. السياق اللُّغويّ (التعاقبيّ). بـ السياق الثقافيّ. ج. السياق الاجتماعيّ. د. سياق المناسبة (وهو ما يطلق عليه البنيويّون قاعدة المناسبة وهو أقرب ما يكون إلى قول القدماء “لكل مقام مقال”؛ فالمقام أو “سياق المقام” هو المناسبة السياقيَّة التي تقتضي قولاً بعينه دون غيره من الأقوال).
4. المعنى الشكليّ والمعنى السياقيّ لا ينفصلان انفصالاً قطعيّاً بل يحدِّدان معاً “مفهوم السياق” بوصفه تعبيراً عن نوعين من العلاقة هما:
أ. العلاقة بين العنصر والعناصر اللّغويَّة الأخرى.
ب. العلاقة بين النصّ والموقف الذي يتجلَّى فيه.
ويرى “هاليداي” السياق بوصفه نصّاً آخر مصاحباً للنص Con-text وهو؛ (أي السياق) ليس محيطاً مادياً فحسب، بل هو بنية سيميوطيقيَّة semiotic structure عناصرها الأعراف الاجتماعيَّة والقيم الثقافيَّة المأخوذة من النظام السيميوطيقي (العلاماتيّ: الأيقونيّ– الإشاريّ – الرمزيّ) الذي يكوِّن الثقافة. وقد قدّم “هاليداي” ثلاثة جوانب تحدد مجتمعة “سياق النصّ”:
1. المجال Field: وهو “موضوع النصّ” أي ما يدور حوله الخطاب.
2. نوع المشاركة Tenor: ويعني طبيعة العلاقة بين المشاركين في النصّ (علاقة رسمية كما لو كان بين المدير والموظف، علاقة حميمة وكما تكون العلاقة بين صديقين أو بين أم وابنها).
3. الصيغة Mode: وتعني الوسيلة أو قناة الاتّصال التي يتحقَّق من خلالها النصُّ (الكتابة كالبحث أو المقال، المنطوق كالمونولوج والديالوج، المزاوج بين الكتابة والنطق كنشرة الأخبار، والحوار في القصص، والمسرحيَّة).
يرى البنيويُّون، بدءاً من مؤسّس علم اللغة الحديث “سوسيور”، أنَّ السياق هو تتابع مجموعة من العناصر وتآلفها في سلسلة الكلام حيث يعتمد هذا التتابع والتآلف على الامتداد فيما يطلق عليه “العلاقات السياقيَّة”. وتثير كل كلمة في سلسلة السياق كلمات أخرى، وتمثل واحدة من عدة اختيارات كانت ممكنة. لذلك فإنّ ثمة محورين: المحور الاختياريّ، والمحور التعاقبيّ. وهما متعامدان على هذا النحو:
محور الاختيار (الاستبدال)
حصان
جواد
فرس
محور التعاقب
(المحور السياقي)
امتطى جواده ورحل
وربما انتبه القدماء إلى ذلك الملمح، بطريقةٍ مَّا، عندما قالوا: إنَّ الكلمة المعجميَّة لها عدد من المعاني، تبدو واضحة فيما سمّوه بالمرادف والمشترك. وأنّ العلاقة السياقيَّة لها معنى واحد يقوم على توطين الكلمة المعجميَّة في وضع واحد من مواضعها؛ فكلمة: “عين” تعني عين الإنسان، وعين الشمس، ومكان انبثاق الماء (معجميّاً) ولكنّني أختار معنى واحداً يحدده السياق الذي استعمله فأقول: شربت من عين صافية (سياقيّاً هنا تحدد العين بعين الماء). كذلك كلمة (خال) فالخال أخو الأم، والخال العلامة في الوجه. ويبدو أن قضية (المشترك) في اللغة العربية هي ما أثارت مفهوم السياق بوصفه محدِّداً للمعنى أكثر من غيرها.
وهناك في الإنجليزيَّة كلمة Bar وكانت تعني في البدء حدوداً من الحماية (سوراً أو سياجاً) ثم أصبحت تعني فيما بعد أي نوع من الحواجز التي توضع في قاعة كبيرة كقاعة المحكمة ثم صارت تعني الحانة أو الخمّارة ثم أصبحت الآن تستخدم للإشارة إلى مستودعات قضبان الحديد، ولكن أغلب اللغويّين يعدون Bar؛ بمعنى الحانة أو الخمّارة، وهو المعنى المركزي للكلمة Central meaning.
ويرى “جون لاينـز” أن معنى الوحدة الكلاميَّة يجاوز ما يقال فعلاً؛ إذ أنَّه؛ أيضاً، ما هو مقصود ضمناً أو ما يفترض مسبقاً. وللسياق صلة وثيقة بهذا الجزء من معنى الوحدات الكلاميَّة، فللوحدة الكلاميَّة ناحيتان: الناحية الكلاميَّة، والناحية اللاكلاميَّة. وقد أهمل اللُّغويّون في رأي “جون لاينـز” ما يتَّصل بالقصد، واكتفوا بما يتصل بالمعنى الكلاميّ.
ونحن نستطيع أن نلمس في القرآن الكريم ما عناه “لاينـز” بالقصد الذي يجاوز ما يقال بالفعل. فلنقرأ قوله تعالى: ﴿ذُق اِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ (الدخان: 46). أو قوله: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ (الطور: 33). أو قوله: ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ (الروم: 31).
إن السخرية في الآية الأولى تعني ما هو أبعد من الدعوة إلى مذاق العذاب بالمقابلة غير المذكورة بين وضعين هما العبودية، والعزة والكرم يذكرنا بقول مصطفى ناصف أن معنى السياق هو المحذوف.
أما التساؤل في الآية الثانية فيعني دفعهم إلى المفاضلة بين “محض العدم” أو “الخلق الذاتي” في حالة إنكارهم لله تعالى وهي مفاضلة محرجة للمنطق البدهي، ومثيرة لإعادة المراجعة.
أما التقرير في الآية الثالثة فهو يجاوز وصف واقع موضوعي موجود وتحديده إلى تعيين منـزعٍ نفسيٍَ يسبب الشعور بالامتلاء واليقين الوهميين عند تحصيل قدرٍ من المعرفة قد يحتمل في ذاته، الصواب وقد يحتمل الخطأ. وهذا المنـزع النفسي هو المولِّد الخفي لغرور الإنسان الذي يعلم (وذلك دون أن يتساءل عن مدى علمه). فالفرح هنا في “فرحون” هو مخيال الإنسان عن ذاته بوصفها حاملةً لمحمولٍ ليس له من الأرجحية إلا ما تتصوره هذه الذات عنه. وكما قال الإمام النِفَّري: “الكون كالكرة والعلم كالميدان. أي أن الكون يتقلَّب في العلم بدون استقرارٍ على حال”. لذلك قال النِفَّري: “العلم حدود وبين كل حدّين جهل”.
نماذج من ملاحظة السياق في القرآن المجيد
لقد ظهرت مراعاة السياق في كتاب الله سبحانه وتعالى ولفت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنظار الصحابة إلى ذلك حتى مهر في ذلك كثيرون منهم مثل الشيخين أبي بكر وعمر، رضي الله عنهم، وعلي، رضي الله عنه وكرم الله وجهه، وأم المؤمنين عائشة، رضي الله عنها، وابن مسعود وابن عباس، رضي الله عنهم، ونستطيع أن نجد في فقه الشيخين واستدراكات أم المؤمنين على الصحابة، واستدراكات علي وابن أم عبد وابن عباس وغيرهم نماذج تملأ مجلدات لكنّنا سوف نقتصر على القليل من ذلك تاركين الاستقصاء إلى ميدان آخر7.
إنّ ملاحظة السياق بأنواعه أمر لا يختلف في موقعه وأهميَّته عن دراسة النص وتحليله فـ”إهمال السياق يؤدي إلى الوقوع في الغلط والمغالطة”8.
ولقد لفت رسول الله،، عليه السلام،، الأنظار إلى هذه الدلالة وأهميّتها فيما روى عنه من تفسير، وفي الرد على كثير من الشبهات التي أثارها المشركون والمنافقون وأهل الكتاب ومن إليهم، فمن ذلك ما ورد في قصة ابن الزبعرى حين زعم أنّه سيخصم رسول الله،، عليه السلام،، وذلك لما نـزل قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ﴾ (الأنبياء: 97) فجاء ابن الزبعرى إلى رسول الله،، عليه السلام،، وقد أكثر المفسِّرون في التعليق على هذه الواقعة وكذلك بعض المحدّثين ورووا في ذلك أحاديث وآثاراً من المستبعد أن يصح شيء منها.
والمسألة، كلّها، لا تتجاوز أنّ قريشاً وابن الزبعري منهم. لم يلاحظوا السياق الذي وردت الآية الكريمة فيه فاضطربوا في فهمهم لها. فالآية جاءت بعد أن عرضت سورة الأنبياء لعدد كبير منهم، وبيّنت ما جرى لهم مع أقوامهم، وختمت ذلك بإعلان وحدة أمَّة الأنبياء في جوهر مضامين رسالاتهم وهو التوحيد، ووحدتهم كذلك في اختلاف مواقف أقوامهم منهم ومما جاءهم به من الخير، ووحدتهم في الغاية والرجوع إلى الله. وبيَّنت الآيات الكريمة اختلاف مصائر أولئك الأقوام فلن يجعل الله المسلمين كالمجرمين، ولا الذين يعملون الصالحات كالذين يجترحون السيئات.
وفي الوقت الذي بشرت الآيات الصالحين بأنّهم لا كفران لسعيهم، وأنَّ كل ما عملوا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى.. أكد الإنذار الأخير لأولئك المشركين بأنَّ الفرصة الوحيدة أمامكم لتؤمنوا ولتنقذوا أنفسكم من نار جهنم هي هذه الدنيا فقط؛ لأنَّ القرى التي هلكت والقرون التي خلت لم يرجع أحد منها ليعمل صالحاً غير الذي كان يعمل، إنّها أمانٍ يتمنَّونها، وكلمات يقولونها لا تتحقَّق. و”حرام على قرية أهلكناها؛ أي حرام عليها الرجوع إلى الحياة الدنيا مرة أخرى لتستدرك وتغيّر عملها” ﴿أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ (الاَنبياء: 94) ثم يجري التفات الآية إلى هؤلاء المشركين لتحذرهم وتنذرهم بأنّ الفاصل بينهم وبين الوعد الحق القريب يسير وليس بطويل. فليفارقوا عنادهم وليؤمنوا بما جاءهم به رسولهم فقد اقترب اليوم الذي سيقذفون فيه مع آلهتهم المزعومين في النار ليستقروا فيها وكأنَّهم حصبها وحصباؤها. وسيكتشف هؤلاء المشركون الأغبياء هذه البديهيَّة ﴿لَوْ كَانَ هَؤُلَاء ءالِهَةً مَّا وَرَدُوهَا، وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (الأنبياء: 98) وهنا يجري القرآن المجيد على عادته في ذكر المتقابلات، ودفع ما قد يتوهمه المتعجلون الذين لا يتدبّرون القرآن ليقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾ (الأنبياء: 100) فإذا كنا قد وحَّدنا في المصير بينكم أيّها المشركون وبين آلهتكم فإنّ هذا ليس بعام في كل قوم وما عبدوه، فهناك رسل وأنبياء صالحون دعوا أقوامهم إلى الدين الخالص، والتوحيد الخالص. فانحرف أقوامهم عن سبلهم فألَّهوهم وعبدوهم من دون الله، وهؤلاء لن يتّحد مصيرهم بمصير أولئك الذين ألّهوهم. فهم أبرياء مما فعل أقوامهم وقد سبقت لهم منه سبحانه الحسنى بأن يفصل بينهم وبين أقوامهم ويفتح بينهم وبين أقوامهم بالحق9. فالسياق يكفي ويغني عن كل ما ذكر، أو حاك في صدور المشركين في إزالة ذلك كلّه. فتجاهلهم للسياق وإثارتهم لما أثاروا هو من قبيل الشغب الذي ألفناه منهم.
إنّ معرفة السياق في القرآن خاصّة تعدّ من الضروريات لسائر أولئك الذين يتعاملون مع القرآن المجيد. فملاحظة السياق تعين على تفسير القرآن بالقرآن، ويمكن أن تزيل أحكام التشابه، ودعاوى النسخ وتصحح في كثير من الأحكام؛ وتعطي المجتهد القدرة على الترجيح.
فالسياق هو الذي يجعلنا نفهم من قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ﴾ (المائدة: 3) أن فاصطادوا جاء لبيان رفع الحظر الذي ورد به قوله تعالى: ﴿غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ (المائدة: 2).
والسياق هو الذي يجعلنا نفهم أن قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاؤا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الاَرْضِ فَسَادًا اَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الاَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الاَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (المائدة: 35).. أنّ المراد بها ليس بيان “حدٍّ من حدود الله يطلق عليه: حدُّ الحرابة” كما ذهب إلى ذلك الأكثرون، بل المراد بذلك بيان ما ترتب على فعل ابن آدم الذي قتل أخاه وقصتهما التي قدمت لقوله تعالى:﴿مِنْ اَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَاءيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الاَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءتْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الاَرْضِ لَمُسْرِفُونَ﴾ (المائدة: 34).
و”السياق” هنا يربط هذه التصرّفات بحرب معلنة على الله ورسوله وسعي في الأرض بالفساد والإفساد؛ وهذه،كلّها، أمور لا تصدر باعتبارها ذنوباً وانحرافات صادرة عن أحد ينتسب إلى الإيمان أو الإسلام لتعد عقوبة شرعيَّة أو حداً من حدود الله، إنّما هي عقوبة لمن وصفوا بذلك، وقد يكونون من المشركين، أو من أهل الكتاب المتحالفين معهم المحاربين لله ورسوله. ولو فرض أن منتسباً إلى الإسلام قام بكل تلك الجرائم فإنّه لا يمكن أن يفعلها وهو مؤمن؛ إذ كيف تجتمع صفة الإيمان بالله والإسلام له مع إعلان الحرب على الله ورسوله؟! إضافة إلى مفارقة السعي في الأرض بالفساد والإفساد؟! إنَّ تصرُّفات كهذه لا يتوقع صدورها عمن في قلبه مثقال حبَّة من خردل من إيمان. وبالتالي فإنّ السياق لا يسمح أبداً بأن يكون المراد بهذه الآية بيان حدّ من “الحدود الشرعيَّة” يسمّى بـ”حد الحرابة”.
إنَّ السياق الداخليّ الخاصّ الذي يبدأ بقصة “ابني آدم” يتناول دوافع خفيَّة تأخذ بوسوسة الشيطان واستعداد الإنسان شكلَ الدوافع المؤثِّرة في تحريك الإنسان نحو القتل، وهي دوافع لا تقف صلات القربى حائلاً دون السقوط في جريمة القتل بنسبيتها وبتأثيرها. ثم يجعل من سقوط أحد ابني آدم في أوحال تلك الجريمة علّة لتشريعات عقابيّة يمكن أن تشكل رادعاً بجعل الإنسان أقدر على مقاومة تلك الدوافع؛ ويصور حجم الجريمة بصورة تجعل من تبدأ الدوافع إلى القتل عملها في نفسه يدرك حجم الجريمة التي يحدثه شيطانه ونفسه بارتكابها؛ إنّها ليست قتلاً لذلك الفرد الذي حقدت عليه النفس المريضة أو غضبت منه أو حسدته، وإنّهاء إعدام للبشريَّة ممثَّلة في آدميّة ذلك الفرد، وقضاء على الحياة الإنسانيَّة بأكملها. وهنا يلتفت السياق إلى أولياء القتيل، أولياء الدم فيجعل لهم سلطاناً كافياً لشفاء أنفسهم مما وقع عليهم من ظلم أفقدهم واحداً منهم، وإقناعهم بأنَّ المعتدي عليهم وعلى فقيدتهم سينال الجزاء العادل، فيبيِّن أن أولئك الذين يقتلون الناس بغير حق لابد للمجتمع من معاقبتهم ومجازاتهم على ما يفعلون، لأن استعداد ذلك المحارب القاتل للقتل لا يمنعه عن قتل الناس جميعاً فكأنه سبحانه ينبّه بذلك إلى أمر خطير أن من وقع في جريمة واحدة، وقتل نفس واحدة قد استكلب واجترأت نفسه على القتل فإذا لم يقتلع الشر من نفسه وتعطل قدراته عن ممارسة أيّة جريمة لاحقة فإنّه سيكرّر الجريمة دون حساب، ولا يهمه، آنذاك، أن ينهي الحياة البشريَّة على الأرض وهنا تتضح البلاغة المعجزة لقوله تعالى ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرة: 178).
فإذا لاحظنا السياق العام لسورة المائدة من بدايتها نجد أنّ المناداة بالوفاء بالعقود تنبّه الأمّة الوارثة أمَّة محمد،، عليه السلام،، بذلك إلى ضرورة الالتزام بعهودها مع الله تعالى ومواثيقها معه سبحانه؛ وكأنّها تنبيه مبكر لها أن لا تقع فيما وقعت فيه بنو إسرائيل الذين جاءت بديلاً وارثاً عنهم فينبغي للأمة البديلة الحرص على الوفاء بالعقود، وأن لا يحلُّوا شعائر الله، وأن لا يجر منَّهم شنئان قوم على العدوان، وأن يتقوا الله، ويجعلوا التقوى شعارهم ودثارهم ثم يبيّن لهم محرّمات الأطعمة إذ أن السقوط فيها ينافي التزكية. ثم يحذّر من الذبح على النصب حماية للتوحيد، وكذلك الاستقسام بالأزلام. وقد يخطر على بال البعض أن يرى في تناول قضايا الأطعمة بعد الأمر بالوفاء بالعقود ونـزولاً إلى الأدنى أو الأقل أهميَّة فينبِّه السياق إلى ما قاله رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في خطبة حجة الوداع: “… إن الشيطان قد يئس أن يعبد… ولكنّه رضي منكم ما دون ذلك…”؛ فيقول سبحانه: ﴿الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ…﴾ (المائدة: 4) فكأن أحكام الأطعمة جاءت بمثابة الخاتمة للتشريعات القرآنيَّة، وبها اكتمل الدين. ويستمر السياق في بيان ما يؤدي إلى تزكية الإنسان تزكية تامّة في المطعم والمنكح ويتوج ذلك بالصلاة وبالطهارة وبالوضوء وبالتيمُّم. ويعيد التذكير بضرورة المحافظة على الميثاق مع الله تعالى ويبيّن نعمة الله بهذا الميثاق فهو ليس عبئاً أو تكليفاً بل هو نعمة أنعم الله بها عليكم فكونوا إذن قوامين لله شهداء بالقسط لا يحملنكم بغض قومٍ على أن لا تعدلوا بل اعدلوا؛ لأنَّ العدل أقرب للتقوى واتقوا الله فلا تجانبوا العدل ولا تتجاوزوا فهو خبير بما تعملون، ويرتِّب سبحانه على ذلك إشارته لهم بالجنة وإنذاره للكافرين بالجحيم ثم يذكِّر المؤمنين بنعمته عليهم، وذلك حين حماهم من الذين أرادوا أن يبسطوا إليهم أيديهم بالسوء فكف أيديهم عن المؤمنين، وكأنَّه علَّل ذلك بتقواهم لله تعالى فأكد الأمر بالتقوى، وأمرهم بالتوكُّل على الله الذي يتولى نصرهم على عدوهم وإعانتهم وحفظهم لتكون نفوسهم أنشط في المحافظة على ميثاقهم مع الله سبحانه وتعالى، ثم يلتفت السياق إلى موقف بني إسرائيل من الميثاق الذي واثقهم به؛ وكأنَّه يريد بذلك تحذير المؤمنين من السقوط فيما سقطت فيه الأمة المستبدلة من نقض الميثاق وفي الآية التالية (14) من سورة المائدة يجعل نقض اليهود لميثاقهم سبباً في اللعنة وقسوة القلوب والجرأة على تحريف كلمات الله عن مواضعها وتناسي آيات الله والسقوط في الخيانة. ويأمر رسول الله،، عليه السلام،، في آخر الآية بأن يصبر عليهم ويعفو عنهم ويصفح في تلك المرحلة؛ إذ أنه ليس من السهل على أمثالهم أن يروا أمة من الأميّين تحتل موقع الخيريَّة والاصطفاء الذين نُحُّوا عنه، ثم يلتفت إلى إخوانهم من بني إسرائيل أو الطرف الثاني منهم وهم النصارى ليدمغهم أيضاً بنقض الميثاق الذي واثقهم الله به ونسيانهم كإخوانهم اليهود حظاً مما ذكروا به، وأن ذلك كان علة لإغراء العداوة والبغضاء بينهم إلى يوم القيامة منبّهاً إلى أنَّ ذلك لن يعفيهم من المسئولية يوم القيامة حيث ينبئهم الله يوم القيامة بما كانوا يصنعون، ثم يوجه نداءاً للفريقين من بني إسرائيل كأنه النداء الأخير بمجيء رسول الله محمد، صلى الله عليه وسلم، ليبيّن لهم ما كانوا يخفون من كتبهم أو يحرفون، وأن ما جاءهم به نور من الله وكتاب مبين كفيل بهدايتهم مرة أخرى إلى سبل السلام التي أضاعوها وإخراجهم من الظلمات إلى النور بإذنه تعالى، وهدايتهم إلى صراط مستقيم، ثم يبيّن لهم خاصة للنصارى منهم حاجتهم الماسة إلى هذا النبي الكريم حيث إن انحرافاتهم وقسوة قلوبهم قد حملتهم على الشرك بالله وتجاوز التوحيد والمزج بين الله تعالى وبين نبيه ورسوله المسيح ابن مريم، ثم ينبه إلى السبب الأساس الذي دعا كلاً من اليهود والنصارى إلى الانحراف عن جادة التوحيد والإشراك بالله سبحانه؛ ألا وهو اغترارهم بنعم الله وتوهمهم أنهم ما والى الله نعمه عليهم إلا لأنَّهم أبناء الله وأحباؤه فرد عليهم ذلك، ثم ناداهم مرة أخرى نداء توكيد بأنَّ هذا النبيَّ الأميَّ كما أرسل إلى الأميّين فهو مرسل إليهم ليبيّن لهم بعد فترة وتوقف في تتابع الرسل والأنبياء الذين أرسلوا إليهم، ويبيّن لهم أنَّه بذلك قد قطع حجته وأنهم لن يستطيعوا القول يوم القيامة بأنهم أو أن أجيالهم المتأخرة ما جاءها بشير ونذير، فإن محمداً، عليه السلام، بشير لهم ونذير، ثم يذكرهم بما كان موسى يدعو إليه ويذكرهم به وبمعصيتهم لموسى وهو منهم لا يستطيعون أن يقولوا إنَّه من قوم غيرهم، كما يحاولون أن يقولوا عن رسول الله محمد، عليه السلام، ويذكرهم بقصة ابني آدم الذين قلَّد بنو إسرائيل الشرير منهما وهو القاتل، وأنَّهم لذلك قد ابتلوا بتشريعات مغلظة شاقة في مسألة القتل والاستهانة بإراقة الدماء والإفساد في الأرض، وقتلهم الأنبياء بغير حق ومخالفتهم لسائر البينات التي جاؤوا بها لأنهم استمرؤوا القتل بما في ذلك قتل الأنبياء ومردوا على القسوة والغلظة فناسب ذلك أن تشدد عليهم العقوبات، وأن تثقل عليهم التشريعات وينتهي السياق عند قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الاَرْضِ فَسَادًا اَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الاَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (المائدة: 35) والآية التي تليها والتي فيها الالتفات إلى أمة رسول الله، عليه السلام، التي كانوا يساكنوها في المدينة المنورة ﴿إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (المائدة: 36) والآية (37) تنادي المؤمنين مرة أخرى للالتزام بتقوى الله وابتغاء الوسيلة إليه، والجهاد في سبيله ضد أولئك وأمثالهم من يهود وإخوانهم بأنَّهم إذا فاتتهم هذه الفرصة؛ فرصة اتّباع هذا النبيّ الأمّيّ، فذلك يعني أنهم ذاهبون إلى عذاب يخلدون فيه لا يمكن أن يتخلَّصوا منه بفداء أو غيره، فالسياق كلّه يقود إلى أنَّ هذه العقوبة إنَّما هي عقوبة لأولئك الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً، وهؤلاء لا يمكن أن يكونوا مؤمنين أو مسلمين بأي معنى.
والذي حمل بعض علمائنا على أن يتجاوزوا السياق ويذهبوا إلى القول بما أسموه بـ”حد الحرابة” قصة العرنيّين وظنهم أن هذه الآية الكريمة جاءت تعقيباً على أحداث تلك القصة مع أنَّ هناك روايات كثيرة تبيّن أنَّ قصة العرنيّين قد وقعت بعد نـزول هذه الآية الكريمة10.
السياق عند الأصوليين
تأثُّراً بالمنهج الذي ذكرناه مما نبَّه القرآن المجيد إليه ولفت الأنظار إليه رسول الله، عليه السلام،، فقد التفت إلى السياق الكلاميُّون في حواراتهم ومجادلاتهم وردودهم على الفرق المغايرة، وقد لا نجد في أنفسنا حاجة إلى الوقوف الطويل أمام مقالات أصحاب الفرق وحواراتهم ومجادلاتهم وكيفيَّة توظيف كثير منهم للسياق في ردودهم على الفرق المغايرة. بل سنحاول أن نبرز مواقف الأصوليِّين من السياق وطرائق توظيفهم له؛ لأنّه أخصر وأدق.
1. وضع الإمام الشافعي باباً في رسالته الأصوليَّة هو “باب الصنف الذي يبيّن سياقه معناه”، وتناول فيه آيات جرى فيها تحديد معنى بعض الألفاظ التي لها أكثر من معنى بالسياق؛ فكأنَّه أراد أنَّ يشير إلى أنَّ السياق يمكن أن يستعمل لتحديد المعنى المراد بالمشترك من الألفاظ القرآنيَّة؛ وهنا نصَّ على السياق بلفظه، لا بمعناه. وفي باب آخر سبق تحدث الإمام عما نـزل عام الظاهر وأريد به الخاصّ؛ وهذا يدل على أنَّ الإمام جعل السياق حجة في أمور ذات صلة بالدليل الشرعيّ، وأنَّه قد يصرف ظاهر دليل إلى معنى آخر. ولذلك كثرت المعاني التي استعمل الأصوليُّون فيها السياق، واستدلوا به على مختلف المسائل التي تناولوها فابن القيم في فوائده يقول: “السياق يرشد إلى تبيين المجمل وتعيين المحتمل والقطعيّ بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع الدلالة، وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم فمن أهمله غلط في نظره وغالط في مناظرته فانظر إلى قوله تعالى: ﴿ذُق اِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ (الدخان: 46) كيف تجد سياقه يدل على أنَّه الذليل الحقير”11.
2. أما شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله (توفي 310ﻫ) فإنه يلح على وجوب النظر في القرآن الكريم في زاوية مراعاة العلاقات النحوية والأسلوبية والمقامية القائمة بين آيات الذكر الحكيم، ولذلك كان يرى أن “اتباع الكلام بالأقرب إليه أولى من اتباعه بالأبعد منه”، وقال أيضاً: “غير جائز صرف الكلام عما هو في سياقه إلى غيره، إلا بحجة يجب التسليم لها من دلالة ظاهر التنـزيل، أو خبر عن الرسول، عليه السلام، تقوم به حجة، فأما الدعاوي فلا تتعذر على أحد12.
3. أما الغزالي (توفي 505ﻫ) فقد وقف وقفات مهمة ركز خلالها على أهمية القرائن المقالية التي يسميها بـ”قرائن الأحوال” في تحديد المعنى يقول: “والقرينة إما لفظ مكشوف كقوله تعالى: ﴿وءاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ﴾ (الاَنعام: 142)، والحق هو العشر. وإما إحالة على دليل العقل كقوله تعالى: ﴿وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾ (الزمر: 64)، وقوله عليه السلام: “قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن”. وإما قرائن أحوال من إشارات ورموز وحركات وسوابق ولواحق، لا تدخل تحت الحصر والتخمين، يختص بدركها المشاهد لها فينقلها المشاهدون من الصحابة إلى التابعين بألفاظ صريحة، أو مع قرائن من ذلك الجنس، أو من جنس آخر، حتى توجب علماً ضرورياً بفهم المراد أو توجب ظناً.
وكل ما ليس له عبارة موضوعة في اللغة، فتتعين فيه القرائن. وعند منكري العموم والأمر، يتعين تعريف الأمر والاستغراق بالقرائن، فإن قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ﴾ (التوبة: 5)، وإن أكده بقوله “كلهم” و”جميعهم” فيحتمل الخصوص عندهم كقوله تعالى: ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾ (الاَحقاف: 24)، ﴿وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ﴾ (سورة النمل:23)، فإنه يريد به البعض”.
وأفرد الغزالي في كتابه “المستصفى” عنواناً خاصاً للسياق سماه: “الضرب الرابع فهم غير المنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصوده” كفهم تحريم “الشتم” و”القتل” و”الضرب” من قوله تعالى: ﴿فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا﴾ (الإسراء: 23) وفهم تحريم مال اليتيم وإحراقه وإهلاكه من قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَاكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً﴾ (النساء: 10). وفهم ما وراء الذرة والدينار من قوله تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ (الزلزلة: 8)، وقوله: ﴿وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَامَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُوَدِّهِ إِلَيْك﴾ (ءال عمران: 74)، وكذلك قول القائل:”ما أكلت له برة، ولا شربت له شربة، ولا أخذت من ماله حبة” فإنه يدل على ما وراءه. فإن قيل: هذا من قبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى. قلنا: لا حرج في هذه التسمية، لكن يشترط أن يفهم: أن هذا بمجرد ذكر الأدنى لا يحصل هذا التنبيه، ما لم يفهم الكلام وما سيق له. كما تنبه الغزالي، رحمه الله، أيضاً إلى قرائن الأحوال أو ما يسمى في الدرس اللغوي الحديث بسياق الحال ودوره في تحديد المعنى قال: “إن قصد الاستغراق يعلم بعلم ضروري، يحصل عن قرائن أحوال ورموز وإشارات وحركات من المتكلم، وتغيرات في وجهه وأمور معلومة من عادته ومقاصده، وقرائن مختلفة لا يمكن حصرها في جنس ولا ضبطها بوصف، بل هي كالقرائن التي يعلم بها خجل الخجل ووجل الوجل وجبن الجبان، وكما يعلم قصد المتكلم إذا قال: “السلام عليكم”، أنه يريد التحية أو الاستهزاء واللهو.
ومن جملة القرائن: فعل المتكلم، فإنه إذا قال على المائدة: “هات الماء” فهم أنه يريد الماء العذب البارد، دون الحار المالح.
وقد تكون دليل العقل كعموم قوله تعالى: ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (البقرة: 28)، ﴿وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الاَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا﴾ (هود: 6)، وخصوص قوله تعالى: ﴿اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ (الزمر: 59)؛ إذ لا يدخل فيه ذاته وصفاته.
4. وأما الزركشي نفسه (توفي 794ﻫ) فقد قال:”ليكن محط نظر المفسر مراعاة نظم الكلام الذي سيق له، وإن خالف أصل الوضع اللُّغوي لثبوت التجوز، ولهذا نرى صاحب “الكشاف” يجعل الذي سيق له الكلام معتمداً، حتى كأن غيره مطروح”.
وفي حديثه عن الألفاظ ودلالتها وطريق التوصل إلى فهم معناها يقول: “الثاني ما لم يرد فيه نقل عن المفسرين، وهو قليل، وطريق التوصل إلى فهمه النظر إلى مفردات الألفاظ من لغة العرب. ومدلولاتها واستعمالاتها بحسب السياق، وهذا يعتني به الراغب كثيراً في كتابه “المفردات” فيذكر قيداً زائداً على أهل اللغة في تفسير مدلول اللفظ لأنه اقتنصه من السياق”13.
5. أما العز بن عبد السلام (توفي 660ﻫ) فيؤكد في كتابه “الإمام” على وظائف السياق في تحديد المعنى ويقول: “السياق يرشد إلى تبيين المجملات وترجيح المحتملات وتقرير الواضحات، وكل ذلك بعرف الاستعمال فكل صفة وقعت في سياق المدح كانت مدحاً وإن كانت ذماً بالوضع، وكل صفة وقعت في سياق الذم كانت ذماً وإن كانت مدحاً بالوضع كقوله تعالى: ﴿ذُق اِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ (الدخان: 46).
6. وقال الشيخ ابن دقيق العيد (توفي 702ﻫ): “أما السياق والقرائن فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه، وهي المرشدة إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات…”.
ونقل عنه الإمام الزركشي قوله ضمن استدلاله على بعض مجالات التخصيص بالسياق: “… لأن السياق مبين للمجملات، مرجح لبعض المحتملات ومؤكد للواضحات… فليتنبه لهذا ولا يغلط فيه ويجب اعتبار ما دل عليه السياق والقرائن، لأنّ بذلك يتبين مقصود الكلام”.
وصرح الشيخ ابن دقيق العيد في موضع آخر بأن دلالة السياق “لا يقام عليها دليل”، وفهم تأثيرها على النصوص الشرعية يعد قاعدة من قواعد أصول الفقه، ولكن قل من تكلم عنها وأعطاها حقها من الدراسة، قال:”فإن السياق طريق إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات وتنـزيل الكلام على المقصود منه، وفهم ذلك قاعدة من قواعد أصول الفقه، ولم أر من تعرض لها في أصول الفقه بالكلام عليها وتقرير قاعدتها مطولة إلا بعض المتأخرين ممن أدركنا أصحابهم وهي قاعدة متعينة على الناظر ذات شعب على المناظر”.
ولعل هذا النص يعبر بوضوح عن القصور الحاصل في دراسة السياق عند الأصوليين، وعدم إفراده بالعناية اللازمة به باعتباره وسيلة لا يستغنى عنها في الإرشاد إلى المقصود الشارع.
7. أما الإمام الشاطبي فقد عنى عناية كبيرة في بيان وفهم أثر السياق في دراسة المعنى. ومما قاله عن “السياق اللّغويّ” خاصَّة:”كلام العرب على الإطلاق لابد فيه من اعتبار معنى السياق في دلالة الصيغ وإلا صار ضحكة وهزءة، ألا ترى إلى قولهم فلان أسد، أو حمار، أو عظيم الرماد، أو جبان الكلب، وفلانة بعيدة مهوى القرط وما لا ينحصر من الأمثلة. لو اعتبر اللفظ بمجرده لم يكن له معنى معقول. فما ظنُّك بكلام الله وكلام رسوله، عليه السلام؟ وعلى هذا المساق يجري التفريق بين البول في الماء الدائم وصبِّه من الإناء فيه”.
ومما قاله في “سياق الحال”: “إنَّ المساقات تختلف باختلاف الأحوال والأوقات والنوازل وهذا معلوم في علم المعاني والبيان. فالذي يكون على بال من المستمع والمتفهم، والالتفات إلى أول الكلام وآخره، بحسب القضية وما اقتضاه الحال فيها لا ينظر في أولها دون آخرها، ولا في آخرها دون أولها، فإنَّ القضيَّة وإن اشتملت على جمل فبعضها متعلق بالبعض، لأنَّها قضية واحدة نازلة في شيء واحد فلا محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أوله، وأوله على آخره، وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع في فهم المكلف”.
وقد تنبّه الإمام الشاطبي إلى سعة مفهوم السياق بحيث صار يشمل سياق السورة كلَّه فينبّه إلى وحدتها البنائيَّة، ومن أمثلة ذلك تفسير قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ ءامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ﴾ (الأنعام: 83)، قال: “فإن سياق الكلام يدل على أن المراد بالظلم أنواع الشرك على الخصوص، فإن السورة من أولها إلى آخرها مقرِّرة لقواعد التوحيد، وهادمة لقواعد الشرك وما يليه، والذي تقدم قبل الآية قصة إبراهيم، عليه السلام، في محاجته لقومه بالأدلة التي أظهرها لهم في الكوكب والقمر والشمس، وكان قد تقدم قبل ذلك قوله: ﴿وَمَن اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِئايَاتِهِ﴾ (الأنعام: 22)، فبين أنه لا أحد أظلم ممن ارتكب هاتين الخلتين وظهر أنهما المعنى بهما في سورة الأنعام”.
ويتسع مفهوم السياق أكثر عند الشاطبي ليشمل التشريع الإسلامي كله وذلك في وحدة منسجمة وهو ما يسميه الشاطبي بـ”السياق الحكميّ” المتميز عن المساق العربيّ. قال رحمه الله: “…وهذا الوضع إن كان جيء به مضمناً في الكلام العربي فله مقاصد تختص به، يدل عليها المساق الحكمي أيضاً، وهذا المساق يختص بمعرفته العارفون بمقاصد الشرع، كما أنَّ الأول يختص بمعرفته العارفون بمقاصد العرب”.
8. بل لا يليق بكلام الله وكلام رسوله أن يفهم بمعزل عن سياقه، قال الإمام الشاطبي موضحاً ذلك: “… كلام العرب على الإطلاق لابد فيه من اعتبار معنى السياق في دلالة الصيغ، وإلا صار ضحكة وهزءة، ألا ترى إلى قولهم: فلان أسد أو حمار، أو عظيم الرماد، أو جبان الكلب، وفلانة بعيدة مهوى القرط، وما لا ينحصر من الأمثلة لو اعتبر اللفظ بمجرده، لم يكن له معنى معقول، فما ظنك بكلام الله وكلام رسوله”.
إن النظر فيما تحمله هذه الشواهد من تأكيدات واضحة على وجوب اعتبار دلالة السياق وإدراك أهميته البالغة في الكشف عن مراد الشارع ضمن مباحث الأصوليين في العموم والخصوص، والإطلاق والتقييد، والحقيقة والمجاز، والإجمال والبيان… يدفعنا ولاشك إلى التساؤل عما يقصده هؤلاء بهذا المفهوم/السياق، وما يعنون بدلالة السياق.
9. وبحث الإمام الشوكاني أيضاً في مسائل تخصيص العموم في إرشاده عن إمكان التخصيص بالسياق ناقلاً رأي الأئمة: الشافعي والصيرفي (توفي 330ﻫ) وتقي الدين بن دقيق العيد وعنون المسألة بـ”التخصيص بالسياق”.
أما ما ورد من نصوص صريحة في الحديث عن السياق، فيكاد يتفق على أسلوب واحد في التعبير عن وظيفة السياق في بيان المجملات وترجيح المحتملات وتقرير الواضحات ولكنّ لنا إضافات أخرى الوظائف السياق وفي ممارسة العلماء والفقهاء ما يدل على وظائف أخرى له. تحتاج إلى مزيد من التأمل.
نقل الإمام الزركشي عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام قوله: “السياق يرشد إلى تبيين المجملات وترجيح المحتملات وتقرير الواضحات، وكل ذلك بعرف الاستعمال، فكل صفة وقعت في سياق الذم كانت ذماً وإن كانت مدحاً بالوضع كقوله تعالى: ﴿ذُق اِِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ (الدخان: 46).
السياق المعاصر وتحدّياته للدراسات الإسلاميَّة
يراد بـ”السياق المعاصر” الأوضاع العالميَّة الراهنة التي نعيشها في عصرنا هذا. وهو سياق اصطلحت على تسميته تراثيّاً بـ”سياق الحال أو سياق المقام”. لقد أوجدت هذه الأوضاع بكل متغيِّراتها مصفوفة نظم ومنظومة قيم، وشبكات علاقات نجمت عن مجموعة كبيرة من التغيرُّات والتطوّرات التي خضعت لها البشريَّة خلال القرون الخمسة الأخيرة. فقد تتابعت مجموعة كبيرة من الثورات العقليَّة والعلميَّة والمنطقيَّة والصناعيَّة والتقنيَّة، كل منها قد أدّت إلى إحداث كم هائل من العلاقات وغيرها. وهذه التغيّرات والثورات وإن كانت قد ولدت في بؤرة من الأرض، أوروبا، لكنّها لم تلبث أن غمرت العالم، كلّه، وانتشرت في جوانبه انتشار اللَّيل والنهار، وشملت آثارها بشكل أو بآخر “المعمورة كلّها”.
سياق ما بعد الحداثة
بالنّسبة لأوربا ومجالها الحيويّ، من هذه الزاوية، أمريكا، والغرب بعامَّة أطلق جمهرة المفكرين فيها على “السياق المعاصر” سياق “ما بعد الحداثة”. ولعل ما يهمنا منه الآثار التي ترتَّبت على السياق السابق له، وهو “سياق الحداثة” خاصَّة في مجالات العلم والفكر والثقافة والجوانب الحضاريَّة المختلفة.
وتلك الآثار قد تناولت فيما تناولته الدين والطبيعة والتاريخ والإنسان. وما من ثورة من تلك الثورات إلاّ وقدَّمت مجموعة من الرؤى والأفكار التي تعارضت مع مسلّمات بشريَّة كانت مستقرة، أو أحدثت فيها تغيُّرات كبيرة، ومنها مسلّمات كنسيَّة لاهوتيَّة، أو مسلّمات دينيَّة مشتركة. وذلك قد فرض على “علماء اللاهوت” تغييرات كبيرة قامت على بعض تلك التغيُّرات مدارس وكنائس وطوائف جديدة، لا في النصرانيَّة، وحدها، بل في ديانات كثيرة حتى ضاقت مساحات الثوابت في كل الديانات التي كانت سائدة في الغرب ولا تزال، واتسعت مساحات المتغيِّرات؛ لتنسجم مع الثورات العديدة المتتابعة التي أشرنا إليها.
تأليه العلم
وحين برزت “الثورة العلميَّة” نادى البعض بـ”تأليه العلم”، والاستغناء التام عن “الدين”، وبـ”مركزيَّة الإنسان” بديلاً عن “مركزيَّة الله”، وبـ”مركزيَّة المختبر” بدلاً من “مركزيَّة الكنيسة”، وانبهرت البشريَّة بمنجزات العلم ومعطيات الحضارة التي أنشأها، وبدأ العلم يهدم بقواعد “التفكير البشريّ الخاصّة”، ويضع “قواعد تفكير بشريَّة عامَّة مشتركة” يضع أسسها في المختبرات وقواعد الصناعات العملاقة، وتتضافر المناجم والمصانع وعقد المواصلات، والاكتشافات على تقديم المتغيّرات المطلوبة لجعل تلك القواعد أكثر فاعليَّة وتأثيراً ولتغيير شبكات النظم والعلاقات بين البشر. وبدأ العلماء والمفكرون يقدّمون ما يستطيعون للحاق بقافلة “العلم الطبيعيّ وفلسفاته”، فوضعت علوم أو معارف تتناول “الإنسان” بجوانبه المختلفة. لتكون بعد ذلك علوماً سلوكيَّة واجتماعيَّة منبثقة من منطلقات الرؤى الجديدة. تتحكم في سائر ما تقدم، وبكل ما يستجد، وصارت تلك المعارف مرجعيَّة شبه مطلقة في بناء الرؤى والأفكار والنظم وتحديد العلاقات، وصياغة المفاهيم، وتشكيل المسلّمات وتحديد المتغيِّرات. وقام علماء اللّاهوت اليهود منهم والنصارى وكثير من قادة الأديان الوضعيَّة بتطوير علومهم اللّاهوتيَّة والدينيَّة، واستبدال بعضها والخضوع لمتطلبات تلك التغيّرات.
فصار في جل تلك الديانات تقليديّون وتجديديّون، وتكاثرت الانقسامات فيها. وتضيَّقت مساحة الثوابت فيها كثيراً مرة أخرى حتى صارت “النسبيَّة والاحتماليَّة” من المسلّمات العامّة.
أما “الإسلام” دين الله الخالد فإن عصمة الله سبحانه لكتابه، وحفظه وجمعه وإقراءه وعدم إنساء نبيّه، عليه السلام، شيئاً منه جعله ذلك في منأى عن التأثر الحاد بتلك العواصف، وهذا جانب إيجابيٌّ تمثّل بنعمة إلهيَّة ولاشك لا يد للمسلمين أنفسهم بها.
أمّا المسلمون، أنفسهم، فقد كان لهم وضع آخر باعتبارهم بشراً يتأثّرون بما يتأثّر البشر به من عوامل ومؤثّرات؛ فهم حين بدأت سلسلة “الثورات التي ذكرناها” كانوا في حالة سبات وتخلّف وتراجع حضاريّ فكانت ردود أفعالهم لما حدث مرتبكة مضطربة، ولم تسمح لهم أحوالهم تلك بجعل رد فعلهم لما حدث يتَّسم بالإيجابيَّة والقدرة والفاعليَّة والوعي الدقيق باللَّحظة التاريخيَّة وإدراك متطلَّباتها، وتحديد كيفيَّة الخروج من حالة الانفعال إلى حالة الفعل الإراديّ الهادف المنضبط.
فهم في جميع الفترات السابقة كانوا يواجهون مشكلات تفرزها بيئاتهم ونظم حياتهم فيواجهونها بحلول يأخذونها من “مرجعيّتهم” أو من “إطارهم المرجعيّ”. فالمشكلة وعلاجها يظهران داخل البيئة المسلمة”.
فالانقسامات، مثلاً، كانت تحدث بشكل “أفقيّ” حول فهم في “المرجعيَّة أو الإطار المرجعيّ” تنجم عنها فرق أو مذاهب تبقى مهما اختلفت في دائرة الإطار الجامع.
لكنّهم فجأة وجدوا أنفسهم يختلفون هذه المرّة اختلافات رأسيَّة تحدث فصاماً غير معهود من ناحية، ومرجعيَّته في المعالجة مرجعيَّة أخرى خارجيَّة. فحين تطرح قضايا “المرأة” مثلاً أو “حقوق الإنسان” أو “قضيّة الحريَّة والديمقراطيَّة” تجد مسلماً ملتزماً بـ”المرجعيَّة الإسلاميَّة وبالإطار المرجعيّ الإسلاميّ” يقدم فيها خطاباً لا يجد صدى عند أخيه العلمانيّ الذي يصر على التثبُّت بانتمائه الإسلاميّ، ويرفض الإلحاد أو الطعن في الدين، بل يتمسّك به على المستوى الفرديّ؛ ومع ذلك فإنّه يرفض معطيات “المرجعيَّة الفقهيَّة” وخطابها ومعالجتها. فإذا قيل له: إنّه خطاب شرعيٌّ جاءت به نصوص شرعيَّة عمد إلى “التأويل”، والدعوة إلى نـزع من “تجديد أو اجتهاد” يخفّف من إلزاميَّة النصوص لينسجم مع أوضاع العالم الذي يعيش فيه، وإذا كان “الإصلاحيّون والمعتدلون” في الأديان الأخرى قد استطاعوا أن يتجاوزوا “أزمة التناقض مع قواعد التفكير الإنسانيَّة المشتركة” بقبول المعطيات العلميَّة، وتأويل النص الدينيّ، أو تهميش دوره فلِمَ لا يفعل علماء المسلمين الشيء نفسه، ويسلكوا السبيل ذاته فيريحون ويستريحون؟! ويحتلُّون موقعهم في مسيرة “العولمة”.
الاستشراق الجديد
ثم بدأت مراكز البحوث والدراسات الغربيَّة تقوم بحفريّات متنوّعة في مصادر الإسلام والمعرفة الإسلاميَّة والثقافة الإسلاميَّة والتاريخ الإسلاميّ؛ ووضع العقل المسلم والنفسيَّة المسلمة، و”الشخصيَّة الإسلاميَّة” بكل جوانبها على طاولات تشريح وتفكيك في محاولات مستميتة لرصد كل شيء. وفرز وميز كل مؤثّر أو متغيِّر. وورث “الاستشراق اليهوديُّ” ذلك، كلّه، وبدأ يتعامل معه بخبراته المتراكمة عبر القرون، وتجاربه الغنيَّة في الاختراق والتزييف والقراءات الملتوية، وإرادته الحديديَّة لحشر هذه الأمّة بكل ما تمثّل في أضيق الدوائر، وأحرج الزوايا لكيلا تقوم لهذه الأمَّة قائمة مرّة أخرى، ولتعود كما بدأت إلى جاهليّاتها المختلفة-جاهليّات الشعوب الأميَّة. وهكذا بلغنا هذا الذي سمّي بـ”السياق المعاصر”.
وهذا “السياق المعاصر” لم يشكل تحدياً لنا في حقل واحد من حقول المعرفة، أو جانب واحد من جوانب الحياة، بل شكَّل تحدِّياً شاملاً عامَّاً لا يمكن أن يواجه إلاّ بما يقدِّم استجابة عامَّة شاملة لذلك التحدِّي توازيه في القوَّة، وتخالفه في الاتجاه.
العلوم الإسلاميَّة
لا نريد بـ”العلوم الإسلاميَّة” كل ما أنتجه “العقل المسلم” من علوم ومعارف بعد أن فتح القرآن المجيد والرسول الكريم الآفاق والأنفس أمامه فجال في كل شيء، وأنتج في كل جانب فصنع فكراً وعلماً وحضارة ومدنيَّة وثقافة وعمراناً. بل نريد بها “العلوم النقليَّة” أو ما سمّي بـ”العلوم الشرعيَّة” أو “الدينيَّة” التي دارت بشكل مباشر حول القرآن المجيد تفسيراً أو بياناً واجتهاداً واستنباطاً وفقهاً فيه. وجعلها علماء “تصنيف العلوم” في أحد عشر علماً خمساً منها أسموها بـ”علوم المقاصد” وهي علوم العقيدة والتفسير والحديث والفقه والأصول. وسبعاً سمّيت بـ”علوم الوسائل”، وهي المنطق والنحو والصرف والبيان والبديع والمعاني واللّغة.
وهذه العلوم أو المعارف هي التي يعتمد عليها في تكوين علماء الدين أو “التديُّن” من إمامة وخطابة وتدريس وإفتاء وقضاء في مجالات خاصَّة. وما إلى ذلك!!
والذين أطلقوا عليها “العلوم الشرعيَّة” أرادوا التنبيه إلى أن “الشريعة” كانت المدار الأساسيّ الذي دارت حوله هذه المعارف من حيث الكشف عن مصدر الشريعة، وأدلتها ومداركها وأحكامها، وكيفيَّة الوصول إلى معرفة ما هو مشروع، وما ليس بمشروع من مباحثها، وذلك لضبط شؤون وشجون الحياة الإنسانيَّة بضوابط الشريعة الإلّهيَّة وتأسيس “فقه الدين” لإقامة عمليَّات ممارسة “التديُّن” على قواعده السليمة دون غلّوٍ ولا تفريط ولا إفراط ولا ابتداع.
وأطلق عليها البعض “العلوم الإسلاميَّة”، وذلك لتأكيد ارتباطها التاِّم بالإسلام منهجًا وغاية ومصادر. ولتتميَّز عن “علوم الأوائل” و”العلوم الفلسفيَّة” بصفة عامة.
وأطلق عليها “العلوم النقليَّة”، لاعتمادها على مناهج النقل والرواية في تعلُّمها وتعليمها وتناقلها وتداولها، وبناء مسائلها وجزئيَّاتها، وتكوين الملكة البحثيَّة فيها. وإن كانت أكثر جزئيَّاتها قد بنيت على مناهج استنباط!!
وأطلق عليها “علوم الديِّن” لدورانها حول “الخطاب أو النصّ الدينيّ” ابتداءً وتاريخًا وآثارًا وإنشاءً وكشفًا ولأنَّها الدليل المرشد في ممارسة “التديُّن”.
وهي علوم ومعارف نشأت عن تصوُّر ذي مواصفات خاصَّة “للقراءة” في الخطاب القرآنيّ وبيانه في السنن النبويّة القوليّة والفعليّة والتقريريّة؛ قائم على فرز وميز ما له علاقة بإنشاء الأحكام التكليفيّة والوضعيّة أو الكشف عنها. وقد نمت هذه العلوم وكملت لتكون بعد ذلك في خدمة ذلك الخطاب احتجاجًا له وتفسيرًا وبيانًا لمحتواه، وفقهًا فيه، وتوضيحًا لكيفيّة التعامل معه، وبناء قواعد الحياة والتوحيد والتزكية والعمران عليه.
فمداخلات هذه العلوم والمعارف من الخطاب ومخرجاتها تعود إلى الخطاب، لتكون جزءًا من مخرجاته بعد ذلك بشكل من الأشكال.
التحدّيات
إنّ “التحدّيات” التي تواجه هذه العلوم والمعارف وحملتها تحدِّيات كثيرة وخطيرة ومتنوِّعة في الوقت نفسه وهي تحدِّيات داخليَّة وأخرى خارجيَّة، ومحليَّة وعالميَّة. وقد لا تتسع هذه المناسبة لاستقراء هذه التحدِّيات، فلعل ذكر أهمها ينبّه إلى ما بقي منها.
1. إنّ سياق عصرنا، هذا، سياق عزل الدين، وحصره في دائرة الخصوصيَّة والشأن الشخصي.
2. إعلاء شأن الحسِّي والتجريبيّ والماديّ والاقتصاديّ.
3. تبع هذا تهميش دور أهل العلم الشرعيّ ومؤسّساته وانخفاض موازين الكفاءة بينهم وبين سواهم.
4.إخراج هذه العلوم والمعارف من دائرة العلم كما في “تعريف اليونيسكو” وغيره للعلم.
5. وبالتالي فعالم الشريعة يعد نفسه “سلطان العلماء” والناس لا يرون فيه إلا فقيهاً لا ينبغي أن يتدخل في أي شأن من شؤون الحياة خارج المسجد.
6. علوم لم تعد بمقاييس العصر ومناهجه من العلوم الضروريَّة، بل التكميليَّة أو الهامشيَّة.
7. علوم تعتمد على الرواية، والرواية لم تعد منهجاً معتدّاً به علميّاً إذا لم يعززها العلم ولذلك لجأ البعض للاستعانة بـ”الإعجاز العلميّ والآثار”.
8. ربطت شياطين الجن والإنس بينها وبين التخلف ونـزعت عنها فضائلها، بل حمّلت مسئوليَّة التخلف.
9. اختلف تصنيف البشر فبعد أن كان التصنيف يقوم على الإيمان والكفر صار يقوم على الإنتاج والتنمية.
10. النصوص الدينيَّة بحسب علوم العصر صارت تعد في النصوص “التاريخانيَّة” ونفوا عنها صفات “الإطلاق والقداسة”.
11. سيادة الفكر الليبرالي بكل ما أدىّ ويؤدي إليه من مركزيَّة الإنسان وغروره.
12. النظر إلى الشريعة على أنّها مجموعة قيود وضوابط مختلفة تنافي مركزية الإنسان وحقوقه.
13.تخلف المسلمين.
14.الصراع بين المفكر والفقيه.
15.الصراعات الطائفيَّة والمذهبيَّة.
16. الخلط بين الثابت والمتغير.
ثقافة الصراع على الهويَّة والانكفاء على التراث
هذا: والخطاب القرآنيّ لا تنقضي عجائبه، لا في نظمه ولا في سياقه ولا في مناسباته.
لعله قد اتضح مما قدمنا أنَّ “سياق الحال المعاصر” أنَّنا نقرأ هذا الكتاب القرآن المجيد ونحن نعايش أزمة طاحنة نلتمس في بحثنا في نظمه وخطابه ونصه وعجائبه سبيلا للخروج منها، لأنَّ القرآن المجيد بتلاوة الرسول العظيم، وتعليمه الكتاب والحكمة وتزكيته، وجهاد الناس به جهاداً كبيراً أوجد الأمة، وأنشأها، فهو مصدر التكوين وأس البناء، ومصدر الإحياء، ومنطلق التجديد.
إنَّنا نتناول هذا الموضوع القرآنيّ الهام “السياق”، وأمتنا التي كوّنها الكتاب؛ في حالة تفكك وتشرذم وفرقة واستضعاف وذلة لا مزيد عليها. ملتمسين للخلاص من هذه الحالة بالقرآن سبيلاً يرسمه لنا بمنهجه وسياقه ونظمه ومقاصده وكليَّاته ومحكم آياته.
فـ”القراءة السياقيَّة” قراءة من يلتمس بالكتاب الكونيّ الذي يهدي للتي هي أقوم منهجا لإعادة بناء الأمة وإخراجها من أزماتها انطلاقا من منهج التكوين بالقرآن الذي مارسه رسول الله، صلى الله عليه وسلم،.
إنَّ “القراءة السياقية” تنأى بنا عن القراءة وفقاً للتصور الكونيّ الماضويّ السكونيّ التاريخانيّ. كما تنأى بنا عن المنطق اللائكيّ المنسوب إلى الحداثة أو ما بعد الحداثة في دراسة اللاهوت.
و”القراءة السياقيَّة” قراءة تساعد على الكشف عن السنن الكونيَّة والاجتماعيَّة والقوانين التي تحكم حركة التاريخ والمجتمع والأمم كافة.
و”القراءة السياقيَّة” تساعدنا في الكشف عن الغايات والمقاصد التي رسمها الله تعالى لحركة الكون والإنسان والحياة في تفاعل وجدل لا ينقطع حتى تصل البشريَّة إلى غاية حدّدها العليم الخبير.
وبـ”القراءة السياقيَّة” نستطيع أن نلتمس سبيلنا لإعادة البناء.
لقد استهدفت هذه الندوة “بتقديم موضوع السياق” إعادة تعليم أبناء أمتنا كيفية القراءة الميسّرة، والتدبّر الحكيم والقراءة التي تتسم بالقدرة على بناء المرونة والحيويَّة في شخصيَّة الأمَّة، وتحقيق الفاعلية، والإرادة والعزيمة لإحياء عوامل التجدّد والدفع العمرانيّ، وإعادة بناء طاقات الأمَّة، في إطار يسمح بتحديد العلاقات بوضوح، بين الثابت والمتغيّر، وهي في الوقت نفسه تعلّمنا كيفيَّة التلاوة “حق التلاوة”؛ تلاوة أولئك الذين إذا تلوا آيات الله أو تُليت عليهم آياته، زادتهم إيمانا فانطلقوا، ويقينا فنهضوا، وعلى ربهم توكلوا في تصحيح مسار الأنفس، وتقويم بناء العقول، وارتياد الآفاق.
لقد آثرتم هذه القضية وتداولتم فيها انطلاقا من نسق ثقافيّ وإطار حضاريّ عمرانيّ وكيان اجتماعيّ قرآنيّ إسلاميّ صاغ عقولنا، وكوّن نفوسنا وبنى ثقافتنا بشريعة غلاّبة استطاعت أن تفرض نفسها على أبناء هذا الكيان الاجتماعيّ حتى حين تغيّب واصب بهذا التشرذم الذي نلحظه، فقد عرفت هذه الشريعة الغراء كيف تحول “الحرام” إلى “عيب” والواجب الشرعيّ إلى مطلوب أمَّتي. وكثيرا ما يجد الإنسان منَّا نفسه يقوم بشيء، أو يلاحظ تصرفا فيستحسن ويستقبح دون أن يلتفت إلى المصدر، ولكنه عند البحث يجد المصدر ذلك التشريع العظيم الذي ربط بين الأصل والعقل والنفس ليجعل المطلوب معروفا، والمرفوض منكراً.
إننا في دراساتنا كثيرا ما نغفل عن أنَّ آبائنا وأسلافنا قد خاضوا في كل ما خاضوا فيه، ولكن في إطار سيادة المرجعيَّة الإسلاميَّة. ونحن نخوض في كل ما نخوض فيه في ظل سيادة مرجعية مغايرة، لها أصولها وجذورها وسيرورتها وصيرورتها، فليس من العدل أن نحاكم تراثنا إلى هذه المرجعيَّة، ولن يخدم ذلك الموضوعيَّة ولا العلميَّة.
إننا نراجع في تراثنا ونحن في حالة استضعاف وهزيمة حضارية واستعلاء خارجي، تهيمن على نفوسنا مجموعات من المشاعر السلبية التي كثيراً ما تولد، عندنا، شعورا بالدونيّة بشكل ضاغط على محاولاتنا لتحقيق الاستقامة العلميَّة والموضوعيَّة في البحث، مهما حاولنا ولكن لابد مما ليس منه بدّ.
ولذلك فنحن أحوج ما نكون إلى دراسات متعمقة جادة وفاحصة في عمليَّات تكوين الأنساق الثقافيَّة، وتداخلها وتقابلها. وكذلك فيما يتعلق بالأديان وتداخلها وتقابلها وكيف يتم كل منهما وفي أي سياق الإيجابيَّة والسلبيَّة لذلك كلّه.
هناك ما تسميه د. منى أبو الفضل، عافاها الله، “جنيولوجيا النخب” أو “أنساب الأفكار” والأشخاص والثقافات وجنيولوجيا النخب، مدخل يستطيع أن يتبين الخاص والمشترك والطريقة التي تستطيع أن تحافظ على الهويَّة والخصوصيَّة وتوازن بين الخاص والمشترك في المجالات المعرفية.
لابد لنا من بناء مداخلنا النقديَّة لما نقرأ ولما نأخذ ولما ندع من ثقافات الآخرين ومن تراثنا.
إنَّ الحضارة المعاصرة حاولت أن تحقق لنفسها إعجازاً يفرض على الآخرين بوفرة المعلومات وكثرتها، وإشاعتها، وجعل الآخرين عاجزين ومشلولين أمام كثرتها وهيمنتها، وتشعبها، ويسر سهولة الوصول إليها، والقدرة على نسبة كل إنجاز لها.
ولذلك فلابد من التدرّع بالقدرة على القراءات المعرفيَّة والمنهجيَّة التي تكشف عن الغايات والمقاصد والنماذج والمناهج وتمكِّن من معرفة مناطق التقابل والتداخل، خاصة حين يكون التداخل المطلوب والتقابل بين شقين مختلفين أحدهما مفتوح والآخر مغلق واقف عند مضائق النهايات.
اتفقت كلمة الأمة منذ عهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، على أنَّ القرآن يفسر بعضه بعضا، وعلى أنَّ أفضل تفسير للقرآن هو ذلك النوع من التفسير…
الهوامش
————————————————————————————————————-
1. نسبوا هذا القول إلى الإمام علي رضي الله عنه…
2. لا وجود للبيت في ديوانه ولا في تكملة الديوان. فلعله سقط منهما. وقد ورد البيت منسوباً إليه بهذا اللفظ في شرح شذور الذهب (28) وتفسير الإمام الرازي (1/15) ط. بولاق. وورد البيت من غير عزو إلى الأخطل في تفسير النيسابوري (1/27) والرسالة العذراء (248) وشرح المفصل (1/21) والمصباح المنير (2/741) والبيان والتبيين (1/218). وجاء معزوّاً إليه في الموشى (8). وقد أكثر علماء الكلام من الاستشهاد به في بحث صفة “الكلام”. وانظر هامشنا على المحصول (2/27).
3. قال له عمر t يوم السقيفة على ما في النهاية لابن الأثير (2/134) ولسان العرب (5/425) ط. بولاق وتاج العروس للزبيدي (3/347) والكامل لابن الأثير ط. المنيرية وسيرة ابن هشام (2/659) والمحصول بتحقيقنا (2/26).
4. انظر المحصول بتحقيقنا (1/390) ط. مؤسسة الرسالة، بيروت (1412ﻫ، 1992م).
5. اللغة والمعنى والسياق، ص:215، وزارة الثقافة والإعلام العراقيَّة بغداد 1987، دار الشؤون الثقافيَّة العامة، تأليف جون لاينـز، ترجمة عباس صادق الوهاب.
6. المصدر نفسه.
7. ونتمنى على أبنائنا وبناتنا في الدراسات العليا أن يوجهوا بحوثهم نحو تجلية هذا المجال ففي ذلك خير كثير لا يقل عن الخير الذي حدث عندما وجه بعض الباحثين الجادين دراساتهم نحو “مقاصد الشريعة” فعادت على الدراسات الشرعيَّة والاجتماعيَّة عامَّة بكثير من الفوائد الملموسة حالياً. ويمكن تسجيل رسالة دكتوراه أو أكثر في بيان آثار السياق في التفسير، وفي فقه الكتاب، والسنّة، والقواعد الأصوليَّة، والفقه…
8. راجع الفوائد: (4/9-10)، وما نقله الزركشي عن ابن دقيق العب في البحر المحيط (4/289-290).
9. أخرج الواحدي في أسباب النـزول قصة مطولة باعتبارها سبب نـزول قوله تعالى: ]إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ[ (الاَنبياء: 100). فراجعه في أسباب النـزول (315-316) وأخرج ذلك الطبري في (17/76) والبغوي والخازن (4/262) ط. الطوبي. والسيوطي في الدر المنثور (4/337) ولباب النقول (2/11) بهامش تفسير الجلالين. ط. مصطفى الحلبي. وتفسير الجلالين نفسه (2/36) والقرطبي في تفسيره (11/343) وأبو حيان في تفسيره البحر المحيط (6/342)، والكشاف للزمخشري والفخر الرازي في التفسير (6/132-133) والمحصول (2/332)، والهيثمي في المجمع (7/68-69) وقد أوردوا حديثاً حول تخصيص “ما” بما لا يعقل أكد ابن حجر أنّه اشتهر على ألسنة كثير من علماء العجم وكتبهم وهو لا أصل له والوضع فيه ظاهر. وأبدى عجبه ممن نقله من المحدثين أمثال أبي داود وابن المنذر وابن مردويه والطبراني عن ابن عباس، وذلك في تخريجه لأحاديث الكشّاف ط. مصطفى محمد الجزء الرابع الملحق (111-112) وتأمل في تعليقنا المطول على قصة ابن الزبعرى بهامش المحصول (2/332-335).
10. قصة العرنيين والعقليين أو النفر المختلط من عقل وعزلية أو غيرهم قصة أخرجها المحدثون بطرق مختلفة تنتهي كلها بأنس ابن مالك، رضي الله عنه، وذلك أن عبد الملك ابن مروان ثم الحجاج بن يوسف الثقفي قد سأله كل منهما عن أشد وأقصى عقوبة عاقب رسول الله، عليه السلام، بها فذكر لهم قصة هؤلاء والحديث على صحته وكثرة طرقه وأسانيده المنتهية بأنس قد كره التحديث به الحسن البصري وغيره من الأئمة وأعلنوا اعتراضهم على أنس وتمنيهم لو أنه لم يحدث الظلمة به لأنهم وجدوا فيه تشجيعاً على ممارسة عقوبات النكال المشددة ولو لم توجد ظروف مقتضية للتحديد ولدينا دراسة نقوم بإعدادها حالياً حول هذا الحديث وما في متنه والطرق التي روي فيها وعلاقته بما عرف بـ”حد الحرابة” نرجو الله تعالى أن يعيننا على إكمالها.
11. بدائع الفوائد (4/9-10).
12. انظر البرهان لإمام الحرمين (1/125) فق (72) المنصورة: دار الوفاء، مصر ، ط2، (1418ﻫ/1997م).
13. راجع البحر المحيط، م، س.