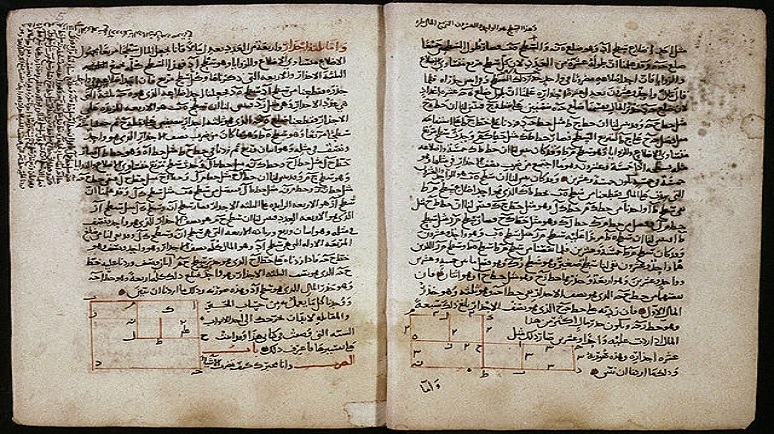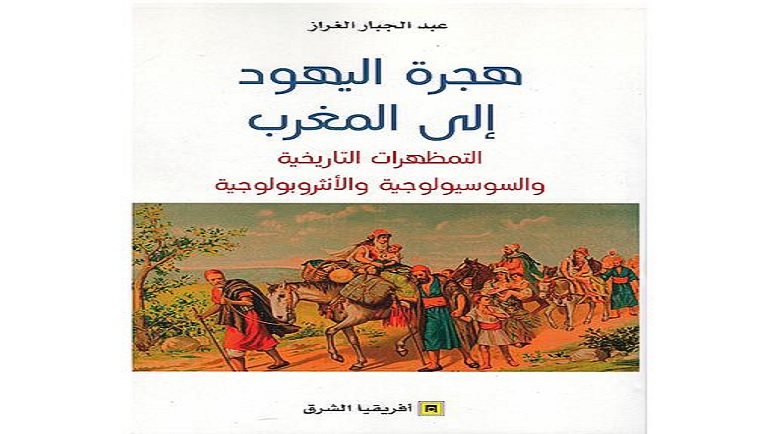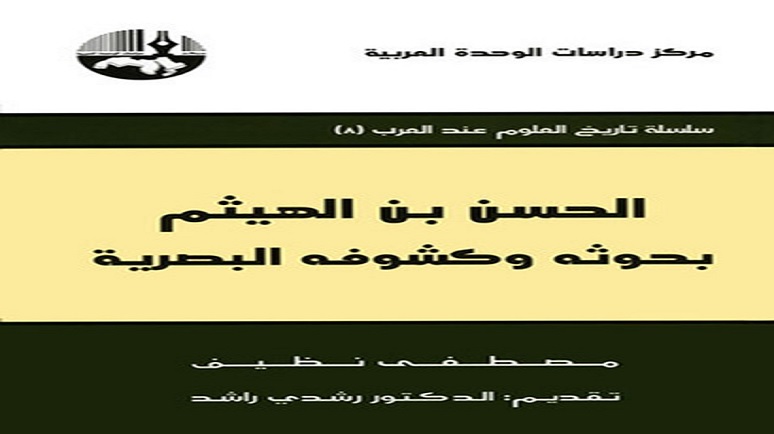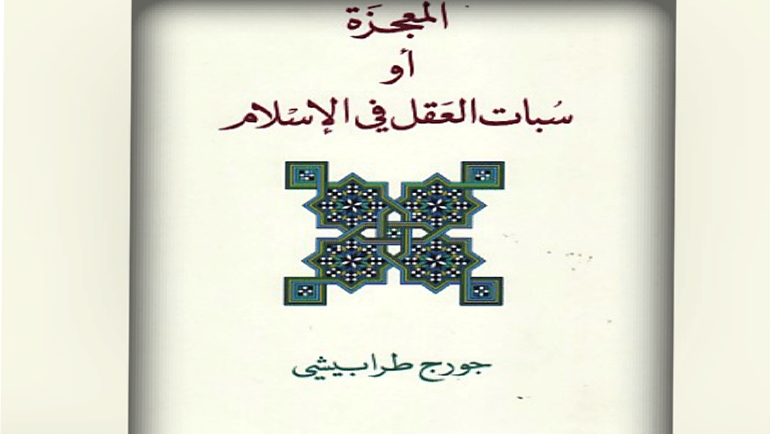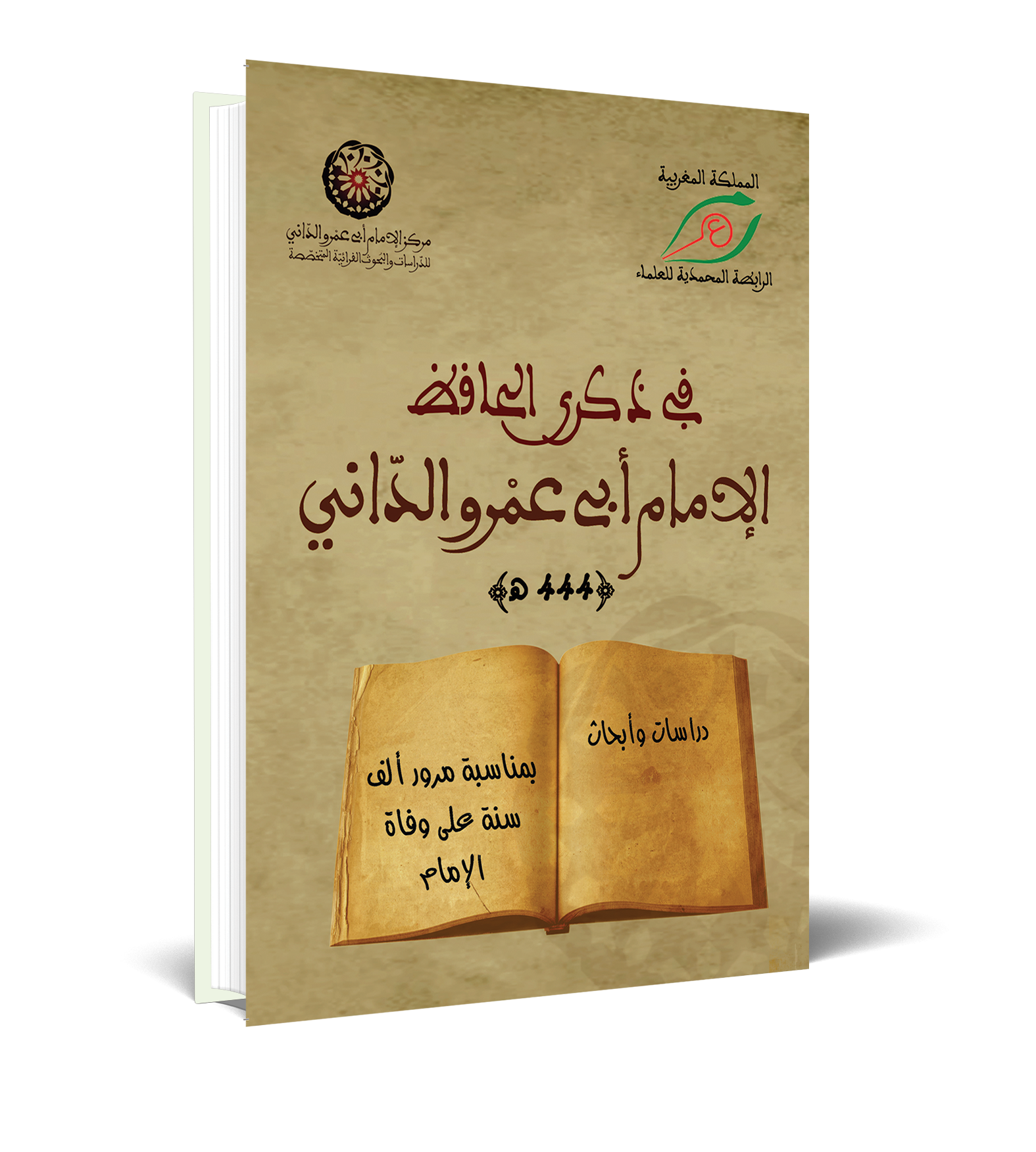صدر عن دار الانتشار العربي ببيروت كتاب “الإسلام كمجاوز للحداثة ولما بعد الحداثة” في طبعته الأولى 2008 لمؤلفه الأستاذ سالم القمودي. وهو كتاب من القطع الكبير (295 صفحة) ينقسم إلى ستة أجزاء، كل جزء يشتمل على مجموعة من الفصول؛ في الجزء الأول تناول الكاتب “الإسلام والفلسفة والعلم” وفي الجزء الثاني أثار إشكالية “الحداثة وما بعد الحداثة”. ليعمق مقاربته، بعد ذلك، في الجزء الثالث حول “الإنسان بين الحداثة وما بعد الحداثة” مبرزا كيف أن ما بعد الحداثة تستبطن خطابا “ضد النزعة الإنسانية” من خلال تكريسها للتمرد على القيم الأخلاقية، وكاشفا ادعاءات البنيوية العلمية ودعوتها، بالمقابل، إلى موت الإنسان ليخلص إلى عرض أهم مقومات التصور الإسلامي للإنسان..
أما الجزء الرابع فقد تناول فيه حقوق الإنسان في المرجعيتين الأوروبية والإسلامية.. في حين تطرق الجزء الخامس إلى العلاقة بين الإسلام والغرب ليخلص إلى أن عمق الصراع بين المجالين الحضاريين صراع ديني ثقافي.. ناتج بشكل أساسي على جهل الغرب للإسلام..
وأخيرا عالج الجزء السادس إشكالية “النهوض الحضاري الإسلامي” وقد تناول فيه الكاتب فكرة التقدم في الإسلام، وحدود دور الإنسان في صناعة التاريخ، منبها إلى خطورة القراءة الخاطئة للإسلام، ومشددا على أن عملية التغيير مسؤولية تقع على كاهل الفرد والجماعة على حد سواء من منطلق العلاقة الجدلية والوظيفية بين الإرادة والفعل سعيا لتحقيق مشروع النهضة التي عمل المؤلف على تحديد أهم شروطها..
وفي هذا السياق يؤكد أن أي مشروع حضاري حقيقي لأي مجتمع من المجتمعات الإسلامية لن يفلح ما لم ينطلق من الإسلام كأصل مرجعي هاد لحركة الفعل التاريخي للمسلمين، وأن التجربة التاريخية أثبتت، بما لا يدع أي مجال للشك، أن النماذج التي قامت على فلسفات وإيديولوجيات غريبة ومفارقة لشرطها الحضاري والعقائدي، وبالتالي الثقافي كان مصيرها الفشل الذر يع المعطل للتطور الطبيعي والذاتي للأمة. ذلك أن الإسلام، وفقا لهذا التصور، “يشكل القانون العام، أو قانون القوانين.. الذي يجب أن تستخلص منه، أو تستند إليه، أو تستأنس به كل القوانين التي تنظم المعاملات والعلاقات بين الناس في الواقع السياسي والاجتماعي؛ لأنه يملك إمكانية التواصل مع الزمان والمكان، ولا يقف عند بيئة دون أخرى، أو عند مجتمع دون آخر “كما أنه لم يكن أبدا” عائقا أمام أي نهوض، أو تقدم، أو تحديث لأي مجتمع من المجتمعات الإسلامية، بل كان دائما هو الدافع لأي تقدم، ولأي نهضة” (ص: 15).
لا يكل الباحث من التأكيد، في أكثر من موضع من مؤلفه، أن الإسلام لا يرفض الحداثة وإنما يدعونا،على النقيض من ذلك، إلى الأخذ باشتراطات منجزاتها العلمية والمنهجية.. لا يرفضها بقدر ما يدعونا إلى التوقف عند مضامينها القيمية كفلسفة وكرؤية للعالم والإنسان والعلاقات الاجتماعية.. وفي الوقت نفسه ينفي الكاتب أن يكون حديثه عن الإسلام وما بعد الحداثة من قبيل المقارنة “فنحن، يشدد، لا نضع الإسلام في مقابلة الحداثة أو نضع الحداثة في مقابلة الإسلام؛ لأن الإسلام دين.. وحي من الله رب العالمين والحداثة فلسفة.. مذهب.. وجهة نظر.. قد تنحرف في طريقها نحو الحقيقة..” ولذلك فهو “متعال للحداثة ولما بعد الحداثة، على مستوى الحقيقة.. وعلى مستوى التأسيس والتأصيل للحياة العامة في مختلف مجالاتها.. فهو يسع كل تحديث.. كل تقدم للعلم.. كل تراكم للمعرفة.. ويستغرق كل بحث عن الحقيقة.. ويؤسس للدنيا التي فيها معاش الإنسان كما يؤسس للآخرة التي إليها معاده.” (ص: 18).